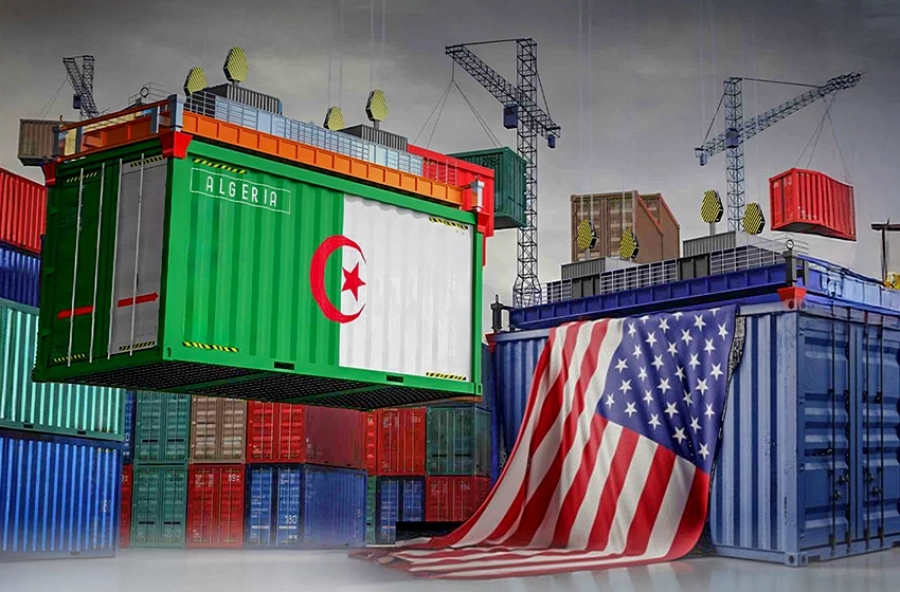قررت المفوضية الأوروبية فتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر بسبب ما اعتبرته قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، وهو ما وصفته الجزائر بالقرار المتسرع والأحادي الجانب. هذا التحرك الأوروبي المفاجئ جاء بعد جلستين فقط من المشاورات، رغم أن أغلب النقاط الخلافية كانت في طور التسوية، ما يعكس منطق تصعيد لا يتماشى مع روح الشراكة التي جمعت الطرفين لأكثر من عشرين عاما. وبينما أبدت الجزائر دهشتها من هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، تبرز خلفيات أعمق لهذا التوتر، تتصل بإعلان الجزائر في وقت سابق عن مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مراجعة تنطلق من واقع اقتصادي جديد ورؤية استراتيجية حديثة، وتسعى إلى تصحيح مسار علاقة ظلت لعقدين من الزمن تميل لصالح طرف واحد دون تحقيق التوازن المنشود.
هذا التصعيد الأوروبي الأخير لا يمكن فصله عن المسار الذي انطلقت فيه الجزائر منذ أشهر، حين قررت، بمنطق سيادي هادئ، إعادة تقييم اتفاق الشراكة الذي يجمعها بالاتحاد الأوروبي. فبينما كانت الجزائر تستعد لجولة جديدة من المشاورات وفق آلية قانونية منصوص عليها داخل الاتفاق نفسه، اختارت المفوضية الأوروبية التحرك في اتجاه مغاير تماما، من خلال إخطار الجزائر بفتح إجراء تحكيمي حول ما وصفته بقيود على التجارة والاستثمار، متجاهلة المسار التفاوضي الذي كان لا يزال مفتوحا.
الخطوة الأوروبية فُهمت في الجزائر على أنها خروج عن روح الشراكة، وخطوة تعكس توجها أحاديا لا يحترم القنوات الرسمية التي أُنشئت لإدارة الخلافات. وهو ما أكده بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي وصف القرار بالمتسرع، خصوصا أن ستة من أصل ثمانية ملفات خلافية كانت قيد التسوية، ولم تُستكمل بعد آليات الحوار بشأن الملفين المتبقيين.
ما زاد من حدة الموقف هو أن هذا الإجراء جاء بعد فترة قصيرة من مشاورات وصفت بالبناءة، ما يطرح علامات استفهام حول النوايا الحقيقية للاتحاد الأوروبي. فكيف يمكن تفسير الانتقال من أجواء الحوار الهادئ إلى خطوة قانونية قد تفتح الباب أمام التوتر؟ الإجابة، بحسب متابعين، تكمن في حجم التحول الحاصل في الجزائر، ورغبتها في تغيير قواعد العلاقة الاقتصادية نحو مبدأ التوازن والندية.
الوزير أحمد عطاف، في رده الرسمي، لم يكتف بالإعراب عن رفض الإجراء، وأوضح أن مجلس الشراكة، وهو الجهة المركزية المخولة للنظر في النزاعات، لم يُفعّل منذ أكثر من خمس سنوات رغم المطالب الجزائرية المتكررة. وبالتالي فإن إحالة الملف إلى التحكيم خارج هذا الإطار يعد خرقا للترتيبات المؤسساتية المنصوص عليها داخل الاتفاق.
ما يؤكد الطابع الأحادي لهذه الخطوة، أن الطرف الأوروبي تجاهل المقترحات العملية التي قدمتها الجزائر لحل ما تبقى من نقاط الخلاف، ولم يكلّف نفسه حتى بالرد الرسمي عليها. وهذا ما اعتبرته الجزائر دليلا على أن القرار الأوروبي لم يكن نتيجة إخفاق في التفاوض، وإنما انعكاسا لموقف سياسي لا يرتاح لفكرة الشريك المتكافئ.
بالمقابل، حرصت الجزائر على التمسك بالقنوات الدبلوماسية، ودعت عبر وزير خارجيتها إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الشراكة، حرصا منها على احترام المسار القانوني والمؤسساتي للعلاقة الثنائية. وهو ما يكشف أن الجزائر رغم موقفها القوي، ما زالت تراهن على الحوار القائم على احترام الاتفاق وليس على فرض التفسيرات الأحادية.
رد الفعل الجزائري تميز بالهدوء والتماسك، حيث لم تنجر الجزائر وراء خطاب تصعيدي، واكتفت بتثبيت موقفها عبر الحجج القانونية والسياسية. هذا الموقف يعزز صورة الجزائر كدولة مسؤولة، تدافع عن مصالحها من دون أن تتخلى عن التزاماتها، وتصر على أن الحلول تمر عبر التفاوض لا عبر فرض الإرادة.
ما يلفت الانتباه أن هذه الأزمة الدبلوماسية الصغيرة جاءت بعد أيام فقط من اتصالات وُصفت بالإيجابية بين الطرفين، من بينها مكالمة رسمية بين أحمد عطاف وكايا كالاس. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن التحكيم لم يكن وليد اللحظة، وإنما جزء من توجه أوروبي لمواجهة السياسة الجزائرية الجديدة بثوب قانوني، في محاولة لتقييد حركتها.
هذا المشهد يعيدنا إلى لب الموضوع: الجزائر لم تعد تقبل بوضع غير متكافئ، ولم تعد تتحرك بمنطق التابع، وإنما بمنطق الدولة التي تمتلك قراراتها وتدير علاقاتها وفق مصالحها الاستراتيجية. ومن هنا، لا يمكن قراءة الخطوة الأوروبية إلا في ضوء هذه الحقيقة الجديدة، التي أزعجت الكثير من العواصم في بروكسل.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري العودة إلى الخلفيات الأعمق التي دفعت الجزائر إلى فتح ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لا بهدف القطيعة، وإنما من أجل تصحيح علاقة اقتصادية ظلت لعشرين سنة تدور في حلقة مفرغة. وهي النقطة التي سيكون من المفيد تحليلها بدقة لفهم هذا التحول في الموقف الجزائري.
مراجعة الاتفاق... الجزائر تصحح اختلالات الماضي برؤية جديدة
فهم الخلفية الحقيقية للتصعيد الأوروبي يمرّ حتما عبر استيعاب السياق الذي سبق هذا التحكيم، والمتمثل في قرار الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من عشرين سنة من دخوله حيّز التنفيذ. فقد أعلنت الجزائر بوضوح أنها لم تعد تقبل بعلاقة غير متوازنة تُثقل كاهل اقتصادها ولا تعود عليها بالفائدة، مؤكدة أن الشراكة بصيغتها الحالية لم تعد مناسبة للتحولات التي عرفتها البلاد منذ توقيع الاتفاق سنة 2002.
الرئيس عبد المجيد تبون عبّر في أكثر من مناسبة عن أن الجزائر تغيرت، وأن ما كان مقبولا قبل عقدين لم يعد مقبولا اليوم، لا سياسيا ولا اقتصاديا. وأكد أن الاتفاق وُقّع في ظروف استثنائية كانت تمر بها الجزائر، خارجة من أزمة أمنية ومعتمدة بدرجة كبيرة على الواردات، في وقت لم يكن الاقتصاد الوطني قادرا على فرض شروطه.
هذا التوصيف الواقعي مثّل نقطة انطلاق نحو فتح ملف الاتفاق على الطاولة، انطلاقا من معطيات جديدة تضع الجزائر في موقع مختلف تماما. فمنذ 2019، شهد الاقتصاد الجزائري تحولات هيكلية في عدة قطاعات، أبرزها الزراعة، والصناعات الغذائية، والمواد الأولية، وهو ما جعل من مبدأ "رابح – رابح" عنوانا لمرحلة جديدة في علاقات الجزائر الخارجية.
الأرقام المتداولة في هذا السياق تسند الطرح الجزائري. فقد خسرت الجزائر، حسب تقديرات خبراء، أكثر من 30 مليار دولار منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أغلبها نتيجة الإعفاءات الجمركية التي استفادت منها المنتجات الأوروبية دون مقابل فعلي على شكل استثمار أو نقل تكنولوجيا. في المقابل، بقيت الصادرات الجزائرية محصورة في المحروقات بنسبة تجاوزت 90 بالمئة، مما عزز التبعية وهيمنت على الميزان التجاري.
الاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزاماته المعلنة في الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بالدعم المالي، ونقل التكنولوجيا، وفتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية. وبدلا من تطوير شراكة صناعية متكاملة، تحوّلت الجزائر إلى سوق استهلاكية للسلع الأوروبية، دون مردود حقيقي على التنمية المحلية أو التشغيل.
من هذا المنطلق، لم تكن المراجعة رغبة ظرفية أو تصعيدية، وإنما ضرورة فرضها الواقع الجديد. فالدولة التي كانت تعتمد على الاستيراد في معظم حاجياتها، باتت اليوم تحقق الاكتفاء الذاتي في قطاعات عديدة، وتسعى لتعزيز صادراتها غير النفطية. كما أن دخول آلاف المؤسسات الناشئة السوق المحلية، جعل من الجزائر شريكا منتجا، لا مجرد مستهلك.
وقد صاحب هذه المراجعة تطورٌ واضح في الخطاب السياسي الرسمي. فالرئيس تبون شدد على أن الجزائر لا تسعى إلى القطيعة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما إلى إعادة صياغة قواعد التعاون، بشكل يخدم الطرفين. هذا الخطاب يعكس روحا بنّاءة، ترفض الاستسلام للواقع السابق، وتبحث عن اتفاق أكثر عدالة وواقعية.
الموقف الجزائري لم يكن مفاجئا، وأُعلن عنه بشكل رسمي منذ بداية 2025، كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه اعترف، عبر سفيره بالجزائر، بأن الاتفاق القديم لم يعد صالحا، وأن الوقت قد حان لتعديله. لكن ما لم يكن متوقعا هو أن تُقابل هذه المراجعة بتصرف قانوني مفاجئ كالتحكيم، مما يطرح سؤالا كبيرا عن مدى استعداد بروكسل لمواكبة التحولات الحاصلة في الجزائر.
الجزائر دخلت هذا المسار من باب سيادي واضح، دون أن تتجاوز أحكام الاتفاق أو تلجأ إلى إجراءات أحادية. وقد وضعت مبدأ إعادة التوازن كعنوان رئيسي لتحركها، بما يضمن أن لا تكون الشراكة عبئا عليها، بل فرصة حقيقية للنمو المشترك. من هنا، يصبح من الضروري فهم التحول الجزائري كخيار استراتيجي، وليس كمجرد رد فعل ظرفي على أرقام أو معطيات اقتصادية.
هذا المنظور يدفع نحو طرح سؤال أكبر: كيف غيّرت الجزائر موقعها في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي؟ وما هي عناصر القوة الجديدة التي مكّنتها من رفع سقف مطالبها؟
عناصر القوة الجديدة... الجزائر تعيد رسم موازين الشراكة
بعد أن قررت الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة انطلاقا من اختلالات موثقة ومعطيات ملموسة، لم يكن هذا القرار معزولا عن تحولات أعمق تشهدها البلاد على أكثر من صعيد. فالجزائر لم تعد الطرف الضعيف الذي يقبل ما يُملى عليه، بل أصبحت تملك أوراقا استراتيجية تؤهلها لإعادة صياغة علاقاتها الخارجية من موقع سيادي ووازن، يعكس حقيقة تطورها الاقتصادي واستقرارها السياسي وتوسع نفوذها الإقليمي.
من أبرز عناصر القوة التي تملكها الجزائر اليوم هو موقعها الجيوسياسي الحساس، فهي تشكل بوابة إفريقيا إلى أوروبا، وعمقا استراتيجيا لمنطقة المغرب العربي والساحل. هذا الموقع يجعلها لاعبا لا يمكن تجاوزه في قضايا الطاقة، الأمن والهجرة، وهي ملفات تشكل أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنطلق، فإن مراجعة الاتفاق يأتي من إدراك واضح لقيمة الدور الجزائري.
الجزائر أصبحت من أهم مزوّدي أوروبا بالغاز الطبيعي، في وقت تشهد فيه القارة العجوز أزمة طاقة خانقة بفعل التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا. ومع انسحاب عدد من الموردين أو تراجع كمياتهم، ازدادت أهمية الجزائر كمصدر موثوق ومستقر، وهي ورقة أثبتت فاعليتها على طاولة التفاوض، لا من باب التهديد، وإنما من منطلق الشراكة التي تحترم مصالح الطرفين.
الاقتصاد الجزائري بدوره عرف تطورا ملحوظا، فالناتج المحلي الإجمالي تضاعف، وتمكنت البلاد من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات حساسة مثل الزراعة وبعض الصناعات التحويلية. كما برز قطاع المؤسسات الناشئة بقوة، مدعوما بإصلاحات قانونية وهيكلية، مما أوجد نسيجا اقتصاديا جديدا يمنح الجزائر قدرة على التفاوض كفاعل اقتصادي في طور التحول.
الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الجزائر يمثل عنصرا إضافيا يعزز مكانتها. ففي محيط إقليمي متقلب، تبرز الجزائر كدولة قوية المؤسسات، قادرة على اتخاذ قرارات سيادية ومواجهة التحديات الداخلية دون اهتزاز. هذا الاستقرار يمنح الثقة للمستثمرين، ويجعل من الجزائر وجهة محتملة لاستثمارات أوروبية تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة في الضفة الجنوبية للمتوسط.
التوجه الرسمي نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين هو كذلك مؤشر على تغيّر قواعد اللعبة. الجزائر لم تعد تحصر علاقاتها التجارية في دائرة واحدة، وانفتحت على قوى جديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، واستقطبت شركات عملاقة من روسيا، الصين، تركيا، والعديد من الدول التي أبدت رغبة في دخول السوق الجزائرية بشروط عادلة. هذا التنويع بعث رسالة صريحة للاتحاد الأوروبي مفادها أن الجزائر تملك خيارات عديدة.
هذا التموقع الجديد تعززه شبكة البنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، من موانئ وطرق سريعة إلى مناطق صناعية ومنشآت طاقوية متطورة، وهي مشاريع جعلت من الجزائر مركز عبور ووجهة استثمارية محتملة. كل هذه المؤشرات لم تعد مجرد شعارات، وتحوّلت إلى وقائع ميدانية تجلب الاهتمام الدولي وتعزز من وزن الجزائر التفاوضي.
أما على الصعيد التشريعي، فقد شهدت الجزائر إصلاحات جوهرية في قوانين الاستثمار، ألغت فيها قاعدة 51/49، وسنّت إجراءات لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط واضحة. وهو ما يعني أن الجزائر لم تغلق الأبواب، بل فتحتها أمام من يحترم قواعد الشفافية والندية، وهو موقف ينسجم مع توجهها نحو مراجعة شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
الجزائر تراهن اليوم على التعاون المنتج، وليس على التبعية التجارية. وهي لا ترفض التعامل مع أوروبا، لكنها ترفض الاستمرار في علاقة غير متوازنة. ومن خلال الموقف الأخير الذي عبّرت عنه عقب التحكيم الأوروبي، أثبتت أنها لا تسعى للصدام، وإنما للدفاع عن منطق التوازن، الذي يخدم الاستقرار المشترك لا طرفا واحدا فقط.
ومن خلال هذا التموقع الجديد، باتت الجزائر تفرض احترامها على الساحة الدولية، وتظهر قدرتها على خوض المفاوضات من موقع ندّي، وليس من موقع الحاجة. وهو ما يطرح على الطرف الأوروبي سؤالا صريحا: هل هو مستعد لمجاراة هذه التغيرات والتعامل مع الجزائر كشريك حقيقي؟ أم أنه يفضل الالتفاف على الواقع من خلال إجراءات أحادية تُربك العلاقة ولا تخدم مستقبلها؟
أوروبا في مأزق التردد... هل تخشى شريكا مستقلا؟
في ضوء التحولات العميقة التي فرضت الجزائر من خلالها معادلة جديدة في علاقاتها الخارجية، وجدت أوروبا نفسها أمام واقع لم تعتد عليه. الطرف الذي ظل لعقدين من الزمن يكتفي بدور المستورد والمستجيب، بات اليوم يطالب بإعادة التوازن، ويضع شروطا للشراكة، ويتحرك وفق مصالحه السيادية. هذا التحول خلق ارتباكا داخل مؤسسات القرار الأوروبي، وفتح نقاشا داخليا حول كيفية التعامل مع الجزائر الجديدة.
قرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر كان انعكاسا واضحا لحالة التوتر الداخلي في بروكسل، بين خطاب رسمي يدعو إلى تعميق الشراكة، وبين سلوك عملي يميل إلى الضغط والاستفزاز. فالتحكيم لم يكن ضرورة ملحّة، خصوصا وأن أغلب الملفات العالقة كانت قيد المعالجة، ولم يكن هناك مبرر واقعي لوقف المشاورات.
ما يزيد المشهد تعقيدا أن التحرك الأوروبي جاء بعد سلسلة من التصريحات الإيجابية تجاه الجزائر، آخرها ما أدلى به سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر من إشادة بمساعي المراجعة، وقوله إن الوقت قد حان لإعادة النظر في الاتفاق. هذا التناقض بين القول والفعل يعكس وجود تيارين داخل مؤسسات الاتحاد: أحدهما يدعو إلى التكيف مع الواقع الجديد، والآخر يتمسك بمقاربات الهيمنة الاقتصادية القديمة.
الاتحاد الأوروبي، وهو يواجه تحديات داخلية كبرى في مجالات الطاقة، الهجرة، وتباطؤ النمو، يدرك تماما أن خسارة الشراكة مع الجزائر ستكون مكلفة على أكثر من صعيد. الجزائر اليوم تمثل عمقا طاقويا استراتيجيا، وسوقا واعدة لاستثمارات متنوعة، ومركزا مستقرا في منطقة تموج بالصراعات. ومع ذلك، لم تتجه أوروبا نحو التفاهم، واختارت الدخول في نزاع قانوني لا يخلو من دلالات سياسية.
هذا التوجه يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتخلي عن عقلية الوصاية، والدخول فعليا في شراكات متكافئة. الجزائر، كما هو واضح من سلوكها السياسي، لا تقبل أن تكون ساحة خلفية أو سوقا مفتوحة فقط، بل تريد علاقة مبنية على المصالح المتبادلة. والجواب الأوروبي حتى الآن لا يبدو منسجما مع هذا الطموح.
قرار التحكيم يبدو، في قراءة واقعية، محاولة لفرض الأمر الواقع، أو لإرسال رسالة سياسية مفادها أن تجاوز الإطار الأوروبي التقليدي له ثمن. لكنه في الوقت ذاته يعكس قلقا أوروبيا من فقدان التأثير في بلد أصبح يتحرك بثقة ويصوغ رؤيته الاقتصادية دون انتظار الإملاءات. فالجزائر اليوم تتقن إدارة أوراقها، وتحسن استخدام ما تملك من أدوات تفاوضية دون ضجيج.
ورغم أن التصعيد القانوني الأوروبي يبدو من الخارج خطوة محسوبة، إلا أنه ينطوي على مجازفة دبلوماسية. لأن الجزائر، بما أبدته من اتزان وثقة، لم تتراجع أمام التحكيم، بل سارعت إلى الرد عبر القنوات الرسمية، وأكدت تمسكها بمجلس الشراكة كإطار شرعي لمعالجة الخلافات. وهو ما يعيد الكرة إلى ملعب الأوروبيين، ويضعهم أمام سؤال الشرعية القانونية والسياسية لما أقدموا عليه.
من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذا التحكيم عن محاولات أخرى شهدتها السنوات الماضية للضغط على الجزائر، سواء عبر تقارير مغلوطة، أو من خلال تحفظات أوروبية على قوانين الاستثمار الجديدة، أو سياسات الحماية الاقتصادية. هذه التحركات، وإن لم تكن معلنة كلها، تكشف أن الجزائر المستقلة اقتصاديا لا تروق لبعض دوائر القرار الأوروبي.
الخطاب الرسمي الجزائري، رغم كل هذه الضغوط، لم يخرج عن طابعه المتزن. فقد جددت الجزائر التزامها بالحوار وبالشراكة المتوازنة، ورفضت الانجرار نحو التصعيد الإعلامي أو السياسي. وهذا الموقف في حد ذاته يعكس نضجا سياسيا، ويؤكد أن الجزائر لا تبحث عن الخصومة، وإنما تبحث عن الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.
هذا الإرباك الأوروبي لم يكن مفاجئا، فالاتحاد اعتاد التعامل مع دول جنوب المتوسط من موقع التفوق، وها هو اليوم يصطدم بحالة جزائرية استثنائية ترفض التبعية، وتطرح معادلة جديدة لا تقبل أنصاف الحلول. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل أوروبا مستعدة للانتقال من مرحلة الامتياز إلى مرحلة الشراكة الحقيقية؟ أم أنها تفضل خوض معارك قانونية تهربا من الاعتراف بالتغيير؟
ما بعد التحكيم... الجزائر ترسم ملامح شراكة ناضجة
وسط هذا المشهد الذي تحوّل من مشاورات هادئة إلى مسارات قانونية متوترة، تبدو الجزائر عازمة على المضي في طريق إعادة تعريف مفهوم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق منطق جديد لا يقوم على المجاملة الدبلوماسية، بل على المعايير الواقعية للمصالح المتبادلة. فالتحكيم الذي سعت إليه المفوضية الأوروبية لم يدفع الجزائر إلى التراجع، وكشف عن رسوخ في الموقف ووضوح في الرؤية، مما يعزز من مناعتها التفاوضية ويمنحها فرصة لإعادة طرح أوراقها من موقع أكثر اتزانا.
الجزائر لا تنظر إلى هذا التصعيد كأزمة، بل كمرحلة انتقالية تفرض إعادة ترتيب قواعد التعاون مع الشركاء الأوروبيين. فالتحكيم في حد ذاته ليس نهاية المسار، ويعد نقطة اختبار حقيقية لمدى استعداد الطرفين للذهاب بعيدا في بناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل. ومن هذا المنظور، فإن ما بعد التحكيم يجب أن يكون مناسبة لتقييم العلاقة من الجذور، وليس فقط معالجة خلاف ظرفي.
مراجعة اتفاق الشراكة تحوّلت إلى أولوية وطنية مدفوعة بمعطيات اقتصادية واضحة. الجزائر لم تعد تقبل بدور المستهلك الدائم للبضائع الأوروبية، وتسعى لتكون شريكا منتجا ومصدرا ومضيفا للاستثمارات ذات القيمة المضافة. وهذا التحول في الطموح الاقتصادي لا يمكن أن يتعايش مع اتفاق قديم لم يراعِ منطق التطور ولا متطلبات التوازن.
لذلك، فإن الجزائر تذهب نحو صياغة تصور جديد للشراكات الاقتصادية، يتجاوز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ليشمل نماذج التعاون مع دول أخرى أثبتت قدرتها على بناء علاقات متكافئة. هذا الانفتاح لا يعني القطيعة مع أوروبا، وإنما يعني أن الجزائر ترفض الحصرية، وتؤمن بحقها في تنويع شركائها بما يضمن لها الاستفادة القصوى من موقعها وإمكاناتها.
في الوقت ذاته، تبعث الجزائر برسائل طمأنة مفادها أن الشراكة ما تزال خيارا استراتيجيا، لكن وفق أسس أكثر واقعية. فالرئيس تبون أكد أكثر من مرة أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ليست محل عداء، وإنما محل مراجعة. وهذا ما يدل على أن الجزائر ما تزال تترك الباب مفتوحا، لكنها في الآن نفسه، لا تقبل أن يُفتح ذلك الباب على حساب سيادتها الاقتصادية.
تفعيل أدوات الحماية التجارية، وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع نحو التصدير خارج المحروقات، كلها خطوات تندرج في استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تقليص التبعية وبناء اقتصاد متنوع ومستقل. ومن الطبيعي أن تصطدم هذه السياسة بأطراف خارجية كانت تستفيد من اختلال التوازن، وتعمل على تعطيل كل محاولة لتصحيح الوضع.
ما بعد التحكيم ستكون بداية مرحلة أكثر وعيا وجرأة في إدارة العلاقات الخارجية. والجزائر، التي تقف اليوم في مواجهة هذا التحدي، تبدو مستعدة لترسيخ مفهوم جديد للشراكة، لا يقوم على تنازلات، بل على احترام سيادتها ومكانتها، ورغبتها في أن تكون طرفا فاعلا في صياغة مصيرها الاقتصادي والتجاري.
لم يكن لجوء الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحكيمي ضد الجزائر سوى انعكاس لحالة ارتباك داخلية تجاه شريك بدأ يفرض منطقه الجديد بثقة ووضوح. الجزائر لم تعد تقبل بدور الطرف المنفعل في معادلة تجارية مختلة، وباتت تُعيد ترتيب أولوياتها من منطلق سيادي واقتصادي صلب. هذا التحكيم، الذي أراده البعض أداة ضغط، كشف في الواقع عن ثبات الموقف الجزائري وهدوئه، وعن انتقاله من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة، في سياق مراجعة شاملة لأسس التعاون الدولي.
لقد أثبتت الجزائر من خلال هذا المسار أنها لا تتعامل بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تُعيد بها صياغة شراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية ويحفظ توازن علاقاتها الخارجية. فالدولة التي بنت استقلالها السياسي بثمن باهظ، لا يمكن أن تفرّط في استقلالها الاقتصادي، خاصة في ظل ما تملكه اليوم من أوراق قوة، تتنوع بين الأمن الطاقوي، الموقع الجيوسياسي، وتوسّع النسيج الإنتاجي الوطني.
في ظل هذه المعطيات، تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة أكثر نضجًا في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، علاقة لا تدار بالخضوع ولا تُملى بالشروط، وإنم تبنى بالحوار المتكافئ والإرادة المشتركة. فإن كانت أوروبا حريصة فعلا على الحفاظ على شراكة استراتيجية مع الجزائر، فعليها أن تدرك أن الزمن الذي كانت تتحرك فيه منفردة قد انتهى، وأن الجزائر اليوم تصيغ مستقبلها بشروطها، لا استعلاء، بل استحقاقا.

بقلم: الأستاذ الدكتور سعيدي يحيى - كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بالمسيلة
الاتفاق التجاري الجزائري الأوروبي: عقدين من الاختلال والتوجّه نحو إعادة التوازن السيادي
وُقّعت اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية سنة 2002 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005 بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول سنة 2007، وتعزيز الاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية. لكن بعد 20 عامًا، ما زالت النتائج غير متوازنة ومخيبة للجزائر. لا تزال الجزائر تعاني من عجز تجاري مستمر مع أوروبا، في حين يبقى الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي محدودًا ومتركزًا في قطاع المحروقات (الهيدروكاربونات).
في هذا السياق، تُعدّ مطالبة الجزائر بإعادة التفاوض على الاتفاقية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل خطوة سيادية واستراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وإعادة تحديد شروط الانخراط مع أوروبا.
علاقة تجارية مبنية على الاختلال
تُظهر هيكلة التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نمطًا مقلقًا. تستورد الجزائر من أوروبا مجموعة واسعة من السلع المصنعة – الآلات، والمعدات النقل، والكيماويات، والمنتجات الغذائية – في حين تصدّر النفط والغاز، وهو ما يشكّل أكثر من 90% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
بالاعتماد على بيانات قاعدة COMTRADE التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2022، يتضح وجود اختلال كبير في بنية التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سواء من حيث التنوع أو القيمة المضافة.
ففي الوقت الذي تُشكّل فيه الآلات ومعدات النقل الحصة الأكبر من صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر بنسبة 42%، لا تمثل هذه الفئة سوى 6% من صادرات الجزائر نحو أوروبا، ما يعكس اعتمادًا جزائريًا مرتفعًا على التكنولوجيا المستوردة وضعفًا في القدرة التصنيعية المحلية.
أما في قطاع الكيمياء والبلاستيك، فقد بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر 18%، مقابل 1% فقط من الصادرات الجزائرية نحو أوروبا، ما يدل على ضعف القاعدة الصناعية الجزائرية في هذا المجال، بالرغم من توفر الموارد الأولية.
ويبدو التفاوت جليًا أيضًا في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، حيث يُصدّر الاتحاد الأوروبي ما نسبته 15% من صادراته نحو الجزائر ضمن هذا القطاع، مقابل 2% فقط من الصادرات الجزائرية نحوه، وهو مؤشر على الحاجة لتطوير القدرات الفلاحية والصناعات التحويلية الزراعية محليًا.
أما الهيدروكاربونات، فتُمثّل حجر الزاوية في صادرات الجزائر إلى أوروبا، بنسبة ضخمة تبلغ 90%، مقابل 2% فقط من صادرات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال نحو الجزائر. هذا الرقم يُؤكد استمرار الجزائر في الاعتماد المفرط على المحروقات كمورد رئيسي للتصدير، ويُبرز هشاشة تنوع صادراتها.
وفي خانة السلع الأخرى، مثل المواد الخام الأولية أو المنتجات نصف المصنعة، يُصدّر الاتحاد الأوروبي 23% من هذه الفئة نحو الجزائر، بينما تُمثل هذه المنتجات 1% فقط من صادرات الجزائر إلى أوروبا، ما يعمق الفجوة التجارية ويُظهر أن الجزائر ما تزال بعيدة عن دخول أسواق الاتحاد بمنتجات متنوعة وذات قيمة مضافة.
هذا التوزيع غير المتوازن يُعزز الدعوات المتزايدة داخل الجزائر لإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتوجيهه نحو شراكة إنتاجية واستثمارية حقيقية بدل الاكتفاء بالتبادل التجاري التقليدي.
هذا الاعتماد على الهيدروكربونات يجعل الجزائر عرضة للتقلبات في أسعار السوق العالمية، ويعيق الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تسيطر السلع الأوروبية على السوق الجزائرية، مع قلة المنافسة من المنتجين المحليين.
كانت الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الجزائر على الاندماج في الأسواق العالمية، لكنها في الواقع أبقتها في موقع مصدّر للمواد الخام – وليس الشريك الصناعي أو التكنولوجي الذي توقعته الاتفاقية.
الاستثمار: فرصة ضائعة
من أبرز الوعود التي حملتها الاتفاقية، زيادة الاستثمارات المشتركة. لكن الاستثمار الأوروبي في الجزائر كان محدودًا ومتخصصًا.
ركزت الشركات الأوروبية على النفط والغاز، حيث العوائد مرتفعة والمخاطر محدودة. أما في مجالات مثل التصنيع، والزراعة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالحضور الأوروبي ضعيف.
تُظهر التقارير السنوية لبنك الجزائر أن الاستثمارات الأوروبية في الجزائر تعاني من تركّز مفرط في قطاع المحروقات، على حساب القطاعات المنتجة الأخرى التي تحتاجها البلاد لتنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.
فبحسب الأرقام، يستحوذ قطاع النفط والغاز على 55% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، ما يعكس استمرار النظرة التقليدية للجزائر كمصدر للطاقة، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى استعداد الشريك الأوروبي للمساهمة في التحول الاقتصادي للجزائر.
أما قطاع المالية والتأمين، فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 20%، وهو ما يُبرز اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالخدمات البنكية والمالية، لكنه لا يُترجم بشكل مباشر إلى دعم للإنتاج أو خلق مناصب شغل مستدامة خارج العاصمة.
ويأتي قطاع التصنيع بنسبة 10% فقط، وهي نسبة متواضعة بالنظر إلى الطموحات الجزائرية في إعادة بعث الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة خارج قطاع المحروقات. هذه الأرقام توضح محدودية التمركز الصناعي الأوروبي في الجزائر، سواء من حيث الحجم أو التنوع.
أما الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، فلا يتجاوز 5%، رغم توفر الموارد الطبيعية والبشرية، ما يؤكد وجود فرص ضائعة كان يمكن أن تُترجم إلى تعاون مثمر في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي.
وأخيرًا، يُسجل قطاع البنية التحتية والطاقة (غير التقليدية) استثمارات أوروبية بنحو 10%، وهي نسبة لا تزال ضعيفة مقارنة بما تتيحه الجزائر من فرص واعدة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والنقل والموانئ، ما يدفع إلى ضرورة مراجعة أولويات الشراكة وجعلها أكثر اتساقًا مع متطلبات التنمية الوطنية.
هذا التوزيع غير المتوازن يُعزز الحاجة إلى تعديل اتفاق الشراكة بما يفرض توجهًا استثماريًا أكثر تنوعًا واستجابة لمصالح الجزائر الاقتصادية السيادية.
يعكس هذا الاهتمام المحدود كلًا من التحديات في مناخ الاستثمار الجزائري – مثل البيروقراطية والتشريعات غير الواضحة وغياب الحوافز – ونهج الاتحاد الأوروبي الذي أولى الوصول إلى السوق الأسبقية على التنمية.
في المقابل، استفادت بعض الدول المجاورة من تدفقات استثمارية أوروبية أقوى، خاصة في مجالات النسيج والتصنيع، بفضل بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وتنبؤًا.
الجزائر تريد إعادة ضبط العلاقة
في السنوات الأخيرة، أصبحت الجزائر واضحة: الاتفاقية الحالية لم تعد تخدم مصالحها الوطنية. وطالبت الحكومة بإعادة التفاوض، في إشارة إلى تحول في السياسة الاقتصادية والخارجية.
لا ينبغي رؤية هذه الخطوة كرفض لأوروبا، بل كخطوة سيادية واستراتيجية تهدف إلى إعادة توازن العلاقة – انطلاقًا من رغبة الجزائر في حماية مصالحها الاقتصادية، وتعزيز الصناعات المحلية، والحد من الاعتماد على شريك واحد.
وهي أيضًا تتماشى مع سياسة الجزائر الخارجية غير المحايدة، وعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع دول مثل الصين وروسيا والهند وجنوب الصحراء الإفريقي.
مقارنة مناخ التفاوض: 2002 مقابل اليوم
عندما وقعت الجزائر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، كان السياق الاقتصادي والجيوسياسي مختلفًا تمامًا :
كانت أسعار النفط منخفضة (حوالي 25 - 30 دولارًا للبرميل)، مما قلل من قدرة الجزائر على التفاوض.
كانت البلاد تخرج من عِقد من عدم الاستقرار السياسي والعنف.
كان هناك دفع قوي للانفتاح الاقتصادي تحت برامج صندوق النقد والبنك الدوليين.
كان الاتحاد الأوروبي في موقع قوي، بينما كانت الجزائر تبحث عن الوصول إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات.
نتيجة لذلك، تم توقيع الاتفاق من موقف ضعيف اقتصاديًا، ووافقت الجزائر على شروط تحرير تدريجي فضّلت المصدرين الأوروبيين.
مناخ 2024: الجزائر أقوى
اليوم، تدخل الجزائر إلى طاولة المفاوضات بقيمة استراتيجية أعلى، خاصة في قطاع الطاقة.
تعكس مقارنة المؤشرات الاقتصادية بين عامي 2002 و2024 تحولًا كبيرًا في مكانة الجزائر الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز موقفها التفاوضي بشأن تعديل اتفاق الشراكة.
في عام 2002، كان سعر النفط (برنت) لا يتجاوز 25 دولارًا للبرميل، في حين قفز في 2024 إلى نحو 85 دولارًا، ما منح الجزائر موارد مالية أكبر ومرونة أوسع في إدارة سياساتها الاقتصادية. ويُظهر قطاع الغاز صورة أكثر وضوحًا؛ فقد ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي من نحو 15 مليار متر مكعب سنويًا إلى ما يقارب 37 مليار متر مكعب، ما أدى إلى زيادة
حصة الجزائر من واردات الغاز الأوروبية من 7% إلى نحو 12%، مما يجعلها اليوم شريكًا طاقويًا لا غنى عنه في ظل التوترات الدولية وأزمات الطاقة.
كما شهد مجال الطاقات المتجددة تحوّلًا نوعيًا؛ ففي الوقت الذي كانت فيه القدرات الشمسية غير مستغلة في 2002، تشير التقديرات الحالية إلى إمكانية إنتاج تفوق 160 غيغاواط، وهو ما يفتح الباب أمام مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر والتصدير نحو أوروبا في إطار التحول الطاقوي.
أما على صعيد الاحتياطات من العملة الأجنبية، فقد انتقلت من نحو 60 مليار دولار في 2002 إلى قرابة 50 مليار دولار في 2024، رغم تراجعها مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنها لا تزال تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وفي ما يخص الناتج المحلي الإجمالي، فقد عرف نموًا لافتًا من نحو 70 مليار دولار في 2002 إلى ما يقارب 200 مليار دولار في 2024، ما يعكس توسعًا تدريجيًا في القاعدة الاقتصادية الجزائرية، رغم التحديات المرتبطة بتنويع مصادر النمو.
تشير هذه الأرقام مجتمعة إلى أن الجزائر باتت في موقع اقتصادي أقوى وأكثر نضجًا مقارنة ببداية الألفية، وهو ما يمنحها أوراق تفاوض إضافية لإعادة صياغة شروط الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفق منظور أكثر عدلاً وتوازنًا واستشرافًا للمستقبل.
هذا التحول في ديناميكيات الطاقة أعطى الجزائر موقفًا تفاوضيًا أقوى. الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي للبحث عن مصدرين بديلين للغاز، والجزائر واحدة من القليل القادر على ملء هذا الفراغ.
التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم المعادلة
الصراع الروسي الأوكراني وأسواق الطاقة
أدى الصراع في أوكرانيا إلى اختلالات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر بديلة للغاز غير روسيا. وباتت الجزائر، أحد أكبر مصدري الغاز للاتحاد الأوروبي، في موقع مفاوض أقوى.
زادت هذه التطورات من الوزن الاستراتيجي للجزائر، وعززت موقفها في إعادة التفاوض حول شروط الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
التوتر مع فرنسا
تدهورت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التاريخية والتصريحات الدبلوماسية والاتهامات بالتدخل. هذا التوتر دفع الجزائر إلى مراجعة علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا، وبالتالي مع الاتحاد الأوروبي ككل.
أصبحت الحكومة الجزائرية تنظر إلى قراراتها الاقتصادية من خلال عدسة السيادة المناهضة للاستعمار، مما جعل إعادة التفاوض على الاتفاقية ليس فقط مسألة اقتصادية، بل رمزًا للانفصال عن النفوذ الغربي.
الاضطرابات في الشرق الأوسط
مع تصاعد الصراع بين الكيان الإسرائيلي وحماس، وارتفاع التوترات في الخليج، وتحول التحالفات الإقليمية، أصبح البحر الأبيض المتوسط منطقة أكثر هشاشة. الجزائر، بصفتها قوة إقليمية كبرى، بدأت مراجعة شراكاتها الاستراتيجية، وتنظر إلى بناء علاقات اقتصادية مع دول تتقاسم معها رؤية الحياد وعدم التحالف والاستقلال.
وقد ساهمت هذه التطورات في جعل الجزائر أكثر حذرًا من الاعتماد على الغرب، وأكثر انفتاحًا على التعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي.
الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية: ما بعد الهيدروكربونات
ليست دبلوماسية الجزائر الطاقوية مقتصرة على النفط والغاز. فالجزائر لديها القدرة على أن تصبح وجهة للطاقة المتجددة في شمال إفريقيا، بفضل إمكانياتها الشمسية الكبيرة.
القدرة الشمسية: 160~ غيغاواط (تكفي لتزويد المنطقة بالكامل)
أهداف الطاقة المتجددة: 15 غيغاواط بحلول 2035
الهيدروجين الأخضر: واحدة من أفضل خمس دول في العالم
هذا يفتح بابًا لأشكال جديدة من التعاون الطاقي، مثل:
شراكات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة
صادرات الهيدروجين
ربط كهربائي إقليمي
إذا استطاعت الجزائر أن تُظهر نفسها كشريك في الطاقة النظيفة، فلن تقوي فقط موقفها التفاوضي، بل ستتماشى أيضًا مع أهداف الاتحاد الأوروبي في الانتقال الأخضر.
هل يصغي الاتحاد الأوروبي؟
لم يعارض الاتحاد الأوروبي الحوار، لكنه تصرف بتحفظ. ما يهتم به الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي هو الأمن الطاقي، خاصة الغاز، الذي يشكل 12 % من واردات الاتحاد الأوروبي.
قد تؤدي إعادة التفاوض إلى اختلالات في إمدادات الطاقة، لكنها أيضًا فرصة للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياسته تجاه الجوار، والانتقال من نهج تجاري إلى نهج تنموي، يدعم الصناعات المحلية، ونقل التكنولوجيا، ومشاريع الطاقة النظيفة.
نحو شراكة أكثر عدالة
مطالبة الجزائر بإعادة التفاوض ليست فقط مسألة اقتصادية – بل هي مسألة سيادة واستراتيجية واستقلال. إنها إشارة إلى أن الجزائر تريد إعادة تعريف موقعها في الاقتصاد العالمي، لا كمورد للخامات، بل كاقتصاد متنوع، تنافسي، ومستقل.
للحركة نحو الأمام، يجب على الطرفين:
تنويع التجارة خارج قطاع المحروقات (الهيدروكربونات)
دعم الصناعات المحلية عبر سياسات وحوافز أفضل
جذب الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل الزراعة، والتصنيع، والطاقة النظيفة
تحديث الاتفاق ليتماشى مع الواقع الجديد والمنفعة المشتركة.
علاقة الجزائر والاتحاد الأوروبي الآن عند مفترق طرق. يجب أن يكون الفصل القادم مكتوبًا ليس في الصمت، بل عبر حوار يحترم سيادة الجزائر واحتياجات الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية.

هواري تيغرسي - خبير اقتصادي
الجزائر تغيّرت... فهل يتغير الاتفاق مع أوروبا؟
يعطي الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، في تصريحه لـ "الأيام نيوز"، قراءة نقدية لمسار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ توقيعه في 2005، مؤكدا أن الجزائر اليوم لم تعد كما كانت قبل عقدين، منوها بأن التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد تفرض مراجعة عميقة لبنود الاتفاق وفق مبدأ "رابح-رابح"، يعيد التوازن للعلاقات الاقتصادية ويستجيب للتغيرات الحاصلة على مستوى الداخل الجزائري والسياق الدولي.
يرى الخبير هواري تيغرسي أن الوضع الاقتصادي للجزائر في عام 2025 مختلف جذريا عن وضعه في سنة توقيع الاتفاق سنة 2005، إذ عرفت البلاد تطورات عميقة في بنيتها الاقتصادية. فالجزائر التي كانت تعتمد بشكل شبه كلي على الريع الطاقوي، باتت اليوم في طور بناء اقتصاد متنوع يقوم على الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية.
ويؤكد أن من أبرز هذه التحولات بروز قطاعات جديدة تُسهم في الناتج المحلي، مع تسجيل تقدم في مسار الاكتفاء الذاتي، خاصة في قطاع الفلاحة الذي بات يؤمّن احتياجات السوق المحلي بدرجة أعلى مما كان عليه سابقا. هذا التحول، بحسب تيغرسي، لا يمكن تجاهله عند الحديث عن أي شراكة اقتصادية دولية.
ويضيف أن الدولة الجزائرية اعتمدت في السنوات الأخيرة سياسات عمومية تهدف إلى تقليص التبعية للمحروقات وتشجيع الصناعة الوطنية، ما يجعل من الضروري أن يُواكب اتفاق الشراكة هذه الديناميكية، بدل أن يظل جامدا في صيغة تجاوزها الزمن.
كما يشير الخبير إلى أن الجزائر باتت تملك رؤية استراتيجية واضحة في المجال الاقتصادي، تقوم على الاستقلالية والاندماج الإقليمي، وهو ما يتطلب أدوات تفاوضية جديدة وعلاقات دولية مبنية على التوازن والاحترام المتبادل.
ويُخلص إلى أن تغيّر موقع الجزائر في الخارطة الاقتصادية يفرض تعديل الاتفاقات التي لم تعد تعكس حقيقة الواقع الحالي، بما فيها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
بنود موقعة... لكن دون تنفيذ
ويشدد تيغرسي على أن أكثر من 90% من بنود اتفاق الشراكة لم تُفعّل، رغم مرور ما يقارب العقدين على توقيعه، وهو ما شكّل، حسب رأيه، أحد أبرز أسباب فشل الاتفاق في تحقيق أهدافه التنموية. فالاتفاق الذي وُقّع تحت شعار إنشاء منطقة تجارة حرة وتنشيط الاستثمار، لم يترجم فعليا على أرض الواقع.
ويُضيف أن البنود التي كانت تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، بقيت حبيسة النصوص ولم تعرف طريقها إلى التنفيذ، ما حرم الجزائر من فرص كان يمكن أن تُحدث تحولا نوعيا في منظومتها الاقتصادية.
ويرى أن غياب التفعيل لا يمكن فصله عن الإرادة السياسية للطرف الأوروبي، الذي لم يُبد الجدية المطلوبة في تطبيق الالتزامات، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وتسهيل نقل التكنولوجيا. وهو ما جعل الاتفاق يتحول، بمرور الوقت، إلى علاقة تجارية غير متكافئة.
ويُشير تيغرسي إلى أن الاتحاد الأوروبي اكتفى بالاستفادة من امتيازات دخول السوق الجزائرية، في حين لم يقم بما يُقابل ذلك من دعم فعلي للتنمية الاقتصادية في الجزائر، سواء عبر التمويلات أو بناء القدرات.
ويخلص إلى أن هذا الخلل في التنفيذ يطرح بجدية مسألة مراجعة الاتفاق، ليس فقط في محتواه، وإنما أيضا في آليات متابعته وتقييمه وتطبيق بنوده.
خلل تجاري مزمن لصالح الطرف الأوروبي
وأوضح تيغرسي أن المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كانت ولا تزال تميل بشكل واضح لصالح الطرف الأوروبي، حيث ظل دور الجزائر في هذه العلاقة مقتصرا على تصدير الموارد الطاقوية، في مقابل تدفق كبير للسلع الأوروبية نحو السوق الجزائرية.
ويشير إلى أن هذا الخلل الهيكلي حرم الجزائر من تحقيق قيمة مضافة حقيقية، خاصة في ظل غياب الصادرات الجزائرية الصناعية أو الفلاحية القادرة على دخول السوق الأوروبية بشكل تنافسي. الأمر الذي جعل الميزان التجاري يصب باستمرار في صالح الشريك الأوروبي.
كما يلفت إلى أن الاتفاق، في صيغته الحالية، لم يحمِ الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المتكافئة، بل ساهم في تقويض بعض القطاعات الإنتاجية المحلية التي لم تكن مؤهلة لمواجهة تدفق المنتجات الأوروبية منخفضة الكلفة.
ويُضيف أن أحد مظاهر هذا الخلل أيضا هو غياب التعاون المتوازن في مجالات حيوية مثل التعليم العالي، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، ما عمّق الفجوة بدل ردمها.
ويرى أن استمرار هذا النمط من المبادلات يُفرغ الاتفاق من مضمونه كشراكة، ويحوّله إلى علاقة تجارية تقليدية يربح منها طرف واحد فقط، وهو ما يجب أن يتغير في إطار التعديل المقترح.
غياب الاستثمارات في القطاعات الحيوية
وسلّط الخبير الضوء على نقطة جوهرية تمثلت في غياب الاستثمارات الأوروبية في العديد من القطاعات الحيوية بالجزائر، بما في ذلك قطاع الطاقة نفسه. وهو أمر لافت بالنظر إلى مكانة الجزائر كمصدر موثوق للطاقة نحو أوروبا.
ويؤكد تيغرسي أن الاتفاق لم ينجح في استقطاب رأس المال الأوروبي بالشكل الكافي، لا في الصناعة ولا في الفلاحة، ولا في التكنولوجيا أو البنية التحتية، ما جعل أثر الاتفاق محدودا من حيث خلق فرص العمل أو نقل المهارات.
ويشير إلى أن البيئة الاستثمارية في الجزائر كانت مستعدة لاستقبال مشاريع مشتركة، لكن الطرف الأوروبي لم يبادر فعليا نحو ضخ استثمارات منتجة، واكتفى في الغالب بالربح من المبادلات التجارية.
ويُبرز كذلك أن قطاع الطاقة، الذي يُفترض أن يكون مجالًا ذا أولوية بين الطرفين، لم يشهد شراكات أوروبية استراتيجية تُذكر، بل بقيت العلاقة مقتصرة على عقود التوريد طويلة الأمد، دون استثمارات في التكرير أو النقل أو الطاقة المتجددة.
ويخلص إلى أن ضعف الحضور الاستثماري الأوروبي في الجزائر يُعد أحد أوجه الإخلال بالاتفاق، ويُبرر المطالبة بمراجعته من منظور يحفّز الاستثمارات بدل التبادل التجاري فقط.
مراجعة شاملة نحو شراكة متوازنة
ويدعو تيغرسي في ختام تحليله إلى مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة بندا بندا، على أساس مبدأ "رابح-رابح"، لضمان تكافؤ المصالح وتحقيق الأهداف المشتركة بعيدا عن منطق الهيمنة.
ويؤكد أن هذه المراجعة يجب أن تركز على استقطاب التكنولوجيا الأوروبية ورأس المال المنتج، مع ربط أي امتيازات مستقبلية بشروط واضحة تتعلق بالتوظيف المحلي، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية في الجزائر.
ويرى أن تطوير قطاعات مثل البحث العلمي، التعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، يجب أن يكون في صلب التعاون الجديد، لأنها تُشكّل الأساس لأي اقتصاد صاعد قادر على المنافسة والانفتاح.
كما يشدد على ضرورة أن تتضمن الاتفاقية آليات متابعة وتقييم صارمة، تُمكّن الجزائر من حماية مصالحها الاقتصادية، واتخاذ قرارات مبنية على المعطيات والأداء الفعلي.
ويخلص إلى أن تجديد الشراكة مع أوروبا يجب أن ينطلق من واقع الجزائر اليوم، لا من ماضيها، وأن يُراعي التوازن والتكامل لا الاستفادة الأحادية، في إطار تحالف اقتصادي عادل يخدم الطرفين.

بقلم: عبد الرحمان هادف - مستشار دولي في التنمية الاقتصادية
هل آن للجزائر أن تعيد رسم شراكتها مع الاتحاد الأوروبي من منطلق سيادي؟
بعد أكثر من عقدين على دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في سبتمبر 2005، لا تزال الحصيلة تثير تساؤلات حقيقية حول مدى توازن هذا الإطار التعاقدي وجدواه الاقتصادية. فعلى الرغم من انفتاح السوق الجزائرية على المنتجات الأوروبية عبر التخفيض التدريجي للحقوق الجمركية، لم تُقابل هذه التنازلات بانسياب موازٍ للاستثمارات الأوروبية أو بنقل فعلي للتكنولوجيا، وهو ما أفرز خللاً هيكليًا في العلاقة التجارية والاستثمارية لصالح الطرف الأوروبي.
السياق الذي أُبرم فيه الاتفاق: الآمال والطموحات
جاء توقيع اتفاق الشراكة في سياق دولي اتسم بانفتاح اقتصادي كبير، حيث راهنت الجزائر حينها على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كخيار استراتيجي لدعم التحول نحو اقتصاد السوق. كانت الآمال معلقة على أن يسهم الاتفاق في تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE) وتنويع القاعدة الإنتاجية، من خلال التكامل مع السوق الأوروبية التي تُعد الشريك التجاري الأول للجزائر.
غير أن هذه الطموحات اصطدمت بتأخر واضح في تنفيذ إصلاحات هيكلية داخلية، خاصة على مستوى تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، وإنشاء بيئة أعمال جاذبة، فضلاً عن افتقار الاتفاق لبنود ملزمة بشأن الاستثمار أو بناء قدرات الإنتاج والتصدير.
تحولات جديدة في السياق الدولي: فرصة لمراجعة الأسس
تشهد المنظومة الاقتصادية العالمية اليوم تحولات عميقة ناتجة عن توالي الأزمات، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب الروسية-الأوكرانية، وما تبعها من توترات جيوسياسية وارتفاع في أسعار الطاقة، واختلالات في سلاسل الإمداد. هذه التحولات دفعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة استراتيجياته الاقتصادية والتركيز على أمن الطاقة والاستقلال الصناعي والتحول البيئي الرقمي.
في هذا السياق، تبرز الجزائر كشريك استراتيجي محتمل بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية والطاقوية، ما يعزز من قدرتها التفاوضية لإعادة تحديد معالم الشراكة، ليس فقط كمصدر طاقة، بل كفاعل اقتصادي إقليمي قادر على المساهمة في إعادة هيكلة سلاسل التوريد الأوروبية، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات النظيفة.
رغبة الجزائر في إعادة التفاوض: خيار سيادي واستراتيجي
التحرك الجزائري لإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة ليس موقفًا ظرفيًا، بل خيار سيادي واستراتيجي هدفه حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وتصحيح اختلالات دامت طويلاً. فالاتفاق بصيغته الحالية لم يعُد مناسبًا لطموحات الجزائر الجديدة، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المنتجة.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى مشروع الشراكة من خلال الاستثمارات المستدامة (SIP) الذي أُطلق في 2023، بمبادرة من وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، ويُنفذ من قبل مكتب الاستشارات الدولي GINGER-SOFRECO.
يهدف مشروع الشراكة من خلال الاستثمارات المستدامة (SIP) إلى نقل العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من مجرد تبادل تجاري غير متوازن إلى شراكة استراتيجية حقيقية تقوم على الاستثمار في قطاعات واعدة. وتأتي الصناعات التحويلية في طليعة هذه القطاعات، نظرًا لدورها في خلق القيمة المضافة محليًا وتقليص التبعية للخارج، من خلال تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تُعزز من قدرات الجزائر التصديرية.
كما تُعد الطاقات المتجددة والنظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، فرصة استراتيجية مزدوجة للطرفين، إذ تسمح للجزائر بلعب دور محوري في أمن الطاقة الأوروبي، وتتماشى مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون.
أما الصناعة الصيدلانية، فهي تمثل قطاعًا ذا أولوية كونه يساهم في تحقيق السيادة الصحية من جهة، ويوفر فرص شراكة تكنولوجية وتجارية هامة مع الشركاء الأوروبيين، خاصة في مجال إنتاج الأدوية الجنيسة والتقنيات الحيوية.
وفي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، تظهر إمكانية كبيرة لتطوير شراكات إنتاجية تدمج التكنولوجيا الأوروبية مع الموارد الطبيعية الجزائرية، بما يسمح بالرفع من الإنتاج الموجه للسوق المحلية والتصدير، مع التركيز على ضمان الأمن الغذائي.
وأخيرًا، يمثل التحول الرقمي أحد المفاتيح الأساسية لنجاح أي شراكة اقتصادية حديثة، حيث يُتيح تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وجذب استثمارات تكنولوجية نوعية، تُعزز من قدرة المؤسسات الجزائرية على الاندماج في الاقتصاد العالمي الرقمي.
هذا المشروع يعتبر فرصة مهمة لتقريب وجهات نظر الطرفين مقارنة بحجم التحديات والفرص، ما يتطلب تفعيلًا أكبر لآليات المتابعة والدفع من الطرفين لضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض
نحو شراكة قائمة على التوازن والربح المشترك: آليات للتفعيل والتجديد
إذا كانت الجزائر تسعى لإعادة التفاوض على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإن هذا المسعى لا يجب أن يُنظر إليه كخطوة تقنية فقط، بل كمدخل فعلي لتأسيس علاقة جديدة تقوم على مبدأ التوازن والربح المشترك. ولتحقيق هذا الهدف، تبرز الحاجة أولًا إلى تفعيل آليات الاتفاق القائمة، وعلى رأسها "مجلس الشراكة"، باعتباره الإطار المؤسساتي الأعلى لمتابعة الاتفاق. فبعد سنوات من الجمود، بات من الضروري أن يتحول هذا المجلس إلى منصة دورية لتقييم مراحل التنفيذ، ومعالجة الاختلالات، وتحديد أولويات جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، يُمثل تسريع تنفيذ مشروع SIP وتوسيع نطاقه خطوة مركزية لإنجاح هذا التحول. إذ لا يكفي الاكتفاء بالمبادرات المعلنة، بل ينبغي أن يشمل المشروع دعمًا حقيقيًا لقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، بما يعزز من حضورها في السوق الأوروبية، مع ضرورة إشراكها في ديناميكية نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير مناطق صناعية نموذجية موجهة للتصدير.
ومن بين الآليات المقترحة أيضًا، يبرز خيار اقتراح برنامج استثماري مشترك، يضع أسسًا واضحة لاستقطاب المستثمرين الأوروبيين، من خلال منحهم حوافز مدروسة، شريطة التزامهم بنقل التكنولوجيا، وتوفير مناصب شغل محلية، وإرساء مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.
وبهدف مواكبة هذه الديناميكية، تبدو الحاجة ملحّة إلى إرساء منتدى حوار اقتصادي دائم يجمع بين ممثلي الحكومتين، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، ليكون بمثابة فضاء مفتوح للتشاور وتقديم توصيات مرنة تتكيف مع الواقع المتغير، وتدفع نحو تعاون أكثر عمقًا ومردودية.
ولضمان شفافية وفعالية هذه الشراكة المتجددة، يجب ربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس (KPIs)، مثل عدد المشاريع الاستثمارية المنجزة، ومعدل الإدماج المحلي، وحجم الصادرات غير النفطية نحو أوروبا، وعدد الاتفاقيات الثنائية القطاعية المفعّلة، ما يسمح بتقييم موضوعي للنتائج، ومساءلة الأطراف حول مدى التزامها بالأهداف المعلنة.
و في الختام يمكن القول ان رغبة الجزائر في إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تشكل خطوة سيادية ضرورية لإعادة التوازن لعلاقة ظلت لسنوات تميل لصالح الجانب الأوروبي. وفي ظل التحولات العالمية الراهنة، يبدو أن الوقت قد حان لتجديد هذه الشراكة على أسس الاستثمار المستدام، التكامل الاقتصادي، والربح المشترك. ولا يمكن تحقيق هذا الطموح دون تفعيل جدي لآليات الاتفاق القائمة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وتعزيز قنوات الحوار الاقتصادي الدائم بين الطرفين.

البروفيسور: حبيب بريك الله - أكاديمي ومحلل سياسي
ديبلوماسية قوية... واقتصاد يُملي شروطه من جديد
يرى البروفيسور حبيب بريك الله، الأكاديمي والمحلل السياسي، في حديثه مع "الأيام نيوز"، أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يمر منذ فترة بتجاذبات متزايدة، خاصة في ظل المواقف الجزائرية الثابتة من القضايا الدولية الراهنة. ويؤكد أن الجزائر، بفضل سياستها الخارجية النشطة وقوة دبلوماسيتها، فرضت نفسها كفاعل إقليمي ودولي لا يمكن تجاوزه، ما جعل مطلب مراجعة الاتفاق يتحول من مطلب جزائري إلى "مطلب أوروبي مهم" في الآونة الأخيرة. وقد تُوج هذا التوجه باعتراف رسمي من الاتحاد الأوروبي، أعلنه سفيره في الجزائر، دييغو مايادو، مؤكدًا قبول الجزائر بمراجعة اتفاق 2005، في خطوة تعكس تطورا ملموسا في نظرة الطرف الأوروبي لعلاقات الشراكة مع الجزائر.
يشدد البروفيسور بريك الله على أن الجزائر وصلت إلى هذا المنعطف بفضل تراكمات سياسية ودبلوماسية أبهرت المتابعين في الداخل والخارج. فالمواقف الجزائرية في القضايا الدولية كانت دائما واضحة ومبدئية، ما منحها احتراما واسعا في مختلف المحافل.
ويؤكد أن هذه الدبلوماسية النشطة لم تقتصر على الدفاع السياسي، وتجاوزتها إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تثبيت الجزائر كشريك موثوق في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي. وهذا ما جعل الطرف الأوروبي يراجع مقاربته السابقة التي كانت تعتمد على الهيمنة الاقتصادية دون اعتبار للمصالح المتبادلة.
ويُضيف أن الجزائر تحركت بدبلوماسية هادئة لإعادة التوازن للعلاقة مع أوروبا، دون التصعيد أو القطيعة، بل عبر فرض الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل. وهو ما أعاد طرح اتفاق الشراكة للنقاش، ليس من زاوية التوتر بل من زاوية التحديث والتصحيح.
ويرى أن توقيت هذا التحول يتقاطع مع تغيرات إقليمية وعالمية جعلت من الجزائر فاعلا مطلوبا في ملفات الطاقة والهجرة والأمن، ما زاد من وزنها التفاوضي في أي علاقة استراتيجية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
ويُبرز أن الدبلوماسية الجزائرية استطاعت كسب محطات سياسية واقتصادية مهمة، وهو ما دفع حتى الشركاء الأوروبيين للاعتراف ضمنيا بأن استمرار العمل باتفاق 2005 دون تعديل لم يعد منطقيا أو عادلا.
اعتراف أوروبي رسمي بمراجعة الاتفاق
ويرى البروفيسور أن ما يُميّز هذه المرحلة هو التحول في الموقف الأوروبي من اتفاق الشراكة، فقد انتقل من حالة إنكار للخلل القائم، إلى اعتراف رسمي بالحاجة إلى المراجعة، وهو ما أكده السفير دييغو مايادو بوضوح.
ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا رسميا يؤكد موافقة الجزائر على الدخول في مسار مراجعة الاتفاق، وهو تطور نوعي في العلاقات الثنائية، يعكس تغيرا في ميزان القوة والمصالح.
ويُضيف أن هذا الإعلان الأوروبي إقرارا بأن الاتفاق بصيغته الحالية لم يعد قادرا على مواكبة تطورات الجزائر الاقتصادية ولا مصالح أوروبا المتغيرة، خاصة في ظل أزمات الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية.
كما يؤكد أن الموقف الأوروبي المستجد يُسجل للجزائر كإنجاز دبلوماسي هادئ تحقق دون ضجيج إعلامي، ولكنه يضع في المقابل الطرف الجزائري أمام مسؤولية كبيرة في التفاوض لتعديل بنود الاتفاق وفق رؤية متكافئة.
ويُبرز أن هذه الخطوة تُمهّد لمرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية الأوروبية، تقوم على أساس الشراكة الحقيقية لا الامتيازات الأحادية، بما يضمن احترام السيادة والمصالح الوطنية للطرفين.
المناطق الاقتصادية الخاصة في قلب المفاوضات
ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها في إطار مراجعة الاتفاق، يُشير البروفيسور بريك الله إلى الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الجزائرية لبحث إمكانية مساهمة المناطق الاقتصادية الخاصة في استقطاب الاستثمارات بين الجانبين.
ويرى أن هذا التوجه يُظهر رغبة الطرفين في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي على أسس أكثر واقعية، خاصة وأن المناطق الخاصة تمثل أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للأعمال.
ويُوضح أن الجزائر تسعى من خلال هذه الآلية إلى تقليص العجز التجاري مع أوروبا، والذي يُعد نتيجة مباشرة لغياب استثمارات حقيقية ومُنتجة من الطرف الأوروبي، مما جعل العلاقة تقتصر على تصدير الغاز مقابل استيراد السلع.
ويُشير إلى أن النقاش حول المناطق الاقتصادية الخاصة جاء من حاجة ملحة إلى تغيير بنية الشراكة الحالية التي لم تعد تحقق التوازن المطلوب بين تدفق السلع وتدفق رؤوس الأموال.
ويُبرز أن وضع هذه المناطق على طاولة المفاوضات يعكس إدراك الجزائر لأهمية الانتقال من منطق الاستهلاك إلى منطق الإنتاج والاستثمار، بما يُعزز من قدراتها التصديرية خارج المحروقات.
اتفاق مجحف وتداعياته الاقتصادية
ويؤكد البروفيسور حبيب بريك الله أن الجزائر لطالما عبّرت عن موقفها الرافض للاتفاق في صيغته الحالية، معتبرة إياه غير متوازن ومجحفا بحق الاقتصاد الوطني، وهو ما أدى إلى خسائر مالية معتبرة للبلاد.
ويُوضح أن تفكيك التعريفات الجمركية، كما ينص عليه الاتفاق، لم يُقابله بناء قدرات إنتاجية وطنية قادرة على المنافسة، ما سمح للسلع الأوروبية بغزو السوق الجزائرية دون حماية فعالة للمنتج المحلي.
ويشير إلى أن العديد من الخبراء اعتبروا أن الجزائر دخلت الاتفاق دون أن تكون مؤهلة له اقتصاديا، خاصة وأن اقتصادها ظل يعتمد على تصدير المنتجات النفطية ومشتقاتها دون تنويع كافٍ في قاعدة الإنتاج.
ويُضيف أن هذا الخلل أفرز عجزا تجاريا مزمنا مع أوروبا، وغيابا شبه تام للاندماج الصناعي والتكنولوجي الذي كان من المفترض أن يكون أحد أهداف الشراكة.
ويُبرز أن الجزائر ليست ضد مبدأ الشراكة، بل ضد الصيغة التي فُرضت بها، والتي خدمت طرفا واحدا على حساب الطرف الآخر، وهو ما يُفسر تمسك الجزائر بضرورة مراجعة دقيقة وشاملة لكل بند من بنود الاتفاق.
موقف الجزائر... قوة اقتصادية لا عقدة نقص
ويشدّد البروفيسور على أن التوجه الجزائري نحو مراجعة اتفاق الشراكة لا يعكس أي إحساس بالضعف أو عقدة نقص، بل هو قرار نابع من معطيات اقتصادية واقعية تفرض التعديل.
ويستند في ذلك إلى تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن المبادرة بمراجعة الاتفاق لم تكن رد فعل على مواقف أو نزاعات، وإنما خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير العلاقة على أسس جديدة ومتوازنة.
ويُشير إلى أن الجزائر لا تُخفي تمسكها بعلاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي، وتعتبره شريكا اقتصاديا مهما في الساحة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تُصر على الدفاع عن مصالحها الوطنية بكل سيادة ووضوح.
ويؤكد أن الدخول في مسار المراجعة يعبّر عن نضج سياسي ودبلوماسي، وإرادة في تأسيس علاقة رابح-رابح تحترم سيادة الجزائر وتُعزز من استقلالها الاقتصادي.
ويُخلص إلى أن سنة 2025 قد تكون مفصلية في إعادة صياغة العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمنطق الشراكة الحقيقية والندية المتبادلة.

عبد القادر سليماني - خبير اقتصادي
اقتصاد جديد... وشراكة قديمة لا تُواكب التحول الجزائري
يرى الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريحه لـ "الأيام نيوز"، أن الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى جاهدة لإعادة توازن اتفاق الشراكة بما يعكس واقعها الاقتصادي الجديد ويضمن مصالحها الاستراتيجية. فـ "جزائر 2025" لم تعد كما كانت عند توقيع الاتفاق عام 2002، إذ تغيرت الظروف، وتطورت القدرات الوطنية، واتسعت رقعة النفوذ السياسي والدبلوماسي الجزائري على المستويين الإقليمي والدولي. وأمام هذه التحولات، أصبحت مراجعة الاتفاق ضرورة ملحة لا تُحتّمها الجزائر فقط، بل باتت محل قبول أوروبي كذلك، في خطوة تعكس تغيرا حقيقيا في الموازين.
انطلقت الجزائر، حسب الخبير سليماني، من قناعة راسخة بأن إعادة تكييف بنود اتفاق الشراكة ضرورة تُحتّمها تحولات داخلية وجيوسياسية عميقة. فالاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2005، لم يعد ملائما لواقع 2025، خاصة أن الجزائر أصبحت اليوم قوة اقتصادية إقليمية ذات رؤية واضحة.
وأكد أن الجزائر تطمح إلى تعديل الاتفاق بما يضمن توازن المصالح الاقتصادية ويُعزز علاقات سياسية أكثر توازنا مع بروكسل. وهذا التوجه الجديد هو تحرّك مبني على تقييم واقعي لتجربة دامت عقدين لم تصب في صالح الطرف الجزائري.
وبحسب سليماني، فإن هدف الجزائر من هذه المراجعة ليس فقط التوازن التجاري، وإنما أيضا تحقيق شراكة سياسية حقيقية مع أوروبا ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدا عن منطق التبعية.
ويُشير إلى أن التحولات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة من حيث القدرات المالية والطاقوية والغذائية، تُؤهلها الآن للتفاوض من موقع قوة لا تبعية، ما يُعد مؤشرا على بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
ويخلص إلى أن تعديل اتفاق الشراكة أصبح ضرورة مشتركة، تجاوب معه الاتحاد الأوروبي علنا، في خطوة تُؤسس لشراكة متوازنة وأكثر عدلا.
الجزائر... قوة اقتصادية تفاوض من موقع سيادة
ويُبرز الخبير أن الجزائر اليوم تُعد من أكبر الاقتصاديات الإفريقية، من حيث الموارد وأيضا من حيث الإنجازات الفعلية، كتحقيق معدل نمو يفوق 4% وسعيها لبلوغ ناتج داخلي يتجاوز 4.000 مليار دينار.
ويُضيف أن هذه القوة الاقتصادية ترتكز على عناصر متعددة، من بينها الأمن الغذائي، الأمن المائي، الطاقات المتجددة، والطاقة التقليدية، مما يجعل الجزائر لاعبا استراتيجيا يصعب تجاوزه في المنطقة.
ويُشير سليماني إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للجزائر، إذ تمثل مبادلاته معها نحو 50% من التجارة الخارجية، وتصل المبادلات مع إيطاليا وحدها إلى 20 مليار دولار، ما يُبرز مدى عمق الترابط الاقتصادي بين الطرفين.
كما يؤكد أن مكانة الجزائر السياسية والدبلوماسية باتت أكثر تقدما، ويتجلى ذلك من خلال أدوارها المتزايدة في الاتحاد الإفريقي، والفضاء المتوسطي، ومحور الجنوب-جنوب، بالإضافة إلى حضورها البارز في المنتديات الدولية.
ويخلص إلى أن هذه القوة الاقتصادية والدبلوماسية المتراكمة تُمكن الجزائر من إعادة التفاوض بندية تامة، وبناء شراكة استراتيجية قائمة على التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والانفتاح العادل للأسواق.
واقع جديد يفرض مراجعة متوازنة
ويُؤكد سليماني أن المؤشرات الجديدة التي تُظهر قوة الجزائر الاقتصادية والسياسية تفرض واقعا مغايرا، لا بد أن ينعكس على بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. فالاتفاق الحالي لم يعُد ينسجم مع هذا الواقع الجديد.
ويرى أن الجزائر لم تعُد تعتمد فقط على المحروقات كمورد رئيسي، وتطورت بنيتها الإنتاجية والفلاحية والصناعية، ما يجعل استمرار الاتفاق القديم غير مبرر، لأنه يعكس مرحلة تجاوزتها الجزائر.
ويُشير إلى أن التوجه الجزائري نحو شراكة أكثر توازنا يتطلب تفعيل آليات مثل مجلس الشراكة، الذي يُمكن أن يتحول إلى أداة عملية لتنظيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين.
ويُضيف أن الاتحاد الأوروبي أبدى تجاوبا واضحا مع هذا الواقع الجديد، حيث أعلن سفيره في الجزائر دييغو مايادور، في فبراير 2025، أن الوقت قد حان لمراجعة الاتفاق بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
ويخلص الخبير إلى أن الاتفاق الجديد يجب أن يكون مبنيا على مبدأ "رابح-رابح"، يحفظ مصالح الطرفين، ويُفعّل الإمكانيات الكامنة في العلاقات الثنائية.
عقدان من الاختلال... و13 مليار فقط
وفي تقييمه للمرحلة السابقة، يوضح الخبير سليماني أن اتفاق الشراكة لم يخدم الجزائر بالقدر المتوقع، فقد بقيت طيلة عشرين سنة مجرد سوق للسلع الأوروبية دون أن تستفيد من مزايا حقيقية.
ويُضيف أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغ نحو ألف مليار دولار على مدار العقدين الماضيين، لكن حصة الجزائر الفعلية من المكاسب لم تتجاوز 13 مليار دولار، وهو رقم يفضح حجم الاختلال في بنود الاتفاق.
ويُشير إلى أن المنتجات الجزائرية، رغم تطورها في السنوات الأخيرة، لم تكن قادرة على دخول الأسواق الأوروبية، بسبب الحواجز الحمائية المشددة التي يفرضها الاتحاد، خاصة في مجالات الزراعة والصيد البحري والمنتجات الغذائية.
كما يلفت إلى أن الاتفاق يتضمن 110 مادة، من بينها بنود تخص إنشاء منطقة تجارة حرة، لكن تلك البنود لم تُطبّق بطريقة متوازنة، بل خضعت لتفسير يخدم الطرف الأوروبي.
ويؤكد سليماني أن هذه الحصيلة تُعطي مبررا قويا لموقف الجزائر المطالب بتعديل الاتفاق، انطلاقا من قاعدة واضحة: لا يمكن الاستمرار في علاقة تخدم طرفا واحدا على حساب الطرف الآخر.
من إصلاحات الداخل إلى توازن الشراكة
ويُبرز الخبير أن مراجعة اتفاق الشراكة تأتي أيضا في سياق داخلي شهد إصلاحات جذرية أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه الحكم، وهي إصلاحات حظيت بإشادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويُضيف أن هذه الإصلاحات مكّنت الجزائر من التحرر التدريجي من التبعية للمحروقات، وأعطت دفعة قوية للقطاعات غير النفطية، خصوصا الفلاحة والصناعة، ما جعل المنتجات الجزائرية اليوم أكثر قدرة على المنافسة.
ويُشير إلى أن هذه الديناميكية الداخلية أسقطت منطق "العجز البنيوي" الذي كان يُبرر استمرار الشراكة القديمة، وحوّلت الجزائر من اقتصاد هش إلى اقتصاد وطني منتج وقادر على التصدير.
ويرى أن هذه المستجدات فرضت على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في الاتفاق، لأن الشريك الجزائري لم يعُد ذلك الطرف الضعيف اقتصاديا، وبات يطالب بحقوقه انطلاقا من قوة مؤسساته ونمو اقتصاده.
ويُخلص الخبير عبد القادر سليماني إلى أن الجزائر اليوم لم تعد تقبل أن تبقى مجرد سوق للسلع الأوروبية، وتطالب باتفاق يحفظ التنمية المستدامة، ينقل التكنولوجيا، ويُفتح أمامه المجال لدخول منتجاتها الوطنية إلى أوروبا بشروط عادلة.