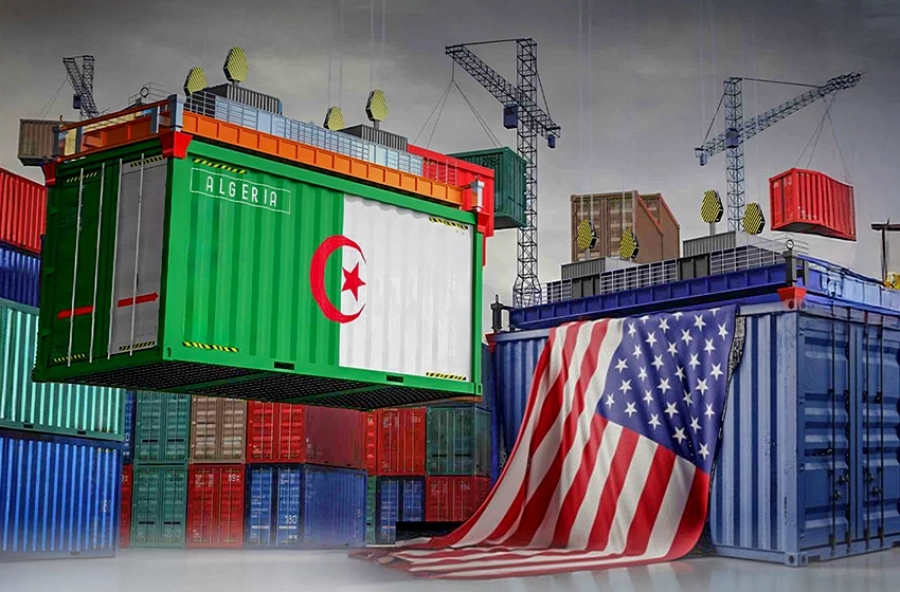في قلب الجغرافيا السياسية المتوترة، تشكّلت ملامح تجربة اقتصادية إيرانية لا تشبه النماذج التقليدية. فبين عقوبات مُحكمة وحصار طويل الأمد، لم تنهزم الدولة، بل أعادت رسم أولوياتها الإنتاجية حول مشروع نووي تحوّل من ملف تقني إلى محرك اقتصادي استراتيجي. في زمن الرهانات على الانهيار، اختارت إيران التعويل على البنية الداخلية، وتوظيف المعرفة المحلية، واستثمار رأس المال البشري لبناء اقتصاد مقاوم يتجاوز معايير السوق الحر، ويؤسس لمنظومة اكتفاء ذاتي متدرّج... فهل أعادت طهران تعريف التنمية من تحت الأرض؟
كان اختيار إيران خوض معركة النووي منذ البداية قرارا استراتيجيا يحمل بعدا سياديا واضحا، ويمثل تحديا صريحا للمنطق الذي حاولت القوى الغربية فرضه بعد الحرب الباردة: إما التبعية أو العقوبة. ففي أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، أعادت طهران تعريف مصالحها الوطنية على أساس الاستقلال السياسي والاقتصادي، ووجدت في المشروع النووي وسيلة للانعتاق من التبعية التكنولوجية والطاقوية، بما يُمهّد لبناء اقتصاد يتنفس عبر أنابيب النفط وأيضا عبر الطاقة الذرية التي توفر قدرة إنتاجية ضخمة، وبنية تحتية استراتيجية يصعب ابتزازها.
وتأسيسا على هذا المنطلق، تعاملت إيران مع مشروعها النووي باعتباره جزءا من معركة أوسع تُخاض ضد محاولات إخضاع القرار الداخلي لأجندات القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. فقد رأت القيادة الإيرانية أن الهيمنة الاقتصادية تُمارَس عبر العقوبات وأيضا عبر التحكم بمصادر المعرفة والتكنولوجيا. وهكذا، وُضع النووي في قلب معادلة "الاستقلال أو الحصار"، باعتباره رمزا لقدرة طهران على كسر القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا الحساسة، وعلى إنتاج ما تحتاجه داخليا مهما كانت الكلفة.
غير أن هذا الخيار لم يكن بلا ثمن. فمنذ بدايات البرنامج، كانت كلفة هذا الطموح السيادي باهظة اقتصاديا. لم تكن إيران فقط تدفع مليارات الدولارات في بناء منشآت نووية معقدة وسط قيود علمية وتقنية خانقة، وإنما دخلت أيضا في صراع مرير مع الأسواق العالمية، حيث أصبحت كل خطوة نووية تُقابل بحزمة عقوبات جديدة، تؤثر مباشرة على التجارة، والمصارف، والعملات، والاستثمارات. ومع ذلك، ظل صانع القرار في طهران يرد على هذه الضغوط بمنطق واضح: "من لا يتحمل كلفة السيادة، سيدفع أضعافها في زمن التبعية".
ومع مرور الوقت، بات المشروع النووي أكثر من مجرد منشآت تحت الأرض أو أجهزة طرد مركزي. تحوّل إلى عنوان رمزي في الوعي الجمعي الإيراني، يُجسّد عن الإرادة الوطنية في وجه العزلة المفروضة. فالإيرانيون الذين عاشوا تحت الحصار، واختبروا مرارة التضخم وشح الموارد، أصبحوا يربطون بين قدرتهم على الصمود وبين بقاء هذا المشروع قائما، باعتباره حائط الصدّ الأخير أمام سيناريوهات الهيمنة الكاملة أو حتى التقسيم. ومن هنا، لا يمكن فهم الإصرار الإيراني على الاستمرار في هذا المسار، رغم كلفته، من دون قراءة السياق الأوسع الذي يتقاطع فيه الاقتصاد بالسياسة، والطاقة بالكرامة.
وانطلاقا من هذا الإطار، بدى واضحا أن التحدي الإيراني تجاوز زاوية تخصيب اليورانيوم أو بناء المفاعلات، إلى "تخصيب القرار الوطني ذاته، وتطهيره من شوائب التبعية الاقتصادية". فالنووي بالنسبة لطهران بابا نحو الاكتفاء الطاقوي، ومنصة تؤسس لاقتصاد مستقل يحاول أن ينجو من لعبة التوازنات الدولية المفروضة.
بنية استراتيجية تتجاوز الكهرباء والقنابل
وإذا كان النووي في إيران قد بدأ كمشروع سيادي لتحرير الاقتصاد من التبعية، فإن تطوره عبر العقود لم يقتصر على توليد الطاقة أو تقليص الاعتماد على النفط، بل اتسع ليشكّل بنية استراتيجية متكاملة، يتداخل فيها العلمي بالأمني، والاقتصادي بالسياسي. ومن هذا المنظور، كانت المنشآت النووية الإيرانية أعمدة رئيسية في مشروع دولة تحاول أن ترسم لنفسها مسارًا خاصًا في نظام عالمي لا يسمح باستقلال من لا يمتلك أدوات الردع والتفوق الذاتي.
تاريخيًا، يمكن القول إن إيران استثمرت في منشآتها النووية كأي دولة طامحة إلى بناء قاعدة للطاقة المدنية، فمفاعل بوشهر، مثلًا، لم يكن وليد التوترات الإقليمية، وإنما ثمرة تعاون دولي منذ سبعينيات القرن الماضي. غير أن التحولات السياسية التي أعقبت الثورة الإسلامية فرضت على طهران مراجعة حساباتها. فكلما ضاقت المسارات الدبلوماسية، اتجهت إيران نحو تعميق بنيتها التحتية النووية، وأصبحت المنشآت الموزعة بين نطنز وفوردو وأراك رمزًا للتحدي والممانعة، وأداة لبناء منظومة علمية وتقنية واقتصادية بديلة عن تلك التي تسيطر عليها القوى الغربية.
وما يميز هذه البنية أن طهران لم تكتفِ بتركيب المعدات وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، بل أصرّت على امتلاك المعرفة المرتبطة بكل حلقة في سلسلة التخصيب والإنتاج. هذا التراكم العلمي، الذي شمل آلاف الباحثين والمهندسين، خلق شبكة اقتصادية متكاملة تدور حول البرنامج النووي، بدءًا من الصناعات الدقيقة، مرورًا بالبنى التحتية، وانتهاءً بالتدريب والتشغيل. وهنا تظهر مفارقة لافتة: العقوبات التي فُرضت لكبح جماح النووي، أسهمت – دون قصد – في دفع إيران إلى مزيد من الاعتماد على الذات، وتحفيز الإنتاج المحلي بدل الاستيراد.
ومع حرب جوان 2025 الأخيرة، وعودة التهديدات الأمريكية "الإسرائيلية" المباشرة للمنشآت النووية، دخلت هذه البنية مرحلة اختبار ميداني حقيقي. فالمواجهة الأخيرة شكّلت محاولة حقيقية لتدمير القدرات الاستراتيجية الإيرانية. ومع ذلك، فإن الصواريخ التي أُطلقت على مفاعلات نووية إيرانية، لم تُوقف البرنامج، بل أعادت تعريفه من جديد كمنظومة اقتصادية-أمنية حيوية لا يمكن لأي دولة أن تتخلى عنها دون أن تُمسّ بسيادتها.
ومن هنا، يبدو أن إيران تجاوزت في تعاطيها مع النووي النظرة الضيقة التي تختزل المشروع في "قنبلة محتملة" أو "مفاعل كهرباء"، نحو رؤية أوسع تعتبر هذه المنشآت ركيزة في بناء نموذج اقتصادي متكامل، قادر على الصمود رغم العزلة. وكلما ازداد الضغط الدولي، تعمّقت البنية الداخلية لهذا المشروع، بما يعزز قناعة القيادة الإيرانية بأن الاستمرار في تطويره هو قرار سيادي لا رجعة فيه، يحمل في طياته رسالة: أن الاكتفاء يبدأ من الداخل، حتى لو كان تحت الأرض.
إقتصاد العقوبات.. حين يُنتج الحصار بنية نووية
كما أن التجربة الإيرانية أظهرت أن البنية النووية التي نشأت في الظل كانت نتاجًا مباشرًا لمعادلة اقتصادية فرضها الحصار. ففي الوقت الذي كانت فيه منشآت نطنز وأراك تتعافى من آثار الضربات، كانت طهران تعيد تقييم ما أنجزته خلال سنوات الضغط، لتكتشف أن العقوبات التي سعت إلى كبحها منحتها، في المقابل، دافعًا غير مسبوق لإعادة تشكيل اقتصاد داخلي مقاوم، يقف على أطراف بنية نووية صلبة، تُغذيها الكهرباء، وأيضًا الكفاءات، والتكنولوجيا، والتحفيز الإنتاجي.
لقد تكوّن ما يُعرف بـ "الاقتصاد المقاوم" في إيران كخيار دفاعي، لكنه سرعان ما تحوّل إلى استراتيجية طويلة المدى، هدفها تقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، وبناء منظومة إنتاج محلية متكاملة. ومع تعذر الوصول إلى التمويل الدولي أو استيراد المواد الحساسة، اضطرت إيران إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية محليًا، مثل الإلكترونيات الدقيقة، والسبائك الصناعية، وأنظمة التحكم. وهكذا، شكّلت العقوبات بيئة ضغط دفعت نحو الاكتفاء بدلًا من أن تؤدي إلى الانهيار.
وبينما كان الغرب يراهن على اختناق الاقتصاد الإيراني، ظهرت نتائج معاكسة. فقد زادت الاستثمارات الحكومية في مجالات العلوم التطبيقية والهندسة، وتم توجيه الموارد نحو الجامعات والمراكز البحثية، ما أدى إلى تخريج جيل من العلماء والمهندسين القادرين على سدّ الفجوة التكنولوجية، خاصة في القطاعات الحساسة. ولعل واحدة من أبرز المفارقات أن الحصار الدولي، الذي حرم إيران من التكنولوجيا النووية الغربية، فتح أمامها أبواب الشراكة مع قوى أخرى، مثل الصين وروسيا، في إطار تعاون لا يخضع لهيمنة العقوبات الأمريكية.
لكن الاقتصاد المقاوم لم يخلُ من تحديات قاسية، إذ تحمل المواطن الإيراني عبءَ التضخم، وارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية، في ظل محدودية الوصول إلى الدولار والتكنولوجيا المستوردة. ومع ذلك، لم تُترجم هذه المعاناة إلى تراجع في دعم المشروع النووي، بل إن الخطاب الداخلي في إيران نجح في ترسيخ فكرة أن الصبر الاقتصادي هو ثمن الكرامة الوطنية، وأن كل خطوة باتجاه التخصيب هي خطوة نحو اقتصاد حرّ لا يخضع للابتزاز.
وهكذا، كان البرنامج النووي نتاجًا لتفاعل داخلي بين الإرادة السياسية والضغط الخارجي. وقد شكّل الحصار أداة قاسية، لكنها ساهمت – من دون قصد – في إعادة صياغة البنية الاقتصادية حول مشروع استراتيجي وطني. وما بين المنشآت المدفونة تحت الأرض وخطوط الإنتاج المحلية فوقها، بُني اقتصاد لا يشبه اقتصاد السوق الحر، لكنه اقتصاد يصمد، ويعيد تعريف فكرة التنمية في ظل المقاومة.
من النفط إلى النووي.. إيران واستراتيجية بناء أمنها الطاقوي البديل
وإذا كانت العقوبات قد شكّلت ضغطًا اقتصاديًا خانقًا، فإن الرد الإيراني جاء عبر اقتصاد مقاوم، وأيضًا من خلال إعادة هيكلة شاملة لأولويات الدولة، وفي مقدّمتها أمن الطاقة. وفي هذا السياق، برز المشروع النووي كبديل استراتيجي للنفط، الذي مثّل لعقود المصدر الأول لعائدات إيران، لكنه كان أيضًا نقطة ضعفها الرئيسية في لعبة الحصار. فكلما أُغلقت منافذ بيع النفط، بدا واضحًا أن التحرر من هذه التبعية لا يكون إلا ببناء قاعدة طاقوية جديدة، لا تُخضعها السفن ولا تقيّدها العقوبات.
لقد استوعبت طهران مبكرًا أن اقتصادًا قائمًا على الريع النفطي لا يمكنه الصمود في بيئة دولية معادية. فالتقلبات السياسية، والحظر المفروض على تصدير النفط الإيراني، وسرعة تأثر السوق بالعوامل الجيوسياسية، كلها جعلت الحاجة إلى مصادر طاقة بديلة ضرورة وجودية. وهكذا، جاء الاستثمار في الطاقة النووية المدنية كخيار استراتيجي، من أجل إنتاج الكهرباء محليًا، وتحرير الغاز والنفط للتصدير متى أمكن، أو للتخزين في أوقات الأزمات.
ومع تشغيل مفاعل بوشهر وربطه تدريجيًا بالشبكة الوطنية، بدأ النموذج النووي الإيراني ينتقل من قاعات البحث والمفاوضات إلى واقع اقتصادي ملموس. ووفقًا للتقارير الرسمية، فإن المرحلة الثانية من مفاعل بوشهر ستوفر آلاف الميغاواط من الكهرباء، ما يُغني عن استهلاك ملايين البراميل من النفط سنويًا. وهذا ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة، وعلى التوازن في سوق الطاقة، ويمنح إيران قدرة تفاوضية أكبر في مواجهة المشترين الدوليين والخصوم الجيوسياسيين.
لكن الأهم من وفورات الكهرباء هو ما يتعلق ببنية الاستقلال الوطني. فمفاعل بوشهر، إلى جانب منشآت أراك وفوردو، يمثّل بالنسبة لطهران قاعدة إنتاجية لا تخضع للعبة العرض والطلب العالمية، ولا للمزاج السياسي للدول الكبرى. فبينما يمكن محاصرة ناقلات النفط، أو منع شركات أجنبية من الاستثمار في الحقول، لا يمكن بسهولة تعطيل مفاعل نووي محمي داخل العمق الإيراني، ومُشيد بموارد وطنية أو بشراكات غير غربية. وهنا يكمن جوهر "أمن الطاقة البديل" الذي اختارته إيران.
لقد أدركت طهران أن المعركة الاقتصادية تُحسم بمن يمتلك مفاتيح الطاقة، فهو من يمتلك مفاتيح القرار. ومن هذا المنطلق، أصبح النووي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الاقتصادي الإيراني، لا لمجرد توليد الكهرباء، بل لحماية القرار السيادي من لعبة الضغط والابتزاز. وإذا كان الحصار قد بدأ بتجفيف منابع النفط، فإن الردّ يكون ببناء مصدر طاقة لا يمكن تجفيفه... بل فقط محاولة كبحه.
الطموح النووي الإيراني.. بين كلفة الاستقلال وثمن التبعية
وفي الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى تقليص اعتمادها على النفط من خلال تعزيز أمنها الطاقوي بالاعتماد على الطاقة النووية، يتبادر إلى الأذهان سؤال جوهري: كم كلّف هذا المشروع الاقتصاد الإيراني؟
فإذا كانت المنشآت قائمة، والمفاعلات تعمل، والعقوبات تتوالى، فإن ثمن هذا الطموح لا يُقاس فقط بما أنفقته الدولة من مليارات، وإنما أيضًا بما تحمّله الاقتصاد من أعباء، وبما قدّمه المجتمع من تضحيات في سبيل بلوغ نقطة التخصيب الكاملة.
ورغم سرية الأرقام الرسمية، تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن إيران أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على برنامجها النووي منذ انطلاقه، تشمل تكاليف الإنشاء، المعدات، البحوث، التأمين، الحماية، وتدريب الكوادر العلمية والتقنية. وإذا أُضيف إلى ذلك أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب البرنامج، فإن الكلفة الإجمالية ترتفع إلى مستويات يصعب حصرها. لكن في المقابل، ترى طهران أنها تبني مشروعًا استراتيجيًا لا يُقدّر بثمن، لأنه يحمي السيادة الوطنية، ويوفر هامشًا من الاستقلال في اتخاذ القرار الاقتصادي، لا تمنحه العائدات النفطية المتقلّبة.
لقد انعكست الكلفة المالية للبرنامج النووي على عدة قطاعات اقتصادية. فقد جرى تقليص الإنفاق على بعض المجالات غير الحيوية لتمويل المفاعلات والأبحاث، وخصصت مبالغ ضخمة للبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، من شبكات تبريد ونظم أمان إلى تأمين المواد الحساسة. وفي الوقت ذاته، وُجه دعم حكومي كبير نحو الجامعات والمعاهد التكنولوجية ذات الصلة، مما ساهم في تكوين طبقة علمية متخصصة، تعتبرها إيران اليوم "استثمارًا طويل الأمد" في عقول أبنائها.
ويعزز قناعة القيادة الإيرانية بجدوى هذه الكلفة، مقارنة ما أنفقته على البرنامج النووي بما تنفقه دول الجوار على التسلّح أو التحالفات العسكرية الخارجية. فبينما تُخصّص بعض دول المنطقة مليارات الدولارات سنويًا لشراء أسلحة أجنبية لا تضمن لها الاستقلال، اختارت طهران توجيه استثماراتها نحو بناء قدرات وطنية تضمن لها الاكتفاء التدريجي. وبهذا المعنى، يُعد البرنامج النووي، من وجهة نظرها، مشروعًا وطنيًا جريئًا لتعويض الخلل المزمن في موازين القوى الاقتصادية والسياسية.
ولعل ما يُبرّر هذا الإصرار، رغم الكلفة الباهظة، هو أن إيران ترى في المشروع النووي حجر الأساس في بناء اقتصاد مقاوم، يُنتج من الداخل، ويواجه التحديات من موقع الندية لا الخضوع. وهكذا، فإن السؤال عن "كم كلف المشروع؟" يظل ثانويًا أمام سؤال أعمق:
"كم كانت ستكلف التبعية؟" — سؤال تحرص طهران على أن تجيب عليه بالأفعال، لا بالأرقام.
كيف تحمّل الريال الإيراني كلفة الطموح النووي؟
وبينما كانت طهران تضخّ الموارد في مشروعها النووي وتراكم المنجزات التكنولوجية رغم كلفته الثقيلة، كان الريال الإيراني في الجبهة الأمامية لمواجهة غير متكافئة مع العقوبات والتقلبات السياسية. فالاقتصاد الذي راهن على خيار السيادة والاستقلال، دفع فاتورته عبر عملة وطنية شهدت تراجعات متتالية، إذ تحوّل المشروع النووي نفسه إلى عامل ضغط مباشر على السوق النقدية، سواء من خلال العقوبات، أو من خلال مخاوف المستثمرين والبنوك الدولية التي تترقّب أي تصعيد نووي لرفع تكلفة التعامل مع إيران أو قطعه بالكامل.
لقد كان الريال مرآةً لكل تحوّل في الملف النووي؛ فعند توقيع اتفاق 2015، ارتفعت قيمته بشكل لافت، وعند انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018، دخل مرحلة انهيار متسارع. ومع كل إعلان عن رفع نسبة التخصيب أو تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت الأسواق المحلية تستجيب سريعًا بالضغط على الريال. وهذا التفاعل الحاد بين النووي وسعر الصرف، جعل من العملة الإيرانية رهينة مباشرة لكل تطور في البرنامج، بما في ذلك التصريحات السياسية، والاجتماعات الدولية، وحتى التغريدات.
لكن ما يُحسب للحكومة الإيرانية، رغم هذا الضغط، هو محاولتها الفصل بين التقلبات السياسية والسياسات النقدية، من خلال تدابير داخلية لامتصاص الصدمات، مثل تطوير أنظمة التسوية بالريال مع بعض الدول الصديقة، وتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة البينية، وإنشاء شبكات مالية موازية تُقلّل من الحاجة إلى العملات الصعبة. كما سعت السلطات إلى كبح المضاربة في السوق السوداء، وضبط الطلب المحلي على العملة الأجنبية، وهي خطوات ساعدت، إلى حدّ ما، في تجنّب الانهيار الكامل رغم الحصار المشدد.
وفي الوقت ذاته، ظهرت مؤشرات على مرونة نسبية للاقتصاد الإيراني في مواجهة هذا التحدي النقدي. فرغم انخفاض قيمة الريال، لم يشهد الاقتصاد انهيارًا شاملًا أو شللًا تامًا، بل استمر في الدوران، ولو بوتيرة أقل، بفضل التكيّف الداخلي، وسياسات الدعم الحكومي، وتحفيز الإنتاج المحلي. والأهم من ذلك، أن الحكومة لم تتراجع عن تمويل المشروع النووي، حتى في أشد لحظات ضعف العملة، ما عكس أولويتها الاستراتيجية التي تُقدّم السيادة على الاستقرار المالي قصير المدى.
وهكذا، يتبيّن أن الريال الإيراني، رغم تآكله الظاهري، لم يسقط في هاوية الانهيار الكامل، بل تحوّل إلى رمز لصمود اقتصادي–سياسي طويل النفس، في وجه ضغط خارجي لا يرحم. وإذا كان بعض المحللين يرون في ضعف العملة فشلًا اقتصاديًا، فإن طهران تنظر إليه كأحد تجلّيات معركة أكبر تخوضها في ميدان الاقتصاد الحرّ المُسيّس، حيث تُواجه كل ورقة ضغط بصبر استراتيجي، ويُستثمر كل تراجع لبناء بنية نقدية أشد صلابة... ولو بعد حين.
المواطن الإيراني.. وقود الصمود وصدى العقوبات
وفي خضمّ المعركة النقدية التي يخوضها الريال الإيراني، لم يكن المواطن العادي بعيدًا عن ميدان المواجهة. فكل تراجع في قيمة العملة انعكس مباشرة على القدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، وسعر الخبز والدواء. وإذا كانت الدولة قد صمدت ماليًا ولم تتخلَّ عن مشروعها النووي في أصعب مراحل التراجع النقدي، فإن الفرد الإيراني وجد نفسه أمام واقع يومي معقّد، يتأرجح بين شعور بالانتماء إلى مشروع سيادي كبير، ومعاناة مع الأسعار المتقلّبة والرواتب التي تفقد قيمتها سريعًا. وهنا تتداخل السياسة النقدية مع العدالة الاجتماعية، ويظهر الوجه الإنساني لكلفة المشروع النووي.
لقد عانى المجتمع الإيراني من موجات تضخّم متعددة، كثيرٌ منها كان مرتبطًا بموجات تشديد العقوبات النووية. فمع كل تصعيد في الملف، تزداد أسعار السلع الأساسية، ويضيق الخناق على ذوي الدخل المحدود، وتبرز مخاوف فقدان الأمن الغذائي في بعض المناطق الريفية والمهمّشة. وتُعدّ فترات ما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من أسوأ المراحل التي عاشها الإيرانيون من حيث غلاء المعيشة، خصوصًا في قطاعَي الدواء والطاقة.
ومع ذلك، فإن ما يُثير الانتباه في المجتمع الإيراني هو الثقافة السياسية المقاومة التي باتت مترسّخة لدى قطاعات واسعة من الشعب، والتي جعلت من التضحية الاقتصادية جزءًا من معادلة الصمود الوطني. ففي استطلاعات غير رسمية نُشرت مؤخرًا بعد الضربات الإسرائيلية، عبّر أكثر من نصف الإيرانيين المستجوَبين عن استعدادهم لتحمّل الضغوط الاقتصادية بشرط الحفاظ على البرنامج النووي، باعتباره "مشروع كرامة" لا يمكن التنازل عنه. وهذا لا ينفي وجود تذمّر شعبي من الأوضاع، لكنه يبيّن عمق البُعد الرمزي للمشروع في وجدان الجماهير.
الصناعات الرديفة للنووي.. اقتصاد تحت الأرض يغذّي ما فوقها
تحوّل المشروع النووي الإيراني إلى محرّك صامت لسلسلة من الصناعات الرديفة التي امتدّت آثارها إلى سطح الاقتصاد الوطني. فسنوات العقوبات والتضييق التقني دفعت طهران إلى تطوير بنية تحتية صناعية وتكنولوجية موازية، هدفها الأول دعم البرنامج النووي، لكن تأثيرها تجاوز هذا الهدف، لتخلق فرص عمل، وتُحرّك عجلة الإنتاج، وتعيد رسم المشهد الصناعي في البلاد من زوايا غير تقليدية.
من أبرز هذه القطاعات، الصناعات الدقيقة والإلكترونية، التي ازدهرت تحت ضغط الحظر المفروض على استيراد أجهزة التحكم والقياس والمراقبة. فإيران، التي حُرمت من الولوج إلى السوق العالمية في مجالات مثل الرقاقات المتقدّمة والحساسات النووية، سعت إلى تصنيع هذه المكونات الحساسة محليًا، ما انعكس إيجابًا على قطاعات أخرى كالاتصالات والطيران. وقد أصبحت هذه الصناعات أداة مزدوجة: من جهة تُعزز استقلالية البرنامج النووي، ومن جهة أخرى تفتح آفاق التصدير نحو دول صديقة، خصوصًا تلك الخارجة عن النظام الاقتصادي الغربي.
كذلك، أدى التركيز على تصنيع قطع الغيار والمعدات الثقيلة الخاصة بالمفاعلات إلى ازدهار شركات وطنية متخصصة في اللحام الصناعي، السبائك الخاصة، والمواد العازلة للإشعاع. ورغم الطبيعة التخصصية الدقيقة لهذه المجالات، فإنها أسست قاعدة من الكفاءات الهندسية والتقنية التي امتد تأثيرها لاحقًا إلى مشاريع البنى التحتية المدنية والطاقة التقليدية. ما بدأ كخدمة تقنية للمفاعل، تحوّل إلى رافعة لقطاعات إنتاجية متعددة، كما تؤكد تقارير غرفة الصناعة الإيرانية التي تشير إلى تأسيس عشرات الشركات خلال العقد الأخير بفضل الطلب الناشئ عن القطاع النووي.
ولا تقتصر الآثار على التكنولوجيا والمعدات، بل تشمل أيضًا القطاع الأكاديمي والتدريب المهني. فقد دفعت حاجة المشروع النووي إلى كفاءات متخصصة، الجامعات الإيرانية إلى فتح أقسام في الفيزياء النووية والهندسة الحرارية والرقابة الإشعاعية، مما أسهم في تطوير المجتمع العلمي المحلي، وتوفير تعليم عالٍ بمناهج وطنية، بعيدًا عن احتكار المعرفة الغربية. بذلك، تحوّل البرنامج النووي من مستهلك للعلم إلى منتج ومصدّر له في بعض المجالات.
رأس المال البشري.. المحرك الخفي للمشروع النووي
إذا كانت الصناعات الرديفة للمشروع النووي قد شكّلت رافعة لإعادة إحياء قطاعات الإنتاج، فإن العنصر البشري هو المحرّك الأساسي لهذا التحوّل. فالمفاعل لا ينبض من دون مهندس، والسبائك لا تُصهر من دون عقل تقني، والسيادة لا تُصان من دون كفاءات وطنية واعية ومؤهلة.
أدركت إيران منذ البداية أن نجاح مشروعها النووي لا يرتبط فقط بالمعدات والتقنيات، بل يعتمد على بناء رأس مال بشري قادر على تحمل التحديات، في بيئة علمية تخضع للعزلة والتضييق. ومن هنا، تعاملت الدولة مع الملف النووي كأولوية علمية إلى جانب كونه مشروعًا استراتيجيًا، فأنشأت جامعات متخصصة، وفعّلت برامج للدراسات العليا في الفيزياء والهندسة النووية، ودفعت آلاف الطلاب نحو التخصص في مجالات تصنفها الدول الغربية على أنها "حساسة".
كان هذا التوجه نوعًا من الرد الذكي على العقوبات؛ فبدلًا من إرسال الطلبة إلى الخارج، باتت إيران تُنتج علماءها محليًا، ضمن منظومة تعليمية مؤهلة، يشرف عليها أساتذة ذوو خبرة ميدانية حقيقية في تشغيل المفاعلات وحماية المنشآت.
ورغم ما تعرّض له البرنامج من اغتيالات ممنهجة لكوادره العلمية – كما حدث مع العالم محسن فخري زاده – لم تتراجع إيران عن مشروع بناء النخبة العلمية، بل تعاملت مع الخسائر كحافز لمزيد من الاستثمار البشري. وتحوّلت عبارة "العلم مقاومة" إلى شعار ثقافي يعبّر عن وعي أجيال جديدة تتجه نحو التخصصات الصعبة، رغم قسوة الظروف الاقتصادية.
ولم تقتصر جهود الدولة على التعليم فقط، بل حرصت على دمج هذه الكفاءات في المؤسسات الإنتاجية والتخطيطية، من المراكز النووية إلى مراكز البحث الاستراتيجي، وحتى في قطاعات الاقتصاد المدني. المهندس النووي أصبح يطوّر تقنيات تُستخدم في الزراعة والصناعة والطاقة، مما جعل من النخبة العلمية الإيرانية ثروة استراتيجية لا يمكن تجميدها أو مصادرتها، لأنها تنمو في بيئة وطنية مغلقة لا يمكن الوصول إليها بالعقوبات.
وهكذا، بين أجهزة الطرد المركزي وقاعات الجامعات، تبلورت طبقة علمية تُعتبر اليوم من أهم منجزات إيران في ظل الحصار، طبقة ترى في المشروع النووي أداة للتحقق الذاتي، ومجالًا لإثبات القدرة الوطنية على إنتاج المعرفة وتطبيقها. وبينما ينظر الغرب إلى "النووي الإيراني" كخطر تقني، تنظر إليه طهران كمسار حضاري، تبدأ فيه المعركة من العقل، وتنتهي عند السيادة.
حين يصبح العلم هدفًا في ساحة العقوبات
انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو الوقود الأهم لأي مشروع سيادي، راهنت إيران على المعرفة كحائط صدّ متقدّم أمام العقوبات. لكنها أدركت أن معركتها لا تدور فقط في أسواق النفط أو مراكز التخصيب، بل في قاعات الجامعات والمختبرات ومراكز البحث العلمي، حيث يُخاض صراع خفي بين الحق في امتلاك المعرفة ومحاولات خنقها من الخارج. فالمعرفة النووية لم تُمنح لإيران، بل كانت دومًا ممنوعة عنها، ما جعل الوصول إليها معركة بحد ذاتها، لا تقلّ ضراوة عن أي مواجهة عسكرية.
وقد اتّخذت العقوبات الدولية على إيران شكلًا جديدًا حين استهدفت العقل لا العتاد؛ فتم حظر بيع البرمجيات العلمية، ومنع تصدير الأدوات المخبرية الدقيقة، وحرمان الجامعات من الاشتراك في المجلات الأكاديمية، بل وحتى تجميد التعاون البحثي مع العلماء الإيرانيين. وفي بعض الحالات، أُلغيت مؤتمرات علمية كان يفترض أن يشارك فيها باحثون إيرانيون فقط بسبب جنسياتهم، وكأن امتلاك المعرفة أصبح تهديدًا يُعاقَب عليه. ومن هنا، أدركت طهران طبيعة الصراع الحقيقية: إنها محرومة من المواد، ومن الأفكار أيضًا.
ردّ إيران على هذا الحصار المعرفي جاء من الداخل، عبر إنشاء منظومة بحثية متكاملة تعمل بمعزل عن التعاون الغربي، وتستفيد من كفاءاتها الذاتية أو من شراكاتها مع دول غير خاضعة للهيمنة الأمريكية. فظهرت مؤسسات مثل مركز أبحاث الليزر، وهيئة الطاقة الذرية، ومعاهد الدراسات المتقدمة، كمراكز تُنتج أبحاثًا رائدة في مجالات عالية الحساسية. وتحوّلت الجامعات إلى منصات لإنتاج بدائل محلية، حتى في البرمجيات والنمذجة الفيزيائية، ما سمح للمشروع النووي بمواصلة تطوره رغم عزله عن شبكات البحث العالمية.
ورغم أن هذا المسار أثبت فاعليته، فإنه لم يكن سهلًا؛ فقد استغرق وقتًا أطول، واحتاج إلى مضاعفة الجهد والموارد، وبناء تراكم معرفي من نقطة الصفر تقريبًا. لكنه منح إيران مكاسب استراتيجية لا تُقدَّر بثمن: لم تعد تعتمد على مراكز أبحاث في الغرب، ولا تخشى انقطاع أدوات تحليل أو دعم برمجي. إنها تنتج العلم من داخل حدودها، وتدرّب كوادرها فيه، وتُراكم خبراتها ببطء وثبات. وربما بات هذا الاستقلال المعرفي هو ما يُقلق خصومها أكثر من تخصيب اليورانيوم نفسه.
لقد شكّل الحصار العلمي لحظة وعي وطني بأن العلم قد يتحوّل إلى سلاحٍ ناعم: يُمنع عن الضعفاء ويُحتكر للأقوياء. ومن هنا، انبثقت استراتيجية طهران في بناء نظام تعليمي وبحثي مقاوم، لا يرتبط بأجندات خارجية، ولا يخضع لتقلبات السياسة الدولية.
اغتيال العقول: استهداف النخبة من أجل شلّ المشروع
إذا كانت المعرفة، في التجربة الإيرانية، قد تحوّلت إلى أداة مقاومة ورافعة للاستقلال، فإن العقل المنتج لهذه المعرفة لم يسلم من الاستهداف. فكلما راكمت إيران كفاءاتها العلمية وأحرزت تقدمًا في تخصيب اليورانيوم أو تشغيل المفاعلات، تحوّلت نخبتها البحثية إلى أهداف، سواء معلنة أو صامتة، لعمليات اغتيال ممنهجة، في الداخل والخارج. وكأن العالم لا يخشى القنبلة بقدر ما يخشى العقل الذي يستطيع صناعتها أو كسر احتكارها.
هنا يتخذ المشروع النووي بعدًا مختلفًا: ليس فقط في كلفته الاقتصادية، بل في ثمنه البشري أيضًا.
فاغتيال العالم محسن فخري زاده في نوفمبر 2020 شكّل نقطة تحوّل صادمة؛ ليس لأنه كان من أبرز المهندسين النوويين فحسب، بل لأنه مثّل جيلًا من العلماء الذين أسّسوا، بصمت، شبكة البحث النووي في إيران. ولم يكن فخري زاده حالة معزولة؛ فقد سبقته أسماء مثل مصطفى أحمدي روشن، ومجيد شهرياري، وغيرهما، ممن تم اغتيالهم بأساليب معقدة وتوقيتات مدروسة، بهدف إحداث شرخ في استمرارية المشروع وضرب معنويات كوادره.
هذا المسار من الاستهداف الجسدي ترافق مع استنزاف نفسي ومهني لبيئة البحث العلمي في البلاد. فالعالِم الذي يعمل في القطاع النووي يعيش تحت ضغط أمني دائم، في حالة من التوتر المستمر بين أداء رسالته العلمية والتهديدات المحدقة به. ورغم ذلك، لم تتراجع الدولة عن دعم هذه النخبة، بل منحتهم مكانة رمزية واجتماعية بارزة، وقدّمتهم للرأي العام باعتبارهم شهداء المشروع الوطني. وقد ساهم ذلك في رفع قيمة البحث العلمي لدى الشباب، وإعادة تعريف العالم كـ"مقاوم".
وما يُلفت النظر أن هذا الاستهداف لم يُبطئ من تقدم البرنامج النووي، بل سرّعه أحيانًا. فقد تعاملت القيادة الإيرانية مع خسارة أي شخصية علمية بوصفها تحديًا يتطلب تعزيز المنظومة، وسدّ الفراغات بسرعة، وتوسيع قاعدة التخصص، وعدم ربط المعرفة بأفراد بل بمؤسسات. وهكذا، أصبحت المعرفة مؤسسة لا يمكن اغتيالها، وفلسفة “أمننة المشروع لا مركزيًّا” هي التي أدارت بها إيران معركتها العلمية تحت ضغط الدم والخطر، من دون أن تتراجع.
العقوبات لا تكفي.. التكنولوجيا سلاح الغرب لإبطاء الطموح الإيراني
وإذا كانت الاغتيالات قد استهدفت العقول في محاولات لشلّ النواة البشرية للمشروع النووي، فإن الحصار التكنولوجي كان الوجه الآخر لاستراتيجية الإبطاء الغربية. فبينما تواصل إيران بناء كوادرها وتدريب جيل جديد من العلماء، تعمل القوى الكبرى على قطع شرايين المعرفة والمعدّات، عبر منع وصول التقنيات الحساسة التي تدخل في تطوير أجهزة الطرد المركزي، وأنظمة المراقبة، والمكونات الصناعية المتقدمة. وهنا تُطرح معادلة قاسية: كيف يُنتَج مشروع عالي التقنية في ظل حصار تقني خانق؟
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، تصاعدت وتيرة العقوبات التي استهدفت عشرات الكيانات والشركات والجامعات الإيرانية، تحت ذريعة مساهمتها في البرنامج النووي. ولم تقتصر العقوبات على الاقتصاد، بل امتدت إلى كل ما من شأنه أن يُسهّل التطوير التكنولوجي: برمجيات متخصصة، أجهزة قياس دقيقة، مكونات إلكترونية، بل وحتى أدوات الأبحاث الفيزيائية والكيميائية.
لكن اللافت أن هذا الحصار لم يؤدِ إلى إيقاف البرنامج، بل على العكس، أدى إلى تسريع خطوات "التصنيع الذاتي" داخل إيران. فعوضًا عن استيراد الأجهزة الجاهزة، لجأ الباحثون الإيرانيون إلى تطوير بدائل محلية، وإن كانت أقل تطورًا من نظيراتها الغربية. لكنها، في الحدّ الأدنى، سمحت بالحفاظ على الاستمرارية، ووفّرت للعلماء خبرة ميدانية مباشرة. وهكذا، تحوّل الحصار إلى حافز للاعتماد على الذات، ودفع بالمؤسسات الصناعية الإيرانية إلى اقتحام مجالات لم تكن حاضرة فيها من قبل.
وتُشير تقارير صادرة عن مراكز دراسات غربية إلى أن إيران طوّرت خلال السنوات الأخيرة أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة من تلك التي كانت متاحة لها قبل الاتفاق النووي، وأن بعض هذه الأجهزة بات يُعتمد فيها على مواد وتقنيات محلية بالكامل. هذا التقدم، رغم العزلة والقيود، دفع بعض الخبراء إلى التحذير من أن سياسة الحصار التقني بدأت تؤتي نتائج عكسية، إذ تحوّل الضغط إلى محفّز للابتكار، بدلًا من أن يكون أداة للكبح.
إن الرهان على "التجويع التكنولوجي" قد يُبطئ بعض جوانب المشروع النووي الإيراني، لكنه، في المقابل، يُنتج عقلية مقاومة للارتهان، ويخلق بيئة علمية وطنية تُعوّض النقص بالإرادة والتصميم. ومن هنا، أصبحت التجربة النووية الإيرانية نموذجًا خاصًا، لا في السياسة فقط، ولا في الجغرافيا الإقليمية، بل أيضًا في كيفية صناعة المعرفة تحت الحصار. ففي غياب العدالة العلمية، يتحوّل التطوير الذاتي إلى أداة سيادة، ويتحوّل العلم إلى مقاومة صامتة.
ورغم الكلفة الاقتصادية الباهظة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، تواصل إيران المضي قدمًا في مشروعها النووي بوصفه خيارًا استراتيجيًا للسيادة والتحرر من التبعية. إنها ترفض المساومة على استقلال قرارها العلمي والتقني، وتُدرك أن البرنامج النووي لم يعد مجرد مشروع علمي أو أمني، بل رمز لصمود دولة محاصرة اختارت أن تبني قوتها الذاتية رغم القيود والعقوبات. وبين واقع اقتصادي مثقل بالحظر، وحلم تحقيق الاكتفاء والردع، تراهن الجمهورية الإسلامية على الزمن والإرادة الوطنية لتغيير قواعد اللعبة، في عالم لا يحترم إلا الأقوياء.

أمير دريوش يوهائي - محلل سياسي - إيران
الدبلوماسية النووية الجديدة.. هل تفتح طهران باب الاتفاقات والاستثمارات؟
يرى المحلل السياسي الإيراني أمير دريوش يوهائي، أن الطموح النووي الإيراني لا يمكن فصله عن التحولات الجيوسياسية التي أعقبت الحرب مع العراق والاجتياح الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق. ورغم أن المشروع النووي كان وما يزال في صلب الاستراتيجية الإيرانية، فإن طهران اعتمدت أيضًا على أدوات ردع أخرى، مثل القوى الوكيلة والبرنامج الصاروخي، قبل أن تنتقل مؤخرًا إلى سياسة الردع المباشر ضد الكيان الصهيوني. ويعتقد أن إيران تقف اليوم على أعتاب تحوّل كبير، سواء في علاقاتها الخارجية أو في إدارتها للملف النووي.
وبحسب يوهائي، فإن التفكير في الردع النووي لم يبدأ بعد الثورة فقط، بل تعود جذوره إلى ما قبل عام 1979. إلا أن هذه الطموحات شهدت تصاعدًا حادًا عقب الحرب مع العراق، وبلغت ذروتها بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، ما عزز قناعة طهران بضرورة امتلاك أدوات استراتيجية لموازنة التفوق الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.
ويشير المحلل السياسي الإيراني في تصريح لـ"الأيام نيوز"، إلى أن الردع الإيراني لم يُبنَ فقط على المشروع النووي، بل على ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، حيث عملت طهران على بناء منظومة إقليمية من الحلفاء والوكلاء، أبرزهم حزب الله في لبنان، الذي اعتُبر لدى كثيرين عنصر ردع فعّال أمام الترسانة النووية الإسرائيلية.
كما يلفت إلى أن هذا الردع الإقليمي لم يكن دائمًا مرتبطًا بخيار السلاح النووي، بل تمحور أحيانًا حول الردع السياسي والصاروخي والميداني، وهو ما جنّب إيران الدخول في مواجهة مباشرة لفترة طويلة، إلى أن وقع التحول الاستراتيجي في عام 2024.
من الحرب بالوكالة إلى المواجهة المباشرة.. أبريل 2024 نقطة التحول
ويؤكد المحلل الإيراني أن الهجوم المباشر الذي شنّته طهران على الكيان الصهيوني في أبريل 2024 شكّل بداية تحوّل استراتيجي في عقيدة الردع الإيرانية، إذ بدأ التركيز يتحول من الوكلاء الإقليميين إلى الردع المباشر من داخل الأراضي الإيرانية.
ويضيف أن هذا التحول أدى إلى سلسلة من الاشتباكات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، كسرت خلالها طهران قواعد الاشتباك القديمة، وأظهرت استعدادها لخوض مواجهة مفتوحة دون وسطاء.
ويرى أن هذا التحول لم يكن منفصلًا عن الحسابات النووية، بل جاء نتيجة إدراك طهران الردع الحقيقي لا يقوم فقط على القدرة على التخصيب أو امتلاك القنبلة، بل على الاستعداد الفعلي لاستخدام القوة وتجاوز الخطوط الحمراء.
التحولات الدبلوماسية تفتح الباب لاتفاق شامل
ويشير دريوش يوهائي إلى أن الانفراجة في العلاقات الإيرانية السعودية كانت محطة مفصلية في السياسة الخارجية الإيرانية، حيث بدأ تراجع تدريجي في دور الوكلاء لصالح سياسة تركز على الدولة ومكانتها الإقليمية.
ويرى أن هذا التطور يمهد لمرحلة جديدة قد تُتوَّج باتفاق شامل مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، لا سيما وأن إيران باتت اليوم دولة "على العتبة النووية"، أي أنها تمتلك القدرات الفنية اللازمة دون إعلان رسمي عن امتلاك السلاح.
ويختم بالقول إن المفاوضات المحتملة لن تقتصر على أجهزة الطرد المركزي ونسب التخصيب، بل ستشمل أيضًا دور إيران الجديد في المنطقة، وحدود نفوذها، واستعدادها لتقديم نموذج ردع بديل عن السباق نحو السلاح النووي.

بقلم: أورنيلا سكر – باحثة في الشؤون الجيوسياسية - لبنان
حرب الردع الكبرى.. هل تنقلب الجغرافيا السياسية إلى أزمة اقتصادية عالمية؟
تدور عجلة الأحداث سريعا في الشرق الأوسط، وهذه المرة، لا يتعلق الأمر بمواجهة تقليدية أو ضربة عسكرية محدودة. فالحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل في عام 2025 تحمل طابعًا مختلفًا، أقرب إلى "زلزال استراتيجي" يعيد رسم خرائط النفوذ، ويضع مفاهيم مثل السيادة والردع النووي على طاولة الاختبار القاسي.
هذه الحرب ليست مجرد فصل جديد في صراع طويل، بل محطة فاصلة في تاريخ المنطقة، توازي – وربما تتجاوز – ما شهدناه في العراق، ليبيا، وأفغانستان خلال العقود الماضية.
تشابهات مثيرة... واختلاف جوهري
من السهل أن نستدعي ذاكرة الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أو سقوط النظام الليبي في 2011، أو حتى الانسحاب المهين من أفغانستان في 2021. في كل تلك الحروب، سقطت أنظمة، وانهارت دول، وبقي السؤال معلقًا: من يملأ الفراغ؟
لكن مع إيران، المشهد مختلف. فالدولة التي تتعرض لضربات إسرائيلية اليوم، ليست مجرد نظام هش أو معزول، بل قوة إقليمية لديها بنية تحتية نووية متقدمة، وامتدادات سياسية وعسكرية تمتد من العراق إلى لبنان واليمن. إنها باختصار، دولة على حافة السلاح النووي.
الردع النووي: من يجرؤ على الخطأ؟
أكثر ما يثير القلق في هذه المواجهة هو أنها تدور فوق "خط النار النووي". فـ "إسرائيل"، التي ترفض علنًا امتلاك إيران لأي قدرة نووية، لجأت إلى ضربات وقائية جريئة. لكن إيران، وعلى غير العادة، لا تبدو مستعدة للتراجع، بل تؤكد أنها تخوض معركة "وجودية". إنها لحظة اختبار حقيقية لمعادلة الردع في الشرق الأوسط: هل تمنع القدرة النووية الحرب؟ أم تشعلها عندما يشعر أحد الأطراف أن خصمه بات على بعد خطوة واحدة من امتلاك القنبلة؟
معركة السيادة والهوية
في خلفية المشهد، تتجاوز هذه الحرب حدود الجغرافيا لتدخل في عمق الهوية السيادية. فإيران ترى أن التنازل عن برنامجها النووي أو منظومتها الدفاعية هو انتحار سياسي وثقافي. أما "إسرائيل"، فترى في التعايش مع "إيران نووية" تهديدًا وجوديًا لا يمكن التساهل معه.
هنا، نحن أمام صراع لا يحسمه السلاح فقط، بل منطق العقيدة، والتاريخ، ومفهوم الدولة.
توازنات العالم على المحك
الحرب الدائرة تكشف أيضًا حجم التحولات في المشهد الدولي.
الولايات المتحدة – المنهكة داخليًا – لم تعد اللاعب الوحيد.
روسيا تترقب وتناور من سوريا، فيما تلوّح الصين بنفوذ اقتصادي هائل يمكن أن يعيد تشكيل موازين القوة.
كل طرف ينظر إلى هذه الحرب كفرصة لتعزيز موقعه، أو تصفية حسابات قديمة.
شرق أوسط جديد يولد من النار؟
من رحم هذه المواجهة، بدأت تتبلور خريطة أمنية جديدة للمنطقة.
التحالفات تتغير.
المواقف الخليجية تزداد استقلالية.
قوى غير دولانية – مثل حزب الله والحوثيين – تدخل المعركة من أبوابها الخلفية.
ما بعد الحرب، لن يشبه ما قبلها.
فإن سقط النظام الإيراني أو ضعفت بنيته المركزية، من يضمن ألا تتحول البلاد إلى "ليبيا نووية" أو "عراق جديد" بوزن جيوسياسي مضاعف؟
الفراغ الأخطر من الحرب
تجربة العراق بعد 2003، وأفغانستان بعد 2021، علمتنا أن إسقاط النظام لا يعني نهاية الحرب، بل بدايتها.
السؤال الحقيقي: من يملأ الفراغ؟
من يضبط السلاح؟
من يمنع الفوضى العابرة للحدود؟
ما لم تُطرح إجابات ذكية ومبكرة، فإن هذه الحرب قد تفتح أبوابًا على جحيم أوسع من حدود الصراع الحالي.
ختاما، الحرب الإيرانية–الإسرائيلية 2025 ليست فقط مواجهة مسلحة، بل لحظة كاشفة:
عن حدود القوة،
عن توازنات الردع،
عن معنى السيادة،
وعن قدرة الشرق الأوسط على إنتاج استقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى بتفاهمات كبرى.
هل تكون هذه الحرب بداية شرق أوسط جديد، أم مجرد حلقة دامية في مسلسل اللا نهاية؟
الأسابيع المقبلة وحدها ستجيب.
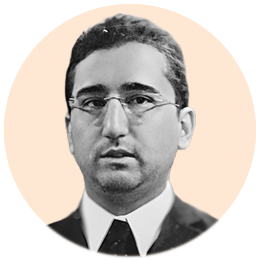
بقلم: علي رضا محمدي - محلل ايراني
النظام العالمي تحت المجهر.. لماذا تخاف القوى الكبرى من إيران؟
منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة وإرساء النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، شاركت إيران في جميع المحافل الدولية كدولةٍ مؤسسةٍ ومساهمة.
تُعد إيران من أوائل الدول التي ساهمت في تشكيل الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، مثل منظمة اليونسكو وغيرها، كما أنها من أوائل المساهمين في صندوق النقد الدولي، وتمثل حاليًا ست دول داخل هذا الصندوق. كما استضافت إيران أول مؤتمر عالمي لحماية المناخ في مدينة رامسر، والذي أصبح لاحقًا سلسلة مؤتمرات COP. وكانت إيران الدولة الوحيدة في المنطقة التي خُطط لها أن تلعب دورًا محوريًا في النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال تشكيل منظمة CENTO، وشراء حصة ضخمة من مشروع EURODIFF، والتوقيع على اتفاقيات مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لتطوير برنامج نووي مدني، وغير ذلك من المشاريع.
هذا ما اتفقت عليه إيران مع القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بشأن مستقبلها.
تجدر الإشارة إلى أن إيران كانت تخطط لشراء شركة "مرسيدس" الألمانية لنقل تقنيات صناعة السيارات إلى إيران والمنطقة، كما أن إيران كانت تمتلك المطار الوحيد في المنطقة المتوافق مع طائرات الكونكورد، لتكون مركز الربط الإقليمي في "القرية العالمية"، يربط بين لندن وباريس وجزيرة كيش في إيران ثم إلى طوكيو. لكن... الثقافة الإيرانية تقوم على التسامح والعدالة في القضايا المحلية والعالمية.
ومع أن الشاه الإيراني آنذاك غضّ الطرف عن قضية فلسطين وأقام علاقات سياسية مع الكيان الصهيوني، فإن الشعب الإيراني عارض هذا التوجه. ومع تصاعد الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، زاد الغضب الشعبي، مما أدى إلى اندلاع الثورة الإسلامية، التي غيّرت مسار المنطقة بأكملها.
ومنذ ذلك الحين، لم تقتصر ردود فعل "حماة النظام العالمي" على رفض الاتفاقيات السابقة، بل فرضوا على الجمهورية الإسلامية العقوبات والحروب، ليس فقط بسبب الثورة الوطنية، بل بسبب النموذج الجمهوري الجديد الذي وُلد في قلب أنظمة ملكية مسلمة.
لقد اختارت إيران طريق الأمة الإيرانية، بدلًا من الانصياع لظلم الملوك وحراس النظام العالمي.
ومن الجدير بالذكر أن الإيرانيين استلهموا ثورتهم من الشعب الجزائري الشجاع، الذي غيّر مجرى التاريخ في وجه الاستعمار، وكان للدكتور علي شريعتي دور بارز ومشترك بين الشعبين.
ورغم كل ما تعرّضت له إيران منذ الثورة، فإنها ما تزال تواصل المشاركة في المحافل الدولية، رغم الحروب والاختلالات التي فُرضت عليها.
وفي الواقع، فإن القدرة النووية ليست فقط حقًا مؤجلًا من الغرب تجاه إيران، بل هي تكنولوجيا محلية طوّرها الإيرانيون رغم أقسى نظام عقوبات فُرض على أي دولة.
ورغم ذلك، تواصل إيران تطوير هذه التكنولوجيا، وهي عازمة على تحقيق الردع النووي، رغم أنها كانت أول دولة في المنطقة تقترح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية قبل خمسين عامًا.
والسؤال البديهي هنا هو: لو كانت إيران تمتلك سلاحًا نوويًا، هل كان صدام ليجرؤ على شن حرب دامت ثماني سنوات وتسببت بكل تلك الخسائر؟
ولو كانت إيران قوة نووية، هل كانت "إسرائيل" لتجرؤ على التخطيط لهجوم سينمائي على أمتنا؟
نحن ندرك المخاطر العالمية التي تترتب على تغييرنا لمسار المنطقة، وندرك أيضًا أن أنشطة حلف الناتو غير القانونية تُشكّل تهديدًا دائمًا لنا.
ويجدر التنويه إلى أن حلف شمال الأطلسي هو في الأساس منظمة دفاع إقليمي شرعية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه منذ عام 2000 بدأ يتصرف كـ"حارس للنظام العالمي" بموجب الفصل الثامن من الميثاق، دون أي تفويض من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، مستندًا إلى تبريرات وهمية مثل "الضربة الوقائية".
فالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي من تقرر حسب مصالحها ووفق نظام قديم منتهي الصلاحية، وتشن الحروب حيثما شاءت.
ولهذا، فإن امتلاك القوة النووية بات حتميًا بالنسبة لأمةٍ إيرانيةٍ تمتد جذورها إلى آلاف السنين، وتمتلك أقدم شكل من أشكال الحكم المستقر في العالم، وتسعى إلى نظام عالمي أكثر عدلًا، يدافع عن الجنوب العالمي، ويؤمن بالأخوّة والعدالة وحسن النية، ضمن نظام عالمي جديد آخذٍ في التشكّل.

بقلم: أ.د. علاء رزاك فاضل النجار - استاذ العلاقات الدولية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي - جامعة البصرة- العراق.
النووي الإيراني.. شرارة تصعيد تهدد اقتصاد الخليج واستقراره
إن البحث في موضوع البرنامج النووي الإيراني يرتبط بشكل مباشر بالنظام السياسي في طهران. إذ أوجدت الطبيعة الإيديولوجية للنظام الإيراني حالة من الصراع والمنافسة مع الدول الغربية وحليفتها "إسرائيل". فمنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، امتازت العلاقات بين الجانبين بالتوتر والتصعيد، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على الاستقرار في منطقة الخليج العربي.
ولا شك أن البرنامج النووي الإيراني المتقدم أثار قلق المجتمعين الإقليمي والدولي، ففي الوقت الذي تُصرّ فيه إيران على أن برنامجها النووي سلمي بحت، وهو خاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها لا تنوي تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء أي بنسبة (90%) حتى في حال فشل كل الجهود الدبلوماسية الداعية إلى التوصل إلى تفاهمات مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي، ترى الولايات المتحدة وعددًا من الدول الغربية لاسيما بريطانيا وفرنسا، فضلًا عن "إسرائيل"، أن امتلاك إيران القدرة على صنع سلاح نووي يعد تهديدًا محتملاً لمنع الانتشار النووي. وإن امتلاك القدرة على صنع السلاح النووي لا يعني بالضرورة امتلاكه. ومما زاد من صعوبة الموقف الإيراني ورود بعض التقارير الدولية التي تؤكد أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق (60%)، وهو قريب من مستوى صنع السلاح، الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي والإقليمي وعجل من التدخل العسكري الإسرائيلي–الأمريكي ضد المشروع النووي الإيراني.
وبعيدًا عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين، بما فيهم الرئيس دونالد ترامب، الداعية إلى أن الضربات الأمريكية قضت على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وما قابَلها من تصريحات رسمية للنظام الإيراني قللت كثيرًا من تأثير الضربات الأمريكية ووصفتها بأنها مبالغ فيها، تظل احتمالية امتلاك إيران للسلاح النووي مسألة واردة جدًا، لاسيما وأن طبيعة النظام الإيراني وما عرف عنه من تشدد ومماطلة في مسألة جوهرية تتعلق بأمنه وسيادته الوطنية ترجح تلك الاحتمالية كثيرًا، حتى مع عودة الأطراف المعنية إلى الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات.
ولا نجانب الصواب إذ قلنا إن امتلاك "إسرائيل" للأسلحة النووية وعدم خضوع برنامجها النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، علاوة على عدم انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، أعطى المسوغات الكافية للحكومات الإيرانية للسعي من أجل تطوير قدراتها النووية، اعتقادًا منها أن ذلك سيجعلها تحافظ على نظامها السياسي القائم. وعلى الرغم من أن صناع القرار السياسي والعسكري في إيران تجنبوا على الدوام الإشارة ولو من بعيد لمسألة كهذه، بوصفها ستكون وبالًا عليهم وتثبت سعيهم لامتلاك الأسلحة النووية، إلا أن القراءة المستفيضة للواقع تدل بشكل لا لبس فيه إلى هذه الحقيقة.
ونتيجة لما سبق، وفي ظل الوضع الراهن، فإن سباق التسلح الإقليمي سيكون أمرًا محتملاً، فمع توفر الإمكانيات والموارد البشرية والاقتصادية الهائلة لدى دول الخليج العربي، ستسعى تلك الدول إلى تطوير برامج نووية مدنية أو حتى عسكرية مستقبلًا كنوع من الردع أو التوازن الاستراتيجي مع إيران. كما ستتجه دول الخليج العربية إلى تعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وزيادة مشترياتها من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، مثل باتريوت وثاد، خشية من تهديدات صاروخية إيرانية. ناهيك عن تعميق الانقسامات بين دول الخليج العربية، والتي تؤيد بعضها وبشكل مطلق الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات والبحرين، في حين تنتهج بعضها سياسة تتسم بالتقارب المصحوب بالحذر في تعاملاتها مع إيران مثل قطر وسلطنة عمان. وإلى جانب كل ذلك يمكن أن يُترجم التصعيد في الملف النووي إلى تصعيد عبر الوكلاء الإقليميين المرتبطين بإيران مثل الحوثيين أو حزب الله أو حتى بعض الفصائل العراقية، مما يشكل تهديدًا لأمن الخليج من خلال الحروب بالوكالة.
ولعل واحدة من أهم تداعيات وانعكاسات حالة الجدل القائمة حول الملف النووي الإيراني ارتباطه بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي ليس على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم أجمع. إذ إن امتلاك دول الخليج العربي احتياطيات كبيرة من النفط والغاز جعل منها منطقة ذات أهمية استراتيجية في سوق الطاقة العالمي، وتؤدي دورًا رئيسًا في تحديد أسعار النفط والغاز، وأن أي تصعيد هناك مثل إغلاق مضيق هرمز أو استهداف منشآت الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واضطراب إمدادات الطاقة.
وعليه، فإن إنهاء هذه المعضلة لابد أن يكون عبر التوصل إلى تفاهمات دائمة مع الجانب الإيراني تضع في الاعتبار ما تشكله منطقة الخليج العربي من أهمية استراتيجية وحيوية للعالم بأسره، وضرورة إبعاد المنطقة عن ويلات الحروب والصراعات الدولية والإقليمية. وأن ذلك يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تقديم "إسرائيل" ضمانات حقيقية وخضوع برنامجها النووي للإشراف الدولي الصارم، وهو أمر يعد شبه مستحيل في ظل المخاوف الأمنية لديها، وسعيها إلى تعزيز ترسانتها العسكرية بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة.

الدكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولي - مصر
الاقتصاد في مهبّ العقوبات.. ماذا بعد انطفاء كاميرات التفتيش؟
يعتبر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، في تصريحه لـ "الأيام نيوز"، أن قرار مجلس الشورى الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل تحوّلًا قانونيًا وسياسيًا خطيرًا يهدد مستقبل الاتفاق النووي ويقوض مبدأ الشفافية الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويؤكد أن هذه الخطوة تُعيد إيران إلى مربع الغموض وتعرّضها لعقوبات محتملة، مما يصعّب إعادة بناء الثقة المطلوبة لأي مفاوضات مستقبلية مع الغرب.
قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة حظي بدعم داخلي واسع، لكنه أثار جدلاً قانونيًا ودوليًا. يرى الدكتور سلامة أن هذا القرار، رغم كونه من الحقوق السيادية المكفولة دوليًا في ظروف استثنائية، لا يعفي طهران من التبعات السياسية والدبلوماسية المترتبة عليه.
ويشرح أن تعليق التعاون لا يعني انسحابًا من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، بل يُعد تعليقًا مؤقتًا للالتزامات، إلا أن المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الخطوات كمؤشر على نوايا سلبية. فإيقاف عمليات التفتيش ورفض تركيب أجهزة المراقبة يجعل البرنامج النووي الإيراني مفتوحًا لكل التأويلات.
بحسب سلامة، هذه الوضعية تُدخل إيران في دائرة "عدم الامتثال"، مما يمكّن مجلس الأمن من تفعيل آلية العقوبات الدولية المعطلة سابقًا بموجب اتفاق 2015. ورغم أن طهران تعتبر ذلك ورقة ضغط تفاوضية، إلا أن النتائج قد تكون عكسية وتعيدها إلى عزلة قصوى.
ويؤكد أن هذه الخطوات تُعمّق الهوة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يجعل استئناف التعاون أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل الانقسامات الإقليمية وغياب الثقة.
غياب التفتيش يعيد البرنامج النووي إلى دائرة الشك
من أخطر تداعيات تعليق التعاون، وفقًا للدكتور أيمن سلامة، دخول البرنامج النووي الإيراني في نفق الغموض، إذ يُحرم المجتمع الدولي من آلية الرقابة والشفافية، ما يفتح الباب أمام كل أنواع الشكوك والاتهامات.
غياب المفتشين يعني عمليا انعدام أي تقارير دقيقة لمجلس الأمن، ويفقد الوكالة قدرتها على تقييم مدى التزام إيران باستخدام سلمي للطاقة النووية. وهذا يضعف موقف إيران أمام العالم، حتى لو لم تسعَ فعليًا لصنع سلاح نووي.
يشير سلامة إلى أن هذه الخطوة قد تستغلها دول خصوم إيران لشن حملات دبلوماسية أو عسكرية، بذريعة الخطر الغامض للبرنامج، ويصبح الحديث عن "الردع النووي" تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي.
هذا الغموض المتعمّد، بحسب تحليله، يضعف موقف طهران التفاوضي بدل أن يعزّزه، ويجعلها تواجه سيناريوهات مفتوحة تبدأ بتصعيد العقوبات، ولا يُستبعد أن تنتهي بعمل عسكري أو عزل دولي شامل كما في الماضي.
مستقبل التفاهمات النووية في مهبّ الريح
يشدد الدكتور سلامة على أن هذا التصعيد القانوني سيعقد بشكل كبير أي محاولة لإحياء الاتفاق النووي أو الوصول إلى تفاهم جديد مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى، إذ إن الثقة، أساس أي مفاوضات، باتت على المحك.
ويرى أن واشنطن أكدت دائمًا أن العودة للاتفاق النووي مرهونة بتعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فإن تعليق التعاون يُفقد إيران شرطًا أساسيًا لاستئناف المفاوضات.
ويضيف أن المجتمع الدولي يفهم هذه الخطوة كمناورة تفاوضية خطيرة، لكنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد تُفسّر كمؤشر على نية إيران تسريع تخصيب اليورانيوم والاقتراب من العتبة النووية.
في ختام تصريحه، يطرح الدكتور سلامة سؤالًا جوهريًا: هل نحن أمام نهاية المسار الدبلوماسي؟ ويترك السؤال مفتوحًا مع تحذير من أن أي تدهور إضافي في العلاقة بين إيران والوكالة سيُقوّض فرص السلام ويُقرب المنطقة من سيناريوهات انفجار أمني واقتصادي غير محسوب.