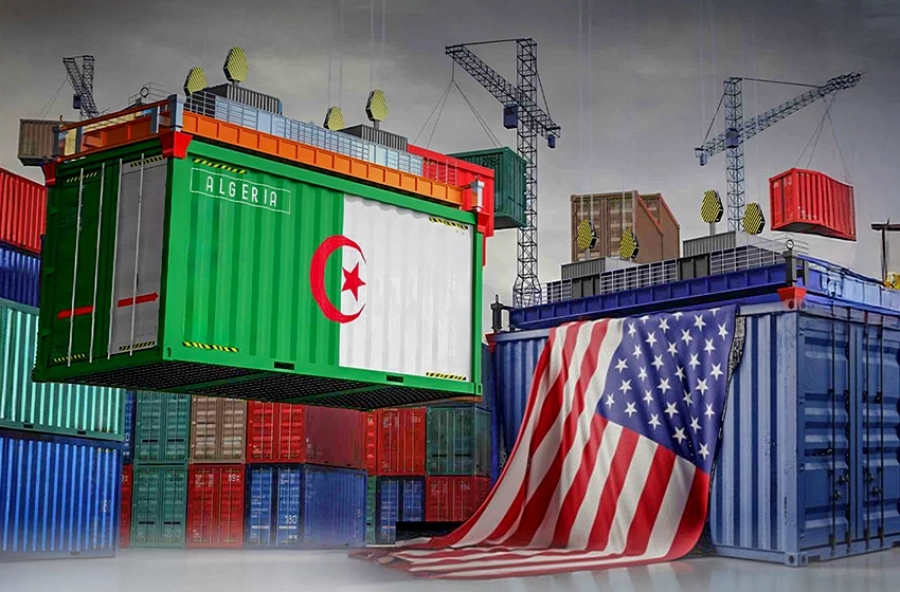بينما تتسابق دول كثيرة نحو الأسواق المالية العالمية بحثًا عن قروض تُثقِل كاهل شعوبها، اختارت الجزائر طريقًا مختلفًا يقوم على تصفية الحساب مع الماضي، واسترجاع ما نُهب من ثرواتها، لإعادة توجيهه نحو بناء اقتصاد وطني مستقل. في أكثر من مناسبة، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية مهما اشتدت الظروف، مؤكّدًا أن الحلول الحقيقية تنبع من الداخل، لا من شروط المانحين. وانطلاقًا من هذا المبدأ، تحوّل ملف استرجاع الأموال المنهوبة من مجرد مسار قضائي إلى ركيزة اقتصادية محورية، تُوظّف فيها الأصول المصادرة والممتلكات المسترجعة لدعم التنمية، وخفض الضغط على الميزانية، وقطع الطريق أمام التبعية. ورغم أن الطريق لا يخلو من تعقيدات قانونية وواقعية، فإن الجزائر تتجه نحو توظيف الأموال المسترجعة في تمويل التنمية بدل الاستدانة... فإلى أي حد يُمكن لهذا الخيار أن يُساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل؟
إذا كانت البداية في ملف استرجاع الأموال المنهوبة قد انطلقت من دوافع قانونية وأحكام قضائية، فإن التطورات اللاحقة بيّنت أن هذا المسار يتجاوز مجرد تنفيذ الأحكام، ليصبح خيارًا اقتصاديًا محوريًا ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة تنموية مستقلة.
فاسترجاع المال العام يندرج ضمن سياق مكافحة الفساد، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج، وتوفير بدائل داخلية تغني عن مصادر التمويل الخارجي المكلّفة.
وقد أدركت السلطات الجزائرية في وقت مبكر أن الأموال المنهوبة لم تكن مجرد خسائر رمزية، بل شكّلت نزيفًا حقيقيًا أضعف البنية الاقتصادية، وأدى إلى تعطيل مشاريع استراتيجية، سواء بسبب تهريب رؤوس الأموال أو تجميد الأصول التي كان يمكن أن تساهم في خلق الثروة.
من الثروة المسترجعة إلى الاستثمار المنتج
لذلك، تحرّكت الدولة بخطة متكاملة تستند إلى القانون، لكنها تتجاوز ساحات المحاكم نحو استعادة دورة اقتصادية كان من المفترض أن تخدم المواطن والمؤسسة العمومية.
تصريحات وزير العدل الأخيرة تؤكد هذا التحول في الرؤية، حيث تم الإعلان عن إرسال 335 إنابة قضائية دولية إلى 32 دولة، إضافة إلى 53 طلبًا لاسترداد موجودات في 11 بلدًا، ما يعكس حجم الجهد المبذول وطبيعة الرهان الاقتصادي الذي باتت تمثله هذه المعركة.
لم تعد القضية مرتبطة بالأحكام فقط، بل بتوظيف نتائجها في تعزيز الإيرادات الوطنية خارج قطاع المحروقات.
وتزداد أهمية هذا المسار في ظل التحديات المالية الإقليمية والدولية، حيث أصبح من الضروري تنويع مصادر التمويل، وضمان حماية الموارد الوطنية من التبديد والتسرب.
فالمال المسترجع اليوم، سواء كان عقارًا أو حسابًا مجمّدًا أو مصنعًا، يشكّل لبنة أساسية في مشروع اقتصادي سيادي يقوم على استثمار ما هو قائم قبل التفكير في الاقتراض أو طلب المساعدات.
التحوّل من منطق العقوبة إلى منطق التوظيف الاقتصادي للثروات المسترجعة يعكس نضجًا مؤسساتيًا في التعاطي مع الملفات الثقيلة، ويمنح الدولة أداة فعالة في تمويل التحول الاقتصادي، بعيدًا عن الشروط الخارجية أو الإملاءات المالية، ويجعل من العدالة الاقتصادية امتدادًا طبيعيًا للعدالة القضائية.
الرئيس يحدّد السقف.. لا استدانة مهما اشتدت الأزمات
في ظل هذا التوجّه الذي يمنح للثروات المسترجعة بعدًا اقتصاديًا واضحًا، يبرز خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوصفه الإطار السياسي الحاسم الذي يحدّد أولويات الدولة المالية. فمنذ تولّيه الحكم، حرص تبون على التأكيد أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، مهما كانت الأزمات أو الضغوط، وهو موقف يُجسّد إرادة صريحة للحفاظ على السيادة الاقتصادية، وتفادي أي ارتهان للقرار الوطني.
هذا التوجّه جاء منسجمًا مع مسار عملي شرعت فيه الدولة، يقوم على تعبئة الموارد الداخلية، وتطهير الاقتصاد من رواسب الماضي، وتوظيف الأدوات المتاحة لتغطية الحاجات التمويلية دون الاستعانة بالقروض الأجنبية.
وكان لافتًا أن هذا الموقف لم يتغيّر رغم الأزمات العالمية المتتالية، سواء في أسواق الطاقة أو سلاسل التوريد أو تقلبات الأسواق المالية.
الرئيس تبون ربط هذا الخيار بإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث شدّد أكثر من مرة على أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو الاستدانة من الخارج يُشكّل خطرًا على استقلالية القرار، وقد يؤدي إلى المساس بالسياسات الاجتماعية التي تميز النموذج الجزائري، خصوصًا فيما يتعلق بدعم الفئات الهشة، وضمان مجانية التعليم والصحة.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة التحرك الواسع في ملف الأموال المنهوبة كجزء من هذه الرؤية الرافضة لأي تدخل أجنبي في الشؤون المالية للبلاد.
فالمال الذي استُعيد من الخارج، حتى وإن كانت مساراته معقدة، يظل أفضل بكثير من قروض قد تفرض لاحقًا شروطًا موجعة تمس الخيارات الاستراتيجية للدولة والمواطن.
هذا الموقف السياسي الصلب منح ملف استرجاع الأموال زخما أكبر، حيث بات يُنظر إليه كبديل سيادي حقيقي، وكمورد محلي يمكن توسيع نطاقه وتحسين أدواته، لتمويل الإصلاحات الكبرى وتحقيق الاستقرار المالي، من دون الدخول في دوامة الديون التي أرهقت الكثير من الدول النامية.
حين تتحوّل المصادَرات إلى أدوات للنمو الفعلي
في ظل هذا الإطار السيادي الذي يرفض الديون ويراهن على ما تم استرجاعه من الداخل والخارج، بدأت نتائج عملية استرجاع الأموال المنهوبة تظهر على الأرض، ليس فقط في شكل أرقام ومصادرات، بل من خلال إعادة تشغيل وحدات إنتاجية وإحياء مؤسسات كانت متوقفة بسبب قضايا الفساد.
هذا التحول العملي عزّز قناعة الدولة بأن الثروات المصادرة يمكن أن تشكّل رافعة اقتصادية فاعلة إذا ما أُحسن توجيهها واستغلالها.
وزير الصناعة الأسبق علي عون أشار في أكثر من مناسبة إلى استرجاع قرابة خمسة عشر مصنعًا، تم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو دمج ما تم استرداده ضمن الدورة الإنتاجية، بدل تركه مجمدًا في سجلات المحاكم أو على رفوف القضايا المغلقة.
هذه الخطوة تُظهر بوضوح أن الدولة لا تكتفي بالاسترجاع لأغراض رمزية، بل تتجه نحو الاستثمار الفعلي فيما تمت استعادته.
هذا التوجه يندرج ضمن سياسة اقتصادية تعطي الأولوية للموارد الوطنية، وتسعى لتحويل الأعباء السابقة إلى فرص جديدة للنمو، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى دفعة إضافية، مثل الصناعات التحويلية، الأشغال العمومية، والصيدلة.
إعادة بعث المصانع المصادرة لا تسهم فقط في خلق مناصب شغل، بل تخفف أيضًا من الاعتماد على الاستيراد، وتعزز التوازن في الميزان التجاري.
من جهة أخرى، يفتح هذا المسار الباب أمام التفكير في كيفية تعميم التجربة وتوسيعها، لتشمل كل الأصول التي يمكن تحويلها إلى أدوات إنتاجية، سواء عبر الشراكة مع القطاع العام، أو من خلال وضع آليات شفافة لتأجيرها أو إعادة تشغيلها من قبل مستثمرين جدد، بشروط تضمن حماية المال العام.
فالتحدي الحقيقي لم يكن فقط في استعادة ما سُرق، بل في حسن إدارته بعد الاسترداد.
ومع تزايد الأملاك المصادرة وتطور آليات المتابعة والتوثيق، بات واضحًا أن الأموال المنهوبة لم تعد عبئًا قضائيًا، بل موردًا فعليًا لدفع عجلة التنمية، ومصدرًا للتمويل الداخلي يعوّض العجز، ويمنح الاقتصاد الوطني نفسًا جديدًا، بعيدًا عن الحلول السهلة قصيرة المدى التي تراهن على الاقتراض.
الثروة المستعادة.. مورد داخلي بديل للتمويل
حين تؤكد الدولة الجزائرية أن الاستدانة الخارجية ليست خيارًا مطروحًا، فإنها لا تُطلق مجرد شعارات، بل تتبنّى سياسة مالية قائمة على تعبئة الموارد الوطنية، وفي مقدّمتها الأموال المنهوبة.
فاسترجاع ما تمّ نهبه لا يُعدّ تصفية لحسابات الماضي فحسب، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في المستقبل، من خلال توجيه هذه الأموال والأصول نحو مشاريع إنتاجية تحقق القيمة المضافة، وتقلل الاعتماد على الخارج.
وقد بدأت وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات القضائية، في وضع آليات جديدة لحصر العائدات المسترجعة، وتوجيهها في مسارات تنموية فعّالة، وهو ما يتطلب تفعيل منظومة الحوكمة، وتحديث أدوات التسيير، حتى لا تتحول الأموال المستعادة إلى كتلة مالية مجمدة من دون أثر اقتصادي ملموس.
بالموازاة، تعمل الدولة على تجاوز الطابع الجزائي للمصادرات، والانتقال إلى منطق التثمير والتشغيل، من خلال خلق آليات تسمح بإعادة إدماج هذه الأصول في الدورة الاقتصادية، سواء عبر توسيع صلاحيات الوكالة القضائية أو تعزيز التنسيق مع القطاع العمومي الاقتصادي.
وهذا ما يعكس توجهًا استراتيجيًا يرمي إلى بناء اقتصاد منتج من الداخل، بأموال الداخل، وتحت سلطة القانون.
هذا النموذج، الذي يربط بين محاربة الفساد واسترجاع الأموال من جهة، وتوظيفها في الاستثمار العمومي من جهة أخرى، يضع الجزائر في مسار مغاير للعديد من الدول التي اختارت الهروب إلى الأمام عبر الديون.
وهو ما يمنح الدولة أفقًا أوسع في ضبط سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، في إطار نظرة اقتصادية شاملة تعيد الاعتبار لثنائية السيادة والعدالة.
من "مصانع العصابة" إلى مؤسسات عمومية تُنتج
ضمن هذا المسار الذي يعتمد على تحويل الموارد المسترجعة إلى أدوات تنمية فعلية، تبرز تجربة تحويل المصانع التي كانت مملوكة لأطراف متورطة في قضايا فساد إلى مؤسسات عمومية منتجة، كأحد أهم أوجه الاستفادة الاقتصادية من ملف استرجاع الأموال. هذه المصانع، التي كانت رمزًا للفوضى واستغلال النفوذ، أصبحت اليوم ورشات إنتاجية تسهم في خلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل.
تعاملت السلطات العمومية مع هذه المصانع كفرصة لإعادة بعث النشاط الصناعي في عدد من الولايات، مستفيدة من جاهزيتها التقنية وطواقمها البشرية السابقة. وقد تم تسجيل حالات واقعية تم فيها تشغيل الوحدات بشكل تدريجي، تحت إشراف مؤسسات تابعة للدولة أو في إطار شراكات تخضع لرقابة صارمة. هذا التوجه ساعد على تقليص آثار توقف تلك الوحدات، وفتح المجال أمام استعادة حيوية صناعية كانت مهددة بالزوال.
تندرج إعادة بعث هذه المصانع ضمن رؤية اقتصادية أشمل، تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتقليص الاعتماد على الواردات، واستعادة التوازن في السوق المحلية. كما أن توجيه هذه الوحدات نحو قطاعات استراتيجية مثل الأشغال العمومية، والصيدلة، والصناعات الغذائية، يعكس وعيًا بتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الوطنية.
ومن خلال متابعة تجربة هذه المؤسسات، يتبين أن عملية الاسترجاع لا تتوقف عند حجز الممتلكات، بل تُستكمل بتحويلها إلى مشاريع تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني. فالقيمة الحقيقية لأي أصل مسترجع تكمن في دمجه في الدورة الاقتصادية، وفي قدرته على الاستمرار ضمن منطق الإنتاج والابتكار والتشغيل.
وقد فتحت هذه التجربة الباب أمام طرح تساؤلات حول إمكانية توسيع العملية لتشمل المزيد من الأملاك المصادرة، وتطوير نماذج قانونية وتنظيمية مرنة تسمح بتسريع إعادة استغلالها، في إطار من الشفافية والحكامة، بما يضمن الاستفادة القصوى من كل ما تم استرجاعه لصالح الاقتصاد والمجتمع.
استرجاع الأموال.. شريان جديد لتخفيف أعباء الميزانية
في سياق إعادة توظيف الممتلكات المصادرة وتحويلها إلى أصول منتجة، بدأ يظهر أثر مباشر لهذا التوجه على مستوى المالية العمومية، حيث ساعدت الموارد المسترجعة في تخفيف الضغط على الميزانية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة في تمويل المشاريع الكبرى وتحقيق التوازنات المالية. هذه الأموال، رغم أنها لا تغطي كل الاحتياجات، أسهمت في تقليص الاعتماد على حلول مالية استثنائية كالقروض أو الطباعة النقدية.
كشفت البيانات الرسمية عن استرجاع مبالغ معتبرة منذ نهاية 2019، فاقت 30 مليار دولار، وتشمل أموالاً مجمدة في الخارج، وعقارات، ومصانع، ومنقولات. هذه الحصيلة لا تُقرأ فقط من زاوية الرقم، وإنما من حيث قدرتها على سد فجوات حقيقية في بعض بنود الإنفاق، سواء في دعم المؤسسات العمومية أو في تمويل مشاريع استعجالية دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية.
وعلى المستوى المحاسبي، يشكّل المال المسترجع موردًا إضافيًا يمكن إدراجه في موازنات بعض القطاعات الحساسة، وهو ما يمنح الحكومة هامشًا أكبر في إعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الإنفاق نحو ما يخدم التنمية والاستقرار الاجتماعي. كما أن هذه الموارد تخفف من وتيرة الضغوط المفروضة على الخزينة، وتمنحها نفسًا قصيرًا ومتوسطًا يسمح بتنفيذ برامج إصلاح دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية.
من ناحية أخرى، يتمثل الأثر غير المباشر في تحسّن صورة الجزائر المالية على المستوى الدولي، حيث يُنظر إلى عملية استرجاع الأموال كمؤشر على الجدية في محاربة الفساد، وكعامل يعزز الثقة في المؤسسات المالية للدولة. هذا العامل قد يسهم في تحسين التصنيف الائتماني، ويمنح الاقتصاد الوطني نوعًا من الحصانة في التعامل مع الشركاء الأجانب.
كل هذه النتائج تؤكد أن استرجاع الأموال لا يقتصر على كونه مسارًا قضائيًا أو إجراءً استثنائيًا، بل يمثل أحد أدوات ضبط التوازنات الكبرى، ويشكّل خيارًا فعليًا لمواجهة الضغوط دون اللجوء إلى سياسات تمس السيادة المالية أو تثقل كاهل الأجيال القادمة.
معركة استرجاع الثروات.. القانون والدبلوماسية في الميدان
وبعد أن أثبتت عملية استرجاع الأموال فعاليتها في تخفيف الأعباء المالية وتحسين مؤشرات السيادة الاقتصادية، يبرز البعد القانوني والدبلوماسي في هذه المعركة باعتباره أحد أعمدتها الرئيسية. فالنجاح في ملاحقة الأموال المهربة لا يعتمد فقط على الأحكام القضائية، وإنما يتطلب تفعيل شبكة معقدة من العلاقات الثنائية والتعاون الدولي، إضافة إلى تسخير المنصات متعددة الأطراف التي تتيح تبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات.
تصريحات وزير العدل الأخيرة كشفت عن تفاصيل دقيقة تعكس حجم الجهد المبذول، حيث أرسلت الجزائر 335 إنابة قضائية دولية إلى 32 دولة، و53 طلب استرداد موجودات إلى 11 دولة، بعضها خارج الفضاء الأوروبي التقليدي. هذا الامتداد الجغرافي يُظهر أن الجزائر تتحرك وفق خطة شاملة، تجمع بين المسارات القضائية الرسمية، والتحركات الدبلوماسية غير المباشرة، بهدف تضييق الخناق على شبكات تهريب المال العام.
لم يتوقف التحرك الجزائري عند الطلبات الرسمية، بل شمل الانضمام إلى عدد من الشبكات والمنصات الدولية المختصة، مثل مبادرة "ستار"، والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات، والشبكة الإقليمية "أرين-مينا"، وغيرها من الهياكل التي أتاحت للسلطات الجزائرية عقد لقاءات تنسيقية مباشرة مع نظرائها في الدول المعنية، وتجاوز بعض العراقيل التي يفرضها البطء القانوني أو تداخل الصلاحيات.
إضافة إلى ذلك، اعتمدت الجزائر آلية التحاور المرئي المنتظم، وتنقلت وفود لجنة الخبراء إلى عدد من العواصم لمتابعة الملفات العالقة، وإقناع السلطات القضائية هناك بأهمية التعاون. هذا التفاعل الميداني منح القضية بُعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا جديدًا، وأكد أن الدولة لا تنتظر الحلول من تلقاء نفسها، وإنما تبادر وتفاوض وتنسق بشكل دائم.
ومع تطور هذه الديناميكية، تتكرس فكرة أن المعركة لا تقتصر على المرافعات أو النصوص، وإنما تشمل تراكما في الخبرة، وتعزيزا للحضور الدولي، وبناء لعلاقات ثقة مع الشركاء. فكل خطوة تُبذل على هذا الصعيد تُسهم في تهيئة مناخ أكثر إيجابية لاسترجاع الحقوق المالية، وتقوية أدوات الدولة في فرض سيادتها خارج الحدود.
لا قروض بعد اليوم.. سيادتنا أولًا
مع اتساع نطاق التحركات القانونية والدبلوماسية لاسترجاع الأموال المنهوبة، يصبح من الواضح أن الجزائر تضع السيادة الاقتصادية في قلب أولوياتها، وتعتبر أن أي لجوء إلى التمويل الخارجي قد يشكّل مدخلًا للمساس باستقلالية القرار الوطني. هذا التوجه يُترجم رؤية متكاملة تنطلق من مبدأ أساسي مفاده أن قوة الدولة تبدأ من قدرتها على التحكم في مواردها ومصيرها المالي.
عبّر الرئيس تبون بوضوح عن هذا المنطلق، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن الجزائر لن ترهن مستقبلها بقروض أجنبية، حتى وإن كانت الظروف الاقتصادية ضاغطة. هذا الموقف يجد صداه في الطريقة التي تدير بها الدولة ملف استرجاع الأموال، حيث تتعامل معه كأداة لتعزيز القدرة التمويلية من داخل المنظومة الوطنية، دون الخضوع لمعادلات السوق الدولية أو شروط المؤسسات المانحة.
التمسك بهذا الخيار يُعد في ذاته تعبيرًا عن إرادة سياسية تسعى إلى بناء نموذج تنموي مستقل، يقوم على تعبئة الموارد الذاتية، وتنويع مصادر الدخل، ومحاربة مظاهر التبعية المالية التي عانت منها البلاد في فترات سابقة. استرجاع الأموال تحوّل إلى رافعة من روافع الاستقلال الاقتصادي، وشكل من أشكال المقاومة الهادئة التي تمارسها الدولة في وجه الضغوط غير المباشرة.
كما أن هذا التوجه يكتسب زخمًا إضافيًا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي أثبتت أن الاعتماد على الخارج لا يشكل ضمانة حقيقية، بقدر ما يزيد من هشاشة الدول أمام تقلبات الأسواق وتقارير التصنيف. لذلك، فإن ما تقوم به الجزائر اليوم من استرجاع للثروات المنهوبة هو في حقيقته تحصين لموقعها الاقتصادي، وتأمين لقرارها السياسي.
ومن خلال هذا المسار، ترسل الدولة إشارات قوية إلى الداخل والخارج مفادها أن التغيير لا يكون فقط بالشعارات، وإنما بإعادة الاعتبار للمال العام، واستعماله كوسيلة لبناء اقتصاد متحرر من الإملاءات، يستجيب لحاجات المواطنين، ويكرّس سيادة الدولة في بعدها المالي والاستراتيجي.
من خزائن الفساد إلى مشاريع تنموية حيّة
في ظل هذا المسار السيادي الذي تتبناه الجزائر، بدأت المؤشرات الإيجابية تظهر تدريجيًا على أرض الواقع، حيث انعكست جهود استرجاع الأموال على بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في تحسين مناخ الثقة بين الدولة والمواطن. فالمكاسب التي تحققت تجسدت في إعادة تشغيل مصانع، وتحريك مشاريع كانت معلقة، وتوجيه الموارد نحو أولويات محسوسة.
المواطن، الذي تابع لسنوات أخبار الفساد والنهب، صار اليوم يلمس نتائج مغايرة، حيث تم حجز عقارات وأرصدة وممتلكات لم يكن يتوقع أن تعود إلى الخزينة العمومية. هذا التغير ساعد في ترميم العلاقة المهزوزة بين الفرد والدولة، وأعاد إلى الأذهان فكرة أن المال العام هو مسؤولية مشتركة، وأن الإفلات من العقاب لم يعد قاعدة قائمة.
كما أن المكاسب الاقتصادية الناتجة عن هذا المسار تُسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار والإنتاج، إذ تشير التجربة إلى أن إعادة الاعتبار للمؤسسات المصادرة واستخدامها في التنمية يفتح مجالات جديدة للشغل، ويقلّص من التفاوت في التوزيع الجغرافي للثروة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم مباشر للنشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن هذه النتائج تفتح المجال أمام بناء ثقافة جديدة في التعامل مع المال العام، تقوم على الشفافية والمساءلة، وتشجع على رقابة مجتمعية أوسع، سواء من قبل الإعلام أو المجتمع المدني. فكل نجاح يتحقق في هذا الملف يدعم فكرة أن مكافحة الفساد مشروع وطني يعيد بناء الثقة ويصنع الفارق على المدى الطويل.
هذا التراكم في النتائج، رغم التحديات، يمنح الدولة رصيدًا معنويًا وماديًا يمكن البناء عليه، ويؤكد أن الإرادة السياسية حين تترجم إلى خطوات عملية، فإنها قادرة على تحويل ملفات شائكة إلى قصص نجاح تقنع الداخل وتعزز صورة الجزائر خارجيًا.
نحو اقتصاد نظيف… نموذج جزائري جديد
بعد هذا المسار الطويل من استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في تقوية الاقتصاد الوطني، تتضح ملامح مشروع جزائري طموح يسعى إلى بناء نموذج اقتصادي نظيف ومستقل، يقوم على محاربة الفساد واستثمار الإمكانات الذاتية، بعيدًا عن التبعية المالية للخارج. هذا النموذج ينطلق من رؤية عميقة تربط بين العدالة الاقتصادية والسيادة الوطنية.
يشير التحول الجاري في الجزائر إلى أن الدولة تسعى إلى تجاوز مرحلة تصحيح الأخطاء نحو مرحلة التأسيس لمنظومة اقتصادية حديثة، أكثر صلابة وشفافية، تُدار فيها الموارد وفق منطق الأداء لا الولاءات، وتُوجَّه الاستثمارات نحو قطاعات منتجة تخلق الثروة وتضمن الاستقرار الاجتماعي. هذا التوجه يؤكد أن استرجاع المال المنهوب ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لمرحلة جديدة يُعاد فيها رسم قواعد اللعبة الاقتصادية على أسس سليمة.
وفي ظل هذا المسعى، تبدو السلطات العمومية حريصة على ترسيخ مبدأ أن المال العام أمانة لا يجوز المساس بها، وأن إعادة تدويره ضمن الدورة الاقتصادية هو واجب وطني يعادل في أهميته واجب حماية الحدود. ومن خلال تعزيز أدوات الرقابة، وتفعيل الشراكات الدولية، وتحيين التشريعات، تتقدم الدولة نحو بيئة اقتصادية أكثر أمانًا، قادرة على جذب الثقة والاستثمار.
المواطن، من جهته، لم يعد مجرد متفرج، وتحول إلى فاعل متابع ومطالب بالشفافية والمحاسبة، وهو ما يدعم المسار الإصلاحي ويمنحه شرعية مجتمعية قوية. فكل نجاح يتحقق في هذا الملف، يُسهم في إعادة بناء علاقة قائمة على المسؤولية والاحترام المتبادل بين الدولة والشعب.
هكذا تفتح الجزائر صفحة جديدة في مسارها الاقتصادي، لا تقوم على القروض والوعود، وإنما على استرجاع الحقوق، وتطهير الماضي، وتوظيف الإمكانات الذاتية في خدمة مشروع تنموي سيادي، يُراكم الإنجازات، ويمنح للأجيال القادمة أرضية صلبة لبناء جزائر الغد.
وفي وقت اختارت فيه دول عديدة الطريق السهل نحو الاستدانة، قررت الجزائر أن تواجه التحديات بإرادة سيادية تنبع من الداخل، فاسترجاع الأموال المنهوبة خيار اقتصادي متكامل يعكس رفض الارتهان ويؤسس لنموذج تنموي مستقل. ما بين الإنابات القضائية والتحركات الدبلوماسية، وما بين المصانع المسترجعة والمشاريع المعاد تشغيلها، ترسم الدولة مسارًا جديدًا يرتكز على تطهير المال العام وتوظيفه في خدمة المواطن، لتؤكد أن بناء اقتصاد قوي لا يتطلب قروضًا مربوطة بشروط، وإنما يحتاج إلى قرار شجاع يربط السيادة بالعدالة، ويحوّل الأزمة إلى فرصة والنزيف إلى استثمار.

أبو بكر سلامي - خبير اقتصادي
الفرصة الذهبية على المحك.. هل تضيع الثروات المسترجعة في متاهات الإدارة؟
يؤكد الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي، في تصريح لـ "الأيام نيوز"، أن مبلغ 30 مليار دولار الذي أعلنت الجزائر عن استرجاعه حتى نهاية سنة 2023 لا يُمثل أموالًا نقدية فقط، بل يشمل مجموعة متنوعة من الأصول مثل العقارات والمنقولات والأسهم وحقوق الشركات، ما يفرض اعتماد مقاربة دقيقة وفعّالة في طريقة استغلالها. ويرى المتحدث أن القيمة الحقيقية لهذه الأموال لا تكمن في حجمها الظاهر، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات إنتاج واستثمار قبل أن تتآكل قيمتها مع مرور الوقت، مشددًا على أن التأخر في توظيفها سيؤدي إلى خسائر مؤكدة، ويجب مواجهته بقرارات جريئة وسريعة تصدر من أعلى هرم السلطة.
ويُوضح سلامي أن الحديث عن استرجاع الجزائر لما يعادل 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة حتى نهاية 2023 لا يعني بالضرورة أن الدولة استرجعت هذا المبلغ على شكل أرصدة مالية جاهزة، بل إن هذه القيمة التقديرية تشمل أنواعا متعددة من الأصول، من بينها عقارات، تجهيزات، منقولات، أسهم، وحقوق ملكية في شركات، وهي موارد تختلف من حيث طبيعتها الاقتصادية وقابليتها الفورية للتسييل أو الاستثمار.
ويشدد على ضرورة تصنيف هذه الأصول عند تقييم جدواها الاقتصادية، موضحًا أن جزءًا منها يمثل سيولة نقدية يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية مباشرة، بينما يتطلب الجزء الآخر إجراءات إضافية لإدخاله في الدورة الاقتصادية، سواء عبر إعادة التشغيل، أو التصفية، أو الدخول في شراكات. وهذا ما يستدعي تكييف السياسات حسب طبيعة كل نوع من الأصول المسترجعة.
ويضيف أن الفهم الدقيق لتركيبة هذه الموارد ضروري لوضع خطة فعّالة لتوظيفها، لأن الخلط بين الأموال الجاهزة للاستعمال والأصول غير السائلة قد يؤدي إلى قرارات اقتصادية غير مدروسة، أو إلى تعثر في تنفيذ المشاريع التنموية. وهو ما يجعل عملية الجرد والتقييم الفني للأملاك المسترجعة خطوة لا تقل أهمية عن الاسترجاع نفسه.
كما يُنبه إلى أن بعض الأصول المسترجعة، مثل العقارات أو الشركات، قد تكون ذات قيمة تقديرية عالية على الورق، لكنها بحاجة إلى صيانة أو استثمار إضافي حتى تتحول فعليًا إلى موارد اقتصادية منتجة. وهذا يتطلب استشرافًا حقيقيًا عند توجيه هذه الموارد حتى لا تتحول إلى عبء إداري أو مالي.
وفي هذا السياق، يؤكد سلامي أن الرهان لا يكمن فقط في استرجاع هذه الأموال من العصابة، بل في حسن إدارتها وتحويلها إلى أدوات إنتاج تدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يحتاج إلى مؤسسات قوية، وآليات رقابة فعّالة، ورؤية اقتصادية واضحة بعيدة عن البيروقراطية.
كيف تُوظف الأموال النقدية في دعم الاقتصاد؟
وانطلاقًا من التمييز بين الأصول المسترجعة، يرى الخبير أبو بكر سلامي أن الأموال النقدية أو الأرصدة البنكية التي تم استرجاعها يمكن أن تُشكل موردًا مباشرًا وسريعًا لخزينة الدولة، لكنها لا تُحدث الأثر المطلوب إلا إذا وُجّهت نحو استثمارات منتجة. ويُؤكد أن توظيف هذه الموارد في نفقات غير مستدامة أو لتغطية عجز ظرفي قد يبددها دون أن تحقق إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يدعو سلامي إلى تخصيص هذا النوع من الأموال لتمويل مشاريع إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة، وتوليد مناصب شغل، وتوسيع القاعدة الجبائية عبر الضرائب والرسوم الجديدة. فالاستهلاك السريع لهذه الأرصدة دون عائد طويل الأمد لن يكون سوى حلٍّ مؤقت، سرعان ما ينتهي دون أثر ملموس.
ويشير إلى أن المبالغ النقدية المسترجعة يجب أن تُدمج ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاعات الاستراتيجية، خصوصًا تلك التي تضمن الأمن الغذائي، والصناعي، والتكنولوجي، ما يُمكّن من تحويل الموارد الاستثنائية إلى قوة دافعة للإنتاج المحلي وتقليص التبعية الخارجية.
كما يُحذر من توجيه هذه الأموال نحو نفقات استهلاكية أو اجتماعية فقط، دون أن يعني ذلك إهمال البُعد الاجتماعي، بل يشدد على أهمية الحفاظ على التوازن بين تلبية الحاجات الآنية وبناء قاعدة اقتصادية صلبة تضمن الاستمرار. ويضيف أن الحكمة تكمن في تحويل هذه الفرصة إلى نقطة انطلاق لتغيير النموذج الاقتصادي نفسه.
ويرى سلامي أن نجاح الدولة في توجيه الأموال النقدية نحو استثمار فعلي سيكون بمثابة رسالة قوية تؤكد التزامها بخيار السيادة الاقتصادية، وتُحوّل مسار استرجاع الأموال إلى أداة بنّاءة لا مجرد عملية قضائية رمزية، خصوصًا إذا ارتبط هذا المسار بآليات تقييم ومتابعة تقيس أثر تلك الاستثمارات على أرض الواقع.
الشركات المصادرة.. بين إعادة التشغيل والشراكة المدروسة
بعد الإشارة إلى أهمية توظيف الأموال النقدية في مشاريع إنتاجية، يلفت الخبير أبو بكر سلامي إلى أن الأصول المسترجعة لا تقتصر على السيولة، بل تشمل أيضًا شركات قائمة أو حصصًا في مؤسسات اقتصادية كانت مملوكة لأشخاص متورطين في قضايا فساد. ويُؤكد أن هذه الشركات يجب ألا تُترك مجمدة أو معطلة، بل ينبغي إدماجها في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال.
ويُقترح سلامي عدة سيناريوهات لاستغلال هذه المؤسسات، أبرزها إعادة تشغيلها من طرف الدولة عبر إدارتها العمومية، أو إسنادها إلى مؤسسات عمومية متخصصة، شرط توفّر الجدوى الاقتصادية والقدرة على المنافسة في السوق. ويضيف أنه في حال كانت الشركة تنشط في قطاع واعد، يمكن التفكير في شراكات مدروسة مع القطاع الخاص، شريطة أن تحتفظ الدولة بالأغلبية لضمان حماية القرار السيادي.
ويرى المتحدث أن إدخال القطاع الخاص كشريك في هذه الوحدات قد يكون مفيدًا في بعض الحالات، خصوصًا من حيث الخبرة التسييرية أو التمويل الإضافي، لكن دون التنازل عن السيطرة الاستراتيجية. وهذا ما يسمح بإعادة بعث النشاط مع الحفاظ على الطابع العمومي للأصول المسترجعة، وهو توازن ضروري لضمان استمرارية المشروع.
كما يشدد على ضرورة التعامل مع كل شركة على حدة، وفق وضعيتها السوقية، وواقعها المالي والتقني، وتفادي اللجوء إلى حلول موحدة قد تظلم بعض الحالات أو تُهدر فرصًا حقيقية. فبعض المؤسسات قد تحتاج إلى إعادة هيكلة، وأخرى إلى تغيير النشاط، وأخرى يمكن بيعها واستغلال العائد منها في مشاريع أكثر نجاعة.
ويحذر سلامي من ترك هذه الشركات دون استغلال لسنوات، ما قد يؤدي إلى تدهور تجهيزاتها، وفقدان عمالها، وتآكل رأس مالها السوقي، وهو ما يشكل خسارة مزدوجة: ضياع للفرصة الاستثمارية، واستنزاف غير مباشر للثروات المسترجعة. لذلك، يدعو إلى قرارات عملية تُعيد الحياة لهذه المؤسسات ضمن إطار حكامة اقتصادية واضحة وفعالة.
العقارات والآلات والمنقولات.. سباق ضد الزمن
ينتقل الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي إلى نوع آخر من الأصول المسترجعة، يتمثل في الممتلكات المادية كالعقارات والآلات والمنقولات. ويعتبر أن هذا النوع من الأصول يتأثر سريعًا بعامل الزمن، حيث تتراجع قيمته بشكل متسارع إذا لم يتم استغلاله في الوقت المناسب، ما يُحوّله من مكسب اقتصادي محتمل إلى عبء مادي ومصدر لخسارة محققة.
ويُذكّر سلامي بحالات كثيرة لمصانع وعقارات تم حجزها منذ سنوات، دون أن تُستغل أو تُؤجر أو تُستثمر، ما أدى إلى تدهور بنيتها التحتية أو تعرضها للإهمال، وحتى التخريب أحيانًا. ويضيف أن الآلات والتجهيزات الصناعية هي الأكثر عرضة للتآكل، كونها تخضع لمعدلات استهلاك مرتفعة، وكل تأخير في استعمالها يعني خسارة جزء من طاقتها الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، يُوضح أن السيارات، ومعدات النقل، والعتاد التقني المُصادَر، إذا تُرك لفترة طويلة دون تشغيل أو صيانة، فإن قيمته السوقية تتآكل، وقد يصل في بعض الحالات إلى نقطة يصبح فيها غير قابل للاستعمال أو حتى للبيع. لذلك يدعو إلى تقييم سريع لكل هذه الأصول، وتحديد وجهتها دون تأجيل.
ويرى أن الحلول متعددة: إما إدماجها مباشرة في مؤسسات عمومية أو مشاريع ناشئة، أو بيعها في المزاد العلني وفق ضوابط شفافة، أو تأجيرها للقطاع الخاص مع ضمان حقوق الدولة. والمهم، حسب رأيه، هو أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لتفادي الخسارة التي تُسجّل بصمت كل يوم تتأخر فيه القرارات.
ويُحذر من البيروقراطية التي تُعيق اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذه الأملاك، ويؤكد أن ترك الأصول المصادرة على حالها دون حركية يُفقدها جوهرها الاقتصادي، ويُحوّلها من أداة استرجاع سيادي إلى ملف إداري ثقيل، وهو ما يتنافى مع روح الإصلاح التي تنشدها الدولة.
دعوة إلى قرارات جريئة من أعلى هرم الدولة
واستنادًا إلى ما سبق، يُؤكد الخبير أبو بكر سلامي أن إحدى أكبر الإشكالات التي تُعيق توظيف الأموال والممتلكات المسترجعة هي البطء في اتخاذ القرار، سواء بسبب الإجراءات القضائية المطولة، أو نتيجة تداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية. ويعتبر أن هذه الوضعية تُفقد الدولة فرصًا ثمينة، وتُحوّل الأصول المسترجعة إلى ممتلكات راكدة تفقد قيمتها بمرور الوقت.
وينبّه سلامي إلى أن الانتظار المفرط لصدور الأحكام القضائية النهائية أو لاستكمال الإجراءات الإدارية قد يكون مبررًا من الناحية القانونية، لكنه غير مبرر من الناحية الاقتصادية. فالكثير من الممتلكات المحجوزة يمكن استغلالها مؤقتًا في انتظار البت النهائي فيها، بطريقة تحفظ حقوق الدولة وتمنع ضياع المورد.
وفي هذا السياق، يدعو الخبير إلى تدخل واضح من أعلى مستوى في الدولة لتحديد الآليات الاستعجالية التي تتيح استغلال الأصول المصادرة فورًا، وفق شروط شفافة وضامنة للحقوق، دون تعطيلها لسنوات. ويقترح اعتماد إجراءات خاصة للممتلكات القابلة للتلف أو التآكل، حتى لا تتحول من مكسب إلى خسارة بفعل التأجيل والتردد.
ويُضيف أن استمرار هذه الوضعية يُبقي مسار استرجاع الأموال رهينة للرؤية القضائية البحتة، دون أن يتحول إلى مسار اقتصادي متكامل. لذلك، فإن تفعيل قرارات جريئة وسريعة من السلطة التنفيذية يمكن أن يُحقق التوازن المطلوب بين احترام المسار القانوني، وبين حماية المصلحة الاقتصادية العامة.
ويختم سلامي تصريحه بالتأكيد على أن الاستغلال العقلاني والسريع للممتلكات المسترجعة هو خيار اقتصادي رشيد، وواجب وطني، واستحقاق سيادي، ينبغي أن يُدار بمنطق المصلحة العليا، وبروح الإصلاح الذي يطمح إليه الجزائريون من أجل بناء اقتصاد منتج ومستقل.

نبيل جمعة - خبير اقتصادي
هامش مالي استثنائي.. الأموال المسترجعة تحت الاختبار
يعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في تصريح لـ "الأيام نيوز"، أن استرجاع الجزائر لأكثر من 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة حتى نهاية سنة 2023 يمثل مكسبًا سياديًا استثنائيًا في ظرف مالي دولي بالغ التعقيد، لكنه في الوقت نفسه مورد غير متجدد لا يمكن اعتباره بديلًا دائمًا أو مستدامًا لدعم الموازنة العمومية. ويرى جمعة أن هذه الموارد تفتح نافذة مالية فورية لتعزيز احتياطات الصرف وتقليص الحاجة إلى التمويل الخارجي، لكنها تتطلب رؤية استراتيجية صارمة في التوظيف، تضمن تحويلها إلى أداة لتحفيز النمو، لا مجرد وسيلة ظرفية لتغطية العجز. ويشدد على ضرورة استثمار هذه الأموال في مشاريع إنتاجية طويلة الأمد، وعدم تبديدها في نفقات آنية، مؤكدًا أن نجاح هذا المسار مرهون بالحوكمة المالية، والشفافية، والتوجيه الفعّال نحو الأولويات الوطنية.
ثروة مسترجعة.. لكنها غير متجددة: بين دعم السيادة وتحديات الاستدامة
ويؤكد جمعة أن الأموال المنهوبة المسترجعة، رغم حجمها الكبير، لا يمكن اعتبارها موردًا دائمًا أو بديلًا هيكليًا للتمويل العمومي، لكونها لا ترتبط بنشاط اقتصادي متجدد ولا تُدرّ مداخيل منتظمة كالضرائب أو الصادرات. ولذلك، فإن التعامل معها يجب أن يتم على أساس كونها فرصة استثنائية، لا مصدرًا ثابتًا لدعم الميزانية.
ويرى أن هذه الأموال تمثل أداة ظرفية لتعزيز السيادة الاقتصادية، وتمنح الدولة هامشًا إضافيًا للمناورة في ظرف دولي صعب يتسم بتقلب أسعار الطاقة وتشديد السياسات النقدية وارتفاع كلفة الاقتراض. غير أن اعتبارها حلًا دائمًا سيؤدي إلى اختلالات مستقبلية في حال نضوبها دون بدائل واضحة.
وفي هذا السياق، يُحذّر من الوقوع في فخ الإنفاق العشوائي لهذه الموارد أو استخدامها فقط لسد العجز في الميزانية، لأن هذا النهج يُبقي الاقتصاد رهينة لظروف استثنائية، ويحوّل الأموال المسترجعة إلى مجرد تعويض مؤقت لموارد مفقودة بدل أن تكون محركًا للنمو.
ويعتبر أن تحويل هذه الأموال إلى رافعة اقتصادية يتطلب الاعتراف بأنها مورد غير متجدد، وبالتالي ضرورة تبني سياسة مالية مدروسة تضمن توجيهها إلى استثمارات منتجة تُولّد قيمة مضافة على المدى المتوسط والبعيد. ويؤكد أن هذه النقطة تمثل الفارق الجوهري بين دولة تُنفق ودولة تُخطط.
ويضيف أن استرجاع الأموال المنهوبة مكسب كبير للدولة، لكنه لن يُحدث أثرًا حقيقيًا ما لم يُدمَج ضمن رؤية مالية واضحة تعتبر هذه الموارد أداة داعمة للسيادة، لا مصدرًا رئيسيًا للتمويل، وتستثمرها بعقلانية لضمان تحوّلها إلى إنتاج وثروة، لا إلى تآكل تدريجي بفعل نفقات ظرفية.
وانطلاقًا من كون الأموال المسترجعة موردًا ظرفيًا غير منتظم، يرى جمعة أن أهميتها الحقيقية تكمن في دورها في تعزيز الاستقرار المالي دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. فهذه الموارد، رغم محدوديتها الزمنية، تمنح الجزائر هامشًا أوسع للتحرك في سياستها الاقتصادية، وتجنّبها الارتهان للأسواق المالية العالمية.
ويؤكد أن استرجاع هذا الحجم من الأموال في ظرف دولي صعب يتسم بتشديد شروط الإقراض وارتفاع كلفته، هو في حد ذاته مكسب سيادي يُمكّن من تعزيز احتياطات الصرف وتحسين وضع ميزان المدفوعات. وهي مؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني.
ويضيف أن هذه الأموال يمكن أن تُستخدم كذلك في تقوية أدوات التمويل الداخلي للخزينة، مما يقلّل من الاعتماد على التمويلات الطارئة أو التدابير النقدية الاستثنائية، التي قد تُخلّ بالتوازنات الاقتصادية الكبرى كالتضخم أو استقرار قيمة الدينار.
ويربط جمعة بين استغلال هذه الموارد وبين تحسين التصنيف الائتماني للجزائر، إذ إن الدول التي تملك هامشًا ماليًا مستقلًا تُواجه الأزمات من موقع تفاوضي أقوى، وتجذب الاستثمارات دون الحاجة لتقديم تنازلات تمس سيادتها الاقتصادية.
ويُشدّد على أن هذه الأموال، رغم ظرفيتها، تمنح الجزائر فرصة حقيقية لتثبيت موقعها المالي خلال مرحلة انتقالية دقيقة، وتمكّنها من تجاوز فترة حرجة دون السقوط في دوامة القروض وشروطها، إذا ما أُحسن توظيفها ضمن سياسة مالية متوازنة تجمع بين التحكم في النفقات والتحفيز الاستثماري.
من الاستقرار إلى النمو.. أولوية الاستثمار الإنتاجي فوق كل اعتبار
وإذا كانت هذه الأموال قد منحت الجزائر استقرارًا ماليًا مؤقتًا، فإن التحدي الأكبر – كما يُشير جمعة – يتمثل في تحويل هذا الاستقرار إلى نمو اقتصادي فعلي ومستدام. ويرى أن الطريق الأنجع لذلك هو توجيه الموارد المسترجعة نحو استثمارات حقيقية في قطاعات إنتاجية واعدة قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل.
ويُشدّد على أن الإنفاق في هذا الإطار يجب ألا يُوجه إلى نفقات استهلاكية أو برامج مؤقتة، بل إلى قطاعات استراتيجية مثل الصناعة التحويلية، الزراعة الذكية، الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية. فهذه المجالات قادرة على توليد مداخيل دائمة وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما يُخفف الضغط على الموازنة ويدعم الاستقلالية الاقتصادية.
كما يلفت إلى أن الاستثمار في هذه القطاعات يُخلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من التمويل وتنتهي بتحسين الناتج الداخلي الخام، ما يجعل من الأموال المسترجعة نقطة انطلاق لتحريك عجلة الاقتصاد، بدل أن تبقى موردًا عابرًا لسد ثغرات ظرفية.
ويرى أن هذا التوجيه يجب أن يكون قائمًا على دراسات جدوى دقيقة تحدد الأولويات حسب المردودية الاقتصادية والتفاوت التنموي بين المناطق، لأن الهدف ليس صرف الأموال في مشاريع استعراضية، بل في بناء قاعدة إنتاجية حقيقية قادرة على الصمود والتوسع.
ويؤكد أن نجاح هذا المسار سيُعزز قدرة الدولة على تقليص حاجتها المستقبلية للاستدانة، من خلال خلق مصادر تمويل ذاتية مستدامة. فكل مشروع يُموّل من هذه الموارد ويحقق عائدًا ملموسًا يُعد استثمارًا سياديًا يعمّق خيار الاعتماد على الإمكانيات الداخلية بدل الارتهان للخارج.
صندوق سيادي جديد... من الإنقاذ المالي إلى التمكين الاقتصادي
وانطلاقًا من ضرورة توجيه الأموال المسترجعة نحو قطاعات إنتاجية، يرى جمعة أن تحويل هذه الموارد إلى قوة اقتصادية دائمة يتطلب إطارًا مؤسساتيًا قادرًا على استيعابها وتوظيفها بفعالية. وفي هذا الصدد، يقترح إنشاء صندوق سيادي استثماري خاص، على غرار الصناديق السيادية في الدول المصدّرة للموارد.
ويُوضح أن هذا الصندوق سيسمح بتجميع الأموال المسترجعة وتدويرها ضمن مشاريع مدروسة بعناية، مع ضمان الشفافية والرقابة، بعيدًا عن منطق الصرف العشوائي أو التوجيه السياسي غير المنتج. ويُعتبر أن هذه الآلية كفيلة بتحويل المال المسترجع من أداة ظرفية إلى ركيزة استراتيجية.
ويضيف أن إدارة هذا الصندوق يجب أن تكون مستقلة، وتشرف عليها كفاءات اقتصادية واستثمارية، مع ربطه بالأولويات الوطنية في مجالات الابتكار، والصناعة، والمؤسسات الناشئة، ومشاريع البنية التحتية ذات المردودية الطويلة الأمد.
ويُذكّر بأن تجربة الجزائر السابقة مع الصناديق السيادية يجب أن تكون منطلقًا لتحديث نماذج الحوكمة والمراقبة، بما يضمن النجاعة الاقتصادية وتفادي تكرار الأخطاء الماضية.
ويُؤكد أن إنشاء صندوق سيادي لاستثمار الأموال المسترجعة يُمثل خطوة استراتيجية تجمع بين الحكمة في التسيير، والواقعية في التوظيف، والطموح في بناء اقتصاد وطني قائم على الإمكانيات الذاتية، بعيدًا عن هشاشة الأسواق الخارجية وتقلبات الإيرادات.
الرقابة والشفافية.. مفاتيح تحويل الأموال المسترجعة إلى رافعة اقتصادية
وإذا كان إنشاء صندوق سيادي خطوة محورية في استثمار الأموال المسترجعة، فإن نجاح هذا المسار – كما يوضح جمعة – يظل مشروطًا بوجود منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة المؤسساتية. فالتحدي لا يكمن في حجم الموارد بقدر ما يكمن في كيفية تسييرها ودرجة الشفافية في إدارتها.
ويُشدّد على ضرورة اعتماد آليات رقابة فعالة تُتيح تتبع كل دينار يتم صرفه من هذه الأموال، سواء عبر هيئات رقابية مستقلة، أو تقارير دورية شفافة تتيح للمواطنين والجهات الرسمية الاطلاع على مآلات هذه الموارد. فكل غموض أو تداخل في الصلاحيات قد يُفرغ هذه الموارد من مضمونها ويُعيد إنتاج مسببات نهبها في السابق.
ويرى أن تطبيق قواعد صارمة في الشفافية والمساءلة يُعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويُكرس ثقافة جديدة في إدارة المال العام، تنظر إلى الاسترجاع لا كنهاية لمسار قضائي، بل كبداية لمسار اقتصادي وتنموي شامل.
كما يُلفت إلى أن الحوكمة لا تقتصر على البُعد المالي، بل تشمل أيضًا اختيار المشاريع، وتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وضمان التوزيع العادل بين المناطق، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الكبرى، وعلى رأسها تقليص التبعية وتعزيز الإنتاج المحلي.
ويختم جمعة تصريحه بالتأكيد على أن الجزائر، برفضها الاستدانة الخارجية، تملك فرصة تاريخية لبناء نموذج اقتصادي سيادي. غير أن تحويل الأموال المسترجعة إلى رافعة حقيقية لهذا النموذج يقتضي وضوحًا في الرؤية، صرامة في التسيير، ومؤسسات رقابية فعالة تضمن حماية المال العام وتحقيق أقصى درجات النجاعة الاقتصادية.

الدكتور علي جلابة - أستاذ المحاسبة والمالية بجامعة الطارف
بين الفرصة والاختبار.. ماذا بعد استرجاع 30 مليار دولار؟
يرى الدكتور علي جلابة، أستاذ المحاسبة والمالية بجامعة الطارف، في تصريح لـ "الأيام نيوز"، أن استرجاع الجزائر لأكثر من 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز السيادة المالية وتقليص الحاجة إلى التمويل الخارجي، لكنه يؤكد في المقابل أن نجاح هذا المسار يتوقف على توفر إرادة سياسية قوية، وإطار قانوني فعّال، وآليات مؤسساتية تضمن الشفافية والحَوكمة الرشيدة. ويوضح أن الأموال المسترجعة ينبغي أن تُحوّل إلى أداة دائمة لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال استثمارها في قطاعات حيوية، وإنشاء صندوق خاص لتسييرها، مع إشراك المجتمع في الرقابة والتوجيه، لضمان تحقيق أثر تنموي مستدام يُعزز ثقة المواطن ويُكرّس استقلالية القرار المالي للدولة.
ويؤكد الدكتور علي جلابة أن هذه العملية تندرج ضمن مسار أشمل يهدف إلى تعزيز السيادة المالية للدولة الجزائرية، معتبراً أن استعادة ما تم نهبه خلال فترات الفساد هو بمثابة استرجاع لجزء من القرار الاقتصادي الوطني، ويُعبّر عن توجه واضح نحو التحرر من التبعية لآليات التمويل الخارجي التي غالباً ما تكون مشروطة ومقيّدة.
ويشدد الدكتور جلابة على أن رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يُعزز من أهمية الأموال المسترجعة، باعتبارها مورداً داخلياً سيادياً يمكن توظيفه في دعم النمو وتمويل الأولويات الوطنية، دون المساس باستقلالية القرار المالي. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحصين هذا المسار بمنظومة قانونية قادرة على ملاحقة الثروات المنهوبة واسترجاعها بكفاءة.
ويشير إلى أن عملية الاسترجاع يجب أن تتجاوز بُعدها المالي لتتحول إلى رسالة واضحة في محاربة الإفلات من العقاب، وترسيخ ثقافة المسؤولية والرقابة على المال العام، مما يُسهم في تحسين مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع، ويُعيد الاعتبار لمؤسسات الرقابة الوطنية.
كما يُشدد على أن النجاح في هذا الملف لا يرتبط فقط بحجم الأموال المسترجعة، وإنما بمدى توظيفها ضمن رؤية اقتصادية شاملة تراعي العدالة التنموية والاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، ما يُحوّل هذه الموارد من ملف مرتبط بالماضي إلى رافعة لمستقبل اقتصادي متوازن.
ويخلص الدكتور جلابة إلى أن استرجاع الأموال المنهوبة هو في جوهره خطوة سيادية، لا يجب التعامل معها كتحصيل قضائي فقط، بل كأداة استراتيجية تدعم القرار الوطني، وتفتح آفاقاً أوسع لبناء اقتصاد قائم على الإمكانيات الذاتية، والاستثمار الرشيد في مقدرات الشعب.
التعاون الدولي... مفتاح لاسترداد ما نُهب خارجياً
وإذا كان استرجاع الأموال المنهوبة خطوة تعزز السيادة المالية، فإن هذا المسار – كما يؤكد الدكتور علي جلابة – لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الشراكة والتعاون الدولي. ويشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال تم تهريبه إلى الخارج بطرق معقّدة، مما يجعل من التعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة شرطاً أساسياً لتتبعها واستعادتها.
يوضح الدكتور جلابة أن بناء شراكات قانونية ومؤسساتية مع الهيئات الدولية المتخصصة، مثل شبكات مكافحة الفساد ومنصات تتبّع الأموال المهربة، من شأنه أن يُسهّل الإجراءات ويُسرّع استجابة الدول المعنية بطلبات الإنابة القضائية، خصوصاً في ظل التحديات التي تفرضها السيادة القضائية والسرية المصرفية في بعض البلدان
ويرى أن الانخراط الفعلي في مبادرات التعاون المالي الدولي يعكس التزام الجزائر بالمعايير العالمية في الشفافية والحَوكمة، ويمنحها رصيداً إضافياً في مفاوضاتها بشأن استرجاع الثروات المنهوبة، كما يُظهر قدرتها على معالجة الملفات المعقدة ضمن إطار قانوني منظم يُعزز صورتها في المحافل الاقتصادية.
كما يُشدد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة، كوزارة العدل ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية للخبراء، لتنسيق التحركات والمرافعة الدولية، وتجاوز العراقيل الناتجة عن ضعف المتابعة أو تشتت المسؤوليات
ويخلص الدكتور جلابة إلى أن التعاون الدولي يشكل عنصراً محورياً في إعادة الأموال إلى البلاد، وفي ترسيخ قناعة دولية بأن الجزائر تتعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، وهو ما يُكرّس مبدأ السيادة المالية في بُعده الخارجي، ويمنح الدولة قدرة أكبر على استعادة ثرواتها بأدوات قانونية ناجعة.
من الاسترجاع إلى التنمية.. أين تُوظف هذه الأموال؟
وبعد نجاح التعاون الدولي في تتبّع واستعادة الأموال المنهوبة، يرى الدكتور علي جلابة أن التحدي الأكبر يبدأ فعلياً داخل البلاد، ويتعلق بكيفية توظيف هذه الموارد في خدمة التنمية الوطنية. ويعتبر أن استرجاع الأموال لا يكتمل أثره إلا إذا تم دمجها في مشاريع استراتيجية تمسّ حياة المواطن وتُحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ويُشدد الدكتور جلابة على ضرورة توجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية، التعليم، الصحة، والفلاحة، باعتبارها مجالات تمسّ بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي وتدعم ركائز النمو طويل الأمد. ويضيف أن الاستثمار في هذه المجالات يعكس إرادة الدولة في تحويل موارد الماضي إلى فرص مستقبلية.
كما يُحذّر من توجيه هذه الأموال نحو تغطية نفقات ظرفية أو استهلاكية قد تُبدد أثرها بسرعة، مشيراً إلى أن كل دينار مسترجع يجب أن يُعامل كمورد نادر يُوجَّه بحكمة نحو مشاريع إنتاجية تُولّد مناصب شغل، وتُخفف الضغط عن الميزانية العامة، وتُعزز الدورة الاقتصادية الوطنية.
ويُشدد على أن العدالة في توزيع المشاريع الممولة بهذه الأموال أمرٌ أساسي، داعياً إلى اعتماد معايير التنمية المحلية عند توجيهها، بما يُقلّص الفوارق الجهوية، ويمنح المواطن شعوراً ملموساً بأن أمواله المنهوبة قد اُسترجعت ووُظفت لصالحه ولصالح الأجيال القادمة.
ويؤكد الدكتور جلابة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب مقاربة اقتصادية متكاملة، تضع استغلال الأموال المسترجعة ضمن رؤية وطنية شاملة للتنمية، تُزاوج بين الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتُؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المال العام محمياً وموجهاً لخدمة المصلحة العامة، لا كما كان سابقاً أداة للفساد والمحسوبية.
صندوق خاص وشفاف لتسيير الموارد المسترجعة
وفي سياق ضمان توظيف عقلاني وفعّال للأموال المنهوبة المسترجعة، يرى الدكتور علي جلابة أن إنشاء صندوق مالي خاص لتسيير هذه الموارد يُعد خطوة ضرورية لترجمة الطموحات التنموية إلى واقع عملي. ويعتبر أن هذا الصندوق ينبغي أن يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ويخضع لرقابة دقيقة تضمن الشفافية والمحاسبة.
ويُشدد الدكتور جلابة على أن وجود صندوق خاص سيمكن من فصل هذه الأموال عن الميزانية العامة، ما يُقلل من خطر توجيهها نحو نفقات استهلاكية أو ظرفية، ويُعزز من فرص توظيفها في مشاريع استراتيجية ذات أولوية، وفق خطط واضحة ومدروسة. كما يسمح ذلك بمتابعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الموارد في المدى المتوسط والبعيد.
ويرى أن هذا الصندوق يجب أن يُدار وفق منطق الاستثمار التنموي، وأن يتم تسييره من قبل خبراء وكفاءات متخصصة في المالية العامة والتنمية الاقتصادية، بعيداً عن الضغوط الإدارية أو الاعتبارات السياسية. ويُشدد على ضرورة أن تكون أهدافه محددة: دعم النمو، خلق مناصب شغل، تحسين البنية التحتية، وتحقيق العدالة التنموية بين الجهات.
كما يؤكد أن اعتماد تقارير دورية حول نشاط الصندوق ومردوديته، ونشرها للرأي العام، من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين، ويحوّل ملف الأموال المسترجعة من مجرد مسار إداري إلى تجربة وطنية شفافة في استرجاع الحقوق وحسن توجيهها، وهو ما ينعكس إيجاباً على العلاقة بين الدولة والمجتمع.
ويختم الدكتور جلابة بالتأكيد على أن الصندوق هو أداة لإعادة الاعتبار للمال العام، ووسيلة لتحويل الألم الناتج عن الفساد السابق إلى فرصة اقتصادية جديدة. ولتحقيق ذلك، يجب أن يُبنى الصندوق على قواعد صلبة من الحَوكمة، تُحوّل الثروة المسترجعة إلى رافعة مستدامة للنمو الوطني.
تعبئة المجتمع... ركيزة لإنجاح المسار
وانطلاقاً من أهمية إنشاء صندوق خاص لتسيير الأموال المسترجعة، يلفت الدكتور علي جلابة إلى أن فاعلية هذا المسار تتطلب تعبئة مجتمعية واعية ومشاركة حقيقية من المواطنين. ويؤكد أن إشراك المجتمع في النقاش حول توجيه هذه الموارد يُعزز الشفافية، ويحوّل هذه العملية إلى مشروع وطني جامع.
ويرى الدكتور جلابة أن استرجاع الأموال المنهوبة يكتسب بُعداً رمزياً كبيراً لدى الرأي العام، ولذلك فإن بناء الثقة بين الدولة والمجتمع حول هذا الملف لا يتحقق إلا إذا شعر المواطن أن صوته مسموع، وأن الأموال التي نُهبت منه تُوظف اليوم لصالحه. ويقترح في هذا الإطار تنظيم فضاءات حوار عمومي وإعلامي لعرض الخطط وتقييم الأداء.
كما يُشدد على أن الحَوكمة الرشيدة لا تنفصل عن إشراك المجتمع، بل تُبنى عليها، من خلال ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة، وتفعيل آليات الرقابة المستقلة، سواء عبر مؤسسات الدولة أو عبر المجتمع المدني. فكل انغلاق أو غموض في هذا الملف قد يُعيد إنتاج نفس الأسباب التي أدت إلى النهب سابقاً.
ويرى أن نجاح الدولة في ربط استرجاع الأموال بحوار مجتمعي شفاف سيمنح العملية بُعداً أخلاقياً وإنسانياً، يُعيد الاعتبار لفكرة المواطنة الاقتصادية، ويُحوّل المال العام من مفهوم إداري إلى شعور جماعي بالملكية والمسؤولية المشتركة في حمايته واستغلاله.
ويختم الدكتور جلابة بالتأكيد على أن استرجاع الأموال المنهوبة يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو عقد اجتماعي جديد، يُكرّس السيادة المالية، ويُعزز استقلالية القرار الاقتصادي، ويُعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الشفافية، المشاركة، والعدل في توزيع الموارد.
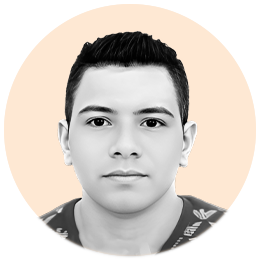
كريم معروف – أستاذ جامعي
من الفساد إلى القضاء..3 مسارات نحو الثروة المنهوبة
يؤكد الأستاذ الجامعي كريم معروف، في تصريح لـ "الأيام نيوز"، أن استرداد الأموال المنهوبة لا يمكن اختزاله في إجراءات قانونية وتقنية فقط، بل هو مسار استراتيجي متعدد الأبعاد، يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية، وتفعيل الأطر القانونية والدبلوماسية المتاحة، وصولاً إلى استثمار هذه الموارد في مشاريع تنموية تُغني الجزائر عن اللجوء إلى التمويل الخارجي. ويعتبر أن الأموال المهربة إلى الخارج تعادل في حجمها ميزانيات دول، وأن استرجاعها يُعد فرصة حقيقية لإطلاق نهضة اقتصادية، إذا ما وُجّهت بذكاء نحو القطاعات الحيوية، في إطار رؤية وطنية شاملة تُعيد الثقة للمواطن، وتُحصّن البلاد من عودة ممارسات الفساد.
ويرى الأستاذ معروف أن عمليات تهريب الأموال والممتلكات خلال فترات الفساد التي شهدتها الجزائر بلغت مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى أرقام تُوازي ميزانيات دول كاملة، وهو ما أدى إلى حرمان البلاد من فرص تنموية كبرى، وأخّر تحقيق أهداف اقتصادية ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الداخلي. ويُصنّف ما حدث بأنه جريمة ممنهجة ضد التنمية الوطنية.
ويؤكد أن هذا النزيف المالي ترك أثرًا مباشرًا على تعثر المشاريع الاقتصادية الكبرى، وفشل السياسات العمومية في ضمان الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية. فالمال العام، بدل أن يكون أداة لبناء اقتصاد وطني متوازن، تحوّل إلى رافعة لنفوذ شبكات الفساد.
ويُضيف أن أحد أخطر تداعيات تهريب الأموال يكمن في ضرب علاقة الثقة بين الدولة والمواطن، حيث يشعر هذا الأخير بأن مقدراته تُنهب دون محاسبة جدية، وهو ما يفتح الباب أمام موجات غضب اجتماعي يصعب احتواؤها ما لم تُترجم الدولة وعودها بمحاربة الفساد إلى أفعال ملموسة.
كما يُشير إلى أن الشعارات لم تعد كافية، وأن المطلوب هو تجسيد فعلي للإرادة السياسية في محاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة، ليس فقط من منطلق استرداد الحقوق، بل من أجل تصحيح المسار الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام التنمية المستدامة.
ويخلص الأستاذ كريم معروف إلى أن الحديث عن اقتصاد وطني مستقل ومستقر لا يكتمل دون تفكيك منظومة الفساد السابقة، واسترجاع كل درهم تم تهريبه خارج الحدود، لأن هذه الأموال هي في جوهرها مشاريع معلّقة، وفرص عمل مهدورة، وخدمات كان من المفترض أن تكون في متناول كل جزائري.
الدبلوماسية في خدمة العدالة.. استرجاع الأموال بين التعاون والتعطيل
بعد التأكيد على حجم الخسائر التي تسبّب فيها تهريب الأموال المنهوبة، ينتقل الأستاذ كريم معروف إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه مسار الاسترداد، وهو طبيعة العلاقات التي تربط الجزائر بالدول التي هُرّبت إليها تلك الثروات. إذ يرى أن فرص استرجاع الأموال لا ترتبط فقط بالقانون، بل تتأثر أيضًا وبشكل مباشر بسياق العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وتلك الدول.
ويُوضح أن التعامل مع دولة "صديقة" يختلف جذريًا عن التعامل مع دولة "متوترة العلاقات"، حيث تبدي الدول الصديقة – مثل جنوب إفريقيا أو تونس أو حتى روسيا – تجاوبًا أسرع وتسهيلات أكبر فيما يخص طلبات الإنابة القضائية واسترداد الممتلكات، بينما تكون الإجراءات أكثر تعقيدًا، أو حتى شبه مستحيلة، في دول كفرنسا أو المغرب أو الإمارات.
ويُضيف أن هذه التباينات تُحتّم على الجزائر التحلي بمرونة سياسية ويقظة دبلوماسية عالية، عبر التفاوض الذكي والانخراط المتوازن في المنصات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ التام على السيادة واستقلال القرار الوطني. فاسترجاع الأموال في هذا السياق يتحوّل إلى اختبار دبلوماسي لا يقل تعقيدًا عن كونه مسارًا قانونيًا صرفًا.
ويُحذر معروف من أن تجاهل البُعد السياسي في التعامل مع هذه الملفات قد يُفضي إلى تعطيل المسار القضائي، إذ قد تلجأ بعض الدول إلى المماطلة أو التهرّب من التعاون، تحت ذرائع قانونية أو بدوافع سياسية غير معلنة، مما يستدعي ربط المسار القانوني بتحركات دبلوماسية متزامنة ومدروسة بدقة.
ويؤكد في السياق ذاته أن بناء شبكات تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف في مجال استرداد الأموال يجب أن يُصبح ركيزة من ركائز الدبلوماسية الجزائرية الحديثة، لأن حماية المال العام واسترجاعه يُعدان من صميم الدفاع عن السيادة الوطنية، وهو واجب لا يحتمل التراخي، ويتطلب من الدولة التحرك عبر جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لتحقيق هذا الهدف المصيري.
قوانين على المحك: ثلاث طرق لاسترجاع المال المنهوب
وانطلاقًا من تعقيدات التعاون الدولي في ملفات استرجاع الأموال، يوضح الأستاذ كريم معروف أن الجزائر تبنّت مجموعة من المسارات القانونية المتدرجة لاستعادة الأموال المنهوبة، وذلك بناءً على نوع الاتفاقيات المبرمة، وطبيعة الدولة التي توجد فيها هذه الأموال، إلى جانب الشروط الخاصة بآليات الاسترداد في المواثيق الدولية. ويؤكد أن هذا التنوع يمنح الجزائر مرونة قانونية معتبرة، لكنه في الوقت ذاته يتطلب جاهزية مؤسساتية ومهارية عالية.
ويُبيّن أن الانطلاقة تكون دائمًا من الاتفاقيات الثنائية، وفي حال غيابها يتم اللجوء إلى الاتفاقيات الإقليمية كالعربية أو الإفريقية، وإذا تعذر الأمر يُعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. وبناءً على هذا التدرج، تمر الجزائر عبر سلسلة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تنظّم عملية المطالبة، بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بلغة التواصل المعتمدة، وانتهاءً بالجهة القضائية أو الدبلوماسية المختصة باستلامه.
ويُفصّل الأستاذ معروف في هذا الإطار أبرز الآليات القانونية التي تعتمدها الجزائر، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مسارات رئيسية يتم اللجوء إليها بحسب طبيعة الملف والدولة المعنية. أولها هو المسار الجنائي، وهو الأكثر شيوعًا، ويعتمد على استصدار حكم قضائي نهائي بإدانة المتورط في قضايا الفساد، ليتم بعدها إصدار أوامر بمصادرة الأصول ذات الصلة بالجريمة. وتشمل هذه المصادرة الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها مباشرة من عمليات الفساد أو التي استُعملت في تنفيذها.
أما المسار الثاني، فهو المسار المدني، الذي يُلجأ إليه في الحالات التي يكون فيها المسار الجنائي غير ممكن أو متعذر. وفي هذا الإطار، تقوم الجزائر برفع دعاوى مدنية أمام محاكم الدول التي أُخفيت فيها الأموال، للمطالبة باسترجاعها عبر إثبات ملكيتها القانونية، أو الطعن في العقود القائمة على فساد، أو المطالبة بإبطال التصرفات المشبوهة التي تمت بها.
ويأتي المسار الثالث كخيار أكثر مرونة، وهو ما يُعرف بـ "المسار الاستثنائي"، حيث يُسمح بمصادرة الممتلكات دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بالإدانة ضد الشخص المعني. ويُطبّق هذا الأسلوب تحديدًا على الأموال أو الأصول، وليس الأشخاص، وغالبًا ما يُستخدم في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المتورط، أو عندما تكون الإجراءات الجنائية طويلة ومعقدة. ويُعتبر هذا الخيار أداة فعالة في الحالات التي تتطلب تدخلاً سريعًا لمنع ضياع الأموال أو نقلها من دولة إلى أخرى.
ويُشير الأستاذ معروف إلى أن هذه المسارات، رغم قانونيتها، تواجه تحديات عملية كبيرة تتعلق بسرعة الإجراءات، ومستوى تعاون الدولة الطرف، وصعوبة شروط الإثبات لدى بعض الأنظمة القضائية الأجنبية. وهو ما يستدعي دعمًا فنيًا للمؤسسات الجزائرية، وتأهيلًا مستمرًا للكفاءات المختصة بهذا النوع من الملفات.
ويُشدد في ختام هذا المحور على أن النجاح في استرجاع الأموال المنهوبة لا يتوقف عند كفاءة النصوص القانونية، بل في مدى حسن توظيفها، وتنسيق الجهود بين كل الجهات المتدخلة، والتفاعل الذكي مع السياق الدولي، بما يحفظ حقوق الجزائر ويُعجّل باستعادة ثرواتها المسلوبة.
أين تُصرف الثروات العائدة؟
بعد استعراض المسارات القانونية التي تعتمدها الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة، يشدد الأستاذ كريم معروف على أن عملية الاستعادة لا تكتمل من دون توجيه هذه الأموال نحو مشاريع واقعية تُسهم فعليًا في بناء اقتصاد منتج ومستقل. ويرى أن المال المُسترجع لا يجب أن يُعامل كغاية بحد ذاته، بل يجب النظر إليه كوسيلة استراتيجية لتحفيز التنمية وتعزيز السيادة المالية دون الحاجة إلى الاستدانة من الخارج.
ويُؤكد أن المشاريع الصناعية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، لا سيما الصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، وقطع الغيار، لما لها من دور كبير في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل. فاستثمار الأموال المُسترجعة في هذا القطاع قد يُحدث تحولًا نوعيًا في الاقتصاد الوطني، ويُساهم في تقليص فاتورة الاستيراد التي تُثقل كاهل الميزانية العامة.
ويُضيف أن المشاريع العقارية لا تقل أهمية، خاصة تلك المرتبطة ببناء السكنات، والمرافق العمومية، والمراكز الإدارية. فمثل هذه الاستثمارات تُخفف من حدة الضغط الاجتماعي، وتُحسن من ظروف معيشة المواطن، كما تُنشط قطاع الأشغال العمومية وتفتح مجالات واسعة للتوظيف المباشر وغير المباشر.
كما يُشير الأستاذ معروف إلى ضرورة تخصيص جزء من الأموال لدعم التجارة المنظمة، من خلال إنشاء مراكز تجارية حديثة، وتأهيل الأسواق الكبرى، وتوفير آليات تمويل للمشاريع الصغيرة، خصوصًا في قطاع الخدمات. فهذا التوجه يُعزز من ديناميكية الاقتصاد الوطني، ويُقلص من الفوضى التي تميز الأسواق غير الرسمية.
ولا يغفل الأستاذ معروف أهمية الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي، مقترحًا توجيه نسبة معتبرة من المال المسترجع لدعم مراكز البحث، وتمويل مشاريع الابتكار التكنولوجي، ورعاية رواد الأعمال الشباب. فاستثمار هذه الأموال في العقول والكفاءات يُعد رهانًا طويل المدى يضمن نموًا مستدامًا وتحولًا اقتصاديًا عميقًا ومنهجيًا.
مفترق الطرق في معركة استرجاع المال المنهوب
وإذا كانت المشاريع التنموية تُجسّد الوجه العملي لاستثمار الأموال المنهوبة بعد استرجاعها، فإن الأستاذ كريم معروف يربط نجاح هذا المسار بأمر جوهري وحاسم، يتمثل في توفر الإرادة السياسية الفعلية وتجسيدها على أرض الواقع. فكل خطوة نحو التتبع، أو الاسترجاع، أو التوظيف التنموي، تظل رهينة بمدى الجدية التي تُبديها الدولة في محاربة الفساد بعيدًا عن الانتقائية أو التأجيل.
ويؤكد أن الخطابات وحدها لم تعد تُقنع أحدًا، وأن الشعب الجزائري بات يعتبر أي تأخر أو تلكؤ في اتخاذ قرارات حاسمة بمثابة تغذية للإحباط، وفتح الباب أمام القوى التي عطلت الدولة سابقًا، سواء من داخل المؤسسات أو عبر شبكات المال الفاسد، للعودة إلى المشهد بطرق جديدة.
ويرى أن تجسيد الإرادة السياسية لا يعني فقط إصدار الأحكام أو توقيع الاتفاقيات، بل يبدأ أولًا من رفع الغطاء السياسي والإداري عن كل من تورط في نهب المال العام، وتفعيل آليات الرقابة الوقائية، وتحرير القضاء من أي وصاية أو تدخل، وتمكين مؤسسات الرقابة من الاستقلالية والصلاحيات الكاملة للقيام بدورها الدستوري.
ويختم الأستاذ كريم معروف بالتأكيد على أن استرجاع الأموال المنهوبة ليس مجرد عملية إدارية أو تقنية، بل هو في جوهره معركة سيادية لا تُكسب إلا بالإرادة الصلبة. وإذا توفرت هذه الإرادة، فإن الجزائر لن تسترجع فقط ما نُهب، بل ستستعيد أيضًا هيبة مؤسساتها، وثقة مواطنيها، وتُطلق مسارًا تنمويًا نظيفًا ومستقلًا، يغنيها عن الاستدانة والتبعية، ويجعل من الداخل منطلقًا حقيقيًا للتغيير.

البروفيسور مراد كواشي – خبير اقتصادي
من الاسترداد إلى الاستثمار.. عودة الأموال لا تعني نهاية المعركة
يرى البروفيسور مراد كواشي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "الأيام نيوز"، أن استرجاع الجزائر لأكثر من 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة حتى نهاية سنة 2023 يُعد مسارًا مؤسساتيًا يعزز مناخ الأعمال، ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاقتصادية الوطنية. ويؤكد أن هذه العملية، إذا ما ترافقت مع إرادة سياسية فعّالة وإصلاحات بنيوية شاملة، من شأنها أن تُكرّس دولة القانون وتُغني الجزائر عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مشددًا على أن استرداد المال العام هو في جوهره استعادة لثقة المواطن والمستثمر معًا.
وينطلق البروفيسور كواشي من التأكيد على أن الأموال المنهوبة التي تسعى الجزائر إلى استرجاعها لا تقتصر فقط على أرصدة مالية في الخارج، بل تشمل أيضًا ممتلكات مادية وأصولًا عينية داخل البلاد وخارجها، تتوزع بين فنادق، مصانع، عقارات، وأموال سائلة تم تهريبها أو تجميدها بطرق ملتوية خلال سنوات من الفساد المؤسسي الذي أثّر سلبًا على مسار التنمية الاقتصادية.
ويشير إلى أن هذه الأصول، التي استحوذ عليها بعض المسؤولين السابقين بطرق غير مشروعة، أصبحت اليوم محلّ إجراءات قانونية ودبلوماسية تهدف إلى استرجاعها وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني. ويعتبر أن ما تم استرجاعه حتى الآن، والمقدَّر بـ30 مليار دولار، لا يُمثل سوى جزء محدود من حجم الثروات المنهوبة، التي تختلف التقديرات حول قيمتها الحقيقية.
ويرى كواشي أن تنوّع طبيعة هذه الأموال يستوجب تنوّعًا في أدوات وآليات الاسترجاع، حيث أن الأصول العينية داخل الوطن يمكن استرجاعها بسرعة أكبر مقارنة بتلك المهربة إلى الخارج، والتي تواجه عراقيل قانونية وسياسية معقدة، ما يستدعي صبرًا ومتابعة مؤسساتية دقيقة ومستمرة.
كما يشدد على أن التقدير الحقيقي لهذه الثروات المنهوبة لا يمكن حصره في رقم واحد، نظرًا لتعقيد الجرائم الاقتصادية التي أدت إلى تهريب الأموال، وأيضًا لصعوبة الحصول على بيانات دقيقة في بعض الدول التي تحتضن هذه الأصول، سواء بدافع السرية المصرفية أو بسبب ضعف التعاون القضائي الدولي.
ويُنبّه إلى أن استرجاع هذه الثروات، سواء كانت عقارية أو مالية، هو من صميم حقوق الشعب، ويجب التعامل معها باعتبارها أداة سيادية، وليست مجرد ملف تقني، لأنها تشكل مدخلًا حيويًا لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.
استرداد الأموال... دعم مباشر للاقتصاد الوطني
وإذا كانت الأصول المنهوبة تتوزع بين الداخل والخارج، فإن البروفيسور مراد كواشي يرى أن استرجاعها يكتسي أهمية اقتصادية قصوى، باعتبارها أموالًا تعود في الأصل إلى الشعب الجزائري، ويجب إعادة دمجها ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية. ويؤكد أن هذه الموارد، إذا أُحسن توظيفها ضمن رؤية متكاملة، يمكن أن تُستخدم كأداة تمويل فعّالة تدعم المشاريع التنموية، وتقلّل من الضغط على ميزانية الدولة.
يشدد كواشي على أن استرجاع الأموال لا ينبغي أن يُنظر إليه كعملية رمزية أو انتقامية فقط، بل كرافعة سيادية حقيقية تُغني الجزائر – ولو جزئيًا – عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. فكل دولار يُسترجع من الخارج يُعتبر بديلاً مباشراً عن قرض محتمل قد يرتّب التزامات مالية مرهقة على الأجيال القادمة، وقد يؤثر على استقلالية القرار الاقتصادي الوطني.
ويضيف أن هذه الأموال المسترجعة يمكن أن تُوجَّه نحو تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والتعليم، والصحة، مما يخلق ديناميكية اقتصادية داخلية، ويوسّع دائرة الاستثمار العمومي، ويُقلّص من الاعتماد على الحلول الظرفية المؤقتة، مثل طبع النقود أو فرض ضرائب إضافية.
كما يؤكد أن تحويل بعض المؤسسات التي كانت مملوكة لفاسدين إلى وصاية الدولة هو خطوة ضرورية لإعادة تشغيلها ودمجها في النسيج الإنتاجي، ما يُعيد الحيوية للاقتصاد الوطني، ويوفّر مناصب شغل جديدة، ويحوّل المال المسترجع إلى أداة تنموية ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
ويشير كواشي إلى أن نجاح الدولة في استغلال هذه الأموال لا يتطلب فقط اتخاذ قرارات مالية مناسبة، وإنما يتطلب أيضًا تبنّي رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على أسس الحوكمة الرشيدة، وترشيد الإنفاق العام، والتوجيه الذكي للموارد نحو القطاعات ذات الأولوية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة.
المؤسسات المصادَرة.. من الفساد إلى التنمية
وفي سياق الحديث عن توظيف الأموال المسترجعة في دعم الاقتصاد الوطني، يرى البروفيسور مراد كواشي أن تحويل ملكية المؤسسات التي كانت تحت سيطرة الفاسدين إلى القطاع العمومي يُعد من أبرز النماذج على استثمار الموارد المصادرة بطريقة تخدم التنمية وتُحقق أثرًا ملموسًا. فهذه الوحدات، التي أُنشئت في الأصل بأموال مشبوهة، يمكن أن تتحوّل اليوم إلى أداة حقيقية لإنتاج الثروة وخدمة المواطن.
يوضح كواشي أن العديد من هذه المؤسسات قد تمت استعادتها فعليًا وإخضاعها لوصاية مؤسسات عمومية متخصصة، وهو مسار طبيعي وضروري، لأن هذه الأموال هي أموال عامة نُهبت من الشعب، ويجب أن تُعاد إليه عبر إدماجها في مشاريع اقتصادية مدروسة تُعيد له الفائدة المباشرة. ويضيف أن من الخطأ الكبير ترك هذه الممتلكات مجمّدة أو عرضة للتدهور دون إدخالها مجددًا في الدورة الإنتاجية.
ويؤكد أن هذه الوحدات تمثل فرصة حقيقية لتنشيط السوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن الجهوي في توزيع الاستثمارات، خصوصًا إذا تم توجيهها نحو المناطق التي تعاني من نقص في الهياكل الاقتصادية والفرص التنموية. ويشدد على أهمية إعادة تأهيل هذه المؤسسات وفق معايير الشفافية والكفاءة، بما يحولها من عبء قانوني إلى مكسب اقتصادي فعّال.
ويرى أن إعادة تشغيل هذه الوحدات يجب أن تستند إلى دراسات جدوى دقيقة، وتُدار بعقليات جديدة تعتمد على الكفاءة والخبرة بدلًا من الولاءات الشخصية، بما يُعزز الثقة مجددًا في قدرة الدولة على إدارة المال العام بفعالية، وإعادة تدويره في مسارات إنتاجية تخلق القيمة ولا تكرّس الريع.
ويؤكد في ختام هذه النقطة أن هذه الخطوة تُعد بمثابة انتقال رمزي وعملي من مرحلة الفساد إلى مرحلة البناء، ومن العبث الاقتصادي إلى منطق الحوكمة الرشيدة، وأن الدولة مطالبة بالحفاظ على هذا التوجه الإيجابي وتوسيعه ليشمل أكبر عدد ممكن من الأصول والمؤسسات المصادرة.
استرجاع الأموال.. عنوان لدولة القانون
وفي السياق ذاته، يربط البروفيسور مراد كواشي بين استرجاع المؤسسات والأصول المنهوبة وبين تكريس مفهوم دولة القانون والشفافية. فهو يرى أن نجاح الدولة في استرجاع أموال الشعب، سواء داخل الوطن أو خارجه، يعكس صورة جديدة لدولة قائمة على الحوكمة والمساءلة، لا على الإفلات من العقاب وتراكم النفوذ الفاسد.
يشير كواشي إلى أن هذه العملية لا تقتصر على الأثر المالي أو الاستثماري فقط، بل تُسهم بعمق في ترميم العلاقة المهتزّة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فعندما يلمس المواطن أن العدالة تُطبّق فعليًا، وأن المال المنهوب يُعاد إلى الخزينة العمومية ويُوظَّف في مشاريع ملموسة تعود بالنفع العام، فإن ذلك يُعيد ثقته تدريجيًا في جدية الدولة وفي المسار الإصلاحي بأكمله.
ويضيف أن دولة القانون لا تُبنى بالشعارات، بل عبر قوانين واضحة وتفعيل فعلي للسلطتين السياسية والقضائية، بما يُظهر التزامًا صادقًا بمحاربة الفساد واستعادة هيبة المؤسسات. وفي هذا الإطار، يُمثّل استرداد الأموال رسالة مزدوجة: رسالة للمواطن تؤكد أنه شريك في الثروة والقرار، ورسالة للمفسدين بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.
ويرى أن تفعيل هذا البُعد المؤسساتي يتطلب الاستمرار في مرافقة عمليات الاسترجاع بخطاب سياسي شفاف، وإجراءات إدارية مرنة، وآليات رقابة دقيقة تضمن عدم تكرار نفس الظروف التي سمحت سابقًا بتهريب الأموال ونهب الثروات الوطنية.
ويؤكد أن نجاح جهود الاسترجاع لا يُقاس فقط بحجم الأموال العائدة إلى خزينة الدولة، بل بما تُعبّر عنه من تحول جوهري في فلسفة الحُكم، ومن ترسيخ لقواعد الشفافية، وهيكلة جديدة ومتوازنة للعلاقة بين السلطة، والثروة، والمسؤولية.
مناخ استثماري أكثر جاذبية... بفضل مكافحة الفساد
وانطلاقًا من تكريس دولة القانون كأحد أهم مكاسب استرجاع الأموال المنهوبة، يرى البروفيسور مراد كواشي أن هذا التحول ينعكس بشكل مباشر وفعّال على ثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب. فمناخ الأعمال لا يُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية الصرفة، بل أيضًا بمدى التزام الدولة بمكافحة الفساد وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المال العام.
يؤكد كواشي أن نجاح الدولة في استرداد أموالها المنهوبة ومحاسبة المتورطين فيها، يبعث برسائل قوية إلى الداخل والخارج مفادها أن الجزائر تتجه بثبات نحو بناء بيئة أعمال أكثر أمنًا واستقرارًا. وهي رسائل يلتقطها المستثمرون بعناية، لأنها تدل على أن رؤوس الأموال لن تكون عرضة لابتزاز شبكات النفوذ أو الصفقات المشبوهة، وأن المنافسة الاقتصادية ستُبنى على أساس الكفاءة والجدارة، لا على العلاقات والمحاباة.
ويُضيف أن مكافحة الفساد تُعد أداة استراتيجية لتحسين صورة الجزائر على المستوى الدولي، لاسيما لدى وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية العالمية. فعندما يُدرك المستثمر أن الدولة تسترجع أموالها المنهوبة، وتُوظّفها في مشاريع حقيقية، وتُصدر تقارير شفافة بشأن مصيرها، فإن ذلك يُعزز ثقته ويشجّعه على ضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراته القائمة.
كما يشدد على أن جاذبية مناخ الاستثمار تتعزز أيضًا عندما يشعر المستثمر المحلي أن الدولة تحميه من المنافسة غير العادلة، وتوفر له بيئة اقتصادية متوازنة ونزيهة. فاسترجاع الأموال المنهوبة يضمن كذلك استرجاع جزء مهم من السوق الوطنية، التي كانت محتكرة في السابق من قبل مجموعات فاسدة، ما يُعيد التوازن إلى حركة المال والنشاط الاقتصادي.
ويختم البروفيسور مراد كواشي بالتأكيد على أن استرجاع الأموال المنهوبة لا يمثل مجرد معركة قانونية معقدة، بل هو رهان استراتيجي على مستقبل الاقتصاد الجزائري. إنه رهان يُرسّخ الثقة الداخلية والخارجية، ويفتح الباب أمام استثمارات نظيفة ومستدامة تُراكم النمو، من دون الحاجة إلى تمويل مشروط أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

الدكتور بن ياني مراد – أستاذ الاقتصاد
الخزائن المغلقة في الخارج.. الجزائر تبحث عن العدالة الاقتصادية
يرى الدكتور بن ياني مراد، أستاذ الاقتصاد، في تصريح لـ "الأيام نيوز"، أن استرجاع الأموال المنهوبة يُعد خيارًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد جزائري نظيف ومستدام، خاصة في ظل التوجه الرسمي الرافض للجوء إلى الاستدانة الخارجية. ويؤكد أن هذه الأموال، التي تعود ملكيتها إلى الشعب، ينبغي أن تُوظف في تمويل مشاريع التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، رغم التحديات الهيكلية التي تواجه الدولة، وفي مقدمتها غياب خريطة مالية دقيقة تحدد مواقع الثروات المهربة. ومع ذلك، يراهن بن ياني على تطور المنظومة القانونية وتوسيع أطر التعاون الدولي، معتبرًا أن المعركة طويلة لكنها قابلة للحسم، إذا ما استمرت الإرادة السياسية بنفس الزخم.
ويشدد الدكتور بن ياني مراد على أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة يمثل معركة حقيقية لإعادة بناء الثقة في اقتصاد نُهبت مقوماته خلال ما وصفه بـ"زمن العصابة". وهي مرحلة كانت، حسبه، حالة ممنهجة لتجريف المال العام وتشويه صورة الدولة داخليًا وخارجيًا، ما يجعل من استعادة تلك الأموال ضرورة ضمن مسار إصلاحي شامل.
ويعتبر أن استرجاع هذه الأصول، سواء المالية أو العينية، يحمل أهمية مزدوجة: فهو من جهة استرداد لحق مشروع للشعب الجزائري، ومن جهة ثانية إشارة رمزية قوية على جدية الدولة في مكافحة الفساد وتفكيك ما تبقى من شبكاته. فكل دينار يُسترجع يمثل إعلانًا عن قطيعة مع الممارسات السابقة، وخطوة نحو اقتصاد يقوم على الشفافية والنزاهة.
ويضيف أن هذه العملية تكتسي بعدًا اقتصاديًا ملحًا، لأن الأموال المنهوبة كانت مخصصة في الأصل لتمويل مشاريع تنموية وتغطية خدمات عمومية أساسية. وغيابها عن الدورة الاقتصادية ساهم في تعميق الأزمات الاجتماعية وتعطيل الإصلاحات. ومن هنا، فإن استرجاعها يشكل نقطة انطلاق لتصحيح المسار التنموي.
كما يوضح أن تحقيق العدالة الاقتصادية لا يمكن أن يتم دون استرجاع الأموال المنهوبة، إذ لا معنى لأي نموذج اقتصادي جديد في ظل استمرار الأموال العمومية خارج نطاق رقابة الدولة. ولهذا، يرى أن هذه المعركة تُعد قاعدة ضرورية لكل تحول اقتصادي فعلي.
ويؤكد بن ياني أن ملف الأموال المنهوبة هو قضية سيادية واستراتيجية بامتياز، تقتضي تعبئة كاملة للمؤسسات، وتضافرًا للجهود القانونية والدبلوماسية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمستقبل الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
بديل سيادي لدعم التنمية دون قروض
في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، يُبرز الدكتور بن ياني مراد أهمية استرجاع الأموال المنهوبة كخيار سيادي بديل عن اللجوء إلى القروض الخارجية، التي غالبًا ما تكون مشروطة وتحدّ من هامش القرار الوطني. ويؤكد أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الأموال المسترجعة، بل في آليات توظيفها بطريقة عقلانية ومنتجة، تُحقق الإنعاش الاقتصادي وتُرسّخ العدالة في توزيع الثروة.
ويُشدّد الخبير على ضرورة إدماج هذه الموارد المسترجعة ضمن استراتيجية تنموية واضحة المعالم، ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الفلاحة، الصناعة، والتكنولوجيا، بدل توجيهها نحو الإنفاق العشوائي أو الاستهلاك الآني. فالأموال المسترجعة تمثل فرصة نادرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق أولويات واقعية ومستدامة، بعيدًا عن منطق الاستدانة أو الخضوع لوصفات المؤسسات المالية الدولية.
ويرى الدكتور بن ياني أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الجديدة للدولة، القائمة على تعزيز السيادة الاقتصادية، وتقليص التبعية للريوع التقليدية أو التمويلات الخارجية. كما أن ضخ الأموال المسترجعة في مشاريع حقيقية وشفافة يُمكن أن يُحدث أثرًا اقتصاديًا مزدوجًا: من جهة تحريك عجلة الاستثمار الداخلي، ومن جهة أخرى رفع منسوب الثقة في قدرة الدولة على تمويل التنمية بإمكانياتها الذاتية.
ويؤكد في هذا السياق أن الأولوية يجب أن تُمنح للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق مناصب شغل دائمة، وتُساهم في تنويع الاقتصاد وتقليص الفجوة الاجتماعية بين المناطق. إذ لا جدوى من استرجاع أموال ضخمة إذا لم تُستخدم في إحداث تغيير ملموس على مستوى حياة المواطنين والعدالة الاجتماعية.
غياب الخريطة المالية الدقيقة.. التحدي الأبرز
ورغم أن استرجاع الأموال المنهوبة يُعد بديلا سياديا قويا لدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن الدكتور بن ياني مراد لا يغفل التحديات الكبيرة التي تعترض هذا المسار، وفي مقدمتها غياب خريطة مالية دقيقة توضح أماكن وجود الأصول المهربة وهويات الأطراف المتورطة فيها. هذا الغموض، بحسبه، يُعقّد من جهود المتابعة ويبطئ وتيرة الاسترجاع.
ويؤكد أن جزءا كبيرا من الثروات المنهوبة تم تهريبه خلال فترات اتسمت بانعدام الشفافية، وتمت تغطية الكثير من العمليات بأسماء مستعارة وشركات وهمية، ما صعّب من مهمة تتبع المسارات المالية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
كما يلفت إلى أن بعض الأصول لا تزال غير معروفة المكان أو المالك الفعلي، ما يجعل الجزائر في حاجة ماسة إلى دعم تقني وقضائي دولي للوصول إلى تلك الأموال، واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بها، حتى لا تظل معلقة أو تضيع بفعل مرور الزمن.
ويرى أن التحدي يكمن في التعامل مع دول تُصنف كملاجئ آمنة للأموال المهربة، وتتحجج أحيانا بسرية المصارف أو نقص الأدلة، ما يعقّد الاستجابة لطلبات التعاون القضائي. لذلك، يجب تعزيز آليات العمل الدبلوماسي الموازي للمسار القانوني.
ويؤكد الدكتور بن ياني مراد على أن استكمال هذا المسار يتطلب عملا مؤسساتيا شاملا، يستند إلى قاعدة معلومات محينة، وتعاون عابر للحدود، وإرادة سياسية ثابتة لا تسمح بأن تبقى هذه الثروات رهينة الغموض، لأن كل يوم يمر دون استرجاعها هو نزيف مضاعف للاقتصاد الوطني.
التعاون القضائي الدولي... آلية لا غنى عنها
وبعد تسليط الضوء على تعقيد تتبع الأموال المهربة بسبب غياب قاعدة بيانات دقيقة وتعدد الأساليب الملتوية لإخفائها، يشدد الدكتور بن ياني مراد على أن الجزائر باتت تُعوّل بشكل متزايد على تفعيل التعاون القضائي والدبلوماسي الدولي، باعتباره المسار الأجدى لكشف مواقع تلك الأصول واسترجاعها بطرق قانونية معترف بها دوليا.
يوضح أن السلطات الجزائرية كثّفت في السنوات الأخيرة إرسال الإنابات القضائية الرسمية، حيث بلغ عدد الطلبات الموجهة نحو دول أجنبية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي إلى 32 دولة، إضافة إلى 53 طلبا محددا لاسترداد أموال ومنقولات في 11 دولة، وفقا لما تم الإعلان عنه من طرف وزارة العدل مؤخرا.
ويشير إلى أن هذا الزخم يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الملف، وانتقاله من مجرد شعار سياسي إلى مسار قانوني تقني مدعوم بالأدلة والوثائق، وبانخراط كامل للمؤسسات القضائية المختصة، ما يُعطي قوة إضافية لموقف الجزائر في أي مفاوضات أو آليات تحكيم دولية.
ويرى أن التعاون الدولي يجب أن يشمل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل رفع الحواجز الإدارية أو القانونية التي تضعها بعض الدول، خاصة تلك التي تتذرع بالسيادة أو السرية المصرفية. وهذا يتطلب تحركا رسميا متعدد الأبعاد، يُزاوج بين القضاء والدبلوماسية والتمثيل السيادي في المحافل الدولية.
ويؤكد على أن الجزائر باتت تمتلك اليوم أدوات قانونية أكثر تطورا، وخبرة مؤسسية تراكمت في السنوات الأخيرة، وهو ما يُمكّنها من خوض هذا المسار بثقة، خاصة إذا استمرت في توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التنسيق مع المنصات العالمية المتخصصة في استرداد الأموال.
المعركة طويلة... لكن الدولة في موقف قوة
وبعد استعراضه الجهود القانونية والدبلوماسية التي باشرتها الجزائر على مستوى التعاون الدولي، يرى الدكتور بن ياني مراد أن المعركة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة ما تزال طويلة وشاقة، لكنها ليست مستحيلة، خاصة في ظل ما وصفه بـ"تطور أداء الدولة الجزائرية مؤسساتيا وتشريعيا"، وقدرتها اليوم على التفاوض والتحرك بثقة في هذا الملف السيادي.
يشير إلى أن حجم التحدي يكمن في ترجمة هذا الاسترجاع إلى تحول نوعي في فلسفة تسيير المال العام، وإقناع الداخل والخارج بأن الجزائر طوت فعلا صفحة الإفلات من العقاب، وباتت تعيد بناء نموذج اقتصادي لا يقوم على الريع أو الفساد، بل على الشفافية والكفاءة والسيادة المالية.
ويؤكد أن استمرار الدولة في هذا المسار يعطي رسائل طمأنة قوية للمواطن والمستثمر في آن واحد، ويُسهم في ترسيخ صورة جديدة لمؤسسات الجمهورية، قوامها الصرامة في مكافحة الفساد، والمهنية في ملاحقة من تورطوا في نهب المال العام مهما طال الزمن أو تعقّدت المسارات القانونية.
ويرى أن الرهان الحقيقي اليوم هو أن تُحافظ الدولة على نفس الزخم والإرادة، وأن تُحوّل الأموال المسترجعة إلى أدوات ملموسة لدعم التنمية والاستثمار وتوفير فرص الشغل، لأن ذلك وحده كفيل بتحقيق أثر مباشر يشعر به المواطن ويُترجم إلى استقرار اجتماعي طويل الأمد.
ويختم الدكتور بن ياني مراد بتأكيده أن الجزائر تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتصحيح أخطاء الماضي، ليس فقط بمحاسبة من أفسدوا، ولكن أيضا بإنهاء كل الأسباب التي سمحت بتهريب الثروات. فإذا تحققت الشفافية، وتمت إدارة هذه الملفات بصرامة وفعالية، فإن الدولة ستخرج من هذه المعركة أقوى، وأكثر قدرة على التحكم في مسارها الاقتصادي السيادي.