كل إنسانٍ يصبح شاعرًا إذا لامس الحب قلبه"، مقولة تُنسب إلى الفيلسوف "أفلاطون"، ولكن الأصحّ هو ما ورد في "مائدة أفلاطون: كلام في الحب"، قال الفيلسوف: "وبعد الكلام عن عدلِ الحب واعتداله وقوَّته بقي الكلام على حِكمته، فأقول: إن هذا الرب شاعرٌ عاقلٌ، حتى إنه يستطيع أن يَخلق شاعرًا من رجلٍ لم يكن كذلك؛ لأن كل إنسان مهما كانت حال نفسه مضطربة قبل الحب، فإنه بفضل الحب يصير شاعرًا، وهذا دليلٌ على أن الحب شاعرٌ وماهرٌ في هذا الفن حسب قواعد الموسيقى". ولو أن "أفلاطون" أطلّ من زمانه، في القرن الرابع قبل الميلاد، على شبكات التواصل الاجتماعي في دنيا النّاس اليوم، لَحكَم على جماهير عربية غفيرة، من أبناء العشرين أو أقلّ إلى آباء السبعين عامًا أو أكثر، بأنها صارت تنتمي إلى زمرة الشعراء، قولاً وصورةً وكتابةً! فأيُّ نعمةٍ كبرى "ابتُلينا" بها، عشقٌ وشعرٌ في زمن الموت الفلسطيني؟ حتى أن فلسطين ذاتها حوّلها العُشّاق إلى أنثى ليس كمثلها أنثى، وأرهقوها بعشقهم "الطوفاني" الملتهب، كأنما ينقصها الالتهاب والاحتراق وهي الغارقة في لجج اللّهب!
وأستسمح القارئ لأنحرف قليلا عن جادّة الموضوع، وأعزّي كل امرأة تحوّلَ بعلُها إلى شاعرٍ يمارس حقّه "الشعري" على شبكات التواصل في الوقت الذي تكون فيه غارقةً في دموع حارقة من أثَر تقطيع البصل! لستُ ضد العشق ولا الكتابة العاشقة، فكلٍّ طنجرته وطبخته وتوابله وناره وحريّته في التعبير.. وأرجو ألا يُساء فهمي في زمنٍ صارت فيه "إساءة الفهم" خطيئة كبرى نقترفها يوميًّا في مجال الدين والدنيا معًا!
العشقُ وجعٌ والكتابة عن العشق وجعٌ أكبر، وفي الحالتين هناك من يستلذّ "الوجعَين" معًا ويسعى إلى التوجّع حتى تتجلّى "عاطفة الشاعر جيّاشة وصادقة".. هذه العبارة التي لازمَت كل القصائد التي كانت تُدرّس في المناهج التعليمية. وقديما قال "ابن طباطبا": "أعذب الشعر أكذبه"، بل ذهب "ابن رشيق المسيلي القيرواني" إلى أن الكذب من فضائل الشعر.. طبعا، لا أريد الإيحاء أو التلميح بأن ملايين العشاق في شبكات التواصل الاجتماعي هم من زمرة "الكذّابين" فالكذب في الشعر - وليس في الشاعر - مع اشتراط العذوبة فيه! وعلى سبيل إنصاف "الحقيقة" فإن الجميع - إلا قليلا - يريدون الكتابة والتعبير، ولا أحد يريد أن يقرأ أو يُنصت.. ربّما أن مستوى الوجع بلغ مُنتهاه، وشبكات التواصل قد منحت الجميع "فرصة تاريخية" لاستفراغ الوجع.. كل أشكال الوجع: فكري ووجداني وحتى عُقد نفسية، بالكتابة على حيطانها وصفحاتها!
قريبا من الوجع في الكتابة الأدبية، توجّهت جريدة "الأيام نيوز" إلى نخبة من الكُتّاب الأفاضل بهذه الرسالة: "قيل لأعرابيّ: ما بال المراثي أجودَ أشعارِكم؟ قال: لأنّنا نقول وأكبادنا تحترق". فالكتابة هي فعل احتراق وتشظّي ومقاومة.. ليحرّر الكاتب أفكارا، أو يكسر جمودا، أو يفجّر ينابيع، أو يواسي نفسه أو غيره، أو يجدّد فهمه للحياة ذاتها!
الكتابة الأدبية ليست مجرّد كلمات مسبوكة في قالب لغوي يضجّ بالبلاغة والصور والتركيب والصياغة.. بل هي ولادة فيها "الحمل" والوجع والمخاض قبل أن تصير مولودا مستقلاًّ عن الكاتب نفسه، له كيانه وكينونته بين الناس، قد يتنكّر لكاتبه أو يُساء فهمه فيكون مصدر وجع للكاتب. ومثلما يحدث لمن يختنق بشربة ماء أو بغصّة للقمة يابسة.. فهناك من يختنق بكتابته ذاتها حينما تتمنّع عليه اللغة وتخونه في اصطياد المعنى الذي يرنو إليه.. والوجع في الكتابة دفع ببعض الكُتّاب إلى الانتحار، ولعله يدفع بعضا آخر من الكُتّاب إلى حافة الانتحار..
فما هي رؤيتكم للوجع في الكتابة الأدبية؟ وهل عشتهم هذا الوجع في تجاربكم الأدبية؟ وهل مسّكم الوجع بعد الكتابة، حينما لا ترضون عمّا نشرتموه فتمنّيتم لو أنه كان في وسعكم أن تجمعوه من بين أيدي الناس، وتعيدوا كتابته من جديد؟
عزيزي القارئ، هل تمارس "التوجّع" على شبكات التواصل بالكتابة؟ ربّما لك تاريخٌ في التوجّع من أيام دراستك، فكان لك دفترٌ صغير تدوّن عليه أوجاعك.. ولعلّك كنت مشروع كاتبٍ كبيرٍ يتوجّع قبل أن يكتب، وأثناء الكتابة، وبعد الكتابة عندما لا يجد مَن يتلقّف أوجاعه!
دعني أهمس لك بسرٍّ خطير، إن ما يُسمّونه "حريّة تعبير"، التي اعتنقها الكثيرون على شبكات التواصل، هي في الحقيقة "حريّة توجّعٍ" خاصة عند الذين يتخفّون وراء أسماءٍ مُستعارة.. فلا تخجل من ممارسة حريّتك في التعبير أو في التوجّع فالأمر سيان، ولكن دون تُوجع غيرك، ولا بأس أن تعزّي تلك المرأة التي تركناها تذرف دموع البصل وبعلُها يتوجّع من العشق والكتابة!

وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
السقّاء والعصفور وضحكة أخيرة..
شيءٌ لزِجٌ سقط فوق رأسي، كان كفقّاعة ماء رُمِيت على أرضٍ جافّة، قلت: "أحّ"، ونظرت مباشرةً نحو الأعلى، رأيته بأمّ عينيّ، كان يقف على شريط الكهرباء مشمّرًا عن ريشه، تحسّست البقعة بأصابعي، حدّقت بها، كانت كنقطة (Ice Coffee) بنّيّةً ولكنّها كانت ساخنة. انتقلت من مكاني، وقفت بعيدًا عن شريط الكهرباء، وراقبت المشهد، بدا الطائر وكأنّه يعاني من إسهالٍ حادّ، إذ صارت البقع تتساقط الواحدة تلو الأُخرى سريعًا وبشكلٍ غير منقطع، قلت وأنا أمسح أصابعي بمنديلٍ ورقيّ: لعلّه خير، تغوّط الطائر فوق رأسي، هذا فأل خير في بلادنا العربيّة.
كانت شمس أيّار/ ماي تلاعب السّماء لعبة الغمّيضة، تارةً تظهر وتارةً تغيب، النّاس يروحون ويجيئون، المدينة تكتظّ بالمارّة، وعلى الرّصيف رجلٌ قاعدٌ منذ دهر، كانت شعيرات رأسه المتبقّية حرباء اللون، لا هي بيضاء ولا سوداء ولا رماديّة، ولا حتّى صفراء، بل قُل مزيجًا من كلّ هذه الألوان دفعةً واحدة، تدلّت من ثغره العتيق لفافة تبغٍ، كان ينفخ دخانها في الهواء فيختلط مع أدخنةٍ كثيرة تملأ المكان، مررت قربه، كان سقَّاءً يبيع الماء، اشتريت قنّينةً وأفرغتها فوق رأسي أمامه، فراح يصرخ: مجنون! مجنون!
تجمّع النّاس حولنا، قالوا له: ما خطبك يا أبا الغضب؟ ضحكتُ.
أبو الغضب، قلتُ، ورحت أقهقه.
قال: اشترى قنّينة ماء ورماها فوق رأسه.
قال الحشد: ألم يدفع ثمنها؟
بلى. أجاب باختصار.
وما المشكلة؟ قالوا، خفّف الحِمل عنك يا رجل. وتفرّقوا كلٌّ في طريق.
تعال، كلّمني يا أنت. قال.
ما بك؟ أجبته.
لمَ رميتها فوق رأسك؟ سألني.
لأنّ ذاك الطائر، انظر إليه انظر، لقد تغوّط فوق رأسي. أجبت.
وانفجر بضحكاتٍ هستيريّة ممتزجةٍ بقحّات صدره المهترئ، بدا للحظةٍ وكأنّه يختنق، أو اختنق حقًّا، مال عن كرسيّه وسقط أرضًا كقطعة قماشٍ سقطت عن حبل غسيل. تجمهر النّاس حوله، رشّوا على وجهه الماء، لم يتحرّك.
مات. قال أحدهم.
سرى الذّهول على وجهي ووجه الحاضرين.
مات؟ كيف مات؟ هكذا مات؟ راحت الأسئلة تنطلق من الأفواه، وأنا مشدوهٌ بما أرى، كانت قطرات الماء لم تزل تتساقط من فوق رأسي.
أخذت زاويةً من الطّريق وتسمّرت في مكاني، جاءت سيّارة الإسعاف، نقلته وانتهى، هكذا فجأةً انتهى دوره، كان يضحك منذ دقائق، والآن لم يعد موجودًا. الحياة خادعة، توهمنا أنّنا مخلّدون، نكبر، نحبّ، نكره، نجادل، نعاتب، نشاجر، نضحك ثمّ قبل أن تنتهي ضحكتنا، تسوقنا نحو الغياب، فكأنّنا ما كنّا.
هذا السّقّاء زُرِع في دماغي، لم أكن أعرفه، وقد أمضى عمره كلّه ولم يعرفني هو الآخر، ثمّ دفعني عصفورٌ نحوه، ثمّ طار العصفور وحلّق معه هذا الرّجل. ما الحكمة في ذلك؟ تساءلت، لكنّني لم أجد ضالّتي.
رحت أكتب عنه، بدأت بتأليف نصٍّ دراميّ في خيالي عن حياته السّابقة، قلت إنّه قضى حياته في العذابات، أهملته عائلته ورمت به إلى الشّارع، سافر أولاده ونسوه، وبقي يبيع الماء كي لا يمدّ يديه لاستعطاف النّاس، عاش حرًّا ثمّ قضى وهو يضحك. وحين أنهيت نصّي عنه مزّقت الورقة وأطعمتها لسلّة المهملات، إنّ ما عانيته من هذا المشهد يفوق وصفًا خياليًّا يشدّ النّاس، ولكنّه خيالي وقد لا يمتّ إلى الحقيقة بشيء. أردت أن أكتب عن شيءٍ حقيقيٍّ ماثلٍ أمامنا ولا نُلقي له بالًا: الموت. هذا الذي يسير معنا كالظلّ ولا نأبه به، أيُّ وجعٍ أقسى من الحقيقة ماثلةً أمامنا؟ هكذا من دون أن نلطّفها ونحسّن مظهرها بشيءٍ من الخيال، هكذا من ضحكةٍ خاطفة إلى نهايةٍ خاطفة، نحتار حينها أنبكي أم نضحك؟ هذه الحياة نصٌّ كوميديٌّ لكنّ الحقيقة مأساة مختبئة بين السّطور وقد يؤدّيها طائر، أو رشّة ماء، أو ضحكةٌ نختتم بها سطرنا الأخير.

سلوى غيّة (باحثة وناقدة - لبنان)
من وجع الحرف إلى رجاء المعنى.. عبِّروا لتعبُروا…
نحن مرايا لما نختبره ونحسّ به، أو لما نتمنّى أن نشعر به. وحياتنا مرتكزة على إحساسنا، مهما بلغت درجة تفكيرنا من المنطق والعقلانيّة.
تهزمنا رائحة قديمة، كلمة سمعناها من عابر تُذكّرنا بكلمة مَن نُحبّ، يهزمُنا رذاذُ قطرة ماء على شُبّاكِ السيّارة، يهزِمُنا إشعارُ الواتساب، يهزِمُنا الحنين.. الحنينُ إحدى هزائمنا، ولا شيءَ يروي هذه الهزائمَ إلّا الحبرُ المرصّعُ بدموعنا.
فالألم لا يُطفئ الحبر، بل يُحرِّضُهُ على السّيلان.
كلُّ أنَّةٍ في صدر الكاتبِ تورقُ نصًّا على الورق، وكلُّ وجعٍ صامتٍ يَنبُتُ جملةً مرتجفةً من قلبِ التّجربة؛ لأنُ ما يُكتبُ على الورقةِ يا أصدقائي، في نظري هو انعكاسٌ لتجاربِ الإنسانِ في مختلفِ صورِها وألوانِها، وهي بالتّالي صدًى لدواخلنا، وأحيانًا تقفزُ فوق التّجربةِ وتتخطّاها. وكلامي هذا لا يعني أنّ الكتابةَ الأدبيّةَ الشعوريّةَ التي لا تحملُ تجربةً فعليّةً تكون خارجةً عن الإحساس.
الوجع في الكتابة هو السّعي المستمرّ نحو تفسير العالم الدّاخلي بكل ما فيه من تناقضات وصراعات، وهو اللحظة التي يتحوّل فيها الألم إلى جمال، على الرّغم مِن قسوته، نحن نوثّق الألم لا نهرب منه.
إنّ فعلَ الكتابةِ يا أصدقائي هو صدى أو ترجمة لخلجاتنا، وسيلته الإيحاءُ الخياليُّ واللفظيُّ، فبدون الوسيلة لا نستطيع الوصولَ إلى التّعبير، والأديبُ بحاجةٍ ماسّةٍ إلى هذه الأدوات.
الكتابةُ يا أصدقائي لا تولدُ مِن فراغٍ، هي تعبيرٌ عن فكرةٍ ووجدانٍ، ولا يكفي وجودُ الشّعورِ لنكتُبَ. في غيابِ أدواتِ الكتابة، نعجزُ أحيانًا عن التّعبير ويخنُقُنا شعورُنا أكثَرَ ممّا هو خانقٌ لنا، والكتابةُ تحتاجُ إلى ممارسةٍ ووعيٍّ عميقٍ باللغة؛ فالفكرة "الموضوع" قد تكون مشتركة، لكن طريقةَ التّعبيرَ عنها هي ما يُميّزُ الأديب، والأديبُ الذي امتلكَ ناصيةَ اللغة، فازَ بجعلِ الساكنِ مُتحرّكًا والمادِّيِّ محسوسًا. فلا يكفي أن يشعُرَ الإنسانُ ليصيرَ شاعرًا أو كاتبًا، بل عليه أن يجدَ اللفظةَ التي تحملُ شعورَه كما هو أو أعمق، فالكتابةُ ليست مُجرَّدَ نقلٍ للأفكار، بل خَلقٌ لعالَمٍ ينبضُ بالحياةِ من خلالِ الكلمات.
دعوني أُخبركُم أنَّ الكلمةَ ليست دائمًا طيّعة، فهي أحيانًا تُعاند، تُراوغ، وتختبئ في زوايا الذاكرة، ترفض أن تُفصح عن نفسها، وكأنّها تختبِرُ صِدقَ مشاعرنا. حين نُمسِكُ القلمَ، لا نكتبُ فقط، بل نُصارعُ الصّمت، نُحاورُ الفراغَ، ونُفتّشُ عن تلك اللفظة التي تُعبِّر عنّا بصدق.
الكاتبُ الحقيقي لا يُملي الكلمات، بل يُصغي إليها، ينتظرها حتى تأتيه طائِعةً، دون قَسرٍ أو إجبار.
أصدقائي، لا أُخفي عليكم أنّني كثيرًا ما مزّقت أوراقًا كتبتُها، لا لأنّ المشاعرَ لم تَكُن حاضرةً، بل لأنّ الكلمات لم تكن وفيَةً لها.
أحيانًا، أَشعُرُ أنَّ اللفظةَ خانتني، لم تَحتمِل ثِقلَ الشّعور، فبَدَت باهتةً، عاجزةً عن نقلِ ما في القلب. في تلك اللحظاتِ، أتركُ القلمَ، أتنفَّسُ الصّمتَ، وأنتظرُ حتّى تأتي الكلمةُ من تلقاءِ نفسِها، تحملُ بين حروفِها صِدقَ الإحساسِ وعمقَ التّجربة.
لا أُريدُ أن أُطيل الحديث، لكنّي أستأذنكم أن أُفوّض نفسي بالكلام، فأقول: مهما خانتكم الكلمات، ومهما تلعثَمَت الألفاظ على أطرافِ شعوركم، لا تتراجعوا. عبّروا، ولو بارتجاف الحبر، ولو مزّقتم الورقة ألف مرّة وشعرتم أنكم خُذِلتم… واصلوا… دعوا الإحساس يقتحم اللفظة، يلامسها، يُوقظها من سباتها، حتّى تأتيكم مُختالة بفستانها، كما لو كانت في انتظاركم منذ البدء.
عبّروا لتعبُروا…
اكتبوا لتنجوا…
فكم من وجعٍ صار أملًا
وكم من ألمٍ أنجب أدبًا خالدا

زينب أمهز (كاتبة وباحثة من لبنان)
الكتابة نافذة الرّوح.. وشبكة اصطياد اللحظة الهاربة!
في البدء، كانت الكلمة... وكانت هي المعجزة التي أنزلها الله على النبيّ، فحرّكت العقول، وأيقظت الأرواح، وبدّلت وجه العالم. ومنذ ذاك الحين، والإنسان يشهد بأنّ الكتابة ليست فعلًا عابرًا أو وسيلة ترفيه، بل هي جوهر الخلق الإنساني، أداة الخلود، ومرآة الوعي. الكتابة ليست حبرًا يُراق على ورق، بل هي نزفٌ داخليّ يتدفق من قلبٍ يضجّ بالمشاعر، ومن عقلٍ يضجّ بالأفكار.
الكتابة نافذة الرّوح، وهي تعبّر عن جميع مكنونات النفس، الحب، الحزن، الفرح، الخوف، الحنين، الاشتياق... وكل نبضة قلب ترقص فرحًا، وكلّ خيبة وكسرة وحسرة، كلّ دمعة نزفت قهرًا أو حزنًا.. والكتابة توثّق جميع الأشياء والأحداث وتطال المشاعر أيضا، ولولا الكتابة لضاعت كلّ أتعاب الأدباء والعلماء والفلاسفة هباءً منثورا، فلولا الكتابة لم ينتقل إلينا من إرثهم شيء، ولولا الكتابة لا يمكننا أن نورّث الجيل القادم، كل ما نتوصّل إليه، وكلّ ما يتوصّل إليه من اكتشافات وتقدّم وغيرها.
هذا بشكلٍ عام، أمّا إن أردنا الحديث بشكلٍ خاص عن الكتابة الأدبية، فإنّ الغوص في بحرها ليس بالأمر الهيّن، بل هو ارتحالٌ طويلٌ في لجّة النفس، حيث الكلمات لا تكون زينة، بل أصداء لما يُخبّئه الداخل من جراح وحنين وأسئلة مؤجلة. إنها دورة متكاملة كما دورة المياه في الطبيعة، لا تفنى ولا تنقطع، بل تعود بأشكالها المختلفة؛ بخارًا حين نحترق، ومطرًا حين نفيض، ونهرًا حين نجري في سرد الحكايا... والكتابة، إن صدقت، تُشبه الماء في نقائه وقدرته على التسلل إلى أعقد زوايا الروح.
الكتابة الأدبية ليست هواية نمارسها في وقت الفراغ، بل هي فرض علينا إتمامه بأمانة. إنها طريقتنا لنقول "نحن هنا" في وجه النسيان، لنترك أثرًا لا يمحوه الغياب، ولا يبتلعه الزمن.
من يكتب أدبًا، لا يدوّن فقط حدثًا أو فكرة، بل يُمارس نوعًا من التطهّر، من الغسل الداخلي، ويحوّل التجربة إلى نصّ، فيصير الألم درسًا، والشوق صفحة، والحياة بأسرها كتابًا مفتوحًا على احتمالات مفتوحة.
فالكتابة إذًا هي الباب الذي نطرقه حين تضيق بنا الحياة، وهي المرفأ الآمن في بحر العواصف، وهي الصرخة حين يُعجزنا النطق، والدمعة حين تُخنق في المآقي. بها نرتّب الفوضى داخلنا، ونلملم شتات أنفسنا، ونُسكت ضجيج الواقع. إنها فعل نجاة، وفعل بوح، وفعل مقاومة. هي صوت المهمّش، وسلاح المُفكر، وشفاء المجروح.
وفي عالمٍ سريع الإيقاع، منهك الأرواح، تُصبح الكتابة ضرورة وجودية، لا مجرد وسيلة تعبير. إنها المساحة التي نمارس فيها وجودنا الحقيقي، بعيدًا عن الأقنعة والضوضاء، إنها الطريقة التي نُمسك بها اللحظة كي لا تضيع، والتي نُقاوم بها النسيان، والتي نُجدّد بها فهمنا للحياة.
فكيف لا تكون الكتابة نافذتنا الكبرى على الذّات، وكيف لا تكون وسيلتنا لتوثيق مشاعرنا، ولتخليد أفكارنا، ولربطنا بحبل متين بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ وكيف لا تكون هي الحبل السرّي الذي يُغذّينا حين تتيبّس فينا الأرواح؟
الوجع في الكتابة الأدبية ليس مجرّد حبر على الورق، بل هو نزفٌ ناعم، واحتراقٌ داخلي يتّخذ من الكلمات مخرجًا للنجاة. هو لحظة يكتب فيها الكاتب لا ليُبدع، بل لينجو؛ يكتب لأنّ الصمت يُوجعه، ولأنّ الجرح أضيق من أن يُحتمل دون صوت. في كلّ سطرٍ موجة ألم، وفي كلّ فاصلة تنهيدة، وكأنّ الكاتب حين يكتب، يُعيد فتح جرحٍ لم يندمل، لا ليتألّم منه من جديد، بل ليضع عليه ضوءًا... ليفهمه، ليحتويه، أو ليرتّب حطامه كي لا ينهار فجأة. الكتابة بالوجع إذًا، ليست فنًّا، بل فطرة، ونداء داخلي للاستمرار رغم الانكسار. وسأورد بعض القصائد، إحداها بقلمي كتبتها إثر فقدان أمّي الغالية، والأخرى لـ "الخنساء" في رثاء أخيها "صخر"، تظهر فيها الكتابة مدى الألم والوجع إثر الفقد، ذلك الثقب الأسود الذي يبتلع أرواحنا.. أقول في قصيدتي:
يوجِعُني الفقدُ يا أمّي
ولهيبُ الشّوق يحرقُني
والقلبُ لذكراكِ مكلومٌ
وأشباحُ الذّكرى تُطارِدُني
من نومي الهانئ تحرمُني
وبِلَيلٍ لا نجمَ يُضيئُه
ترمي أشجاني وتُثكِلُني
أيا أمّاهُ..
أيا وجعي
يا جُرحًا في الرّوح يغورُ
أليس لوصلك من سُبُلٍ
دُلّيني أمّاهُ من سُؤلٍ
أليس لهجركِ من مرسى؟
أليس لوجعي من منفى؟
أيا أمّاهُ
يا حُزني
يا بحّة صوتٍ يبكيكِ
يا لهفة ضلعٍ في صدري
في كلّ صلاةٍ يناجيكِ
ضمّيني أمّي ضميني
ومن هذا الهجر أجيريني
وبيدكِ خذي عقدة الشَّعرِ
وخذي أمّاه سهد المقلِ
إليك أحنُّ أيا أمّي
مدّي من العلياءِ يديكِ
أغمضتُ العينَين فضُمّيني
وتقول "الخنساء" في رثاء أخيها "صخر":
أَعَيْنَيَّ جُودَا وَلَا تَجْمُدَا -- أَلَا تَبْكِيَانِ لِصَخْرِ النَّدَى؟
أَلَا تَبْكِيَانِ الْجَرِيءَ الْجَمِيلَ -- أَلَا تَبْكِيَانِ الْفَتَى السَّيِّدَا؟
طَوِيلَ النِّجَادِ رَفِيعَ الْعِمَادِ -- سَادَ عَشِيرَتَهُ أَمْرَدَا
إِذَا الْقَوْمُ مَدُّوا بِأَيْدِيهِمِ -- إِلَى الْمَجْدِ مَدَّ إِلَيْهِ يَدَا
فَنَالَ الَّذِي فَوْقَ أَيْدِيهِمِ -- مِنَ الْمَجْدِ ثُمَّ مَضَى مُصْعِدَا
يُكَلِّفُهُ الْقَوْمُ مَا عَالَهُمْ -- وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ مَوْلِدَا
تَرَى الْمَجْدَ يَهْوِي إِلَى بَيْتِهِ -- يَرَى أَفْضَلَ الْكَسْبِ أَنْ يُحْمَدَا
وَإِنْ ذُكِرَ الْمَجْدُ أَلْفَيْتَهُ -- تَأَزَّرَ بِالْمَجْدِ ثُمَّ ارْتَدَى
ومن هذين المثالين نرى أنّ الكتابة تُترجم المشاعر التي تختلج في القلب وتحوّلها إلى كلمات... فتُبصرُ العيونُ ما كان خافيًا، وتتنفّس الروحُ بعد اختناق. إذ بالكتابةُ نخرج إلى الميناء الآمن لعواصف الداخل، فهي الوسيلة التي نُرمّم بها شروخ أرواحنا. فإن لم نستطِع البوح، كتبنا... وإذا كتبنا، عشنا مرّتين: مرةً في الألم، ومرةً في تجاوزه.
الكتابةُ مقاومةٌ للواقع
في عالمٍ يضجُّ بالظلمِ والقهرِ، تُصبح الكتابةُ فعلَ مقاومةٍ بامتياز. هي وسيلةٌ للتّعبير عن الرّفض، وللتّصدي للهيمنة، وللتّأكيد على الكرامة الإنسانية. من خلال الكتابة، يُمكن للكاتب أن يُسلِّط الضوء على معاناة المظلومين، وأن يُعبِّر عن صراعاتهم، وأن يُطالب بحقوقهم.
إذًا، لا يقتصر دور الكتابة على معالجة ما ينضح به القلب وتفيض به العين من وجع، بل تمتدّ لتكون فعل مقاومةٍ صامتٍ، وصوتًا عالٍ في وجه الذلّ والعدوان. الكتابة سلاح الذين لا يحملون سلاحًا، وصرخة الذين خنقهم الصمت، واحتجاج من لا يملك منبرًا. هي التعبير النبيل عن الرفض، والرغبة المستميتة في التغيير، ومحاولة لرسم واقعٍ بديل على ورق، لعلّه يصير يومًا واقعًا في الحياة.
فها هو "محمود درويش" يتأمّل في معاني الحلم والهوية والوجود، معبّرًا عن رؤيته الفلسفية العميقة. يقول "درويش" في مطلع قصيدته:
سأحلمُ.. لا لأصلح مركبات
الريح، أو عطبًا
أصاب الروح
فالأسطورةُ اتّخذت مكانتها
المكيدة، في سياق
الواقعيّ
وليس في وسع القصيدةِ أن
تُغيّر ماضيًا يمضي ولا يمضي
ولا أن توقف
الزلزال
لكني سأحلُم، ربما اتسع
بلادٌ لي كما أنا واحد من أهل
هذا البحر..
في هذه الأبيات، يُعبّر "درويش" عن أنّ الحلم ليس وسيلة لإصلاح ما لا يمكن إصلاحه، بل هو فعل وجودي يُعيد للذّات توازنها في عالمٍ مضطرب. ويُشير إلى أنّ القصيدة، رغم جمالها، لا تملك القدرة على تغيير الماضي أو إيقاف الكوارث، لكنها تمنح الشاعر مساحة للحلم والتأمل.
وكذلك "عمر الفرّا" يعبّر عن رفضه واستنكاره بقلمه للواقع المرير، مهدّدا العدو بأنه لن يستكين حتى يرحل عن أرضنا. وهذه مقتطفات من قصيدة "ثُورْ" للشاعر "عمر الفرا":
ثُورْ...
ثور تحزّم واشْعل التنُّور.
ثور...
من حيفا لذرى الجولان
ومن غزّة لوادي الغور
ثور...
وَصِّلْها لعين الشمس
ثور
فجّر...
كل شرايينك
ولا تُمضي العمر ناطور
تجذّر...
بالأرض شجرة
ولا تبقي جنح عصفور
الموت أهون ألف نوبة
من العيشة بوطن مقهور
خسارة...
لِلِّي ما يدري
بأيّ لحظة لُزوم يثور
زلزِلها... تهزّ القاع
دمّر... كل حديد السور
ثور، ثور...
يا مستعمر أرض بلادي...
كل شي تغيّر، كل شي تحوّل
لا تحلم برجوع الماضي
غير الثورة – الطلقة لا تتأمّل
أرض بلادي...
ملك أولادي
ملك الحنطة
وملك المنجل
غلط وجودك فوق ترابي
غلطك تاريخي من الأول
جيتك، ترى جيتك
أنا جيتك...
ما تعرفني شلون
بأيّ شكل بأيّ لون
والكتابةُ تُعدُّ أيضًا وسيلةً لإعادةِ فهمِ الحياة. من خلال الكتابة، يُمكن للإنسان أن يُعيد تأمّل تجاربه، وأن يُعيد صياغة ماضيه، وأن يُخطّط لمستقبله. هي عمليةٌ تحليليةٌ تُساعدُ على فهم العلاقات، والمواقف، والمشاعر، مما يُساهم في نمو الشخصية، وتطوّر الفكر.
كما يُشيرُ بعضُ الباحثين، فإنّ الكتابة تُتيحُ للكاتب أن يُبحر في أعماق ذاته، وأن يُعيد اكتشاف نفسه، وأن يُعيد بناء رؤيته للعالم.
والكتابة كإعادة فهم للحياة، ليست ترفًا فكريًّا، بل ضرورة وجودية. إذ كثيرًا ما تكون الكتابة المرآة التي نطلّ بها على دواخلنا فنفهم ذواتنا، والأداة التي نعيد بها تشكيل مفاهيمنا حول الوجود والزمن والناس. في لحظة ألم أو دهشة أو انكسار، نجد أنفسنا نكتب، لا لنوثّق ما حدث فحسب، بل لنفهم لماذا حدث، وكيف أثّر فينا، وما الذي تغيّر بعده في نظرتنا إلى العالم.
الكتابة تخلق فهمًا جديدًا من الفوضى، وتمنح ترتيبًا لما تبعثر فينا، وتُعيد إلينا ما كنّا نظن أننا فقدناه من يقينٍ أو أمل. حين نكتب، نكتشف كم كنّا نجهل أنفسنا، وكم للحياة من أوجهٍ لم نرها إلّا عبر حبر القلب.
بهذا التأمّل، تصبح الكتابة وسيلتنا لنُبصر النور داخل العتمة، ولنستعيد الفرح من بين ركام الحزن. هي ليست سردًا للواقع، بل تفكيكا له، وإعادة بنائه على نحوٍ يجعلنا نكمل المسير بفهمٍ أعمق ووجدانٍ أنضج.
في النهاية تُعدُّ الكتابةُ الأدبية أكثرَ من مجردِ وسيلةٍ للتّعبير، فهي عمليةُ تحريرٍ للذات، ومقاومةٌ للواقع، وإعادةُ فهمٍ للحياة. هي وسيلةٌ للتصالح مع النفس، وللتغلب على الصدمات، وللنمو الشخصي. ومن خلال الكتابة، يُمكن للإنسان أن يُعيد بناء ذاته، وأن يُعيد تشكيل واقعه، وأن يُحقق التوازن النفسي.
... وليس لكلّ ما أوردنا من معانٍ كاملة، ولا لأفكارنا روحٌ نابضة، ما لم يصُغها الكاتب بصدقٍ وموهبةٍ وشغف. فالكلمات، مهما عظُمَت معانيها، تظلّ مبعثرةً جوفاء، إن لم يلتقطها الكاتب من وهج التجربة، ويُعيد تشكيلها في قلبه قبل قلمه.
هو الكاتب من يمنح الفكرة هويّتها، ويزرع في العبارة نبضها، هو الذي لا يكتفي بنقل الحقيقة، بل يكسوها ثوب البلاغة، ويصهرها في أتون الإحساس، لتغدو كلمة واحدة منه، أبلغ من ألف شرح. فالكاتب، يمكننا القول، إنّه كالصيّاد الذي يجد في كلّ قصة وفكرة مهما كانت عابرة، مادّةً تستحقّ وضعها على مائدة الورق، ففي عالم الكلمات، حتّى العاديّات تتحوّل إلى روائع إن صادفت فنّانًا يُجيد لعبة الحروف، فمهمّة الكاتب أن يجعلك ترى الأشياء من جهاتها الأربع، ويسلّط الضوء على المناطق المُعتمة في عقلك لترى المشهد كاملًا. ولأن الكتابة نقيض العاديّة، فهي عملية إخراج الأشياء والأحداث العادية بطريقة مدهشة، بطريقة بسيطة مدهشة، على يد الكاتب الماهر، هي تلك الكلمات التي تجعل القارئ حين يقرأ ويلتقط الفكرة يشعر بأنه كان بإمكانه التقاط تلك الفكرة بنفسه، وأن يقول تلك الكلمات لكنه لم ينتبه لولا أنّ الكاتب نبّه عقله إليها، لذلك نرى الكثير حين يقرأ عباراتٍ ما يشعر بأنّ الكاتب كتبها من قلبه لا من قلمه، وكأنّه كتب ما يشعر به القارئ أيضا لا هو وحده، فهي كتابة تلامس القلب والوجدان والرّوح. وهذا هو سحر الكتابة، وهذا هو سحر اليد التي صاغت تلك الجوهرة.
وليس ذلك وحسب، فالكاتب هو لسان أولئك الذين أخرستهم الآلام وطحنتهم عجلات الأحكام، فالكاتب ابن بيئته، ينقل هموم الناس وآمالهم وأحلامهم وألمهم وفق رؤيته الخاصة، ووفق استشرافه للمستقبل. ولا يمكننا أن نغفل أنّ لكلّ كاتبٍ أسلوبه وطريقته الخاصّة التي تصبح بصمة فيما بعد تختصّ به، هو وحده، ويصبح أسلوبه متعارفًا عليه حتى قبل أن تقرأ اسمه، فبمجرّد أن تسمع قصة، أو حكمة، أو قصيدة، يمكنك أن تعرف لمن تعود، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر مع: محمود درويش، نزار قباني، جبران خليل جبران... والكثير من الأدباء والشعراء الذين تركوا لنا إرثًا عظيمًا من نتاجهم الأدبي الذي يميّز كلٍّ منهم عن الآخر.
وختامًا، يطول الكلام كثيرًا عن الكتابة والكاتب، الذّهب والصائغ.. لكن يمكننا القول إنّ الكتابة الأدبية فعل نجاة، وصرخة وعي، ومرآة تعكس عمق الروح وارتجاف القلب.
هي المساحة التي نلجأ إليها حين تضيق بنا الحياة، لنفهمها أكثر، لنفهم أنفسنا أكثر. والكاتب حين يكتب، لا يروي حكايةً فقط، بل ينسج خلاصه، يُحرّر وجعَه، ويقاوم بالصوت حين يخبو الكلام.
إنّ ما يُقال كثيرٌ، ولكن ما يُخلّد قليلٌ، وما يُخلّد لا يُكتب إلا حين تكون الكلمات ابنة الألم أو الحُلم أو الحنين.

سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
بين صاحب الظل الطويل والصوت الخفي.. رسائل حياة وموت!
"عزيزي صاحب الظّل الطّويل، لا أعلم كيف أناديك، فأنت لم تخبرني باسمك. لقد رأيت ظلّك فقط على الجدار عندما زرت الميتم، وكان طويلًا جدًّا. لذا قرّرت أن أسميك (صاحب الظّل الطّويل)، شكرًا لأنّك أرسلتني إلى الكلّية. سأكون فتاة مجتهدة جدًّا، وأعدك بأن أجعلك فخورًا بي".
سنوات وسنوات، و"جودي أبوت"، تلك الفتاة اليتيمة، تراسل صاحب الظّل الطّويل، تشاركه يوميّاتها بحماسة وحبّ، من دون أن تعرف من يكون، أو أن تقابله، أو حتى أن يردّ على رسالة واحدة من رسائلها. ولكن، لمجرّد أنّه وهبها الأمل في الحياة، وهبته الوفاء. تصرّف واحد نابع من قلب صادق وروح طاهرة كان غذاء لها، منحها العزيمة والقوّة. كتبت له من دون ملل، ومن دون انتظار، جعلت مشاعرها حياة مزروعة بحروف من الامتنان اللّامتناهي.
أمّا "شوجو نيشيميا"، تلك الفتاة الصّماء، ذات الصّوت الخفيّ، لم تمتلك حظّ "جودي" في الاحتواء والدّعم، بل على العكس، تعرّضت للتّنمّر بسبب وضعها الصّحي، شعرت بالعجز، تملّكتها الوحدة، وسيطر عليها الشّعور بالذّنب والخذلان، فكتبت رسالتها الشّهيرة بنيّة الانتحار:
"أنا آسفة، آسفة لأنّي سبّبت كلّ هذا الحزن، حاولت أن أكون قويّة، لكنّي فشلت. أريد فقط أن أرتاح، أن أختفي، ألّا أكون عبئًا على أحد بعد الآن".
من حسن حظّها أنّه تمّ إنقاذها في اللّحظة الأخيرة لتبدأ بعدها رحلة العلاج والتّشافي، ولكن ماذا لو لم يسعفها الوقت؟ لربّما كانت الآن في عداد المغيّبين عن الحياة، عن سبق إصرار وتصميم.
رسالتان، من فتاتين عاشتا الوحدة بظروف مختلفة، ولكن الفرق بينهما يكمن في البيئة التي حاوطت كل منهما، واحدة نهلت من الدّعمِ القوّةَ، وواحدة لم تجد سوى فُتات الضّعف والانكسار.
وكم من هذه النّماذج نجدها حولنا، وكم من رسالات نقرأها حتى نكاد نختنق من فيض المشاعر المنكبّ فيها.
نسمع كثيرًا "نيّالو قادر يحكي ويعبّر"، تمامًا مثل "جودي"، رسالات يوميّة ترمي فوق سطورها ما ينغل في داخلها؛ "العترة ع يلي بخبّي بقلبو"، وكم من "شوجو" نجدها حولنا، وكم من النّاس تقف الحروف في الحلق وتضيع أقلامهم، يكبّلهم الاكتئاب والآلام، حتى يفقدوا القدرة على فهم ما يعانون، فلا يعود الصّمت أصدق الكلام، ولكنّه يصبح السّلاح الأكثر فتكًا.
فطوبى لأدباء النّكسات القلبيّة، طوبى للآه التي تفجّر براكين الهدوء من بين تشقّقات الرّوح، طوبى لثرثرات اللّيل تأخذ معها عواصف المشاعر المنكسرة، وويل للصّمت يبتلع الدّموع البكماء حتّى تجفّ شواطئ الحياة.
"في حزن وسع المدى
في وجع جوا عميق
لا صوت باقي ولا صدى
ولا مين يكفي الطّريق"
هذه الأغنية من كلمات الشّاعر اللّبناني "نزار فرنسيس"، لها وقعٌ خاص على كلّ من سمعها، فدائمًا ما ينجذب "السّمِّيعة" إلى أغنيات الحزن، ليس حبًّا بالبكاء، ولكن عجزًا عن التّعبير، فنجد من ينقل نكبتنا، لنستمع ونبكي دون أن نلفظ حرفًا واحدًا. معاناة حقيقيّة، نصفّق لها ولا ندري ما وراء هذا الإبداع من ألم، من انهيار، ومن غرق في عالم من الفقدان.
كلّ ألم يسرق من الرّوح قطعة ابتسامة، نفقد أنفسنا قبل أن نقد الحياة!
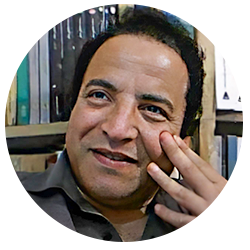
د. شعبان عبد الجيِّد (كاتب وشاعر مصري)
جدليَّةُ الإبداعِ والألم!
منذ فترةٍ بعيدةٍ وأنا على قناعةٍ بأن "الألمَ" مسألةٌ شخصية؛ وكما أن الإنسانَ يُولَد وحدَه ويموت وحدَه، فهو أيضًا يتألَّمُ وحدَه. إن وجودَنا يظلُّ ملتبِسًا بالوجود الخارجي إلى أن نتألم، والألمُ، كما يقول الدكتور "زكريا إبراهيم" في كتاب (المشكلة الخلقية)، هو الذي يكشف لنا عن وجودنا الفردي، في وحدة قاسيةٍ تتمزق معها الرابطة التي كانت تُوثِقنا بالكون. وليست "اللذةُ" كذلك؛ لأن اللذة بطبيعتها باسطة، في حين أن الألم من شأنه دائمًا أن يردَّنا إلى ذواتنا، ويحتبسَنا في وجودنا الفردي، وحينما يستشعر الإنسان اللذة فإنه يستسلم لهذا الشعور وينسى نفسَه، ولكنه حين يستشعر الألمَ يقبعُ في ذاته، وينطوي على نفسِه. ومن هنا ذهب البعض إلى أن الألم وحده هو الذي يتيح لنا الفرصة لأن نعاني "تجربة الوَحدة" على حقيقتها.
إن السعادة تخلق ضربًا من الانسجام بين الذات والعالم الخارجي، وهو ما يؤدي إلى أن تنسى الذاتُ نفسَها، أمَّا الألم فهو يعزلنا على حدة؛ وحين يتألم الإنسان فإنه سرعان ما ينطوي على نفسِه، لكي يتجه بانتباهه واهتمامه نحو تلك النيران الباطنة التي تشتعل في جوفه. إننا نتألم فُرادَى: لأن الألم "خبرة باطنية"، هيهات للآخرين أن يشاركونا في معاناتها. وإذا كان كثيرٌ من الناس ينسبون إلى "الألم" دورًا مهمًّا في صميم حياتهم، فذلك لأنهم يشعرون في قرارة نفوسِهم بأن الآلامَ التي عانُوها، هي التي كوّنت معظم الجانب الشخصي من وجودهم.
إن كلًّا منَّا حين يتألم، يشعر بأن ألمَه فريدٌ في نوعه، شاذٌّ في حدّته، وكأن ألمه أيضًا هو نسيجُ وحدِه، كما أن ذاته هي الأخرى نسيجٌ وحدها، فيصرخ صرخة المتألم: "دعوني وحدي! اتركوني بمفردي! إن أحدًا منكم لا يستطيع أن يتصور إلى أيِّ حدٍّ أتألم! إن أحدًا منكم لا يستطيع أن يقف على طبيعة حزني!". وهي صرخةٌ تنبعث من أعماق نفسٍ حزينةٍ وحيدة، تشعر بأنها في جانبٍ والعالم كله في جانبٍ آخر.
ولقد قيلَ إن وراءَ كلِّ إبداعٍ عظيمٍ ألمًا عظيمًا، ولست أفهم، بل إن أحدهم قد بالغ في ذلك كثيرًا فقال: إن "كل من لا يتألم لا يبدع، وإن أبدع بدون ألم يكون إبداعه مبتورًا منقوصًا لا متعة فيه، ومن لم يتلذّذ بالألم لا يشعر بمتعة الإبداع، ومن لم يذق مرارة الألم لا يشعر بالسعادة". والحق أنه ما من شيءٍ عظيمٍ أو جليلٍ في هذه الحياة الدنيا، قد أمكن أن يتحقق يومًا دون ما ألمٍ أو عذاب، وحسبُنا أن نرجع إلى التاريخ البشري لكي نتحقق من أن الإنسانية قد اضطرت دائمًا إلى أن تجتاز أقسى التجارب وأصعبَ المِحَن، من أجل الوصول إلى مراحلَ أسمَى من الرقيِّ والتقدم.
الشعراءُ والألم
ومن بين الناس جميعًا، يأتي الشعراءُ في مقدّمة من يحسّون بالألم فيبالغون في تصوّره وتصويره، وينطوون على أنفسهم في عزلةٍ قاتمةٍ، يعزفون فيها أوجع ألحانهم، ويتوجعون فيها بأشجى أنغامهم؛ بل إن منهم من يخلق هذا الألم خلقًا إذا لم يكابده واقعًا؛ وهو ما عبَّر عنه الشاعر السوري "بدوي الجبل حين" قال:
خُلِقَ الشاعرُ والبؤسُ معًا -- فهما خلَّانِ لن يفترقا
ومن العجيب أن صاحب هذا البيتِ نفسَه لم يُعرف عنه يومًا أنه كان حليفَ بؤسٍ، أو شاعرَ ألم، والذين كانوا يعرفونه يقولون إنه شاعر "الرجولة"، كم بعث الرجولة في دماء الجيل كله عزمًا ونارًا، وكم بعث الرجولة في دنيا العرب كلِّها رغابًا وطِماحًا. ولكنها "الفكرة" السائدة أوحت إليه ما كانت توحيه منذ زمن، وما تزال توحيه إلى اليوم، من أن الأديب لا يكون أديبًا حقًّا ولا ينتج أدبًا حقًّا، إلا أن يكون حليفَ بؤسٍ أو ألم، وخِدن شقاءٍ أو تعاسة، وإلَّا أن يعتصره الشقاء اعتصارًا، حتى يريقَ نفسَه على مذبح الألم دموعًا ودماءً، أو يُذهبَها حسَراتٍ وزفَرات!
وهنا يطرح السؤالُ نفسَه: لِمَ يحتاجُ الأديبُ إلى هذا الألم لكي ينشئ ويبدع؟ ولِمَ كانت تجارب البؤس والشقاء ضرورةً للكاتب أو الشاعر من أجل أن يُخصِبَ ويثمر ويفيض خصبًا وإثمارًا؟ ألِأَنَّ إحساسَ الشاعر أو الكاتب لا يهتز إلا للألم، ولا يستجيب إلا لمِطرقة البؤس والحزن؟ أم لِأَنَّ دوافع الألم أقوى من دوافع اللذة، ومِطرقة البؤسِ أشدُّ فعلًا في نفس الأديب من رعشات الهناءة والفرح، أو قشعريرة الغِبطة والألم؟
ألِأَنَّ أدب الدمع أغزرُ ينبوعًا من أدب الابتسام، وصور اليأس أنضرُ جمالًا وأذكى عطرًا من من صور الرجاء؟ أم لأنَّ الحياة بمكانٍ من القُبح، ومنزلةٍ من الشرِّ، بحيث لا يليق بها إلا أدبُ الآلام والأسقام؟ أم لأنَّ الناسَ أحوجُ إلى الأديب الكئيب الباكي منهم إلى الأديب الضاحك، المنطلق المتفائل؟
ضرورةُ الألم
الحق كما يرى الأستاذ "حسين مروة"، في مقاله عن "الأديب والألم" (مجلة الأديب، أكتوبر 1951)، أنه ليس شيءٌ من هذه الأسباب يصلح حُجَّةً لما يرَون من ضرورة الألم للأديب كي يكون أديبًا حقًّا، وكي ينتج أدبًا حقًّا. والأديب، في الواقع، إنسانٌ قبل كلِّ شيء، ولإنسانيته حقٌّ في أن تكون موفورة النصيب من حياة الرفاهة أو الهناءة، بَيْدَ أنه، من بعد هذا، إنسانٌ ممتاز، أو هو، على الأقل، إنسانٌ موهوبٌ بعضَ المزايا؛ فهو يحسُّ الأشياءَ بأسرع، وأدق، وأعمق مما يحسُّها غيرُ الأديب، وينظر إلى الأمور بعين أهدى، وأنفذ، وأشمل مما ينظر إليها الإنسانُ العادي.. فإذا رأى الناسُ الأمرَ من جانبٍ واحدٍ رآه هو من عدة جوانب، وإذا لم يكن للشيء إلا وجه واحدٌ في مستوى الأذهان، كان له في ذهن الأديب وجوهٌ ووجوه.
ولعلَّ القائلين بضرورة الألم للأديب يقصدون أمرًا آخر، وهو أن الأديب يجرِّب الألم في ذاته لكي يدرك آلام الناس، فيحسن تصويرَها، حتى يجدوا أنفسَهم في ذات نفسِه، وحتى يكون أداة إصلاحٍ في مجتمعه، وليس عليه، حينذاك، أن يتألم ويشقَى ويكتئب. وساعتها يكون للألم نفسِه وجهان: الصراع الذي يواجهه المبدع، ويمكث في جزيرته منعزلًا عن العالم، ليستطيع أن يعبّر عن صرخاته المكبوتة في جوانب نفسِه، والأنّات المتزاحمة في ثنايا قلبه، والوجه الآخر، عالم المتلقّين الذين يتمتّعون بقراءة إبدعه المعجون بتربة الآلام، دون أن يدركوا تمامًا حجم المعاناة التي يقاسيها والشدائد التي يَمُرُّ بها.
ويبدو أن لفريقٍ من الشعراء رأيًا آخر في هذا الأمر؛ تلخّصه تلك الأبيات البديعة للشاعر السوري "زهير ميرزا"، من قصيدته "الألم" (مجلة الأديب، سبتمبر، 1944):
أبدًا، منبعُ الخــــلودِ من البؤسِ، وكأسُ الآلام تُحيِي عظامَه
ومن اليأسِ، فاسقني جَرعةَ المُرِّ، فدنيا الآلام، دنيا الوسامه
ما بكى الشاعــــــرُ اللـــــــياليَ إلا كي تغذِّي دموعُه إلهامَه
دمعةٌ فُجِرَت من الصخـــر الصَّلْدِ، ففيها من الصفاءِ علامه
كم يُديرُ الكؤوسَ، يترعُها الشعر نميرًا، وكم يطفِّفُ جــامَه
ثم يسقيه للزمان وفيـــــــه... رغباتٌ، لعلَّ تُطفِي أُوامَه
سكِرَ الدهـــــــــــــرُ سَكرةً من حُمَيَّاه، فأذكَى خلودَه للقيامه!
رأي الأستاذ "أحمد أمين"
وهذا ليس مجرد رأيٍ شعري، يدفع إليه الإحساس ولا يؤكدُه الدليل؛ بل إن له وجاهته التي يؤيّدها الواقع وتثبتُها الشواهد، وإن شئت، كما يقول الأستاذ "أحمد أمين" في مقاله عن "نعمة الألم" (مجلة الرسالة، أبريل 1934)، فتعالَ معي نبحث في عالم الأدب، أليس أكثرُه وخيرُه وليدَ الألم؟ أوَ ليس الغزل الرقيق نتيجةً لألم الهَجر أو الصدِّ أو الفراق؟ ذلك الألمُ الطويل العريض العميق تتخلّله لحظاتٌ قصيرةٌ من وصالٍ لذيذ، وليس هذا الوصال اللذيذ بمنتجٍ أدبًا كالذي ينتجه ألم الفراق، وإن الأديب كلما صهره الحب، وبرَّح به الألم، كان أرقى أدبًا وأصدقَ قولًا، وأشد في نفوس السامعين أثرًا، ولو عشق الأديب فَوُفِّقَ كلَّ التوفيق في عشقه، وأسعفه الحبيبُ دائمًا، ومتّضعَه بما يرغب دائمًا، ووجد كلَّ ما يطلب حاضرًا، لسئم وملَّ، وتبلَّدت نفسُه، وجمدت قريحته، ولم يخلِّف لنا أدبًا ولا شبه أدب، ولو كان مكان مجنون ليلى عاقل لكان كسائر العقلاء، وإنما فضِّل المجنون لأن نفسَه كانت أشدَّ حسًّا وأكثر ألمًا.
ولو شئت لعددت كثيرًا من أدباء العرب والغرب أنطقهم بالأدب حينًا ألمُ الفقر، وحينًا ألم الحب، وحينًا ألم النفي، وحينًا ألم الحنين إلى الأوطان، إلى غير هذا من أنواع الآلام. نعم قد أجدت اللغة على الأدب كثيرًا ـ لقد أنتجت لهو امرئ القيس، وطرَفة، وخمرَ أبي نواس، وفخرَ أبي فراس، ومجون الماجنين، وفكاهة العابثين، وكان غنى ابن المعتز ولذَّته ينبوعًا صافيًا لحسن التشبيهات، وجمال الاستعارات. وخلَّفَت لذة هؤلاء أدبًا ضاحكًا، كما خلَّف الألمُ أدبًا باكيًا. خلَّفَت اللذةُ أب المسلاة (الكوميديا) وخلَّف الألمُ أدب المأساة (التراجيديا) ولكن أيُّ الأدبين أفعلُ في النفس، وأيهما أدلُّ على صدق الحس، وأيهما أنبلُ عاطفةً وأيهما أكرم شعورًا، أيُّ النفسين خير؟ أمَن بكى من رؤية البائسين أم مَن ضحِكَ من رؤية الساخرين؟ أمَن رأى فقيرًا فعطف عليه، أو هُزَأَةً فضحك منه؟
قصيدةُ "الألَم"
وأثبت هنا أبياتًا من قصيدة طريفةً ملؤها الوجع القاتم والحزن الكئيب، كتبها شاعر الشباب السوري "أنور العطار"، وسمّاها "الألم"، ونشرتها له مجلة الرسالة في 27 أبريل 1936، وهي توافق ما ذهب إليه الأستاذ "أحمد أمين"، وإن كان صاحبها، ربما تحت ضغط اللحظة الشعورية، قد غالى في تصوير آلامِه وأسرفَ في التعبير عن أشجانه:
أنا في عـــــزلتي يُطيفُ بيَ الرعـ -- ــبُ فأبكي من طولِ شجوِي وأفرَقْ
تعتريني الهمومُ فالطـــــرف حيرا -- نُ مندًّى مــــن الدمـــــــــوع مؤرَّقْ
وجَناني ولهانُ يُرمضُـــــــه الحــــــــبُّ -- ويذكو به الجــــــــــوَى إن تشوَّقْ
تـــتراءى ليَ الحــــــــياةُ قَـــــتامًا -- ما بها مسربٌ يَبينُ فيُــــــــــــطرَقْ
ويلُــــــوح الوجــــــــودُ قفرًا يبابًا -- عجَّ فــــي ســـــــاحه العفاءُ وأطبقْ
صُـــــــوَرٌ من كآبتي ليس تُمحَى -- أنا منها مشتَّتُ النفسِ مُصــــــــــعَقْ
من شجوني أني أرى الوهمَ يحيا -- ولقد صــــــاغه خــــــــــيالي ونمَّقْ
لي عَـذابُ اثنتين نفسي التي تشـ -- ـقى ونفسي التي أحِــــــــب وأعشقْ
عشت من طول حسرتي أتشكَّى -- مثلما يشتكي الحَـــــــــــمامُ المطوَّقْ
ضاع عمري كما تضيع الينابيـ -- ــعُ وتخــــفَى أمـــــــــواهُهها وتُغلَّقْ
وانطوى مثلما تمرُّ الضـــــبابا -- تُ ويفنى خــــــــيالُها ويُــــــــــمزَّقْ
لستُ أسطيعُ أن أغيِّرَ طبــعي -- يُخلقُ الطبع مُــــــــكرَهًا يــوم تُخلق
أنا قيثارةٌ تنـــــوح على الدهــ -- ــرِ ودمعٌ عــــــــــلى المدَى يترقرقْ
أنا لحـــــنٌ مضـرَّجٌ بالمآسي -- كادت النفسُ مِـــــــــن تشكِّيه تُزهَقْ
هو في الصدر لاعــجٌ يتنزَّى -- وهـــــو في الفكر جــــــــدولٌ يتدفقْ
الأسَى دمعةُ الحنانِ على الأر -- ضِ وكَنزٌ من المــــــــراحِمِ مطلَقْ
تتسامى الأرواحُ فيـه إلى اللــ -- ــهِ وتندَى من الطــــــــيوبِ وتعبَقْ
البلاغاتُ سطـــــعةٌ من سناهُ -- والفصاحـــــات نفحـــــةٌ منه تُنشَقْ
تَسْتحمُّ النفوسُ فيـــه من الإثـْ -- ــمِ وتنقَى من العيــــــــــوبِ وتألَقْ
كلُّ عــــهدٍ لم ينتظمْه مُضاعٌ -- كلُّ وُدٍّ لم يعتـــــمِده مُـــــــــــــفرَّقْ!
"أبو القاسم الشابِّي" والألم
وأذكر وأنا على عتبة الجامعة كنت قد قرأت دراسةً كاشفةً لأستاذنا الدكتور "شوقي ضيف"، رحمة الله عليه، عن "الإحساسِ الحادِّ بالألم في شعر الشابي"، ضمن كتابه "دراسات في الشعر العربي المعاصر"، ذهب فيها إلى أن الذين يُصابون بالمرض مثل "أبي القاسم الشابي" يختلفون؛ فمنهم من يتألم ولكنه يحوِّلُ ألمَه إلى فلسفةٍ في الحياة وإلى تفكيرٍ واسعٍ فيما يلاحقها من نعيمٍ وبؤسٍ وسعادةٍ وشقاء. ومنهم من يعلو على ألمه، بل من يحاول أن يقهره وينتصر عليه حتى النهاية، فتراه ضاحكًا باسمًا، كأنما تحوّل الألم عنده إلى لذة. ومنهم، وهم الكثيرون، من لا يحوّله الألم إلى فيلسوف ومفكرٍ كبير، وأيضًا لا تحوّله العلّةُ إلى ضاحكٍ في الحياة أو مبتسم، وإنما تحوّله إلى لحنٍ ضخمٍ للعويل والبكاء، ونشيدٍ باكٍ يندب فيه نفسه وحياته ندبًا حارًّا. ومن العجيب أن "الشابِّيَّ" الذي قال:
إذا الشعب يـومًا أراد الحياةَ -- فلا بدَّ أن يستجيب القدَر
ولا بدَّ للـــــــــيل أن ينجلي -- ولا بدَّ للقيــــد أن ينكسر
ومن لم يعانقْه شوقُ الحـياةِ -- تبخَّـــر في جوِّها واندثر
والذي قال:
سأعيش رغــــــمَ الدَّاءِ والأعداءِ -- كالنّسرِ فــــوق القمّة الشمَّاءِ
أرنو إلى الشمسِ المضيئةِ هازئًا -- بالسُّحْبِ والأمطار والأنواءِ
لا ألمحُ الظـــلَّ الكئيبَ ولا أرى -- مـــا في قرار الهُوَّة السوداءِ
هو نفسُه الذي قال:
حَطَّمَتْ كَفُّ الأَسَى قِيثارَتي
فِي يَدِ الأَحْلامْ
فَقَضَتْ صمْتاً أَناشيدُ الغَرامْ
بَيْنَ أَزْهارِ الخَريفِ الذَّاوِيَهْ
وتَلاشَتْ في سُكُونِ الإكْتِئَابْ
كَصَدَى الغِرِّيدْ
كُفَّ عَنْ تِلْكَ الأَغاني البَاسِمَهْ
أَيُّها العُصْفُورْ
فَحَيَاتي أَلِفَتْ لَحْنَ الأَسَى
مِنْ زَمَانٍ قدْ تَقَضَّى وعَسَى
أَنْ يُثِيرَ الشَّدْوُ في صَمْتِ الفُؤَادْ
أَنَّةَ الأَوْتَارْ
لا تُغَنِّينِي أَغَاريدَ الصَّبَاحْ
بُلْبُلَ الأَفْراحْ
فَفُؤادِي وهوَ مَغْمُورُ الجِرَاحْ
بتَبَارِيحِ الحَيَاةِ البَاكِيَهْ
لَيْسَ تَسْتَهْويهِ أَلْحَانُ السُّرُورْ
وأَغَاني النُّورْ
إنَّ مَنْ أَصْغَى إلى صَوْتِ المَنُونْ
وصَدَى الأَجْداثْ
لَيْسَ تَسْتَهْويهِ أَلْحانُ الطُّيُورْ
بَيْنَ أَزْهارِ الرَّبيعِ السَّاحِرَهْ
وِابْتِسامَاتِ الحَيَاةِ السَّافِرَهْ
عَنْ جَلاَلِ اللهْ
غَنِّنِي يا صاحِ أَنَّاتِ الجَحِيمْ
واسْقِنِي الآلامْ
أَتْرِعِ الكَأْسَ بأَوْجَاعِ الهُمُومْ
واسْقِنِي إنِّي كَرِهْتُ الابْتِسَامْ
غَنِّنِي نَدْبَ الأَمَانِي الخَائِبَهْ
واللَّيالِي السُّودْ
غَنِّنِي صَوْتَ الظَّلامِ المُكْتَئِبْ
إنَّنِي أَهْواهْ
هَاكَ كَأْسَ القَلْبِ فَامْلأْهَا نُوَاحْ
واسْكُبِ الحُزْنَ بِها حتَّى الصَّبَاحْ
إنَّها من طِينَةِ الحُزْنِ المَرِيرْ
صَاغَهَا الخَلاّقْ
بِئْسَتِ الأَفْراحُ أَفْراحُ الحَيَاهْ
إنَّها أَحْلاَمْ
وتفسير ذلك في رأيي، حسب ما فصَّلتُه في دراسة لي عن "النقد السياقي"، أن لكل قصيدة سياقها، النفسي أو الاجتماعي أو التاريخي، والشاعر في النهاية إنسانٌ مبدع، يحسُّ شيئًا فيكتب شيئًا، وهو في كلِّ الأحوال لا يناقضُ نفسَه، ولا يكذب قومَه، وقد حدث لي أنا شخصيًّا شيءٌ من هذا، ففي الوقت الذي قلت فيه:
نَبِّئْ بما يَنْـهشُ الأحـــشاءَ يـا قَلَمِي -- وصِــفْ حـقـيـقةَ ما ألقَـى من الألمِ
أَرِحْ فـــؤادَ الـذي جَلَّت مواجـــعُــهُ -- وبُـــحْ بِسِـــرِّ عذابي واحتراقِ دمي
" ما لا يُقالُ " الذي قد عِشْتُ أكتُمُهُ -- عـــــن الأنــــام أثارَ النارَ مِلْءَ فَمـي
أضاعَ عمري ضـــلالاً وانتهتْ عـبثـاً -- حكايتي فيــــــــه أسفاراً من النـدمِ
وصِــرت من حَــيْرتي درباً بلا أمــل -- وكأنني جُثَّـــــــة تسعى بلا قــــــدم
وأقـول: يا ليتني ما كنتُ مُذْ كُتِبَتْ -- في اللوح أقدارُنا وظلِلْتُ في الـعدمِ!!
قلت في قصيدةٍ أخرى:
لا تبتئس... أنتَ الذي تَهَبُ الحــــياةَ حــياتَها
بيـــديكَ تملكُ أمـــرَها: دورانَـــــها وثبـــاتَـــها
إياك تَبخَس قــــدرَ نفسِك يا رفيـقي في الكــفاح
فبدون سعيك في الصباح تموت أحـلامُ الصباح
قم واكتشف طـاقات ذاتِكَ.. إن ذاتَــك معجـزة
أنت المكلَّــفُ بالمُحــــال.. وقـــادرٌ أن تُنجـــزَه
لا تستهن وتــــقلْ لنفسِـكَ: لستُ إلا واحـــــدا
فأبــــوك آدمُ فــي البداية كان فـــرداً واحـــــدا
سيجيء بعدك ألفُ جـــــــيلٍ مثل من كانوا هنا
وتظــــلُّ وحـــدك كائناً فــذاً... فلســتَ الهيِّنا
قد يشبهونك في الملامحِ والخـــلائق والصفات
وتــظــلُّ أنت نسيــجَ وَحـــدِكَ بين كلِّ الكائنات
كن في الوجودِ أخا الوجودِ وعش حياتَك مبصرا
لا حــــائراً أعـــمى ولا عبـــدَ الــقيـــودِ مسيَّــرا
دع عنك خـــوفَ العاجزين وحَـــيْرةَ المتلجلــجِ
وانشر شِــراعَك في العُباب وخذ طريقَك وانهَجِ
طهِّر عزيمتَك القويـــةَ من مخــــاوف عُــــزلتِك
واخــرج إلى الــدنيا وأسمِعها ملاحــمَ قصَّــــتِك
سِــــر مطمئناً... لا تَخَــف مما يُـــخَبِّئُـه الغــــدُ
إن الغــــدَ الآتــي بعيــــــدٌ... والمخاوفُ أبْعـــدُ
دع ما يُسطَّرُ فـــــي الغيوبِ لأمر عـلّام الغيوب
إن الغيوبَ رحيمةٌ جــــــــداً.. ويومُكَ لا يؤوب
من صُنــع أوهــــامِ الفتى ما قـــد يـــكابدُه الفتى
فَعِشِ الحياةَ ولا تخـــف ممـا مضى أو مــا أتــى
واعــلم يقيــنًا أن دَورَكَ ليــس يُحسِنُه سِــــواك
فإذا رحلتَ عن الوجـود إلى مَدى فاترك شذاك!
وليس في الأمر تناقضٌ كما يبدو، وليس من هاتين القصيدتين شخصين مختلفين؛ فأنا الذي كتبت كلتيهما، وأنا أدرَى الناسِ بما صاحبهما من أحوال، وما كان وراءهما من دوافع، وكلُّ ما حدث أنني كنت في الأولى حزينًا مكتئبًا، بل يائسًا مختنفًا، تحطّمَت آمالي، وأتت رياح القدر بغير ما كنت أشتهي، فأحسست بأن عمري قد ضاع سُدى، ولا أمل ولا نجاة!
ولأن هذه الأحاسيس، وإن كانت صادقة، لا يمكن أن تظل مسيطرة على النفس، ولأن الحياة لا تمضي على حالة واحدة من الهناء أو الشقاء، فإنني لم أستسلم لها، رغم أنني عبّرت عنها كثيرًا بما يُوجع ويُبكي، وكنت أجد في ذلك متعةً وخلاصًا في الوقت نفسِه، وتجاوزتها حتى لا أستغرق فيها فتغرقني، ورأيت أن الحياة لا تستقيم للضعفاء اليائسين، وأن الآمال العظيمة لا يحققها إلا الأقوياء أولو العزم والطموح، ولذلك كتبت القصيدة الثانية.
وعندي من شعري أمثلةٌ كثيرةٌ أخرى، لم يفهمهما كثيرون ممن يقرؤون كلامي، منها قصيدتي "حديثُ الدموع":
دموعي.. كيف أخجلُ من دموعي -- وحـــزني هـــــا هنــا شيءٌ طبيعي
فحُلمي ضائعُ فــــــــي ليـــل بؤسي -- وما أدراكَ بالحُـــــــــــــلمٍ المَضِيعِ
حـــــــــــياتي بعثرَتها الريــحُ حتى -- تلاشــــــت كاختناقــــات الشــموعِ
ودربي فــــي دياجي الهَـولِ وحشٌ -- مخيفٌ... والذَّهابُ بلا رجـــــوعِ
وشــــدوي فــي الأصـائل والليالي -- تبدَّدَ... مثل حــشرجة الصـــريعِ
وعمري دوحــــــــةٌ تذوِي وتَهوِي -- ليصبح كالخريف... بلا ربيــــــعِ
ويسحـــــق روضِـيَ الآسِـي ذبولٌ -- تمشَّى في الجــــذورِ إلـــى الفروعِ
يلاحقُني الأسَــــى صحـوًا ونــومًا -- وليس لعاجـــــــزٍ غيرُ الخـــضوعِ
وصرتُ كواحدٍ... أو قُل كصِفرٍ -- تغيَّبَ في ازدحــــــامات الجـــموع
بلا طعمٍ بقائي... وانتهــــائـــي -- فظيعٌ... بــل وأكثرُ من فـــظيعِ
وأذرِفُ دمعتي لـــــــرثاء نفـسي -- لعلَّ الأُنسَ فــــــي سَفْحِ الدُّمــــــوعِ!
والتي قلتُ بعدها:
آمِــن بنفسكَ؛ أنت تقـــدرُ أن تكــونَ كمــا تشاءْ
حطم قيودك: قُـــم وحلِّق في مـدارات الفضـــاءْ
لا تشْكُ مــــن آلام عيشك أو تَـــقُــــل: يا للشقاءْ
فالمبكيات إلـــــــى فــــناءٍ والهموم إلــــى انتهاء
والسُّحْبُ فــوقك مثقلاتٌ ســـابحاتٌ بالرجــــــاء
لولا انتظارُ الغيث لانصــرفت وضاقت بالسماءْ
أتظن أنك حين تدعو ســـوف تنصـــرك السماءْ؟
أتظن أن الله دومـــاً ســــوف يفعل مـــــا تــشاءْ؟
أكذا.. وأنت بجوف دارك.. لا كفاح ولا شقاءْ؟
يا صاحبي.. أخطأت جـدًّا كلَّ أسباب الدعـــاءْ!
وقلتُ أيضًا:
إن في الأرضِ مــا تريدُ من الأرضِ -- فهيَّا... وهاتِ حَــــبلاً وفأسا
وخُـــذ الأمرَ مــأخذَ الجَـــدِّ واطــرَح -- هَــمَّ دنياكَ... وانسَ عجـــزاً ويأسا
وحــده القاعدُ الضعيفُ أخــو الهُونِ -- مَـــــن يُجَـــــــرَّعُ الــــــــذُّلَّ كأســا
فَثِبِ الآن فـــــوق هــــــام الثُّــريَّـــا -- إنما العاجــــزُ الذي ســـــوف يأسَى
لا تعيشنَّ خـــاملَ الذِّكـــــــرِ ذَيـــلاً -- كُـن من الآنَ فـي الحـــوادثِ رأسا
لا تُعينُ السماءُ غـــــيرَ أولِي العزمِ -- ومَـن صـــــــارَعَ الشــــــدائدَ بأسـا!
ولقد كان رائدي في تحدّي الألمِ والتغلب عليه، كلمات مضيئات من النثر الفنيِّ البديع، قرأتها ذات يوم في مقال "حين يصهرك الألم" للدكتور "شكري فيصل" (مجلة الأديب، سبتمبر، 1945)، قال في بعضها: "حين تصهرك الآلام، يا صديقي، وتنال منك هذا المنال القاسي، وتتلظَّى، أنت، في كآبتها المحرقة، وتتلوَّى في بركانها المشبوب، فاحذر أن تغمض عينيك على الدمعة الشاكية، وأن تعضّ شفتيك على الآهة الباكية، وأن تنبض أعماقُك بالزّفرة النادبة؛ فما كان للألم أن يحرق، وإنما هو يطهِّر، وما كان لكآبة الأحزان أن تُبكِي، وإنما هي تثير. وما كان لها أن تنلَ من الإنسان القوي، وإنما هي توقظ فيه هذه المشاعر التي كادت تخفتها أوضارُ المادة، وتهزّ فيه هذه الأحاسيس التي كادت تذهب بها مواضعات الحياة، وتنبّه منه دنياه الكبرى لتقو له إنه ينطوي على العالم الأكبر...
حين تستشعر، يا صديقي، أن الألم إذ يهزّك إنما يهزّك هزّة الرضى، ويستثيرك استثارة الوُدّ، ويكويك كَيَّ الطبيب، وينال منك ما ينالُ الكِيرُ من الحديد، يطرح غشه، وينفي صدأَه، ويستصفي جوهره، ويفعل بك ما تفعل المِطرقة بالمعدن، تهذِّبه وتسوِّيه، وتصقله وتكوِّنُه.. حين تستشعر ذلك بالرضى والوُدّ، فأنت إنسانٌ، يا صديقي، يشعر ويذوق ويستمتع، ويحسُّ الحياة الإحساسَ الواضح، ويراها الرؤية التي يكشفها الله لعباده المصطفَينَ الأخيار.
... من هذه الآلام التي يتبرّم بها هؤلاء الناس الذين لم يتذوّقوا دنياهم، صاغ الشعراء، يا صديقي، أروعَ أناشيدِهم، وألَّف المغنُّون أبرع ألحانهم. وفي مِداد الآلام غمس الكُتَّابُ أقلامَهم ليكتبوا أجمل فصولهم وأكرم آثارهم. ومن أصباغ هذه الآلام استقى المصوّرون لوحاتهم ومخلفاتهم، وعلى هدهدتها رسم المهندسون، وبنَى البنَّاؤون، وصاغ الصائغون. وفي غمار الآلام التي لا تعرف كيف تصبر، والتي خاضها العلماء والرواد والمكتشفون نبتت هذه المدنيَّةُ يا صديقي.. فحذارِ.. حذارِ أن أسمعكَ تشكو آلامَكَ شكاةَ الضعيف.. لأني أريدُك رجلًا".
ولعلَّ قصيدة "سيمفونية الألم" للشاعر العراقي "حارث طه الراوي" (مجلة البيان الكويتية، أكتوبر 1988)، خيرُ ترجمان عمليٍّ لهذه الوصية الرائعة:
من أيِّ جُــــــرحٍ بهــــــذا القلبِ تنتقمُ؟ -- كفاك تنكأ جـــــمرًا أيُّــــــــها الألمُ
مدجَّجًا أنت يا هَمِّي تُــــهاجـــــــــمُني -- فلا أفـــــــرُّ، ومثلي كــــيف ينهزمُ؟!
فاضرب بأمضَى سيوفِ الدهرِ منتقمًا -- فكلُّ سيفٍ بصخـــــري سوف ينثلِمُ
أنا التَّجَــــــــــلُّدُ فــــــــي أقصى تأجُّجِهِ -- أنا الخــــــــلود، ألَا فليخسَأِ العدَمُ
أنا الذي صـــــــارع الآلام عـــــــــاتيةً -- فما استكان، ومــــــا زلَّت به قدَمُ
إن التحَــــــــــدي ـ وإن آذَى ـ يحفِّزُني -- نحو الوثوبِ ومثلي قصـــدُه القمَمُ
أقسمت أن أتحـــــــــدَّى كلَّ جـــــائحةٍ -- بوثبة الليــــثِ، فلْينعَمْ بِــــيَ القسَمُ
وأن أسير وعــــــزمي لا يفارقــــــني -- إن خار عزمٌ وأبدَت ضعفها الهِمَمُ
أطلقتُ صبري على الأرزاء فارتعدَت -- من غضبةِ الليثِ إذ يخـطو ويحتدمُ
وقد سبق "المتنبي" العظيم إلى هذا المعنى وزاد عليه، حين صاغه على طريقته العبقرية، فقال:
سُبحانَ خالقِ نفسي كيف لذَّتُها -- فيما النفوسُ تـــــراه غــايةَ الألَمِ
الدهرُ يَعجبُ من حَملِي نوائبَه -- وصبرِ نفسي على أحداثِهِ الحُطُمِ!
وللقارئ الكريم أصدق أمنياتي بحياة ليس فيها أوجاعٌ ولا آلامٌ، وأن يرزقَني وإياه العفوَ والعافية وحُسنَ الختام!

د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات العربية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر)
"آلامُنا هي أطفالُ معانينا".. قراءة في أوجاع الكتابة العربية
مما لا شك فيه أن للكتابة الأدبية الجادة آلامها وأوجاعها التي تترك بصمتها على هذه الكتابة فتشف عن هذه الآلام وتنضح بتلك الأوجاع، فتطهّر الكاتب وتؤثّر بدورها في القارئ الذي يعاني ما يعانيه الكاتب فيشاركه آلامه وأوجاعه، فيستريح هو الآخر إذ يجد من يحسن التعبير عن همومه وآلامه وأوجاعه، ويمهّد له سبيل الآمال المرجوة والأحلام المنشودة.
ولعل أصدق ألوان الأدب هو شعر الرثاء لأنه يدل على التفجّع والحزن واحتراق الأكباد على المرثي، ولهذا جاد هذا اللون من الشعر عند النساء ودونك "الخنساء" التي امتلأ ديوانها بشعر الرثاء حتى اشتهرت به، وقد بكت أخاها "صخرا" بكاءً مريرا لِما كان يتمتع به من أخلاق كريمة وفروسية وكرم ونجدة، حتى إنها جعلت منه مثالا يُحتذى حين قالت:
وإنّ صَخراً لَتَأتَمّ الهُداة بِهِ -- كَأنّهُ عَلَمٌ في رأسِهِ نارُ
وكادت "الخنساء" تقتل نفسها حزنا على أخيها لولا كثرة الباكيات على إخوانهن، وإن كنّ لا يبكين مثل أخيها ولكنها أخذت تعزي النفس عنه بالتأسّي، تقول الخنساء:
ولولا كثرة الباكين حولي -- على إخوانهم لقتلت نفسي
وما بكين مثل أخي ولكن -- أعزي النفس عنه بالتأسي
وظل الرثاء على هذا النحو من الصدق على مرّ العصور سواء كان رثاءً للقادة والعظماء أو رثاءً للأهل والأقارب أو رثاءً للمدن والممالك الزائلة كما في الأندلس قديما وكما في فلسطين حديثا.
وهناك كُتّاب وشعراء أجادوا التعبير عن هذا الألم في الكتابة وأبرزهم المنفلوطي والرافعي، ولعل هذا الألم عندهما ناشئ عن حسّهما المُرهف وتعبيرهما عن المشاعر الإنسانية والآلام البشرية سواء في المصائب التي تصيب البشر أو في تصوير المشاعر في الحب وما يعترضه من عقبات وما يحول بين المُحبّين، وهو ما صوّره قبلهما "ابن حزم الأندلسي" في رسالته الرائدة "طوق الحمامة في الألفة والألّاف"، وما صوّره "ابن زيدون" في تسجيل قصته مع "ولادة بنت المستكفي"، بعد حدوث الجفاء بينهما بفعل الوشايات من الحساد.
وقد صوّر الشعراء السُّجناء آلامهم في سجنهم تصويرا بديعا، كما فعل "المعتمد بن عباد" في سجنه بـ "أغمات" في المغرب، حيث يقول مقارنا بين حاله وحال أسرته قبل محنة الأسر وبعدها:
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا -- فساءك العيد في أغمات مأسورا
ترى بناتك في الأطمار جائعة -- يغزلن للناس ما يملكن قطميرا
برزن نحوك للتسليم خاشعة -- أبصارهن حسيرات مكاسيرا
يطأن في الطين والأقدام حافية -- كأنها لم تطأ مسكا وكافورا
ولا شك أن كثيرا من الأدباء والشعراء يعانون وجع الكتابة، كما أن بعضهم يعانون الوجع بعد الكتابة، حينما لا يرضون عمّا نشروه فيتمنون لو أنه كان بوسعهم أنْ يجمعوه من بين أيدي الناس، ويعيدوا كتابته من جديد؟
وأنا واحد من هؤلاء الشعراء والكتاب، فكثيرا ما أكتب من وحي المعاناة الشخصية أو الجمعية، وأحيانا بل كثيرا ما لا أرضى عن شعري أو مقالاتي.
يتألم الإنسان وذلك قدرٌ محتومٌ، لأن الله عزّ وجلّ خلقه في الدنيا ليعيش المتناقضات، فيحزن ليفرح، ويتألّم ليأمل، ويخاف ليأمن، ويموت ليحيا، تلك هي معادلات الوجود والفناء، لن يستطيع بشرٌ القفز على هذه المعطيات لأنه في الأصل قاصرٌ عن تغيير المشهد، إذ كيف يغير وهو المجبول على فعل هذا أو ذاك ليس لديه خيار آخر غير الحياة أو الموت، فإما أن يحيا عزيزا رغم الألم وإما أن يموت ذليلا وقد غمّه الألم.
فالألم محبوبٌ وإن كان مكروها، يقول الله تعالى: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ"، ليست فلسفة ولكنه مكرمة من عند الله رب العالمين الذي خلق كل شيء بقدر، فالحقنة مثلا مؤلمة في ظاهرها لأنها تخزّ الجسم وتؤلمه، ولكنها نافعة جدا للجسد الواهن الذي يبحث عن خلايا جديدة تجدّد مناعته أو تحسِّنها، ولا يبدو أنها تتحسن إلا بالألم، ليبقى الألم عنوان الانتصار على النفس الموهومة بالكبرياء والفوز.
يشهد التاريخ على صحة هذه النظرية الفطرية في الإنسان ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك قيل إن الإبداع يكون دليلا على أن صاحبه تجرّع الألم صغُر أم كبر، فرحم الإبداع لا يقبل جنينًا مشوّهًا، ولا يستقبل إلا نطفة مؤلمة تبحث عن بويضة تشاطرها الرأي ليتم التلاقح ويحصل الإبداع، ويظهر الجنين المتألّم ولولا ألمه لما بكى.
كل من لا يتألم لا يبدع، وإن أبدع بدون ألم يكون إبداعه مبتورا منقوصا لا متعة فيه، ومن لم يتلذذ بالألم لا يشعر بمتعة الإبداع، ومن لم يذق مرارة الألم لا يشعر بالسعادة.
يقول "كافكا": "أنا أتألّمُ بينما أنتم تَمدحونَ كتاباتي"، وتُعطينا هذه العبارة مَلمَحًا مُهمًّا في تفسيرِ وفهمِ جدليّةِ الألمِ والإبداع كما يراها "كافكا"، فتُشيرُ العبارة إلى وجودِ علاقة تربطُ الألمَ والمعاناة بالمنتج الإبداعي وجمالياته، يقولُ فيما القارئ مُنغمس في استشعارِ جماليات المُنتج الإبداعي الأدبي، لا تظهرُ إليه بصورةٍ واضحة أن هذا الخلق الإبداعي الجديد، هو نتاج بناء هرمي من المعاناةِ والآلام التي تراكمت داخل المبدع وصولاً إلى لحظةِ تجلّي المُنتج الإبداعي بمواصفاتِهِ الجماليّة كونه في نهايةِ المطاف فن.
إذًا فالعمليّة الإبداعيّة كما يرى "كافكا"، مسار تَخلقهُ معاناة مُتّصلة، يُعاد تشكيلها ضمن ديناميكات مختلفة وصياغتها في معالجاتٍ موضوعيّةٍ جديدة، ومما لا شك فيه أن فعل الإبداع ينطوي على إعادة تقديم لما هو مألوف بصيغٍ أو طرقٍ غير مألوفة كما يرى "طارق سويدان" وفي هذا التقديم للإبداع التقاطة ذكيّة لفهم أن ثمة تحوّل لإعادة صياغة الأشياء والمعاناة واحدة منها ضمن سياقات جديدة.
والناظر إلى الأدبِ الفلسطيني المُتشكل إبان نكسة حزيران/ جوان 67 بسردِهِ وشِعرهِ، يُمكِنهُ التأكد من حقيقةِ أن معظمَ ما تم إنتاجه كان انعكاساً لقضايا المجتمع، قضايا التحرر والمقاومة والاستقلال وغيرها من القضايا الكُبرى بما تم الاتفاق على تسميتِه بـ "الأدب المُلتزم". ومن يطالع المجموعة الشعرية "آخر الليل" لمحمود درويش و" أشد على أياديكم" و"ادفنوا موتاكم وانهضوا" و"أغنيات الثورة والغضب" لدى توفيق زيّاد، بالإضافة إلى "دمي على كفي" و"سقوط الأقنعة" لسميح القاسم، "وكراسة فلسطين" و"قصائد على زجاج النوافذ" لمعين بسيسو، يُمكنهُ ملاحظة سمة التقريريّة والخطابيّة الغالبة على معظمِ هذا النتاج الشِعري، وهو طبيعي ومُبرّر في سياق الوظيفة الاجتماعيّة الواقعيّة للأدب، والتي هي في سياق شعب تحت الاحتلال يجبُ أن تكونَ وظيفةٌ تحريضيّة، وهنا يتضاءل حضور الذات الفرديّة المُبدعة إلى حدِّ إنكارها بوصفها ذاتا مُستقلة والتركيز على كونِها ذاتا مُنخرطة تماماً بِمجتمعها، لكن أينَ ذهبت هذه النتاجات الآن وكيف يتم النظر إليها؟ إنه يتم استحضار هذه النتاجات الإبداعية اليوم في سياقِ التأريخ والتوثيق والاستدلال على الحدثِ التاريخي.
والألم هو الدافع الحقيقي للإبداع والعامل المشترك في حياة الموهوبين، والألم مصدر الإلهام والخيال، بإمكانه تحويل الموهبة إلى طاقة كبرى تحرك الأفكار، وقوة عُليا تستقطب الأحاسيس، لتنثر بين أيادي البشر في النهاية أرقى القصص وأروع الأشعار.
والألم بما يفعله بالجسد والروح من أفاعيل يؤدّي إلى خلق نوع من النقص في نفسية الموهوب، فيحاول قهر الألم وتفجير الأوجاع بالتحليق في سماوات واسعة وتوظيف قدراته الخاصة بطريقة فنية تستوعب الحزن وتجسّد المعاناة، فينزف القلم المحروم، ويبحث القلب المكلوم عن الملاذ الآمن والفضاء الرحب حتى يفرغ ما يدور بذاته من هموم وعذابات.
والنتيجةُ روائعٌ تحارب الاضطهاد وتتشبّث بالحياة، وإبداعاتٌ تحاول إثبات وجود المحرومين في هذا العالم، وملاحم تعصر تجارب الكادحين، وأعمال ترسم زفرات المغيبين وأنات المتشردين.
وليس كل إنسان تخضّبت حياته بالآلام بمقدوره صُنع الإبداع، لأن الأمر يتعلق بصاحب الموهبة وصاحب الملكات الفطرية الغائرة في النفس، ولكن حينما تصطدم حياة الموهوب بالآلام والظروف القاهرة كالمرض، والفراق، والفقر، والقهر، والظلم، عندئذ يصبح الألم هو الوقود الذي يلهب المشاعر والنيران التي تشعل الأحاسيس حتى تصل بصاحبها إلى ذروة الإبداع وقمة التميز، وهذا معناه إن الإبداع يولد ويترعرع في رحم المعاناة، وإن المبدع يسعى بكل ما أوتي من قوة لتكوين العمل الإبداعي في حين تتمزق روحه بين أنياب الفاقة وذل الحياة.
ومن ناحية أخرى، فإن الألم يحمل وجهين لعملة واحدة، فهو البلاء الذي يواجهه المبدع بمزيد من الصبر والتضحية والغرق في عوالم الكتابة ليستطيع التعبير عن الصرخات المكبوتة والأنّات المتزاحمة في ثنايا القلوب، وهو أيضا عالم جميل وممتع للمتلقّين والقرّاء الذين يتلذّذون بمشاهدة الجمال وقراءة الإبداع المعجون بتربة الآلام والصادر من ركام الجروح، بل يقابلون المبدع بنظرات الإعجاب وكلمات الإطراء دون أن يدركون حجم معاناته.
فالألم في حياة المبدع ليس فقط أحاسيس عابرة وذكريات أليمة، وإنما الألم هو ثقافة وفكر وخيال واختزال لمآسي البشر ومحفّز للبحث عن النور في ظلمة الأيام والمسؤول الأول عن ولادة الإبداع.
وعن الألم والإبداع كتبت "فاطمة المزروعي" في مجلة "البيان" الإماراتية إن "الحياة ليست كلها سعيدة ولا حزينة قد تمرّ علينا ساعات نشعر فيها بمشاعر الإحباط والحزن والاكتئاب، المبدع الحقيقي يعرف كيف يستفيد من عثراته وآلامه ويحول المصائب والمصاعب في حياته إلى دروس يمكنه الاستفادة منها وخير دليل على ذلك ما نراه من المصاعب التي قد تمرّ على العلماء والمخترعين والرفض التام لمخترعاتهم في بدايتها ثم عزمهم وإصرارهم على استكمال الطريق، وإيمانهم أن الألم ليس إلا طريقاً للإبداع والإنتاج، فيستفيدون من أحزانهم وفترات هبوطهم ويأسهم، فيأخذون منها العبرة والدافع والطاقة ليعودوا لاستكمال أهدافهم المثمرة، ذلك الألم ربما يكون نفسياً أو جسدياً، ولكنه قد يفجر الإبداع والابتكار، والكثير من المبدعين اختاروا لحظة الألم ليصنعوا منها مجدهم ونجاحهم، وكلنا نؤمن أنه لولا تضحيات الكثير من العلماء وصمودهم أمام التعصب للجهل لما تقدّمت البشرية في مجالاتٍ كالطب والاقتصاد والمجتمع وغيرها."
ويقول "أحمد أمين" عن نعمة الألم: "إن الأديب كلما صهره الحب، وبرّح به الألم، كان أرقى أدباً وأصدق قولاً، وأشد في نفوس السامعين أثراً". لذلك فإن الكثير من المبدعين قد عانوا في طفولتهم من شظف العيش ونشأوا في ظروف صعبة، ولكنهم برزوا كمبدعين حقيقيين، وكان إبداعهم وسيلة للنجاح والتميز والابتكار.
والأمثلة على ذلك كثيرة من حياة أدبائنا الكبار مثل طه حسين والعقاد والرافعي والمازني.
ويرى "فريدريك نيتشه" أن المتعة والألم مرتبطان معًا بقوة، ومن يُرد أكبر كمية ممكنة من المتعة فعليه أن يقبل بكميةٍ تُساويها من الألم، حيث يعتقد أن لكل إنسانٍ مُطلقَ الاختيار، إما أن يختار أقلّ قدر ممكن من المعاناة وبالتالي يستغني عن قدر من النضوج وتحقيق الذات، أو يختار احتضان معاناته بأكبرِ قَدرٍ ممكن، وبالتالي لا يحصل فقط على كمية أكبر من النضج وتحقيق الذات، وإنما على سعادةٍ خفية نادرًا ما يشعر بها من استنكر معاناته. يقول "نيتشه": "إذا قررت تقليل درجة الألم البشري فأنت أيضًا تقلل قدرة البشر على الشعور بالمتعة والسعادة". ويوافقه في هذه الرؤية النفسية أيضًا "فرويد"، الذي يرى أن السعادةَ والحزن وجهانِ لعملةٍ واحدة، فـ "الأنا" الفرويدية تلجأ إلى تحمُّلِ الحزن، والقبول بذلك قبولًا مؤقتًا بغية حدوث الإشباع في النهاية، والوصول إلى مراد تحقيق السعادة عبر إشباعِ غَرائزِ البشر.
لكن الميراث العربي، والرؤية العربية للحُزن ترى غير ذلك، من حيث وظيفة الحزن، فهي تنظر إليه بوصفه قدرًا محتومًا على الذات البشرية، سواءٌ أكانت هذه الذات خاطئة وتستحق العقاب من الله بمنظور ديني يجعل الحزن عقوبة من أخطاء البشر تلحق بالنفس البشرية، والحل الوحيد هو الصبر عليه، والرضا بقضاء الله وقدره، واللجوء للدعاء والتوبة وفعل الخيرات. هذا المنظور الذي يناقض تمامًا منظور "فرويد" أو "نيتشه" بحيث لا يصبح الجنون مرضًا بقدر ما هو الشفاء الوحيد للخروج من حالة الحزن المقيمة والمفروضة على بني البشر، حتى صار المثل يقول: "مع كل فرحةٍ ترحة"، وصارت المقولة المشهورة التي يرددها العامة مع كل فرحة أو ضحك: "اللهم اجعله خيراً"، تمهيدًا لما سيأتي من حُزنٍ وتَعاسة بعد الضحك!
ويرى "ألفريد دي موسيه" أنه "لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم"، وهذا يعني المعاناة الخالدة أو الإبداع في حضرة الألم. ويقول "المتنبي":
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله -- وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
وقد كانت العرب على حق حين قالت "كل ذي عاهة جبار" وهو قول علمي أكثر منه أدبي مضمونه جمَع بين الفلسفة والعلم، وفي أدبنا العربي قديمه وحديثه مبدعون كبار ينسحب عليهم هذا القول وذلك التحليل، وهناك رسالة دكتوراه شاركت في الإشراف عليها مع زميلي الأستاذ الدكتور "محمود الفوي"، ونوقشت أمس بعنوان "ملامح الانكسار في نتاج شعراء الجاهلية"، أعدّها الباحث الجاد "عبد الله متولي عبد العليم عبده"، عرض فيها لمعاناة ثلاثة من شعراء العصر الجاهلي هم امرؤ القيس وعنترة بن شداد وعامر بن الطفيل، وانعكاس هذه المعاناة على إبداعهم الشعري، ومن القدر العجيب أن الباحث يعاني من ضعف البصر، مما جعله يتحدّى هذه المعاناة ويواصل دراساته العليا حتى يحصل على الدكتوراه في الأدب العربي من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، بينما اكتفى كثير من زملائه المبصرين بدرجة الليسانس.
والعجيب في أدبائنا الشعراء والكُتاّب المتألّمين أنهم كانوا كالشُّهب في سماء الخلق الفني أضاءوا إضاءات سريعة واختفوا عن الوجود لم يثبتوا ثبات النجوم حتى لَيملّها الرائي، فقد كانت حياتهم قصيرة وكان الألم والنشيج والأنين حجر الزاوية فيها، وأشد ما يلفت في الشهاب سرعة حركته واندفاعه في السماء وشدة ضيائه الذي يكاد يخطف الأبصار ويكسف ما حوله من نجوم عتيقة. وكذلك كانت حياة هذا النفر من الأدباء ولعل شاعرنا الصداح "فوزي المعلوف" (1899/ 1930) خير من يمثل هذه الفئة وهو إن لم يصبه الداء العياء في صدر شبابه، بل كان مثالا للصناعي الناجح في البرازيل والغني المتألق الوسيم، ولكن معاناته كانت نفسية وجودية رأت الحياة بمنظار "أبي العلاء"، وتشرّبت معاني "رباعيات الخيام" فبدا لها الوجود غفوة والموت صحوة والمال والبنون والصحة والوسامة مظاهر خداعة تتستر على هاوية العدم وقاع الفناء، وعانى هذا الشاعر من النفاق والرياء والكذب والغرور والحسد تلك الصفات المميزة للإنسانية في ملمحها العام، اسمعه يقول:
من يمت ألف مرة كل يــــــوم -- وهو حي يستهون الموت مره
تعب كلها الحياة وهـــــــــــــــذا -- كـل مـا قال فيلسوف المــــعره
وقد نفذ الشاعر إلى لباب الوجود، فإذا هو الزوال والفناء:
نـظرت وردة إلـي وقـالت -- أنت مثلي في الكون للكون كاره
ويـح نفسي مـن الربيع ففيــه -- أجتـنى بـين آسـه وبـهـاره
ومن الصيف فهو يحرق أكمامي -- علـى رغـمها بـلفحة نــاره
والـنسيم البـليل هو إلا -- قـاتلي بـين وصـله ونفاره؟
يتصابـى حـتى أســلمه نفسي -- فـيجفو والـعطر مــلء إزاره
وكان آخر ما نظم هذا الشاعر قوله:
مرحبا بالعذاب يلتهم العيـ -- ـن التهاما وينهش القلب نهشا
مشبعا نهمة إلى الدم حرى -- ناقعا غلة إلى الدم عطــــشى
وقد خاطب قلمه أجمل خطاب فقال:
يا يراعي ما زلت خير صديق -- لي منذ امتزجت بي وستبقى
باسما من سعادتي حين أهنا -- باكيا من تعاستي حين أشقى
وأما الشاعر اللبناني الآخر "إلياس أبو شبكة" (1903 - 1947)، "بودلير الشرق"، هذا الشاعر الذي أبدع في وصف الغواية، وتتبع العورة والسّقطة، فقد كان الألم دافعه في الإبداع وحاديه في الكتابة، يقول:
من لم يذق في الخبز طعم الألم -- ولـم يـنكر وجـنتيه الســــــــقم
من لـم يغـمس في هواه دمـــه -- من يمنع الأهـوال أن تطعمــــه
من ليس يـرقى ذروة الجلجـــــله -- ولم يسمر في الهوى أنمـــــله
لن يعرف الـعمر شعاع الإله -- ولـن يــــــــرى أمـاله في رؤاه
وقد عانى ألما جسديا ونفسيا معا عجّلا به إلى هاوية العدم وما أجمل قوله:
إن الشقا سلم إلى السما -- فعدن ميراث لمن تألما
وأجمل منه هذا المقطع الظاهر فيه التأثر بالرومنطيقية الفرنسية الحزينة:
اجرح القلب واسق شعرك منه -- فـدم القـلب خمرة الأقلام
وإذا أنت لم تـعذب وتـغمس -- قـلما فـي قـــــــــرارة الآلام
واشق ما شئت فالشقا محرقات -- صعدت من مذابح الأرحام
رب جرح صار ينـبوع شعر -- تلتقي عنده النفوس الظوامي
وزفير أمسى إن قدسته الروح -- ضـربا مـن أقدس الأنغام
وعذاب قد فاح مـنه بـخور -- خالد فـي مجـامر الأحلام
وكذلك كان الشاعر "صالح الشرنوبي" (1924-1951)، رفيق "صالح جودت"، فقد جرته كآبته ومعاناته النفسية وقلقه الوجودي إلى الموت تحت عجلة القطار، وهو القائل:
غدًا يا خيالي تنتهي ضحكاتنا -- وآمالنا تفنى وتـفنى المشاعـر
وتسلمنا أيدي الحياة إلى البلى -- ويحكم فينا الموت والموت قادر
وقد كان الشاعر "خليل شيبوب" (1891-1951) صريع الداء مكدود البدن تساقط نفسه أنفسا على حد وصف "امرئ القيس" لِعلّته، وزاده الألم النفسي قهرا وعذابا فانفجر يقول:
أنا بين الأمراض والحسرات -- ذهبت صبوتي وضاعت حياتي
كم دعوت السماء دعوة يأس -- عالما أن راحتي فـي ممـاتي
حبذا الموت يـا ظلام فـإني -- تاعس الحظ قد سئمـت حياتي
وأما الشاعر السوداني "التيجاني يوسف بشير" (1912-1937) فقد كان الألم النفسي دافعه إلى الإبداع وسلمه إلى التحليق في سماء الابتكار، وقد كان شهابا خطف الأبصار سناه ثم انتهى رمادا، وقد صوّر معاناته قائلا:
ثـم مـاذا جـد مـــــــــــن -- بعد خلوصي وصفائي؟
أظلمت روحي ما عدت -- أرى مــــــــــــــا أنــا راء
أيهذا الـعثير الغـــــــائم -- فـي صـحو سمــــــائي
للمنايا الـسود آمـالي -- وللـموت رجـائـــــــي
وفي قصيدته "قلب الفيلسوف"، يقّدم لنا الشاعر ملامح شخص مرهف الحس، شديد الألم، تغطّيه أسمالٌ بالية على هيكل مكدود وهو يعني نفسه ومن على شاكلته:
أطل من جبل الأحقاب محـتملا -- سفر الحياة على مكدود سيمـاه
عاري المناكب في أعطافه خِلَق -- من العطاف قضى إلا بـقايـاه
مشى على الجبل المرهوب جانبه -- يكاد يلمس مهوى الأرض مرقاه
هنا الحقيقة في جنبي هنا قـبس -- من السماوات في قلبي هنـا الله
أما شاعر العربية الكبير وبلبلها الصداح ونسمتها المنعشة وعبيرها الفواح شاعر تونس الخضراء "أبو القاسم الشابي" (1906 - 1934) فالألم الجسدي وقصور قلبه كانا سبب نكبته ومعراجه إلى سماء الخلود وطريقه إلى الشعر بعد أن امتلك أسبابه وتهيّأت له فواتحه، ونعني "الشابي" المكدود العليل الصارخ من الألم المستشعر نهايته القريبة في شرخ الشباب ونضارة العمر، ونكتفي بمقطعين يعبّران عن معاناته الجسدية والنفسية من قصيدته "الصباح الجديد" وكأنه يؤمن في هذه القصيدة بتناسخ الأرواح، أو بفكرة البعث بعد الموت واستمرار الحياة إلى الأبد في أطوار وحيوات مختلفة، ولكنها حيلة اللاوعي وغريزة البقاء تسكن لوعته حتى تحين القاضية، يقول مخاطبا آلامه وجراحه:
أسكـني يـا جـراح -- واسكـتي يـا شجـون
مـات عـهد النواح -- وزمـان الـجـنـون
وأطـلّ الصـبـاح -- مـن وراء الـقـرون
في فجـاج الـردى -- قـد دفـنـت الألــم
ونـثرت الدمـوع -- لــريـاح الــعـدم
واتخـذت الـحياة -- مــعزفـا للنــغـم
أتـغـنّى علـيــــــــه -- في رحـاب الـزمـان
وقد كتب "فاروق جويدة" عن "العقّاد" بين شموخ الكاتب وكبرياء الإبداع (الأهرام، الجمعة 11 من جمادي الآخرة 1446 هــ 13 ديسمبر 2024 السنة 149 العدد 50411) فقال: "فى حياة البشر معجزات فردية يخص بها الخالق سبحانه بعض الناس.. ليس من الضروري أن يكونوا أنبياء أو رُسلا، ولكن الأقدار تمنحهم حظًّا أكبر من التأثير والدور والمهابة.. هذه المكانة تجسّدت فى اثنين من قمم الإبداع فى الثقافة العربية، وهما طه حسين وعباس محمود العقاد.
طه حسين، الرجل الذي حُرم من نعمة البصر، أصبح عميد الأدب العربي، يرى بعيون الملايين.. أما عباس محمود العقاد، الرجل الذي لم يُكمل تعليمه، فقد أصبح موسوعيًا فى كل شيء، حتى رفض درجة الدكتوراه عندما منحتها له جامعة القاهرة.. إنه العملاق عباس العقاد.
قلت إن الأقدار تصنع أحيانًا زلازل بشرية تغيّر سكون الأرض واستسلام العقول.. كان العقاد ظاهرة موسوعية، حلّق فى كل جوانب الفكر والإبداع.. اقترب كثيرًا من الفلسفة وناقش أعقد القضايا فيها، حتى وصل إلى الخالق سبحانه وتعالى في كتابه الأشهر (الله)، وسافر في آفاق النبوّة حين كتب عن محمد والمسيح عليهما السلام.. كما قدّم متعة الفكر والتحليل فى سلسلة العبقريات عن عمر، وعلي، وعثمان، أصحاب المصطفى، وكيف كانوا نماذج رفيعة فى القدوة والأخلاق والتحضر..
وجنح العقّاد إلى مملكة الشعر، وقدّم عشرة دواوين من الشعر الراقي الرصين، وأنشأ مدرسة الديوان ليقدم من خلالها صورة الشعر كما رآه.. دخل فى معركة دامية مع أمير الشعراء أحمد شوقى، وكان ضاريًا فى هجومه على شعره.. اختلف كثيرًا مع طه حسين، وكان سبب الخلاف بينهما قضية الانتماء الثقافي؛ حيث كان طه حسين مبهورًا بثقافة الغرب، بينما كان العقاد عروبي الفكر والثقافة.. وحين سُئل العقاد عن أيّ الألقاب يُفضِّل، قال: الشعر هو أرقى مراتب الإبداع، واستشهد ببيته الشهير:
والشِّعرُ مِن نفسِ الرحمنِ مَنبَعُهُ -- والشاعرُ الفذُّ بينَ الناسِ رحمنُ
دخل العقاد السجن، وكان عضوًا فى البرلمان، بتهمة العيب فى الذات الملكية، عندما قال تحت قبة البرلمان: إن هذا الشعب قادر على الإطاحة بأكبر رأس فيه.. مارس السياسة وأحب زعيم الأمة سعد زغلول، وكان الكاتب المفضل لديه.. أطلق عليه لقب (الكاتب الجبار)، وكان كاتب الوفد الأكبر.. حين قامت ثورة يوليو، حاولت استقطاب كبار كتاب مصر، خاصة الثلاثي الأشهر: عباس العقاد، طه حسين، وتوفيق الحكيم.. عندما كتب جمال عبد الناصر فلسفة الثورة.. كتب العقاد مقدمة الكتاب.. لكن قضايا خلافية برزت بين الثورة والعقاد، أبرزها قضية الحرية التي لم يفرط فيها، وهو أحد أبناء ثورة 1919 وزعيمها سعد زغلول.. وكان هناك جانب آخر وقف بين العقاد والثورة، كان كبرياؤه وشموخه الذي جعله يعيش حياته من قلمه يكتب في الصحف والمجلات. وقد حكى لي أنيس منصور - والرواية عنه - أن العقاد في آخر أيامه اضطر لبيع جزء من مكتبته حتى يواجه ظروف الحياة، وأنه ذهب لمصطفى أمين وحكى له القصة وأخذ 200 جنيه تحت حساب مقالات العقاد فى أخبار اليوم، وكان يتقاضى خمسين جنيها عن كل مقال ورفض العقاد أن يتسلم المبلغ وقال لأنيس سوف أحصل فقط على كل مقالة أنشرها.. كان العقاد يتسلم جائزة الدولة التقديرية من جمال عبد الناصر، وقال: إن الدولة التي تُكرم النابغين من أبنائها هي في الحقيقة تُكرم نفسها. ويبدو أن عبد الناصر غضب يومها من كلمة العقاد.. كانت بعض مواقف العقاد السياسية محسوبة عليه، ولهذا تفرّغ لكتاباته الفلسفية والفكرية، وكان منها كتابه الممتع (في بيتي) ثم (أنا وهي)، اعترافات ذاتية كشف فيها مواقف كثيرة فى حياته... وقصة العقاد مع الكاتبة اللبنانية مي زيادة أحاطها الغموض، ولم يتحدث عنها كثيرًا، وقد كتب العقاد رثاءً شهيرًا فيها بعنوان (أين في المحفل مي يا صِحاب؟)، حين رحلت مي زيادة وغابت عن صالونها الذي كان يجمع قمم الفكر والإبداع فى عصرها، وقد حيرت مي الناس بين حب جبران والعقاد.. وإن كان هذا النوع من الحب صفحة جميلة من الذكريات. قال "العقاد":
أَيْنَ فِي المَحْفِلِ مَيٌّ يَا صِحَابْ؟ -- عَـوَّدَتْنَا هَا هـُنَا فـَصْــلَ الخِـطابْ
عَرْشُـهَا المِنـْبَرُ مَرْفـُوعُ الجَـنَابْ -- مُسْـتَجِـيبٌ حِيْنَ يُدْعَى مُسْـتَجَابْ
أَيْنَ فِي المَحْفِلِ مَيٌّ يَا صِحَابْ؟
سَائِلـُوا النـُّخـْبَة مِنْ رَهـْطِ النـَّدِيْ -- أَيْنَ مَيٌّ؟ هَلْ عَلِمْتُمْ أَيْنَ مَــــيْ؟
الحـَـدِيـْثُ الحـُلْوُ وَاللَّحْـنُ الشَّجـِيْ -- وَالجَـبـِيْنُ الحـُّرُ وَالوَجْـهُ السَّـنِـيْ
أَيـْنَ وَلـَّىْ كـَوْكـَبَاهُ؟ أَيْنَ غـَابْ؟
شِــيـَمٌ غـُرٌّ رَضـِيـَّاتٌ عِــذابْ -- وحـِــجـَــى يـَـنـْـفـُـذُ بِالرَّأْيِ الصَّـــــوَابْ
وَذَكَـــــــاءٌ أَلْــمَــعـِــيٌّ كـَالشـِّــــــــهـَابْ -- وَجَــمَــالٌ قـُــدْسِـــــيٌّ لا يُعَابْ
كُلُّ هَذَا فِي التُّرَابْ؟ آهِ مِنْ هَذَا التُّرَابْ
وَيـْـكَ مَا أَنْـتَ بـِــرَادٍّ ما لديك -- أَضْـيَعُ الآمَالِ مَا ضَاعَ عـَلَيـَكْ
مَجْـــدُ مَيٍّ غـَيْـرُ مَوْكُوْلٍ إِلَيْكَ -- مجد مي خالص من قبضتيكْ
وَلَهَا مِـنْ فـَضْلهَا أَلْفُ ثـَوَابْ
ويبقى "العقاد قمة" من قمم مصر المُبدعة والخالدة، وهو يحمل سمات زمنٍ وحضارةٍ وتاريخٍ كانت مصر فيه قلعةً للإبداع والنهضة والتفرد، وقدمت ثقافةً أضاءت بها عقول الملايين فى كل مجالات الحياة".
ويقول "فاروق جويدة" في قصيدته "مرثية ما قبل الغروب" سنة 1997، مُصوّرا الألم الجمعي للأمة العربية ومعاناتها:
فـي أيّ شيء أمام الله قد عدلوا؟ -- تاريخنا القتل.. والإرهاب.. والدَّجلُ
مـن ألفِ عامٍ أرى الجلاد يتبعُنا -- فى موكب القهر ضاع الحُلمُ.. والأجلُ
نـبكي على أمةٍ ماتت عزائِمها -- وفوق أشلائها.. تَساقَطُ العللُ
هَل يَنفَعُ الدَّمعُ بعد اليومِ فى وطنٍ -- مِن حُرقةِ الدمعِ ما عادت له مُقَلُ
فى جُرحِنا الملحُ هل يَشفى لنا بدنٌ -- وكيف بالملح جرح المرء يندملُ
أرضٌ توارت وأمجاد لنا اندثرت -- وأنجمٌ عن سماء العمرِ ترتحلُ
ما زالَ في القلبِ يَدمى جُرحُ قُرطبةٍ -- ومسجدٌ فى كهوفِ الصمتِ يبتهلُ
فكم بكينا على أطلال قُرطبةٍ -- وَقُدسُنا لم تزل في العار تغتسلُ
في القُدسِ تبكي أمامَ الله مِئذَنةٌ -- ونهر دمعٍ على المحرابِ ينهمِل
وكعبةٌ تشتكي لله غربتهـــا -- وتنزف الدمع في أعتاب من رحلوا
كانوا رِجالاً وكانوا للورى قبسًا -- وجذوةً من ضمير الحقِّ.. تشتعِلُ
لم يبقَ شيءٌ لنا من بعدِ ما غربت -- شمس الرجال.. تساوى اللصُّ والبطلُ
لم يبقَ شيءٌ لنا من بعدِ ما سقطت -- كل القلاع.. تساوى السَّفحُ والجبلُ
في ساحة الملك أصنامٌ مزركشة -- عِصابةٌ مِن رمادِ الصُّبحِ تكتحـلُ
وأُمّةٌ في ضَلالِ القَهرِ قد ركعت -- مَحنيةَ الرأسِ للسَّيافِ تمتثِــــلُ
فى كل يومٍ لنا جُرحٌ يُطـــــاردنا -- وقصةٌ من مآسي الدَّهرِ تكتمِـــلُ
من ذا يصدق أن الصُّبحَ موعدنا -- وكيف يأتي وقد ضاقت بنا السبل؟
قد كان أولى بِنا صُبــحٌ يعانِقـــــــُنا -- ويحتوي أرضَنا لو أنهم.. عدلــوا
عُمرى هُمـومٌ وأحلامٌ لنا سقطـت -- أصابها اليأسُ.. والإعياءُ.. والمللُ
يا أيها العمر رِفقـًـا كَان لي أمــــــلٌ -- أن يبرأ الجرح.. لكن خانني الأملُ
ففي خيالي شُمــوخٌ عِشتُ أنشده -- صَرحٌ تَغَنَّت بِهِ أمجادُنا الأولُ
لكنَّه العار يأبـى أن يفارِقنا -- ويمتطى ظهرَنا أيان نرتحـلُ
يا أيُّها الجُرحُ نارٌ أنت فى جسدي -- وجُرحُنا العار ُكيف العارَ نحتمِـلُ؟
قالـوا لنا أرضُنا أرضٌ مباركة -- فيها الهُدى.. والتقى والوَحيُ والرُّسلُ
ما لي أراها وبحر الدَّم يغـرقـُهـا -- وطالعُ الحَظ َّ فى أرجائها.. زُحَلُ؟
لم يبرَحِ الدَّمٌ في يـومٍ مشانِقَهـا -- حتى المشانقُ قد ضاقت بِمَن قــُتِلوا
يا لَعنَةَ الدَّم من يوما يُطَهِّرهــا؟ -- فالغدرُ في أهلهـــا دِيـنٌ لَهُ مِللُ
في أيّ شيءٍ أمـــام الله قد عدلوا؟ -- وكــُلهم كاذِبٌ.. قالــــوا وما فعَلـوا
هذا جبـانٌ وهذا باعَ أمّتـــــــــهُ -- وكلهم فى حِمى الشيطان يبتهـلُ
مِن يومِ أن مزَّقوا أعـراض أُمّتهم -- وثوبُها الخِزي.. والبُهتان.. والزّلـَلُ
عَارٌ على الأرضِ كيف الرِّجسُ ضاجعها -- كيف استوى عندها العِنِّينُ.. والرَّجُلُ؟
يا وصمةَ العار هُزِّي جِذعَ نخلتِنا -- يَسَّاقط ُ القَهرُ والإرهاب.. والدَجـَلُ
ضاعت شُعُـوبٌ وزالت قبلـَنا دُوَلٌ -- وعُصبة ُالظـُّلمِ لن تعـْلــُو بِها دُوَلُ
وقد كان "مصطفى لطفي المنفلوطي".. أديب البؤساء والأشقياء! حيث تميّز بأدب فريد مبتكر في قَصصٍ رائع، يصف الألم والبؤس ويمثل العيوب، بأسلوب عذب ولفظ قوي وبيانٍ جَزِل.
وقد عانى "المنفلوطي" في بداية عهده بالأدب، فعندما كان في الثالثة عشرة من عمره؛ كان مشايخ الأزهر يرون أن الإلمام بالأدب هو عمل من أعمال البطالة والعبث وفتنة من فتن الشيطان، وكانوا يَحولون بينه وبين الأدب ما استطاعوا، كالأب الذي يحول بين ابنه وبين نزغات الهوى والفتن، فيقول "المنفلوطي": "لم أكن أستطيع أن ألمَّ بكتابي إلا في الساعة التي آمن فيها على نفسي وقليلًا ما كنت أجدها، وكثيرًا ما كانوا يهجمون مني على ما لا يحبون، فإن عثروا في خزانتي أو تحت وسادتي أو بين لفائف ثوبي على ديوان شعر أو كتاب أدب؛ خُيّل إليهم أنهم قد ظفروا بالدينار في حقيبة السارق".
أما الأديب "مصطفى صادق الرافعي".. فله رؤيته الفلسفية للألم والمرض، حيث يرى أن من لم يتجرّع مرارة الألم؛ لا يمكنه أن يصف مدى قسوته، ومن حُرم الشعور بآلام الآخرين؛ لن يتمكّن من التعبير عن محنتهم ومعاناتهم، وهذا الذي أخفق في إخراج نفسه من محنة آلامه، كيف له أن يبسط يد العون لغيره ممَّن يكابدون الصراع مع الآلام والأحزان؟!
وما أن وجد "الرافعي" لنفسه مخرجًا من آلامه؛ حتى دوَّن بقلمه ما يرشد قُرّاءه إلى كيفية التخلص من كل ألم وحزن وتعاسة وشقاء، خاصة وأنه برغم فقدانه لحاسة السمع في ريعان شبابه، لم يكن في معزل عمَّن حوله. وفي عام 1931، أصدر "الرافعي" كتابه الأدبي "أوراق الورد" الذي حوى الرسائل المتبادلة بينه وبين محبوبته، وهو إلى جانب ما يتميّز به من معانٍ رقيقة ودلالات عميقة، تضمَّنَ فصلا دوَّن فيه "الرافعي" رؤيته الفلسفية لكلٍّ من الألم والمرض، وتحت عنوان "صرخة ألم"، تحدّث "الرافعي" عن أوصاف الألم الذي يسبّبه الحب وتسبّبه الحياة، وكأنه لا يمكن الحديث عن الجمال والحب بدون الحديث عن الألم والمعاناة!
ويرى "الرافعي" أنّ الألم هو أشدّ وثاقٍ يكبّل الإنسان، ومع ذلك فهو المعنى الأهم في الحياة والذي يعبّر عن إنسانية البشر. ومعاناة الإنسان من الألم لا تنتج فقط من المرض الداخلي الذي يصيب جسده فيندفع الألم خارجًا منه، ولكنها تتولّد أيضا من كل ما يحيط بجسده من أمراض خارجية ترد إليه الألم من جديد. وكأن قوته قد قُدِّر لها أن تحاصَر داخليًّا وخارجيًّا؛ كي يتم إحكام السيطرة عليها، وحتى كل ما يحاول الإنسان التمكّن منه عن طريق الإحاطة بمعناه؛ لا يجني منه كلما اكتمل لديه المعنى سوى الألم.. فالحكمة مثلًا يتألم بسببها الحكيم الذي ألَّم بها وحده فأصبح وسط الجموع التي لا تفقهها ولا تبغيها غريبًا وشاذًّا؛ ومن ثم وحيدًا. وهذا لا ينفي أيضًا أن كلًّا من الجاهل والسّفيه يتألّمان بسبب الافتقاد إلى الحكمة ألمًا أشدّ، ولكنه خفي عنهما؛ وذلك بسبب عدم تمكّنهما من جني ثمارها النافعة.
إن ألم الإنسان يشبه ألم الطفل المُدلل الذي يَسعد بالتحكم في كل ما يحيط به ولا يحزن أو يتألم إلَّا إذا تمرّد عليه ما لا يقوى على إخضاعه لقوته المحدودة. ومع ذلك فإن كل ألم يعود على الإنسان إما بمنفعة أو لذة أو حكمة. وها هو الإنسان الحكيم لا يبدو عليه الألم بسبب عجزه أمام كل ما هو مادي، ولكن بسبب تعاليه دون غيره عن الماديات، وترفّعه عنها في عالم يغرق في الماديات ويخضع لسلطانها.
أما أهم ثمار الألم والحزن التي أشار إليها "الرافعي" فهي الارتقاء بإنسانية البشر لأن تلك العواطف والأحاسيس السامية التي تتولد بسبب الألم والمعاناة بإمكانها أن تخلق حياة معنوية للقلب إلى جانب الحياة المادية للجسد. فكل شيء مادي يفقده الإنسان فيتألم لفقدانه ينبعث بسببه صوت كان دفينًا في أعماق ضميره؛ كي يحثّه على الترحيب بما يجب أن يحلّ محله لأنه خير منه بسبب روحانيته، وبالفعل فإن نفسه كانت في أمسّ الحاجة إليه، ولولا ذلك الفقد المادي لما حصلت على ما تحتاجه وتفتقده من روحانيات هي الأهم لها من أجل الارتقاء بها، وهكذا فإن كل فقدٍ مادي يعوّضه مكسب روحاني ومعنوي، فالألم هو طفل كل معنى نكتسبه بفضله، أو كما يقول "الرافعي": إن آلامَنا هي أطفالُ معانينا.
وفي تخيُّلٍ لا يخطر إلَّا على خاطر فيلسوف حكيم لا يفصل بين طبيعة الإنسان وطبيعة الأرض التي خُلِق من طينها، قارن "الرافعي" بين ما يُكدِّر صفو حياة الإنسان من أحزان وهموم وآلام، وبين مظاهر الطبيعة التي تبدو خلّابة لعوام الناظرين إليها، فإذا به يرى الهموم مثل الجبال الراسيات، وأنهار الدموع مثل الأمواج المتدفقات، والأحزان مثل البراكين الثائرات، مما أوحى إليه بأن ما يمنح النظام للطبيعة، وما يمنح الألم للإنسان هو السرّ الكامن في أعماقهما والذي بدونه لن يكون لهما معنًى أو بقاء، فالألم هو سرّ الضعف الإنساني، وهو أيضًا سرّ النضج النفسي، الذي يُتَغَلّب على حماقة الطفولة فور تحققه، فيزول تعلقها الساذج بكل ما هو زائف ومؤقت، ما دام لم يزل في نظرها برَّاقًا ولامعًا. فالعين لا ترى الأشياء المادية كبيرة وبراقة، إلَّا إذا كان ما سواها من معنويات وروحانيات لم يزل في نظرها صغيرًا ومنطفئًا، والألم بإمكانه أن يبعث القوة في الروح، بقدر ما يسببه في البدن من ضعف؛ وذلك في حالة إذا ما فقه الإنسان بقلبه السرّ في المنع والحكمة من البلاء.. آنذاك فقط تتحول أمامه المحنة إلى منحة، والألم إلى أمل؛ فتحلّ في لحظة فارقة إيجابية التعلق بالحياة وببداية جديدة محل سلبية انتظار النهاية وطلب الموت، لذلك فإن أسقام الأبدان وأوجاع القلوب؛ تقضي فقط على الأبدان الضعيفة أمام جبروت المرض وآلامه، وعلى القلوب الهشة أمام عنفوان الفقد وأحزانه، أما إذا صادفت أثناء عدوانها أرواحًا قوية ومؤمنة، فستتهاوى أمامها وكأنها غير موجودة برغم ما تسببه من ألم يعاني منه البدن، وحزن ينفطر منه القلب، ولن يرتاح كل من يعاني من ألمٍ ما، ولن تلتئم جراحه إلَّا عندما يبصر بنفسه، ما أفرزه الألم وأنتجته المعاناة من حبّات لؤلؤ، لم تكن لتخرج من أصدافها.
وهناك مقولة لـ "توفيق الحكيم": "لا شيء يجعلنا عظماء إلا ألم عظيم"، تصوّر علاقة الإبداع بالألم، على اعتبار أن الحكيم يقصد بالعظمة هنا عظمة الإبداع تحديدا.
وتقول "سعدية مفرح": "إنني أرفض المقولة وما تفضي إليه فليس كل الذين يعانون من الألم هم من العظماء، ولا كل العظماء ينبغي عليهم أن يعانوا الآلام ".
والإبداع صفة أصيلة في خلق الكائن البشري يتميز بها دون غيره من أشقائه الذين تربوا معه للأسرة والظروف نفسها. لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى الظروف الخارجية، السلبية والإيجابية معا، باعتبارها عناصر معززة أو محبطة للموهوبين وللمبدعين، ولهذا لا ينبغي أن تكون شمّاعة للكسل، وحجّة للموهوب كي يتراجع تحت وطأة ظرف ما عن مواصلة الطريق.
وقد صوّرتُ في شعري كثيرا آلام الغربة وأوجاعها مثل قصائدي: يا ليلة العيد، خطاب الحبيب، طيف الحبيب، أين الحبيب؟ وغيرها من القصائد التي ضمّنتها في دواويني الثلاث: هموم وأشجان، لو تطلبين العمر، من وحي الأحساء. كما صوّرتُ ألم الفقد ووجع الفراق في رثائي لأخي الحبيب وشقيقي "صفوت" الذي توفي شابا في حادث سير في "جدة" منذ أكثر من ربع قرن، وفي رثائي لوالدي الحبيب ووالدتي الحبيبة، وبعض الأصدقاء من الشعراء، كما صوّرتُ الألم والوجع الناتج عن حقد بعض الزملاء في الغربة، ومنها قصيدة "حاقد" من ديواني "هموم وأشجان"، وقصيدة "أبلغ البيان في الرد على مفلوت اللسان" من ديواني الثاني "لو تطلبين العمر"، وتكفي هذه الإشارات، فلا أريد أن يكون المقال ذاتيا، ولعلي أعود لذلك في مقال قادم إن شاء الله.
وعن الشعر وتصويره للمشاعر المختلفة من فرح وترح وسرور وحزن، قلتُ:
الشعر بسماتنا في طلعة الفلق -- والشعر وحشاتنا في ظلمة الغسق
والشعر آهاتنا في الليل نطلقها -- كم يستريح بها من مغرم قلق
والشعر ترنيمة للطير قد صدحت -- فوق الغصون، فهاجت شوق ذي أرق
والشعر ما غازل الأزهار راودها -- عن عطرها، فحبته ساحر العبق
والشعر آلامنا قد صورت كلما -- فالنفس من سحرها تخلو من الحرق
والشعر سحر حلال، خمر آنية -- معتق، وله نهفو بلا نزق
ما الشعر إلا خبايا الروح نسكبها -- على رقيق من الألواح والورق
ويطيب لي أن أختتم مقالي بقصيدة جعلت عنوانها "الغلبان"، وستكون ضمن ديواني الرابع "فراديس الحب"، قلت فيها:
نعم والله غلبان، صديقي -- ومن غُلبي تراني جفّ ريقي
تكاثرت الذئاب عليّ حتى -- لقد نصبوا المجانق في طريقي
فمن تهمٍ مُلفقة وكيد -- لتدليس بلا سند وثيق
ولي رب لطيف ردَّ كيدا -- لنحر عصابة المكر الصفيق
يسوء نفوسهم أني جواد -- فصرت محسدا بين الفريق
وحب الناس لي كنز وربي -- وذا والله يشعرهم بضيق
وإني لست أحمل أي حقد -- وقلبي ملؤه الحب الحقيقي
وهم للحقد أرباب تراهم -- وقد أعماهم وهج البريق
فيا ربّاه سامحهم وأكرم -- بسيم الثغر ذا القلب الرقيق
وفي إطار الوجع والألم المفجر للإبداع، كتَب صديقي الدكتور "شعبان عبد الجيد"، مقطوعة بعنوان "الكرام واللئام"، وصدّرها بقوله: إلى أخي وصديقي: د. بسيم عبد العظيم، قال فيها:
لقد صارتْ حياة المرء بؤسًا -- وويلاً في مصاحبة الأنــامِ
وكلُّ كريمِ قومٍ سوف يشقى -- شقاءً بالطَّغامِ وبــالـلــئامِ!
فرددت عليه قائلا:
صدقت حبيبنا شعبان إني -- شقيت من الطّغام وباللئام
ولولا مثلكم لبقيت وحدي -- فويلي من مصاحبة الأنام
تهون لي بشعرك كل صعب -- وتتحفني بآيات الكلام
والكلام في هذا الموضوع ذو شجون وأرجو ألا أكون قد أطلت فأمللت، والله المستعان وعليه التكلان.
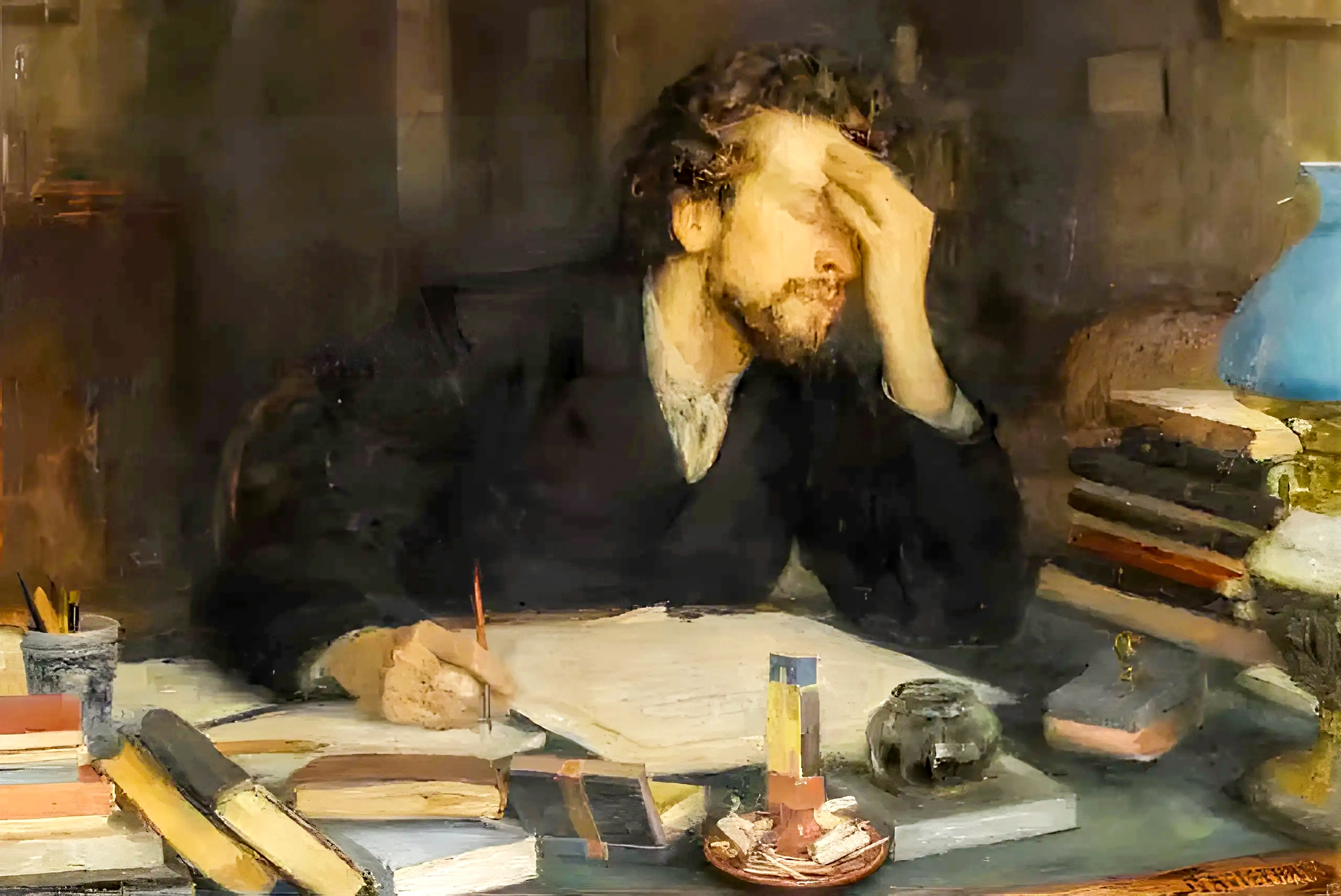
سمر توفيق الخطيب (كاتبة وباحثة فلسطينية - لبنان)
الكتابة.. ولادةٌ من رحم الأوجاع
تُولد الكتابة من رحم الواقع الذي يعيشه الكاتب أو الشّاعر، فتعكس تجاربه الشّخصية والاجتماعية المستمدة من المواقف والمشاعر والأحدث، فيعبّر بصدق عن الأمل والألم والحلم والخيبة... وكل ذلك يجعله يسرح بخياله، فيجمل لنا المفردات والمعاني، ويسردها لنا برقي العارف المتمكّن، نتيجة ما كنزه ونهله من علوم؛ فيمدّنا بنصوص تعكس روحه المثقفة والقادرة على مزج العاطفة بالفكر والإحساس بالوعي، فلا يقتصر وصفه على ما كان، بل يستبصر ما يمكن أن يكون أيضا.
وإذا ما تطرّقنا إلى الشعراء القدامى، نجد أنهم تمكّنوا من وصف الصّحراء والحياة البدويّة، ما مكّننا من التّعرف على عاداتهم وتقاليدهم وطرق العيش؛ فقد تمكن شاعر العرب "المتنبي" ( - 965م)، أن يبهرنا بشعره الحماسي في وصف الفارس المغوار والمشهور الذي لا يهاب شيئًا، فيقول:
الخيلُ واللّيلُ والبيداءُ تعرفُني -- والسّيفُ والرّمحُ والقرطاسُ والقلمُ
صحبتُ في الفَلَوات الوحشَ منفَرِدًا -- حتى تَعَجّبَ مني القُورُ والأكَمُ
كما تعرّفنا من خلال كتاباتهم على الصّراعات بين العائلات، ففي مسرحية "روميو وجولييت"، التي تُعدّ من أشهر المسرحيات الكلاسيكية، تمكّن الأديب الإنكليزي "وليام شكسبير" (1564 - 1616) من تخليد هذا العمل الأسطوري؛ فنجد أن كل عاشق في بلاد الغرب أو حتى في البلاد العربية يُنادى باسم "روميو" وكذلك المحبوبة تُنادى باسم "جولييت". وتمكّن الكاتب من وصف الأحداث التي وقعت بين عامي (1260 - 1387) في مدينة "فيرونا" الإيطالية التي تتمتع باستقلالها الذّاتي، وكان من الشّائع أن تحتدم معارك عنف وحقد بين الأسر النبيلة وقتها مثل ما كان يحدث بين عائلة "مونتاغ" وعائلة "كايبوليت" نتيجة الوضع السياسي، حيث كان هناك صراع بين الأحزاب على السّلطة والنّفوذ في المدينة، فينقل "شكسبير" بدقة روح العصر الإقطاعي آنذاك، ونستشعر ذلك حين يقول: "جولييت أفهذا حبي الأوحد/ من صلب عدوّي الأوحد؟".
وتعرّفنا على مكانة المرأة في المجتمعات العربية في العصور السّابقة، فنجد أنه كان من المحظور أن يتم التّغزل بها من قبل العاشق لأن ذلك يُعدّ انتهاكًا لكرامتها، ومسيئًا إلى سمعتها وسمعة عائلتها. فنجد أن مسرحية "مجنون وليلى" لأمير الشّعراء "أحمد شوقي" (1868 - 1932م)، تسلط الضّوء على العاشقين في البيئة العربية، إذ إن "قيسًا" وحبيبته "ليلى" هما أشهر عاشقين في الثّقافة العربية. فكل عاشق في البلاد العربية يُدعى "قيس" وكل محبوبة تُدعى "ليلى". وتدور أحدث المسرحية حول قصة واقعية كتبها "أبو الفرج الأصفهاني" (284- 356 هـ) تكرّست فيها مشاعر الحُبّ الصّادقة للشاعر "قيس بن الملوح" (24هـ/645م - 68هـ/688م)، حيث كان يعيش في بادية "نجد" في العصر الأموي؛ وكان وقتها يترافق وابنة عمّه "ليلى" منذ الصغر يرعيان مواشي أهلهما ويلعبان معًا أيام الصّبا، ولكن عندما كبرت حُجبت عنه. فاشتد بـ "قيس" الوجدُ وهام على وجهه ينشد الأشعار المؤثرة والتي خلّدتها ذاكرة الأدب في حبه لـ "ليلى" وتغزّله بها. وكان من طبيعة أهل "نجد" في تلك العصور القديمة ألا يزوّجوا بناتهم بمن شبّبوا بهنّ؛ صيانة للتقاليد والأعراف التي كانوا يخضعون لها بشكل تام. فما كان من "ليلى" إلا أن قدّمَت الواجب القبلي على العاطفة، ورفضت الزّواج من "قيس" رغم حبها الكبير له، فأصيب بالخبل:
إذا سمعت اسم ليلى تبت من خَبَلي -- وثابَ ما صرعت مني العناقيد
كسا النداء اسمها حسنا وحببه -- حتى كأن اسمها البشرى أو العيد
ليلى! لعلي مجنون يخيل لي؟ -- لا الحي نادوا على ليلى ولا نُودوا
وإذا ما تطرقنا إلى ما كُتب بعد نكبة فلسطين، حيث وجد الشعراء أنفسهم بحاجة إلى اعتماد مُغاير للقصيدة الكلاسيكية، كونها تحتاج إلى الاهتمام بالحفاظ على القافية، فوجدوا في القصيدة الحديثة ملاذهم، فتمكّنوا من وصف الأحداث والتّعبير عن الواقع المستجد بحرية أكثر.
فقد تمّ كتابة عددٍ لا يُحصى له من الكتب والقصائد لوضعنا أمام الواقع المُزري في دولة فلسطين، فها هو شاعر المقاومة الفلسطينية "محمود درويش" (1941 - 2008)، يصف لنا الأحداث فيها مستعينًا بالشعر الحديث، فوُفّق إلى وصف ما يدور فيها وأصبحت أشعاره تتداول في كل مرة يتم فيها التعدّي على أهلنا في كل فلسطين ولا سيما في غزّة، حيث المقاومة الدّائمة للاحتلال الصهيوني حتى تحقيق النّصر الموعود، بإذن الله.
ومن هنا، لا بدّ للكاتب أو الشّاعر من أن يُصوّر لنا آلامه وأفراحه وكل ما يتأثر به من محيطه وبيئته، فتصبح الكتب والقصائد تمثل هذا المجتمع أو ذاك؛ فتعبّر بدقة عمّا يحدث فيها. فكم من كاتب أو شاعر نقل لنا الصّراع الفلسطيني - الصهيوني بأدق التّفاصيل، وبلغة سهلة وبسيطة ومكثفة بحيث يمكن لأيّ مُتلقٍ أن يفهمها ويتأثر بها ويردّدها. فهذا الصّراع الذي بدأ أوائل القرن العشرين ولا يزال إلى يومنا هذا، مكّنهم من التّعبير عن رفض الواقع المؤلم والمستجد، فكانوا بذلك صوت ناسهم ومجتمعاتهم التي تؤمن بهذا النّوع من القضايا التي تمثل شرف الأمة العربية.
فها هو الشّاعر "درويش" قد تخطّى في أشعاره المعاني البسيطة لرموز الطبيعة الخاصة في قصائده، والتي استخدمها لنفسه، فتكرّرت وشكلت صورًا ميّزَت شعره، ومنها: الأرض، التّراب، التّين، الزيتون، البرتقال، يافا، حيفا، البداية والنهاية... إلخ. فوصف لنا آلامًا ومعاناة يعيشها الشّاعر وكل إنسان فلسطيني، فعَبَر بذلك حدود فلسطين؛ إذ تمكّن في قصيدته "هي أغنية، هي أغنية"، من أن يمنح الشّعر العربي المزيد من الأناقة والجاذبية، حين يقول:
أنا مَنْ رأى ما لا يَرَى. هي أُغنيهْ لا شيء يعنيها سوى إيقاعِها، ريحٌ تهبُّ لكي تهبَّ لذاتها. هي أُغنيهْ حجرٌ يُشاهدُ عودةَ الأسرى إلى ما ليس فيهم، أُغنيهْ قمرٌ يرى أسرارَ كُلِّ الناس حين يخبئون جنونهم في ضوئِهِ ويصدقون الأغنية.
وعندما سرد لنا الشّاعر "درويش" قصة العرس الذي تحوّل إلى جنازة في قصيدته "أعراس"، استطاع تحويل مفردات الشّعر والمعاني إلى صور أخرى، ترفض همجية الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي سرق لحظات الفرح، وقصف حفل الزّفاف بطائراته الحربية:
عاشقٌ يأتي من الحرب إلى يوم الزفافْ
يرتدي بدلتَهُ الأولى
ويدخلْ
حلبة الرقص حصاناً
من حماس وقرنفلْ
.....
وعلى سقف الزغاريد تجيء الطائرات
طائرات
طائرات
تخطفُ العاشقَ من حضن الفراشهْ
ومناديل الحداد
وكم من كاتب وشاعر ساهم في حث الناس على الثورة على الواقع الأليم، فبموهبتهم ومَلَكة الكتابة عندهم، استطاعوا أن يكونوا أصحاب رسائل في محاولة منهم لإيقاظ الضمير البشري، علّهم يجدوا من يصغي ويسمع، وتمكّنوا بذلك من تخليد كتاباتهم وقصائدهم، فعَبرت الحدث وأصبحت تمثل أيّ حدث آخر فيه المعاناة نفسها، كما نجد ذلك في قصائد "درويش" الذي توفي ولا تزال قصائده خالدة في أذهان أيّ متلقٍ من الشّعب الفلسطيني وكل حر في بلادنا العربية. فهو لم يكتب إلى فئة مُعيّنة من النّاس، ما مكّنه من نقل الرسائل، بحيث يسترجعها كل مواطن عند أيّ حدث يحصل في فلسطين من طرف الاحتلال الغاشم، كما يحصل في أيامنا هذه نتيجة حرب الإبادة والجوع على غزّة؛ ما مكّن النّاس من استعادة أشعاره في أذهانهم، فعبّرت عن آلامهم وما يختلج في صدورهم:
على هذه الأرض، هناك ما يجعل الحياة جديرة بالاهتمام
على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات
كان اسمها فلسطين
أصبح اسمها فلسطين
سيدتي، لأنكِ سيدتي، أستحق الحياة
فالكتابة وسيلة للتنفيس والنّجاة والفهم وتخليد ذلك الوجع الذي يجعل النّصوص أكثر إنسانية، كونه أكثر من مجرد شعور يُعبَّر عنه من خلال الحروف؛ لأنه نوع من البوح الصّامت، ينتقل من الرّوح إلى الكلمات. فنجد أن ألم الكاتب يختبئ في الاستعارات والتّشبيهات، وبين السّطور، تعبيرًا عن الحنين أو الخيبة وما إلى ذلك من مشاعر ألم أو حتى فرح، يقول الشّاعر "مهذل الصقور" ( - 1824م):
أتَظُنُّ أنكَ عندما أحرَقْتَنِي -- ورَقَصْتَ كالشيطانِ فوق رُفاتي
وتَرَكْتَنِي للذَّاِرياتِ تَذُرُّنِي -- كُحلاً لعين الشمس في الفلوات
أتظن أنك قد طَمَست هويتي -- ومَحَوْتَ تاريخي ومعتقداتي
عبثاً تُحاول... لا فناء لثائرٍ -- أنا كالقِيامةِ ذاتَ يومٍ آت

هند سليمان أبو عزّ الدين (باحثة وكاتبة من لبنان)
صرير القلم.. صوت القلوب
يتسرّب من خفقات القلب صوت في الظّلام، ليبحث عن ظلّه المتخفّي في أحضان الألم، فيمسك قلمًا ويُطلق له العنان، ليبكي على الورق، وليُخبر حكايات دموعه التي خجلت من عينيه الذّابلتين، فاختبأت خلف هضاب الحنين، وأوجاع السّنين، وخاطبت الأدب، شعرًا ونثرًا، قائلة: "تركت لك أوتار المشاعر، فاعزف عليها أنغام متاعبك الدّفينة، واكتب كلامًا يُدمي القلب ويحرّره من الهموم والأحزانِ، وحروفًا تبعثرت في الصّمت، وأضاعها عجز اللسان، وعلى أنغام الشّجن قُل ما كتمه الفؤاد في رحلة بحثه عن بسمة تضيء ليالي غربته الموجعة، وانقُل لنا تجارب حفرت أخاديدها في وجه أثقلته دموع الحبّ ونيران الفقد، وحريق الشّوق والحزن"، وقد عبّر الشّاعر إلياس أبو شبكة عن تفجّر الشّعر من ينابيع الألم، وانبثاقه من زوايا الجراح، في قوله:
رُبَّ جُرحٍ قَد صارَ يُنبوع شِعرٍ -- تَلتَقي عِندَهُ النُفوسُ الظّوامي
وهكذا تُصبح التّجربة الشعريّة رحلة معبّدة بأشواك الوجع والأنين، وحكاية مُكلّلة بالورد والنّدى، يغسل فيها القلب مشاعره المأسورة والمسجونة خلف بحّة الصّوت الحزين، ويلملم فيها الدّمع جراحه المختبئة خلف تلال الخوف والوحدة والظّلام، القابعة في زوايا الحبّ والأحلام، فيَبكي الشّعرُ الأحبّةَ ويجسّد ألم الفراق، ومآسي الوحشة والغربة، ليهمس في أذن القارئ وفي فؤاده شاكيًا حالته الوجدانيّة وأحاسيسه الإنسانيّة، فيبدو كأنّه يحمل هموم الإنسان وأوجاعه ويضعها بين الكلمات مزيّنة بالإيقاع، وبالصّور البيانيّة المؤثّرة والجميلة.
وعندما يُنادي الخيالُ القلمَ تبدأ رحلة البوح والتّعبير، ويختلط الحبر بالدّموع، والعتم بالشّموع، فتنسكب الأبيات لتكتب نفسها على الورق، بريشة صنعتها من الحُرقة، ومزجتها بما يختبئ بين الضّلوع، فينطلق الكلام من الآلام، ويصرخ فيه الصّوت الذي يئنّ خلف قناع التّعب، ليترك الشّاعر في حالة تجمع بين الحزن والفرح، والإبداع والذّهول، واليأس والأمل، والفشل والنّجاح، فتضيع المشاعر في غابة من الفوضى، وتكسر المعاناة قيودَها لتبدأ رحلة التّحرّر والتّشافي، فتنطلق القوافي، ويقتحم الشّعرُ الشّاعرَ، فتشرق شمس الهدوء والسّكينة في عينيه، وتُزهر براعم الرّبيع في يديه، وينمو العشب أخضرا يانعًا مفعمًا بروائح الجمال، وتغسل حياته ثيابَ همومها في نهر الكتابة، فتولدُ القصيدة!
ومن رحم الأوجاع، تبدأ ولادة الأبيات الحرّة والفتيّة، فتتدفّق من شفاه المآسي والضّياع، ليَصير اليراع نبضًا، والعاطفة قيثارة، والأفكار طوفانًا يُغرق الأوراق بالأماني المفقودة بين الوقت والعمر، والمحفورة على جدران الشّعور، والمرسومة على لوحات السّكوت، فتنصهر العبارات في بوتقة من العذاب الجميل، لتزهو بحلّة بهيّة تُنقذ العواطف من تخبّطها وسيرها بين جمر المتاعب والمشكلات والصّعاب، فتخرج من يد الفكر المجرّحة بشوك الوجع زهرةٌ يفوح عطرها شعرًا جميلًا أو نثرًا مخضّبًا بلواعج الحبّ والأسى والشّوق والحزن والبكاء، فيغيب الشّاعر في حالة يسيطر عليها الوجدان الذي ينهمر على الورق كما يهطل المطر في فصل الشّتاء.
فالأديب، كاتبًا كان أم شاعرًا، هو عصارة التّجارب التي طبعت بصمتها على خدّ كتاباته، وتركت آثارها في تفاصيل عمره، وحكايات طفولته وشبابه، وحرّكت أصابعه لتمسك دفاترها وتُسافر معها بين المعاني، فيصير الأدب بين يديه غيابًا بين الواقع والخيال، يضع فيه يده على الجراح ليُداويها، ويُحارب بألفاظه قسوة الحياة وهمومها، فتغدو الكتابة طبيبًا يُعالج داء شقائه وتعبه، ودواء يُخفّف عنه الألم، ومنديلًا يمسح دموعه، وصديقًا يسمع شكواه ويُقدّم له النّصائح.
وهكذا يُصبح القلم شاهدًا على معاناته اليوميّة في رحلة البحث عن الكلمة، وينطلق لسان المشاعر معبّرًا عن أحزانها، فتُصبح الكتابة تحرّرًا من صمت الوجع، ونسجًا لأمنيات كثيرة، ورسمًا لواقع يسعى الشّاعر أو الكاتب إلى تحقيقه، فيسلّم يراعه للقلبِ ليعبّر عمّا يختلج فيه من عواطف إنسانيّة صادقة، ويترك في كلّ نصّ شيئًا من ذاته، ويعتصر أحاسيسه في كلّ فكرة لتصير نابضة بالحبّ والحنان والشّوق والفقدان، فينغمس وجدانه في ألفاظ جميلة، ويحفر مآسيه في كلّ قصيدة، وتغدو الكتابة عشقًا وتوقًا إلى التحرّر من نيران الألم، فيحيا الكاتب أو الشّاعر ما تبوح به أسرار القلم فوق الورق، وتتقاذفه الحروف بين أحضان عالمها السّحري، فتأخذه إلى آفاق بعيدة، ليعيش في كلّ يوم رحلة أوجاع جديدة.

سحر قلاوون (كاتبة من لبنان)
حين تصبح الكتابة حربا يموت فيها الكاتب!
نكتب لنرتاح، نكتب لنُشفى من جراحنا، نكتب لنبحث عن سعادة ضاعت منا في منتصف الطريق... هذه العبارات وغيرها الكثير يردّدها بعض ممن يكتبون، فهم يبحثون عن سعادة بين الأحرف وعن راحة طال انتظارها.
لكن معظمهم سيفاجأ، لا بل لنقل سيُصدم، حين يبدؤون فعلًا بممارسة الكتابة، ويسبر أغوارها، فيكتشفون أن الراحة هي حلم لن ينالوه، وأن الجراح تُكوى بالكلمات، وأن السعادة ما هي إلا حكاية خيالية تستعيدها ذاكرتنا بين الحين والآخر لنتمكّن من الإستمرار في هذه الحياة.. لست هنا متشائمة، بل أنا أحاول رسم الواقع بالكلمات، ليس إلا.
لكن بعض الناس، قبل أن يشرعوا في الكتابة، يتخيّلون أنهم سيكونون في غاية السعادة حين يكتبون رواية ما، لكن سرعان ما يغرقون في هموم أبطالها، فيُصيبهم الهمّ والغمّ والحزن.
وإن كان القارئ الذي قضى بضع ساعات مع رواية ما وهو يقرؤها، فمات بطلها في النهاية، يحزن كثيرا لذلك، فما هو حال الكاتب الذي ربّما يكون قد قضى أكثر من سنة برفقة هذا البطل؟ ألن يشعر بأن صديقه المُقرّب قد اختفى فجأة؟ ألن يكون هذا الكاتب هو الأكثر تألّما لفراق بطلٍ هو أكثر العالِمين بحكايته من البداية إلى النهاية؟
أليس هو من قرّر ماذا يحبّ ذلك البطل وماذا يكره، مما يخاف وما الذي يشعره بالطمأنينة؟ أليس هو من قرّر تاريخ ميلاده ففرح حين وُلد، وعاش معه كل صراعاته ومسح دموعه وعانقه؟
هذا الكاتب مثلما فرح حين وُلد بطله، سيشعر بالوجع عند وفاته خاصة لأنه اضطر هو بنفسه لوضع تاريخ وفاة له. لكن العبرة تستوجب ذلك أحيانا، فالكاتب لا يقتل بطله طمعا منه بالمزيد من الوجع، بل يكون لديه هدف ما.
فالكاتب الذي يقرّر قتل بطل قصته التي تتحدث مثلا عن ولدٍ فقير يبيع ألواح الشوكولا على الطرقات، قد يريد بهذه الحركة أن نتعاطف مع هؤلاء الأطفال وأن نعي الخطر الذي يحدق بهم وهو يتجوّلون في الطرقات بدلا من أن يكونوا يدرسون في مدارسهم.
إن الموت هو سنة الحياة، وفي الكتابة، الموت هو رسالة عظيمة يستعين بها الكاتب رغم كل الألم الذي يسببه له، لكي يوصل أفكاره إلى أعماق وجدان وفكر القراء علّه يترك بدواخلهم تأثيرا ما.
ذات مرة قرأت تعليقا على فيسبوك، من قارئ، قال إنه كان يقرأ ذات مرة رواية ما، فحين ماتت فيها شخصية من الشخصيات بسبب التدخين، قرر هو المدخن الشّره، التوقّف تدريجيا عن التدخين.
فهل يكون الكاتب قد نجح في إيصال رسالته إلى المدخن هنا، أم لا؟ بالطبع استطاع ذلك، فقد جعل القارئ يتعلق بالشخصية، ومن ثم أرانا التعب الذي ألمّ بها بسبب التدخين ومن ثم الوفاة، وهنا اتخذ القارئ الخائف على صحته قرارا لطالما قام بتأجيل، لكنه ما عاد باستطاعته التأجيل بعدما قرأ ما قرأ، فهو لا يريد أن يموت كما ماتت الشخصية في تلك الرواية.
الكاتب يتألم، والقارئ يتألم، إذًا الجميع يتألمون، وهنا يأتي سؤال: من أين يأتي كل هذا الألم؟
إن هذا الألم يأتي من رحم المجتمع، وليس وليد المُخيّلة، فكم من مرّات تكون فيها مخيلة أمهر الكُتّاب أرحم بألف مرة من واقع مرير نعيشه؟!
وبما أن المجتمع يعاني من آلام لا تُعدّ ولا تُحصى، وبما أن الكاتب يقاوم ويتحرّر ويغيّر مصير بلاد من خلال كلماته المتدفقة على الأوراق، فإنه يكون على استعداد لقتل كل أبطاله في سبيل إنقاذ المجتمع.
هنا، تصبح الكتابة ساحة حرب يموت فيها الكاتب فيصفّق له القرّاء على إبداعاته، فيكون القتيل السعيد بنجاحه، على أمل أن يثمر نجاحه الأدبي تغييرا ملموسا في مجتمعه.

عدوية موفق الدبس (باحثة وكاتبة سورية - لبنان)
هل من طوق نجاة لهذه الحرية؟
دفترٌ بنفسجيّ صغير، مرصّع بالورود، يحمل قفلاً شبهَ حديدي، لكنّه هشّ، لو هبّ عليه النسيم لانكسر. بداخله سطور بخطوط مائلة، تتوسّد هامشًا أحمر من الجهة اليمنى. تجلس على هذه السطور كلماتٌ وجملٌ مثقلةٌ بأخطاء إملائية فادحة، تختلط فيها الكسرة بالياء، والفتحة بالألف، والطاء بالتاء، والضمة بالواو، ناهيك عن كلمات عامية، بل إنّ العامية نفسها تبرّأت منها، لكنّها أخطاء صادقة، قبل أن نتعلّم مراوغة الخطأ وتحكيمه وِفقًا للمسموح والممنوع من البوح.
ورغم كل ذلك، لقّبته صاحبته بـ "دفتر الأسرار"، وكانت تُغلقه مع كل غروب، بعد أن تدوّن فيه أقسى لحظات يومها الطويل، وكأنها تخشى أن تبوح به لغير الورق. تلك اللحظات التي لو وُضعت على ظهر بعير، لمات من الضحك!
حمل هذا الدفتر أسرارًا خطيرة لطفلةٍ لم تتجاوز الثامنة من عمرها، كتبت فيه عن ألمها حين رأت والدتها تقبّل خالتها التي تصغرها بعام، فغزت قلبها فكرة أن أمّها تخلّت عنها، وأنها لم تعد تحبها، وربما ستسمح لخاطفة الأطفال بأن تأخذها بعيدًا.
كتبت أيضًا عن خيبة أملها في والدها، حين تجاهل همسة "أحبك يا أبي"، التي خرجت بصوتٍ يكاد لا يُسمع، علّه يلتفت إلى فستانها الجديد، ويغمرها بعبارات الغزل. لكنه لم يفعل، فظنّت أنه ذهب إلى السوق واشترى لنفسه ابنةً جديدة!
حلمها البسيط بالسهر مع الكبار حتى وقتٍ متأخر لم يتحقق، رغم مفاوضاتٍ عائلية عُقدت تحت رعاية "سلطات عليا"، وتمّت الموافقة فقط لأن "غدًا عطلة". لكنها سرعان ما خذلها النعاس، فصار النوم عقوبةً لا مكافأة.
أما الفقد، فلم يتّسع له ذلك الدفتر، فاحتاجت إلى دفاتر عدّة لتكتب عن "صوصها" الأصفر، الذي لم يُرافقها سوى أربع ساعات، لكنه عاش في ذاكرتها أسابيع. كتبت عن لونه، وعن شغفه بالماء، وعن رقصاته ورياضاته الصغيرة، وكأنه مخلوق أسطوري. وربما لأن وفاته جاءت في ظروف غامضة... أو كما اعترفت في الصفحة الأخيرة: "أنا من قتلته". فقد كانت تحاول تعليمه الطيران، لأنه بلا أمّ، وأخبرتها والدتها أن "الأمّ تُعلّم كل شيء". فأرادت أن تكون له أمًّا، لكنه وقع من الشرفة... ومات.
كبرت الطفلة، وكبرت أحلامها البسيطة: الجلوس على طاولة الكبار، الاستماع لأحاديثهم الخطيرة، تذوّق طعامهم. كانت تحسد شقيقتها التي تكبرها بأربع سنوات لأنها تجلس على كرسيّ خشبيّ كبير، بينما هي تجلس على كرسيّ بلاستيكي صغير، وتُقدَّم لها الأطباق نفسها ولكن بأوانٍ مختلفة.
لم تكن كل الذكريات حزينة، فقد لمست رأس كلب ضخم أرعب أهل الحي، واحتفظت بجرادةٍ خضراء كبيرة، لأن لونها كان يُبهرها حتى اليوم.
كبرت، وكبرت معها الهموم. لم تعد تدوّنها في دفترٍ مقفل، بل حفرتها في الذاكرة، وسكنتها في القلب. وإن كتبت، فهي تكتب الآن بوجعٍ وحنين، إلى تلك الهموم الطفولية التي بدت اليوم... أبسط. تأكّدت أن الحبّ لا ينقص حين تقبّل أمّك غيرك، وأن الغزل من والدك في الكبر قد يُحرجك، وأن النوم صار الآن هديةً ثمينة بعد تعب الأيام.
تعلّمت أن الفقد لا يقتصر على الموت، فثمة أرواح ما زالت تسكن الأجساد، لكن القدر كتب لها الرحيل. وأن طاولة الكبار لا تحمل المجد، بل تعني الترتيب والغسل بعد الولائم. وأن الجرادة والكلب اللذان كانا يثيران فضولها، صارا من أكبر المخاوف.
هي الكتابة... تلك التي تحوّل مخاوفنا إلى حروف، كعلبة بندول تُسكّن أوجاع كل مجروح، وتحتوي أنين كل مهموم.
لكن، ماذا عن أولئك الذين فُرض عليهم أن يُقيّدوا حروفهم؟ من خُزنت كلماتهم في شريط أحمر أسفل شاشة الأخبار، حتى لا يُنفَوا من هذه الحياة؟!
لم تكن الكتابة يومًا قيدًا، بل كانت - وما زالت - حرية. نحن من قيّدناها، وارتدينا قناع النفاق، وادّعينا المثالية في حروفنا.. فهل من طوق نجاة لهذه الحرية؟

منيرة جهاد الحجّار (كاتبة وباحثة من لبنان)
بين الأمل والألم سرٌّ تخطُّه الكلمات
سرٌّ كُتب على جبين الحياة، ألمٌ، فَولادة، ثمّ حياة، سرٌّ يشقّ جيوب الأمل لينشره في كلّ مكان، يعتصر خمر الألم فيذوب عطرًا في كأس الكلمات! ما كان العمر يومًا يرشف طعم الفرح لولا عربون الألم، فأيّ لذّة تستحقّ إن لم تسعَ، وتتألّم؟ وأيّ أمل يخفيه الملل؟ وماذا لو انتحرت المشاعر؟
آلة حقيقيّة تدقّ ناقوس الخطر، وإنسان تسابق معها وأفرغ جرار الرّوح من المشاعر، فأيّ فرق بينهما؟ قد يصبح الإنسان آلة، لكن استحالة أن نأتي بآلة تعيش بين رجفة عين، ودمعة خُلقت لتموت، استحالة أن تجد آلة تلامس الرّوح وتخضع لحرارة المشاعر، وأمام ما نشهده اليوم من تكنولوجيا، ما الدّور الذي سيؤدّيه الإنسان، هل يكفي أن يكون مشرفًا؟
إن لم تكن إنسانًا فكيف تكتب؟ ولمن تكتب؟ وكيف بمن انتحرت مشاعره على حافّة الألم ليصنع بألمه جبيرة القلم، فيموت فوق أوراقه، يتسلّق المعنى وبين يديه حفنة من الآلام، تلك الآلام التي لم يعشها حقيقة في تجربته الفرديّة، إنّما أبحر في مهبّ الآلام الإنسانيّة، في تجربة شعوريّة نقلته إلى عالم الخيال! نعم، فالكاتب يتألّم مرّة في الخيال عندما يعيش تجارب النّاس، ومرّة في الواقع حين ينزف ألمًا فوق أوراقه، ومرّة عندما يتعثّر في حياته. من هنا فإنّ الإبداع وليد شعور يختصر رحلة الألم، وخيال ينقل الكاتب ليعيش دور شخصيّات متعدّدة، وإذا كان الألم أساسًا للإبداع، فكيف يمكننا أن نقول عن الذّكاء الاصطناعيّ مبدعًا؟ كيف يمكن له أن يلامس قلبًا لطالما كان يحتاج إلى من يشاركه حرارة المشاعر، إلى من يشاركه الحواس؟ لأنّ الحواس تمتصّ الألم، وتفتح أبواب الخيال لتطلّ على عالم مليء بالإبداعات... عالم وجد طريق النّجاة عبر الأدب، عالم حمّل قاربه كلمات تلاطمت في بحر الألم، لترسو على شواطئ الورق، ويبقى في العمق جراح كثيرة لا تُرى، ينبشها القارئ بحسب تجربته وثقافته.
ليس كلّ من يتألّم هو مبدع، لكنّ كلّ مبدع يتألّم بصور مختلفة، فيعيش صفحات حزن، وقلق، وتوتّر... إنّ الإبداع الحقيقيّ يخرج من اختناق شعور صادق، يعبّر عن ضجيج قابع تحت رماد كلمات صامتة، مات مؤلّفها وفتحت ذراعَيْها للمتلقّي، وهنا نعم قد يُساء فهم الكاتب، وقد يُقرأ النصّ بطريقة لم يقصدها الكاتب، لتعدّد التّجارب والثّقافات، وقد يُظنّ أنّها تجربة شخصيّة، وهي في الواقع قد تكون تجربة خياليّة التقت بمشاعر الآخرين، فخرقت قلب الكاتب وجعلته يتألّم ليحيك لنا إبداعًا صادقًا، حقيقيًّا!
كأنّك إن كتبتَ، ملكتَ العالم بمشاعرك، والألم اليوم حاضر في كلّ مكان، يختصر المسافات ليقف بين أيدينا، فتجوب العالم بكبسة زرّ، وتغوص في عمق مشاكل الكون، وهنا مسؤوليّة القلم كبيرة في التّعبير والإضاءة على ما يواجه الإنسان من تحدّيات، وما يتلقّاه من سموم تعلن موت الإنسان، فكيف يكون الإنسان إنسانًا إن تخلّى عن مشاعره، وقيمته في الحياة، ورسالته الإنسانيّة التي تختبئ خلف حروفه أو أعماله، وما قيمة الأدب إن صُنع صناعة بأوامر برمجيّة؟

بدر خالد شحادة (باحث وناقد من لبنان)
الكتابة.. وجع يفيض بالحياة
لا شكّ أن الكتابة، على اختلاف أشكالها وأنواعها، تحمل في طيّاتها صرخة كاتبٍ، ووجعَ أمةٍ، وتاريخًا متراكمًا من التجارب. هي ليست مجرّد كلماتٍ تُسَطّر، بل ضجيجٌ داخليّ يكاد يخترقُ الصدور، من القلبِ وإليه، ذهابًا حين تُنشر، وإيابًا حين تُقرأ.
الكتابة فعلٌ وجوديٌّ يُفجّر أوردة الذكريات، ويقتحمُ اللاوعي من قالب "اللاأدري" إلى حيّز "المعقول". فيها تنهار الحروف لحظة خطّها، فتتحوّل الأوهام إلى مرايا، والأحلام إلى ذكرياتٍ تئنّ بها الكلمات، وتبكيها "الموضوعية الجافة" التي نادى بها أولئك الذين زعموا الموضوعية؛ أولئك الذين يقتلون يوميًّا مشاعرَ الأديب، وذاتيةَ الشعر، وذائقةَ الروح النقيّة.. البريئة من نهجهم القاتل لكلّ إبداع.
إنه لا يخفى على أحد أن الوجع هو من أنجب الأدب، وخطّ الشعر، وبنى نهضةً، وكتب مآسيَ ما استطاعت أفراحُ الدنيا كلّها أن تُدوّنها. فكلّما وُضعت رشفةٌ من دمعةٍ على ميزان الحياة، طاشت أطنانُ السعادة، وانحنت أمام صدقِ تلك الدمعة ونقائها.
الشواهد على ذلك كثيرة، لقد فقدَ "طه حسين" بصره في سنٍّ مبكرة، لكنه تحدّى إعاقته ليصبح "عميد الأدب العربي"، وكتب سيرته الذاتية "الأيام"..
وأما "غسان كنفاني"، الحزن الذي أنجب الإبداع حيث تُعدّ روايته "رجال في الشمس" من أبرز أعماله، حيث تتناول معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، وتطرح تساؤلات عن مصيرهم في ظل الظروف القاسية. وفي روايته "أرض البرتقال الحزين"، يصف "كنفاني" الحزن الذي يعيشه الفلسطينيون بعد فقدانهم وطنهم..
في عام 1981، فقد الشاعر السوري "نزار قباني" زوجته "بلقيس الراوي" في تفجيرٍ دمويٍّ ببغداد. هذه الفاجعة ألهمته قصيدته الشهيرة "بلقيس"، حيث عبّر عن حزنه العميق وغضبه من الواقع العربي.
والشواهد كثيرة تحتاج مقالات ومقالات لتفنيدها..
إن الكتابة ـ إذًا ـ ليست ترفًا ولا تكلّفًا.. إنّها نَزيفُ من صدقٍ، ومرآةُ زمنٍ، وصوتُ مَن لا صوتَ له بحق!!

عمّار بلخضرة (ناقد من تونس)
الكتابة وأوجاعها.. جرح مفتوح تتسلّل منه الكلمات!
ليست الكتابة مجرد وسيلة للتعبير، هي وسيلة للوجود ذاته. هي أكثر من الكلمات التي تُنسج في جمل؛ هي رحلة في مساحاتنا الداخلية، إذ لا تلتقي الأفكار دائمًا، ولا يتساوى الشعور مع الكلمة. الكتابة، بالنسبة إليّ، هي نوع من المقاومة. مقاومة للزمن الذي يمرّ سريعًا، وللألم الذي يتراكم، وللصمت الذي يحيط بنا حينًا بعد آخر. إنها المعركة التي نَخوضها داخل أنفسنا، لنفهم من نحن، ولماذا نكابد، وما الذي يجعلنا نكتب دون أن نعرف السبب في أحيانٍ كثيرة؟
في لحظات الكتابة، تَسكن الكلمات في حنجرتنا، تنتظر أن تُطلق سراحها. قد تُقاومنا بعض الأحيان، كما لو أنها خائفة من الوقوع في فخّ الوصف، لكنها في النهاية تهرب من بين أصابعنا، وتجد طريقها إلى الورقة التي تصبح مسرحًا للخيال والذاكرة والوجع. الكتابة، إذًا، ليست فقط عملية نقل الأفكار إلى كلمات، بل هي محاولة للإمساك بكل شيء غير مرئي، وتقديمه للعيون التي قد لا تدركه إلا عند قراءته.
كل نصّ يُكتب هو محاولة جديدة لفهم الزمن، ولتفسير هذا العالم الذي يبدو أحيانًا غريبًا، وأحيانًا أخرى غير قابل للفهم. هي محاكاة لرحلة الإنسان مع نفسه، سعي دائم في البحث عن المعنى، عن الجمال، عن الحرية. وكما أن الحياة هي سلسلة من اللحظات التي لا نعرف إن كانت ستتكرر أو تنقضي، هكذا الكتابة؛ هي محاولة لإيقاف اللحظة التي تهمس لك فيها الأفكار، وتفتح أمامك أبوابًا لم تُكتشف بعد.
والكتابة ليست دائمًا مبهجة، ليست دائمًا تحريرًا، ولا دائمًا مجرد فعل إبداعي يفرغ القلب من همومه. الكتابة، في الكثير من الأحيان، تكون الوجع نفسه. هي جرح مفتوح تتسلل منه الكلمات، وجع لا يمكننا إخفاؤه أو تجاهله، لأن الكتابة تفضحنا. هي عملية مؤلمة، كما لو أنك تحاول أن تلتئم بينما تفتح الجرح من جديد. لا شيء في الكتابة يبدو سهلًا حين تكون عميقة. الحروف تصبح أثقل من أن تحملها أصابعنا، والكلمات تُشبه قطع الزجاج التي تتناثر داخل النفس، مذكّرة إياك بما كنت تخشاه، بما كنت تخفيه، بما لا تريد أن تراه عيون العالم.
حين تكتب، فأنت لا تكتب فقط عن أفكارك، بل تكتب عن الألم الذي لا يتوقف. تكتب عن ذلك الفضاء الذي لا يمكنك ملؤه بالكلمات البسيطة، لأن الكلمات تتعب مثلك، وتتألم مثلك. وفي كل مرة تكتب، تفتح بابًا من الذاكرة، وتدعو اللحظات المؤلمة لتدخل. الكتابة ليست مجرد نقلٍ لما في ذهنك، بل هي إعادة صِياغة لجروحك القديمة. هي أن تخرج من عزلتك لتواجه نفسك، لتكون عاريًا أمامك أولًا، ثم أمام العالم.
الوجع في الكتابة لا يأتي فقط من الألم الذي نريد إيصاله للآخرين، بل من صراعنا الداخلي مع الكلمات التي لا تكفي. نحن نبحث دائمًا عن كلمات لا تعبّر عن كل شيء، كلمات تصف كل ذلك الألم الذي يطوّقنا دون أن يكون له اسم. ونحن نكتب، نتمنى أن نصل إلى نقطة نتمكن فيها من إخراج ما في داخلنا بشكل كامل، لكننا نعلم في أعماقنا أن الكتابة تظل ناقصة، تبقى دائمًا في حالة بحث.
وما يوجع أكثر في الكتابة هو اللحظات التي نشعر فيها بالعجز. لحظات نكتب فيها، ثم نمزّق ما كَتبنا، ثم نعيد الكتابة، ثم نغرق في شكوكنا. "هل هذا يعبّر عني؟ هل الكلمات هذه ستُفهم؟"، هكذا يتكرر الوجع في الكتابة، حين نحاول أن نفهم أنفسنا من خلال الحروف، وعندما نعجز عن نقل كل ما يختلج في داخلنا.
وفي اللحظات التي تكتب فيها عن الفقد، عن الخيبة، عن الأمل الذي تلاشى، عن الأحلام التي لم تكتمل، يصبح الوجع جزءًا من الكلمة نفسها. الكلمة لا تتحول إلى شفاء، بل إلى مرآة تبعث الألم على سطحنا، وتضعه في وضح النهار. الكتابة حينها تصبح عبئًا، لكنها في الوقت نفسه، هي السبيل الوحيد لتجاوز ذلك العبء. حينما لا نجد في الحياة من يفهمنا، نجد في الكتابة تلك المساحة الوحيدة التي تتيح لنا أن نكون كما نحن، بلا أقنعة.
الكتابة تجرّنا إلى العزلة أحيانًا، وتضعنا في مواجهة مع قلوبنا التي لا نستطيع الهروب منها. لكنها، رغم كل ما تحمل من وجع، تمنحنا شيئًا من القوة في النهاية. إنها تذكير لنا بأننا أحياء، وأننا قادرون على التعبير عن أنفسنا، رغم كل شيء.
هناك العديد من الكتابات الأدبية التي تغرق في وجع الكتابة، وتتناول الألم المرتبط بالكلمات وكيف يمكن لها أن تعكس جراح الكاتب نفسه. وفيما يلي أمثلة من أعمال أدبية مشهورة تطرّقت إلى هذا الموضوع..
وجع الكتابة في الأدب العالمي
"الغريب" (ألبير كامو): "كامو" في كتابه "الغريب" لا يركز فقط على الصراع مع العالم الخارجي، بل مع الذات أيضًا. بطل الرواية، "موسول"، يصف عالمه بطريقة متجردة وعقلانية، ولكن هناك معاناة كامنة خلف كل جملة. الوجع في الكتابة في هذه الرواية يظهر في الكيفية التي يتعامل بها الكاتب مع سرد القصة: هو يكتب عن الحياة كأنها لا معنى لها، وفي هذه الكتابة ذاتها، يعكس العدم والمعنى الضائع.
"آلام فيرتر" (يوهان غوته): في هذا العمل، يتعامل جوته مع الوجع النفسي العميق الذي يعيشه فيرتر بطل الرواية. الكتابة في "آلام فيرتر" هي وسيلة للاحتجاج ضد القوانين الاجتماعية وحواجز القلب. فيرتر يكتب عن معاناته من الحب الذي لا يُستجاب، وفي هذه الكتابة يظهر الألم، لكن لا يشفى. الكتابة تصبح سجنا للأحاسيس، بدلًا من أن تكون مخرجًا للراحة.
"في قبوي" (دوستويفسكي): في كتاب "في قبوي"، يذهب "دوستويفسكي" في الكتابة إلى أعماق الوجود الإنساني، ويُظهر كيف أن الكتابة تُعبّر عن تمزّق الذات وعزلة الفكر. الكتابة لا تخدم هنا كأداة للخلاص أو للراحة، بل أداة للتغلب على الوجود المؤلم. في هذا العمل، يظهر الوجع بوضوح في الصراع بين الكتابة والواقع، حيث تنسج الحروف خيوطًا تجرّ معها هوياتنا المحطمة.
"الإنسان والبحث عن المعنى" (فيكتور فرانكل): "فرانكل" في هذا الكتاب يروي تجربته الشخصية في معسكرات الاعتقال النازية، ويعرض كيف أن الكتابة كانت أداة للتغلب على الألم الوجودي. الكتابة هنا ليست فقط لتوثيق الألم، بل أيضًا للبحث عن المعنى وسط العذاب. الكتابة تصبح الطريقة الوحيدة للتمسك بالأمل في عالم فقد فيه كل شيء.
"العطر" (باتريك زوسكيند): في "العطر" يطرح "زوسكيند" فكرة الكتابة كفن عذاب. من خلال بطل الرواية "جان باتيست جرونوي"، الذي يسعى إلى لصنع عطر خارق يُجسّد فيه عذاباته النفسية، يُظهر "زوسكيند " كيف أنّ البحث عن الكمال يعمّق المعاناة، وأن الكتابة في هذه الحالة هي عملية مؤلمة تستمدّ جذرها من القسوة والحاجة إلى فهم العالم عبر الألم.
وفي العديد من الكتابات الألمانية المعاصرة، وخاصة أعمال "فرانز كافكا"، نجد الكتابة تتجسد في صورة وجودية مؤلمة. في "المحاكمة"، يتم استخدام اللغة بشكل يعكس الضياع والقلق الوجودي، وتظهر الكتابة كـ "ملجأ" في مواجهة النظام الاجتماعي والسياسي القاسي. الوجع في الكتابة يظهر كأداة لتفسير وتفريغ المشاعر الداخلية التي يصعب التعبير عنها في الواقع.
وجع الكتابة في الأدب العربي المعاصر
الكتابة في الأدب العربي المعاصر غالبًا ما تكون انعكاسًا مباشرًا للألم الشخصي أو الاجتماعي. الوجع ليس مجرد إبداع بل هو مخرج، إذ يعبّر الكُتّاب عن معاناتهم تجاه قضايا مثل: الهوية، الاغتراب، الحرب، الفقر، الخيانة. في كثير من الأحيان، نجد الكتابة تصبح وسيلة لتحرير النفس من هذه الأوجاع، ولكن في الوقت نفسه تبقى تحت وطأة هذا الوجع، فلا شفاء تام، بل هو مجرد لحظات من التعبير عن ذلك الألم.
" أولاد حارتنا" (نجيب محفوظ): "أولاد حارتنا" من أبرز أعمال "نجيب محفوظ" التي تُظهر التوتر بين الأيديولوجيا الدينية والاجتماعية من جهة، والإنسانية المعذّبة من جهة أخرى. في هذه الرواية، الوجع ليس فقط وجع الكتابة، بل وجع وجودي، يعيشه الفرد في مواجهة مع الحياة والموت. الكتابة هنا تقوم على محاكاة الشخصيات التي تبحث عن معنى في عالم مضطرب، حيث تُعبّر الألم عن النضال مع الحياة نفسها.
"موسم الهجرة إلى الشمال" (الطيب صالح): هذه الرواية الشهيرة، التي كتبها "الطيب صالح" في 1966، تتناول صراع الهوية والاغتراب. من خلال شخصية "مصطفى سعيد"، الذي يعود إلى بلاده بعد دراسته في لندن، تتبدّى المعاناة النفسية والفكرية حول مفهوم الهوية الشرقية الغربية. الكتابة هنا تحمل وجع الاغتراب الداخلي، فالخوف من عدم الانتماء، وعدم التمكن من التوفيق بين الحياة في الغرب والشرق، يظهر عبر سرد الرواية. الوجع في الكتابة هنا يكمن في صراع الذات مع الانتماء، وكيف أن هذا الصراع ينعكس في الكلمات التي يكتبها.
" الخبز الحافي" (محمد شكري): رواية "الخبز الحافي" هي مذكرات شخصية للكاتب "محمد شكري" الذي يتحدث عن حياته في المغرب، ويعكس فيها معاناته من الفقر والتهميش الاجتماعي. الكتابة هنا تتجاوز كونها وسيلة للتعبير، لتصبح صرخة ضد المعاناة اليومية. الكاتب يكتب عن معاناته في شوارع "طنجة"، وعلاقته مع الفقر والجوع، والحرمان النفسي. الوجع في الكتابة هنا يتجسد في عري الكلمات، إذ لا يوجد شيء لتجميل الواقع، والكتابة هي وسيلة لتحرير نفسه من سجنه الداخلي والخارجي.
"حكاية بحار" (حنا مينه): "حنا مينه"، في "حكاية بحار"، يسرد حكاية (سعيد حزوم) ابن بحار مغامر هو (صالح حزوم)، والذي كان يمثل قمة الرجولة وحب المغامرة، ليس لدى سعيد فحسب بل لدى كل الذين خبروا البحر وعرفوا تحولاته. تعرض الرواية محاولات (سعيد) ليكون صورة عن والده الذي اختفى في ظروف غامضة، ونشاهد في سير الأحداث التخبط والصراع الذي يواجهه البطل في سبيل أن يكون هو ذاته امتداداً لحياة وبطولات والده، لا مجرد شخص يعيش في ظل سيرة والده المعروفة. الكتابة في هذه الرواية تقوم على البحث عن الهروب من القيود التي تفرضها الحياة، لكن في الوقت نفسه يظهر الوجع الداخلي الذي لا يترك الشخصية.
"خارج المكان" (إدوارد سعيد): رغم أن "إدوارد سعيد" معروف بمقالاته النقدية حول الثقافة والسياسة، إلا أن كتابه "خارج المكان" يعكس وجع الكتابة في صراع الإنسان مع العالم من حوله. الكتابة هنا تصبح محاولة لفهم العزلة التي يواجهها الفلسطينيون في الشتات. "سعيد" يستخدم الكتابة كأداة لتحليل الوجع الشخصي والجماعي، وكيف أن الإنسان الذي يواجه القهر والموت يظل يحاول كتابة معنى لمصيره.
"ذاكرة الجسد" (أحلام مستغانمي): في "ذاكرة الجسد" تأخذنا "أحلام مستغانمي" في رحلة من الحزن والوجع النفسي عبر قصة حب ملتهبة وغير مكتملة. الكتابة هنا ليست فقط عن الحب، بل عن الخيانة، والضياع، والتضحية. الوجع هنا يعكس مشاعر الألم والخذلان في العلاقات العاطفية، إذ تصبح الكلمات سيوفًا، تُدمي القلب كلما كَتب عنها بطل الرواية. الكتابة تتنقل بين الرغبة في الشفاء والندم على الماضي، وبين البحث عن سكينة في الوقت الحالي.
هذه بعض الأمثلة التي تُظهر كيف أن الكتابة قد تكون المرآة التي يعكس فيها الكاتب آلامه. الكتابة لا تعني دائمًا الشفاء، بل هي في بعض الأحيان مصارعة مع الذات، وسبيل للتعايش مع الوجع الذي لا ينتهي.
الوجع في شعر "محمود درويش"
"محمود درويش"، شاعر فلسطين الكبير، يُعدّ من أبرز الشعراء الذين استطاعوا أن يُعبّروا عن الوجع بأسلوب فني رفيع، فقد جعل من الألم، سواء كان ألم الاغتراب، الفقد، أو القهر السياسي، جزءًا من تجربته الإبداعية. وفي قصائده، تتحوّل الكتابة عن الوجع إلى لحظات من التحرّر الوجداني، رغم الألم الذي يغلّف الكثير من نصوصه. يمكن القول إن وجع الكتابة عند "درويش" ليس مجرد تسجيل للألم، بل هو رحلة بين الكلمات لمحاولة فهم هذا الوجع، ومحاولة للانتصار عليه.
1 - الوجع الوطني والإنساني: كان "درويش" يمثل صوت فلسطين، وصوت المظلومين في وطنه وفي الوطن العربي بأسره. في قصائده، نجد أن الوجع لا ينحصر في الألم الشخصي، بل يتعدّاه إلى الألم الجمعي. شعره مليء بالتعبير عن معاناة شعبه من الاحتلال، والغربة، والشتات، وفقدان الهوية.
في قصيدته الشهيرة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، نجد "درويش" يكتب عن الوجع الذي يعانيه الإنسان الفلسطيني بشكل يومي، ولكن في الوقت نفسه، يتحدث عن التمسك بالحياة رغم كل الظروف. هنا، الوجع لا يعني الاستسلام، بل هو التمرد على الضعف، ومحاولة العثور على فرص الحياة في أقسى الأوقات. يقول "درويش":
على هذه الأرض ما يَستحِقُّ الحياة: على هذه الأرض سيَّدةُ الأُرض، أُمُّ البداياتِ أُمّ النِّهايات. كانت تُسَمَّى فلسطين. صارَت تُسمَّى فلسطين. سيِّدَتي: أَستحِقُّ، لأنَّكِ سيِّدتِي، أَستحِقُّ الحياة.
2 - الوجع الشخصي والوجودي: في قصائد "درويش"، يظهر الوجع الشخصي في العديد من النصوص التي تتحدث عن الخيانة، الفقد، أو الانتظار الطويل. مثلًا في قصيدته "لا تعتذر عما فعلت"، نجد الوجع العاطفي يبرز بوضوح، حيث يكتب "درويش" عن الخيانة والخيبة، ولكن بلسان شاعري يُنظّم الألم بأسلوب فني راقٍ، يقول "درويش":
لا تعتذرْ عمَّا فَعَلْتَ – أَقول في
سرّي. أقول لآخَري الشخصيِّ:
ها هِيَ ذكرياتُكَ كُلُّها مرئِيّةٌ:
ضَجَرُ الظهيرة في نُعَاس القطِّ
عُرْفْ الديكِ
عطرُ المريميَّةِ
قهوةُ الأمِّ
الحصيرةُ والوسائدُ
بابُ غُرفَتِكَ الحديديُّ
الذبابةُ حول سقراطَ
السحابةُ فوق أفلاطونَ
ديوانُ الحماسةِ
صورةُ الأبِ
مُعْجَمُ البلدانِ
شيكسبير
الأشقّاءُ الثلاثةُ، والشقيقاتُ الثلاثُ
وأَصدقاؤك في الطفولة...
في هذه الأبيات، نجد الوجع يتداخل مع الفلسفة الوجودية، إذ يصبح الألم جزءًا من المعركة اليومية التي يعيشها الإنسان، مع الحياة والحب.
3 - الوجع الثقافي والسياسي: تجسد الكتابة عن الوجع السياسي في شعر "درويش" من خلال العديد من القصائد التي تركز على المقاومة، الصراع مع الاحتلال، وفقدان الوطن. في قصيدته "بطاقة هوية"، يعبّر عن الوجع الفلسطيني، ولكن أيضًا عن كرامة الإنسان في مواجهة قسوة الواقع. هنا، يعكس الوجع الفلسطيني من خلال التمسك بالهوية والرفض القاطع للظلم.
سجِّل.. برأسِ الصفحةِ الأولى
أنا لا أكرهُ الناسَ
ولا أسطو على أحدٍ
ولكنّي.. إذا ما جعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي
حذارِ.. حذارِ.. من جوعي
ومن غضبي!!
يربط "درويش" بين الألم والهوية، حيث لا يمكن الفصل بين الوجع والهوية الفلسطينية التي تُفرض عليها محو التاريخ والوجود. الكتابة تصبح بذلك شكلًا من المقاومة ضد محو الذاكرة والهوية.
الوجع دافعٌ للكتابة
في شعر "محمود درويش"، نلاحظ أن الكتابة عن الوجع ليست سلبية أو مُحطمة، بل هي طريق نحو التغيير، إعادة صياغة الألم. الكتابة تصبح أداة لتوثيق المأساة، لكن أيضًا أداة لبناء الوجود، الهوية، والكرامة. من خلال الكلمات، يَخلق "درويش" مقاومة ضد الألم ويُحوّل الوجع إلى أداة للحرية والجمال.
وإذًا، فإنّ "محمود درويش" في قصائده لا يكتب فقط عن الوجع الفلسطيني، بل عن كل الوجع الإنساني. الكتابة لديه هي وسيلة لتوثيق التاريخ، وتجسيد الصراع بين الوجود والعدم، بين الحياة والموت، وبين الحب والخيانة. الوجع في شعره ليس أمرًا ثابتًا، بل هو محرك للتحرر، وكل قصيدة له هي معركة ضد الظلم وضد ضياع الذات.
خاتمة الكلام
الوجع في الأدب ليس مجرد شعور سلبي أو حالة عابرة؛ بل هو عنصر أساسي في التحولات الوجدانية التي يعيشها الإنسان، ويعكس عمق التجربة الإنسانية بكافة أشكالها. عبر تاريخ الأدب، كان الوجع هو المحرك الرئيسي للكثير من النصوص الأدبية العميقة، بدءًا من معاناة الشعوب تحت نير الاستعمار، وصولًا إلى الوجع الوجودي الشخصي الذي يعبر عن العزلة، والخيانة، والفقد.
في الأدب العربي المعاصر، كما في الأدب العالمي، نجد أن الكتابة عن الوجع تتجاوز مجرد التعبير عن الألم، بل تصبح أداة للتغيير والـمقاومة. الكتابة تصبح وسيلة لتحويل هذا الألم إلى قوة إبداعية قادرة على توثيق التاريخ، وتحقيق الشفاء النفسي، بل وأكثر من ذلك، تفتح أفقًا للبحث عن الأمل رغم الظلمات.
الوجع في الأدب لا يقتصر على كونه صرخة يائسة، بل هو أيضًا دعوة للحياة، وسعي نحو الفهم، والسعي نحو الحرية. ومن خلال الشعر والرواية والمسرح والمقالة، يُعيد الأدباء رسم ملامح الوجود الإنساني، حيث لا يكون الألم مجرد عبء، بل هو جزء من كينونة الإنسان، محرك له لاستكشاف نفسه والعالم من حوله.
في النهاية، يبقى الوجع في الأدب حافزًا للإبداع وبوابة لفهم أعماق الإنسان. ومن خلاله، يتمكّن الأدب من العبور إلى الروح الإنسانية، وفتح أفقها على إمكانيات لا متناهية للتعافي والنمو والتجدد.










