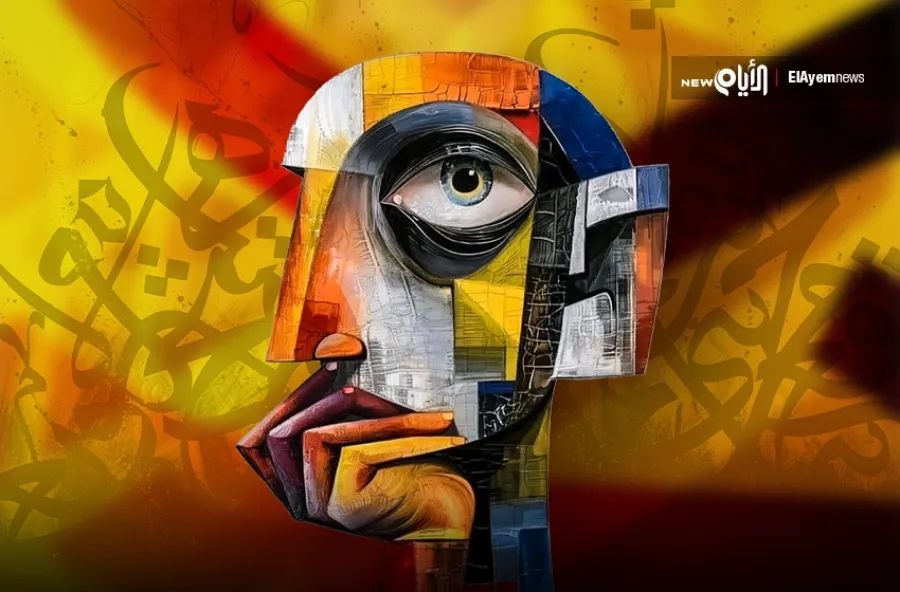في الصراع الأبدي بين الخير والشرّ، ينتصر الخير بذاته لأنه مرتبطٌ بالخير المطلق، وأما الشرّ - حتى ولو كان مُطلقًا - فإنه لا يستطيع خوض الصراع بذاته لذلك يلجأ إلى التحالف مع مختلف القوى الشرّيرة، إنسيّة كانت أم جنيّة، ولكنه ينكسر وينهزم في النهاية. وما نراه في غزّة - مثلا - هو صراع الخير، الذي يمثّله الشعب الفلسطيني الأعزل، ضد تحالف قوى الشرّ، ولا ريب أن غزّة بذاتها ستنتصر في النهاية لأنها مرتبطة بالخير المُطلق، ولا يُمكن لتحالف قوى الشرّ أن تهزمها لأن الأمر وقتها يكون أشبه بانقلابٍ كونيٍّ في نظام العدالة الإلهية، وانتصار الشيطان على الخير المُطلق. وبعبارة أخرى، لا يُمكن للباطل أن يهزم الحقّ، ولكن وفق إرادة الحق وليس وفق إرادة أهل الحق.
"الجنّ" من القوى التي يحاول الشرّ أن يستعين بها ليحقق انتصاره على الخير، ولكن التاريخ لم يحدّثنا عن قُدرة الجنّ على تغيير مجرى التاريخ الإنساني، أو تحقيق انتصار جيش على جيش مثلا، ولكنه حدّثنا عن محاولات تسخير الجنّ من طرف ملوك وسلاطين وحُكّام، منذ زمن "حامورابي" فيما قبل التاريخ إلى أعوان "هتلر" في القرن العشرين، لخدمة أغراضهم العسكرية، بل حدّثنا عن عصابات دولية احترفَت تقديم خدماتها إلى زعماء وسياسيين ومشاهير من خلال جلسات استحضار الأرواح وقراءة الفنجان وفتح المندل وغيرها من الطُّرق التي تزعم قراءة الغيب.
يُقال بأن الجنّ أخيارٌ وأشرار، لهم هيئات وصفات متعدّدة، وتكاد الكتب التي تحدّثت عنهم تُجمع على ما أورده الدكتور "عمر سليمان الأشقر" (1940 - 2012) في كتابه "عالم الجن والشياطين"، قال في باب "أسماء الجن في لغة العرب وأصنافهم": "قال ابن عبد البر (فقيه ومؤرّخ أندلسي): الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب: فإذا ذكروا الجن خالصًا، قالوا: جنّي. فإذا أرادوا أنه ممّا يسكن مع الناس، قالوا: عامر، والجمع: عمّار. فإن كان مما يعرض للصّبيان، قالوا: أرواح. فإن خبُث وتعرّض، قالوا: شيطان. فإن زاد على ذلك، فهو مارد. فإن زاد على ذلك وقوي أمره، قالوا: عفريت، والجمع: عفاريت. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ (الجن ثلاثة أصناف: فصنف يطير في الهواء، وصنف حيّات وكلاب، وصنف يحلّون ويظعنون)، رواه الطبراني، والحاكم، والبيهقي في الأسماء والصفات، بإسناد صحيح".
وجاء في كتاب "كنز الدُّرر وجامع الغرر" للمؤرّخ "أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري" (ت 1462): "قال المسعودي (مؤرّخ وجغرافي): زعموا أنّ الشياطين خمسة وثلاثون قبيلة، وأنّ الذين يطيرون في الهواء خمسة عشر قبيلة، والذين يمشون على أرجلهم خمسة وعشرون قبيلة، والذين في الماء عشرون قبيلة، والذين يمشون ويخرجون مع الزوابع اثنا عشرة قبيلة، والذين خُصّوا بلهب النيران عشر قبائل، ومُسترقو السّمع ثلاثون قبيلة، وسكّان الهواء وهم مثل الدخان ثلاثون قبيلة، ولكلّ طائفة من هؤلاء القبائل ملك يردّ شرّهم".
أما عن أسماء قبائل الجنّ، فنذكر: بنو القماقم، بنو قيعان، بنو غيلان، الشماشقة الغاوون، الطماطمة، بنو الأحمر، الميامين (منهم: ميمون السّحابي، ميمون الغوّاص، ميمون الغمامي..)، سكان المزابل، سكان الخرابات، أهل الزوابع.. ومن ملوك الجنّ السبعة، حيث كل واحد منهم يقدّم خدماته يومًا واحدًا في الأسبوع، ويُقال بأن يعضهم هو خادمٌ لسورة قرآنية، نذكر: الملك شمهورش، الملك مُرّة، الملك ميمون أبانوخ.. وتذكر الكُتب أسماء الجنّ اليهود فمنهم: زنقط، القط الأسود، الغَضوب.. وأمّا الجن النصارى فمنهم: طلمش، خربط ابن زخبيلة بنت الملك الأحمر..
ولإبليس ابناءٌ أيضًا، ولكل منهم تخصّصه، وقد اختلفت أسماؤهم من كتابٍ إلى آخر، ونذكر منهم ما أورده "بدر الدين العيني" (ت 855 هـ) في كتابه "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، قال: "روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن لإبليس أولادا كثيرين واعتماده على خمسة منهم شبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور، وقال مقاتل: لإبليس ألف ولدٍ، ينكح نفسه ويلد ويبيض كل يوم ما أراد، ومن أولاده المذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضي، وجعل كل واحد منهم على أمر ذكرته في تاريخي الكبير، ومن ذريّته: الأقنص وهامة بن الأقنص ويلزون وهو الموكل بالأسواق وأمّه طرطية ويقال بل هي حاضنتهم، ذكره النقاش، قالوا: باضت ثلاثين بيضة :عشرة بالشرق وعشرة بالمغرب وعشرة في وسط الأرض، وأنه خرج من كل بيض جنس من الشياطين كالعفاريت والغيلان والحيّات وأسماؤهم مختلفة كلهم عدوٌّ لبني آدم، أعاذنا الله من شرّهم، وله جنود يرسلهم إلى إضلال بني آدم. وقد روى ابن حبّان والحاكم والطبراني من حديث أبى موسى الأشعري مرفوعا قال: إذا أصبح إبليس، يبعثُ جنوده، فيقول من أضلَّ مسلما ألبسته التاج الحديث، وروى مسلم من حديث جابر سمعت رسول الله يقول: عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة". لعلك لاحظت عزيزي القارئ بأن أسماء قبائل الجن وملوكهم وأبناء إبليس.. معظمها باللغة العربية، وهذا أمرٌ ليس لي في أيّ تفسير!
لعلّ السؤال يلحّ عليك عزيزي القارئ، هل من أحدٍ شاهد الجنَّ بأمّ عينيه؟ ودعني أحدّثك بشيء من التاريخ، ففي الربع الأول من القرن العاشر الميلادي قام الرحّالة "أحمد بن فضلان" برحلة "إلى بلاد الترك والروس والصقالبة"، المعروفة بـ "رسالة ابن فضلان"، وحدّثنا عن مشاهداته في بلاد ملِك الصّقالبة، قال: "ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيها كثرةً، من ذلك: أنّ أوّل ليلة بتناها في بلده (ملِك الصقالبة)، رأيتُ، قبل مغيب الشّمس بساعة قياسية، أفق السماء، وقد احمرّت احمرارًا شديدًا، وسمعت في الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية، فرفعت رأسي، فإذا غيمٌ أحمر مثل النّار قريبٌ مني، وإذا تلك الهمهمة والأصوات منه، وإذا فيه أمثال النّاس والدّوابّ، وإذا في أيدي الأشباح، التي فيه تشبه النّاس، رماح وسيوف أتبيّنها وأتخيّلها، وإذا قطعة أخرى مثلها أرى فيها أيضا رجالا ودوّاب وسلاحا، فأقبلت هذه القطعة تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة، ففزعنا من ذلك، وأقبلنا على التضرّع والدعاء، وهم يضحكون منا ويتعجّبون من فعلنا".
وأضاف: "وكنّا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة، فتختلطان جميعا ساعة ثم تفترقان، فما زال الأمر كذلك ساعة من اللّيل ثمّ غابتا، فسألنا الملك (ملك الصّقالبة) عن ذلك فزعم أنّ أجداده كانوا يقولون: إنّ هؤلاء من مؤمني الجنّ وكفّارهم وهم يقتتلون في كل عشيّة وإنّهم ما عدِموا هذا مُذ كانوا في كلّ ليلة".
و"ابن فضلان" لم ير الجن فحسب بل رأى فردًا ينتمي إلى يأجوج ومأجوج، قال: "فإذا أنا بالرجل، وإذا هو بذراعِي اثنا عشر ذراعًا.. وإذا له رأس كأكبر ما يكون من القُدور، وأنف أكثر من شبر، وعينان عظيمتان، وأصابع تكون أكثر من شبر. فراعني أمره وداخلني ما داخلَ القوم من الفزع وأقبلنا نكلّمه ولا يكلّمنا بل ينظر إلينا.. فحملته إلى مكاني، وكتبتُ إلى أهل ويسو، وهم منّا على ثلاثة أشهر، أسألهم عنه، فكتبوا إليّ يعرّفونني أنّ هذا الرجل من يأجوج ومأجوج، وهم منا على ثلاثة أشهر، عُراة، يَحول بيننا وبينهم البحر لأنّهم على شطّه، وهم مثل البهائم ينكح بعضهم بعضا.. فلم يكن ينظر إليه صبيّ إلا مات، ولا حامل إلا طرحت حملها، وكان إن تمكّن من إنسان عصره بيديه حتى يقتله".
وأذكّرك عزيزي القارئ بأنني اخترتُ لك "رسالة ابن فضلان" لأنها نالت حظًّا وافرًا من الدراسات العربية والغربية، وبعض الباحثين اعتمدوا عليها في توثيق تاريخ الصّقالبة، هم سكّان شمالِ القارَّة الأوربيَّة، على أطرافِ نهرِ الفولغا.. و"ابن فضلان" نفسه كان مُوفدًا رسميًّا في رحلةٍ من طرف الخليفة العبّاسي "المقتدر" إلى بلاد الصقالبة الذين طلبوا عونه، "استغرقت الرحلةُ أحد عشر شهرًا في الذّهاب، وكانت مليئةً بالمغامراتِ والمشاقّ والمصاعب السياسيَّة والانفتاحات على الآخر المختلفِ ثقافيا"، (المُقتبس من قراءة للكاتب العراقي "شاكر لعيبي" حول رحلة "ابن فضلان" وملاحظات حول دارِسيه).
عزيزي القارئ، الحديث عن الجن يُحيل الذّهنَ إلى السّحر مباشرة، لأن السَّحرة يسخّرون الجنّ في الأعمال الشرّيرة مثل: تقديم أطفالٍ بمواصفات خاصة قربانًا للجن من أجل الوصول إلى كنوز الذّهب، وجلب المحبوب وغيرها من الأمور الشيطانية. غير أن هناك من يقول بوجود السّحر الحلال، ويرى بأن السّحر فيه "علوم الحكمة" أيضًا مثل: علم الزّيارج والجفر، علم الرّمل، علم الحرف والعدد.. ولعلّ علم العدد هو الذي شاع خلال السنوات الأخيرة فهناك من استعمله - مثلا - في استنباط تاريخ زوال "إسرائيل" من آيات القرآن الكريم. ولاحظ عزيزي القارئ أن بعض فنون السّحر تُسمّى علومًا ربّما لأنها لا تعتمد على الجنّ أو لأنّ لها مناهج وأصول وقواعد حسابية ورياضيّة مثل: العدد والزيارج، بل أنّ بعض هذه العلوم تجدها فصلاً مستقلاًّ في الطبعات القديمة لأشهر كُتب التراث الديني خاصّة مثل كتاب " الإتقان في علوم القرآن" للإمام "جلال الدين السيوطي"، واعتقادي بأن "تضمين" تلك العلوم في الكتب الدينية له أهدافه الشيطانية، وهذا موضوع آخر، لا سيما فيما يتعلّق بالإمام "السيوطي" فقد نُسبت إليه كُتب ورسائل في "الجنس" لتشويه هذا العلاّمة العظيم، وحرمان العقل العربي من مؤلّفاته الجليلة..
من المُجدي أن أحدّثك عزيزي القارئ عن الجن في الأدب العربي مثل كتاب "ألف ليلة وليلة" وما يتضمّنه من حكايات حول المصباح السحري وبساط الريح وغيرها من الحكايات، إضافة إلى ارتباط شعراء كثيرين بالجن، فقد كان الاعتقاد السائد في العصر الجاهلي بأن لكل شاعر جنيًّا "يوحي" إليه بالشعر.. أو أحدّثك عن الجنّ في ثقافتنا الشعبية، وأروي لك قصصًا عن تخويف الأطفال من الغول و"تيس القيّالة" (عتروس القايِلة)، وأقاصيص حول زواج الجني من الإنسية أو الإنسي من الجنيّة وما دار من نقاشات حتى بين العلماء حول مشروعية هذا النوع من الزواج، وحكايات عن اختطاف الجني للأطفال، وما لا يُحصى من القصص حول تلبّس الجن للإنسان، ورصد الكنوز القديمة، والظواهر الغريبة، مثل اشتعال النيران، والتي لا تفسير علميٍّ لها إلاّ أن تكون بسبب قوى خفيّة..
في هذا السياق، يُمكنك عزيزي القارئ أن تستحضر بعض العادات المجتمعية مثل رشّ الملح عند عتبة باب البيت أو على دم الذبيحة لطرد الجنّ، أو وضع القطران على أقدام الأطفال في ليلة 27 رمضان لحماية الأطفال من الجنّ المُحرّرين، أو حرق بعض الأنواع من البخور ليلة الخميس والإثنين لاسترضاء الجنّ، أو تعليق التمائم وصُرَر الحبّة السوداء واليد الفضيّة والخرزة الزرقاء.. على صدور الأطفال خاصة لحمايتهم من الحسد والعين وتحصينهم ضد الجنّ، وأمور أخرى كثيرة تميّز منطقة عربية عن منطقة أخرى..
ودعني أنحرف بك عزيزي القارئ إلى عالم آخر قريب من عالم الجن لأنه يطلبُ الأجوبةَ المستقبليةَ من عالم الغيب، وأقصد "علم التنجيم" الذي صارت له برامج في القنوات التلفزيّة، ومساحات في الوسائط الإعلامية، وله ارتباط وثيق بعوالم زعماء الحُكم والسياسة ومشاهير الفن والرياضة، بل إن بعض المُحلّلين السياسيين صاروا يعتمدون على تنبّؤات المنجّمين في قراءة مستقبل الدول والشخصيات السياسية..
يُقال: "الفلسفة أمّ العلوم" في الفكر الغربي، فقد سجّل القرن 17 بداية انفصال علوم: الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الإنسانية. ويُقال أيضًا أن علم التنجيم، في حضارات ما قبل التاريخ، هو علمٌ سابق لكل العلوم، بل هو أصل كل العلوم، فقد انبثق عنه: علم الفلك والرياضيات وعلوم الطّب والأدوية والكيمياء.. ولا يزال تأثيره ساريًّا إلى اليوم، منذ أكثر من خمسة آلاف عام، في المعتقدات الشعبية وفي الحياة الدينية والاجتماعية.
وتروي إحدى الأساطير بأن آدم (عليه السلام) "تسلّم أسرار علم النجوم مباشرة من خالقه، وهكذا انتقل هذا العلم إلى أولاد آدم. وعرف الإنسان أن الأرض ستُدَّمر بالنار أولاً، ثم بالماء فيما بعد، وهذه المعلومات دُوِّنت على قوسين أحدهما من القرميد والآخر من الحجر الصلد. وحسب رواية المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسفوس: لقد دمّر الطوفان قوس القرميد بينما لم يزل قوس الحجر قائما في زمنه في سورية". (اقتباس من كتاب "علم التنجيم: أسراره وخفاياه" لصاحبه "عبّود قره"). من المجدي أن أشير إلى أن التنجيم الذي نقصده هو "العلم" الذي استخدمه ويستخدمه المنجّمون والسّحرة والمتنبّئون في ربط أقدار الناس وحظوظهم ومستقبلهم بالهيئة الفلكية وحركة الأجرام السماوية ومَنازل القمر، ويُعرف أيضًا بقراءة الطالع أو قراءة الأبراج..
والحديث عن التنجيم يسوق إلى الحديث عن تفسير الأحلام وقراءة الفنجان وكفّ اليد.. وغيرها من الوسائل التي فتحت أبواب الثّروة والشهرة لبعض الناس، لا سيما أولئك الذين ربطوا بين هذه الوسائل وبين الدين، فحملوا ألقاب مشايخ وشيخات.. وليس في الجُبّة إلاّ الشيطان!
سأترك لك عزيزي القارئ أن تبحث عن علاقة كثير من عُظماء العالم بالتنجيم، منذ ما قبل التاريخ إلى ما قبل اليوم، وأذكر لك بعض الأسماء منها: نابليون بونابرت، ملك فرنسا لويس الحادي عشر، الرئيس الفرنسي شارل ديغول، ملكة بريطانيا إليزابيث الأولى، الرئيس الامريكي رونالد ريغان.. والقائمة أطول من أن تُحصى إلى درجة أنه ظهر تخصّصٌ يُسمّى "التنجيم السياسي". ولاحظ عزيزي القارئ أنني لم أقترب من زعماء العرب ومشاهيرهم حتى لا ينحرف تفكيرك وتعتقد بأن كثيرًا من البلدان العربية يحكمها فعليًّا المنجّمون!
في مدار هذه الأفكار أو قريبًا منها، توجّهت جريدة "الأيام نيوز" إلى نخبة من الكُتّاب الأفاضل بهذه الرسالة: الأدب العربي مدينٌ للجن في وادي عبقر بإنجاب فحول الشعراء في العصر الجاهلي، وقد زعم بعض الشعراء بأن لكل منهم جنٌّ يلهمه الشعر.. وكثيرةٌ هي الكتب التي تنتمي إلى التراث العربي ويُحذَّر حتى من قراءتها لأنها تحتوي على تعاويذ وطلاسم وما يختصّ بعوالم السحر، ولكنها تبقى كُتبًا تراثية ولا يُمكن للثقافة العربية أن تُنكرها. ثم إن التخويف من الجن كان وسيلة "تربوية" يستعملها الأهل في تربية أبنائهم، ولكل منطقة عربية حكاياتها في هذا الشأن.. وقد نشطت خلال السنوات الأخيرة الكتابات والمنشورات حول الجن، من ناحية دينية أو من نواحي أخرى، فما هي رؤيتكم للجن في الأدب والفنون وحتى السينما؟ وهل تذكرون أقاصيص عن توظيف الأهل للجن في "تربية" أبنائهم؟ وما هي رؤيتكم للجن في الثقافة الشعبية عمومًا؟ ثم إن الخوف من العين والحسد يسيطر على مختلف الفئات في المجتمعات العربية رغم أن العرب لا يمتلكون ما يُحسدون عليه، فما رأيكم في هذه القضية؟
ما لم أحدّثك عنه عزيزي القارئ أن هناك مَن يُحذّر من "السحر الإلكتروني"، ويرى بأن بعض المواقع هي نوافذ يتسلّل منها الجنّ إلى أعماق مَن يتصفّحها فيُسبّب له اضطرابات نفسية وفكريّة ويدفعه إلى القنوط والتفكير السلبي.. هل تعتقد بأن الأمر مجرّد مزحة؟ ربّما هي مزحة! لأنك تسبح في بحار الأنترنت الظاهر، ولكن ما يُخفيه "الويب المُظلم" والطبقات الأخرى الخفيّة للأنترنت مُرعبٌ أكثر من عالم الجنّ والتنجيم.. ولم أحدّثك عن الحسد "المجاني"، ولماذا يخشى العربُ من الحسد وهم لا يملكون شيئًا يُحدسون عليه؟ ستجد إجابات هذه الأسئلة وأسئلة أخرى في ثنايا هذا الملف؟
وإذا كان لديك سؤالٌ خاص حول التنجيم وقراءة الفنجان والكفّ والطالع.. فيُمكنك مراسلتي، لأنني أفكّر جديًّا في احتراف "التنجيم السياسي" طلبًا للثورة والشّهرة والنفوذ من أسهل طريق، ولا تخشى على أموالك عزيزي القارئ، واعتبر أنني تقاضيتُ ثمن خدماتي لك مُسبقًا، فحسبي أنك قرأت الموضوع كاملا.
-21-08-2025-08-41-19-4067.png)
وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
أحببناها بجنون.. أصابتنا عينٌ حاسدة فسُرقت منّا فلسطين!
كانت لحيته قد أخذت في النموّ فجأةً، وبدأ يبتعد عنّي شيئًا فشيئًا أو قُل صار يتجنّبني. كانت المعادلة تسير وفق نظام ثابت: تطول اللحية فتقصر أواصر العلاقة. بدايةً لم أسأله، إذ إنّ لكلٍّ منّا ما يشغله، ويحدث أن يكون هذا الانشغال سرّيّ، فيصمت أحد الطرفين عن البوح بما يزعجه أمام الآخر، لكنّ الغلوّ في الابتعاد جعلني أسير أفكاري، أو قُل تحوّلت أفكاري لسائق تاكسي، واحدة تأخذني وأُخرى تردّني، ولم أجد لأسئلتي جوابًا فقرّرت المواجهة.
التقيت به في المقهى الذي كان يرتاده في مرحلة الابتعاد، وكان هذا اللّقاء بعد شهرٍ من المراقبة، تلك تقاصيل غير مهمّة، لأنّني جئت كخبرٍ عاجل أمام شاشة عينيه:
- مرحبًا، كيف حالك أيها العفاسيّ؟ قلت مقهقهًا. وقد لقّبته بالعفاسيّ تيمّنًا بالمنشد الشيخ "مشاري العفاسيّ".
- أهلًا، وعليكم السّلام. هداك الله.
- ما بك يا رجل، حفظتَ أنشودتين للعفاسيّ فانقلبت إلى شيخٍ جليل؟ ما رأيك أن تفتي لنا بأمرٍ ما؟ أردفت أقول مبتسمًا.
- لا وقت للمزاح، أستأذنك.
قالها هكذا من دون أن يرفّ له جفن وترك المكان، وتركني مجدّدًا أسيرَ أسئلتي التي لم أجد لها أجوبةً.
احتسيت فنجان قهوتي على مهل، دفعت الحساب ورحلت.
يقتل القرش سبعة أشخاص سنويًّا كمعدّل ثابت لإجرامه، في حين أنّ الإنسان يقتل نحو عشرين مليون قرش كل عام. هذا ما قرأته أثناء جولةٍ قمت بها على الشبكة العنكبوتيّة، فسألت نفسي: من الأخطر يا تُرى؟
ابتعد عنّي صديق طفولتي فجأةً، بل ولم يعد يردّ على اتّصالاتي وكأنّه اختفى من الحيّ كلّه، قلت: لعلّه خير.
لعلّه خير، إنّ أكثر الأمور التي نعجز عن فهمها نرمي عليها هذه التعويذة المؤلّفة من كلمتين: لعلّه خير. لكنّ خبرًا فظيعًا نقلته وسائل الإعلام هزّ كياني، وكان مفاده أنّ شيخًا يتعامل بالسّحر والشّعوذة قُبِض عليه في منزلٍ مهجور، ضحكت للخبر لكنّ صورة صديقي التي أُرفقت مباشرةً بعد الخبر جعلتني أتشردق بالضّحكة كمن ابتلع حبّة أرزّ في قصبته الهوائيّة.
الجنّ صديقي يا صديقي. قالها حين قرّرت زيارته في سجنه، لم أجد ما أردّ به عليه، لكنّني أحسست بخيبة كبيرة، لقد استبدلني صديقي بجنيّ، يا للعار!
- وكم ستُسجن؟ سألته.
- لا يهم، أنا لست هنا، أنا في مكانٍ آخر، ولكنّي مللت من البشر فجئت أنشد الهدوء هنا. قال.
- هدوءٌ في السّجن؟ ما ألطف كلامك، هل صرت تحتسي شراب التنمية البشرية؟
- اسخر، هذه عادتك. قال مقطّبًا حاجبيه.
- حسنًا متى أستحضرك فنحتسي قهوتنا معًا؟ قلت ساخرًا.
- لا تسخر وإلّا سلّطت أحدهم عليك. قال مهدّدًا.
- سلّط يا صديقي سلّط، فقد مللت من مرافقة البشر، لعلّي أجد جنيًّا أتسلّى معه ريثما تعود إلى رشدك. وداعًا. شتمته في سرّي ورحت.
في اللّيلة نفسها، اتّخذت من شرفة المنزل مكانًا أجلس فيه فسمعت صراخ جارتنا: الحقّ على تلك الملعونة أم ياسر، لقد أُعجبت برائحة الملوخيّة ولم تقل شيئًا، رأيتها بأم عينيّ وهي تتلفّت نحو المطبخ، ولهذا احترقت الطبخة.
- أنتِ طالق. قال زوجها.
- لقد طلّق جارُنا زوجتَه لأنّ جارتنا حسدتهما على حياتهما والعياذ بالله من هذه العين. قالت الجارة التي سمعَت الحديث.
قهقهتُ بصوتٍ عالٍ.
- لقد لسعت العينُ عقلَ جارنا، إنّه يقهقه كلّ يوم في مثل هذا الوقت. قالت أُخرى وكانت تقصدني.
أتممت قهقهتي وقلت في سرّي: ماذا لو قلنا أنّنا أحببنا فلسطين إلى حدّ الجنون، فأصابتنا عينٌ حاسدة وسُرقت منّا تلك الأرض؟ إنّها شمّاعةٌ جميلة فكرة العين الحاسدة، نستطيع أن نرمي فيها كلّ إخفاقاتنا ولن يُحاسبنا أحد.
أكملت قهقهتي حتى ظنّ الجميع أنّي جُننت.
-21-08-2025-08-40-25-8803.png)
سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
بيبيدي بوبيدي بووو!
علاء الدّين وحكيتو هتكون
مليانة بالحواديت
جن على عفاريت
تلج ورعد ونار
أتمايل مع هذه الأغنية ليس كباقي الأغنيات، ففيها من السّحر ما يُخضع أجسادنا لترانيمها، نتماوج على نغماتها بعيدًا عن الواقع، حتّى ربّما لا أسمع إن ناداني أحدهم، فحواسي جميعها تحت سيطرة الشّعوذة الخياليّة، أعود إلى طفولتي والابتسامة على وجهي وكأنّي لم أكبر، "علاء الدّين والفانوس السّحريّ"، هذا الفارس النّبيل الذّي نفض غبار الزّمان المتراكم عن فانوس قديم، طار الغبار وطارت معه عتمة القمقم، ليصدح صوت ضخم: "شبّيك لبّيك عبدك بين إيديك، اطلب واتمنّى"![]()
هل فكّرتم يومًا ماذا ستكون أمنياتكم الثّلاث التي ستطلبونها من جّني الفانوس؟ منذ أن وعيت واشتدّ عودي وأنا أفكّر، والحقيقة أنّني كلّما اخترت أمنيات، أكتشف أنّي لا يمكن أن أكتفي بثلاث فقط، فالطّمع طبع الإنسان، ودومًا ما يستفزّني هذا العدد، خصوصًا أنّنا في واقعنا نعلم جيّدًا أنّه كلّ مكسب مقابله خسارة، وكلّ خطوة إلى الأمام هناك ثمن مدفوع لثباتها، والله وزّع علينا الأرزاق، فلماذا "يُعَكْنِن" علينا الخيال؟
إلى أن نافسته الجنّية العرّابة لـ "سندريلا"، عصا سحريّة، وطلبات بلا حدود، كلّ أمر مُجاب، وهذا هو المطلوب ![]() هناك مثل شعبيّ يقول: "يا أرض اشتدّي ما حدا قدّي"، وكأنّي ملكة في عالم مختلف، لا يزال أثره فينا حتّى اليوم، آمر وطلباتي مجابة، وبين العصا اللّامحدودة والفانوس صاحب العدد الثّلاثة، سأختار العصا، وأطلق العنان لنفسي وخيالي وطموحاتي التي لا تنتهي.
هناك مثل شعبيّ يقول: "يا أرض اشتدّي ما حدا قدّي"، وكأنّي ملكة في عالم مختلف، لا يزال أثره فينا حتّى اليوم، آمر وطلباتي مجابة، وبين العصا اللّامحدودة والفانوس صاحب العدد الثّلاثة، سأختار العصا، وأطلق العنان لنفسي وخيالي وطموحاتي التي لا تنتهي.
هل أنا حقًّا طمّاعة؟ سبق واعترفت أمامكم أنّ الطّمع من طبع الإنسان، ولكن لأدافع عن نفسي وعن كثيرين مثلي، بعيدًا عن قناعتنا بالواقع، وبأنّنا جميعًا نسعى في سبيل تحقيق مستوى حياة يليق بكينونتنا الإنسانيّة، أكاد أجزم أنّنا لو حصل والتقينا بالجنّية العرابّة لما تأخّر أحدنا عن الاستئناس بقدراتها المباشرة، لأنّنا ببساطة نريد الأفضل، ولا يعني هذا أن نأخذ من الغير، ولكن طالما مسموح لنا أن نغرف من الأمنيات ما نشتهي من دون ضرر، فليكن، ولم لا؟!
ومن يظن أنّ أمنياتنا ستكون في إطار المال والجمال والصّحة، فهو قد أخطأ في تقدير خيالنا الجامح، ولهذا أخبرتكم أنّ الموضوع لا علاقة له بالطّمع بشكل مطلق، ولهذا الأمنيات الثّلاث وحدها لا تكفي، أيّتها العرّابة أريد أن أكون جنّية صغيرة مثل "تنكر بيك"، وتلقي العرّابة بتعويذتها عليّ: "بيبيدي بوبيدي بووو".
وأراني جنيّة خضراء مشاكسة، تحمل بيدها غبارها السّحريّ، وتطير من مكان إلى مكان بجناحاتها الرّقيقة، رافضة كلّ القيود التي تحدّ من قدراتها. كم فكّرنا أن نتحرّر من قيود ذواتنا، من أفكارنا، من عُقَدنا، من مشاعرنا، من كلّ شيء، حرفيًّا كلّ شيء، لنكتشف العالم بعين مختلفة، من دون خوف أو تردّد.
حرّية نقطف منها ما نشاء، عالم نرسمه كما يطيب لنا العيش، بعيدًا عن الهموم، بعيدًا عن الحياة، كلمات قليلة مطرّزة على صفحات الخيال نهرب بها إلى مثاليّة مفقودة.
هل تريد أن ترمش فتجد نفسك في بلاد "أطلاتنس"؟ هل فكّرت لو تستطيع التّنفس تحت الماء والتّحدّث مع الأسماك؟ هل تمنّيت لو ينتهي الظّلم بلحظة؟ فقط أغمض عينيك وافرك الفانوس أو نادي العرّابة . ![]()
-21-08-2025-08-41-51-7998.png)
سحر قلاوون (كاتبة من لبنان)
وهل بقي لنا ما نُحسد عليه؟
من يعرفني جيدا يدرك أنني أحب الاحتفاظ بأشيائي المميزة بعيدا عن أعين الناس، وذلك لأنني أحب أن تبقى لي، فأكثر الصور التي أحبها لا أعرضها، وأصدقائي المقرّبين لا أتحدث عنهم كثيرا، وحتى كتبي المفضّلة لا أخبر الناس عنها، أما أحلامي فأبقيها بين جدران قلبي، فكل ما أحبّه أبقيه لي وحدي وأدعو الله أن يحفظه لي، ربما ليس من باب الخوف من العين والحسد، لكن لديّ طريقة تفكير معينة مقتضاها أنه كلما بقيت الأشياء التي نحبها بشدة بعيدة عن أعين الناس، كلما بقيت أنقى وأطهر وأجمل.
فأنا من أنصار فكرة أن يُبقي الشخص ما يحب له وحده، من دون أن يشاركه مع أيّ أحد، وهذا ليس من باب الأنانية، بل هو حق مشروع للإنسان.
لكن على الصعيد الأعم والأوسع، أجد سؤالا يراودني باستمرار، وهذا السؤال هو: هل بقي لنا كأمّة عربية ما نُحسد عليه؟ هل هنالك الكثير من الإنجازات التي نحققها اليوم تجعلنا نشعر بالخوف من أن يحسدنا عليها الآخرون؟
لنلقِ لمحة سريعة على واقعنا، ربما هذه اللمحة تجعلنا قادرين على تحديد: هل لدينا ما يدعو الآخرين ليحسدونا عليه، أم لا؟
في الماضي، كنا أمّة العلوم والآداب والفنون، كنا نشرب المعرفة مع الماء، ونتناول الثقافة مع كل وجبة طعام، وكنا لا نعرف إلى التوقّف عن طلب العلم سبيلا.
لقد برعنا في كل شيء، في الهندسة والطب والزراعة، كما في الشعر والنثر والنحت. ألّفنا الكتب، وكنا مثالا حسنا وقدوة للجميع. كنا أهل الاختصاص والدقة والحكمة، وحققنا إنجازات لا تُعدّ ولا تُحصى.
كان الجميع يحسدنا على ما نملك، على الدين والأرض والمجتمع، كما على سعة الفكر وعمق الوعي والحلم الذي لا يعترف بالحدود ويأبى الانصياع للعوائق والصعاب.
كنّا نقدّر قيمة كل شيء، فقد كنّا على استعداد للتخلّي عن أرواحنا ولكننا لا نترك أرضنا التي اختارها الله لنا واختارنا لها، فكنّا نعتني بها كما تعتني الأم بأطفالها، فنفلحها ونسقيها ونزيل منها الأشواك ونزرعها لتكون عونا لنا في المستقبل.
وإن كنت أتحدّث عن الأمّة السابقة بالقول "كنّا"، واضعة نفسي معها، فذلك ربما لأنني أتمنى لو كنت معهم، وربما جميعنا نتمنى لو أننا كنا من تلك الأمّة التي أنجزت وأبدعت وحافظت على نفسها وإرثها من الوقوع فريسة كل الفتن.
أما اليوم، فنحن أمّة وقعت في فتن عديدة، لعل أخطرها هي فتنة وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحنا أسرى لها، تتحكّم بنا وتسيطر على تفاصيل حياتنا، منذ استيقاظنا من النوم نتفحّصها كمن يبحث عن كنز في مكان خاطئ، نراقب صفحات المشاهير، لا سبب لشهرتهم سوى التفاهة.
وبدلا من أن نعمل لنكسب المال من أجل حياة كريمة، بتنا نفتح "لايفات تيك توك" ونتوسّل المال عليها، ويا له من عمل يرفع الرأس!
المرات التي شاهدت فيها "لايفات التيك توك" معدودة، وقد شاهدتها بدافع المراقبة والبحث لأصبح قادرة على توصيف ما يجري على الإنترنت بعيدا عن الخيال، ويا ليتني لم أدخل ولم أرَ.
فقد وجدت أمًّا تسمح لابنتها أن تكون معرّضة لشتى أنواع التنمّر، وكل ذلك لا يهم، فالمهم عندها هو أن يرسل لها الداعمون الأسود والورود، ونِعمَ الأم!
لقد رأيت نساءً ورجالًا، شاباتٍ وشُبانًّا، كلهم يتسوّلون، يفعلون أشياء سخيفة، فقط بهدف لفت النظر ومن ثم الغرق في أموال داعمين، الله وحده يعلم ماذا يكون هدفهم من وراء إرسال الأموال لهؤلاء المتسوّلين!
أما الشهادات، فهي تؤخذ وبالجملة، وبدل الشهادة الواحدة، قد يحصل الشخص على شهادتين أو ثلاثة، لكن المعرفة والثقافة لا تقاس بالشهادة وحدها، وكم من خرّيج جامعة تجده ليس قادرا على التحدث في موضوع اختصاصه!
نحن أمّة تحب السرعة لأننا كما يقال "نعيش في عصر السرعة"، لكن ألم ينتبه أحدٌ إلى أننا بتنا نعيش في عصر اللاقيمة، حيث لم يعد هنالك قيمة للمال وللعلم وللكتاب، وحتى للإنسان؟ فقد تجرّد كل شيء من قيمته في عصر السرعة، فأصبح كل شيء يباع ويشترى مقابل اللاشيء.
في الماضي، كان اجتماع الناس يولّد القوة، أما اجتماعهم اليوم فلا يولّد سوى الخلافات والمشاحنات. في الزمن الماضي، كان الناس يعرفون أهمية التعاون وجمال تمنّي الخير للغير، أما اليوم فكلٌّ يريد نفسه ولا أحد آخر سواه، فلا تجد أحدا يتمنّى الخير لأحد، لا بل يحسد الشخصُ شخصًا آخر على بضع دولارات وضعها في جيبه.
اُنظروا وراقبوا أين كنا وأين صرنا، وقولوا لي بربكم على ماذا نُحسد عليه نحن اليوم؟ هل نُحسد لأننا أمّة، أفرادها يتمنّون الشرَّ لبعضهم البعض؟! وهل نحسد مثلا لأننا أمّة باتت ترمي الكتب بدلا من أن تقرأها؟! أو هل نحسد يا ترى لأننا على استعداد لبيع أرضنا ومبادئنا وقيمنا مقابل حفنة من الأموال؟!
أنا لا أريد أن أكون متشائمة، فمن يعرفني يدرك جيدا كم أغرقُ في التفاؤل في الكثير من الأحيان حتى وإن لم يكن يوجد ما يدعو إليه، لكنني أحب التفكير بطريقة إيجابية وعدم الشكوى والاعتراض دوما.
لكن هنالك فرقٌ كبير بين أن نكون إيجابيين فلا نغرق في أوهام لا تنفعنا، وبين أن نكون إيجابيين وفي الوقت نفسه قادرين على رؤية الأمور على حقيقتها وإعطاء نقدٍ قد يكون بنّاء ودافعا للتغيير والتحسين. فكلمةٌ بنّاءةٌ خيرٌ من ألف كلمة مادحة.
وهكذا أصبحنا بين ماضٍ لن ينفعنا فيه نظم القصائد التي تتغزّل به والمعبّرة عن الشوق والحنين، وبين حاضر أقلّ ما يمكن أن يقال عنه أنه مبكٍ لأنه جعلنا أمّة مثيرة للشفقة، لنقف بخوف أمام مستقبل مجهول لا نعرف كيف سيكون حالنا فيه.
ونبقى على أمل أن نتحرّر من قيود الجهل والتبعية العمياء، لنكمل كتابة سيرة الأمّة الماضية بقلم الإنجاز والإبداع.
-21-08-2025-08-42-15-7441.png)
زينب أمهز (كاتبة وباحثة من لبنان)
قوى الغيب.. تسكننا!
بالرّغم من كلّ ما وصل إليه الإنسان من تطوّر معرفي وتقدّم تكنولوجي، ما تزال بعض المعتقدات الراسخة تحتفظ بمكانتها في عقول وقلوب الناس، كالحسد والعين والجن. قد تظنّ أن هذا الإرث سيندثر مع اتّساع دائرة الوعي، لكن الواقع يقول عكس ذلك. فحتّى اليوم، لا تزال تلك المعتقدات تمارس تأثيرًا كبيرًا على سلوك الأفراد وتفكيرهم، وكأنها متجذّرة في الروح الجمعية لا تُمحى بسهولة.
وإذا كان الحسد والجن في نظر البعض من تراث الخرافة والأساطير، فهما في نظر المؤمنين بهما أمران ثابتان، خاصة أنّهما ذُكرا في القرآن الكريم، وهذا بحدّ ذاته كافٍ لأن يُخرجهما من دائرة الخيال إلى دائرة اليقين. فالحسد، كما ورد في قوله تعالى: "وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ" (الفلق، الآية: 5)، لا يُستهان بأثره، إذ يرى كثيرون أنه سببٌ في تعطّل الرّزق، أو المرض المفاجئ، أو تعكّر صفو العلاقات.
ولذلك، بات الخوف من الحسد جزءًا من حياة الناس اليوميّة؛ فكم من شخص يحرص على كتمان نِعمه، ويُخفي فرحه، ويتجنّب مشاركة إنجازاته خشية من عينٍ قد تصيبه وتبدّد ما جمع! وكم من أمّ تُردّد المعوّذات على أطفالها قبل خروجهم من المنزل، وكم من عائلة تعلّق خرزة زرقاء أو تضع يد طفلها على رأسه إن أثنى عليه أحد.
إنها ثقافة الخوف، المتوارثة من جيلٍ إلى جيل، حتى أصبحت جزءًا من الهوية الثقافية. وقد تجلّت هذه المعتقدات حتى في الفنون والأدب، فامتلأت الروايات، والمسلسلات، وحتى الأغاني الشعبية، بصور العين الحاسدة، والجنّ المتربّص، والسحر المدفون. وكثيرًا ما نرى في الأفلام، سواء كانت أميركية، هندية، أو حتّى عربية، حضورًا واضحًا لموضوعَي الجن والعين، يظهر أحيانًا في سياق مرعب يثير الرهبة، وأحيانًا أخرى في إطار تهكّمي ساخر، لكنهما يظلان من الموضوعات المطروحة والتي تلقى رواجًا واسعًا لدى المشاهدين، مما يعكس مدى تجذّر هذه المفاهيم في الوعي الجمعي، رغم اختلاف الثقافات والبيئات.
أمّا في الطفولة، فقد كان الحديث عن الجن وسيلة "تربوية" يلجأ إليها الأهل لضبط سلوك أبنائهم، من منّا لا يذكر ذلك، كُنّا نُحذّر من اللعب ليلاً، أو الاقتراب من أماكن مهجورة، أو النظر إلى المرايا بعد المغيب، خوفًا من "جنّي" يرانا ولا نراه. كانت وسيلة لبثّ الخوف في القلوب، لكنها بقيت محفورة في الذاكرة الجمعية حتّى اليوم.
كلّ هذه المظاهر، رغم بساطتها، تفتح أبوابًا عميقة حول طبيعة الإنسان وخوفه مما لا يُرى. فهل هو ضعف إيمان أم مجرّد بُعد عن المنطق؟ أم أنّ في الأمرِ ما لا يُفسَّر بالعقل فقط؟
ومن التجارب الشخصية، حادثة وقعت لي في صغري، عندما كنت في الثامنة من عمري. ذهبت لأروي الزهور في منزل جيراننا الذين نزحوا إلى بيروت، وفجأة، فتح الباب المقفل بسلسلة حديدية " الجنزير" حوالي 20 سم، ورأيت رجلاً طوله من الأرض حتى السقف، لكن رأسه كان عبارة عن لمبة. هربت مذعورة، ومنذ ذلك الحين لم أستطع النظر نحو ذلك المنزل. قد يضحك البعض من هذه القصة، لكنها كانت تجربة حقيقية حدثت معي.
فأنا، لا أرى أنّ تصديق هذه الأمور مرتبطٌ بالمستوى العلمي أو الثقافي للإنسان، فالمسألة أعمق من ذلك بكثير. هناك حقائق غيبيّة لا تُقاس بالعلم وحده، ولا تُفسَّر بمنطق العقل فقط. نعم، لا بدّ من التمييز بين من يسلّم حياته كلّها لتلك المعتقدات، فيصبح أسيرًا لوهم الجن والحسد، يُرجع كل تعثّر أو ألم أو خسارة إلى "عين" أو "سحر"، فما بالك مثلًا بمن يُرجع أتفه ما يحصل معه من أمور إلى "صَيْبة العين"، إذا تمزّق الفستان، أو إذا انكسر فنجان القهوة، أو إذا ذبُلت الوردة... وغيرها من أمور ممّا لا يُعدّ ولا يُحصى، (صدقوني إنّها موجودة في مجتمعنا حقًّا)، فيعيش هذا الإنسان في دوامةٍ من التوجّس والقلق، يفرّق الحال بينه وبين من يُقرّ بوجود هذه الظواهر، لكنه لا يسمح لها بأن تعطّل مسار حياته أو تنال من سلامه الداخلي.
فالفرق شاسع بين الإيمان بوجودها كجزء من عقيدتنا - لأن القرآن الكريم أشار إليها بصراحة - وبين أن نُسقط عليها كل مصائرنا. فحين يقول الله تعالى: "وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ" (الفلق، الآية: 5)، أو حين يتحدث عن الجن في أكثر من موضع، فإنّ هذا إثبات إلهي لا يحتمل الجدل. ومتى ما كان النصّ القرآني صريحًا، فنحن كمسلمين لا نملك حياله إلّا التصديق، لأنّ ما ورد في كتاب الله هو من الغيب الذي نؤمن به دون حاجة إلى دليلٍ مادي.
وإن سألتني عن الحسد هل هو موجود؟ أقول لك نعم، فقد ذُكر أوّلًا في القرآن الكريم، وهو موجود بين الناس، لكن الحسد يا عزيزي ليس مجرّد شعور عابر، بل هو مرضٌ داخليّ يؤذي صاحبه قبل أن يطال المحسود. هو انعكاس لنقصٍ في النفس، ودلالة على فراغٍ داخليّ يعانيه الحاسد، إذ لا يغبِط بل يحسد من يمتلك ما يفتقده، أو حتّى ما لا يقدّره كما يجب. هو داءٌ خفيّ، دنيء، لا تقف آثاره عند حدود الدنيا فحسب، بل تمتد إلى الآخرة، فقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: "إيّاكم والحسد، فإنّه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب".
فعلامَ نحسد بعضنا بعضًا؟! لماذا لا نتمنّى الخير لغيرنا كما نرجوه لأنفسنا؟ إذ إننا لا نعلم حجم ما تحمّله هذا الإنسان في سبيل ما وصل إليه، ولا ندرك ما خسره وما فقده مقابل ما نراه عليه من نِعم، صدقوني في هذه الدنيا لا يوجد شيء بالمجّان، فكل ربحٍ خلفه مئات الخسائر. نحن نرى الصورة الظاهرة، لكننا نجهل كمّ التعب، الغياب، التضحية، والانكسارات التي مرّ بها هذا الشخص. فالماديّات التي نحسد الناس عليها غالبًا ما تُبنى على أعوامٍ من الشقاء.
وما بالك بمن يحسد غيره على محبة الناس له؟! أيّ دناءة هذه؟ أن يُحسد الإنسان على النقاء الداخلي الذي جعل له في القلوب وِدادًا! والأسوأ من كلّ ذلك أنّ الحاسد غالبًا لا يعترف بحسده، بل يختبئ خلف أقنعة المودة والمجاملة، يبتسم لك ويحادثك بكلامٍ معسول، لكنه يضمر لك الكره ويتمنّى لك الزوال.
وأنا شخصيًّا، لم أشعر يومًا بهذا الشعور، لا أقول ذلك تزكية، فقد تربّينا، والحمد لله، على مبدأ "العين الشبعانة"؛ فلا يُغوينا بريق، ولا تستهلكنا الرغبة فيما في أيدي الناس. نرضى بما قسمه الله لنا، ونقنع بما نملك، ونتمنى الخير لغيرنا كما نرجوه لأنفسنا، فهكذا علّمنا الإيمان، وهكذا تربّت نفوسٌ تعرف أن العطاء من الله، وأن البركة في الرضا. ولكنني أدركت معنى الحسد حين اختبرتُ وجوهًا من حولي في ميدان العمل، بعضهم يثني عليك في العلن، ويطعن فيك من الخلف، فقط لأنك نقيّ ويحبك الناس.
وأنا للحقيقة لا أغبِط في هذه الحياة إلّا اثنين: من لا يزال يملك أمّه، إذ إنني فقدت أمي، وأعلم تمامًا حجم هذه الخسارة التي لا تُعوّض، وأتمنى من قلبي ألا يُحرم أحدٌ من والدته، وأدعو بطول أعمار الأمهات جميعًا. والثاني، من اغترف من بحر العلم حتّى فاض به، أتمنى أن أكون مثله، وأحثّ نفسي على اللحاق به، فتلك هي الغِبطة المحمودة التي تدفعك لأن تكون أفضل، لا لأن تحقد على من هو كذلك.
وفي الختام، يبقى الحديث عن الجن والعين والحسد، رغم ما فيه من غموضٍ وهيبة، متجذّرًا في ثقافتنا الشعبية ووعينا الجمعي، لا تمحوه سنوات التقدّم. نعم، لا يجوز أن يُختزل كلّ ما يصيبنا بهذه الأسباب، لكن إنكار وجودها مطلقًا هو إنكار لما جاء في القرآن الكريم. فالعين حق، والحسد داءٌ دفين، والجن خلقٌ من خلق الله. لكن علينا أن نوازن بين الإيمان بهذه الأمور دون الغرق في وساوسها، وأن نُحصّن أرواحنا بالذِّكر، والرضا، وحُسن الظنّ بالله، فهو وحده الحافظ والكافي، وما دونه فزَعٌ زائل.
-21-08-2025-08-42-38-3994.png)
عدوية موفق الدبس (باحثة وكاتبة سورية - لبنان)
تعويذة "الحاج عمر".. وأشباح بيت جدّي
في أيام آب/ أوت الملتهبة، الشبيهة بهذه التي نعيشها الآن، كنا نحمل حقائبنا الصغيرة ونشدّ الرّحال لأيام متتالية إلى حضن بيت الأجداد، بعيدًا عن ضجيج المدن وزحام المجاملات، كنّا كالبدوِ الرُّحّل، نسير على وقع شارة مسلسل "الزير سالم"، لكن بفارقٍ بسيط هو أنّنا أطفال هناك، ولا "جسّاس" بيننا أو "جحدر" وكانت أكبر "حرب بسوس" تقوم بيننا من أجل قنينة "عرق سوس"، كان كل شيء نقيًّا وصحيًّا؛ الهواء نقي، والطعام والشراب من خيرات الأرض، وكانت الكلمات صادقة خالية من شوائب التملّق.
في بيت الأجداد، كنّا نفعل ما لا نجرؤ على فعله في بيوتنا. نقفز، ونلهو، ونصرخ، ونطرق أبواب الجيران ونهرب، من دون أن يلاحقنا أحد. أذكر جيدًا ذاك العجوز الملقب بـ "الحاج عمر" رحمه الله، كلما جئتُ إلى بيت جدي، كنت أتسلل إلى حديقته، أعبث بشجرة التوت، أتسلّقها، وأقطف حباتها الحلوة أنا و"العصبة" من أخوالي وخالاتي، الذين لا يكبرونني إلا بعام أو ثلاثة، بل وبعضهم يصغرني ببضعة أشهر.
كان "الحاج عمر" يخرج من بيته متكئًا على عصاه، مسبحة زرقاء في يده، وعلى باب منزله "كفّ العبّاس"، ويبدأ بالصراخ حين يسمع ضحكاتنا المتناثرة. لم أكن أشعر بوجوده، لأن تركيزي كان منصبًّا إما على شجرة التوت أو على عناقيد العنب النائمة قرب النهر الصغير الذي يصل بيته ببيت جدي. كنت أهرب قبل أن يصلنا بثوانٍ، فيتعجب الجميع: "كيف عرفتِ أنه قادم وأنتِ لم تريه؟" فأردّ مازحة: "الله خلق لي عيونًا خلف رأسي".
لكن الحقيقة أنني كنت أتعرّف على قدومه من رائحة البخور التي تسبقه، ولم أخبرهم بهذا السرّ كي لا يسبقني أحد في الهرب، وحتى تكون لسعة العصا من نصيبي وحدي. ثم يذهب إلى جدّي ليشكونا، بينما نحن نقف بعيون بريئة ونقول: "لن نعيدها". فيحاول جدّي إغراءنا بشجرة توت أكبر، وثلاث شجرات عنب، وشجرة جوز ضخمة، لكننا نهزّ رؤوسنا صامتين، لأن المتعة الحقيقية لم تكن في التوت أو العنب، بل في الهروب من ذاك العجوز والضحك بأعلى صوت.
في إحدى المرّات، نصب لنا فخًا ليمسك بنا. وضع ثلاث حبّات طماطم صغيرة وأربع جوزات قرب النهر، وجلس يراقب. فضولنا جرّنا نحو الطعم، وفجأة انقضّ علينا صارخًا، وأمسك بي، بينما فرّ الجميع. يومها لم أشمّ رائحته؛ فقد كنت أعاني من زكام الصيف الذي سرق مني حاسة الشم.
أخبرني الأولاد بعدها أن "الحاج عمر" قرأ عليّ "تعويذة" جعلت العيون التي في مؤخرة رأسي تختفي. وبالطبع لم أخبرهم أن العيون لم تكن موجودة أصلًا، لكنني صدّقت الكذبة مع الوقت، خاصة بعدما بدأوا يهددونني بأنه يستطيع إرسال الجن والأشباح ليمسكوني، خصوصًا في الليل.
والحقيقة أنني كنت أرى الأشباح فعلًا في بيت جدي، تحديدًا عند النوم في تلك الغرفة التي كنت أهرب منها كل ليلة إلى غرفة المعيشة، رغم أن فيها شبحًا آخر عريض الكتفين يقف على الباب. لكن الغريب أنه لم يكن يخيفني مثل الأشباح الثلاثة الذين كانوا يقفون خلف باب غرفة النوم، شامخين، يحدّقون بي بصمت طوال الليل. وعندما أخبرت أمي، نصحتني بقراءة آيات التّحصين قبل النوم، ومنذ ذلك الحين لم يقترب مني شيء.
كنت أتحصّن بشدّة، أغطّي جسدي بالكامل حتى أطراف أصابعي، رغم الحرّ الشديد وكل هذا كي يتعذّر على الجن سحبي، وأغمض عيني بقوة عندما ينطفئ النور رغم أن نتيجة الظلام واحدة وفي الحقيقة ما زلت إلى الآن إن ذهب النور من دون إنذار أغمض عينيّ ريثما يعود.
وفي أحد الأيام، لعبت كثيرًا حتى غلبني النعاس ولم أتحصّن. وفي منتصف الليل، شعرت بالأشباح الثلاثة تنقضّ عليّ، فصرخت حتى استيقظ الجميع. وكانت المفاجأة أن تلك الأشباح لم تكن سوى سجّاد جدتي، تضعه خلف الباب في شهر آب/ أوت حتى الشتاء، وإذا فتح أحدهم الباب دفعة واحدة سقطت السجّادة على الأرض ومعها أوهامي.
ضحك الجميع، لكنني أسررت لهم أن هناك شبحًا حقيقيًّا، وأشرت إلى باب غرفة المعيشة. عندها قال جدّي مبتسمًا: "هذا معطفي الصيفي، أرتديه وأنا ذاهب إلى المسجد".
ساد الصمت، وشعرت أن قصّتي انتهت، لكنني قررت أن أفشي سرّ "الحاج عمر". وقبل أن أتكلم، قال جدّي: "إنه رجل تقي، والكلمات الغريبة التي يتمتم بها ما هي إلا دعاء لنا أن يهدينا الله إلى أحسن حال". كانت تلك صدمة كبيرة، لكنها حملت معها دفء الحقيقة.
ليتها تعود تلك الأيام… أيام الأشباح المزعومة، والضحكات الصادقة، والهروب الذي كان بطعم الحرية، والأمان الذي كان يسكن حتى في قلب الخوف.
-21-08-2025-08-44-55-2141.png)
غِوى غوراني (كاتبة من لبنان)
الحماية الحقيقية في الأدعية وحدها أم في صفاء القلوب أوّلا؟
كما خلق الله الجنة والنار، وميّز بين الخير والشر، ووهب العالم توازنًا بين النور والظلمة، وضع في حياةٍ موازية لحياتنا مخلوقات من نار؛ منها ما لا يؤذي ومنها الخبيث الذي يتسلل إلى العقول والأجساد فيكون للإنسان كما تكون الظلال. وكما أودع الله في قلب الإنسان نية طيبة خالصة، تدعو للخير وتفرح لنجاح الآخرين هناك نوايا أخرى حاقدة تحزن لوجود النعمة عند الغير فتطلق نظرة حسد وخبث تطفئ به نور الصحة وتعطّل عبره مسار الرزق وتفتح أبوابًا خفيًّة للأذى ولو من نظرة. فما هي هذه الحيوات التي تحيا بالتوازي معنا؟ ومن هم سلاطينها؟.
الجن والعين والحسد ثلاث مفاهيم متداخلة تحمل الحقد والأذيّة عندما تدخل حياة الإنسان، فبأيّ شكل يتداخل دور الجن في تفسير ظاهرة العين والحسد في الثقافة الشعبية وغيرها من الثقافات؟ وإلى أيّ حدّ ممكن أن تؤثر هذه المعتقدات على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي؟ وهل هناك فرق بين النظرة الدينية والنظرة الشعبية لكل منهم؟
حين نفتح كُتب التراث ونصغي إلى الحكايات التي رُويت على ألسنة أجدادنا، نجد أن الجن لم يكن غريبًا عن المخيّلة العربية بل قد نما في زواياها وتحوّل إلى ظلّ يرافق الحكايات، وإلى جانبه تترصّد الإنسان العين الحاسدة التي لا تُرى ولكن، يُحسب لها ألف حساب.
فتلك القوى التي تتحرك في العالم الموازي لعالم البشر آمن بها العرب منذ القدم وكانت دومًا حاضرة في الروايات والأساطير، متنقّلة على الألسن عبر العصور، وكان الجن من أبرز هذه القوى، يتربّص بالبشر ويودي بحياتهم إلى الهاوية في لحظات الغفلة والضعف، وفي الجانب الآخر تُعتبر العين والحسد قوتين خفيّتين تُخلق إحداهما من نظرة إعجاب لا يُستعاذ منها وأخرى من قلب تغلي فيه مرارة الحقد والغيرة، فالحسد يستدعي الجن، والعين تكون سببًا لضرر غير مرئي.
عندما نتعمق في هذه المعتقدات، التي لم تكن مجرد خرافات في نظر الناس، نجد بأنها أدت إلى حفظ الروابط الإجتماعية، فالحذر من الحسد يدفعهم إلى ستر النِّعم وعدم المبالغة في إظهارها، غير أن الإلتزام بالأدعية والتحصينات الشرعية يعزز الروابط الدينية خاصة عند المسلمين ويذكّر الفرد بضعفه أمام قدرة الخالق.
فقد ذُكر الجن والعين والحسد في مواضع متعددة في الأحاديث النبوية وفي القرآن الكريم، مثل سورة الجن وسورة الناس، باعتبارهم قوى غيبية قد تصيب الإنسان بأذى، ولكن رغم قدرتها على الإضرار إلا أنها لا تتجاوز إرادة الله وحكمه وأن الحماية الحقيقة منها تكون باللجوء إليه. إذ إنّ وسائل الحماية الدينية تتمثّل في المداومة على الأذكار والصلاة وقراءة المعوذتين وغيرها من الواجبات والعادات الدينية، إضافة إلى تجنّب الغلوّ في الحديث عن النِّعم أمام من يُخشى حسده، مع شكر الله عليها.
في النهاية يبقى موضوع العين والحسد والجن مزيجًا بين الموروث الشعبي في الأدب العربيّ والاعتقاد الديني والمجتمعيّ وبين الخيال والواقع. فقد تنوّعت واختلفت الآراء حياله، بين من يراه حقيقة ثابتة تؤكدها النصوص الشرعية وبين من يعتبره مجرد إرث ثقافي يعكس تصورات الأجيال التي مضت، ولكن ما لا يمكن الاختلاف عليه هو أن التحصين بالذِّكر وحُسن النية ونقاء القلب يبقى أكثر العوائد التي لا يملكها إلّا من آمن بأن الخير أقوى من الشر وأن الله هو الحافظ من كل مكروه. فهل الحماية الحقيقة تكمن في العبادات الدينية والأدعية وحدها أم هي صفاء القلوب قبل كل شيء؟ وإلى أيّ مدى يمكن للتعاليم الدينية أن تظل حصنًا لنا أمام هذه العوالم الغامضة؟
وهل سننسى كعربٍ القشورَ التي نحسد بعضنا عليها ونفتّش على شيء ذي قيمة يحسدنا الغرب عليه؟ أم أنّه كنت لو ناديت أسمعت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي!
-21-08-2025-08-45-20-9101.png)
ليا الترك (طالبة إعلام في جامعة بيروت العربية - فلسطينية/ لبنان)
من وادي عبقر إلى جوّالاتنا.. قراءة في فنجان الجن.. والعين المسكونة
يقولون إن وراء كل شاعر عظيم "جنّيًا عبقريًّا"، يجلس عند رأسه كمدير إبداعي متفرّغ. لا يتأخّر عن موعده، يوقظه قبل الفجر ويهمس له: "هيا استيقظ، فالبحر الطويل بانتظارك. هو جنّي من "وادي عبقر"؛ ذلك المكان الذي لا نعرف له بابًا ولا خريطة، لكنه في خيال العرب كان أكاديمية الفنون الأدبية للعالم الآخر. هناك، حسب الروايات، كانت الشياطين تعقد اجتماعاتها على صخور ناعمة، وتكتب أشعارًا بالرّمل قبل أن تسرقها الرياح وتُلقيها في حجر شاعر مسكين فيظن نفسه عبقريًّا.
ولم يكتفِ العرب بالحكاية، بل أعطوا لكل شاعر جنّيًا باسمه: امرؤ القيس وصديقه "لافظ بن لاحظ"، والأعشى مع "مسحل".. أسماء تبدو كأنها خرجت من مسلسل أسطوري، لكنها بالنسبة لهم كانت أصدق من الضوء. والغريب أن أحدًا لم يرَ هؤلاء، لكن حضورهم في القصائد كان أقوى من أيّ دليل، حتى صار الجن جزءًا من تعريف الموهبة. فالشاعر في نظرهم لا يولد عبقريًا، بل يوقّع عقد شراكة مع شيطان موهوب.
مرّت القرون، ولم يخرج الجن من حياتنا. لم يختفوا في الضباب ولم يذوبوا في أساطير الماضي… فقط بدّلوا عناوين سكنهم. من وادي عبقر إلى زوايا الكتب المهجورة، حيث الغبار أكثر وفاءً من القرّاء. تلك الكتب التي إذا فتحتها شعرت أن غبار القرون العتيقة يزحف إلى صدرك مع أول نفس. خذ مثلًا كتاب "شمس المعارف الكبرى" لـ "البوني"؛ مجرد اسمه كفيل بأن يغيّر مسار أيّ جلسة. لا تحتاج حتى إلى قراءته؛ فذكره وحده يجعل البعض يبتسم بتوتر، والآخرين يتهامسون وكأنك استدعيت شيئًا من عالمٍ آخر. يُقال إنه مليء بالطلاسم والتعاويذ التي تفتح أبوابًا… وأبواب الغيب، كما نعلم، ليست من النوع الذي تحبّ أن تُطرق فجأة. الغريب في الأمر أن هذه الكتب لم تكن يومًا دخيلة على ثقافتنا؛ إنها جزء أصيل من تاريخ طويل اعتاد أن يجعل الماورائيات مفتاحًا لتفسير كل ما استعصى على العقل… أو على الكسل.
في طفولتنا، لم يكن الخوف من الجن مجرد حكاية نسمعها قبل النوم، بل كان جزءًا من منهج التربية غير المعلن. الأمّهات والجدّات كنّ يعرفن جيدًا كيف يستعنّ بالخيال لضبط سلوكنا: "لا تخرج بعد المغرب، الجن بيخطفوك"، "نم قبل ما يجيك أبو رجل مسلوخة"، "إياك تروح عالنهر لحالك، بيطلع لك الغول". كنا نصدق ببراءة، نرتجف بصدق، ونبقى في أماكننا كما أردنَ تمامًا.
وكان لكل بلدٍ عربي حكاياته المرعبة. ففي لبنان، كان شبح "أم الشعور" يطلّ من بين الظلال، بشعر طويل مبلل يتدلّى كالأفعى، تخطف الأطفال من أقدامهم إذا تجرّأوا على اللعب قرب المياه. وفي المغرب والجزائر، عاشت "عيشة قنديشة" في الذاكرة الشعبية؛ امرأة فاتنة تظهر للرجال ليلًا لتغويهم قبل أن تقودهم إلى نهايات لا تُحمد. أما في الشام، فهناك "الطنطل" الذي يظهر في الطرقات المهجورة، و"أبو لبده" الذي يسكن الخرائب وكأنه حارس عقّارات مسكونة.
لكن الجن لم يبقوا أسرى الحكايات الشفوية؛ لقد انتقلوا معنا إلى الشاشة الكبيرة والصغيرة. في أفلام الأبيض والأسود ظهروا في صورة كوميدية: يرقصون، يختفون فجأة، يطلقون دخانًا ويغنّون على إيقاع الطبلة. ثم تطوّروا في السينما الحديثة ليصبحوا أكثر ذكاءً ورعبًا؛ في "الفيل الأزرق" مثلًا، لم يعودوا يكتفون بتخويف الأطفال، بل صاروا يغزون النفس البشرية نفسها، يتقمّصون وجوهًا بشرية، ويتسللون إلى التفاصيل التي لا نراها. أما في الأدب، فقد منحنا "أحمد خالد توفيق" تجربة مختلفة: قرأنا عنهم بين رغبة حقيقية في التصديق وابتسامة ساخرة تخفي خلفها سؤالًا أكبر: وماذا لو كان كل هذا حقيقيًّا؟
ورغم أن الجن فقدوا بعض سطوتهم في المدن الحديثة، إلا أن العين والحسد بقيَا أقوى من أيّ زمن مضى. الحسد، ذلك الضيف الثقيل الذي يتّهمه الناس بإفساد الأفراح وكسر القلوب وتعطيل المشاريع. في ثقافتنا، العين أسرع من الرصاصة، وأفتك من أيّ وباء عالمي، ولا تحتاج حتى إلى ذخيرة… مجرّد نظرة تكفي. لذلك اخترعنا طقوس الحماية: الخرزة الزرقاء على الأبواب، رشّة الملح على العتبات، وعبارة "ما شاء الله" التي نكرّرها بحماسة في كل حديث عن نجاح أو جَمال حتى صارت بمثابة كلمة مرور اجتماعية. هذه كلها طقوس بِتنا نمارسها حتى لو كنا نضحك عليها أحيانًا. ومع وسائل التواصل، تطورنا أكثر. أصبحنا نخفي وجهتنا قبل السفر، نقتطع الصور حتى لا يظهر شيء فاخر، نعيش في صراع يومي بين الرغبة في مشاركة الفرح والخوف من أن ندفع ثمنه بنظرة عابرة.
ربما نفعل ذلك لأن هذه المعتقدات تمنحنا تفسيرًا مريحًا لكل ما لا نحتمله. فبدل أن نلوم أنفسنا على فشل أو خسارة، نرمي التّهمة على عين حاسدة أو جنّ متربص، فيرتاح الضمير قليلًا. لكن المشكلة أن المبالغة في هذا الاعتقاد تجعلنا أسرى له؛ سجناء خوف دائم من نظرة، أو كلمة، أو حتى فكرة. وكأننا نعيش حياتنا تحت تهديد "التصويب البصري" أكثر من أي شيء آخر.
والدين نفسه أقرّ بوجود الجن والعين، لكنه رسم لهما حدودًا واضحة ومعاني دقيقة. غير أن الطبيعة البشرية لا تُقاوم الإضافات؛ فالنص الصريح يختلط بالموروث الشعبي حتى يصبح الحذر خرافة، وأحيانًا… تجارة رابحة. كم من "راقي" أو "شيخ" يحوّل خوف الناس إلى مصدر رزق مضمون، يبيع ماءً مقروءًا عليه وكأنه إكسير الحياة، أو يَعِد بطرد الجن مقابل جلسات لا تنتهي، وكأن الأرواح الشريرة تعمل بنظام الاشتراكات الشهرية.
ومع ذلك، لا يبدو أن الجن والعين والحسد سينتهون يومًا. الجن غيّروا وجوههم فقط: تركوا الخرائب ليظهروا في رواية تشدّك، أو فيلم يثير أعصابك، أو مقطع مرعب على "تيك توك" يُشعرك أن هاتفك مسكون. أما الحسد، فلا يحتاج حتى إلى التخفّي؛ إنه يعيش بيننا بلا أقنعة: في البيت، في العمل، في السوق، وربما في قلب أقرب الناس.
الفرق أن زمننا الحديث لم يكتفِ بالحسد التقليدي؛ بل ضاعف سرعته وانتشاره. فالشاشات جعلت المقارنة عادة يومية، وجعلت حياتنا معروضة بالكامل أمام عيون الغرباء، حتى صار كل نجاحٍ، وكل فرحة، وكل قطعة حلوى نشارك صورتها، هدفًا مفتوحًا على احتمالات الغيرة… أو ما نحب أن نسمّيه: العين القاتلة.
ربما لا نرى ما رآه الأجداد، وربما لم نعد نفسّر كل حدثٍ بالغيب كما كانوا يفعلون، لكن شيئًا فينا ما زال يقفز قلبه حين تُروى حكاية عن جنّي يزور البيوت، أو عينٍ أسقطت عروسًا في يوم فرحها. نحن مزيج من المنطق والخوف، من الإيمان والدهشة؛ نعيش في عالم حديث، لكننا نحتفظ في زوايا قلوبنا بباب صغير لا نجرؤ على إغلاقه تمامًا. ومن خلف ذلك الباب، لا نعرف ما ينتظرنا: ربما هو جنٌّ يبتسم، وربما نظرة حاسدة، وربما صمت المكان نفسه يحمل شيئًا يراقبنا. نغلق أعيننا لوقتٍ قصير، ونعتقد أننا آمنون… لكن أحيانًا، في خضم الليل، وفي همس الريح بين الجدران، نشعر أن شيئًا ما لا يزال هناك، يراقبنا، يضحك لنا بخفاء، وكأن الغيب لم يغب أبدًا.
-21-08-2025-08-45-41-9114.png)
د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب ـ جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر)
الجن في الأدب والدين والسينما والثقافة الشعبية
الأدب العربي مدينٌ للجن في "وادي عبقر" بإنجاب فحول الشعراء في العصر الجاهلي، وقد زعم بعض الشعراء بأنَّ لكل منهم جنٌّ يلهمه الشعر.. وكثيرةٌ هي الكتب التي تنتمي إلى التراث العربي ويُحذَّر حتى من قراءتها لأنها تحتوي على تعاويذ وطلاسم وما يختص بعوالم السحر، ولكنها تبقى كتبًا تراثية ولا يُمكن للثقافة العربية أنْ تُنكرها.
ثم إنَّ التخويف من الجن كان وسيلة "تربوية" يستعملها الأهل في تربية أبنائهم، ولكل منطقة عربية حكاياتها في هذا الشأن.. وقد نشطتْ خلال السنوات الأخيرة الكتابات والمنشورات حول الجن، من ناحية دينية أو من نواحي أخرى.
والجِنّ (اسم جمعٌ لكلمة "الجَانّ"، ومفردها "جِنِّيّ"، أو "جِنِّيَّة")، وفي القاموس: المفرد يُسمّى جني والأنثى تُسمّى جنية، وهو من الفعل جَنّ (بفتح الجيم وتشديد النون وفتحها) وهو بمعنى استتر وغطّى ومنها قولهُ تعالى في القرآن الكريم: "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ" (الأنعام، الآية: 76)، أي سترهُ ظلام الليل وغطّاه، والجن، وبحسب الأديان والأساطير العربية القديمة، مخلوقات تعيش في العالم ذاته ولكن لا يمكن رؤيتها عادة، وهي خارقة للطبيعة التي تدركها حواسّنا، لها عقول وفهم، ويقال إنما سُمّيت بذلك لأنها تستتر ولا تُرى. فلم ينكر المعتقد الإسلامي على العرب وجودها، بل أَفرد جزءًا ليس بيسير ليتحدث عنها في النصوص الدينية الإسلامية، مزاوجا في كثير من الأحيان بين "الإنس" (أي الناس أو البشر) و"الجن".
ويعتقد الكثير من الناس بوجودها وبأنها هوائية قادرة على التشكّل بأشكال مختلفة، ولها قدرة على عمل الأعمال الشاقة، كما أجمع المسلمون قاطبة على أنَّ النبي محمد مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس ولقد ورد ذكر ذلك في القرآن: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (سورة الأنعام، الآية 19)، وهناك سورة كاملة في القرآن اسمها "سورة الجن".
وقد كتب الدكتور "عبد الله بن سعد الدريس" عن الجنّ في التراث العربي دراسةً ببليوجرافية درس فيه عوالم الجنّ التي تتشوّف النفس البشرية للبحث عن أسرارهم وخباياهم، وفي الإسلام نشطت الأقلام بتدوين قصصهم الغريبة والعجيبة، وصدّ التعاويذ البشرية بمعوذات شرعيّة، وقد أشار الباحث إلى مقالة تحكي ما بقي من الخرافات بعنوان: "الأرضة آفة المخطوطات والبنايات وخرافات حولها"، ثم واصل عمله بجمع وتتبّع ما دوِّن عن الجنّ في الفهارس والأدلة وحفظها في مكان واحد باسم: الجنّ في التراث العربي دراسة ببليوجرافية، فبلغت (523) مادة مكتوبة، من بينها 61 مخطوطًا، و50 مقالًا و85 بحثًا، وبلغت الرسائل العلمية 35 عنوانًا، للماجستير منها 23 رسالة، وللدكتوراه 12 رسالة. وعدد الدوريات والمجلات التي تم الرجوع إليها واستخـراج المقالات والدراسات 37 مجلة.
وقد قام بحصر وتوثيق الإنتاج الفكري العربي حول عوالمهم، ووضعه بين أيدي الباحثين والدارسين تقديرا لجهود المؤلفين المعاصرين، وللوقوف على الثغرات الواجب تغطيتها لمساعدة مراكز المعلومات. وقد أعرض الباحث عن العناوين التي نهى الإسلام عنها، كما تجاوز الباحث تدوين الروايات العربية رغم كثرتها للتّباين بين عناوينها ومحتوياتها. وانتهى الباحث إلى تدوين مجموعة من الملاحظات والرؤى، أهمها: قوة التداخل والترابط في الحديث عن الجنّ، ونسبة مُؤلَّفات حول الجنّ إلى مجاهيل، والجدل الظاهر في بعض موضوعات الجنّ كدخولهم في الإنس، وزواجهم، والسطو على الموضوع بتغيير عنوانه. والتشابه في عناوين المؤلفات عن الجنّ، وهو قسمان: نوع مغتفر في اختلاف النسخ للنص الواحد، وبعضها الآخر تكرار للعنوان نفسه، والكتابة عن عالم الجنّ بمؤلفات متقاربة تتولى طبعها دار واحدة، وأحصى في هذا الشأن خمسة كُتّاب، لهم 34 كتابًا، والتباس مؤلفات الجنّ بالآيات والأذكار الصادرة عن الرقاة والمحتسبين.
الجن في الأدب العربي
استخدم الأدب العربي الجن كشخصيات خيالية لخلق أجواء من الغموض والإثارة.
الجن في الأدب المعاصر
لا يزال الجن حاضراً في الأدب العربي المعاصر، حيث يتم استخدامه في القصص والروايات لخلق أجواء خيالية ومشوقة.
الجن وسعد بن عبادة: يذكر التاريخ الإسلامي أن الجن تسببوا في مقتل الصحابي سعد بن عبادة. وقد أورد الدميري بعض أسماء الجن في الثقافة العربية ذكر منها ولم يحصرها في: أم الصبيان، وأم الدويس، والغول.
شعر الجن في التراث العربي.. مظاهر وقضايا ودلالات
وقد ألف الدكتور "عبد الله سليم الرشيد" كتيّبا عن "شعر الجن في التراث العربي.. مظاهر وقضايا ودلالات"، صدر عن المجلة العربية، ويشتمل الكتاب على توطئة، وثلاثة فصول الأول عن "الجن في التفكير العربي"، أما الثاني "مواقف بعض العلماء من هذا الشعر والأخبار المتصلة به"، وتضمن ثالثها، مقامات هذا الشعر.
فهل قالت الجنُّ الشعرَ؟ نعم، هذا ما زعمتْه العربُ في أدبيّاتها، وجعلتْ لشعر الجنّ مقاماتٍ ومظاهرَ، وأَضْفَت عليه أجواءً من الغرابة، وسمّت الجنيَّ الشاعرَ هاتفاً، وتتميماً لما ذُكر فإنَّ عنصراً مهمًّا في الشعر وهو: أنَّ الشعر يقوم على التخييل، فإن إدخال عنصر "الجن" فيه هو جزء من ذلك التخييل، أو الإيهام الموجّه.
شعراء العرب في الجاهلية وعلاقتهم مع الجن
ومن قبائل الجن المشهورة عند العرب هم قبائل: الشيصبان والجلاس والبلاز والقاز والخيعتبور.. وكان الجني الذي يلقّن الشاعر "الأعشى"... يقول:
ولي صاحب من بني الشيصبان -- فطورا أقول وطورا هوه
الجن في العلم الحديث
لا توجد أدلة علمية على وجود الجن في العلم الحديث، حيث أقيمت أبحاث وتحقيقات عدة عن المزاعم المنتشرة حول ما يُعرف بالبيوت المسكونة ولم تتوصل تلك التحقيقات والأبحاث إلى نتائج إيجابية. بينما في أحد التحقيقات توصّل المحققون إلى أنَّ وجود فراغات في الجدران وبعض الآلات الكهربائية القديمة كالمراوح يؤدي إلى ظهور الكثير من الأصوات عبر دوران وحركة الأجهزة وبسبب دخول الهواء في الجدران. كما أنَّ سبب الرطوبة الشديدة يُعزى كذلك إلى الأسباب المتعلقة بقدم تلك الدور.
من جهة أُخرى يُعزى كثيرٌ من حالات رؤية أو سماع الأجسام والكائنات الغريبة إلى هلوسات ذات صلة بالجاثوم أو بالباركينسون أو بتعاطي بعض المواد المخدرة فضلاً عن حالات نفسية مثل الشيزوفرينيا.
ويُضاف إلى الأسباب العلمية التي تجعل بعض الأشخاص يتوهّم وجود كائنات أخرى تُراقبه ذات وجوه أو صفات مشابهة للبشر وخصوصاً في الليل والأماكن المتروكة هو الباريدوليا.
ويُعزى إلى عدد غير قليل من المواد الكيمياوية المحدثة للهلوسات دور إيهام العامة في بعض البلاد بوجود جن مسلط من قبل ساحر، حيث يوهم الساحر الناس بإعطائهم عددا كبيرا من الوصفات والتعليمات ويدس بينها إحدى المواد المهلوسة ذات التأثير الفعلي وكثير من هذه المواد مستخدمة في البلاد العربية أيضا.
الجن في الإسلام
يُجمع المسلمون على إقرار وجوده وقد ورد في القرآن: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر:27]. ويوجد في القرآن سورة كاملة باسم الجن وهي سورة الجن.
ويعتقد المسلمون بأنَّ للجن قوى مادية غير عادية، وأنَّ الجن باستطاعتها رؤية الناس، والبعض يعتقد إنَّ أجسام الجن غير مرئية وقادرة على التشكل بالشكل الذي تريده، ولكن الجن له وجود مادي لحياة عاقلة ورد ذكرهم في الكتب السماوية.
ويقوم بعض المتخصصين بالقراءة من القرآن على أشخاص مسّهم أو تلبَّسهم الجن لإخراجهم ويحدث في ذلك مخاطبة الجني ومجادلته حسب اعتقاد بعضهم.
ولقد سُمّوا جنًّا في لغة العرب لاستتارهم عن العيون، فهم يرون الناس ولا يستطيع الإنسان رؤيتهم، وهذه الحقيقة ذكرت في القرآن: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف:27]، والمقصود إنَّ الإنسان لا يرى الجن على صورتهم الحقيقية التي خُلقوا عليها ولكن قد نراهم بصور أخرى متجسّدين لها أو وهمًا للعقل كشبحٍ وغيره كما يحصل لبعض الأشخاص.
ويقرّر القرآن إنَّ حقيقة الجن خلق آخر غير الإنس وغير عالم الملائكة والأرواح، وبين الجن والإنسان قدر مشترك من حيث الاتّصاف بصفة العقل والإرادة ومن حيث القدرة على اختيار طريق الشر والخير، ومن حيث التكليف بالعبادة وحسب ما ذكر في القرآن في قولهِ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:56]، وفي قوله: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر:27].
الجن في القرآن الكريم
كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً في الأرض، وبين الإغراق في الوهم، والإغراق في الإنكار، يقرّر دين الإسلام حقيقة الجن، ويصحّح التصورات العامة عنهم ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانهم الموهوم:
الجن لهم حقيقة موجودة فعلاً وهم كما يصفون أنفسهم: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا﴾ (سورة الجن، الآية 11). فمنهم الضّالون المُضلّون ومنهم السذّج الأبرياء الذين ينخدعون: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (سورة الجن، الآية 4-5).
فهم قابلون للهداية من الضّلال، مستعدون لإدراك القرآن سماعاً وفهماً وتأثراً: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ (سورة الجن، الآية 1-2).
فهم قابلون بخلقتهم لتوقيع الجزاء عليهم وتحقيق نتائج الإيمان والكفر فيهم: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ (سورة الجن، الآية 13-14).
وهم لا ينفعون الإنس حين يلوذون بهم بل يرهقونهم: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (سورة الجن، الآية 6).
والجن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ (سورة الجن، الآية 12).
ولقد صحّحت هذه الآيات القرآنية ما كان يعتقده المشركون من العرب وغيرهم ويظنونه عن قدرة الجن ودورهم في هذا الكون، حيث وردت في الجن آيات كثيرة توضح حقيقتهم في هذا العالم ومنها: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ (سورة الأنعام، الآية 130)، ومنها ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ (سورة الحجر، الآية 27)، ومنها ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة السجدة، الآية 13)، ومنها ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورة الذاريات، الآية 56)، ومنها ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (سورة الرحمن، الآية 33)، ومنها ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ (سورة الجن، الآية 1)، ومنها ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾.
الجن في السُّنة النبوية
ورد في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: أستطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا به جاء من قبل حراء فقلنا: "يا رسول الله فقدناك وطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم"، فقال صلى الله عليه وسلم: "أتاني داعي الجن فذهبتُ معه فقرأت عليهم القرآن"، قال ابن مسعود: فانطلق بنا، صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم...) (صحيح مسلم بشرح النووي، 4/170).
ورُوي في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من نار، وخُلق آدم كما وصف لكم" (صحيح مسلم بشرح النووي 18/123).
أصناف الجن في السنة النبوية
عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون" (رواه الطبراني، وابن حبان، والحاكم).
فالجن على هذا الأساس لهم العديد من الأشكال والأصناف التي يتشكل بها، فمنهم الغواص في قولهِ: ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ (سورة ص، الآية 37)، ومنهم غير ذلك أصناف متعددة.
ويمتاز الجن بسرعة التنقل بحكم أنَّ جسدهم متكوّن من طاقة، الطاقة الكهرومغناطيسية نفسها التي تنبعث من النار.
الجن في الثقافات العربية
تحتوي الثقافات العربية على العديد من القناعات والمفاهيم المتعلقة بالجن وتتداول بعض الأساطير والقصص عنهم بعضها يؤخذ للتسلية وقد يؤمن بعضهم بوجودها على أرض الواقع. وأورد الدميري بعض أسماء الجن في الثقافة العربية ذكر منها ولم يحصرها في: أم الصبيان، وأم الدويس، والغول.
وهذه التصنيفات لمسمّيات الجن عند الناس فقط، ولا يوجد دليل يبيّن حقيقة هذه الأسماء، ولا يعني ذلك وجودها حقيقة سوى في خرافات القصص الشعبية التي يتداولها البسطاء، مثل قصة علاء الدين والمصباح السحري، أو مارد المصباح، وعموما لم يرد لهذه المُسمّيات ذِكر في مصدر موثوق، سوى كلمة شيطان وجن أو عفريت التي ذُكرَت في الكتب السماوية. ولغويًا يطلق جني وجان للمفرد وجن للجمع، فإن أريد ممن يسكن البيوت مع الناس قيل عامر، فإن كان ممن يتعرض للأطفال والصبيان قيل: روح أو أرواح، فإنْ كان خبيثا سُمّي: شيطان، فإذا زاد خباثة وشرًا قيل مارد، فإن قوي على عمل الأعمال سُمّي: عفريت. وورد ذكرهم في الأدبيات العربية بأنهم يتصوّرون على شكل الحيوانات والبهائم ومنهم مَن يتصور بشكل الإنسان وهذا وهمٌ للأعين لا حقيقة له، وورد ذكر تصوّر الجن في صورة القط الأسود والكلب الأسود، بل ورد ذكرهم كذلك في أدبيات القرون الوسطى في أوروبا لصورة الشيطان بأن له لحية مُدبّبة وقرنان ورأس أسود وغير ذلك، كما ورد في دائرة المعارف الحديثة.
الجن في النقوش والآثار
لا تظهر الجن، بالمفهوم الإسلامي، في نقوش ما قبل الإسلام مطلقاً، وإنما توجد مجموعة من الآلهة الوصية والحامية في مدينة "تدمر" تُسمّى "جن" (ginnayê)، وظهرت عند الأنباط مرتين، وهي تسمية مشتقة من المصطلح اللاتيني (genii) "الجنيوس" الروح الحارسة في الدين الروماني.
وتؤكد الباحثة "إيميلي سافاج – سميث" على التمييز بين الآلهة الصالحة والجن الشرّيرين، لكنها تعترف بأن مثل هذا التمييز ليس مطلقا. في "تدمر" و"بعلبك" تستعمل مصطلحات "جني" و"إله" بالترادف. ويرى "فلهاوزن" بالمثل أنه في عصور ما قبل الإسلام كان يُفترض وجود كائنات جنيّة صديقة ومفيدة، وهو يميز بين المصطلحين (إله وجني) استنادًا إلى العبادة، حيث تُعبد الجن في الخفاء بينما تجري عبادة الآلهة علناً، على الرغم من أنَّ قابلية الجن للموت تجعلهم في مكانة أدنى من الآلهة. ويبدو أن تبجيل الجن كان له أهمية أكبر في الحياة اليومية للعرب قبل الإسلام، أكثر من الآلهة أنفسهم. ثقافة الجن ومجتمعهم كانا مشابهين لثقافة عرب الجاهلية، حيث كان هناك زعماء قبليّون يحمون حلفاءهم وينتقمون لأيّ عضو في قبيلتهم أو حلفائهم.
وبحسب العقيدة الإسلامية، تبدأ قصة الإنسان بتمرد إبليس، زعيم الجن، الذي رفض أنْ يسجد لآدم، ليُطرد كعقاب من الله، وهكذا يبدأ حربه ضد الله والإنسان، بدأه بخداع آدم وحواء في الجنة، مما أدى إلى هبوطهما إلى الأرض.
إنَّ إبليس المخلوق من نار يشبه الإنسان روحيًّا من حيث القدرة على الحكم الأخلاقي المستقل وحرية التصرف. وغالبًا ما يُصوَّر الجن غير المرئي على أنه كائنات مخيفة، وفي التصوّر الإسلامي، يحتل الجن عالم الظل، في آن واحد مشترك مع البشر، ولكنه أيضًا يتجاوز الزمان والمكان الماديين.
ويمكن للجن رؤية الأشياء التي يقوم بها البشر وسماعها، وبعضهم لديه القدرة على التأثير على أفعال الإنسان، والتأثير بهدوء على الرجال والنساء لاتخاذ خيارات قد لا تكون في مصلحتهم الفضلى. ويُعرف الجن الذي يرافق البشر باستمرار، بالقرين وهو نوع واحد فقط من عدة أنواع أخرى من الجن.
وتأتي كلمة "جِنّ" من الجذر العربي الثلاثي "جَنّ"، والذي يعني إخفاء وهو وصف مناسب للكائنات التي يتم إخفاؤها عن الرؤية البشرية، في عالم موازٍ يعرف باسم عالم الغيب.
وتشير "أميرة الزين"، مؤلفة كتاب "الإسلام والعرب والعالم الذكي للجن"، إلى أنَّ هذه الكائنات كانت تُعبد من قبل العرب قبل الإسلام، الذين اعتبروها جزءاً من عناصر الطبيعة، كما يعتقد بعض الباحثين والهواة أنَّ الجن نشأ في الأساطير القديمة لبلاد ما بين النهرين، حيث كانت الكيانات الشبيهة بالجن تُعبد كآلهة.
سكان الأرض الأصليون: في بعض الأساطير العربية، يقال إنَّ الجن هم السكان الأصليون للأرض، وأنهم حكموا الكوكب مرّة واحدة بعد محاربة أشكال الحياة الأخرى المعروفة باسم الــ "هِن" المخلوقة من الرياح، ومخلوقات الــ "بِن"، المخلوقة من الماء.
ورجّح "زكريا القزويني"، عالم الفلك الفارسي من القرن الحادي عشر، أنَّ أصل الجن يعود إلى وقت مبكر من خلق الله للحياة، يسبق تاريخ البشرية، وكان "القزويني" منبهرا جدًا بالأمور الخارقة للطبيعة، إلى درجة أنه أنتج كتابًا مصوّرًا برسومات لمخلوقات أسطورية رائعة لم يتم تسميتها. والكتاب الذي يحمل عنوان "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" كُتب باللغة العربية وتُرجم إلى اللغتين الفارسية والتركية.
وتحت وصفه لمملكة الحيوانات، كتب فصلاً عن المخلوقات بما في ذلك الوحوش والشياطين والجن، حيث يوصف الأخير بأنه مخلوقات غير محسوسة وقادرة على تغيير شكلها.
وذُكرت هذه الكائنات غير المرئية في القرآن الكريم، حيث وُصِفت بأنها مخلوقة من نار، حيث كانت هذه المخلوقات تحظى بتقدير بعض المجتمعات قبل مجيء الإسلام، والتي ربما استمرّت أيضًا في عبادة الجن كآلهة.
وقد خُصّصت سورة كاملة في القرآن، وهي "سورة الجن"، للحديث عنهم، وفي كامل القران، يتم التذكير بأن الخلاص يقدّم لكل من الإنس والجن على حد سواء.
وبحسب أحد التقاليد الأسطورية، كانت الأرض في يوم من الأيام مرتعًا للفوضى التي تسبب فيها أقوام الهن والبن، الذين ربما كانوا قبائل قديمة يتمتعون بقوى خارقة للطبيعة.
تم ذُكر الهن في التقاليد العربية قبل الإسلام، وقد تم قبول وجودها من قبل المسلمين العلويين والمجتمع الدرزي، الذين يؤمنون أيضًا بالبن الذين قيل إنهم يعيشون فيما يُعرف الآن باليمن.
ويشار أيضًا إلى رِم وتِم، حيث يقترح البعض أن الأربعة هم الكائنات نفسها الموصوفة في كتاب التكوين التوراتي على أنهم عمالقة نفيليم، وهم عمالقة غامضون كانوا موجودين في وقت ما قبل البشرية.
الملائكة والبشر والجن
وتعتبر بعض الأساطير أنه بمجرد أن نجح الجن في هزيمة هن وبن، أصبحوا سادة الأرض، ولكن بدلاً من السلام تبع ذلك الدمار، حتى تم إرسال ملائكة من نور نقي إلى الأرض لمحاربة الجن الأشرار الذين تسببوا في مذبحة.
تم سرد قصة مماثلة في كتاب أخنوخ، الذي يصف معركة بين الملائكة والشياطين، وربما كان مصدر إلهام لأوصاف الجن في وقت لاحق من قبل المسلمين، مثل القزويني وغيره.
وبحسب الكتاب، عندما انتصرت الملائكة في المعركة، تم إلقاء الجن الشرّير في أجزاء نائية من الكوكب، مثل الجزر والكهوف والغابات. ثم ذُكر الجن فيما بعد في الحكايات العربية كأرواح مخيفة في التضاريس المهجورة، تنتظر المسافرين العابرين لتخضعهم للعذاب.
ويقال إنَّ البعض الآخر بنوا منازل على أنقاض حضارات مثل منطقة مدائن صالح، التي تعرف الآن بالمملكة العربية السعودية الحديثة.
ويُعتقد في الغالب أنَّ الجن أرواح خبيثة، لكن بحسب العقيدة الإسلامية فهناك أيضًا أفراد صالحون من الجن يعيشون بهدوء جنبًا إلى جنب مع البشر في بُعد موازٍ غير مرئي، ومثل البشر لديهم هياكل عائلية وممالك ويمكن أنْ يكونوا مسلمين أو كافرين.
وينسب المسلمون إلى الجن أحيانًا المساعدة في بناء بعض أعظم المباني في العصور القديمة، مثل الأهرامات ومعبد سليمان، ففي القرآن، كان للملك سليمان، المعروف بالنبي سليمان في العالم الإسلامي، القدرة على السيطرة على الجن وقيل إنه كان يبقيهم مشغولين للتأكد من أنه ليس لديهم الوقت لإحداث الفوضى في الأرض.
ويقال إنَّ سليمان استخدمهم لبناء معبده العظيم حيث كان لقوتهم ومهاراتهم دور كبير في ذلك، وكان منهم من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وهم لا يعلمون الغيب بدليل أن سيدنا سليمان بعد أن مات ظلت الجن يعملون حتى أكلت دابّة الأرض منسأته، فلما خرّ تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
وهم ذوو قوى خارقة، فقد قال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام حين طلب من أتباعه أن يأتوه بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
المَسّ بالجن
تاريخيا، لعب الجن دورا كبيرا في الفولكلور البدوي، فعلى سبيل المثال، غالبًا ما كان يُنسب الشعر، وهو فن قديم ومعتز به في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، إلى ما يشبه المسّ بواسطة الجن.
ولا يزال آخرون يلومون العالم غير المرئي على الحالات الطبية مثل الصرع أو الاضطراب ثنائي القطب، وكانوا يُبقون المرضى بعيدا عن الأعين بسبب الوصمة المجتمعية المرتبطة بالتعرّض المفترض للمسّ من قبل الجن، وفي المقابل يطلبون المساعدة من الشخصيات الدينية لطرد الأرواح الشريرة.
ومع انتشار العقلانية العلمية في عصرنا الحالي، فإن الإيمان بالجن بين المسلمين إما يتم تفسيره بشكل متزايد على أنه حكاية رمزية لظواهر طبيعية، أو يتم تنحيته ذهنيًّا على أنه أحد العناصر المتعلقة بعلم الغيب، ويقول البعض إنَّ الجن لا يستطيع امتلاك البشر جسديًا، وأسوأ ما يمكن أنْ يفعله هو زرع الأفكار في العقل، وترك الأمر للفرد لقبولها أو رفضها.
ويظل وجود الجن وشكلها مفتوحًا للتأويل، حيث يقول بعض المسلمين إنها مجازية بحتة ويقول آخرون إنَّ إنكار الإيمان بالجن ينفي إيمان المرء بالإسلام.
ومع ذلك، لا يزال الاعتقاد بالجن منتشرًا بين المسلمين، مع التقاليد المرتبطة بهم والتي تتناقل إلى الأجيال الجديدة عبر مشاركة قصص الجن قبل النوم وخلال التجمعات العائلية، وممارسة بعض الطقوس مثل ارتداء التمائم وتلاوة الأذكار.
الجن عند الفراعنة
الجن حارس المقابر الفرعونية وأسرار الفراعنة المرعبة عن استخدام السحر الأسود لحراسة الكنوز الفرعونية، ما بين الأسطورة والحقيقة هناك أقاويل كثيرة تنتشر من حين لآخر عن أسرار المقابر الفرعونية والسحر الأسود الذي كان يُستخدم لحراسة المقابر الفرعونية التي تحتوي على ثروات لا تقدر بثمن، لذلك لجأ الفراعنة إلى استخدام السحر الأسود لحراسة تلك الكنوز من اللصوص وذلك لاعتقادهم في البعث في زمان آخر، حيث لا أحد يستطيع أنْ ينكر وجود السحر والجن منذ زمن هاروت وماروت ونبي الله سليمان.
والجن هو حقيقة وذُكر في جميع الأديان السماوية ولا يستطيع أحد أن ينكر وجوده وكذلك السحر الأسود، حيث إنه انتشر منذ زمن سيدنا سليمان، وهو أفتك أنواع السحر.
وكذلك لا نستطيع أن ننكر حقيقة أنَّ الفراعنة برعوا في السحر بأنواعه، حيث تم إثبات ذلك من نقوش المعابد الموجودة إلى الآن، حيث اعتاد الفراعنة على دفن الكنوز الفرعونية مع الموتى اعتقادا منهم بأنهم سوف يبعثون في حياة أخرى ويقومون باستخدامها.
الجن حارس المقابر الفرعونية
من أسرار الفراعنة أنهم استخدموا السحر الاسود لحماية الكنوز والثروات من اللصوص، حيث قام الفراعنة بتعيين الجن حُرّاس المقابر الفرعونية عن طريق تحضير الكهنة لأحد الجن وتعيينه كحارس للمقبرة، وقد حكى بعض الشيوخ تجربتهم في التعامل مع الجن حراس المقابر بأنهم من أنواع مختلفة وأبشعهم رجل أسود مرعب لا يترك الكنوز إلا بطلب قربان من البشر أحيانا وهذا يفسر بعض الحوادث في قرى الصعيد عن اختفاء الاطفال.
كما يوجد أنواع أخرى من الجن مثل الذي يظهر على هيئة قرد ضخم بعين حمراء.
شيوخ العزيمة
هناك أنواع من الجن مَن يظهر على شكل أفعى كبيرة ويتم التعامل معه عن طريق بعض الشيوخ الذين يسمّون بـ "شيوخ العزيمة"، ويحذر هؤلاء الشيوخ من الاقتراب من تلك المقابر لأنه لا يستطيع التعامل مع كل أنواع الجن حيث قد يسبب القتل والمس الشيطاني.
ثلاثة طرق استخدمها الفراعنة لحماية المقابر
استخدام الفراعنة الجن الذي يُسمّى بالرّصد وفخ المهلك واللعنة، ويُعدّ الرصد من أخطر أنواع الجن الموجودة ويحتاج إلى شيخ له صفات معينة للتعامل معه ولكن حيث يستطيع الشيوخ التعامل مع بعض هؤلاء الجن الضعيف الذين يستخدمون كوسيط بين الرصد والشيوخ، حيث من الممكن أن يفرّ الجن من قوة الشيوخ أو يضلّهم عن مكان الكنز.
فخ المهلك
صمم الفراعنة بعض الطرق المتعددة للوصول إلى المقابر، وذلك من أجل حمايتها من السرقة، حيث أنهم كانوا يصنعون طريقاً مغطى بطبقه رقيقة من الرمال.
بحيث لا يحتمل عصفور.. بما يدل على شدة نعومة الرمال المستخدمة ويكون موقع هذا البئر قبل الغرفة التي يوجد بها الكنوز لكي يكون مصيدة للسارق.
أما المهلك الثاني هو سرداب مصمم على حجر كبير وباب وهمي من الأحجار وفي المنتصف حجر كبير مميز الشكل وعند لمسه ينهار السقف وجميع الغرف. مما يدل على براعة الفراعنة في علم الهندسة وقدرتهم على تصميم وترتيب الأحجار لتؤدي الغرض الذي يريدونه.
أما المهلك الثالث: فهو وجود أبواب وهمية متماثلة في الشكل عندما تصل إليها سوف تصاب بالحيرة فإنك لا تعرف ما هو الباب الذي يؤدي إلى الكنز، وعندما يفتح أحد هذه الأبواب تجد رياحا قوية من الرمال البيضاء تؤدي إلى الوفاة، وكذلك سوف تجد بعض الغازات السامة تنبعث من جدران المقابر لتهلك مَن يقترب إليها، مما يدل على مدى العلم الذي وصل اليه الفراعنة منذ آلاف السنين في جميع المجالات وهدفهم الأول والأخير هو حماية الكنوز والثروات.
ما هو الركاز؟
الركاز هو كل مال عُلم أنه من دفن أهل الجاهلية ما قبل الإسلام، لذلك يحلّل أهل القرى مثل هذه الثروات رغم تحريم وتجريم الدولة لها، لهذا يتعرضون لمخاطر كبيرة من قبل الجن حراس المقابر.
لعنة الفراعنة: يقال إنها تصيب أي أحد يحاول أن ينبش في المقابر الفرعونية لسرقتها، حيث تم الكشف عن حادثة حدثت بالفعل وهي مسجلة عند اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون" أنهم وجدوا عبارة مكتوبة على باب المقبرة "سيرفرف الموت السام بأجنحته كل مَنْ أزعج الملك".
ويؤكد كتاب "لعنة الفراعنة" أنَّ كل العلماء الذين اكتشفوا هذه المقبرة توفّوا بطرق غريبة ومختلفة.
الجن في التراث الشعبي: دراسة مقارنة
يُعدّ الجن من أبرز المكونات الرمزية في التراث الشعبي العربي، إذ ارتبط اسمه بعالم الغيب والمجهول، وشكّل حضورا واضحا في الحكايات والمعتقدات الشعبية، فضلاً عن وروده في النصوص الدينية الإسلامية، مما منح صورته طابعا خاصا يجمع بين العقيدة والخيال الشعبي. وقد اهتمت الثقافات الإنسانية عامة بتصوير كائنات خفية تمثل القوى الغامضة، وهو ما أوجد تشابهاً بين صورة الجن في الموروث العربي وصور الأرواح والكائنات العجيبة في الفولكلور الأوروبي والآسيوي والإفريقي.
وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على صورة الجن في التراث الشعبي العربي، ثم مقارنتها بما يقابلها في الثقافات العالمية، مع بيان أوجه التشابه والاختلاف ودلالاتها الرمزية.
أولاً: الجن في التراث الشعبي العربي
يحتل الجن موقعًا بارزًا في المخيلة الشعبية العربية، حيث امتزجت الرؤية الدينية بالتصورات الأسطورية.
البعد الديني: جاء ذكر الجن في القرآن الكريم باعتبارهم مخلوقات خُلقت من نار، مكلّفة بالعبادة والطاعة، مما جعل وجودهم حقيقة إيمانية عند المسلمين.
البعد الشعبي: طوّرت المخيّلة الشعبية صورة أوسع للجن، فاعتبرتهم قوى غامضة تسكن الخرائب والآبار والوديان، وقدرتهم على التشكل بأشكال حيوانية أو بشرية، ونُسبت إليهم أدوار في المرض والمس والسحر.
في الأدب الشعبي: تجلت صورة الجن في حكايات "ألف ليلة وليلة" وغيرِها، حيث ظهروا في هيئة كائنات عجيبة تمتلك قدرات خارقة، تجمع بين الخير والشر، وتؤدي دوراً مهماً في نسج الأحداث الأسطورية.
ثانياً: الجن في الثقافات العالمية
1- في الفولكلور الأوروبي: ظهر ما يشبه الجن في أوروبا تحت مسميات متعددة مثل الغوبلن والإلف والترول، وجميعها كائنات غامضة تعيش في الغابات والكهوف. وقد حملت صفات مزدوجة: منها من يساعد الإنسان، ومنها من يضلله أو يؤذيه. وفي العصور الوسطى ربطت الكنيسة هذه الكائنات بالشياطين، كما حدث في بعض التفسيرات الشعبية العربية.
2- في الثقافة الهندية: تُعرف الأرواح في الهند بـ اليكشا والراكشا، وهي كائنات غيبية تسكن الجبال والأنهار، منها الخيّرة ومنها المؤذية. وقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالممارسات الدينية والطقوس، كما أُسند إليها التأثير في الأمراض والمس، وهو ما يشبه اعتقاد العرب في الجن.
3- في الموروث الإفريقي: في إفريقيا، برزت الأرواح الخفية أو "أرواح الأجداد" التي تُستحضر في الطقوس الشعبية وتؤثّر في حياة الأفراد والجماعات. وقد ارتبطت بقدرات خارقة، واستُخدمت الطقوس والرقى لطردها أو استرضائها، وهي فكرة تتقاطع مع الموروث العربي الإسلامي حول الاستعاذة من الجن والرقية الشرعية.
ثالثًا: أوجه التشابه والاختلاف
أوجه التشابه:
- تمثل جميع هذه الكائنات محاولة لتفسير الظواهر الغامضة التي يعجز العقل عن تفسيرها.
- ارتبطت هذه الكائنات بالأماكن المهجورة والمظلمة كالصحارى والكهوف والجبال.
- دخلت في الممارسات السحرية والشعوذة والطقوس الشعبية.
أوجه الاختلاف:
- يتميز التراث العربي بأن صورة الجن فيه جمعت بين الاعتقاد الديني (الجن مخلوقات مكلفة) والخيال الشعبي، بينما اقتصرت في الثقافات الأوروبية والهندية والإفريقية على البعد الأسطوري أو الطقوسي.
- في الموروث العربي، وُجد توازن بين الجن كقوة شريرة وكائن قادر على الخير، بينما في بعض الثقافات الأخرى طغى الجانب العدائي أو الطقوسي.
يتضح من هذه الدراسة أن صورة الجن في التراث الشعبي العربي تمثل امتدادًا للنزعة الإنسانية العامة في تجسيد المجهول عبر كائنات غيبية. غير أن ما يميز التجربة العربية هو تداخل البعد الديني مع الشعبي، مما منح صورة الجن ثراءً خاصًا يجمع بين العقيدة والأسطورة. ومن خلال المقارنة بالثقافات العالمية، يتأكد أن الاعتقاد بوجود قوى غيبية أمر مشترك بين الشعوب، لكنه يتلوّن بحسب الخلفية الدينية والثقافية، فيغدو الجن مرآة لوعي الإنسان بالخوف والرهبة من المجهول، ورمزاً لتفسير ما يعجز عن إدراكه بالعقل والتجربة.
الجن في الشعر العربي: من الإلهام إلى الرمز
يحظى الجن بمكانة بارزة في المخيال العربي منذ الجاهلية، حيث ارتبطت صورتهم بالرهبة والغموض، ثم انتقلت إلى الشعر لتصبح عنصراً مؤثراً في تشكيل الصور الفنية والتعبيرية. وقد تراوحت صورة الجن في الشعر بين كونهم مصدراً للإلهام والإبداع، وكونهم رمزا للغموض والقوة الخارقة، حتى غدوا عنصرا جماليًّا ورمزيًّا في مختلف الأغراض الشعرية من الغزل إلى المدح والهجاء والوصف. تهدف هذه الدراسة إلى تتبع صورة الجن في الشعر العربي عبر العصور، ورصد تحوّلاتها من الاعتقاد الواقعي إلى البعد الرمزي والفني.
أولاً: الجن والإلهام الشعري في العصر الجاهلي
في المجتمع الجاهلي، كان الاعتقاد سائداً بأن لكل شاعر تابعاً من الجن يلهمه القول، وهو ما أضفى هالة غيبية على شخصية الشاعر.
قال الأعشى عن مصدر إلهامه:
دعاني إلى قولِ الهُجاء مُسَحَّلٌ -- شَيطانُ إنْسٍ بَعْدَ ما أنا مُعْتَبُ
حيث يقرن بين شعره وبين شيطانه "مسحل"، مما يعكس اعتقادًا شائعًا بارتباط الشعر بالجن.
كما ارتبط ذكر الجن بالليل الموحش والصحراء، التي صوّرها "امرؤ القيس" في معلّقته، حيث ارتبط الليل الطويل المخيف بمسكن الجن، وإن لم يصرّح بهم صراحة.
ثانيًّا: الجن في الشعر الإسلامي والأموي
مع مجيء الإسلام، تغيّرت صورة الجن في الوعي الجمعي، إذ أعاد القرآن ضبطها باعتبارهم مخلوقات من خلق الله، لا مصدر إلهام للشعراء. ومع ذلك بقيت إشاراتهم الشعرية قائمة، ولكن في أطر مجازية أكثر:
في الهجاء: استُخدمت استعارات الجن لتصوير الخصوم بالمكر أو الخديعة.
في الغزل: شبّه الشعراء جمال المحبوبة بسحر الجن، كما في قول "بشار بن برد":
كأنَّ فُتونَها جنّيَّةٌ تُخفي -- وتُظهِرُ في الظلامِ قوامَها
ثالثًا: الجن في الشعر العباسي
في العصر العباسي، ومع اتساع الخيال الشعري، اتخذت صورة الجن بعداً فنياً رمزياً أوسع:
في المدح: وظّف الشعراء صورة الجن لتضخيم القوة، كما قال المتنبي في سيف الدولة:
تَصُولُ بِهِ الهَامُ الجُحافُ كَأَنَّهُ -- جُنودٌ مِنَ الجانِّ اجتَمَعنَ عَلى أَمرِ
حيث جعل جنود الأمير كأنهم جموع من الجن، في تهويل للقوة.
في الوصف والفانتازيا: استخدمت صور الجن لإضفاء طابع عجيب وغرائبي على المشاهد الشعرية.
رابعًا: الجن في الشعر الأندلسي
في الأندلس، تأثّر الشعراء بالقصص القرآني عن تسخير الجن لسليمان، فأصبح الجن رمزًا للعظمة والبناء. قال "ابن خفاجة" في وصف قصر:
بناهُ له الجنُّ استجابةَ أمرِه -- فصارَ من الإعجازِ أعجوبةً تُرى
وهو توظيف للجن كبنّائين عظماء في سياق تصوير العمران الأندلسي الباذخ.
خامسًا: البعد الرمزي لصورة الجن في الشعر
من خلال تتبع العصور، نلاحظ أن الجن اكتسبوا دلالات متعددة في الشعر:
- رمز للإلهام الشعري في الجاهلية.
- رمز للغموض والوحشة في وصف الليل والصحراء.
- رمز للجمال الفاتن في الغزل، حيث شُبّهت المحبوبة بالجنية.
- رمز للقوة الخارقة في المدح والحماسة.
- رمز للبناء والعظمة في الأندلس، متأثراً بالقصص القرآني.
يُظهر حضور الجن في الشعر العربي كيف امتزج الموروث الشعبي بالخيال الشعري، فتحوّل من اعتقاد جاهلي بوجود "شيطان الإلهام" إلى رمز أدبي غني بالدلالات. وقد نجح الشعراء في توظيف صورة الجن بمرونة، بحيث استوعبت أغراضاً مختلفة: من الغزل والهجاء إلى المدح والوصف، ومن تصوير الرهبة إلى التعبير عن الجمال والعظمة. وهكذا يمثل الجن في الشعر العربي انتقالاً من المعتقد الشعبي إلى الرمز الفني، ويكشف عن قدرة الشعر على تحويل الغيبيات إلى صور جمالية باهرة.
الجن في الأعمال الدرامية المصرية والعالمية
يُعدّ الجن من أكثر الكائنات الغيبية حضورًا في المخيلة الإنسانية، إذ ارتبطوا بالأسطورة والخرافة والخوف من المجهول. ومع تطور الفنون الحديثة، وجد الجن طريقهم إلى المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، حيث تحولت صورتهم من مجرد كائنات أسطورية في الموروث الشعبي إلى رموز درامية وفنية متعددة الأبعاد. وتكشف دراسة صورة الجن في الدراما المصرية والعالمية عن تشابهات واختلافات ترتبط بالثقافة والدين والبيئة الاجتماعية.
أولاً: الجن في الدراما المصرية
الدراما المصرية، بما تحمله من تفاعل مع التراث الشعبي العربي والإسلامي، قدمت الجن في أشكال متنوعة:
في الأعمال التراثية والفلكلورية: ظهرت قصص الجن المستمدة من "ألف ليلة وليلة" في المسرح والسينما منذ بدايات القرن العشرين، حيث صُوِّر الجن ككائنات خارقة قادرة على التحول وتحقيق الأمنيات، مثل شخصية "العفريت" الذي يساعد أو يعادي البطل.
في الدراما الدينية والتاريخية: استُحضرت صورة الجن في الأعمال التي تناولت قصص الأنبياء، خصوصًا في سياق الحديث عن تسخيرهم لسليمان عليه السلام.
في الدراما المعاصرة: مثل مسلسل ما وراء الطبيعة (المأخوذ عن روايات أحمد خالد توفيق)، حيث وظّف الجن كرمز للغموض والخوف النفسي، بعيدًا عن الشكل الكلاسيكي للجن الشعبي.
الرمز الاجتماعي: في بعض الأفلام الكوميدية أو الشعبية، جرى توظيف الجن بشكل ساخر، يعكس وعي المجتمع وتهكمه على الخرافات.
ثانيًّا: الجن في الدراما العالمية
تختلف صورة الجن في الأعمال الدرامية العالمية باختلاف الثقافة:
في الدراما الغربية (هوليوود): غالبًا ما يُقدَّم الجن في صورة "الجني" (Genie) كما في فيلم "علاء الدين"، حيث يظهر ككائن أزرق مرح يحقق الأمنيات. لكن في أعمال أخرى، يظهر الجن (Demon/Jinn) ككائن شرّير يمثل قوى الظلام، كما في أفلام الرعب (The Exorcist أو The Conjuring).
في الدراما الهندية (بوليوود): الجن أو "الجنات" حاضرون بكثافة، إما في صورة كائنات شريرة مرتبطة بالسحر الأسود، أو في صورة عاطفية ترتبط بالحب المستحيل، ويظهر هذا في العديد من الأفلام والمسلسلات الهندية ذات الطابع الفانتازي.
في الدراما اليابانية والآسيوية: يُستعاض عن الجن بكائنات شبيهة مثل "اليوكاي" (Yokai) أو "الأوني" (Oni)، وهي أرواح أو شياطين تلعب دوراً مشابهاً للجن، حيث تتراوح بين الخير والشر، وتُستخدم كرمز للقوى الخفية.
ثالثًا: أوجه التشابه والاختلاف
أوجه التشابه:
- الجن يمثلون في كل الثقافات رمزاً للغموض والخوف من المجهول.
- يُستخدمون دراميًّا لإضفاء الإثارة والتشويق، سواء في الرعب أو الفانتازيا.
أوجه الاختلاف:
- في الدراما المصرية والعربية، غالبًا ما يُستحضر الجن في إطار ديني أو شعبي متأثر بالقرآن والسُّنة.
- في الدراما الغربية، يظهر الجن بين صورتين: "الجني اللطيف" الذي يحقق الأمنيات، و"الشيطان الشرير" في أفلام الرعب.
- في الدراما الهندية والآسيوية، يختلط الجن بالديانات المحلية والأساطير، فتتنوع صورته بين الحارس الروحي والروح المؤذية.
يُظهر حضور الجن في الدراما المصرية والعالمية كيف تحوّلت هذه الكائنات الغيبية من مجرد معتقد شعبي إلى أداة فنية متعددة الاستخدامات. ففي مصر، ظل الجن مرتبطًا بالتراث والدين، بينما في العالم اتخذ أشكالاً أسطورية أو كوميدية أو رُعبِيّة. وتكشف هذه التّنويعات عن قدرة الجن على التلوّن مع الثقافة والوسيط الفني، ليظلوا أحد أبرز الرموز التي تستحضرها الدراما لإثارة الخيال وتحريك الوجدان الإنساني.
الجن في الأفلام المصرية
يُعدّ الجن من أكثر الكائنات الغيبية حضورًا في الموروث الشعبي العربي، وقد انتقلت صورتهم إلى السينما المصرية منذ بداياتها، حيث شكّلوا مادة خصبة للأعمال الكوميدية والفانتازية وأحيانًا لأفلام الرعب. وتكشف دراسة صورة الجن في الأفلام المصرية عن تفاعل الفن مع الخيال الشعبي من جهة، ومع القضايا الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
أولاً: الجن في السينما المصرية التراثية
منذ أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، بدأت السينما المصرية في توظيف صورة الجن والعفاريت بشكل كوميدي أو فانتازي.
- فيلم "عفريتة هانم" (1949) بطولة فريد الأطرش وسامية جمال، حيث ظهرت "عفريتة" مرحة تسكن مصباحًا وتساعد البطل في مواجهة خصومه. وقدّمت الصورة الشعبية للجن بشكل غنائي استعراضي بعيد عن الرهبة.
- فيلم "أحبك يا حسن" (1958) تضمن ظهور شخصية "عفريتة" تثير المواقف الكوميدية.
ثانيًّا: الجن في الأفلام الكوميدية
الكوميديا المصرية وجدت في "الجن والعفاريت" مادة خصبة للتهكم على الموروث الشعبي، وربط الخرافة بواقع اجتماعي ساخر.
- فيلم "الفانوس السحري" (1960) بطولة إسماعيل يس، حيث يلتقي البطل بجني يحقق له الأمنيات في إطار كوميدي ساخر.
- فيلم "عفريت مراتي" (1968) بطولة صلاح ذو الفقار وشادية، وهو من أشهر الأفلام التي جسدت "العفريتة" كشخصية أنثوية تدخل في صراع كوميدي مع الزوج.
ثالثًا: الجن في أفلام الفانتازيا والرعب
ابتداءً من السبعينيات، بدأت السينما المصرية توظف الجن في سياق أكثر إثارة ورهبة:
- فيلم "التعويذة" (1987) بطولة محمود ياسين ويسرا، ويُعَدّ من أبرز أفلام الرعب المصرية، حيث يستحضر الجن في إطار السحر والشعوذة.
- فيلم "الإنس والجن" (1985) بطولة عادل إمام ويسرا، حيث يجسد عادل إمام شخصية جني يقع في حب فتاة، في مزيج بين الرعب والرومانسية والفانتازيا.
- فيلم "البيه رومانسي" (2009) قدّم الجن في إطار معاصر يمزج الكوميديا بالفانتازيا.
رابعاً: الدلالات الرمزية والاجتماعية
رمز الخوف من المجهول: في أفلام الرعب مثل التعويذة، عكس حضور الجن القلق الاجتماعي من السحر والشعوذة.
رمز للفتنة والإغراء: في أفلام مثل الإنس والجن وعفريت مراتي، تجسد الجنّية رمزاً للمرأة الغامضة التي تربك الرجل.
رمز للخيال الشعبي: في الأفلام الكوميدية القديمة، عُرض الجن ككائنات خفيفة الظل، في محاولة للاقتراب من وعي الجمهور الشعبي والتخفيف من رهبتهم.
تكشف صورة الجن في الأفلام المصرية عن تنوع كبير في التناول الفني: من العفريتة المرحة في الأفلام الاستعراضية، إلى الجني الكوميدي الذي يثير الضحك، إلى الجني المرعب الذي يستحضر الخوف من المجهول. وبذلك جسّدت السينما المصرية تدرج صورة الجن من الأسطورة الشعبية إلى الرمز الفني المتلون، بما يعكس التحولات الاجتماعية والثقافية والذوق الفني للجمهور.
وهذه أشهر 10 أفلام مصرية عن الجن والعفاريت مع ملخص قصير لكل فيلم:
1- عفريتة هانم (1949). بطولة: فريد الأطرش، سامية جمال. الملخص: يحكي عن فنان فقير يجد مصباحاً سحرياً تسكنه "عفريتة" جميلة تساعده على تحقيق أحلامه، في إطار استعراضي غنائي يمزج بين الكوميديا والرومانسية.
2- الفانوس السحري (1960). بطولة: إسماعيل يس. الملخص: يلتقي البطل بجني ساخر يسكن فانوساً سحرياً، ويحقق له الأمنيات في مواقف كوميدية تكشف خفة دم إسماعيل يس، مع إسقاطات على الطمع الإنساني.
3- عفريت مراتي (1968). بطولة: صلاح ذو الفقار، شادية. الملخص: زوج يكتشف أنَّ زوجته في الأصل "عفريتة"، فتبدأ المفارقات الكوميدية بين حياة الرجل العادي وقوة الزوجة الخارقة، في طرح ساخر لمسألة الصراع بين الجنسين.
4- الإنس والجن (1985). بطولة: عادل إمام، يسرا. الملخص: شاب وسيم يتضح أنه جني يقع في حب فتاة بشرية، لتبدأ صراعات بين العالمين، في عمل يمزج بين الرومانسية والرعب والفلسفة حول العلاقة بين الإنس والجن.
5- التعويذة (1987). بطولة: محمود ياسين، يسرا. الملخص: أحد أوائل أفلام الرعب المصرية، يحكي قصة أسرة تواجه قوى شريرة من الجن بفعل السحر الأسود، لتتصاعد الأحداث في أجواء مشحونة بالرعب والخوف.
6- بيت القاضي (1995). بطولة: عزت العلايلي، ميرفت أمين. الملخص: يتناول أحداثاً غامضة داخل بيت قديم يُقال إنه مسكون بالجن، حيث يختلط الرعب بالجانب البوليسي في إطار يحاكي الموروث الشعبي عن "البيوت المسكونة".
7- كابوس (1990). بطولة: مديحة كامل، حسن حسني. الملخص: فيلم رعب نادر تناول فكرة الجن الذي يظهر في أحلام البطلة ويحوّل حياتها إلى جحيم، مما يثير الشكوك بين المرض النفسي أو المسّ الشيطاني.
8- الأبالسة (1971). بطولة: فريد شوقي، ناهد يسري. الملخص: يقدّم الجن والعفاريت كرموز للشر المطلق الذي يفتك بالمجتمع، في إطار درامي مليء بالعنف والإثارة.
9- كلام جرايد (2014). بطولة: لطفي لبيب، عزت أبو عوف. الملخص: فيلم اجتماعي كوميدي، تطرح أحداثه موضوع الجن بطريقة ساخرة من خلال الإشاعات والخرافات المنتشرة في المجتمع المصري.
10- البيه رومانسي (2009). بطولة: محمد إمام، حسن حسني. الملخص: يقدم قصة شاب يواجه أحداثاً غير متوقعة مع ظهور "جني" في حياته، في مزيج من الكوميديا والرومانسية والفانتازيا الخفيفة.
هذه الأفلام تكشف كيف تطورت صورة الجن في السينما المصرية:
- من المرح والفانتازيا الغنائية (عفريتة هانم، الفانوس السحري).
- إلى الكوميديا الاجتماعية (عفريت مراتي).
- إلى الرعب والإثارة (التعويذة، بيت القاضي).
- وصولاً إلى المزج المعاصر بين الكوميديا والفانتازيا (البيه رومانسي).
الجن بين السينما المصرية والعالمية: دراسة مقارنة في التصوير الدرامي
يُعَدّ الجن أحد أكثر الكائنات حضورًا في المخيلة الإنسانية عبر العصور، إذ ارتبط بالأساطير والديانات والموروث الشعبي على السواء. وقد وجدت السينما في هذا الكائن الغامض مجالاً خصبًا لتجسيد الرعب، وإثارة الدهشة، وإضفاء الطابع الكوميدي أو الفانتازي. وإذا كانت الثقافة العربية قد حمّلت الجن دلالات ترتبط بالسحر والشعوذة والخوف الشعبي، فإن الثقافة الغربية تعاملت معه بوصفه امتدادًا لفكرة الأرواح الشريرة أو القوى الغيبية. ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة المقارنة، التي تسعى إلى تتبّع صورة الجن في السينما المصرية والعالمية، مع تحليل دلالاتها الثقافية والفنية.
أولاً: الجن في السينما المصرية
شهدت السينما المصرية تحوّلات واضحة في طريقة تمثيل الجن، يمكن تقسيمها إلى مراحل زمنية:
- مرحلة الفانتازيا الغنائية (1940م): مثل فيلم عفريتة هانم (1949) حيث صُوِّر الجن في قالب غنائي استعراضي.
- مرحلة الكوميديا الساخرة (1950–1960م): كما في الفانوس السحري (1960)، حيث أصبح الجن أداة لتحقيق الأمنيات وإثارة الضحك.
- مرحلة الاندماج الاجتماعي (1960–1970م): كما في عفريت مراتي (1968) الذي أدخل الجن في إطار الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.
- مرحلة الرعب الشعبي (1980–1990م): مع أفلام مثل الإنس والجن (1985) والتعويذة (1987)، حيث ارتبط الجن بالسحر الأسود والخوف من المجهول.
- مرحلة السخرية الحديثة (2000م وما بعده): كما في البيه رومانسي (2009) وكلام جرايد (2014)، حيث تحوّل الجن إلى رمز للخرافات في المجتمع.
يتضح أنَّ السينما المصرية ظلّت قريبة من الموروث الشعبي، متأثرة بالتصورات الدينية والاجتماعية حول الجن، فاستعملته تارة للتسلية والكوميديا، وتارة أخرى لتجسيد المخاوف الجمعية.
ثانيًا: الجن في السينما العالمية
في المقابل، شهدت السينما العالمية (خاصة الهوليوودية) مسارًا مختلفًا:
- مرحلة الفانتازيا الشرقية (1940م): كما في (The Thief of Bagdad) (1940) الذي استلهم ألف ليلة وليلة.
- مرحلة الكوميديا العائلية (1960م): مثل المسلسل الأمريكي (I Dream of Jeannie) (1965)، الذي قدّم الجن في صورة رومانسية كوميدية.
- مرحلة الرعب الشيطاني (1970م - 1980م): حيث ظهرت أعمال مثل (The Exorcist) (1973) و(Wishmaster) (1987)، وفيها اقتربت صورة الجن من مفهوم الأرواح الشريرة.
- مرحلة الفانتازيا التجارية (1990م): مع أعمال مثل (Aladdin) (1992) من ديزني، التي قدّمت الجن بصورة مرحة صالحة للأطفال.
- مرحلة الرعب النفسي (2000م وما بعده): كما في (Djinn) (2013) (إنتاج إماراتي/ أمريكي) و(The Possession) (2012)، حيث ارتبط الجن بالكوابيس والهواجس المظلمة.
تُظهر هذه المرحلة أن السينما الغربية تميل إلى إدراج الجن في إطار "الرعب الشيطاني" أو "الفانتازيا الطفولية"، بعيدًا عن جذوره الشعبية الشرقية.
ثالثًا: المقارنة والتحليل
- السينما المصرية قدّمت الجن منطلقًا من التراث الشعبي، ممزوجًا بالكوميديا أو الرعب الشعبي، ما جعل صورته متجذّرة في المخاوف والعادات العربية.
- السينما العالمية تعاملت مع الجن كرمز أسطوري عالمي أو كيان شيطاني، فحمل أحيانًا صبغة هزلية وأحيانًا رعبًا تجاريًا موجّهًا للجمهور.
- بينما ظلّت السينما المصرية مرتبطة بخطاب (ديني – اجتماعي) يرسّخ صورة الجن كقوة خفية مؤثرة في الحياة، فإن السينما العالمية أعادت إنتاجه ضمن سياقات الفانتازيا الهوليوودية أو الرعب الميتافيزيقي.
- يمكن القول إنَّ الجن ظلّ في السينما - سواء المصرية أو العالمية - تجسيدًا لقلق الإنسان من المجهول ورغبته في تجاوز حدود الواقع. غير أنّ الاختلاف الثقافي جعل السينما المصرية تُركّز على "الجن الشعبي" المتجذّر في الموروث الديني والاجتماعي، بينما جعل السينما العالمية تُقدّمه في ثوب "الروح الشريرة" أو "المخلوق الفانتازي". ومن ثمّ، فإنَّ دراسة الجن في السينما لا تكشف فقط عن أبعاد جمالية أو درامية، بل تُظهر أيضًا كيف تتشكّل المخيلة الجمعية للشعوب من خلال الفن السابع.
وقد استلهم "ابن شهيد" رسالته الطريفة "التوابع والزوابع" من عالم الجن وتوابع الشعراء وزوابعهم، وقد سبقه "بديع الزمان الهمذاني" بـ "المقامة الإبليسية"، وقد استلهم بعض الأدباء المعاصرين الجن في رواياتهم كما سبق في الأفلام المصرية، ومن آخر ما قرأت في هذا الباب رواية "الأبواب المشرعة" لصديقي الروائي "محمد حلمي سالمان"، وقد قارنها أستاذنا اللواء الدكتور "توفيق علي منصور" بحكايات الجن الألمانية وحكايات الجن الدنماركية.
ويحتاج موضوع الجن إلى كُتب تتناوله من مختلف النواحي الثقافية والاجتماعية والفنية، وقد طال المقال وأخشى أن يكون الجن قد أملى بعضه، ولذلك فسأمسك الآن وأكف عن الكلام المباح وغير المباح خشية على نفسي وعلى القراء.
ولعلنا نرجئ العين والحسد إلى مقال قادم إن نسأ الله في الأجل وكفانا شر العين والحسد.