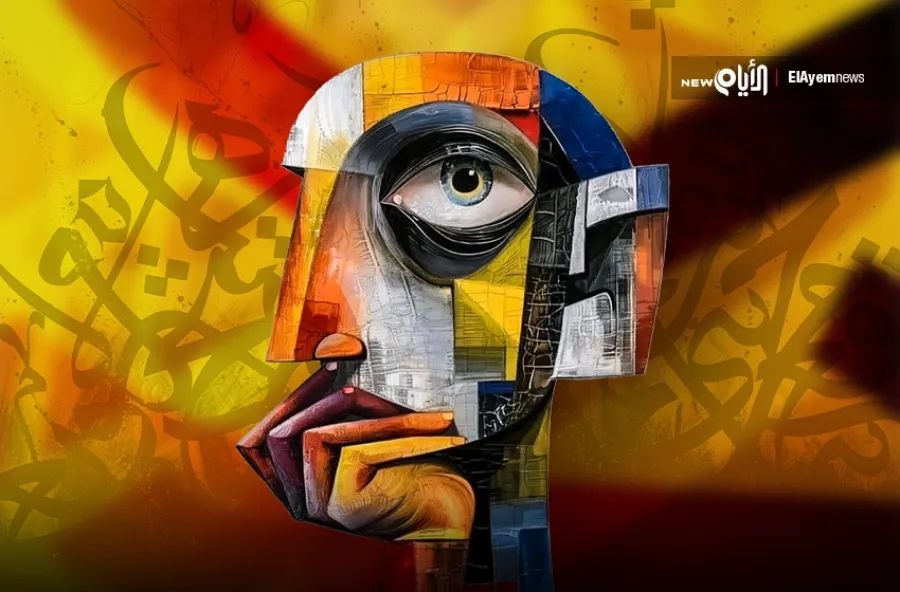(.)، "النقطة" هي لا شيء بمفردها ولكنها مع الحروف وبين الكلمات لها شأنٌ عظيم، فقط حسمت خلافات، وأنهت صراعات، ووضّحت معاني كانت غائمة أو ملغومة، ولولاها لما استطعنا قراءة القرآن الكريم قراءةً صحيحة.
إن العرب والمسلمين الذين صنعوا مجد اللغة العربية وآدابها وفنونها، وأقاموا حضارةً امتدَّت أنوارُها من مشارق الأرض إلى مغاربها، انطلقوا من "وضع النقاط على الحروف". أما نحن أبناء، هذه الأجيال الرقمية، فقد فقدنا فنّ "وضع النقاط على الحروف"، بل ناب عنّا "الذباب" في ذلك، وأجيز لنفسي القولَ بأننا أجيالُ السَّطرِ المفتوح الذي ينتظر من يضع نقطةً في آخره، ويُنهي مسيرتنا في مسالك التّيه والغموض واللامعنى..
وحتى تُدرك عزيزي القارئ مدى خطورة النقطة في حياة الإنسان والمُجتمعات والشعوب، سأروي لك حكاية الحاكم الذي كان له جيشٌ لم يُهزم في معركة، ولكنه لم يكن يعلم تعداد جنوده.. فأمر كاتبه أن يخطّ رسالةً عاجلة إلى قائد الجيش، قال: "إذا قرأتَ رسالتي هذه فقُم من فورك بإحصاء جنود الجيش". وفي غقلة من الكاتب، الذي كان يستعمل القلم والمحبرة، حطّت ذبابةٌ على حرف الحاء في كلمة "إحصاء". ولك عزيزي القارئ أن تتخيّل النقاطَ السوداءَ التي يتركها الذّباب أينما حطّ، فلا عجب إن تحوّلت الحاء إلى خاء بفعل ذبابة.
لمّا وصلت الرسالةُ إلى قائد الجيش، بادر من ساعته إلى تنفيذ أمر الحاكم. ويُقال بأن الجيشَ انهزم في أول معركة خاضها بعد تلك الرسالة، وتوالت انهزاماته إلى أن فقدَ الحاكم مملكته وضيّع شعبه وأسلم مفاتيح دولته إلى مُستعمرٍ يعرف قدَرَ النقطة على الحَرف، ويمتلك فنّ "وضع النقاط على الحروف".
أنا لا أدعوك عزيزي القارئ إلى محاربة الذباب فالعالم بكل علومه ومبيداته لم يُفلح حتى الآن في القضاء عليه، ولكنني أدعوك أن تضع النقاط على الحروف بنفسك، فإن غفلتَ عن ذلك سيتولّى الذباب مهمّة تنقيط حروفك نيابة عنك. وأنا على ثقة في ذكائك عزيزي القارئ بأنك تعي خطورة التنقيط في تشويه الحقائق وتزييف المعاني في عصرنا هذا الذي أسمّيه "عصر الذّباب"، بعد إذنك طبعًا.
ولكن قبل أن تصل إلى "النقطة"، عليك أن تصادق لغتك العربية الجميلة، وتتذوّق حروفَها وهي مُشكَّلة في كلمات وجُمل ونصوص.. ولا أشكُّ أبدًا بأنك ستصطدم بصخرة النحو وقواعد اللغة، وتقف عاجزًا أمام عبارات مستعصية ستحتاج فيها إلى قواميس ومعاجم لتفهم معاني كلماتها. وأصارحك بأنني لو خُيِّرتُ بين دراسة النحو وقواعد اللغة كما يَدرسها التلاميذُ والطلاّب في المؤسسات التعليمية، وبين تفكيك "برج إيفل" بُرغِيًّا بُرغِيًّا، لاخترتُ الثانية بصدرٍ رحب، طبعًا على أن تكون تكاليف تنقّلي إلى "باريس" مدفوعةً بالكامل.
وأعذرك عزيزي القارئ إذا كان حالك يشبه حالي واستصعبتَ العربيةَ الفصحى بسبب النحو وقواعد اللغة، فهذا "سيبويه"، إمام مدرسة النحو في "البصرة"، مات وفي صدره شيءٌ من "حتّى"، نحتسبه "شهيد النحو" فقد مات بسبب مناظرة حول مسألة نحوية جمعت بينه وبين "الكسائي"، إمام النحو في "الكوفة"، والقصة أطول من سطرٍ بلا نقطة فلا تنتظر أن أرويها لك.. وهذا إمام آخر في النحو هو "أبو نزار الحسن بن صافي"، الذي اشتهر بلقب "ملك النحو"، أرّقته وأعيته مسائلٌ في النحو فوضع كتابًا بعنوان "المسائل العشر المتعبات إلى الحشر"، وقيل أنه أوصى بأن تُدفن معه في قبره، (على ذمّة "علم الدين السخاوي المقرئ" في كتابه: سفر السعادة وسفير الإفادة).
وأكاد أجزم لو أن "عنترة بن شدّاد"، الذي كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب، وكان ولا يزال مرجعًا لعلماء النحو وقواعد اللغة، بُعث أيّام "سيبويه" و"الكسائي" وأمثالهما، لوضع النقاط على رؤوسهم وسبى "كان" وأخواتها وفضح جريمة الخجل التي أسقطت الاسم السادس للأسماء الخمسة.. ولو أنه يُبعث في "عصر الذباب" هذا، فلا أكاد أتخيّل ما الذي سيفعله وإن كنتُ على يقين بأنه سيبحث عن عبلة في شبكات التواصل الاجتماعي. سيُقال بأن "عنترة بن شداد" من عصر "السّليقة" اللغوية، وكأننا الآن في عصر اللغة "المسلوقة" رغم ما وفّره لنا العلم من وسائل ومناهج وتقنيات يُفترض أن ترتقي باللغة إلى أعلى الدرجات، لا أن تنحدر بها إلى أسفل الدركات..
من المُجدي أن نتساءل: كيف للغةٍ خرجت من الصحراء ثم سادت العالم في زمن "قياسي" حتى غدت لغة العلوم والحضارة، أن يصير تعلّمُها في بيئتها وبين أهلها أصعب من تعلّم "النظريّة النسبيّة" للعالم الفيزيائي "ألبرت أينشتاين"؟ ولا أريد أن أخوض في مسألة بالغة الخطورة وهي توظيف اللغة العربية الفصحى في الهيمنة على عقول الشباب المتحمّسين لدينهم الإسلامي إلى درجة الانحراف بهم عن طريق التسامح والتعايش إلى طريقٍ دمويٍّ خرّب ويُخرّب الأوطان، وخطيئة أولئك الشباب أنهم لم يوطّدوا علاقتهم باللغة العربية الفصحى، ومنحوا "ٌقداسة" القرآن الكريم لمَن خاطبوهم بعربية "قديمة" تحتاج إلى قواميس ومعاجم لفهمها، فوقعوا فرائس سهلة لآخرين امتلكوا الفصاحةَ والبلاغة..
ولن أخوض في علاقة اللغة بالسيادة والبعث الحضاري وما الذي يعنيه تغليب العاميّة على الفصحى في مجال التعليم خاصة. ولن أخوض أيضًا في رسالة المسجد التي تحوّلت إلى مُجرّد خُطب يستمع إليها المُصلّون وهم يتثاءبون لأنهم لا يكادون يفهمون شيئا بسبب القاموس اللفظي المُستعمل فيها. فغايتنا أن ننبّه إلى إثارة قضية اللغة العربية المُيسّرة في دوائر التفكير والنقاش..
في سياق هذه الأفكار، توجّهت جريدة "الأيام نيوز" إلى نخبة من الكُتّاب بهذه الرسالة: لا يكفي أن يكون المثقف مثقفًا (بالمعنى الشعبي والشائع)، بل يجب أن يكون فعّالا حتى تكون الثقافة فعّالة في المُجتمع، وحتى تتجلّى جهوده وتضحياته في الحياة اليومية للمجتمع. ومن أبرز تجليّات المثقف الفعّال والثقافة الفعّالة توطيد العلاقة بين الفرد ولغته العربية الجميلة، لا سيما في مجالات المسلسلات والأفلام والأعمال التي تلقى رواجًا بين الناس. فاللغة العربية تكاد أن تكون خاصة بالنّخبة، بل إنّ العاميّة الدّارجة تطغى عليها حتى في مجال التعليم على اختلاف مستوياته بدعوى أن المهم هو نقل وتوصيل المعلومات.
ما هي رؤيتكم لهذه القضية، وهل أنتم من أنصار التّمكين للغة العربية المُيسّرة - التي لا تحتاج إلى معاجم وقواميس لفهم مفرداتها - في الصناعة التلفزيونية والسينمائية، خاصة تلك الموجّهة إلى الأجيال الناشئة؟ وما هي رؤيتكم للمثقف الفعّال والثقافة الفعّالة في المُجتمع؟ وكيف ترون مستقبل اللغة العربية في الأوساط التعليمية؟ مع الإشارة إلى أن فئات كثيرة لم تعد تتواصل مع خُطب صلاة الجمعة - مثلا - ولا تستوعبها لأنها تعتمد لغةً غير مُيسّرة وبعض الأئمة صاروا يعمدون إلى اللغة الدارجة للتبسيط وتيسير الفهم.
وماذا عنك عزيزي القارئ؟ هل توافق على التّمكين للغة العربية المُيسّرة في المؤسسات التعليمية، والصناعة السنيمائية والتلفزيونية، وفي المسارح والمنتديات وصناعة المحتوى الرقمي وغيرها من الفضاءات.. و"حشر" اللهجات المحلية والعاميات في المقاهي وأحاديث المجالس الأخوية والعائلية؟ وهل تعتقد بأن قواعد اللغة والنحو من الأمور التي أعاقت توطيد العلاقة بين الطلاب واللغة الفصحى؟ تجرّأ على الجواب ولا تترك الذباب يضع النقاط على حروفك.

وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
لا مجد لقومٍ لا يُمجّدون لغتهم
- أتُريدُ منديلًا أم منديلًا تُريد؟
- أُريد منديلًا.
- خُذ هذا منديل.
- ما هذا الشيء؟ "كَيْلَنِكْسْ"؟ أعطِني منديلًا.
- ألا ينفع "الكَيْلَنِكْسْ"؟ هل هي رِجسٌ من عمل الشيطان؟
النجم المصريّ السينمائيّ والمسرحيّ، الممثّل العربيّ الأكثر شهرةً على شاشات التّلفاز والمسرح، في الخمسين عام التي مضت، "عادل إمام"، استطاع من خلال مسرحيّة كُتِبت باللهجة المحكيّة المصريّة أن يخرج عن النص المكتوب ليقدّم لنا في "واد سيّد الشّغّال" أنموذجًا عن استخدام اللغة العربيّة الميسّرة من دون قصدٍ ربّما، فأبقى - بأدائه المحبّب للجمهور المتلقّي - كلماتٍ ما فتئ صداها يتردّد في أذهاننا حتى اليوم، ومن شاهد المسرحيّة، يدرك تمام الإدراك ما أقصده. كما أنّ النجم "محمّد سعد"، والذي اشتُهر بفيلم "الليمبي"، استطاع بفيلمه المعنوَن "الليمبي في قُرَيش" أن يسلّط الضّوء، وإن عن غير قصد، إلى طريقة أداء اللغة الفصيحة في الكوميديا، وفي مشهدٍ بسيط كان يحاور فيه "أبا لهب" فيسأله:
- أتريد أيّ ذنبٍ من الخارج؟ خمر، ميسِر، زنا.. قل ولا تستحِ يا عمّاه.
- فيردّ عليه أبو لهب ضاحكًا: لا، لديّ جميع الذنوب، اذهب.
- فيردّ "محمّد سعد": حسنًا، في لعنة الآلهة.
وإنّني أكاد أجزم بأنّ جميع من شاهد هذا المقطع أصابته ضحكةٌ هستيريّة، لا لأنّ "محمّد سعد" أدّى دوره بشكلٍ احترافيّ وحسب، بل لأنّنا نفتقد لهذه اللغة الفصيحة في ما نشاهِده، فقد صُوّرت لنا هذه اللغة كبعبعٍ نخشى أن نخرجه فيلتهمنا، فقمنا بوضعها في أماكن عاجيّة إلى أن صارت تحفةً أثريّة نخشى أن نمسّها، في حين أنّها لغةٌ إيقاعيّةٌ سَلِسة تستطيع أن تُدخل البهجة إلى المتلقّي إن استُخدمت بشكلها البسيط.
والآن فلنوجّه أنظارنا إلى الضفّة الأخرى، هل أصبحت لغتنا الفصحى الجميلة المُيسّرة لغةً نخرج بها عن النص الأصليّ لكي نُخبر الآخرين بأنّها لا تزال حيّة؟ هل بات استخدامها قائمًا على ارتجالٍ مسرحيّ أو سينمائيّ نسخر عبره من أفكار حملها الأقدمون؟ وما الأمر الذي قد يترتّب عن استخدامها بشكلها المباشر الكامل من دون أن تكون خطّةً بديلة لنصٍّ كُتب بالعاميّة المحكيّة؟ هي أسئلةٌ أتطرّق إليها بعيدًا عن النجاحات الباهرة التي عرفتها الكوميديا في مصر تحديدًا.
بدايةً، لا بُدّ لنا أن نعترف أنّنا كشعوبٍ عربيّة ابتعدنا عن اللغة الفصيحة واستبدلناها بلغاتٍ أُخرى كالفرنسيّة والإنكليزيّة، ولن أخوض في الأسباب التي أدّت إلى هذا الأمر فذلك شيءٌ آخر، أمّا ما أودّ طرحه ها هنا هو انتقالنا إلى العاميّة العربيّة التي استسغناها وعرفنا دهاليزها كلّها وذلك لسهولة تعلّمها وخلوّها من قواعد الصّرف والنّحو أوّلًا، ولأنّنا نشأنا عليها ثانيًا ولأسباب أكثر ثالثًا ورابعًا وعاشرًا..
حسنًا، دعونا نتّفق بأنّ هناك هُوّةً بين اللغة العربية الفصيحة والعرب، وهذا ما سنخوض فيه، ولن أكون من المنظّرين في هذه المسألة، إذ لا يمكن أن أقوم بجلد ذاتنا العربيّة وقد نشأتُ كالكثيرين على العاميّة، وربّما لولا دراستي للغة العربيّة لكان صوتي كصوت الكثيرين الآخرين إذ يقولون: ما الذي سنجنيه من استخدامنا للفصحى بدل العامية؟ إنّنا نفهم لغتنا العامية ونتواصل عبرها، وإن احتجنا أن نتواصل مع غيرنا يمكننا أن نتحدّث الإنكليزية أو الفرنسية، أو العربيّة المكسّرة.
فلنضع خطّا عريضًا باللون الأحمر تحت كلمة "مكسّرة"، إنّها كلمة حقيقية، نردّدها جميعًا، شئنا ذلك أم أبينا، ولكن ماذا لو استبدلناها بالعربيّة "المُيسّرة". ما دمنا نكسّر ونرمّم وفق أهوائنا، لمَ لا نستبدل الكاف بالياء، فتتحوّل "مكسّرة" إلى "مُيسّرة"؟ الأمر بسيطٌ جدًّا وعظيمٌ جدًّا.
حسنًا، ما الضرر في أن يُصنع نصُّ فيلمٍ كوميديّ باللغة الفصحى الميسّرة؟ وأقصد بالميسّرة أي اللغة الفصيحة البسيطة التي لن يلقى عامة الناس صعوبةً في فَهمِها، وأحدّد الكوميديا لأنّني مقتنع تمام الاقتناع بأنّ الإنسان يتقبّل أيّ شيء إن غُلّف بابتسامة، وعبرها نستطيع أن نوجّه الرّسائل التي نريد، وسيتقبّلها الجمهور ما ظلّت محافِظةً في الفكر الذي تطرحه على ما يناسب العقول، وما بقي خطابُها لا يتعدّى على المُحرّمات ولا يثير النعرات.
اللغة العربية الفصيحة تحتاج إلى إعادة إنعاش بما يتناسب مع لغة العصر، ومن أجل ذلك، نحن بحاجة إلى أن نُعيد إدخالها بطريقتها الميسّرة إلى عقول النّاس، لا سيّما الأجيال النّاشئة المفتونة بتكنولوجيا العصر وذكائه الاصطناعيّ، وإن استطعنا أن نصنع أفلامًا كرتونيّة كوميديّة ذات فكر عربيّ أصيل بلغةٍ ميسّرة، وأفلامًا سينمائيّة كوميديّة تحمل الفكر الأصيل بلغة العصر المبسّطة فإنّنا حتمًا سنعيد مجد اللغة الفصيحة، ونُنزلها من قصرها العاجيّ الذي سئمته وأبغضت وجودها فيه كصورةٍ زيتيّة معلّقةٍ في صدر البيت، لا عمل لها سوى أنّها تذكّرنا بمن رحل.
ختامًا، اللغة العربيّة حيّة ما دمنا نحييها، فإن قتلناها فموتنا كعرب محتّم، فلا يحيا قومٌ قد هجروا لغتهم وهمّشوها.

سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
ماذا لو عاد معتذرًا؟
"عايز شتيمة من بتاعت النّاس المثقّفين لإنّي بتخانق مع محاسب وقال لي: ستدفع الثّمن غاليًا!" ![]()
وانهالت التّعليقات السّاخرة على صفحة الفايسبوك، مرفقة بضحك هستيريّ، وإبداع لا متناهٍ من الشّتائم المتنوّعة: تبًّا لك أيّها الأحمق، ستندم ندمًا شديدًا! ![]()
هل تتخيّلون معي لو كان المشهد حقيقيًّا؟ لا شكّ أنّنا اعتدنا على سماع الشّتائم المتبادلة بين النّاس المتخاصمين، ولو أنّني لا أشجّع الألفاظ اللّاأخلاقيّة وأعتبرها تلوّث سمعيّ، إلّا أنّه واقع لم يعد بإمكاننا الهروب منه، أتراها تفقد المعركة جدّيتها إن تحوّلت الشّتائم من لغة الشّوارع الرّثّة إلى الفصحى الأنيقة؟ وهل يلتقي الرّثّ والأنيق؟ لربّما حينها سيتحوّل المشهد إلى كوميديا هزليّة تتنافس فيها الأطراف إلى تلميع الشّتيمة وإلباسها بدلة "توكسيدو" (signé) ترتقي بهم إلى مستوى الثقافة اللّغوية، وكأنّ الشّتيمة بالفصحى ترفيه لا يعكس صورة الإهانة.
ولا تكمن المشكلة بكميّة الشّتائم المقترحة فحسب، وإنّما هناك مشكلة لا تقلّ عنها أهميّة، وهي الإملاء، شتيمة مطعّمة بملعقتين من الخطأ الإملائي ![]() ، وتتحوّل الكارثة إلى كارثتين، أخلاقيّة ولغويّة، وا فرحتاه!
، وتتحوّل الكارثة إلى كارثتين، أخلاقيّة ولغويّة، وا فرحتاه! ![]()
وهل يعتذر هؤلاء؟ فماذا لو عاد أحدهم معتذرًا؟ وعن ماذا يعتذر؟ وربّما هذه الجملة التي استفزّت الجماهير العربيّة، وأيقظت المشاعر الجريحة التي تركت ندوبها في نفوسنا، ولكن! آه من هذه الـ "ولكن"! ![]() هذه العبارة التي فتحت نيران الحروف ضدّ كلّ مُعتدٍ، حتى هذه العبارة الثّقافيّة: "ماذا لو عاد معتذرًا؟" كانت الإجابات عنها قدح، وذمّ، وسبّ، ولعنة على أسلاف غارس السّكين
هذه العبارة التي فتحت نيران الحروف ضدّ كلّ مُعتدٍ، حتى هذه العبارة الثّقافيّة: "ماذا لو عاد معتذرًا؟" كانت الإجابات عنها قدح، وذمّ، وسبّ، ولعنة على أسلاف غارس السّكين ![]() ، مغتال الأرواح الطّيبة، حتى أخرج منها الزّومبي، سيّد الوحوش: "حتى لو عاد مكسورًا سأكسر ما تبقّى منه".
، مغتال الأرواح الطّيبة، حتى أخرج منها الزّومبي، سيّد الوحوش: "حتى لو عاد مكسورًا سأكسر ما تبقّى منه".
دعونا لا ننكر، أنّه ورغم انتصار العاميّة في السّاحة الشّعبيّة، ولكن يبقى للفصحى نكهة خاصّة في المواقف الهزليّة، وكأنّنا نُلبسها رداء العصر السّريع، فليس من أحد يمتلك وقت التّرجمة ليغوص في أعماق الكلمات المندثرة، فمن طرائف العرب أن كان النّحوي المعروف "أحمد بن سيلجون" يتمشّى مع صديقه على نهر دجلة، فلمح فتاة تنظر من نافذة بيتٍ فقال: انظر إلى هذه الدعجاء الفيحاء السويجاء الوركاء الناهد الهرطل البنجويش السوتحيش الكاعب الراتب الريفون تطلّ من طويقتها الهرطاقة الرطاقة وكأنها قمر . فقال صديقه مستغربًا: ما معنى القمر؟". ![]()
وهذا بالضّبط ما نعيشه اليوم، بين الشّتيمة والسّخرية، وكأنّ العربيّة الفصحى أصبحت تتّخذ منحى مختلف تمامًا، فهي إمّا للمتخصّصين، أو السّاخرين، حتى البرامج التّلفزيونيّة والمسرحيّات تتّخذ منها فقرة كوميديّة لتركّز على الفكرة بطريقة مختلفة. حتى نحن في أحاديثنا، بدأنا نتّبع هذا الأسلوب بشكل تلقائيٍّ، وكأنّنا تحرّرنا من حدود اللّغة لنأخذ منها ما على هوانا لا غير، مع نصب الفاعل، ورفع المجزوم ![]() ، ولكن لا بأس، فعلى حجّة "المغزى في بطن الشّاعر"، فمن يهتمّ بالنّحو طالما أنّ الفكرة هي الأساس .
، ولكن لا بأس، فعلى حجّة "المغزى في بطن الشّاعر"، فمن يهتمّ بالنّحو طالما أنّ الفكرة هي الأساس .![]()
فماذا لو عدنا إلى اللّغة معتذرين؟ ![]() أتراها تسامحنا أم ترمينا بشتيمة من بطن الشّاعر؟
أتراها تسامحنا أم ترمينا بشتيمة من بطن الشّاعر؟

تمسّكوا بلغة القرآن الكريم
سمر توفيق الخطيب (الكاتبة والباحثة الفلسطينية - لبنان)
أسئلةٌ كثيرة تراودنا حول الّلغة العربية الفصحى، وحول كيفية المحافظة عليها وحمايتها من عبث العابثين، مع أننا على يقين تام أنها لن تندثر أبدًا، فهي باقية ومتجذّرة فينا إلى أبد الآبدين، لأنها لغة كرّمها الله، سبحانه وتعالى، بأن اختارها لتكون لغة القرآن الكريم، ولهذا نبقى مطمئنين عليها رغم تعرّضها إلى نكسات متكررة ومحاولات لطمسها.
وبالرغم من ذلك، تقع علينا مسؤولية كبيرة في حماية هذه اللّغة عبر الاهتمام الدّائم بتنقيحها من الألفاظ الدّخيلة والأخطاء الشّائعة، ويجب علينا أن نجتهد ونبذل الكثير من أجل إعادة إحيائها في أذهان أجيالنا الصّاعدة. وتقع على كاهل المثقف مسؤولية كبيرة، إذ عليه أن يكون فعالًا في مجتمعه للمحافظة على اللّغة كونه قادرًا على التأثير في المجتمع من خلال آرائه وأفكاره، عبر نشر المعرفة حولها والتّعريف بتاريخها وأهميتها؛ وتعليمها للآخرين والتّعاون مع المؤسسات التّعليمية لتعزيز تعليم اللّغة العربية وتطوير المناهج الدّراسية؛ والمشاركة في النّقاشات الثّقافية لنشر التوعية حول أهميتها في المجتمع؛ وكتابة الأعمال الأدبية كالروايات والقصص والشعر وكتابة المقالات أو الكتب أو المُدوّنات؛ إضافة إلى دعم المبادرات اللّغوية كالبرامج التّعليمية والأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز استخدامها؛ والمشاركة في المهرجانات والندوات التي تعزز اللّغة العربية؛ واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشجيع على استعمالها وحث الشّباب على العودة إلى أصولها التّراثية واستخدام لغتهم الأم وذلك بسبب اعتماد أجيالنا الحالية على اللّغات الأجنبية كوسائل للتواصل لاسيما عبر القرية الكبيرة التي جمعت العالم حولها، وبكل أسف، لم يكن للغتنا العربية الفصحى النّصيب الكافي للتداول فيها بين النّاس.
رغم كل هذه التّحديات، فاللّغة العربية لا تضيع، لأنّها اللّغة التي اختارها الله، سبحانه وتعالى، لأن تكون لغة القرآن الكريم، وحثّ رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يقرأ، فهذا أمر إلهي، كما جاء في قوله تعالى: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (القرآن الكريم، العلق: 1).
لن نخاف من اندثار لغتنا، نظرًا للجهود التي تُبذل باستمرار في تحرّي الحقائق والمراقبة، من أجل تنقيحها من شوائب الألفاظ الدّخيلة والمتداولة. ومع الوقت، فإننا نلحظ الاهتمام أكثر فأكثر بهذه اللّغة، بحيث إنه من المرجّح، وكما يُشاع بين أوساط مبرمجي الكمبيوتر، أن هناك اهتمامًا بجعلها اللّغة الأساسية التي ستُعتمد في البرمجة، وهذا سيكون مصدر عزّنا وفخرنا.
وها هي أجيال اليوم التي تستعين ببعض الرُّموز المختصرة كوسيلة للتعبير أثناء التّواصل فيما بينها عبر "الواتساب"، تجعلنا نشعر بالقلق، فكل شيء سريع، وكل شيء يتأثّر مع تسارع وتيرة الحياة، وكل ذلك لا بد وأن يؤثّر، ولو بشكل جزئي، على لغتنا الأم، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للحدّ من تداول الألفاظ الدّاخلية، ولن نخشى أو نخاف على اللّغة العربية، رغم كل الصّعاب، لأننا نؤمن بأنّها مُكرّمة من الله، سبحانه وتعالى، إنها لغة الضّاد.
ولا بد من الإشارة إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأهل، فعليهم الاهتمام أكثر بهذه الأجيال التي تولي أهمية لكل ما هو جديد، فها نحن نجد أنّ الكثير من الشّبان والشّابات يدرس اللغات الأجنبية ويهتم بإتقانها، فعلى سبيل المثال نجد أنه من الدّارج جدًا تعلم اللغة التّركية، حيث يتدرب الشّباب على الأغاني التّركية بغية إتقانها. فها هو جيلنا الجديد، يلهث خلف كل ما هو جديد ومستجد، وقد لا يكون مفيدًا، ولكن وكما يُقال: "كل جديد له رهجة".
ويبقى هذا الجيل مقصّرًا جدًا بحق اللّغة العربية، كونه لا يسعى إلى الاهتمام والتّغني بها، وهنا تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الأهل في حث هذه الأجيال على العودة إلى تراثهم اللغوي، حتى يألفوه ويتداولوه فيما بينهم. فنجد أن البعض يتداول اللّغات الأجنبية كالإنكليزية والفرنسية كبريستيج، في إشارة إلى انتمائه إلى فئة أو بيئة معينة من الّناس، وهذا ما يسهم في التخلي رويدًا رويدًا عن تداول اللّغة العربية.
وتقع مسؤولية كبيرة أيضًا على المدارس، لاسيما تلك التي تنتهج البرامج الحديثة، فنجد وكأنها لم تعد تهتم لتدريس أصول اللّغة العربية، وكأنها لغة ثانوية وغير مهمة، لا تقدم أو تؤخر، وقد يكون ذلك هدفًا من أهداف دول الغرب الذي يحاول السّيطرة على كل شيء، ويهدم كل ما يمتّ بصلة إلى تراثنا وتراث أجدادنا العربي.
إن لغتنا جديرة بالعناية والاهتمام فهي متنوّعة وغنيّة بالمعاني والمفردات، فعلى أجيالنا أن تتمسك بلغة القرآن الكريم، فهذه اللغة التّي ميّزها الله، سبحانه وتعالى، بأن اختارها لتبقى وتحيا من خلالنا رغم كل المحاولات الحثيثة لجعلها في المرتبة الدّنيا نسبة إلى غيرها من اللّغات الرّائجة في عصرنا وتسعى أجيالنا إلى تعلّمها.
هيّا، فلنعد إلى سابق عهدنا، ولنحي لغتنا عبر الرّسوم المتحركة وبرامج الأطفال الهادفة، حيث يقوم الطفل بالتعلم من أبطالها، فيردد المفردات الفصيحة التي تتداولها شخصيات هذه البرامج. ففي السّابق، كانت العائلة تحرص كل الحرص على أن يحضر أطفالها هذا النّوع من البرامج ليكتسبوا اللّغة بتلقائية ويُسر، ويكون الطفل مستمتعًا بذلك. وكم نحن اليوم بحاجة إلى المزيد من البرامج والمسلسلات التّاريخية التي تتحدث الفصحى ونستمتع بها.
وفي أيامنا هذه، كل شيء تغير، كل شيء يسير بشكل سريع، ورغم كل محاولات طمس معالم لغتنا العربية وإذا ما اضطررنا إلى تعلم لغات لنتمكّن من التواصل مع الآخر عبر القرية الصغيرة، فلا ينبغي علينا أن نهمل لغة القرآن، بل علينا أن نعاود التّداول بها ونشجع الآخر على تعلمها، فكما حاول الغرب طمسها، لا بد وأن نحارب لأجلها، وعلى الرّغم من كل شيء فإنها لا بد باقية إلى يوم القيامة.
فهناك العديد من الوسائل التي تلعب دورًا مهمًّا في التّوعية بأهمية اللغة العربية الفصحى ودورها في الحفاظ على الهوية الثّقافية والتّراث العربي والتي يمكن تطبيقها على مختلف المستويات، سواء في المدارس أو في المجتمع أو في وسائل الإعلام، إذ يجب أن يكون تعليم هذه اللّغة جزءًا أساسيًّا من المناهج الدّراسية في المدارس لتشمل تعليم لغتنا الأم بشكل أكثر فعالية، ويجب تشجيع النّاس على استخدامها في حياتهم اليومية سواء في الكتابة أو التّحدث، واستخدام البرامج التعليمية وتطوير المناهج الدّراسية، مثل الرّسوم المتحركة وبرامج الأطفال الهادفة والمسلسلات التّاريخية الّتي تتحدث الفصحى وتعزيز الاهتمام بها، ويجب تشجيع قراءة الكتب والمجلات والصّحف بالعربية، واستخدام التّكنولوجيا مثل التّطبيقات والمواقع الإلكترونية، لتعليم اللّغة وتوفير الموارد التّعليمية، كما يمكن تنظيم المبادرات المجتمعية، كالدّورات والأنشطة الثّقافية، لتعزيز الاهتمام بلغتنا.
ويمكن لخطيب الجمعة، أيضًا أن يلعب دورًا مهمًّا في إحياء اللّغة العربية الفصحى، بحيث يستخدم هذه اللّغة في سياقها الصّحيح، فيركز على الأمثلة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النّبوية، مما يعزز اللّغة ويسهم في جذب جيل الشّباب لاستخدامها؛ من خلال استخدام الخطيب لغة بسيطة ومفهومة يُمكن لشبابنا تداولها بسهولة ويُسر. وعلى خطيب الجمعة أن يبتعد عن استخدام الكلمات الصّعبة وفي حال اضطر إلى استخدام بعض مفرداتها، عليه أن يفسّرها ويستخدم الكثير من الأمثلة والقصص القرآنية والسّير النّبوية من خلال التأكيد على أهميتها في فهم الدّين والثّقافة العربية ولتوضيح المفاهيم الدّينية والاجتماعية، فيجعل الخطبة أكثر جاذبية وتقبّلًا للآخر ما يُمكّن الجمهور من التّفاعل معه من خلال الإجابة على أسئلتهم وتشجيعهم على المشاركة في النّقاشات الهادفة. كما عليه التّركيز على القضايا المعاصرة التي تهمّ شباب اليوم، لاسيما الحثّ على تعاضد الأسرة والمجتمع...
فلا بد لنا وأن نتمسّك بلغتنا العربية، فهي اللّغة المقدسة على الرّغم من أنها تواجه تحدّيات عديدة، بسبب اعتماد أجيالنا الحديثة وبشكل كلي على اللّغات الأخرى في المحادثات ومختلف وسائل التّواصل الاجتماعي.
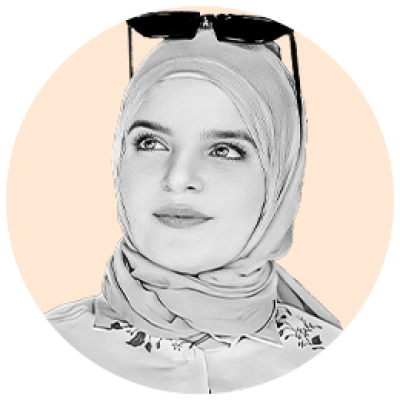
عدوية موفق الدبس (باحثة وكاتبة سورية - لبنان)
أنقذوا أبناءكم... نحن نحترق!
جميعُنا كانت أولى خطواتنا على الأرض متعرِّجة؛ نقف ثم نقع، ثم نقف ونحاول من جديد، حتى تستقيم خطواتنا.
هكذا حالنا تقريبًا في كل الأمور التي نتعلّمها، سواء أكانت أشياء جديدة أو نظنّها كذلك. لطالما قيل لنا إنه لا يمكن صعود الدّرج من الأعلى، بل علينا المشي خطوة خطوة. ولا يمكننا فهم معنى الخطر دون أن نجرّبه. لا نعلم أن النار تحرق حتى نُلسَع بها. لم نبتعد مهما علا صوت الأمّهات بالتحذير، ومهما زأرت أعين الأباب، لم نفهم حتى احترقنا... أو لعلّ الأصح أن نقول: حتى تعلّمنا. من أول يوم إلى آخر يوم في حياتنا، نحن مخلوقون لنتعلّم.
أذكر جيدًا بكائي الشديد وألمي عندما كنت أعود من المدرسة في الصف الأول وحتى أواخر الصف الثالث الأساسي، وعيوني مليئة بالدموع. كنت أقول لأمي: "لماذا لا أجيد قول حرف الراء؟". كنت حين ألفظه، أغلق أسناني السفلية والعلوية على بعضها، وأضع لساني في راحة فمي وأقول الكلمة. نعم، نعم، كما فعلتم أنتم الآن، أنا كنت أفعل كذلك.
كان أصدقائي يقولون لي: "هيا قولي ورقة، رز، زر، رف"... كل الكلمات التي فيها حرف الراء.
كان شتائي الدراسي هكذا طيلة العام. وإن أتى الصيف، هل تظنون أنني أكون سعيدة؟ لا، على العكس. يأتي ابن عمتي الذي يظن نفسه مضحكًا – أخبرتكم عنه من قبل – ويقول لي متحدِّيًا: "أتحدّاكِ أن تقولي: أمر أميرُ الأُمراء أن يحفر بئرًا في الصحراء!". كنت أحب التحدي رغم معرفتي بالنتيجة: ضحك هستيري من كل الموجودين.
حتى زاد الأمر سوءًا، فقلت لأمي: "علِّميني حرف الراء!". شرحت لي وساعدتني، لكن دون جدوى. فقلت في سرّي: "عندما أتعلّم حرف الراء، سأظل أكرره طيلة الحياة!". حتى أتت خالتي، وقالت لي: "ما عليكِ إلا أن تضعي لسانكِ قليلًا في سقف حلقكِ، وتفتحي فمكِ قليلاً، وتجعلينه يرقص، وانفخي قليلًا من الهواء". نعم، نعم، مثلما فعلتم الآن، أحسنتم.
في الحقيقة، لم أنجح مباشرة، لكنني حاولت وحاولت. وضعت لساني على الشّفة العُليا، ورغم الصوت المضحك الذي أصدرته، كنت في قمّة السعادة! وبعد كثير من التمرين، أتقنت قول حرف الراء بطلاقة. ومن شدّة فرحي، لم أتوقف عن قول كل الكلمات التي فيها حرف الراء، حتى تلك التي لا تحتاج إليه!
لكن، لم أكن وفيّة لوعدي. صمتُّ كثيرًا في حياتي. لم أبقَ كما وعدتُ نفسي أنني لن أتوقف عن قول حرف الراء.
أما الآن، فلم يعد تعثّري مقتصرًا على حرف الراء فقط. فقد أكسر، وأجزم، وألفظ بطريقة مغايرة. لكن لا أحد يتنمّر عليّ، بل على العكس، يصفّقون لي ولغيري. ليس لأنهم لا يريدون جرح شعوري، لا، بل لأنهم ببساطة لا يعرفون الصواب أو نطق الكلمات كما ينبغي، كما كانت خالتي تفعل معي. هكذا حال بعض "مثقفينا"، لا أعمّم، ولكن للأسف.
نحن البشر، نسعى لتعلُّم أمر ما، ونجزم أنه كل شيء، وما إن نحصل عليه، يصبح عاديًا، أو حتى نتخلّى عنه إن كان يحتاج جهدًا أو وفاءً أو حتى إخلاصًا.
نحن - وللأسف - مشهورون بعدم التزام العهود منذ نعومة أظافرنا حتى آخر يوم في حياتنا. نكذب، ونجزم أننا سنبقى مع من نحب طيلة العمر. نقول إننا لن نغادر أرض الوطن، وإننا أقوياء بما يكفي لنكون حازمين في قراراتنا.
نقول إن العمر مجرد رقم لا يغيّرنا، وأنه لا يوجد بديل لهذا العطر. نقول إننا نعرف كل شيء، وإن ذاكرة القلب ستبقى مجمّدة في رفّ الغبار، ولن يطّلع عليها أحد إلا بعد فوات الأوان.
ندّعي حبَّ الوضوح ونحن غارقون في فجوة الغموض. وفي أكثر المواقف، نتظاهر بعدم الفهم، ما هي إلا خدعة للهروب من علقم المعرفة.
استخفّينا بأجمل الأمور، وكذبنا، وضيّعنا كل شيء. حتى أهم ما نملك، بعناه بثمن بخس.
الزمن تغيّر، أعلم... لكننا ما زلنا نستطيع التعلّم. لم نُخلق ومعنا كُتيِّب إرشادات عن النطق الصحيح أو الكلمات الفصيحة.
أيتها الأم الفاضلة، ماذا تشعرين عندما تتحاورين مع ابنك بالإنجليزية وتلقين في أذنه كلمات غريبة عن جذوره، وتنسين التحدث معه بلغة أجداده؟
لستُ ضد تعلُّم اللغات – لا على العكس – ولكن ما الخطأ إن كانت هذه اللغات وجبة خفيفة بعد الوجبة الرئيسة: الفصاحة؟
كم هو مؤسف أن نرى امرأة سبعينية لا تجيد فهم كتاب الله. تقرأ كل شيء بطلاقة، لكن الفهم غائب عنها.
وما شعورك أيها الأب إن رأيت ابنك يشاهد مسلسلات مدبلجة للغة العاميّة، يكتب موضوع التعبير بلغة الإنترنت، ينسى تاريخه، ويساهم في ضياع هويته، ويقدّمها على طبق من ذهب قائلًا: خذوا تاريخي، خذوا عروبتي، خذوا ما شئتم من أصولي، باسم التحضّر والتقدّم.
إن لم نشعر بألم المصيبة، فلن نتحرك.
يا أحبّتي، نحن نحترق...
هلمّوا! أنقذوا أبناءكم...
عسى أن ننقذ ما بقي من الثمار قبل أن يلتهمها الحريق.

العربيّة الميسّرة.. حتى لا تغرق أجيالنا في فوضى العصر!
هند سليمان أبو عزّ الدين (كاتبة وباحثة من لبنان)
أقبل العصر الحديث، حاملًا معه الوسائل التكنولوجيّة، ووسائل التّواصل الاجتماعيّ، فتغيّرت طرائق التّعبير والاتصال، وتركت تأثيرها في جوانب الحياة كافّة، فابتعد النّشء الجديد عن اللّغة العربيّة الفصحى، وبات يجدها صعبة ومعقّدة، فالقلم العربيّ الأصيل الذي كان يكتب العبارات الجميلة، والجمل الحلوة العذبة، أصبح في نظر بعض الشبّان والشّابّات خصمًا ثقيلًا، وعبئًا مثيرًا للكآبة والملل، أمّا كتاب القراءة الذي كان يزخر بالقصص الجميلة والصّور العذبة، فبات مهملًا غريبًا، فقدت صوره حيويّتها، وتبعثرت كلماته على أفواه قارئيها ضائعة بين الحروف بعد أن تكسّرت فوق صخور الصّبر وهي تُحاول مواجهة تعسّر القراءة في عصر يعيش فيه الأطفال غربة عن لغتهم محاولين إلقاء اللّوم عليها واتهامها بالصّعوبة، وفي خضم هذه المعاناة اللغويّة كثرت الدّعوات المطالبة باعتماد لغة عربيّة ميسّرة في المدارس وفي البرامج التّلفزيونيّة والإذاعيّة، فهل هذه الدّعوات مجدية؟ وكيف يمكننا اليوم أن نعيد إلى عقول النّاشئة أهميّة الفصحى وضرورة استخدامها للكتابة والتّواصل؟
إنّ الدّعوة للغة عربيّة ميسّرة تهدف، اليوم، إلى إعادة الاتّصال بين الجيل الجديد وبين لغته الأمّ، ودفعه للغوص في مفرداتها وعباراتها واكتشاف اللآلئ الجميلة والثّمينة، فالأطفال والشّباب الذّين صاروا يستسهلون استخدام لغة "الواتساب" ابتعدوا عن الفصحى، لذلك قد تكون هذه الدّعوة، في عصرنا هذا، ضروريّة لإعادة التّفاعل مع اللّغة العربيّة، ولتبديد الأوهام التي تحاول السيطرة على عقول بعض الشّباب وإيهامهم بصعوبة لغتهم، وبتعقيد ألفاظها ومفرداتها.
فاستخدام العربيّة الميسّرة التي تُحافظ على جمالها وفصاحتها، واعتمادها في المدارس وفي البرامج التّلفزيونيّة والإذاعيّة، يُعيد بناء جسر التّفاعل والمحبّة بين النّشء الجديد ولغته، فتعبر فوقه الحروف العذبة والتّعابير الرّائعة، وتُطلق العربيّة كنوزها فتغرف الأكفّ الجواهر القيّمة. وهذا ما يُعزّز الحفاظ على الهويّة، ويروي بذور الانتماء الثّقافي إلى الحضارة العربيّة بمياه الفخر والاعتزاز، ويُسهم في ترسيخ التّواصل بين أقطار الوطن العربيّ، لذا يجب أن نعلّم أبناءنا أنّ الابتعاد عن الفصحى ليس محاكاة للعصر بل هو اغتراب عن الانتماء والثّقافة والهويّة، وضياع بين الأفكار الغريبة والمغلوطة.
ولتعزيز دور اللّغة العربيّة وتحقيق نتيجة مثمرة في هذا المجال، يجب تيسيرها وجعلها قريبة من لغة الحياة اليوميّة مع الاحتفاظ بعذوبتها وأصالتها، وينبغي أيضًا تبسيط المناهج التّعليميّة وتقريبها من ذهن الطلّاب، والسّعي إلى استخدام التّقنيات الحديثة في شرح الدّروس، والابتعاد عن الحشو والمعلومات المكثّفة التي لا يحتاج إليها التّلميذ ولا يستفيد منها، والاعتماد على اللّعب والمرح مع التّركيز على القراءة من خلال الحكايات والكتب الجميلة المصوّرة، واعتماد الألواح التّفاعليّة لحثّ الأطفال على الاستماع إلى القصص الجميلة والتّفاعل معها، كما يجب التحدّث بلغة فصيحة أنيقة تستقرّ في عقل الطّالب وتُصبح جزءًا من حياته اليوميّة، خصوصًا عندما تصدر من معلّم لطيف ومحبوب يتعلّق قلب المتعلِّم به فيتلقّف علومه بصدر رحب.
وللتّركيز على العربيّة الميسّرة يجب أن تنطق بها الرّسوم المتحرّكة، فالرّسوم المتحرّكة التّعليميّة الهادفة إلى تعزيز القيم والأخلاق النّبيلة حين تنطق بالفصحى يستقرّ كلامها في فكر الطّفل وفي قلبه، فيجده مقبولًا وجميلًا، لذا يسعى إلى ترديد عبارات أبطاله المحبّبين والتشبّه بهم فيستفيد من لغتهم ومن أخلاقهم الحميدة.
لقد أصبحت الحاجة اليوم إلى تعزيز اللّغة الفصحى ملحّة، وأصبحت مسؤوليّة كلّ من يُعنى بالشّأن الثّقافي والتّربوي، فما نشهده من ميل بعض الشّباب إلى التّكلّم بلغات أجنبيّة يترك أثرًا كبيرًا في الفرد والمجتمع، ويؤدّي إلى زيادة الإحساس بالغربة والتّشتّت، في عصر غلبت عليه الأفكار المتزاحمة الغريبة، لذا يجب التّمسّك بالهويّة والعودة إلى أحضان اللّغة الأمّ لأنّها تُشكّل الحضن الدّافئ والملاذ الآمن الذي يقينا من الغرق في الفوضى التي يتّسم بها هذا العصر، فحين تتغيّر اللّغة على ألسنة الجيل الجديد تتغيّر معها القيم والأخلاق والعادات الاجتماعيّة، لذا علينا أن نسعى بكلّ جهدنا لنحافظ على أمجاد اللّغة العربية، فهي اللّغة التي تتميّز بها حضارتنا وثقافتنا، فهل سيدرك أبناؤنا أهمّيّة لغتهم وضرورة الاعتناء بها واستخدامها في حياتهم اليوميّة؟

د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب ـ جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر)
لغتنا الجميلة.. ما مكانتها الأوساط التعليمية وكيف ننهض بها؟
لا يكفي أنْ يكون المثقف مثقفًا (بالمعنى الشعبي والشائع)، بل يجب أنْ يكون فعّالا حتى تكون الثقافة فعالة في المُجتمع، وحتى تتجلّى جهوده وتضحياته في الحياة اليومية للمجتمع، ذلك أنَّ الثقافة تعني الحذق والفطنة، وثقف الرجل الحديث: فهمه بسرعة، وثقف العلمَ أو الصناعةَ: حذقهما، وثقف فلان: صار حاذقا فطنا، فهو ثَقِفٌ، وثقف. وثقَّف الشيء: سواه وأقام المعوج منه، وثقَّف الإنسان: أدبه وهذبه وعلمه (مولدة)، والثقافة: الحذق والفطنة، والعلوم والمعارف والفنون والآداب وشؤون الحياة التي يطلب الحذق فيها.
ومن أبرز تجليّات المثقف الفعّال والثقافة الفعّالة توطيد العلاقة بين الفرد ولغته العربية الجميلة، لأنَّ اللغة وعاء الفكر، ولا بد للوعاء أنْ يكون سليما وأنيقا وبسيطا حتى يستوعب الفكر ويؤديه إلى المستهدفين منه، ولا سيما في مجالات المسلسلات والأفلام والأعمال التي تلقى رواجًا بين الناس، فاللغة العربية تكاد تكون خاصة بالنّخبة، بل إنّ الدارجة تطغى عليها حتى في مجال التعليم على اختلاف مستوياته بدعوى أنَّ المهم هو نقل المعلومات وتوصيلها.
وأرى أنْ تستخدم اللغة الوسطى المُيسّرة التي لا تحتاج إلى المعاجم والقواميس لفهم مفرداتها في الصناعة التليفزيونية والسينمائية، وبخاصة في الأعمال الفنية الموجهة إلى الأجيال الناشئة.
وهناك تجارب كثيرة للأطفال منها قناة "طيور الجنة" التي كانت تتبنّى في مسلسلاتها وأغانيها اللغة العربية المُيسّرة، وهناك مسسلات أخرى وبخاصة مسلسلات الأطفال السورية التي تصاغ بلغة عربية ميسرة قريبة من مدارك الأطفال ومُحبّبة إلى قلوبهم، وبهذا تنطبع اللغة العربية الميسّرة في أذهانهم وتعتادها ألسنتهم عن طريق المحاكاة التي يغرم بها الأطفال.
ونرى أنَّ المثقف الفعّال هو الذي يتفاعل مع قضايا مجتمعه ولا يقف منها موقف المتفرّج بل يشتبك معها ويحاول توجيه دفّة الثقافة الوجهة الصحيحة بما لديه من ثقافة وفكر وتجارب حياتية، والثقافة الفعّالة في المُجتمع هي التي تسعى إلى تغيير أوضاع المجتمع وتصحيح الأخطاء وتقويم السلوكيات بحيث تنسجم مع الدين السائد في المجتمع وتوازن بينه وبين العادات والتقاليد الموروثة عن الأسلاف، وتحاول ترشيد هذه العادات والتقاليد وتهذيبها.
وما نراه من تعامل المجتمعات العربية مع اللغة العربية يجعلنا نشعر بالقلق على مستقبل اللغة العربية وبخاصة في الأوساط التعليمية، فقد شاع استخدام اللهجات العاميّة في البلاد العربية المختلفة في التعليم بكافة مراحله من الحضانة حتى الجامعة، كما شاع ما لا يقلّ خطورة عن استخدام العاميّات وهو التعليم باللغات الأجنبية بدءًا من الحضانة حتى الجامعة كذلك، فانتشرت المدارس الدولية في بلادنا والجامعات الأجنبية، وهذا يخلق ازدواجية في التعليم ويسهم في تقطع أوصال المجتمعات وانقسامها إلى طبقتين: أولاهما تستخدم اللغة العربية المتدنّية من خلال اللهجات المحلية، والأخرى تستخدم اللغات الأجنبية، مما يسهم في ضياع الهوية العربية التي تنتهج النهج الوسطي دون تفريط أو إفراط، ويتمثل ذلك في اللغة العربية الفصحى الميسرة.
ونلاحظ أنَّ فئات كثيرة لم تعد تتواصل مع خُطب الجمعة مثلا وتستوعبها لأنها تعتمد لغةً غير مُيسّرة وبعض الأئمة صاروا يعمدون إلى اللغة الدارجة للتبسيط وتيسير الفهم، ولو أنَّ الخطباء استخدموا اللغة العربية الميسرة لأراحوا أنفسهم وأراحوا المسلمين فقد يسّر الله القرآنَ للذِّكر وجعله بلسان عربي مبين، لا يستعصي على الفهم، فهو ذو بيان مشرق ليس فيه تقعّر وليس فيه تهاون في اللغة، ويستطيع فهمه المتعلم وغير المتعلم على تفاوت في درجة الفهم.
ولو أننا أولينا اللغة العربية ما هي جديرة به من العناية في بيوتنا وشوارعنا ومدارسنا ومساجدنا وحتى في دور العبادة لغير المسلمين وهي تستخدم اللغة العربية، لاستطعنا أنْ نقرّب الفجوة بين المتعلمين وغير المتعلمين من جهة، ولاستطعنا تنشئة أجيال تعشق لغتها لأننا قمنا بتبسيطها بالوسائل العلمية الحديثة مستغلين القصص والروايات والأشعار التي تُكتب للأطفال في الأعمار المختلفة، وعندنا الآن كليّات للطفولة المبكرة وكليّات للتربية النوعية وأقسام للتعليم الابتدائي، وبها رسائل علمية تحدّد اللغة التي تناسب كل مرحلة عمرية، لكي يكتب بها كُتّاب الأطفال أدبهم بفنونه المختلفة، مع الأخذ في الحسبان تزويد الطفل بقسط مناسب من القرآن الكريم في مراحل التعليم المختلفة، ليستقيم لسانه ويتهذّب خلقه ويقوى جنانه ويرشد عقله، ثم يأتي بعد ذلك المحفوظات من الأناشيد المنظومة شعرا للأطفال والحكم والأمثال التي يسهل حفظها وتطبع لسان الطفل باللغة العربية السليمة، وتشجيعه على محاكاتها نطقًا وكتابةً في موضوعات عصرية تتعلق بالحياة.
وهناك أفلام مصرية كثيرة أنتجتْ في القرن العشرين تعتمد اللغة العربية الميسرة بالإضافة إلى المسرحيات والمسلسلات، ومن أبرز المتحدثين باللغة العربية في الأفلام والمسرحيات: يوسف وهبي وعادل صدقي وحمدي غيث وعبد الله غيث وعبد الوارث عسر ومحمود ياسين ومحمود الحديني وأحمد ماهر وغيرهم من الممثلين الذين تركوا فينا آثارا لغوية جميلة.
ولعلي أذكر هنا ما طالبت به إحدى بناتنا من طالبات الدكتوراه في الجزائر حيث استضفتهن في لجنة العلاقات العربية وكانت الندوة عن المسلسلات العربية، وتبعتها ندوة أخرى عن "المسرح الجزائري: الواقع والمآلات"، فطالبتْ بأنْ تهتم مصر بالمسلسلات والأفلام من حيث المضمون واللغة، وأنْ تتقي الله في الأجيال الجديدة من الشعوب العربية، فقد تربّتْ الأجيال السابقة على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات المصرية ذات القيمة الفنية والمضمون واللغة الراقية، ولكن الوضع الآن مؤسف بحق، وكانت محقة في ملاحظتها ومصيبة في طلبها.
ويمكن تشجيع الطلاب على الحديث باللغة العربية بعمل المسابقات في الكتابة والحديث باللغة العربية وعمل المسابقات في الشعر والقصة القصيرة والمقال بين طلاب المدارس والجامعات ورصد الجوائز القيمة مادية وعينية، وهذا يتم بالفعل وأقوم بتحكيمه على مستوى كليتي الآداب والعلوم في جامعة المنوفية منذ عودتي من السعودية، كما أقوم بتحكيم المسابقات الشعرية برعاية الشباب بجامعة المنوفية بين طلاب الكليات المختلفة، وكذلك أقوم بتحكيم المسابقات التي تجريها مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية لتقوم بتصعيد الفائزين لينافسوا بوزارة الشباب والرياضة، وهؤلاء الشباب يأتون من مراكز الشباب على مستوى القرى والمدن في المحافظات المختلفة.
كما أقوم بالإشراف على النشاط الأدبي للطلاب الوافدين الموهوبين الذين يدرسون بجامعة المنوفية من مختلف البلاد العربية والإفريقية وأجد فيهم نماذج مشرّفة تبشر بمستقبل أدبي مرموق، وأحاول توجيه هؤلاء الطلاب إلى الجهات الثقافية في بلادهم للتفاعل معها والإفادة منها، كما أفعل ذلك مع طلاب الجامعة مستغلًّا صلاتي الواسعة بالأدباء على مستوى مصر من جهة وعلى مستوى الوطن العربي بحكم انتمائي لاتحاد كتاب مصر من جهة ورئاستي للجنة العلاقات العربية بالاتحاد من جهة أخرى.
كما أقوم بالتنسيق لمسابقة القارئ الماسي بكلية الآداب جامعة المنوفية منذ عامين، وهي مسابقة مهمة جدا تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر القراءة بين طلاب الدول العربية في مختلف المراحل التعليمية وترصد لها الجوائز القيمة.
وكل ذلك شيء جيد ولكنه يحتاج إلى المزيد من العناية بزيادة عدد الجوائز وقيمتها المادية أو العينية وتسليط الضوء من وسائل الإعلام المختلفة ونشر نتاج الفائزين لتشجيعهم.
وفي الأعوام الأخيرة، تبنّت حرم رئيس جمهوية مصر العربية مسابقة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة للمبدع الصغير ورصدت لها الجوائز المشجعة على الإبداع، وهي خطوة طيبة على طريق الإبداع الأدبي للناشئة.
كما أنّ هناك شعبة لأدب الأطفال باتحاد كُتّاب مصر، وجائزة لأدب الطفل، وهناك المجلس العربي للطفولة، بالإضافة إلى مجلات الأطفال التي كنتُ أشتريها لأبنائي وما زلتُ أشتريها لأحفادي تشجيعا لهم على القراءة باللغة العربية الفصحى، وربما يوافق ذلك موهبةً عند بعضهم فيكتب نوعا من أنواع الأدب في المستقبل.
وهناك مسابقة للكتاب الأول بالشارقة لتشجيع المؤلفين الشباب وجوائزها قيمة.
وكنا في الأسبوع الماضي نشهد حفل توزيع جائزة "باشراحيل" الأدبية، الذي أقيم بمركز الإبداع والفنون بدار الأوبرا بالقاهرة والذي ترأسه الأديبة والناقدة الدكتورة "ناهد عبد الحميد"، وقد حضره كبار النقاد والأدباء كما حضره الفائزون من مصر والدول العربية، وكان من بين الفائزين الروائي القدير أ. محمود عرفات والشاعر المبدع البيومي عوض والروائية المبدعة د. إنجي البسيوني وكلهم من الأصدقاء، وكان على رأس النقاد أستاذي الشاعر والناقد الكبير أ. د. يوسف نوفل والناقد الكبير محمد حسن عبد الله والشاعر والإعلامي الكبير أ. السيد حسن نائي رئيس اتحاد كتاب مصر والناقد الصديق د. حسام عقل رئيس ملتقى السرد العربي.
ولا شك أنَّ هذه الجوائز تشجع على الإبداع الأدبي وتطلق الطاقات الكامنة للأدباء، ونحن نهيب برجال الأعمال في مصر والدول العربية أنْ يخصصوا جزءا مما أفاء الله عليهم به لمثل هذه الجوائز الأدبية.
وهناك وسائل للنهوض باللغة العربية التي هي هويّة الأمّة وأهم عوامل نهضتها، وقد كتبت عنها من قبل ما يحسن أنْ نعيده هنا عسى أنْ يفيق المسؤولون عن التعليم والإعلام في البلاد العربية قبل فوات الأوان.
"وسائل النهوض باللغة العربية في ضوء مشروع قانون حماية اللغة العربية"
مما لاشك فيه أنَّ اللغة - أية لغة - عنصر مهمٌ من عناصر هوية الأمّة - أيّة أمّة - ولهذا نجد الأمم تهتم بلغاتها وتسعى للارتقاء بها وتعمل على نشرها بكافة السبل والوسائل، وتبذل في سبيل ذلك كل ما تستطيع من جهد علمي ومادي ومعنوي، فتنشئ المعاهد والأقسام اللغوية والكراسي العلمية للغاتها في أنحاء العالم وتشجع الدارسين لها بالمنح الدراسية، لأن اللغة هي وعاء الفكر وحاملة العلم وناقلة الحضارة، ومن هنا كان اهتمامنا باللغة العربية، هذه اللغة الشاعرة كما سمّاها "العقاد"، والتي مُنيت بأرزاء كثيرة من جهل أبنائها من جهة، وكيد أعدائها وحقدهم عليها من جهة أخرى، لعلمهم أنها اللغة الخالدة لارتباطها بالقرآن الكريم، فهي أطول اللغات الحيّة عمرًا، فنحن نقرأ الشعر الجاهلي الذي مضى على إنشائه ستة عشر قرنًا أو يزيد فنفهمه ونستوعبه، كما نقرأ القرآن الكريم والشعر والنثر العربي على مر العصور، بينما نجد لغات أخرى ماتتْ أو حُنّطتْ ودخلتْ إلى متحف التاريخ، والأمثلة على ذلك واضحة لكل ذي بصر وبصيرة.
ومع أهمية اللغة العربية في الحفاظ على هوية الأمة العربية في عصر العولمة الثقافية، وضرورة حمايتها والاهتمام بها وتقويتها على ألسنة أبنائها ـ وهي جديرة بهذا الاهتمام ـ فإن واقع اللغة العربية في حياتنا يوحي بانعدام هذا الاهتمام، مما يسهم في الضعف اللغوي الذي نعاني منه، حتى كادت اللغة العربية أنْ تكون غريبة علينا، وصار الجهلاء يتندّرون على مَنْ يلتزم الحديث باللغة العربية الفصحى، ويرجع ذلك إلى عوامل كثيرة، تناولها علماء اللغة في كتبهم، ولعل أبرزهم المرحوم د. إبراهيم أنيس، والمرحوم د. رمضان عبد التواب، والمرحوم د. عبد الصبور شاهين، والمرحوم د. تمام حسان، والمرحوم د. كمال بشر، والرحوم د. عبده الراجحي وغيرهم، الذين تناولوا أسباب الضعف اللغوي ممثلة في الاستعمار الذي أراد السيطرة على الوطن العربي والإسلامي، فعمل على صرف العرب عن لغتهم التي هي أحد أهم أسرار قوّتهم وتماسكهم، وشجع على استخدام اللغة العامية وبخاصة في مصر ولبنان، ومن أبرز الكتب التي تناولت الدعوة إلى العامية كتاب "تاريخ الدعوة إلى العامية، وآثارها في مصر" للدكتورة نفوسة زكريا عام 1964، وقد عني بالجانب التاريخي، وكتاب "أباطيل وأسمار" للعالم المحقق الأستاذ محمود محمد شاكر، وقد نشر منجمًا في مجلة الرسالة عامي 1964 - 1965م، وقد توخّى الكاتب أنْ يدفع عن الإسلام والعربية غائلة بعض عملاء المبشّرين من أمثال سلامة موسى ولويس عوض ومدرستهما، ومن خلاله نتبيّن البعد السياسي والعقدي لهذا الصراع بين دُعاة العامية ودُعاة الفصحى، وكتاب "الزحف على لغة القرآن" لأحمد عبد الغفور عطار، عام 1965م، وقد أحسن مؤلِّفه عرض القضية واستقصى جوانبها في مصر ولبنان، وفي سائر البلدان العربية، وتتبَّع سعي بعض أعداء الفصحى في سيرهم وفي نشاطاتهم.
وقد تابع هؤلاء الدعاة إلى العامية بعض المستشرقين ولعل أقدمهم المستشرق الألماني "ولهلم سبيتا" (1818/ 1883م) الذي كان موظفًا بدار الكتب المصرية، وألّف كتابه "قواعد اللغة العامية في مصر" داعيًا إلى استخدام العامية ونبذ الفصحى، وكانت اللغة العربية قد بدأت تستعيد شبابها وقوّتها وانطلقت الألسنة من عقال العجز، بعد إنشاء مدرسة دار العلوم ونبوغ بعض روّادها مثل الشيخ حسين المرصفي، وإحياء البارودي لشعر العربية الفصحى.
كما كتب أنطوان مطر مقالاً بعنوان (اللغة العربية والظروف الحاضرة، وما ينتظر تحقيقه من آمال في مستقبل عالم المتكلمين بها) في العدد الخامس والعشرين من مجلة ديوجين (مايو ويوليو 1974م) وصف فيه العربية الفصحى بأنها لا يمكن أنْ تستعمل اليوم في نقل الفكر الحديث لأنها لغة ذات طابع ديني قوي جدًا وقد عبرت عن حضارة قديمة قوية التأثير ظلت مرتبطة بتراثها القديم كأنها لن تكون أكثر من وسيلة للتعبير عن التاريخ ولتجاوز التطور الاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي، كما تجاوزه التطور التقني، لأنه ظل منفصلاً عن حركة التقدم العلمي المسرعة لأسباب سياسية في جوهرها.
وبين "سبيتاط و"أنطوان مطر" قرن كامل، ومع ذلك نجد أسس دعواهما واحدة تقوم على التعريض بالفصحى، فهي لغة طقوس دينية (كاللاتينية والقبطية داخل الكنائس)، وهي لغة تاريخية ميّتة كاللغة المصرية القديمة، وهي لغة متخلفة تجاوزها التقدم العلمي والحضاري، وباختصار: هي أسوأ لغة في العالم منذ كان، إلى أنْ لا يكون!!
وكأنما عزّ على أعداء الإسلام أنْ يكون الإسلام سببًا في خلود العربية، فهم يحاولون قلب الناموس، ليصبح الواقع أنَّ العربية ماتت بسبب اتصالها بالإسلام.
وحال هؤلاء تدعو إلى الرثاء فهم يعانون آلامًا عقلانية ونفسانية هائلة أصابهم بها ثبات العربية والإسلام في توحدهما التاريخي أمام ضراوة الحرب الاستشراقية، وخبث الكيد الذي اصطنعه المستشرقون لفصم هذه العروة الوثقى، التي هي في الحق إرادة الله.
وبعد "سبيتا" ظهر مستشرق ألماني آخر هو "كارل فولرس" (1857/ 1909) وكان أمينًا للمكتبة الخديوية بالقاهرة وألَّف عدة كتب أو رسائل في العامية المصرية وأشهرها كتابه "اللهجة العامية الحديثة في مصر"، ثم جاء مستشرق إنجليزي هو "وليم ولكوكس" (1852/ 1932م) وكان مهندسًا في الإنشاءات وهو الذي أشرف على تخطيط وبناء خزّان أسوان عام 1898م، الذي قال في إحدى محاضراته: "قضيت عشر سنوات أشرف على مدرسة الهندسة وأمتحن طلبتها، وكنت أجد بين الطلبة من يعَّدون حقًا من الأذكياء، ولكنهم كانوا يسيرون في دروسهم ببلادة، لأنهم كانوا يقرؤونها باللغة الفصحى المصطنعة، وليس باللغة المصرية الحية"، ويردّد في أحاديثه "إنَّ الذي عاق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفصحى"، و"إنَّ اللغة العربية الفصحى ماتتْ بسبب جمودها وصعوبتها".
وكانت هذه الحملة على الفصحى من الزاوية العلمية تمهيدًا سياسيًّا لاستيلاء المستشار الإنجليزي "دنلوب" على التعليم في مصر، وتغليب الإنجليزية في جميع مراحل التعليم.
ثم يتقدّم المخطط خطوة أخرى حيث كتَب القاضي "سلوف ولمور"، الذي كان يعمل في محاكم مصر، كتابه "العربية المحلية في مصر" ودعا فيه إلى اتخاذ الحروف اللاتينية في الكتابة العربية، واتخاذ اللاتينية لغة أدبية.
ويرسم المرحوم د. عبد الصبور شاهين ملامح التدرج في تقديم الاتفاق الاستعماري ضد لغة القرآن هكذا:
1 – العربية صعبة - جامدة - ميتة.
2 – العربية ليست لغة للعلوم.
3 – الإنجليزية لغة التعليم.
4 – لا بد من تبنّي الرموز اللاتينية في الكتابة العربية.
5 – يجب اتخاذ اللاتينية لغة أدبية، كما أصبحت الإنجليزية لغة للتعليم.
وممّن تابع هؤلاء المستشرقين في مصر - كما سبق - سلامة موسى ولويس عوض، وفي لبنان عُرِفَ من هؤلاء الدعاة للعامية الخوري مارون غصن، وهو مبشّر حاقد على الإسلام ولغة القرآن، وشايعه أنيس فريحة وسعيد عقل الذي دعا إلى سلخ لبنان بلغته أو بلهجته من جسد العروبة واتخاذ الرموز اللاتينية في كتابتها.
ويخلص المرحوم عبدالصبور شاهين إلى بعض الملاحظات أهمها:
1 – طبيعة الصراع الذي يقف فيه المسلمون مدافعين عن الدين والفصحى والقرآن ضد الأعداء المتربّصين من كل أرجاء الأرض.
2 – بُعد نوايا هؤلاء الأعداء عن هدف الإصلاح اللغوي الذي لا يمكن أنْ يتحقّق إلا في إطار الفصحى.
3 – أنَّ هؤلاء الدعاة ليسوا لغويّين، وإنما هم خليط من الورّاقين أمناء المكتبات والمهندسين وخبراء الاستعمار وعملائه، فكلامهم في مشكلة اللغة غير مقبول.
4 – والأهم من ذلك أنَّ أحدًا من هؤلاء لم يتفضّل علينا بتجربة كتابة أدبه أو فكره باللغة العامية لنرى كيف يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ؛ لأنه يعلم مقدّمًا أنَّ مصير ما يكتبه حينئذ هو إلى المزابل لا غير!!!
5 – أنَّ أعداء القرآن والفصحى ركّزوا حملتهم على مصر أولاً، ثم كانت لهم جولة في لبنان؛ لأنَّ مصر قلب الوطن العربي ومنارة التوحيد في العالم الإسلامي.
6 – أنهم ركزوا حملتهم وهجومهم على العربية حتى لكأنّها هي اللغة الوحيدة في العالم التي تستحق مثل هذا الهجوم، لا لشيء إلا لأنها لغة القرآن.
7 – لا بأس من دراسة اللهجات كواقع لغوي، ولكننا ضد محاولة تمزيق الأمة العربية بتقطيع علاقتها بالفصحى، وهي المقوم الأساسي لأية وحدة عربية.
8 – هذه الدّعوات لا تزال مستمرة ترصد فرص الغزو وتنشط في إثارة الشكوك، والله غالب على أمره، تحقيقًا لوعده الصادق بحفظ القرآن الكريم، "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" (الحجر، الآية: 9).
ونتّفق مع د. سليمان الشطي في أنَّ اللغة العربية تستحق منا الكثير، ونحن نعطيها القليل، بل نتهاون حتى في هذا القليل الذي لا يكاد يُذكر، إذا نظرنا إلى الواجب المطلوب، وإذا قارنّاه باهتمام الأمم بلغاتها.
ولما كانت اللغة تحتاج إلى مَنْ يراعاها ويخطّط لها ويحميها، فلا بد من تضافر جهود العرب جميعًا مؤسسات وحكومات وأفرادًا للنهوض باللغة العربية من كبوتها، حتى تكون سبيلاً لنهضة الأمّة وارتقائها، فالأمران متلازمان، وصدق حافظ إبراهيم: "وكم عزّ أقوام بعزّ لغات".
ولا ينبغي أنْ يقتصر اهتمامنا باللغة العربية الفصحى على اليوم العالمي لها في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، فنقيم الاحتفالات في المدارس والجامعات واتحادات الكُتّاب، ثم ننفض أيدينا من الفصحى لنتكلم العامية في بيوتنا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا ودواوين الحكومة ومؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة.
ومن هنا قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بوصفه أقدم المجامع اللغوية العربية، بإعداد مشروع قانون حماية اللغة العربية، وقد قام بإنجاز المشروع لجنة مكتب المجمع برئاسة د. حسن الشافعي، وتمت مناقشة المشروع بقطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا لمناقشته بمجلس الوزراء، ثم اعتماده من مجلس النواب ليكون تشريعًا واجب التنفيذ، وذلك انطلاقًا من مسؤولية مجمع اللغة العربية وحرصه الشديد على لغتنا الأم (العربية الفصحى) واستجابة للحاجة اللغوية والثقافية والمجتمعية الملحة، تجاه ما أصاب اللغة العربية من تدهور على ألسنة أبنائها، وما نراه من ظواهر لغوية جديدة ومصطلحات غير معهودة، وقد سبق هذا المشروع قوانين مصرية أولها عام 1942م وثانيها عام 1958م وثالثها عام 1959م والرابع عام 1976م، وكلها قوانين ملزمة بوجوب استعمال اللغة العربية، وقد اطلعت اللجنة على قوانين الدول العربية وأبرزها قانون حماية اللغة العربية في الأردن عام 2015م.
وسوف نستعرض نصوص مشروع القانون مبيّنين مدى إسهامه في النهوض باللغة العربية وحمايتها.
مادة (1): اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال لغة أخرى في المكاتبات، والبيانات، والقطاعات، والإعلانات، والعقود والمخاطبات الرسمية، والتراخيص والإيصالات، والعقود، والسجلات، والدفاتر، والمحاضر وما يلحق بها من وثائق، (فإذا كان شيء من ذلك مُحرّرًا أصلا بلغة غير عربية، وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية)، (ويترتب على عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار المحررات المذكورة كأن لم تكن).
وأرى أنَّ الحكم باعتبار المحررات كأن لم تكن أمر تعجيزي، وإنما يمكن فرض غرامة مالية كبيرة، وتحصيلها للإنفاق منها على تعليم اللغة العربية الفصحى ونشرها، فمن أمن العقوبة تمادى في الخطأ.
مادة (2): يجب استعمال اللغة العربية في جميع وجوه النشاط الرسمي للوزارات، والمصالح الحكومية، والمحافظات، وأجهزة الحكم المحلي، والمؤسسات العامة والخاصة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات، والشركات، والنوادي والمؤسسات التعليمية أيَّا كانت طبيعتها، (وإذا دعت الحاجة إلى استعمال لغة أجنبية في أيٍّ مما سبق، فعلى الجهة ذات الشأن أن ترفق بها ترجمة صحيحة إلى اللغة العربية).
وأقترح أن تكون العقوبة معنوية بتوجيه اللوم ولفت الانتباه، ومادية كما سبق في مادة (1) للإنفاق على برامج إثراء اللغة العربية في المجتمع عموما، وفي المؤسسة المخالفة خصوصا.
مادة (3): يجب أنْ يكون باللغة العربية أي إعلان يُبثّ، أو ينشر، أو يثبت على الطريق العام، أو في أيّ مكان عام، أو على وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبرحجما، وأبرز مكانا.
وأرى أنْ يصلح الخطأ على حساب المعلن فورا وإلا تتم إزالة الإعلان، كما أقترح إضافة وسائل النقل الخاصة وضرورة مراعاة الناحية الجمالية في الإعلان بجودة الخط للرقي بالذوق العام.
(مادة4): الأفلام والمسلسلات وسائر المصنّفات الناطقة بغير العربية المُرخّص بعرضها في مصر، مرئية أو مسموعة، يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
يمنع إذاعة أيّة أعمال لا تلتزم بهذا الشرط منعًا باتًّا في وسائل الإعلام العامة والخاصة على السواء، ويعاقب المخالف عقوبة معنوية، وعقوبة مادية كبيرة، ينفق منها على وسائل النهوض باللغة العربية.
(مادة (5): يجب أنْ تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلًا مميزا لها، والأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، وعناوين المَحالّ، والأختام، والنقوش البارزة، ولا يجوز قبول طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال والمميزات أو تجديدها، إلا إذا كتبت باللغة العربية. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز قبول الطلب مكتوبا بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، بشرط أن تكون اللغة العربية أبرز مكانا وأكبر حجمًا من اللغة الأجنبية. يجب فرض عقوبة معنوية، وعقوبة مادية على المخالفين ينفق منها على وسائل النهوض باللغة العربية، بالإضافة إلى عدم التصريح لهم.
مادة (6) يجب أن تُكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة تنتج في مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر في تحديد قيمتها، والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة في إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرارٌ من وزير التجارة. ويجوز أن تُضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدَّة للتصدير للخارج، ولا يجوز أن يقلّ حجم الكتابة بالعربية في هذه الحالة عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.
وأقترح ضرورة إلزام المستورد، أو المصدّر، أو المنتج المحلي بهذا الأمر، وفرض غرامة معنوية، وغرامة مادية مناسبة يُنفَق منها على تعليم اللغة العربية بالطرق الحديثة المحببة لجذب المتعلمين إليها.
مادة (7): يجب أنْ تُحرّر باللغة العربية أوراق النقد، والمسكوكات والطوابع والنياشين، والأوسمة المصرية، وبراءات منحها، والشهادات العلمية، وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية، وصيغ التصديق عليها. فإذا دعت الحاجة إلى كتابة شيء مما تقدم بلغة أجنبية، وجب أن تصحبها ترجمة باللغة العربية، على أن تكون الكتابة بالعربية أكبر حجما، وأبرز مكاناً.
هذه مسئولية الدولة، وعليها أن تلتزم بالقانون وتحترم الدستور لتكون قدوة لمواطنيها.
مادة (8): يجب أنْ تُسمّى بأسماء عربية سليمة؛ الشوارع، والأحياء، والساحات، والحدائق العامة، والشواطيء والمنتزّهات، وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المُسمّاة بأسماء أعلام غير عربية، ويجب أن يُكتب تحت اسم العلم العربي أو الأجنبي تعريف موجز دال على أهمية صاحبه العلمية، أو السياسية أو الفنية أو التاريخية، ونحوها.
يجب إضافة الساحات والحدائق والشواطيء والمنتزهات الخاصة، وفرض عقوبات مادية ومعنوية على المخالفين مع إلزامهم.
مادة (9) تعتمد الدولة سياسة لغوية ملزمة لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم كافة في المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة على التأليف في تخصصاتهم باللغة العربية، وبترجمة أحدث المراجع في كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية.
هناك تجربة ناجحة لتدريس الطب بالعربية في سوريا، ويمكن تضافر الجهود بين الدول العربية في ذلك في إطار الجامعة العربية ومؤسساتها الثقافية والتعليمية، وهناك تجارب في دول مجاورة مثل تركيا وإيران، وكيانات لقيطة كالكيان الصهيوني الغاصب، حيث تُدرّس العلوم بلغات هذه الدول والكيانات.
وقد اتخذت جامعة الأزهر أخيرا قرارا يقضي بتدريس الطب باللغة العربية وهناك دراسات ومناقشات حول هذا الموضوع المهم الذي يمكن أنْ ينسحب على بقية العلوم التطبيقية وسيكون لهذا الأمر أثره الكبير إذا أحسن التخطيط له وتنفيذه مع الاستعانة بالتجربة السورية والبناء عليها والتعاون مع الجامعات السورية لتتكامل الجهود بدلا من البدء من الصفر وتضييع الوقت، ويمكن تعميم هذه التجربة على الدول العربية، ولا شك أنْ ذلك سيؤدي إلى الإبداع في هذه العلوم.
مادة (10) اللغة العربية الصحيحة هي لغة التعليم في مراحله كافة، وفي جميع فروع المعرفة، وهي لغة البحث العلمي، وتلتزم الدولة بإعداد الأساتذة والمدرسين إعدادا يمكنهم من هذا الالتزام. والأساتذة الجامعيون والباحثون في مراكز البحوث الذين يكتبون دراسات بلغة أجنبية للنشر في الدوريات أو لتقديمها إلى الملتقيات العلمية، يجب أن يقدّموا ملخّصًا لها باللغة العربية إلى الجهات التي يعملون بها، توسيعًا لنطاق الإفادة منها، والمناقشات والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وسائر الاجتماعات التي تعقد في مصر يجب أن تكون باللغة العربية، فإذا كان بعض المشاركين لا يُحسنها، تعيَّن أن توفر الجهة المنظمة للاجتماع؛ ترجمة فورية من العربية.
ينبغي التأكيد على أن هذا الأمر يحافظ على هوية الدولة، ويكسبها هيبة واحتراما في المجتمع الدولي، وأن تلزم الدولة بذلك، شأنها شأن الدول المُعتزّة بهويتها وحضارتها، كما أرى أن تُترجم البحوث العلمية المقدمة إلى مؤتمرات عالمية أو المنشورة في مجلات دولية ترجمة كاملة، بدلا من الاقتصار على ترجمة الملخص، وتنشر في مجلة مصرية محكمة، حتى يُستفاد منها ويحدث عندنا تراكم علمي يكون زادا لنا على طريق التعريب للعلوم من جهة، وإثراء البحث العلمي في مصر والعالم العربي من جهة أخرى.
مادة (11) يجب أنْ يحرص القادة والمسؤولون، والسياسيون والدُّعاة والمعلمون والمحاضرون، والمتحدّثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومُقدّمي البرامج والضيوف على التحدُّث بلغة عربية سليمة سهلة.
ويجب معاقبة الإعلاميين خصوصًا، على عدم التزامهم بالفصحى، فقد تشرّبنا الفصحى من فاروق شوشة، وصبري سلامة، وفهمي عمر، وعمر بطيشة، وغيرهم من المذيعين الملتزمين بالفصحى، ومن الفنانين المحسنين للأداء بالفصحى مثل: عبد الوارث عسر، وعبد الله غيث، وحمدي غيث، وأشرف عبد الغفور، وعمر الحريري، ومحمود الحديني، وإسلام فارس، وسميرة عبد العزيز، ومحمود ياسين، ونور الشريف، وغيرهم، وعدم تكرار استضافة أيّ ضيف لا يلتزم في حديثه باللغة العربية الفصحى، ويكون ذلك عن طريق مراقب لغوي للبرامج.
مادة (12) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مُصحّحين لغويين مُؤهَّلين يكون عليهم تحرّي صحة ما يُنشر أو يذاع من الناحية اللغوية، وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبي الفني، لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية.
تفرض عقوبات معنوية وعقوبات مادية على المؤسسات المخالفة ينفق منها على وسائل النهوض باللغة العربية، إذ إنها تعدُّ مخالفة للقانون والدستور الذي ينصّ على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية.
مادة (13) يجب أنْ يجتاز كل مُرشّح للعمل في وظيفة مُدرّس في التعليم العام أو الفني بأنواعه، والمرشح للعمل عضو هيئة تدريس في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية، والمرشح للعمل مذيعًا، أو مُعدّ برامج، أو محرّرا في أي مؤسسة إعلامية؛ امتحان كفاءة في اللغة العربية. ويصدر وزير التعليم العالي بالتشاور مع وزير التعليم اللائحة الخاصة بهذا الامتحان وشروط اجتيازه، ويُستثنى من أداء هذا الامتحان غير الناطقين باللغة العربية من المعلمين الذين يدرسون بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
يجب إضافة المدارس والمعاهد الخاصة، وعدم استثناء غير الناطقين باللغة العربية، أو العاملين في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام، ما داموا مواطنين مصريين أو عربًا من هذا الامتحان، وحتى لو كانوا غير عرب فلا بد أن يحصّلوا قسطًا من اللغة العربية على الأقل من باب المعاملة بالمثل، وهو مبدأ مشروع في التعامل، واحترام لغة البلد الذي نعمل به، وهويته اللغوية والثقافية.
مادة (14) تلتزم المؤسسات التعليمية الأجنبية، مدارس وجامعات ومعاهد تخصصية، بأن تضمن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية للطلاب، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي حسب تبعية المؤسسة المعنية، وأن تستمر هذه المناهج على مدى سنوات الدراسة كافة.
على أن يُجرى اختبار كفاية في اللغة العربية بمعرفة الوزارة لخريجي هذه المؤسسات قبل أنْ يمنحوا شهادات تخرجهم لضمان التزامهم بإتقان لغتهم الأم.
مادة (15) تعمل الجهات الإعلامية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة على توسيع المساحة التي يعتمد فيها على اللغة العربية الصحيحة، وعلى مجمع اللغة العربية أن يقدّم سنويًّا إلى الجهات المعنية ملاحظات حول اللغة المستعملة فيها للتشاور حولها واقتراح وسائل تنفيذها.
أرى ضرورة الاقتصار على اللغة العربية الفصحى حتى يتعوّد متابعو هذه الجهات الإعلامية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة على سماع اللغة وقراءتها فتكون طيِّعة على ألسنتهم وأقلامهم، وأن تتعاون أقسام اللغة العربية وكليات الألسن ودار العلوم وكليات اللغة العربية وكليات الدراسات العربية والإسلامية مع مجمع اللغة العربية في هذه الملاحظات.
مادة (16) اللغة العربية هي اللغة الأصلية للتعليم في جميع المؤسسات التعليمية للأطفال، ويجوز تعليم لغة أجنبية أو أكثر، ويكون ذلك بموافقة الوزير المختص.
أرى ضرورة الاقتصار على الفقرة الأولى من هذه المادة، وأنه لا يجوز تعليم لغة أجنبية أو أكثر بجانب اللغة الأم، حتى لا تؤثر هذه اللغة الأجنبية أو اللغات على لغة الطفل، وفقًا لدراسات علم النفس اللغوي الحديث التي تقطع بتأثر اللغة الأم للطفل حال تعلّمه لغة أخرى قبل اكتمال نضجه اللغوي، واستقامة جهاز النطق عنده على مخارج حروف لغته الأم، وإلا حدث التداخل اللغوي والبلبلة في لسان الطفل وعقله.
مادة (17) تصدر جميع تشريعات الدولة، ولوائحها التنفيذية، والقرارات الإدارية بأنواعها كافة باللغة العربية وحدها ويجوز إذا اقتضت الحاجة إرفاق ترجمة معتمدة من الجهة الرسمية المعنية، إلى لغة أجنبية أو أكثر، ويكون ذلك بموافقة الوزير المختص. ويُعيّن في كل وزارة أو محافظة أو مؤسسة عامة خبير متخصص في اللغة العربية تكون مهمّته مراجعة ما يصدر عن الجهة التي يعمل بها، والتأكد من صحته اللغوية.
مادة (18) مجمع اللغة العربية هو الجهة المُختصّة في الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون، وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته في هذا الشأن إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه. ويتابع المجمع من خلال وزارة التعليم العالي نشر قراراته في الوقائع المصرية وفقًا لما نص عليه القانون رقم 112 لسنة 2008.
ضرورة اشتراك جهات أخرى تحت إشراف مجمع اللغة العربية مثل أقسام اللغة العربية بالجامعات المصرية، وكليات دار العلوم، والألسن، واللغة العربية، والدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر، لأن العبء كبير ولا ينهض به مجمع اللغة العربية وحده.
مادة (19): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 1 إلى 8، و12، و14، و15، و18، بغرامة لا تقلّ عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذي وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة من شخص معنوي، ترفع الدعوة الجنائية على ممثله القانوني، وفي هذه الحالة توقع عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس. ضرورة النص على توجيه الغرامات لخدمة تعليم اللغة العربية والنهوض بها في مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام المختلفة، وعمل مسابقات للطلاب والقراء في إجادة اللغة العربية كتابة ومحادثة.
مادة (20): يلغى القانون رقم 115 لسنة 1958، والقانون رقم 12 لسنة 1976م بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (21): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، ويختم بخاتم الدولة، وينفذ باعتباره قانونا من قوانينها.
تعقيب ومقترحات
- كنت أتمنى أنْ يتضمن القانون إشراف مجمع اللغة العربية على وضع المناهج التعليمية ومراجعتها من الناحية اللغوية في المراحل التعليمية كلها، وخصوصا منهج اللغة العربية، بحيث يكون المنهج مُرغِّبا في تعلم اللغة العربية الفصحى، ومشجّعًا على ممارسة اللغة والحديث بها في الروضة والمدارس حتى الجامعة، وعمل مسابقات، ومكافأة المجيدين في اللغة العربية كتابة وحديثا شفويا لتشجيعهم، لأنَّ في ذلك حفاظا على الهوية العربية للمجتمعات العربية.
ـ وكذلك محاصرة العامية في المؤسسات التعليمية من الروضة حتى الجامعة، وتجريم المعلمين وأساتذة الجامعات الذين يستخدمون اللهجة العامية في تدريسهم للطلاب، لأنَّ العاميات العربية ـ للأسف - أصبحت هي وسائل التدريس في كافة الجامعات العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه. وكان من نتائج ذلك انتشار المتعلمين الذين لا يقدرون على قراءة نص عربي فصيح بدون أخطاء لغوية ونحوية وصرفية لا تكاد تُحصى.
ـ ضرورة الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم من الروضة مرورًا بمراحل التعليم المختلفة لأنه من أهم الوسائل في إتقان اللغة العربية واستقامة اللسان بها منذ الطفولة.
ـ ضرورة الاهتمام بانتقاء معلم اللغة العربية، والاهتمام بإعداده إعدادا لغويا راقيا، من حيث المناهج الدراسية، والتدريبات العملية، والممارسة اللغوية طيلة فترة الدراسة بالجامعة مع أساتذة الكليات المعنية بإعداد وتأهيل طلاب اللغة العربية وأقسام اللغة العربية في الكليات.
ـ الاهتمام في مناهج التعليم المختلفة باختيار النصوص الجيدة من التراث العربي وضرورة تقديمها للطلاب مضبوطة ضبطا كاملا نحويا وصرفيا لاستقامة اللسان منذ الصغر، وتعوّده على سلامة النطق باللغة العربية.
ـ ضرورة قيام مجمع اللغة العربية بواجبه في سرعة التعريب وملاحقة مستجدات الحضارة، ومخترعات العلوم وطرحها مع أسمائها المشتقة من اللغة العربية، أو المعرّبة، لضمان سيرورة الاسم مع المُسمّى، بدلا من الانتظار حتى يشيع الاسم الأجنبي، ثم يوضع له اسم عربي فيولد هذا الاسم العربي ميتا لا يستخدمه إلا القلة من الغيورين على اللغة العربية، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى.
- تشجيع البحوث العلمية والاختراعات حتى نسهم في صنع الحضارة وبالتالي في ارتقاء اللغة العربية كما نهض بها أسلافنا حين استوعبت العلوم والفنون والآداب إبان ازدهار الحضارة العربية والإسلامية، وكما استوعبت من قبل حركة الترجمة في عصر الدولة العباسية التي نقلت علوم الأمم القديمة إلى اللغة العربية ولم تضق عنها.
- تشجيع الترجمة من لغات العالم المختلفة وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتواصل الحضاري مع الأمم الأخرى، ولغتنا العربية قادرة على استيعاب هذه العلوم وهضمها إذا وجدت هممًا عالية من أبنائها الغيورين عليها.
- أوصي بمحو الأميّة بين أبناء الشعوب العربية، وبخاصة في مصر، فمن العار علينا أنْ تكون نسبة الأمية على هذا النحو المخيف، ونحن أمة "اقرأ".
هذه بعض الملاحظات على قانون حماية اللغة العربية الذي أعدّه مجمع اللغة العربية بالقاهرة مشكورا، ونأمل أنْ يجد طريقه إلى التطبيق الجاد، وأنْ تكون لغتنا العربية غدًا أحسن حالا ومآلا بفضل جهودكم وجهود المخلصين من أبنائها الغيورين عليها.
ولعلي قد ذكرت في مقال سابق ما شاهدته من تكلم ابن صديقي وابنته باللغة العربية أمامي بطلاقة وبصورة جعلتني أسأل أباهما فقال إن ذلك من أثر الاستماع إلى أفلام الأطفال باللغة العربية ومحاكاتهم لها، حتى صارت العربية ملكة عندهما في هذه السن الصغيرة.
ولقد كنت أحرص على أنْ يستمع أطفالي إلى هذه الأفلام من جهة وإلى برامج الكبار مثل لغتنا الجميلة لفاروق شوشة، وأذكر أن ابني المهندس أحمد بسيم وهو طفل صغير، صاغ جملة تعجبية جعلتني أتعجب منها في حينها، فقد نشأ بجوار بيتنا موقف سيارات المحافظة، وكنا في طريقنا من المنوفية إلى القاهرة، فإذا به يقول: يا للحظ السعيد، بهذا الموقف الجديد!
نسأل الله أنْ يقيض للغتنا العربية الفصحى من يذود عنها ويحمل على عاتقه مسؤولية نشرها والارتقاء بها، ولن يكون ذلك إلا بأن يبدأ كل منا بنفسه وبيته فيكون قدوة لأبنائه ومشجعا لهم على الحديث بلغة القرآن الكريم، وليس ذلك عسيرا فأمّي يرحمها الله ـ وكانت أميّة ـ كانت تتحدث كثيرا بالفصحى من كثرة سماعها لإذاعة القرآن الكريم وما يبثّ فيها من تلاوات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة وبرامج وأحاديث باللغة العربية الفصحى والميسرة.
وأنْ يهتم المعلمون جميعًا بالحديث باللغة العربية الفصحى في فصولهم ويشجعوا تلاميذهم على الحديث والكتابة بها، وأخص معلمي اللغة العربية.
وأنْ نحرص على الارتقاء بلغة الإعلام المسموع والمرئي وكذلك الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.
وغير ذلك مما ذكرنا آنفا في هذا المقال وفي غيره من المقالات التي تدعونا إليها جريدة "الأيام نيوز" الجزائرية أسبوعيا.
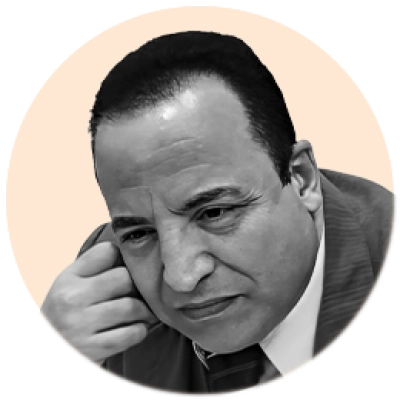
د. شعبان عبد الجيِّد (كاتب وأكاديمي مصري)
آفَةُ اللغةِ هذا النحو.. رأيٌ في تعليم اللغة العربية!
"وُجِدَت الطبيعةَ أولًا، ثم وُجِدَ عِلمُ الفيزياء. وَوُجِدت اللغةُ أولًا، ثم وُجِدَ عِلمُ النحو"! (الكاتب)
في حياتنا بعامّة، وفي تعليمنا المدرسيِّ والجامعي بخاصة، ثَمَّةَ فجوةٌ واسعةٌ بين المثال والواقع، بين النظرية والتطبيق، بين المعرفة والسلوك، وليس أدلَّ على ذلك من (علم النحو) الذي نصدِّع به أدمغة طلابنا منذ نعومة أظفارهم، ونُكرِهُهم إكراهًا على تجرُّعِه غصبًا عنهم، حتى إن كانوا لا يستسيغونه ولا يقبلونه ولا يفهمون منه شيئًا. ولا أذكر أنني، في مراحل تعليمي الأولى، كنت أرتاح كثيرًا لحصة النحو أو أنتفع بشيءٍ مما أسمعه فيها؛ ولم أكن حين أقرأ أو أكتب أستحضر قاعدة النحو لأعرض عليها ما أقرؤه أو أكتبه؛ وإنما كنت أعتمد في ضبطه وتقويمه على ما كنت أحفظه من القرآن وما أطالعه وأردِّدُه من روائع الشعر والنثر.
وطفلُ (الكُتَّاب) الذي يحفظ القرآن كلَّه، أو بعضه، يصير مع الوقت متمكِّنًا من تسجيل آلاف من كلمات اللغة صوتًا وكتابةً، وهذه الثروة الضخمة الهائلة تحتوي في داخلها عشرات من القوالب اللغوية والاستعمالية، وآلافًا من الصور التصريفية، وكلها صالحة لأن يقاس عليها غيرُها، مما ليس من ألفاظ القرآن، دون حاجة ماسَّةٍ إلى تعلم النحو وقواعده.
ولا أذيع سرًّا إذا قلت إنني لم أحضر في مادة النحو خلال سنوات الدراسة الجامعية الأربع، غير محاضرتين أو ثلاثًا، كانت كلها في السنة الأولى، قررت بعدها أن أعتمد على نفسي في تحصيل هذا العلم، وتوسعت في العودة إلى أهم مصادره ومراجعه، فكنت أسأل زملائي عن الموضوعات المقررة ثم أتابعها في مظانها المختلفة، ولم يعنِّي على فهمه سوى ما تكوّن لديَّ من سليقةٍ لغوية، تأتت لي من محفوظ الكلام الفصيح ومسموعه. ولولاه ما استطعت أن أنظم بيتًا، أو أنشئ مقالًا، أو أسطِّرَ خاطرة.
ولا يعني هذا أنني أقلِّلُ من قيمة (علمِ النحو)، أو أزعم أنه لا نفع فيه ولا جدوى منه؛ فهو علمٌ كبيرٌ من علوم العربية التي ساهمت في صيانتها والحفاظ عليها، كل ما أقصد إليه أن الطريقة التي تعلمناه بها كانت عقيمةً سقيمة، تفصل اللفظ عن المعنى، كما يُفصَل الجسد عن الروح؛ فليس العيب في تعلم اللغة (علم النحو) على إطلاقه، ولكن آفتها (هذا النحو) الجامد الصَّلد المعقد المضطرب، الذي لا تكاد تثبت فيه مسألة، ولم يعد واسطةً لفهم كلام العرب واتباع سبيلهم في القول. وانتهى بملك النحاة، الحسن بن صافي، وكان أنحَى أهلِ طبقته، بعد أن أنفق عمره كلَّه في تعلُّم النحو وتعليمه، إلى أن يستشكل عشر مسائل، وتستعصي عليه، فيسمّيها "المسائلَ العشر، المتعبات إلى يوم الحشر"، ويأمر أن توضع معه في قبره، ليحلّها عند ربه! فما بالك بأمثالنا من العامة والبسطاء؟؟
آفةُ اللغةِ هذا النحو!
هذا عنوانٌ قديم، جعله الأستاذ أحمد حسن الزيات لإحدى مقالاته في مجلة الرسالة (15 يوليو/ جويلية 1933)، ذكر في مفتتحه أن الطالب الناشئ كان يدخلُ الأزهرَ، فيجدُ أولَ ما يقرأ من كتب النحو "شرح الكفراوي على متن الأجرومية"، وهذا الكتاب شديد الكلَفِ بالإعراب، يأخذُ به المبتدئ أخذًا عنيفًا قبل أن يعلمه كلمة واحدة من أقسام الكلام ووجوه النحو...
وليس من شكٍّ في أن دراسة النحو على هذا الشكل تفيد في بحث اللهجات في اللغة ودرس القراءات في القرآن، ولكن دراسته لضبط اللغة وتقويم اللسان أمرٌ مشكوكٌ فيه كلَّ الشك. نحن اليوم وقبل اليوم إنما نستعمل لغةً واحدة، ونلهج في الفصيح لهجةً واحدة، فلماذا لا نجرِّد من النحو القواعد الثابتة التي تحفظ هذه اللغة، وتقوِّمُ تلك اللهجة، وندَعُ ذلك الطَّمَّ والرَّمَّ لمؤرّخي الأدب، وفقهاء اللغة، وطلابِ القديم، على ألَّا يطبِّقوه على الحاضر، ولا يستعملوه في النقد. وإنما يلحقونه بتلك اللغات البائدة التي خُلِقَ لها وتأثَّر بها، فيكون هو وهي في ذمة التاريخ وفي خدمة التاريخ.
ويشير الأستاذ "الزيات" إلى أن المدارس المدنية قد صنعَت شيئًا من ذلك؛ فنجحت بعض النجاح في تجريد "نحوٍ" عامٍّ يكاد يسير في وجهٍ واحد، ولذلك لا تجد المتخرّجين فيها يتقارعون في النقد بالنحو القديم، ويقصرون المناظرة على هذا الجدل العقيم. ولكن فريقًا ضئيلَ الشأنِ من بقايا الثقافة القديمة، لا يزالون يظنون أننا مجبرون على إخضاع ألسنتنا وأقلامنا لتلك اللهجات البالية، فيقعد بهم تخلّف الذهن وضعف الملَكة وكلال الذوق، عند هذه البقايا الأثرية ينبشون عنها قبور البِلَى، ثم ينثرونها كالشوك في طريق الأدباء الموهوبين، ويتبَجَّحُون بأن هذا اللغو هو اللغة!!
يقرؤون الكتاب القيم للعالِمِ الباحثِ، أو للاديب المجدِّد، فيعمون عن خطر البحث في نفسِه، ومجهود الباحث في بحثه، ولا يرون إلا حرفًا وقع مكان حرف، أو جمعًا لم يجدوه في كتُب الصَّرف. لا نريد أن نسمِّيَ الأسماءَ ولا أن نضرب الأمثال، فحسب الشذوذ أن يدلَّ على نفسِه، وحسبنا أن نهيب بالعلماء والأدباء أن يُشَذِّبوا هذه الزوائد من لغتنا لتقوَى، ويُنَحُّوا هذه الطُّفَيليَّات عن أدبنا لينتعش.
وبعد ما يقرب من سنتين من نشر هذا المقال، استعار الأستاذ "علي الطنطاوي" عنوانه ليكتب في مجلة الرسالة نفسِها (7 يناير/ جانفي سنة 1935) كلمةً في هذا الموضوع الكبير، ذكر فيه أن "الكسائيَّ" قد مات وهو لا يعرف حدَّ نِعمَ وبِئسَ، وأن المفتوحة، والحكاية. وأن "الخليل" لم يكن يحسن النداء، وأن "سيبويه" لم يكن يدري حدَّ التعجب. وأن رجلًا قال لـ "ابن خالَويه": أريدُ أن تعلمني من النحو والعربية ما أقيم به لساني. فقال له ابنُ خالويه: أنا منذ خمسين سنةً أتعلم النحو، وما تعلمت ما أقيم به لساني. فأيُّ فائدةٍ من النحو، إذا كانت قراءته خمسين سنةً لا تُعلِّمُ صاحبَها كيف يُقِيمُ لسانَه؟ وما الذي يبقى للنحو إذا لم يؤَدِّ إلى هذه الغاية، وإذا أصبح أصعب فنون العربية وهو لم يوضَع إلا لتسهيلِها وتقريبها؟
ومن يُقبِلُ على النحو، وهو يرى هذه الشروح وهذه الحواشي التي تحوي كلَّ مختلِفٍ من القول، وكل بعيدٍ من التعليل، وفيها كل تعقيد، حتى ما ينجو العالِمُ من مشاكلها مهما درس وبحث ونقَّب، ولا يستقرُّ في المسألة على قولٍ حتى يبدو له غيرُه، أو يجد ما يردُّه ويعارضه.
ويعتقد الأستاذ "علي الطنطاوي" إلى أن سبب هذا التعقيد أن النحاةَ اتخذوا من النحو وسيلةً إلى الغِنى، وطريقًا إلى المال، وابتغَوه تجارةً وعرَضًا من أعراض الدنيا، فعقَّدوه هذا التعقيد وهوَّلوا أمرَه، حتى يعجز الناس عن فهمه إلا بِهِم، فيأتوهم فيسألوهم فيعطوهم، فيَغتنوا.
ومن أقبح الخطأ وأشنعه، كما يقول الدكتور "طه حسين"، أن نظن أن إتقان النحو يُمَكِّنُ من إتقان اللغة، أو أن تعمُّقَ مسائلِه يمكِّن من فهم أسرارها، إنما النحو فلسفةٌ، والكثير منه تفٌ للمثقفين ليس غير. وهو من حيث هو علمٌ مستقلٌّ، شيءٌ مقصور على أصحابه المشغوفين به المتخصصين فيه.
وقد أتيح لي هذا العام، والكلام للأستاذ العميد، أن أقرأ بعض إجابات التلاميذ في امتحان القسم الخاصِّ من الشهادة الثانوية فرأيت عجبًا، ولكنه عجبٌ يملأ القلوب حَنَقًا وغيظًا. رأيت الفسادَ الذي يُدخِلُه درسُ النحو والبلاغة على أذواق الشباب في التعبير والتصوير، وفي صوغ اللفظ والملاءمة بينه وبين المعنى، وفي إرسال الكلام عن غير فَهم، وإرسال الجُمَلِ التي حُفِظَت عن المعلم، والتي لم يفهمها المعلم حين ألقاها، ولم يفهمها التلميذُ حين تلقَّاها، ولم نفهمها نحن حين صحَّحناها.
وهذا رأيٌ سبق إليه "الجاحظ" في رسائله حين كتب فصلًا في رياضة الصبي وقال فيه: "وأمَّا النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوامِّ في كتابٍ إن كتبه، وشِعرٍ إن أنشَده، وشيءٍ إن وصفَه، وما زاد على ذلك فهو مَشْغَلةٌ عما هو أولَى به، ومذهِلٌ عمَّا هو أرَدُّ عليه منه، من رواية المثل الشاهد، والخبر الصادق، والتعبير البارع. وإنما يَرغب في بلوغ غايته، ومجاوزة الاقتصاد فيه، مَن لا يحتاج إلى تعرُّف جَسِيمات الأمور، والاستنباط لغوامض التدبير لمصالحِ العباد والبلاد، والعلم بالقُطب الذي تدور عليه الرَّحَى، ومن ليس له حظٌّ غيرُه، ولا معاش سواه. وعويصُ النحو لا يُجدي في المعاملات، ولا يُضطرُّ إليه في شيء".
ولعل هذا هو ما جعل أستاذَنا الدكتور "شوقي ضيف" يقول في مقدمة كتابه "تيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثًا": إن جميع البلاد العربية اليوم تشكو مُرَّ الشكوَى من أن الناشئة فيها لا تحسن النحو، أو بعبارةٍ أخرى لا تحسن النطق بالعربية نطقًا سليمًا، وكأنما أُصيبَت ألسنتُها بشيءٍ من الاعوجاج والانحراف، جعلها لا تستطيع أداءَ اللغة العربية أداءً صحيحًا. ونخطئُ خطأً كبيرًا إذا ظننَّا أن شيئًا من ذلك أصابَ ألسنة الناشئة في بلداننا العربية جعلها تعجز عن النطق السديد بالعربية؛ إنما مرجع هذا العجز أو القصور إلى النحو الذي يُقدَّم إليها، والذي يرهقها بكثرة أبوابه وتفريعاته وأبنيته وصيغه الافتراضية التي لا تجري في الاستعمال اللغوي. وهو، مع ذلك، يغفل شطرًا كبيرًا من تصاريف العربية وأدواتها وصياغاتها، مما يجعل الناشئة لا تتبيّن كثيرًا من أوضاع اللغة واستعمالاتها الدقيقة.
وقد ذكر الأستاذ "يوسف الحمَّادي" في كتابه "النحو في إطاره الصحيح" أن هذا العلمَ قد وُلِد وبدأ خطواته الأولى على طريق الحياة، وهو ملتزمٌ جادَّتَه، مهتدٍ بالحاجة التي دفعت دفعًا إلى المبادرة بتأليفه، وهي خشية اللحنِ في كتاب الله الكريم، وحرَصَ روّادُ الأمّة الإسلامية على أن توضَعَ لأبنائها مجموعة من القواعد، يستعصم بها من يقرأ فلا يُخطِئ، ومن يفكر فلا يرسل أفكارَه مضطربةً مفكَّكة، ومن يتحدّث أو يكتب فلا يَفسُدُ بسبب الخلل أو الخطأ النحوي حديثُه أو كتابتُه.
كذلك وُلِد النحو، وكذلك بدأ حياته الباكرةَ ملتزمًا أو كالملتزم، طبيعيًّا أو كالطبيعي، ولكنه لم يلبث طويلًا حتى ضاع الطريق من تحت قدميه ومن تحت أقدام النّحاة القائمين على أمره؛ فقد بادروا إلى حَشْوِه بما شاءوا، وشاءت لهم ثقافة العصر حولهم، من فلسفةٍ ومنطق جدلي، وقياس يفترض اللغة افتراضًا، ونصوص مدسوسة ، أو شاذة، أو مضيعة النسب لا يُعرفُ قائلُها ولا ناقلُها، وزادوا فملأوا مادتَه بالتراكيب الموضوعة، والقواعد المصنوعة، والآراء الخلافية التي لا تكاد ترى وجه الكلمة الفاصلة في مسألة من مسائله.
وجاء العصرُ الحديث فلم يتجهَّم للنحو، ولا عزَف عنه، بل أقبل على مادته بأخلاطها وأوشابها، في المتون والحواشي والتعليقات، فحشد الجهود لتصفية هذه المادة مما علِق بها فكدَّر صفاءَها، وبذل ما استطاع لجمع الصالح منها، وتنسيقه أو تيسيره أو تطعيمه بالأمثلة العصرية الحيَّة، كما كان من هذه الجهود ما اتجه إلى تطويرها أو تطوير بعضِها.
ولست هنا لأعرض، لا إجمالًا ولا تفصيلًا، للجهود الكثيرة التي بُذلت من أجل تيسير النحو وتقريبه إلى أذهان الناشئة والطلاب؛ ولكنني أرى أنها، رغم إخلاص أصحابِها وتجديدهم، قليلة النفع على مستوى الواقع العملي؛ فاللغة كما يقول الدكتور "علي عبد الواحد وافي" في كتابه "اللغة والمجتمع"، شأنها شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى، عُرضةٌ للتطور المطَّرِدِ في مختلِف عناصرها: أصوتها وقواعدها ومتنها ودلالاتها، وتطوّرُها هذا لا يجري تبعًا للأهواء والمصادفات، أو وَفقًا لإرادة الأفراد، وإنما يخضع في سَيْرِهِ لقوانينَ جبريَّةٍ حتميَّةٍ مطَّردة النتائج، واضحة المعالم محققة الآثار، ولا يدَ لأحدٍ على وقف عملها، أو تغيير ما تؤدي إليه، فليس في قدرة الأفراد أن يقفوا تطوُّرَ لغةٍ ما، أو يجعلوها تجمُدُ عى وضعٍ خاص، او يسيروا بها في سبيلٍ غيرِ السبيل التي رسمتها لها سنن التطور الطبيعي، فمهما أجادوا في وضع معجماتها وتحديد ألفاظها ومدلولاتها، وضبط أصواتها وقواعدها، ومهما أجهدوا أنفسَهم، في إتقان تعليمها للأطفال، قراءةً وكتابةً ونطقًا، وفي وضع طرق ثابتةٍ سليمة يسير عليها المعلمون في هذا الصدد، ومهما بذلوا من قوة في محاربة ما يطرأ عليها، من لحنٍ وخطأٍ وتحريف، فإنها لا تلبث أن تحطّم هذه الأغلال، وتفلت من هذه القيود، وتسير في السبيل التي تريدها على السير فيها سننُ التطوُّر.
ولا يعني هذا أن النحو لا ضرورة له، أو أننا، كما يرى فريقٌ من المربّين، يمكننا أن نستغني عن تدريس القواعد في حصص مستقلة، والاكتفاء بكثرة التدريب على الأساليب الصحيحة قراءةً وكتابة، والعناية بأسلوب الكلام في التدريس؛ فيكون للمحاكاة أثرٌ في تقويم الألسنة، لأن تخصيص بعض الحصص لتدريس القواعد ضربٌ من العبَث، وفيه تبديدٌ للجهودِ بدون ثمرةٍ تعود على التلميذ.
والرأي كما يذهب الأستاذ "عبد العليم إبراهيم" في كتابه الرائد "الموجِّه الفني لمدرسي اللغة العربية"، هو أن نراعي استخدام الطريقة "العرضية" في السنوات الأولى، ونؤجّل دراسة القواعد بالطريقة المنظمة المقصودة إلى آخر المدرسة الابتدائية؛ إذ يكون التلميذُ أكثرَ نضجًا وتقبُّلًا للقواعد العامة. وأن نختار من القواعد ما له أهمية وظيفية، وفائدة في الكلام، ولا داعي إلى كثرة التفصيلات، وسرد المذاهب المختلفة، وحفظ الصيغ المعهودة.
إخفاقنا في تعليم اللغة العربية
والأمرُ لا يتعلق بالنحو وحده، فهو في النهاية فرعٌ من فروع اللغة العربية، وهي كثيرة، ولعله ليس أهمَّها كما سوف نرى، ولكنه يتصل بطريقة تدريسنا لهذه اللغة في مدارسنا وجامعاتنا، وغايتنا منها، وهو موضوع يتشعّب فيه القول، وربما يكثر فيه الخلاف، وسوف أكتفي هنا بعرضِ واحدٍ من الآراء التي ارتحت إليها كثيرًا، وقد رأيت له صدى واسعًا في بحوث لغوية وتربوية، أخذ معظمها منه دون أن يشير إليه، وهو للأستاذ العلَّامة "محمد عرفة"، رحمة الله عليه، نشره أولَ ما نشره في بضع مقالات بمجلة الرسالة سنة 1943، ثم جُمِع بأخْرة في كتابٍ صدر هدية مع مجلة الأزهر (يناير/ جانفي 2020) تحت عنوان "مشكلة اللغة العربية: لماذا أخفقنا في تعليمها وكيف نعلِّمها؟".
والرجلُ في مقالاته ينتهج نهجًا عمليًّا واقعيًّا، غذَّته خبرته وقراءاته وتجاربه، وكان ممّا قاله: إن المَرءَ يكون قد أتقنَ لغةً ما إذا كان يتكلم ويقرأ ويكتب بهذه اللغة، جاريًا على قواعدها، مراعيًا قوانينها، لا يلحن فيها ولا يخطئ، وإن المدرسةَ تكون قد نجحت في تعليم اللغة إذا كان الذين تخرَّجوا فيها جميعهم أو أكثرهم على هذه الصفة، فهل مَن تخرَّجوا في مدارسنا كذلك؟!
سأل الأستاذ "محمد عرفة" هذا السؤال منذ أكثر من ثمانين سنة، حين كانت الحياة الثقافية والأدبية في أزهى عهودها: أدباء يبدعون وينتجون وقرّاء يطالعون ويتابعون، ورغم ذلك كانت إجابته من خلال واقع كان يعيشه، وشواهد رآها بعينيه:
أما الكلامُ باللغة العربية فلا تكاد تجد أحدًا يتكلم بها، فالشعب كلُّه يصطنع في التفاهم والتخاطبِ اللغة العاميَّة، وليس من الناس من يصطنع اللغة العربية إلا في الندرة، وعلى سبيل الشذوذ، حتى إن دروس اللغة العربية تُلقَى بالعاميَّة، فقد دخلَت العاميَّة على العربية حجرات دروسها، وغزَتها في معاقلها، وأخصِّ الأماكن بها.
ومن المضحِك حقًّا أن تجد مدرِّسَ النحو أو الصرف أو البلاغة، أو مفسّر النصوص العربية؛ من شعرٍ ونثر، يُلقِي دروسَه وقواعدَه بلغةٍ عامية، لا يراعي ما يقول من قوانين، ولا يقوِّم لسانه بما يسرد من قواعد.
فأمَّا الكتابة والقراءة بها، فلا يقرأ باللغة الفصحَى ولا يكتب إلا فئةٌ قليلة، تمكّنت من حفظ لسانها من الخطأ عند القراءة والكتابة، وجمهرة المتعلمين لم يصلوا إلى هذه المنزلة، فالشابُّ يتخرَّج في المدرسة أو في المعهد، ولسانُه لا يكادُ يقيم جملة، أو يعرب كلامًا، ولا يستطيع أن يعبّر عن خلَجات نفسِه بأسلوبٍ صحيحٍ مستقيم. وإذا لم يكن هذا إخفاقًا، فماذا يكون الإخفاق؟
وينتهي الأستاذ "محمد عرفة" إلى أن مدارسنا لم توفَّق في الوسيلة كما لم توفَّق في الغاية، أو قل: إنها لم توفَّق في الغاية، لأنها لم توفَّق في الوسيلة؛ فالوسيلة إلى تعلم اللغة هي دروسها، ولمَّا تستطع مدارسُنا أن تحبّبها إلى التلاميذ، فهم يأتون إليها متثاقلين، ويستمعون إليها كارهين، وهم يبغضونها بغضًا يملأ ما بين جوانحهم... وليس العيب في ذلك على الشباب؛ لأنهم يدرسون الهندسةَ والحسابَ والطبيعةَ في غير ضيقٍ ولا حرج، بل يدرسونها في شغفٍ ومحبَّة، إنما العيب على دروس اللغة العربية وحدَها.
الطريقةُ العملية في تعليم اللغة العربية
وأذكر حين كنت طالبًا في السنة التمهيدية للماجستير، أن أستاذنا الدكتور "رمضان عبد التواب"، رحمة الله عليه، كان يدرِّس لنا كتابه "التطور اللغوي: مظاهرُه وعِلَلُه وقوانينه"، وقد سألته مرةً عن الطريقة المثلى لتعليم اللغة العربية؛ فقال لي: إننا يجب أن نتعلم اللغة كما نتعلم السّباحة؛ فنحن لا نقرأ كتبًا تعلمنا كيف نسبح في الماء، ولكن واحدًا ممن تعلموا السباحة ينزل بنا الماء، ويأخذنا على يديه، ويوجهنا بعض التوجيهات، ثم يتركنا لنصارع الموج وحدنا، فإذا تعرضنا لخطر الغرق، أنقذنا على الفور، ودلَّنا على الخطأ الذي كاد يودي بحياتنا، ومرة بعد مرة يتركه تمامًا حتى يستطيع أن ينقذ نفسه بالمحاولة بعد المحاولة. هكذا ينبغي أن ندرس اللغة بطريقة عملية، ولو أننا أعطيناه كتابًا في فن العَوم، وحفظه عن ظهر قلب، ثم نزل البحر ليسبح، فسوف يغرق في شبر ماء، وسوف ينسى كل ما حفظه عندما يرتطم بأول موجة، ويذهب ضحية القواعد والقوانين.
وذكَّرني هذا برباعية زجلية من رباعيات "صلاح جاهين"، يصف فيها ببساطة شديدة كيف تتعلم العصافير فن الطيران:
عيني رأت عصــــفور ووياه ابنُه -- بيحدفه في الريح وياخده فْ حُضنُه
نوبتين وتالت نوبة عجبي عليهم -- كانوا ســــــوا بيرفــــرفــــوا ويغنُّوا
وقد ضرب الأستاذ "محمد عرفة" مثالًا قريبًا من هذا حين تساءل: أينجح الحائكُ في تعليم الحياكة، والبَنَّاءُ في تعليم البِنَاء، والنجَّار في تعليم النجارة، وكل ذي صنعةٍ في تعليم صنعته، ويَخيبُ رجلُ العلم والتربية في تعليم اللغة العربية؟
سرُّ نجاح أولئك في المرانة والتكرار حتى يكسبوا الصنعة، وسرُّ خيبة هؤلاء في الاعتماد على القواعد وترك الحفظ والمرانة والتكرار. ولو أخذ كلٌّ بطريقة الآخر لخاب الناجح، ونجح الخائب.
لو علَّم الحائكُ تلميذَه بطريق القواعدِ فحسب، وظلَّ طول عمره يقول له: شُدَّ الخيطَ طولًا واسلك فيها الخيوط عرضًا ليتكوَّن منه سُدًى ولُحمة، ولم يأخذْه بأعمال الحياكة الكثيرة وتكرارها والمرانة عليها لخاب في التعليم ولم يُكسِبْه الحياكة، ولو أخذ عالِمُ العربية بطريق المِرانة والتكرار والحفظ، فحفظ تلاميذُه أساليب العربية البليغة، ومُثُلَها الرائعة مما يعتاد في الخطاب، وأخذهم بالنسج على منوالها في الحديث والكتابة والخطابة لنجَحَ في تعليمه.
ولا عجب أن يكون هذا الصانعُ العاميُّ أقربَ إلى الحقيقة من هذا العالِم المربِّي؛ لأنَّ هذا العاميَّ يرجع إلى الواقع ويستملي منه، وهذا العالِم قد أغفلَ الواقع وقلَّد ما كان عليه الآباءُ والأجداد.
هذا العاميُّ يعلم أن قواعد الصنعة لا تعطي الصنعة، ولا يعطيها إلا تمرين المتعلم، وأخْذُه بنماذج كثيرة، وتكرير ذلك حتى يتقنَها. وهذا العالِم أغفلَ هذه الحقيقة وظنَّ أن قواعد اللغة تُكسِبُ البلاغةَ، فأخذ يبدأ فيها ويعيد، ويكرر ويكثر من التكرار، فأكسبَهم ملكَةً في قواعد اللغة، ولم يُكسِبهم ملكة اللغة.
الغرضُ من تعليم اللغة، وكيف يتحقق
يكاد علماء التربية وطرق التدريس يُجمعون على أن الغاية من تدريس اللغة العربية أن يتمكّن الطلاب من فهمها وتذوّقها والتعبير بها، شفاهيًّا وكتابيًّا، عن أفكارهم ومشاعرهم بلغةٍ فصيحة وسليمة، ويقتضي ذلك أمرين:
1ـ السرعة: فكلما خطر ببال المتكلم معنى خطرَ اللفظُ الدَّالُّ على مفرداته، وخطر التركيب الدالُّ عليه في وِحاء (سرعة)، وكلما سمع جملةً فهم معانيَ ألفاظِها وما يدلُّ عليه التركيب.
2ـ الإجادة: وذلك بأن يكون جاريًا على قوانين هذه اللغة لا يخطئُ فيها، وذلك لا يكفي في أن تكون اللغة معلومةً فحسب، بل لا بدَّ ان تكون ملَكَةً، أي حالةً راسخةً في النفس.
ومن خبرتي طالبًا ومدرِّسًا، أستطيع أن أزعم أن الطريقة التي ندرّس بها اللغة العربية، في مدارسنا وجامعاتنا، لا يمكن أن تنتهيَ بنا إلى مثل هذا المستوى؛ فالكثرة الكاثرة من المدرّسين يشرحون دروسهم بالعامية، ومعظمهم لا يحسنون التحدّث بالفصحى أكثر من دقيقتين، ولا يقرؤون غير الكتب المقررة على الطلاب، وكأنهم هم أنفسهم مجرد طلابٍ كبارٍ في السن، لا يطالعون ما كُتب في فنّهم، ولا في غير فنهم، ولا يجد عندهم التلاميذ ما يستحق التقليد والمتابعة؛ فمن لا يقرأ لا يُقرِئ، وفاقد الشيء لا يعطيه.
ومن المهم هنا أن أشير إلى ذلك الفصل الذي كتبه الدكتور "طه حسين" في كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" (سنة 1938) وجعل عنوانه "القراءة الحرة وإعراض التلاميذ والمعلمين عنها" وذكر فيه أن التلاميذَ لا يُعرضون وحدهم عن القراءة؛ وإنما يشاركهم المعلمون في هذا الإعراض، "ولعلي لا أخطئُ إذا قدَّرت أن إعراضَ التلاميذ عن القراءة ربما كان نتيجةً لإعراض المعلمين عنها. فالمعلمون في مصر لا يقرؤون. هذه حقيقةٌ ثابتةٌ من إضاعة الوقت أن نتكلف إقامة الدليل عليها...
ومهما يكن المَلومُ في ذلك فالمحقَّق أن المعلمين في مصر لا يقرؤون، وهم من أجلِ ذلك لا يقفون عند ما حصَّلوا في المدارس حين كانوا فحسب، بل ينسون أكثرَه ويقفون عند المناهج والبرامج التي يُكلَّفون تعليمها في المدارس، يرددونها إذا أصبحوا ويرددونها إذا أمسَوا، حتى يصبحوا مناهج وبرامج تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. فكيف تريد من هذا المعلم الذي لا يقرأ أن يدفع التلميذَ إلى القراءة يرغِّبه فيها ويزيّنها في قلبه، ويحاسبه عليها آخر الشهر أو آخر العام؟".
وليست هذه الكارثة في المدارس فحسب؛ بل انتقلت عدواها إلى الجامعات أيضًا، فنجد كثيرًا من الأساتذة يلقون محاضراتهم في النحو أو الأدب أو البلاغة، بلغة أقرب إلى العامية، قلما يلتزمون فيها الفصحى البسيطة التي تحفظ ماء وجههم وتؤكد أستاذيتهم، وصار الطلاب أنفسهم يتعجبون ويعجبون إذا وجدوا أستاذًا متمكنًا من لغته ومادته، ويشرح لهم الموضوعات الأدبية أو اللغوية أو البلاغية، بلغة عربية مبينة.
وأذكر أنني شهدت مناقشة لرسالة ماجستير في إحدى الجامعات الإقليمية، وكان أحد المناقشين ينصب المرفوع والمجرور، وكان كلما نصب ما يستحق الرفع أو الجرّ، نظرت إلى أستاذنا الدكتور "عبد اللطيف عبد الحليم" (أبو همام)، وكان رئيس لجنة المناقشة، فيغمز لي بإحدى عينيه حتى أفوتها كما نقول، ولما انتهت المناقشة، وذكرت ما كان من الأستاذ المناقش، قال لي شيخي "أبو همام" بسخريته اللاذعة: "أصله شاطر في النصب"!
ومثل هؤلاء الأساتذة (النصّابين!!) يجنون على الأجيال التي يدرّسون لها، ويخرّجون لنا طلابًا لا يجيدون فهم لغتهم ولا يحسنون التحدّث بها، فيظنون أن التزام الفصحى تكلّف وتقعّر، يبعث على الضحك والسخرية قبل أن يستحق الإعجاب والتقدير. وتخيّل معي حال اللغة العربية بعد بضعة عقود، وقد تولّى أمر تدريسها والمحافظة عليها أمثال هؤلاء. وجلُّهم يعلّمون الطلاب كيف يجيبون لا كيف يفكرون، وكيف ينقلون لا كيف يبدعون. ويهيّئون أذهانهم لأسئلة الامتحانات ولا يهيئون وجدانهم للحياة وما فيها من مشكلات.
ولم يدر من يقومون على أمر تعليم اللغة العربية أن حلَّ هذه المشكلة ليس مستحيلًا، ولا صعبًا، وأن بإمكاننا أن نبدأه إذا وجّهنا طلابنا إلى هذه النصائح الذهبية التي يسوقها الأستاذ "محمد عرفة" في خلال بحثه الذي نعرض له:
أكثِروا من المطالعة في كتب الأدب، احفظوا الكثير من أشعار العرب، احفظوا ما تقدرون عليه من من الخُطَب، اروُوا الأمثال السائرة، والنوادر البارعة، والرسائل البليغة، والمحاورات العذبة، اخلقوا في بيئتكم المدرسية جوًّا عربيًّا لا تتحاورون فيه إلا بالعربية، فإن لم يكن ذلك في جميع الدروس ففي دروس اللغة العربية.
لِتقوموا بروايات تمثيلية تحفظون أدوارَها، وتستظهرون محاوراتها، ولْيمثلْ كلٌّ منكم دورَه باللهجة العربية والتمثيل الخطابي.
لا تكتفوا في العام الدراسي بحفظ مقطوعةٍ أو مقطوعتين، ولا برسالة أو برسالتين، بل فَلُّوا دواوين الأدب واختاروا واحفظوا وأسرِفوا في الحفظ، وطالعوا وأسرِفوا في المطالعة، واكتبوا الرسائل، وحبِّروا المقالات على نمط ما تحفظون وغرار ما تألفون. بذلك، وبذلك وحده، تحوزون ملَكةَ اللغة، وتملكون زمامَ البيان.
درسٌ من "طه حسين"
إن القاسمَ المشترك بين الخطباء البلغاء والكُتّاب المنشئين، هو ذلك الزاد الثريُّ من المحفوظات والمقروءات من روائع المنظوم والمنثور، وما أكثرها في تراث هذه الأمّة. ولقد كنت أعجب من أمر الدكتور "طه حسين"، حين أسمع له محاضرةً أو أقرأ له مقالًا: كيف تنقاد له اللغة بمفرداتها ومعانيها ليتخيّر منها كيف يشاء، ويسوقها لمرادات عقله ونفسه؟ لقد حدّثني أستاذي الدكتور "الطاهر أحمد مكي"، طيَّب الله ثراه، أنه شهد محاضرة عامة لـ "طه حسين" في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وكانت ممتلئة عن آخرها، وحين بدأ الرجل حديثه ساد القاعة كلها صمتٌ وخشوع، وانساب حديث الرجل في سلاسة وجمال، ومضى ثلاث ساعاتٍ متصلةً لا يتلعثم ولا يتلجلج، لا يند عنه شاهد، ولا تستعصي عليه فكرة؛ يتكلم وكأنما يقرأ من كتاب، ويتحدث وكأنه يعزف موسيقى. أمَّا مردُّ ذلك فهو القرآن الكريم الذي حفظه الأستاذ صبيًّا، وما قرأه وطالعه وحفظه من كتب الأدب القديم، وهي تمثل في معظمها النماذج العليا للبلاغة والبيان. ناهيك عما ثقّف به نفسه عبر قراءاته في الآداب الغربية، قديمها وحديثها.
دفاعٌ عن الحفظ
وأذكر أن وزارة المعارف في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته، كانت توزّع على الطلاب كتاب "الشوقيات المختارة لطلاب المدارس" و"المنتخب من أدب العرب"، وغيرهما من كتب المطالعة التوجيهية والمحفوظات، يتسلّمها الطلاب مجانًا، ولا يمتحنون فيها، وهي في مجملها تقدّم لهم زادًا لغويًّا دسمًا يمكنهم من صياغة أفكارهم ومشاعرهم على مثاله أو قريبًا منه. ومن المؤسف أننا نجد أصواتًا زاعقةً لبعض أساتذة التربية تحارب الحفظ في جميع صوره، وتقول إن فشَل التعليم يرجع إليه وحده، وتدعو إلى ما تُسمّيه "تشغيل العقل" من أول يومٍ في حياة الطفل كبديل طبيعي للحفظ، وهو ما يحتاج منَّا إلى شيءٍ من المناقشة الموجزة المتمهلة:
يذكرُ الأستاذ "يعقوب عبد النبي" في مقاله "رأي في تعليم اللغة العربية" (مجلة البيان، يناير/ جانفي سنة 1973) أن القدماء قد أداروا طريقتهم في التعليم على الحفظ، ولا شيء غير الحفظ، فابتدأوا بحفظ القرآن الكريم، وانتقلوا منه إلى حفظ كلِّ شيءٍ من النثر والنظم، ومتون العلوم، حتى أسانيد الروايات في الحديث والتاريخ، اهتمّوا بحفظها. والقليلُ من القدماء من عُنِيَ باستعادة ما حفظ لعرضه على موازين العقل، بل اكتفى الأكثرون بحفظ كل شيءٍ من المعاني، الغثّ بجانب السمين، والأساطير ممتزجةً بالحقائق، والمحسوسات مفسَّرةً بالاوهام.
من هذا البيان الموجز لسلوك العقل وعمله في التعليم، نرى أن القدماء قد أخطأوا خطأً فاحشًا عندما اكتفَوا في طريقة تعليمهم بالحفظ، ولم يفرِّقوا بين رديء ما يحفظون وبين جيِّده، ولم يحكِّموا عقولَهم فيما جمعوا من معلومات، بل صدقوا بجميع الروايات وآمنوا بجميع الأفكار، ولا شكَّ أن المربّين المحدثين كانوا أشدَّ من القدماء خطأً؛ لأنهم فرضوا على العقول حصارًا ألَّا تدخلَها أية معلومات إلَّا عن طريق (تشغيل العقل) المزعوم، وبذلك جعلوا خزائنه فارغةً لا شيء فيها سوى ما توحي به الغرائز الجامحة المدمرة في رحلة المراهقة بغرائزها العمياء.
إن التعليم النافع المفيدَ هو الذي يجمع بين طريقة القدماء في الحفظ بقوة وإسرافٍ في مرحلة الطفولة خاصَّة، وأن يكون أكثر المحفوظ من نصوص اللغة، وقوالبها التصريفية، لأن اللغة هي الأداة الوحيدة لكل تفاهمٍ أو تعبير أو تعليم، فالحصول على ثروة وافرةٍ منها في وقتٍ مبكِّرٍ من حياة المتعلم، تُحيل الطريق أمامَه سهلًا يسيرًا في اجتياز مراحل التعليم بإجادة وتفوق. كذلك يجب أن تجمع طريقة التعليم في الوقت نفسِه بين طريقة المحدثين بقوة وإسراف، في (تشغيل العقل) بالإكثار من استعادة ما سجله في خزائنه من ألفاظٍ وعبارات، وقوانين وقوالب للتصريف والاستعمال، ومن هذا التكرار في الاستعادة تتكوّن السليقة اللغوية التي تستطيع أن تتصرف في القول فلا تخطئ، وتعرب فلا تلحَن. على أن كل تكرار لما في الحافظة، يقوِّي ملَكة تركيز الانتباه إلى حدٍّ كبير، ويعطي الحافظة قدرةً هائلةً على سرعة التسجيل، وسرعة الاستعادة، ومن هذين تنمو الثروة اللغويى، وتكون دائمًا في متناول اللسان عند القول، وفي متناول القلم عند الكتابة.
ويؤكد الأستاذ "محمد عرفة" هذا الرأي في انحيازٍ واضحٍ إلى الحفظ، فيقول: إن كلَّ ما في الوجود يشهدُ أن اللغة إنما تُكتسبُ بالحفظ والتكرار، وأن القواعدَ لا تُغني في اكتساب الملَكة فتيلًا. لعلك جلست إلى بعض الممثلين واستمعتَ إلى حديثه فرأيته يتكلم بالعربية لا يكاد يخطئ، وينحدر كالسيل، ويهدر كالرعد.
ولعلك جلست إلى بطلٍ من أبطال اللغة العربية، يعرف قواعد النحو والصرف والبلاغة، لا تكاد تخفَى عليه منها خافية، فرأيته يتكلم بالعامية لا يكاد يقيم جملة، ولا يستطيع أن يَلين لسانُه بالعربية، فعجبت كيف يملك الأولُ هذا القدر من العربية مع جهله، وكيف يقصر عنه الثاني مع علمه.
أتدري لِمَ هذا؟ إن الاولَ زاول اللغة العربية عملًا، وحفظ أدواره في الروايات، وألقاها ومرن على ذلك فاكتسب ملكَتَها، فإن تكلَّم بعدُ صدَرَ عن الملَكة فأجاد؛ أما الثاني فعلم قواعد النحو والصرف والبلاغة، ولم يزاول اللغة حفظًا وعملًا، فلم يكتسب ملكَتَها، فكان هذا القصورُ المَعيب...
سَلُوا كلَّ كاتبٍ يحوك الوشْيَ وينفث السحر، وكلَّ شاعرٍ يقول الشعر وينظم الدُّر، في مصر وفي بلاد الشرق: بماذا نِلْتم هذه المنزلة ووصلتم إلى هذه الدرجة من البيان؟ يجيبوك بأنهم لم ينالوا هذه المنزلة إلا بالقراءة الكثيرة والحفظ الكثير، ومزاولة الكتابة والحديث.
لا تلوموا تلاميذَكم ولُوموا أنفسَكم!
ويتساءل الرجل في أسى: أيجمُلُ برجال التعليم أن يُخطِئوا في تعليم الولدان اللغة العربية، فيعلِّموا بالقواعد ما لا يُعلَّمُ إلا بالتكرار والحفظ، ثم يطالبوهم بكتابة مواضيعَ تكون جاريةً على أساليب اللغة، خالية من اللحن والغلَط، فإن لم يستجيبوا لهم لاموهم ونسبوا إليهم العجزَ والتقصير؟!
كيف يكتبون كتابةً جاريةً على أساليب العربية ولم تتكوّن في أذهانهم مقاييس ونماذج عربية يكتبون على مثالِها؟ وكيف يتكلّمون كلامًا جاريًا على أساليب اللغة ولم تتكون في أذهانهم صورٌ ذهنية تدعوهم للتكلُّم على منهاجها؟ وكيف نطالبهم بالسرعة والجودة في الكلام وتوفير الزمن والجهد، وهم لم يكتسبوا ملَكة اللغة التي يكون بها ذلك؟
الحق أنكم إذ تلومون التلاميذَ على خيبتهم في اللغة تلومون غير مَلُومين، وتأخذونهم بذنبٍ أنتم عِلَلُه، وبجريرةٍ أنتم أسبابُها. ولو أنصفتم لَلُمتم الطريقة التي علَّمتموهم عليها، أو بالحري: لرَجَعتم باللوم على أنفسكم.
ومن اللافت أن "ابن خلدون" قد سبق بألمعيته الفذة إلى مثل هذا الرأي حين بيَّن في مقدمته أن اللغة ملَكة، وأن الملَكاتِ لا تُكتسَبُ بالقواعد؛ وإنما تُكتسب بالحفظ والتكرار، وأن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية، ومستغنيةٌ عنها في التعليم. وقال إن اللغات كلها ملَكاتٌ شبيهةٌ بالصناعة؛ إذ هي ملَكاتٌ في اللسان للعبارة عن المعاني... والملَكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولًا وتعود منه للذات صفة، ثم تتكرر فتكون حالًا، ومعنى الحال أنها صفةٌ غيرُ راسخة، ثم يَزيد التكرار فتكون ملَكة، أي صفة راسخة.
آرء روسُّو ولوبون وسبنسر
ولا يكتفي الأستاذ "محمد عرفة" بذكر الآراء التي انتهى إليها أعلام العرب القدماء، فأورد في عُجالة بعض ما خلُص إليه بعض فلاسفة الغرب المحدثين، وذكر أنه ما من كاتبٍ كتب في التربية إلا وأنحَى على طريقة القواعد، ورأى أن اللغة لا تُعلَّم إلا بالحفظ والمحادثة؛ فـ "روسُّو"، رجل الفكر الفرنسي في القرن الثامن عشر، نبَّه في صراحةٍ على أن اللغات يجب أن تُعلَّم بواسطة المحادثات لا بواسطة الصرف والنحو. والدكتور "جوستاف لوبون"، المفكر الفرنسي" ذكر في كتابه "رُوح التربية" أن الأمم الراقية لا تأخذ التلاميذ في تعليم اللغات بكتب النحو، وإنما تأخذهم بالكلام المألوف. ثم قال: وهذه الطريقة لا تحرم التلاميذَ درسَ النحو، فهو يَدرُسُ النحو أحسنَ درسٍ بهذه الطريقة اللاشعورية، التي تحوِّل النحوَ إلى ملَكةٍ راخةٍ لا إلى تكلُّفٍ وتعمُّل.
ودعا "سبنسر"، الفيلسوف الإنجليزي" في كتاب "التربية"، إلى تعليم اللغات بأسلوبٍ أشبه بسنن الطبيعة التي يتعلم بها الطفل لغته الأصلية بلا معين ولا مرشد، فيضمحل التعليم بواسطة القواعد ويعتاض عن طريق ذلك بطرق ناجعة، وذلك ما أفضَى إلى تأجيل علوم النحو والصرف والبلاغة للطلاب. واستأنسَ برأي المسيو "مارسيل"، الذي ذهب فيه إلى أن علوم النحو والصرف والبلاغة ليست مما يُبتدأُ به في تعليم الأطفال، واكها متمماتٌ ومكمِّلات.
ثم قال "سبنسر": "وقُصارَى القولِ إنه لمَّا كانت علوم النحو والصرف والبلاغة إنما نشأت بعد تكوُّن اللغة، كان من الواجب أن يتلقَّاها التلميذُ بعد تكون اللغة".
كلمةٌ أخيرة
هذا هو مجملُ رأيِ الأستاذ "محمد عرفة" في "مشكلة اللغة العربية"، ولا أدري إن كنت قد وُفِّقتُ في عرضه أم لا، لكنني أريد أن أؤكد في النهاية على أن الشيخ الجليل، وقد تربَّى على كتب النحو القديم في الأزهر الشريف، ويعرف لها دورَها وقدرها، لا يُبغضُ القواعد ولا يُزري عليها، بل هو يحبّها ويجلُّها ويعلم لها مكانتها، ويعلم أنها حفظت اللغة العربية طوال هذه القرون، ويعلم أنها حكمٌ فاصلٌ إذا خانت المرءَ ملَكتُه اللغوية، يسنشرها فتحكم بالصواب. وهي حصنٌ حصينٌ لجأت إليه اللغة فحماها من التغير والاندثار، ولولاها لبادت كما بادت اللغات الأخرى.
إن هذا ما لا يُنكِرُه الأستاذُ الكبيرُ على القواعد، إنما الذي ينكره عليها أن يكون بها كسبُ ملَكة اللغة العربية، وقد أبانَ الدليلَ أنها لا تُكسَب إلا بالحفظ والمرانة والتكرار.
وإن كان لي أن أختم هذه المقالة بشاهدٍ من عندي، فهو ما رأيته من أمر حفيدي (سليم حازم شعبان)، وهو طفلٌ يخطو نحو السابعة، إذ سمعته ينطق جُملًا سليمة بالعربية الفصحى، شدّني فيها صحة حروفها ودقة مخارجها، فقلت في نفسي: لعله يردد ما سمع ويكرر ما حفظ، فلما ناديته وأخذت أحاوره بالفصحى، تجاوب معي دون تأتأة أو اضطراب، وقد كان يومها في آخر شهور السنة الأولى الابتدائية، ولا يعرف من قواعد النحو شيئًا، ولكنه كان يسمع قنوات الكارتون التي تقدّم برامجها باللغة العربية الفصحى، ويكاد يدمن مشاهدتها، فالتقط منها، دون توجيه ولا قواعد، ما أقام لسانه بما سمعته منه. وقدَّم، دون أن يقصد، درسًا في تعلم اللغة من خلال السماع والتكرار والمخالطة. وهو ما لم تأخذ به مدارسنا إلى يوم الناس هذا.
ولا أنسى أبدًا ما ذكره لي أستاذي الجليل الدكتور "عبد اللطيف عبد الحليم" (أبو همام)، من أنه حين أرسلته الجامعة مبتعَثًا إلى إسبانيا للحصول على درجة الدكتوراه، لم يكن يعرف من الإسبانية شيئًا، وبدأ تعلّمها هناك حين عاش مع أسرة إسبانية لا يعرف أفرادها من العربية حرفًا، فاضطر إلى أن يسمع ويقلد، وينصت ويردِّد، ويقارن ويستنبط، حتى استقام لسانه بلغة القوم، ثم جاء من بعد ذلك أمر النحو والقواعد. وهو ما حدث لكثيرين ممن ذهبوا إلى الغرب لمواصلة دراساتهم في معاهده وجامعاته!

محمد كمال إبراهيم (شاعر وكاتب من لبنان)
الهُويّة الزجاجيّة تُكسَر بسهولة
في ورقة بحثية نُشرت العام 2000 لعلماء اللسانيّات الثلاثة: (Jean-François Prunet)، (Renée Béland)، (علي إدريسي)، توضّحت فكرةٌ رئيسةٌ تُقرِّبُ لنا طريقة عمل اللغات السامية داخل عقل متكلّمها، حتّى أنّها أثبتت أنّه إن تتحدثِ العربيّةَ بصفتها لغتك الأم فإنَّ طريقةَ تفكيرِك الذهنيّة تختلفُ عن طريقة تفكير أبناء اللغات الأخرى، وخاصة اللغات الهندوأوروبية. الورقة البحثيّةُ بعنوان: (The Mental Representation of Semitic Words)، وتعني بالعربية "التمثيل الذهنيّ للكلمات السامية".
ومن تجاربِ هذه الورقة البحثيّةِ مراقبةُ مرضى مصابين بالحُبسة الكلاميّة (Aphasia)، وهي مرضٌ أو تخلّفٌ نطقي ينتج عن تلفٍ دماغيٍّ يؤدي إلى صعوبة في إنتاج الكلام. إلّا أن المصابين المتكلمين باللغات السامية (العربيّة والعبريّة) قد أظهروا نتائجَ مختلفةً عمّن يتكلّمون اللغاتِ الأوروبيةَ (كالإنكليزية والفرنسية)، إذ تبيّن أنَّ المصابَ العربيَّ بهذه الحُبسة قد احتفظ بقدرة تركيب الأوزان والصيغ اللغويّة رغم فقدانه للجذر اللغويّ. هذا الأمر يثبت أنَّ في العربيّةِ مستويين داخلَ ذهن المتكلم، أوّلهما الجذرُ، والثاني الوزن.
ولنوضّحَ الأمر، أكثر سنأخذ مثال الجذرِ الثلاثيِّ "ك ت ب"، الذي يدلُّ في صيغة الفعل الثلاثيّ "كَتَبَ" - وهو جذر - على فعل الكتابة في الزمن الماضي، إلا أنّنا في العربيّة المعروفة بالاشتقاقيّة نستطيع أن نولّد من هذا الجذر عائلة مرتبطة في التركيب متقاربة في المعنى، فنصيغ منها "كاتِب" وهو اسم الفاعل لندلَّ على من يكتب، و"مكتبة" لندلَّ على المكان. ومثلها "دَرَسَ" فعلا، و"دارِس" للدلالة على من يؤدّي فعل الدراسة، و"مدرسة" للمكان.
لماذا ذكرنا كلَّ هذا؟
تخيّل معي عزيزي القارئ أنّنا رغم امتلاكنا لغةً غنيّةً إلى هذا الحدِّ إلّا أنّنا لا نقبل إلّا بأن نُدرّس أبناءَ هذه اللغة مناهجَهم الدراسيّةَ باللغاتِ الأجنبيّة، وخاصّةً الإنكليزية والفرنسة، وكأنَّ لغتَنا تعجز عن إفهام أبنائها هذه العلوم. لكن ما تبيّن أنَّ تعليم الصغار لهذه المواد بلغتهم العربية الأم سوف يساعدهم على استنتاج المعنى من خلال تغيير الأوزان المتأصّل في فطرتهم وسليقتهم اللغويّة، دون الحاجة إلى خفظ المصطلحات حفظًا أعمى مُعرَّضًا للنسيان في أيّ وقت، فالطفل العربيّ سيسهل عليه استنتاج معنى "مكتبة" أو "ملعب" لمجرد فهمه الجذر، أما في الإنكليزيّة فعليه أن يحفظ معاني "library" و"court" غير المرتبطتين إطلاقا بـ "write" و"play"، حتّى وإن قلت له "playground" لأنّه أيضًا في هذه الحالة عليه أن يحفظ معنى كلمة "ground" الغريبة عنه. قِس على ذلك كل المواد العلميّة من طبيعيّةٍ ورياضيّةٍ وفيزيائيّة...
تجدر الإشارة إلى أنّنا لا نلغي دور تعليم هذه المواد بلغة أجنبيّة كعنصر في عملية "الانغماس اللغوي"، تلك الطريقة الشهيرة من طرائق تعليم اللغات التي تعتمد على غمر المتعلِّم بشكل كامل أو جزئي باللغة المستهدفة في الحقول التعلميّة غير اللغويّة كالرياضيّات وبقيّة ما سبق ذكره.
بالعودة إلى الورقة البحثيّة، استهدف البحث أيضًا "زلّات اللسان"، وهي حالات تداخل في الذهن تصدر أخطاء في اللفظ، فيخطئ المتكلِّم مغيِّرًا في الكلمة بشكل يتنافى مع استعمالها الصحيح. مثلًا يقول "أرتاج" بدلًا من "أحتاج"، وذلك لأن ذهنه قد وهبه التعبيرين "أحتاج" و"أريد"، فدمج بينهما في حالة تسمّى "زلات اللسان"، وهنا يلاحَظ أيضًا أنَّ الخطأ دائمًا ما يأتي إمّا في الوزن وحده أو في الجذر وحده، وهذا ما يؤكد اختلاف طريقة عمل الذهن في العقل العربيّ لغويًّا عن غيره من اللغات، فلمَ علينا أن نرمي كل هذه الميّزات والنِّعم ونلجأ إلى الغات الغربية غير القابلة للاشتقاق؟ وبغضّ النظر عن سموّ العربيّة مقارنةً بغيرها، لمَ علينا اللجوء إلى لغة أُخرى ونحن نملك لغةً غنيّةً قائمةً بذاتها؟
إنَّ لهذه الأسئلة أجوبةً كثيرةً قد تخفى عن الأعين، وأبعادًا تتخفّى وراء قناع من وهمٍ يُدعى "العولمة"، وما يرافقه من مصطلحات مثل التطوّر ومواكبة الركب، والاتهامات بالتخلّف. أمّا الحقيقة الخفيّة فهي أنّنا نخسر حربًا قائمةً في كلِّ الأثناء، لكنّنا لا نعلم ولا نحارب فيها حتّى، بل قُل إنّنا نحارب ولكن بصفِّ عدوِّنا، فنعمّق خساراتِنا يومًا بعد يوم، هذه الحربُ حربٌ وجوديّةٌ، نعم، إنَّ هُويّتنا العربيّةَ قابعةٌ تحتَ تأثير مخدِّرات الجمال الأجنبيّة التي نجحت في خداع الأجيال الجديدة، وخداع القائمين على أمور الدول العربيّة، الذين لا همَّ لهم إلّا الاقتصاد الآنيُّ الذي لن يدوم بعد فقدان الهُويّة التّام، وبالتالي فقدان الشخصيّة العربيّة.
إنَّ في استهدافِ الغربِ لغتَنا تحويلًا لطبيعة هُويّتِنا، كأيّةِ عمليّةِ تحويل كيميائيّة تحوّل عنصرًا من طبيعةٍ إلى أخرى، إذ لا يخفى أنَّ هذا الابتعادَ الممنهجَ عن العربيّة سيحوّل طبيعةَ هُويّتنا إلى زجاجيّة، مُعرِّضًا إيّاها للكسر في أيّ وقت، وعلينا نحن أبناءها أن نعيد لها طبيعتها الصلبة التي تستحقها دون أيّة منّة أو إشادة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل علينا أن نعود إلى لغة أسلافنا القديمة التي صارت صعبة على غير المتخصصين؟ هنا، لا بدَّ من التأكيد أنَّ اللغةَ كالكائنِ الحيِّ، تتكيّفُ مع المتغيّرات لتبقى، وبالتالي ليس علينا أن نستعمل الفصحى القديمة بمفرداتها المُعقّدة وغير المستعملة، بل أن نلتزم بها ضمن إطار يسير بها إلى البقاء، فلا شكَّ أنَّ اللغةَ العربيّةَ من أقوى اللغات، لكن الشعار الشهير قد تغيّر من "البقاء للأقوى" إلى "البقاء للأكثر قدرةً على التكيّف مع التغيير". طبعًا هذا لا يعني التغيير في اللغة وقواعدها وأصولها الثابتة، فبمعلومة قد تصدمك، إنَّ الإنكليزيّ حاليًّا إذا قرأ لـ "شكسبير" - الأديب الأكثر شهرة في الثقافة الإنكليزية - فإنّه قد لا يستطيع فهمَ ما يعنيه في مؤلَّفاته، وهو المُتوفَّى العام 1616، أي ممّا لا يزيد عن أربعة قرون، بينما نستطيع نحن العربَ فهم معظم النصوص العربيّة منذ "الجاهليّة"، بل ومنذ بداية عهد المخطوطات والكتابة المحفوظة. إذًا ليس علينا سوى التوجّه إلى ما في العربيّة ممّا يتناسب مع العصر الحاليّ لتظل مفهومةً ومحبوبةً من قبل أبنائها قبل غيرهم.
ختامًا، علينا ألّا ننسى أنّها لغة القرآن الكريم، وهنا ما قد يكفينا كي ندفع أنفسنا نحو محاولات إعادة إحياء لغتنا العربيّة الجميلة. ولكن هل نستطيع لوم مَن فقدوا هذا الأمل في ظلِّ كلِّ هذا الانبطاح العربيّ السياسيّ والثقافيّ والأيديولوجي؟

سحر قلاوون (كاتبة من لبنان)
لغة البحث عن المعنى
عندما يُصيبني الملل، أجدني أفتش بين محطّات التلفاز عن شيء أشاهده، بعيدا عن الكتب التي أداوم على قراءتها والهوايات التي تضيف لحياتي معنى. أبحث عن شيء ما لأشاهده، ربما فيلم أو مسلسل، فيلفت نظري مشهد ما، فأبدأ بمتابعة الأحداث. ربما تكون القصة جيدة، ومسار الأحداث مقنع، والشخصيات مرسومة بشكل ممتاز، وعند نهاية كل حلقة من حلقات المسلسل أجدني متشوّقة لمعرفة أحداث الحلقة التي تليها.
لكن كل هذه المميزات لا يمكن لها أن تمحو النقطة السلبية التي أجدها في معظم الأعمال العربية. إذ أجدني أقف أمام كل عمل متسائلة: أين موقع اللغة العربية الفصحى من هذا العمل؟
فهل فكرتم يوما حين شاهدتم مسلسلا ما عن سبب ابتعاد صُنّاعه عن اعتماد اللغة العربية فيه؟ ربما البعض فكّر بذلك، والبعض الآخر لم يفكر، لكن النتيجة واحدة، وهي غيابٌ قاسٍ لهذه اللغة العظيمة والمليئة بالجمال عن الشاشة.
يستغني صُنّاع المسلسلات والأفلام عن هذه اللغة، ويستبدلونها بلهجاتهم المحكية، ربما يرون أنهم بهذه الطريقة يجعلون عملهم الدرامي أقرب إلى آذان وقلوب المشاهدين، لكن أين الحقيقة من كل هذا؟ الحقيقة هي أن المشاهد، كل مشاهد، سيتعلق بالعمل الذي يحمل بين طيّاته المعنى والجمال في آن واحد. واللغة العربية الفصحى هي لغة البحث عن المعنى، ولغة الجمال والإعجاز، فهل لنا من بديل عنها؟ بالتأكيد لا.
إن الأعمال التي اعتمدت اللغة الفصحى قليلة، لا بل نادرة، وهنا يجد مُحبّو اللغة العربية أنفسهم واقفين وجها لوجه أمام الإحباط.
وعن خوف صنّاع الأعمال التي تعرض على الشاشات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، فيما يتعلق بنفور المشاهدين من اللغة العربية الأصيلة، أقول بيني وبين نفسي يا ليتهم يتخلّون عن هذا الوهم، فالجمال لا يمكن أن يسبّب النفور، وما أجمل اللغة العربية! كما أن اعتياد المشاهدين على اللغة المحكية، فهو بسبب وجودها أمامهم ليس إلا، وفي حال وجدت أمامهم أعمال باللغة العربية الفصحى فإنهم بكل تأكيد سيتابعونها بكل استمتاع وحب.
فالإنسان هو ابن الأشياء التي يعتادها، ونحن قد اعتدنا على اللغة المحكية، بغضّ النظر عن مدى ضعفها أمام العربية الأصيلة، وإن أوجدنا أعمالًا تعتمد على الفصحى فستسرّ السامعين.
فهل سيأتي اليوم الذي تتزيّن فيه شاشات التلفاز بهذه اللغة التي لا تقلّ شأنا عن أيّ لغة أخرى ولا يمكن لأي لجهة محلية أن تعوض ألم غيابها؟

أ. د. صبري فوزي عبد الله أبو حسين (أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات، بجامعة الأزهر)
الفُصحى الميَسَّرةُ الجميلة الجامعة في أدب "ابن المقفَّع"
دائمًا ما تُثار مشكلة اللغة العربية في عصرنا الحديث من خلال ما يُسمّى (الازدواجية اللغوية) حيث انفصام العرب المستعملين لها بين مستوى (اللغة العربية الفصحى) في الكتابة الرسمية، والخطاب الديني الخاص! ومستوى (اللهجات المحلية) في الخطاب الشعبي اليومي الحياتي، وقد توزّع المفكرون في شأنها بين تيارين فكريين يهيمنان على الخطاب الثقافي، هما: (تيار كلاسيكي محافظ)، يتشدد في تعصبه للفصحى، ويشدّد النكير على خصومها، ويرى النيل منها مؤامرة كونية! و(تيار علماني متحرر) يرى في الفصحى معوقًا من معوقات التنوير والتثقيف، ويراها صعبة عصيةً، لا يفهمها عامة الشعب، وينفرون منها، ومن ثم يدعو هذا الفريق إلى التخلص منها وإحلال العامية مكانها في التعليم والإعلام، وفي صياغة الفنون السردية المختلفة من ملاحم ومسرحيات وقصص، وما تفرع منها في الفنون الإذاعية والدرامية والتمثيلية حيث الأغاني، والمسلسلات، والأفلام، بكل ألوانها!
وهذا التمزّق اللغوي والفكري له مضارّه على جوانب مختلفة من حياتنا تعليميًّا، وإعلاميًّا، وأدبيًّا وفنيًّا، وقد أدى كذلك إلى تراجع مكانة الفصحى، وإلى غياب أو تغييب المستوى الفصيح عن كثير من مجالات واقعنا، وإلى تهميش مساحة حضوره، عند كثير من أجيالنا الشابة القادمة، وانتشار أو نشر المستوى اللهجي العامي! بحجة عدم كفاءة الفصحى أو عدم قدرة الناس على استخدامها والالتزام بها شفاهيًّا وكتابيًّا وإبداعيًّا، وصعوبة التواصل الفعَّال بها، وأنها تؤثر سلبيًّا في التحصيل العلمي لدى الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، لاسيما في قطاع تعليم العلوم التجربيبة والطبية والهندسية والتكنولوجية!
بل إن من الأنكى حاليًا أن نجد فئات كثيرة من الجمهور العربي لا يتواصل مع خُطب الجمعة والمحاضرات الدينية الرسمية، ولا تستوعبها؛ لأنها خطب ومحاضرات تعتمد لغةً تقليدية جافة، عالية، وغير مُيسّرة وبعض الأئمّة والدعاة صاروا يعمدون إلى اللغة العامية الدارجة بحجة تيسير الفهم!
والحل في نظري يتمثل في ضرورة تعزيز استخدام الفصحى المُيسّرة الجميلة الجامعة، وتسهيل حضورها في وسائل الإعلام والتعليم وفي الحياة اليومية، وتحسين تعليم الفصحى بجعلها أكثر جاذبية وفعالية، واستثمار كبار المبدعين و المثقفين والإعلاميين والفنانين في دعم الفصحى وتجميلها وجذب الناس جميعا إليها! فليست اللغة العربية لغة البيانات الحكومية، ولا لغة الشيوخ وعلماء اللغة والدين فقط! إن حصرها في هذا المجال فقط هو تمويت لها!
وقد أثيرت مشكلة اللغة العربية في قضية نقدية ذات صدى في مدوَّنات النقد الأدبي الحديث، وهي قضية لغة الحوار السردي بين العامية والفصحى، فمن يمارس الكتابة السردية بكل ألوانها القصيرة والمتوسطة والطويلة يجد نفسه أمام معضلة الحوار، هل يكتبه بطريقته العامية الموجودة في الواقع محققًا ما يُسمّى (الصدق الواقعي) أو يكتبه بالفصحى محققًا ما يسمّى (الحفاظ على الفصحى)، وضاربا بالصدق الواقعي عرض الحائط، وهذا الاضطراب والتخبط أثر من آثار الازدواج اللغوي التي نعيشها في عصرنا.
وقد أحدث هذا الخلاف نقاشًا حادًّا مستمرًا حول استخدام إحدى اللغتين: الفصحى التي هي اللغة الرسمية والأكثر فصاحة لكنها بعيدة عن واقع الناس، وغير معبّرة عن حالتهم! أو العامية التي هي لغة التواصل الحيّة، وهي الأقدر على التواصل مع الجمهور وتلبية احتياجاتهم اليومية، وإيصال حالتهم النفسية والفكرية عن طريق لهجتهم الخاصة ذات الإيحاء المؤثر، لكنها تفقد بريقها وإيحاءها مع مرور الزمن، كما أنها تفهم عند طبقة أو جيل من الناس، ثم لا تفهم عند بقية الطبقات والأجيال، كما أننا لدينا في الوطن العربية عاميات كثيرة لا تُعدّ ولا تحصى وما بينها من الفوارق أكثر مما بينهما القواسم المشتركة والخصائص الجوامع! هذا إضافة إلى ما تحتوي عليه العاميات من ألفاظ خادشة للحياء وعبارات ماجنة داعرة هابطة! وهكذا تتصارع الفصحى مع العامية، في مجالات مختلفة، بسبب هيمنة هذين التيارين، وعدم وجو تيار وسطي ثالث، يقدم حلًّا مقنعًا ومقبولاً واقعيًّا ونخبويًّا وجمهوريًّا! يمتثل فيما سُمّي حينًا بـ (العامية الفصحى) أو (الفُصْعَمِية)، وأستحسن أن يُسمّى (الفصحى المُيسّرة الجميلة الجامعة)!
"ابن المقفع" رائد الفصحى الميسرة الجميلة الجامعة
(الفصحى الميسرة الجميلة الجامعة) هي لغة تحافظ على الثوابت اللغوية، وتمتح من المستجدات التداولية الحياتية بوعي وانضباط، وتتجنّب مظاهر التشدّق والتقعّر والإغراب والتعقيد والتنافر، إن مستعملي هذه اللغة يقصدون قصدًا إلى استخدام معجم لغوي سهل واضح سيّار، وإلى توظيف الجمل القصيرة الموجزة، الموصلة للمعنى والرسالة بأقصر وسيلة، مع الحرص على الجمال المطبوع العفوي البديع الجاذب الآسر، فليست هذه (الفصحى الميسرة الجميلة الجامعة) وليدة زماننا هذا، إنها موجودة في كل زمان ومكان، وأراها بادية وحاضرة في النصف الأول من القرن الأول الهجري فيما يُسمّى (مدرسة الترسُّل) حيث يأتي الخطيب أو الكاتب بكلامه مُرسلاً من كل قيد، دون التقيّد بالسّجع ولا الازدواج ولا أعشاب البديع. إنها مدرسة تعتمد على هَجْر الألفاظ البدوية الجافَّة والألفاظ العامية المبتذلة، والعناية بفصاحة اللفظ وسهولته، والتأنُّق في اختياره لتوجد مُلاءمة دقيقة بين الكلمة وأختها في الجَرْس الصوتي، والحرص على التعبير الموجز في مواضع والمطنب في مواضع أخرى حسبما يقتضيه الحال، هذا إلى وضوح الأسلوب، ودقة المعنى، وترتيب الأفكار، بغية إرسال الرسالة إلى أكبر قطاع من الجمهور: مستمعين أو قارئينٍ. وتُسمّى هذه المدرسة - كذلك – مدرسة (الطبع) تلك التي يعتمد أصحابها على الموهبة في الإبداع، ويكون أسلوبهم سهلاً ممتنعًا، ولا يظهر فيه الهفوات أو التكلفات اللغوية أو النحوية أو البلاغية التي نراها عند فاقدي الموهبة! ونرى هذه المدرسة التعبيرية عند خطب "قس بن ساعدة الإيادي" وعند كبار الخطباء في عصر صدر الإسلام، وعند الحسن البصري وابن المقفع، وسهل بن هارون، وغيرهما! واستمرت هذه المدرسة حديثًا فيما يُسمّى بـ "فن المقال" عامة، و"فن المقال الصحفي" خاصة، وفيما يُسمّى (لغة الصحافة)، و(لغة الإعلام) أو (اللغة العربية المعاصرة)!
وقد كان كبار الأدباء في القرن الثاني جميعه يتخذون هذا الأسلوب الفصيح الوسط إمامهم ومثلهم، سواء أكانوا مترجمين مثل "ابن المقفع"، أم مُدبِّجين لرسائل أدبية طريفة مثل "سهل بن هارون"، وقد بلغ القمة التي كانت تنتظره عند "الجاحظ" المتكلم، وهو أسلوب كان يوازن دقيقة بين طرافة المعاني، وإثارة الجمال في نفس القارئ والسامع، ولكن بدون كدٍّ ومجاهدة، ولذلك نسك أصحابه في مذهب الصنعة، فهم لا يبالغون في تكلفهم، ولا يستدعون الألفاظ من بعيد، ولا يدققون فيها كل التدقيق، ولا يصفونها كل التصفية.
يقول الدكتور "شوقي ضيف" (رحمه الله): مما لا ريب فيه أن هذه الثقافات الدخيلة التي نقلت إلى العربية، وسعت طاقتها، بما اكتسبت من المعاني العقلية والفلسفية، وقد أصبح النثر العربي نثر ثقافة متشعبة، تمدّها روافد كبيرة من إيران الهند واليونان، وليس ذلك فحسب، فقد أخذت تدخل في هذا النثر طرائق النظر الأجنبية، وأساليب الأجانب في تفكيرهم، والذي لا ريب فيه أيضًا أنه قام على هذا العمل نخبة من رجال الفكر الذين يحسنون اللغتين المنقول عنها، والمنقول إليها، فإذا هم يستخدمون أسلوبًا مولّدًا جديدًا يحتفظون فيه للعربية بصورتها النحوية والتركيبية، ونحن لا نستطيع أن نقف على مدى إحسانهم في هذا الأسلوب، إلا إذا لاحظنا أن لغتنا لم يصبها أثناء ذلك شيء من الفساد، فقد عمدوا إلى تخصيص بعض ألفاظها للدلالة على المصطلحات الفلسفية والعلمية الجديدة، وكان إذا اضطرهم معنى لفظ أجنبي إلى الاحتفاظ به عرّبوه، كما حدث في أسماء كثير من النباتات والأحجار، والعقاقير والأمراض، وبعض أسماء الآلات أو أسماء بعض العلوم، وكانوا كثيرا ما يضيفون صيغًا جديدة، ولكنهم لم يبتعدوا بها عن تراكيب العربية، ومن يقرأ كُتب "ابن المقفع"، وهو من أوائل المترجمين يرى كيف استطاع أن يضفي على أساليبه الطوابع العربية تامة كاملة. وبذلك اتسعت لغة الصحراء، وأصبحت لغة ثقافية ذات أسلوب مرن يستوعب كل ما لدى الأجانب من كنوز المعرفة، ومذاهب الفلسفة مما كان له أثره في الأدب نثره وشعره، كما كان له أثره في العلوم الإسلامية والإنسانية...
ومِن أبرز روّاد هذه اللغة العربية الفصحى المُيسّرة الجميلة الجامعة الكاتب الكبير "عبد الله بن المقفع" (106هـ- 142هـ) في رسائله الوعظية النصحية: "الأدب الكبير"، "الأدب الصغير"، "الدرة اليتيمة"، "رسالة الصحابة"، التي تحوي الكثير من الحِكَم المستمدة من الثقافات الإسلامية واليونانية والفارسية، في مجالات متنوعة بين دينية واجتماعية وسياسية وتروية واقتصادية، وإنها رسائل تعليمية وتوجيهية رائدة، إذ تُعدّ من أوائل نصوص الفكر السياسي والاقتصادي والتربوي الإصلاحي في التاريخ الإسلامي كله، كتبها "ابن المقفع" لغاياتٍ إصلاحيّة؛ لِما كان يشهده من فساد إبّان العصر العباسيّ، وقد رأى أنّ هذا النّصحَ المتنوع المجالات واجبٌ حين ساءته أحوال عصره. وقد استخدم في صياغتها ذلك الأسلوب السهل الممتنع المطبوع المترسل، الميسّر الجميل في معجمه وجُمله، والجامع لكل فنون القول وأغراضه.
يقول الأمير "شكيب أرسلان" في مقدمة رسالة الدرة اليتيمة لابن المقفع: "إن أكثر مشاهير الكُتاب ومَصَاقع الخطباء من أهل المئات الأُوَل بعد الهجرة لم تظفر الأيدي بكلامهم إلا قليلًا منه، منثورًا في بعض التآليف والمجاميع، متفرقًا منقطعًا بعضه عن بعض، مع أنهم العمدة في هذه الغاية والقدوة في هذا السبيل. والناس في الأدب إنما تلتقط من فضلات مآدبهم، وتترشّف من أسآر مشاربهم؛ ولذلك جعلتُ من بعض همي، مع عدم اتساع البال، ونصْب النفس لهذه الأشغال، التنقيبَ عن بعض آثار القوم، أهل هذا الشأو البعيد، والشأن الخطير، حتى ظفرتُ وأنا في هذه الأيام بدار الخلافة العظمى بجملة من الكتب، منها هذه الدرة اليتيمة لعبد الله بن المقفع المنشئ المشهور، معرِّب كتاب كليلة ودمنة، فاخترت عموم الفائدة بطبعها؛ لأنها - مع صغر حجمها - قد جمعت بين أعلى طبقات البلاغة، وأسمى درجات الحكمة، وتضمّنت من الحِكَم البوالغ والحُجَج الدوامغ، ما لم يتضمّنه كتاب قبلها ولا بعدها، فكانت حَرِيَّةً بأن يتخذها الكاتب منتجعَ لُبِّه وحماطة قلبه، وأن يجعلها دستور إنشائه ومثال احتذائه، وحقيقةً بأن يتخذها الإنسان نُصْب ناظره، وشغل خاطره، يهتدي بنور حكمها في ظُلَم المعاضل، ومُدلهمات المشاكل، ويتدرَّب بما أوضحته من سبل التصرف الحكيمة، ونهجته من جواد الكمال القويمة، على امتزاج لحكمتها بقواعد الكون، ودخولها تحت طور الطوق. وما أنا محدث عن ابن المقفع وهو رب هذا الأمر، وواسطة هذا العقد، وفي شهرته ما يغني عن الإفاضة والإشادة، وفي الاطلاع على هذه الرسالة ما يكفي الشاهد مؤنة الشهادة. ولعمري لو استفرغ مجتهدٌ وسعه في إهداء أرباب الأقلام طُرفة تُعجبهم، فقصاراه نشر كلام مثل ابن المقفع؛ إذ لا يجد في هذا الباب أجزل لهم نفعًا ولا أسنى لديهم وقعًا؛ ولذلك كان لا شبهة عندي في أن ما توخيه من الفائدة يلاقي إقبال الطلاب، ويقتضي ثناءهم بحسن الانتخاب، فقد يكون من فضل المرء في حسن انتقائه ما يربو على فضله في حسن إنشائه، إذ كان من الاختيار ما هو أنطق بالفضل، وأدلّ على العقل، على حد قول القائل: "قد عرفناك باختيارك؛ إذ كان دليلًا على اللبيب اختيارُه".
وتجد هذا الأسلوب السهل الممتنع حاضرًا - كذلك - في ترجمة "ابن المقفع" كتاب ""كليلة ودمنة"، ذلك الأثر الأدبي الخالد، الذي أسهم في الأدب العالمي عمومًا. وهو كتاب اختُلف في أصله كما اختُلف في ترجماته، وهو يتناول قصصًا تجري على لسان الحيوان في ظاهرها، وتستنطق الحيوان لتصل إلى أهداف أخرى أخلاقية وإصلاحية لشؤون المجتمع والسياسة. فالحيوان في كليلة ودمنة أداة توظيف لغاية قَصَدَها الكاتب. وقد يتحقق هذا الهدف بعرض الحكمة مباشرة، أو من خلال الفكاهة التي تظهر في قيام الحيوان بالدور الإنساني سواء المسلك أو الحوار. قال ابن المقفع: "وأما الكتاب فجمع حكمة ولهوًا؛ فاختاره الحكماء لحكمته والسفهاء للهو، والمتعلم من الأحداث ناشط في حفظ ما صار إليه من أمر يربط في صدره ولا يدري ما هو". وقد صرح ابن المقفع أكثر من مرة أن للكتاب غرضًا ظاهريًا وآخر باطنيًا، فيقول: "وكذلك من قرأ هذا الكتاب، ولم يفهم ما فيه ولم يعلم غرضه ظاهرًا أو باطنًا لم ينتفع بما بدا له من خطه ونقشه". والكتاب منبع دلالات ورموز عديدة ومتنوعة، ولنعش مع أنموذج من هذا الكتاب السردي لكي نقف على لغته وقفة واقعية:
أنموذج: الأسد وابن آوى والحمار
قال القِرْدُ: زَعمُوا أنهُ كانَ أسدُ في أجمةٍ وكان معهُ ابنُ آوَى يأُكل منْ فضَلاتِ طَعامهِ، فأصابَ الأسدَ جَرَبٌ وضَعُفَ ضُعفاً شديداً وجُهِدَ فلمْ يَسْتطعِ الصَّيْدَ، فقالَ لهُ ابْنُ آوى: ما بالُكَ يا سيّدَ السَّباعِ. قدْ تَغيَّرَتْ أحوالُكَ؟ قال: هذا اَلجرَبُ الذي قد أجهَدني وليْسَ لهُ دَواءُ إلاَّ قلْبُ حِمارٍ وأذُناهُ. قال ابْن آوى: ما أيْسَرَ هذا، وقدْ عَرَفْتُ بمكانِ كذاَ حماراً وأنا آتِيك بهِ، ثمَّ دَلَف إلى الحِمارِ فأتاهُ وسلَّمَ عليْه وقال: ما لِي أراكَ مَهْزُولاً ؟ قالَ: ما يُطعمُني صاحِبي شيئاً. فقالَ لهُ: كيْفَ تَرْضَى المقامَ معهُ على هذا الحالَ؟ قال: ما لِي حيلةٌ للهرَبِ منه فلسْتُ أتوجّهُ إلى جهةٍ إلاَّ أضرَّ بي إنْسانٌ فكدًّني وأجاعني. قال ابنُ آوَى: فأنا أدُلكَ على مَكانٍ مَعْزُولٍ عنِ النَّاسِ لا يَمُرُّ بهِ إنْسانُ، خَصِيبِ المَرْعى لم تَر عيْنَ مثله خصبا.
قال الحِمارُ: وما يحبسُنا عنه؟ فانْطلقْ بِنا إليه. فانْطَلَقَ بهِ نحوَ الأسدِ وتقدَّمَ ابْن آوى ودَخَلَ الْغابةَ على الأسدِ وأخبرَهُ بمكان الحِمار، فخرَجَ إليهِ وأرادَ أنْ يَثِبَ عليْهِ فلم يَسْتطعْ لِضعْفِه، وتَخلَّصَ الحِمارُ منهُ فأفلَتَ هَلعاً على وجْهِه. فلمَّا رأى ابْنُ آوى أنَّ الأسدَ لمْ يقْدِرْ على الحِمارِ، فال: يا سيَّدَ السِّباعِ أَعجزْتَ إلى هذهِ الغايةِ؟ فقالَ لهُ: إنْ جِئتَني بهِ مرَّةً أْخرَى فلَنْ يَنْجُوَ منِّي أبداً، فمضَى ابْن آوى إلى الحِمارِ فقالَ لهُ: ما الذِي جَرى عليْكَ، إنَّ الأسد لم يعرفْك، وقد ظنَّكَ ضبعاً، اعتادت أن تعتدي على أشباله، وأن الأسد قد أعلمني أنه لو كان عرفك، لرَحَّبَ بكَ، وسمحَ لك أن تشاركه السكن في الغابة، ترعى وتمرحُ و تذهبُ فيها أنّى شئت! فلمَّا سَمِعَ الحمارُ ذلكَ اطمأن ونَهَقَ وأخَذَ طريقهُ إلى الأسدِ، فَسَبَقَه ابن آوى وأعلَمَهُ بمكانهُ وقال له: اسْتعِدَّ لهُ فقدُ خَدَعتُهُ لكَ فلا يُدْركَنَّكَ الضَّعْفُ في هذهِ النَّوْبةِ فإنهُ إنْ أفلَـَتَ لنْ يَعُودَ مَعي أبداً، فجاشَ جأشُ الأسدِ لتَحْريضِ ابنِ آوى لهُ، وخرَجَ إلى موضِعِ الحِمارِ فلمَّا بَصُرَ به عاجلَهُ بوَثبةٍ افترسهُ بها. ثم قال: قد ذَكَرَتِ الأطبَّاءُ أنه لا يؤكلُ إلاَّ بَعْدَ الغُسْل والطُّهُورِ فاحتَفِظْ بهِ حتى أعودَ فآكلَ قلبه وأذُنْيهِ وأتركُ ما سِوَى ذلكَ قوتاً لكَ. فلمَّا ذَهبَ الأسدُ لِيَغتَسِلَ عَمَدَ ابْنُ آوَى إلى الحِمارِ فأكل قلْبَهُ وأذُنيهِ رَجاء أن يَتَطيَّر الأسدُ منهُ يأكل منهُ فلا يأكل منه شيئًا. ثمِّ إنَّ الأسدَ رَجعَ إلى مكانه فقال لاِبن آوَى: أيْنَ قلْبُ الحِمارِ وأذُناهُ ؟ قال ابْن آوى: أوَلمْ تَعْلَمْ أنهُ لوْ كانَ لهُ قلبُ وأذُنانِ لمْ يَرجعْ إليْكَ بعْدَ ما أفلًتَ و نجَا من الهَلَكِة!
فهذا نص سردي درامي فيه حوار، وجاء بلغة سهلة حيّة معاصرة، تصل إلى الناس جميعًا، وهذا شأن كل الكتابات السردية التراثية باستثناء بعض المقامات التي جاء الإغراب اللغوي هدفًا من أهداف إبداعها!
إن الدعوة إلى التمسك باللغة العربية الفصحى الميسرة الجميلة الجامعة تعلّمًا وتعليمًا وبحثًا في علومها، يحتاج إلى تيسير عمليات تعلمها وتعليمها واستخدامها، وعلى نشرها في كل مجال، وكل فن، وبين الأجيال القادمة، فهي ضرورة دينية لفهم الإسلام والعمل به، وفهم تراثنا، وضرورة وطنية لحماية البلاد والعباد من كل فهم مغلوط تشددًا أو انحرافًا! وضرورة اجتماعية للتواصل السهل الحي المهذب بين الناس. إنها لساننا وفخرنا وزينتنا، نلتزمها في كل زمان ومكان، ومع البشر كافة، ونحتفل بها ونفرح لها وبها في كل أيامنا، ما دام القرآن الكريم يُتلى، وما دامت السُّنة النبوية تُبلَّغ وتُعلَّم وتوصل إلى البشر أجمعين، ونحييها في فنوننا الأدبية، والإعلامية، والتمثيلية، والغنائية، ولا نقتصر على يوم واحد نجعله عيدها فقط!
نعم: إنني من أنصار التّمكين للَّغة العربية المُيسّرة الجميلة الجامعة، التي لا تحتاج إلى معاجم وقواميس لفهم مفرداتها، والتي تستطيع أن تغزو القطاع الكبير من المتكلمين والكاتبين دون مشقة أو إعنات. وإن مستقبل اللغة العربية الفصحى يحتاج منَّا أن تُعمّم هذه اللغة في أفلامنا ومسلسلاتنا، والأعمال الفنية التي تلقى رواجًا بين الناس؛ حتى يحاكيها أبناؤنا وأحفادنا. وإن المثقف الفعّال في المُجتمع، تتجلّى جهوده في توطيد العلاقة بين الفرد ولغته العربية الجميلة، وهو الذي ينقل اللغة العربية من كونها لغة ضيقة المساحة خاصة بالنّخبة، إلى كونها لغة سهلة واسعة المساحة، تستخدم في مجالات التعليم والإعلام والفن، على اختلاف المستويات، لاسيما الموجّهة إلى الأجيال الناشئة! فيكتب للفصحى حياة، ويحدث بالفصحى حياة، ويكتب لها حضور بين الأحياء، ووسط المطبوعات والمدونات، ورقية وإلكترونية!

سامر المعاني (كاتب من الأردن)
العربية.. جميلة ورشيقة وقدراتها بلا حدود
اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ولغة الضاد، ولغة الشعراء، هي اللغة التي تشمل كل مقومات االغة الحيّة من حركات ونقاط وتراكيب. إنها لغة غنية بالمعاني والمفردات والخصوصية التي لن تجدها في لغة أخرى.
اللغة العربية لغة رشيقة وجميلة قابلة للتطور والتفاعل والتعامل مع المتغيرات الحداثية والتكنولوجية وقابلة لأن تكون مُيسّرة بشكل مثالي دون جمود وسطحية في المعنى والمراد.
إنها لغة فريدة من نوعها حيث تتميز بجمالها وروعتها، وتتميز أيضا بقدرتها على التعبير عن المشاعر والأفكار بكل دقة. اللغة العربية هي لغة الشعراء والكتاب العرب، ولغة القرآن الكريم الذي يُعتبر أعظم كتاب في اللغة العربية.
للحفاظ على اللغة العربية في المدارس والجامعات، يجب أن نُعلّم الطلاب والطالبات اللغة العربية بشكل صحيح، ونُعرّفهم بقواعدها ومفرداتها. يجب أن نُشجّع الطلابَ على القراءة والكتابة باللغة العربية، ونُقدّم لهم نماذج من الأدب العربي الرائع.
كما يجب أن نُدرج اللغة العربية في المناهج الدراسية بشكل مُبسّط ومُيسّر وليس معقدا نركز فيه على الإعراب والتعليل، ونُعطيها الأهمية التي تستحقّها من حيث قدرتها على المنافسة بين اللغات القادرة على التكيف مع معطيات العصر.
يجب أن نُشجع الطلاب على استخدام اللغة العربية في حياتهم اليومية، ونُقدّم لهم الفرص للتحدث والكتابة باللغة العربية.
الصحافة والإعلام والدراما يقع عليها دور كبير فهي وسائل فعّالة لنشر اللغة العربية والحفاظ عليها. فيمكن للمسلسلات والأفلام العربية أن تُعرّف الناس باللغة العربية، وتُشجعهم على تعلمها. كما يمكن للدراما أن تُقدّم نماذج من اللغة العربية الصحيحة، وتُعرّف الناس بقواعدها ومفرداتها.
كما يمكن للدراما أن تُسهم في نشر الثقافة العربية، وتُعرّف الناس بالتراث العربي. يمكن للمسلسلات والأفلام العربية أن تُقدّم نماذج من الحياة العربية، وتُعرّف الناس بالعادات والتقاليد العربية.