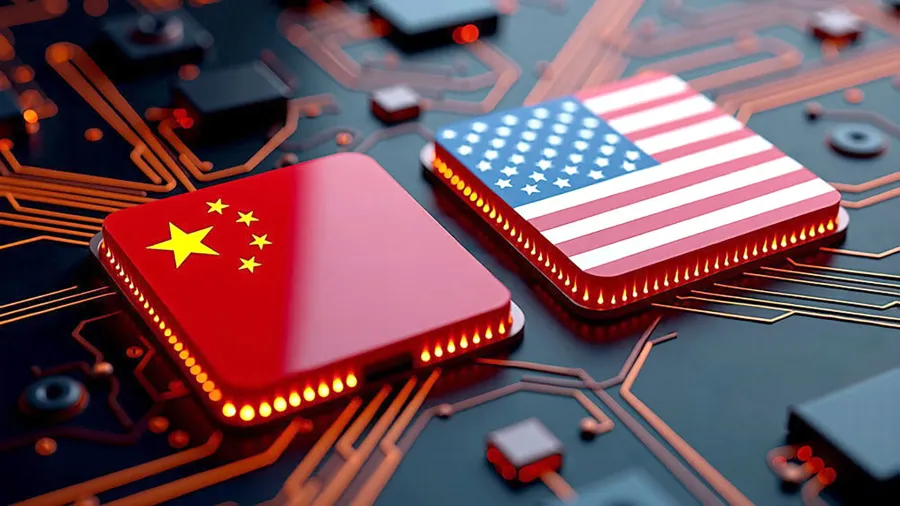في عالم تُقاس فيه قوة الأمم بما تملكه من عقول لا بما تختزنه من موارد، يصبح الابتكار سلاحا استراتيجيا بامتياز، فالورقة البيضاء في يد المخترع لم تعد رمزا للخيال العلمي، بل وثيقة اقتصادية وسياسية تحدد موقع الدول في سباق التكنولوجيا والمعرفة. إنها المساحة التي تكتب فيها الشعوب مستقبلها، حين يتحول الإبداع الفردي إلى قرار سيادي واستثمار وطني يضمن الاستقلال والتنمية.
قد تبدو "الورقة البيضاء" مجرد مساحة صامتة، لكن في يد المخترع تتحوّل إلى منصة إطلاق لمستقبلٍ بأكمله. هناك، حيث لا يُسمع إلا صوت القلم، تبدأ ثروات القرن الحادي والعشرين في التشكل: أفكار صغيرة تولد في الظل، لتضيء خرائط الاقتصاد العالمي. من سيليكون فالي إلى حاضنات الجامعات العربية، أثبتت التجارب أن الشركة التي تُبنى على فكرة لا تحتاج إلى أرض تُستخرج منها الثروة، بل إلى عقل يؤمن أن "الخربشة الأولى على الورقة" قد تساوي يوما مليارات.
في زاوية صغيرة، قد لا يلاحظها أحد، تُولد الفكرة خجولة مثل ومضة في عتمة، لا تصدر ضجيجا ولا تحمل لافتة، لكنها تملك شيئًا لا يُشترى: القدرة على الإزعاج الجميل. الإزعاج الذي يوقظ العالم من سباته ويقول له: "هناك طريقة أخرى للعيش". هكذا وُلدت معظم الابتكارات التي نعرفها، من خربشة على ورقة إلى مشروع يملأ الأسواق ويغيّر أنماط الحياة. ليس في مكاتب الزعماء أو رجال الأعمال، وإنما في غرف الطلبة والمقاهي والمختبرات المنسية. فالفكرة لا تبحث عن الأضواء، وإنما تبحث عمن يؤمن بوهجها قبل أن يراه الآخرون.
كل فكرة جديدة تبدأ كمشكلة لم تُحل بعد، أو كحلمٍ صغير لا يملك تذكرة عبور إلى الواقع. لكن بين الشك والإيمان، هناك عقلٌ يجرّب، ويدٌ تكتب، وعزيمةٌ ترفض أن تضع الورقة في الدرج. في اقتصاد المعرفة، لا يُقاس النجاح بحجم المكتب ولا بعدد الموظفين، وإنما بجرأة السؤال الأول: "لماذا لا نفعلها بطريقة مختلفة؟". ومن هذا السؤال، يبدأ الانقلاب الهادئ الذي يصنع الفرق بين من يستهلك ومن يبتكر.
إنّ الورقة البيضاء التي نستهين بها في لحظة تفكير، هي في الحقيقة مساحة حرّة لولادة الإمبراطوريات. مايكروسوفت لم تبدأ بمصنع، بل بسطر برمجي. وأمازون لم تبدأ بسلسلة متاجر، بل بفكرة عن "متجر بلا جدران". حتى التجارب العربية التي تألقت، كانت أولاً فكرة في رأسٍ صغير حُوصرت بالشكّ، قبل أن تحاصر الأسواق بالمنتجات. الورقة البيضاء ليست مجرّد ورق، إنها الحاجة في لحظة خلقها الأولى، تنتظر من يرسم ملامحها.
لكنّ الفكرة مهما كانت عظيمة، تحتاج إلى وقودٍ من نوعٍ خاص: إيمان صاحبها بها في مواجهة السخرية، والخذلان، والعثرات. فالمخترع لا يُختبر في مختبره فقط، بل في قدرته على الصمود أمام العيون التي لا ترى ما يرى. كثير من الأفكار ماتت لأن أصحابها صدّقوا العالم أكثر من أنفسهم، وكثير من الثروات وُلدت لأن صاحبها قال: "سأجرب ولو وحيدًا". هنا، تتبدّل المعادلات: ليست القوة في الرأسمال، وإنما في الرؤية.
وهكذا، حين تخرج الفكرة من الظلّ وتواجه النور، لا تكون قد تغيّرت هي، بل تغيّر كل شيء حولها. العالم الذي لم ير فيها سوى ورقة، يراها الآن خريطة طريق. السوق الذي تجاهلها، يفتح لها الأبواب. وبين البدايات المتعثّرة والنهايات المبهرة، يظهر جوهر اقتصاد المعرفة: لا مكان فيه لمن ينتظر التعليمات، بل لمن يكتبها. غير أن الحلم، مهما اشتعل، يحتاج إلى بيئة تمنحه الأكسجين... وهنا تبدأ الحكاية.
اقتصاد المعرفة.. حين تصبح الفكرة عملةً صعبة
الثراء اليوم بات حكرا على من يعرف كيف يحوّل السؤال إلى منتج، والفكرة إلى تدفق نقدي. في زمنٍ صارت فيه المعلومة أغلى من البترول، والمعرفة أدقّ من الماس، وُلد نظامٌ جديد من الاقتصاد لا يقيس الثروة بما في الجيوب، بل بما في العقول. هنا، لا يُقاس الناتج المحلي بطنّ الحديد، بل بعدد الأفكار التي يمكن تحويلها إلى براءات اختراع، وشركات ناشئة، وحلول تُعيد رسم خرائط السوق.
اقتصاد المعرفة هو الوجه الجديد للثروة: لا يحتاج إلى ناقلات نفط، بل إلى شبكات ألياف بصرية. لا يقوم على العمالة اليدوية، بل على الذكاء الجماعي. لا يخضع لتقلبات المناخ، بل لإبداع الإنسان. في هذا الاقتصاد، المصنع الحقيقي هو "العقل"، والمورد الأساسي هو "المعلومة"، والعامل الأهم هو "المبتكر". كل فكرة قابلة للتطبيق هي منجم مفتوح، وكل طالبٍ يبدع في مختبره هو شركة ناشئة مؤجلة تنتظر قرار التمويل.
لقد قلبت المعرفة الموازين: لم يعد موقعك الجغرافي يحدد مصيرك، بل موقعك الفكري. دولٌ بلا نفطٍ صارت مراكز للبرمجيات، وأممٌ لا تملك أنهارًا صارت تصدّر الحلول الرقمية للعالم. من وادي السيليكون في كاليفورنيا إلى مدن الذكاء الاصطناعي في دبي وسنغافورة، تثبت الوقائع أن القيمة لم تعد في اليد التي تحفر، بل في العقل الذي يبتكر. إننا نعيش زمن العقل المنتج لا اليد العاملة.
ولأن الفكرة باتت عملة صعبة، فقد أصبحت الأسواق أكثر حساسية تجاه من يملكها. المستثمرون يبحثون عن "العقول قبل العقارات"، والبنوك تخصص خطوط تمويل للمشاريع التي تبدأ بملف "PDF" لا مصنع من إسمنت. في عالمٍ يقوده الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة، أصبحت الشركات الأغنى هي التي لا تُرى منتجاتها بالعين، لكنها تغيّر العالم بالمعادلات والخوارزميات.
ومع هذا التحوّل، بدأت الدول تراجع معايير الثروة والسيادة. فالقوة اليوم لا تُقاس بعدد الدبابات، بل بعدد براءات الاختراع، وعدد الجامعات التي تُخرّج عقولًا تفكّر خارج الصندوق. من يملك المعرفة يملك القرار، ومن يملك القرار يرسم الاقتصاد. غير أن الفكرة وحدها لا تكفي... فهي بحاجة إلى بيئةٍ تُنبتها، وإلى مؤسساتٍ تحتضنها، وإلى تشريعاتٍ تمنحها الضوء الأخضر بدل الإشارات الحمراء. وهنا تفتح الحكاية بابها التالي...
حين تتحدث البيئة.. تصمت العقبات
قد تكون الفكرة عبقرية، لكنها بلا بيئة داعمة تشبه بذرة تُلقى على صخر: لا تموت فورًا، لكنها لا تنمو أبدًا. في عالم اقتصاد المعرفة، لا يكفي أن تمتلك العقل الذي يبتكر، بل يجب أن تعيش في مناخٍ يؤمن بأن “الاختراع ليس جنونًا بل استثمار”. البيئة ليست رفاهية، هي الشريك غير المعلن لكل فكرة ناجحة، والمحضن الذي يحوّل الشرارة إلى نار، والمختبر إلى شركة. من دونها، تبقى الورقة البيضاء مجرّد حلم معلق في هواء البيروقراطية.
في الدول التي آمنت بأن العقول ثروة وطنية، أصبحت الفكرة مشروعًا وطنيًا. فأنشأت الحاضنات ومراكز الابتكار، وفتحت الجامعات أبوابها للمشاريع لا للشهادات فقط، وربطت البحث العلمي بالصناعة والتمويل والمجتمع. قطر مثلًا جعلت من المختبرات نوافذ على السوق، والسعودية حولت "رؤية 2030" إلى عقد شراكة مع المبتكرين، والجزائر بدأت في ترسيخ فكرة أن الجامعة ليست نهاية الرحلة، بل بدايتها. حين تتحدث البيئة بهذه اللغة، لا تعود الأفكار تبحث عن منفى، بل تجد وطنًا يحتضنها.
القانون في اقتصاد المعرفة ليس أداة ضبط، هو أداة إطلاق. التشريع الذكي لا يراقب المبتكر، بل يحميه، ولا يثقل كاهله بالملفات، بل يفرش أمامه الطريق نحو السوق. الدول التي طوّرت منظوماتها القانونية جعلت من الفشل مرحلةً من مراحل النجاح، ومن المغامرة فعلًا وطنيًا لا مغامرة شخصية. أما الأنظمة التي لا تزال ترى في الريادة خطرًا على النظام العام، فهي تزرع الشك في نفوس المخترعين قبل أن يزرعوا أفكارهم في أرض الوطن.
ولأن البيئة ليست مجرد قوانين، فإنها تشمل أيضًا الثقافة. ثقافة تُعلّم الطفل أن السؤال طريق اكتشاف. ثقافة ترى في الخطأ محاولة، لا فضيحة. ثقافة تفتح الباب أمام التعاون بدل الاحتكار، وأمام الفريق بدل الفرد الواحد. فالمعرفة تنمو في حوارٍ مستمر بين العقول، في فضاءٍ يُكافئ الفضول لا التكرار. البيئة التي تحتفي بالأسئلة أكثر من الإجابات، هي وحدها القادرة على إنتاج أجيالٍ تسأل العالم: "ماذا بعد؟"
وحين تنضج البيئة، تختفي الأعذار، ويُصبح الطريق إلى السوق ممهدًا، لا مفخخًا. عندها، تتحول الفكرة الصغيرة إلى مشروع وطني، والمخترع الفرد إلى رائد أعمالٍ يقود فريقًا، والفشل الأول إلى درسٍ يُدرّس. البيئة لا تخلق العبقرية، لكنها تمنحها فرصة النجاة. ومن هذه الفرصة تولد القصص التي تبدأ بـ"كان يا ما كان" وتنتهي بـ"مليار دولار في الميزان". ومع كل قصة نجاح، يزداد يقيننا أن المعجزات ليست خارقة للطبيعة، بل محكومة بقوانين السوق... وخطط الطريق تبدأ دائمًا من ورقة بيضاء.
من الورقة إلى المليار.. خريطة الطريق الخفية
كل مشروعٍ عظيم يبدأ بخطٍّ مرتعش على ورقة، لكن الخطّ لا يتحوّل إلى توقيعٍ على عقد إلا حين يتحوّل الحلم إلى “نموذجٍ قابل للتنفيذ”. في اقتصاد المعرفة، الفكرة وحدها لا تُقنع السوق، بل الخطة التي تمشي على قدمين. من التفكير إلى التصميم، ومن النموذج الأولي إلى المنتج، الطريق طويل ومليء بالانعطافات. من يظن أن النجاح يقفز من الورق إلى البورصة دفعة واحدة، لم يزر مختبرات الذين يسهرون ليجعلوا الفكرة “قابلة للتكرار” و”قابلة للربح”. فكل فكرة تمرّ باختبار قاسٍ: هل تستطيع أن تعيش خارج عقل صاحبها؟
ثم يأتي التمويل… ذاك التحدي الذي يفرز الحالمين من المنفّذين. في عالمٍ يتغير بسرعة، لم يعد المستثمر يبحث عن الضمانات بقدر ما يبحث عن الرؤية. يريد أن يرى في صاحب الفكرة “مهندسًا للغد” لا “حالمًا بالماضي”. بعض المشاريع تُموَّل لأنها جميلة، وأخرى تُموَّل لأنها ممكنة، لكن المشاريع التي تغيّر التاريخ هي تلك التي تُموَّل لأنها ضرورية. التمويل في اقتصاد المعرفة شراكة في مغامرة، فيها ربحٌ للمال، وربحٌ للفكرة، وربحٌ للوطن.
ومع التمويل، تأتي لحظة بناء الفريق. فلا شركة تُقام على فكرةٍ واحدة، بل على “عقولٍ تتحدث اللغة نفسها”. المخترع يحتاج إلى المسوّق، والمحاسب يحتاج إلى المبرمج، والحالم يحتاج إلى الواقعي. وحدها الفرق التي تجمع الخيال والانضباط، تملك القدرة على التحليق دون أن تحترق. لهذا، فإن بناء الفريق شرطًا أساسيًا لتحويل الابتكار إلى منظومة قادرة على الإنتاج المستدام. في عالم المعرفة، الشركة هي فريقٌ من العقول قبل أن تكون مقرًا من الإسمنت.
ثم تأتي مرحلة التوسّع، حيث تنتقل الفكرة من الحيّز المحلي إلى الفضاء الإقليمي وربما العالمي. هنا يُختبر الذكاء الاستراتيجي: كيف تحافظ على روح الفكرة وأنت تكبر؟ كيف تترجمها إلى لغاتٍ وأسواقٍ جديدة دون أن تفقد نكهتها الأصلية؟ الشركات التي نجحت في هذه المرحلة لم تكن الأكبر تمويلًا، بل الأكثر قدرة على التكيّف، والأشدّ إيمانًا بأن "المستقبل سوقًا مفتوحة للأفكار التي تجرؤ."
وفي نهاية الرحلة، حين يتحوّل الحلم إلى شركةٍ تُدرّ الأرباح وتخلق الوظائف وتوقّع العقود، لا يكون الإنجاز الحقيقي هو المليار في الحساب، بل المعادلة التي أُثبتت: أن المعرفة يمكن أن تكتب أقدار الاقتصاد، وأن الورقة البيضاء ليست ورقة عابرة، بل وثيقة تأسيس لعصرٍ جديد. ومع كل قصة نجاح، تتكرّس القناعة بأن الاقتصاد الذي يَزرع الأفكار لا يخاف مواسم الجفاف. لكن ما الذي يجعل هذه القصص ممكنة؟ إنها المعادلة الذهبية التي تجمع بين المعرفة والابتكار والبيئة الداعمة… وهنا، نصل إلى سرّ اللعبة.
المعادلة الذهبية نحو الثروة
التفوق أصبح لمن يعرف كيف يستخدم الأدوات التي يملكها بذكاء. فالثروة اليوم لا تُقاس بما يُستخرج من باطن الأرض، بل بما يُستخرج من أعماق العقل. ومن هنا تولد المعادلة الذهبية التي تصنع الفرق بين الدول التي تستهلك الأفكار، وتلك التي تُصدّرها: معرفةٌ تُنير الطريق، ابتكارٌ يشقّه، وبيئةٌ تُمهد له العبور. تلك ليست صدفة، بل نظامٌ يمكن بناؤه مثل أي بنية تحتية، لكن أدواته من نوعٍ آخر: الأفكار، المؤسسات، والثقة.
المعرفة هي الوقود الذي لا ينضب، موردٌ متجدد لا يخضع لتقلبات السوق ولا لعقود التوريد. إنها القاعدة التي تُبنى عليها كل طموحات الأمم. من دونها، يصبح الاقتصاد جدارًا هشًّا مطليًا بالذهب، ومن يمتلكها يصنع الذهب ذاته. لذلك، لا عجب أن نرى الدول الكبرى تتنافس على “الجامعات” أكثر من “الحقول”، وتُموّل البحث العلمي كما تُموّل الجيوش. المعرفة سلاح سياديّ يُستخدم للدفاع عن المكانة، لا عن الأرض فقط.
أما الابتكار، فهو الجسر الذي تعبر عليه المعرفة من الكتب إلى الأسواق. فكم من فكرة عبقرية ماتت في الرفوف، لأنها لم تجد من يجرؤ على تحويلها إلى نموذجٍ قابلٍ للحياة. الابتكار ليس فقط أن تبتكر شيئًا جديدًا، بل أن ترى القديم بعينٍ جديدة. هو إعادة ترتيب الواقع بطريقةٍ أكثر عدلًا وكفاءة. ولهذا، يُعدّ المبتكر صانعًا للزمن، يسرّعه أو يبطئه كما يشاء. من لا يبتكر، يستهلك وقت الآخرين؛ ومن يبتكر، يبيع الوقت لمن لا يزالون في الطوابير.
أما البيئة الداعمة، فهي المناخ الذي يسمح لهذه المكوّنات أن تتفاعل دون أن تحترق. في بيئةٍ خانقة، تموت الفكرة خنقًا قبل أن تتنفس. في بيئةٍ منفتحة، تتحول الفكرة إلى شركة، والشركة إلى قطاع، والقطاع إلى اقتصادٍ قائمٍ على الابتكار. البيئة هي قوانين وتشريعات ومنظومة قيمٍ ترى في الفشل بداية، وفي الاختلاف مصدرًا للتنوع، وفي الشباب أصولًا استثمارية لا عبئًا على الميزانية. من يزرع الثقة، يحصد المشاريع.
وحين تتفاعل هذه العناصر الثلاثة في توازنٍ دقيق، تولد الثروة. ثروة تقاس بالتأثير، بالكرامة الاقتصادية، وبالقدرة على إنتاج الحلول بدل استيرادها. إنها ثروةٌ تخلق استقلالًا، لا تبعية. فالمعادلة الذهبية خريطة طريق: معرفةٌ تصنع الفكرة، ابتكارٌ يترجمها، وبيئةٌ تمنحها الجناحين. ومن هذه الجناحين، تُحلّق الأمم نحو مستقبلٍ يُقاس بعدد العقول التي قررت أن تبدأ بخربشةٍ على ورقة بيضاء... فكتبت بها قصة ثراءٍ جديدة.
ولفهم هذه السلسلة المتكاملة التي تبدأ بشرارةٍ فكريةٍ وتنتهي بمشروعٍ يُضيء واقع الاقتصاد، كان لا بد من تتبّع مسارها في محطاته المتتابعة، حيث تتقاطع النظرية مع التطبيق، والفكرة مع التجسيد، والطموح مع التحدي. من مجتمع المعرفة الذي يؤسس للوعي الاقتصادي الجديد، إلى الشرارة الأولى التي تولد من رحم الإبداع، مرورًا بـ الجامعة كمهدٍ للابتكار ومنصةٍ لتخريج الأفكار، ثم إلى البيئة الحاضنة التي تمنح المشاريع الدعم والتشريعات، وصولًا إلى التجربة الجزائرية التي تكشف ملامح الواقع بما فيه من فرصٍ وعقبات، وانتهاءً بـ صوت الميدان داخل الحاضنات، حيث تُختبر الأفكار وتتحوّل من مخططاتٍ أكاديمية إلى شركاتٍ ناشئة تنبض بالحياة. ومن هنا، تتوزع عدسة التحليل بين الخبراء والممارسين الذين قدّموا قراءاتهم العميقة لمسار الريادة، كلٌّ من زاويته الخاصة، في محاولةٍ لرسم صورةٍ شاملةٍ عن كيف تُصنع الثروة في زمنٍ يحتاج إلى عقولٍ تعرف من أين تُستخرج الأفكار.

بناء الاقتصادات الحديثة بات مرهونًا بمدى قدرة المجتمعات على إنتاج المعرفة واستثمارها، فـ"مجتمع المعرفة" أصبح أساسًا راسخًا لاقتصادٍ يولد من رحم الفكرة ويزدهر بتفاعل العقول. ضمن هذا السياق، يسلّط الأستاذ ميلودي محمد، أستاذ محاضر بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، الضوء على "مجتمع المعرفة كأساس لاقتصاد المعرفة"، محللًا كيف يمكن للمجتمع أن يتحوّل من مستهلكٍ للمعرفة إلى منتجٍ لها، ليحصد الاقتصاد ثمار الفكر والابتكار

بقلم: ميلودي محمد - أستاذ محاضر بجامعة عمار ثليجي الأغواط
اقتصاد العقول.. السلاح السياسي الجديد في سباق الأمم الكبرى
تعتبر المعرفة أداة قوة وسيطرة الدول مثل واقع الولايات المتحدة الامريكية والدول المتقدمة الأخرى حيث يرى أحد المفكرين وهو فرانسيس بيكون إن المعرفة هي القوة، بمعنى أنه ربط اكتساب المعرفة بالقوة والسيطرة أي من يملك المعرفة يملك القوة، وغياب المعرفة يساهم في الفقر والتخلف؛ حتى أنها أصبحت رأس مال معرفي مثلها مثل رؤوس الأموال الأخرى؛ والتكنولوجيا الحديثة ساعدة وساهمة في سهولة انتقال المعرفة وانتشارها، والانسان لكي يكون صانعا ومصدرا للمعرفة عليه بالعلم والتعلم.
من الموجة الزراعية إلى الموجة الذكية... رحلة تطوّر المجتمعات نحو المعرفة
ظهر نتيجة تطور المجتمعات وتغيره، وتوجد دراسات كثيرة وآراء حول هذه الموضوع وأهمها دراسة المفكر ألفن توفلر بأن مظاهر مجتمع المعلومات نجدها في مرحلة حضارية من تاريخ المجتمعات يسميها "بالموجة الثالثة"، إذ يقسم تاريخ الحضارة إلى ثلاث موجات:
تمثل الموجة الأولى سيطرة الزراعة والصيد، ويمكن اعتباره مجتمع زراعي؛ وتمثل الموجة الثانية سيطرة الصناعة، وظهرة مع الثورة الصناعية وهو مجتمع صناعي؛ أما الموجة الثالثة فتشكل المعلومات مادتها الأولية والأساسية، وتعزز تكنولوجيا المعلومات حياة الأفراد في هذه المرحلة وهو مجتمع المعرفة. وهناك مفكرين أضافوا موجات أخرى: الموجة الرابعة: وهو مجتمع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وبدأت مع الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالاعتماد على الخوارزميات والتعليم الآلي والروبوتات.. وترتكز على الأتمتة والمدن الذكية والأنظمة الذاتية أما الموجة الخامسة: فهو مجتمع ما بعد المعرفة وترتكز على الاستدامة والذكاء العاطفي والحوكمة الأخلاقية، بحيث يعتبرون أن المعرفة غير كافية بل لابد لها من توظيف الأساليب الأخلاقية والإنسانية. ومجتمع المعرفة يعد نتاج الموجة الثالثة ويعتبر الأساس للانتقال إلى الموجات الأخرى
مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة... شراكة لا انفصال بينها
يقصد بمجتمع المعرفة بأنه: ذلك المجتمع الذي يقوم بنشر وإنتاج وتوظيف المعرفة في المجالات الاجتماعية، بهدف تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة ويعتمد على التعليم والبحث العلمية وتكنولوجيا المعلومات؛ بينما اقتصاد المعرفة فيقصد به: ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة عن طرق اكتساب ونشر وإنتاج وتوظيف المعرفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ وعليه نرى أنه هناك ترابط وتكامل بينهما حيث لا يمكن بناء اقتصاد المعرفة دون وجود مجتمع معرفي يشجع على الابداع والابتكار، وينمى العقول البشرية كما أن اقتصاد المعرفة يوفر الحوافز والفرص لتوظيف الابداع والابتكار وهما يساهمان في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رأس المال البشري والمعرفي، بالإضافة إلى أن مجتمع المعرفة يسرع التحول الرقمي بينما اقتصاد المعرفة يستثمر فيه لتحقيق النمو.
أبعاد متعددة لمجتمع المعرفة... خارطة طريق نحو بيئة حقيقية للابتكار
هناك عدت أبعاد نذكر منها:
- بعد معرفي قائم على المعرفة: وذلك من خلال انتاج وتداول وتوظيف المعرفة حيث يشمل التعليم والبحث العلمي والابتكار والابداع، ويمكن قياسه بجودة التعليم وعدد الباحثين وعدد المنشورات البحثية.
- بعد اقتصادي قائمة على اقتصاد المعرفة: حيث أن المعرفة هي السلعة أو المصدر الأساسية للقيمة المضافة، أي أن المجتمع الذي ينتج المعرفة ويستعملها في نشاطاته المختلفة هو مجتمع قادر على المنافسة وأصبح اقتصاد المعرفة مصدر أساسي للثروة في مجتمع المعرفة.
- بعد تنموي قائم على التنمية الانسانية والمستدامة: وذلك على اعتبار أن المعرفة سبيل لتحقيق التنمية الإنسانية والمستدامة، كما أنه لا وجود لتنمية بشرية بدون تنمية معرفية؛
- بعد معلوماتي قائم على تكنولوجيا المعلومات: يمكن اعتبار أن المعلومات هي الأساس القائم عليه مجتمع المعرفة، وثمة ارتباط بين المعلومات والمعرفة وذلك أن تكنولوجيا المعلومات تساعد في الانتقال من المعلومات إلى المعرفة، كما يسهل الوصول إلى المعرفة ونشرها؛
- بعد سياسي: تقوم على مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات ممثلة في مجموعة من الأساليب الإدارية والأدوات التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في تنظيم المعرفة، كما يركز على السياسات العامة التي تدعم المعرفة والابتكار، ويشمل الحوكمة الرقمية، الشفافية، البيانات المفتوحة، وتقاس بمدى دعم الدولة للبحث العلمي وريادة الأعمال؛
- بعد أخلاقي: التشريعات تساعد في حماية الإنتاج المعرفي، عن طريق القوانين التي تساعد في ذلك كقانون التعامل الالكتروني، وقوانين تداول المعلومات لضمان سلامة المعلومات من القرصنة؛
- البعد التعاوني الدولي والإقليمي: وذلك عن طريق تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات والندوات، وبناء مشروع موحد لشبكة المعلومات الإقليمية والعربية؛
- البعد الاجتماعي والثقافي: ويكون عن طريق مشاركة المجتمع في انتاج واستهلاك المعرفة، ويشمل الثقافة الرقمية، التعليم مدى الحياة، والمشاركة المجتمعية، وتقاس بدرجة الوعي المعرفي والانفتاح على التغيير ومستوى العليم العام.
كل هذه الأبعاد وغبرها تساعد في بناء بيئة حقيقية للابتكار وذلك من خلال توفير بيئة داعمة تساعد في الاستثمار في التعليم ويكون ذا جودة عالية، وتشجيع البحث العلمي والابداع في مختلف المجالات، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعات، وحماية الملكية الفكرية لتشجيع الابتكار، والاستثمار في القدرات البشرية من خلال تدريب وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التعليم المستمر، كما لابد من تشجيع الثقافة الابتكارية والترويج له من خلال تشجيع الابداع والابتكار في المجتمع، كما لا ننسى الدعم المالي.
مجتمع المعرفة... حجر الأساس لبناء اقتصاد قائم على الابتكار
كما قلنا آنفا أنه لا يمكن اقامة اقتصاد المعرفة دون وجود مجتمع قائم على المعرفة، لأنها البيئة الحاضنة التي تنتج وتغذي اقتصاد المعرفة، الذي يحوّل المعرفة إلى قيمة إنتاجية واقتصادية، ويكمن الرابط بينهما من خلال:
- أن المعرفة هي الأساس الذي يوفره مجتمع المعرفة لاقتصاد المعرفة وذلك من خلال انتاج ونشر وتوظيف المعرفة وهي الأساسيات لبناء اقتصاد المعرفة؛
- كما أن مجتمع المعرفة يشجع على الابتكار الذي هو محرك رئيسي لاقتصاد المعرفة؛
- كما أن استخدام التكنولوجيا في مجتمع المعرفة يساهم في دعم اقتصاد المعرفة؛
- مجتمع المعرفة هي بيئة داعمة ومشجعة على التعليم والابتكار تساهم في نجاح اقتصاد المعرفة.
ويؤثر مجتمع المعرفة على اقتصاد المعرفة من خلال توليد المعرفة عن طريق البحث والتطوير، ونشر المعرفة بين الأفراد والمنظمات مما يعزز اقتصاد المعرفة، ويساهم في تعزيز المنافسة الاقتصادية من خلال الابتكار والتطوير والابداع؛ كما أن اقتصاد المعرفة لا يمكن بنائه في أرضية هشة لمجتمع المعرفة لأنه ينتج عنه مخاطر منها: انتاج المعرفة دون اشراك المجتمع وغياب التفاعل معه، تفوت في الوصول إلى المعرفة مما ينتج فجوة معرفية بين الأشخاص والمناطق...
ومما سبق يمكن القول إن مجتمع المعرفة الأساس لبناء أي اقتصاد معرفي ناجح، فبدون مجتمع يُنتج ويستهلك المعرفة، لا يمكن تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، كما يتطلب بناء اقتصاد معرفة إصلاحات هيكلية تبدأ من المجتمع، وتنتهي بسياسات اقتصادية داعمة للابتكار والابداع، فإذا أردنا بناء اقتصاد معرفي، فعلينا بناء مجتمعا معرفيا، فالمعرفة ليست ترفا فكريا بل ضرورة وطنية ملحة.

حين تتجذر المعرفة في المجتمع، تصبح الفكرة بذرة ثروة، والعقل الخلّاق هو المصنع الأول لكل ازدهار. فقصص النجاح الكبرى لم تبدأ بأموال طائلة، بل بخربشةٍ على ورقةٍ بيضاء آمن صاحبها بقدرتها على التغيير. في هذا الإطار، تقدّم البروفيسور مانع سبرينة، أستاذة التعليم العالي، مداخلة ثرية حول "شرارة الفكرة… بداية الثروة"، تبيّن فيها كيف تتحوّل الومضة الأولى إلى مشروعٍ ضخم، وكيف تبدأ الإمبراطوريات من فكرةٍ بسيطة تُزرع بإيمانٍ وتصميم.
بقلم: البروفيسور مانع سبرينة - أستاذة التعليم العالي
قصة الثراء تبدأ بفكرة... هكذا تولد الإمبراطوريات
أن تولد فقيرا فذلك ليس خطأك، لكن أن تموت فقيرًا فذاك خيارك. فالمورد البشري لم يعد مجرد عنصر من عناصر الإنتاج، إذ أصبح مصدرًا للقوة والتميّز وتوليد الثروة، لما يملكه من معارف ضمنية وصريحة تجعل منه رأسمالًا حقيقيًا يزيد بالاستخدام ويميل للتوليد الذاتي. هذا المورد يمتلك ملكات التفكير ومكنونات المعرفة ومؤهلات الإبداع والابتكار، ما يمكّنه من التربّع على عرش التميّز وارتداء حُلّة التفرد، لتتسابق المؤسسات اليوم إلى جعله جزءًا من أصولها واستثمار طاقاته المعرفية في منتجات ابتكارية واختراعات تفردية.
تقدّم الدول ورقيها بات يُقاس بما تولّده من معارف وما تملكه من عقول مبتكرة، إذ قد تزن فكرة ابتكارية واحدة ثروة دولة كاملة، فما عاد رأس المال المادي كافيًا في ميزان التحديات. فالكفة ترجح اليوم نحو المعرفة والابتكار، والدليل شركات مثل جوجل، آبل، ومايكروسوفت، التي بلغت قمم الشهرة لا بموارد مادية، بل بعقول بشرية وأفكارٍ غيرت وجه العالم.
ومن هنا، تحوّلت اقتصادات كبرى الدول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، بعد إدراك أن من يملك المعرفة يملك القوة، ومن يملك القوة يضمن البقاء، خاصة في عالمٍ تتقادم فيه معلومة الصباح مساءً، ويُسدل الستار على اختراع الليل مع فجر اليوم التالي، ما أفرز تحديًا جديدًا تجسّد في مفهومي اليقظة المعرفية والذكاء الاقتصادي.
اقتصاد المعرفة.. حين تصبح الفكرة رأس المال الأول والطريق إلى القمة
يستمد اقتصاد المعرفة قوّته من خصوصية مورده الأساسي، المعرفة البشرية، التي تشكل حجر الزاوية في بنائه ومرتكز استدامته. فالفكر الابتكاري الإنساني هو المصدر الأول لتوليد الأفكار وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية مبتكرة، إذ لا تقوم النهضة الاقتصادية اليوم على رأس المال المادي، بل على العقل المنتج الذي يحوّل الفكرة إلى استثمار، والمعرفة إلى قيمة مضافة. فكل نشاط اقتصادي ناجح بات يعتمد على المعلومات الحديثة والأفكار الإبداعية، التي تُعدّ أساسًا للتميّز والتجديد وضمان الاستمرار والتطور في بيئة عالمية تتسارع فيها المتغيرات.
وتبرز تكنولوجيا المعلومات كأداة مركزية في هذا النموذج الاقتصادي الجديد، حيث تمكّن من تحصيل المعلومات الدقيقة، وتُنشئ شبكات اتصال فعّالة بين مختلف الأطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي، سواء كانت مؤسساتٍ أو أفرادًا. فهي البنية التحتية الرقمية التي تُسهّل انتقال المعرفة، وتربط بين المبدعين والمستثمرين والمستهلكين في دورة اقتصادية واحدة تُبنى على تبادل الأفكار لا السلع فحسب. هذه الشبكات المعلوماتية تُحوّل الاقتصاد إلى منظومة تفاعلية تتشارك فيها المعرفة كما تتداول فيها السلع.
ولا يمكن لاقتصاد المعرفة أن يزدهر دون التعلم المستمر وتطوير المهارات. فالمورد البشري المبدع لا يُكتسب جاهزًا، بل يُصنع بالتكوين والصقل، ليصبح قادرا على تحويل المعارف إلى تطبيقات عملية، والأفكار إلى ابتكارات تُحدث الفارق في السوق. فكل مهارة جديدة تُضاف إلى الفرد تمثل لبنة في صرح هذا الاقتصاد، وكل عملية تعلم تُقربه أكثر من الإبداع والإنتاجية العالية، مما يعزز قدرة الدولة والمؤسسات على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تُعدّ استمرارية الابتكار والبحث العلمي والاستثمار فيهما شرطًا رئيسيًا لضمان استدامة النشاط الاقتصادي. فاقتصاد المعرفة لا يعرف الجمود، بل يقوم على ديناميكية متواصلة تُنتج معارف جديدة، وأبحاثًا استشرافية تُحافظ على عنصر التميز وتُجدّده باستمرار. وكلما ازداد الاستثمار في البحث والابتكار، ازدادت قدرة الاقتصاد على التجدد ومواكبة التحولات التقنية، مما يجعله أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات والتغيرات المفاجئة.
في هذا الإطار، تتراجع أهمية الموارد المالية والمادية لتأخذ دورًا ثانويًا مكمّلًا، بينما تتقدّم المعرفة والفكرة الابتكارية لتصبحا رأسمال المشروع الحقيقي ووقوده الأساسي نحو القمة. فالاقتصادات التي تضع العقل في صدارة مواردها لا تحتاج إلى وفرة في الثروات الطبيعية، لأنها تصنع ثروتها بنفسها، وتخلق من كل فكرة بذرة مشروع، ومن كل مشروع قصة نجاح.
من فكرة بسيطة إلى إمبراطوريةٍ عالمية.. دروس من قصة مايكروسوفت
الفكرة الابتكارية المميزة تتحول إلى مشروعٍ عالمي ضخم حين تجد بيئة داعمة وفكرًا منتجًا ودعائم مادية مناسبة. مثال ذلك قصة شركة مايكروسوفت العملاقة التي انطلقت كفكرة صغيرة في ذهن شابين شغوفين بالحاسوب، بيل غيتس وبول ألين، اللذين ابتكرا برنامجًا بسيطًا لتزويد نظام IBM الشخصي بتقنيات جديدة. تأسست الشركة عام 1975، وسرعان ما أثمرت الفكرة شراكة استراتيجية مع شركة "ويندوز" العالمية، وأطلقت نظام MS-DOS الذي غيّر وجه التكنولوجيا. من تلك الخطوة المتواضعة، تحولت مايكروسوفت إلى واحدة من كبريات الشركات العالمية، لتُصبح قصتها درسًا خالدًا في قوة الفكرة حين تلتقي بالإصرار والتخطيط.
هذه التجربة ليست استثناء، بل نموذجًا يتكرر في عالمٍ باتت فيه الأفكار الابتكارية الصغيرة وقودًا للمشاريع الكبرى. فالتحول من ومضة فكرة إلى كيانٍ اقتصادي ضخم يستلزم مسارًا مدروسًا يجمع بين الرؤية العميقة، والتخطيط الدقيق، والالتزام الصارم بالتنفيذ. كل خطوة في هذا المسار تمثل اختبارًا لقدرة صاحب الفكرة على تحويلها إلى حقيقةٍ ملموسة.
من الفكرة إلى الريادة... خارطة طريق لتحويل الإبداع إلى مشروع ضخم
تحقيق القفزة من فكرة بسيطة إلى مشروع ريادي ضخم لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة تخطيطٍ واعٍ وتفكيرٍ عميق والتزامٍ صارم بمراحل علمية وعملية مدروسة. فكل فكرة مهما بدت مبتكرة تحتاج إلى مسارٍ واضحٍ يربط بين الحلم والواقع، وبين الإبداع والتنفيذ. هذه الرحلة تبدأ بخطوة أولى أساسية تتمثل في المسح الشامل للسوق، وفهم احتياجاته الحقيقية، وتحديد مدى ملاءمة الفكرة لإمكانيات صاحبها وطموحاته. فالمعرفة الدقيقة بمتطلبات السوق هي البوصلة التي توجه المشروع نحو الاتجاه الصحيح، وتجنّبه الوقوع في فخ الأفكار الجميلة ولكن غير القابلة للتطبيق.
ثم تأتي مرحلة دراسة الفكرة بعمق للتأكد من جدواها وفعاليتها وقابليتها للتطوير، ومقارنتها بما هو متاح في الأسواق من منتجات أو خدمات مشابهة. فالفكرة الريادية لا يكفي أن تكون جديدة، بل يجب أن تحمل قيمة مضافة واضحة تميزها عن المنافسين. هذا التحليل النقدي المبكر للفكرة يساعد في كشف نقاط قوتها وضعفها، وتحديد ما يجعلها مختلفة وقادرة على جذب المستهلك والمستثمر في آن واحد.
وفي الخطوة الثالثة، لا بد من وضع خطة تطويرية متكاملة تجسّد الفكرة على أرض الواقع ضمن إطارٍ علميٍّ وعمليٍّ مدروس. تتضمن هذه الخطة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتقدير التكاليف المالية، وتحديد مراحل التنفيذ بدقة، مع الحرص على أن تواكب الفكرة مستجدات السوق والتطورات التقنية. فكل مشروع كبير بدأ بخطة صغيرة، لكن محكمة، تُترجم الطموح إلى خطوات قابلة للقياس والمتابعة.
وبعد اكتمال دراسة الجدوى، تُطرح مسألة التمويل والدعم بوصفها عنصرًا حاسمًا في رحلة المشروع. إذ ينبغي تحديد مصادر التمويل المناسبة، سواء كانت شخصية أو مؤسساتية، والبحث عن برامج دعم أو شراكات محتملة يمكن أن توفر المساندة المالية اللازمة. فغياب التمويل لا يعني توقف المشروع، بل يستدعي الإبداع في إيجاد البدائل وتوسيع دائرة العلاقات لجذب المستثمرين القادرين على رؤية إمكاناته.
وتُعدّ التكنولوجيا الحديثة ركيزة أساسية في مرحلة التجسيد، إذ تُسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع تنفيذ المشروع وتطويره، وتمنحه أدوات أكثر دقة ومرونة للتعامل مع السوق. فكل مشروع ريادي في العصر الحالي يحتاج إلى قاعدة رقمية قوية، سواء في التسيير أو التسويق أو التواصل مع العملاء، مما يجعل من التكنولوجيا حليفًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه.
كما يشكل تكوين فرق العمل المبتكرة نقطة تحول رئيسية في مسار الفكرة، إذ لا يمكن لأي مشروع أن ينجح بجهد فردي. فالفريق المصغّر المتكامل، الذي يمتلك المعرفة والخبرة وروح المبادرة، هو القلب النابض الذي يمنح المشروع طاقته وقدرته على الاستمرار. هذه الفرق لا تُدار بالإكراه بل بالتحفيز، وتعمل بروحٍ جماعية تترجم الرؤية إلى واقعٍ عمليٍّ ناجح.
وفي مرحلة لاحقة، تبرز أهمية الترويج والتشهير بالمشروع بطريقة مدروسة وجاذبة، تُوصل فكرته ومخرجاته إلى المستهلك والمستثمر والداعم في آن واحد. فالتسويق ليس مجرد إعلان، بل هو فن إيصال الرسالة الصحيحة إلى الجهة المناسبة في الوقت المناسب. وكل مشروع يُحسن عرض فكرته أمام الجمهور يزيد من فرص دعمه وتبنيه وتوسّعه في السوق.
وفي نهاية المطاف، يظل رائد الفكرة الابتكارية هو العنصر الحاسم في نجاحها. فالشخصية القيادية المرنة، التي تمتلك روح التحدي وتقبل المخاطرة، وتؤمن بقدرتها على خلق الفرصة بدل انتظارها، هي القادرة على نقل المشروع من الفكرة إلى الريادة. مثل هؤلاء لا يعرفون الخسارة، لأنهم يعتبرون كل تجربة خطوة نحو النجاح، وكل عثرة درسًا يفتح الطريق نحو القمة.

الأفكار مهما بلغت روعتها تحتاج إلى حاضنةٍ علميةٍ تُنبتها، وفضاءٍ أكاديمي يزوّدها بالأدوات والمنهجية. هنا، تبرز الجامعة كأول منصةٍ لتجريب الفكرة، وصقل المهارة، وربط البحث العلمي بريادة الأعمال. فبين مدرجات الدرس ومخابر البحث، تتشكّل ملامح المشاريع الناشئة. في هذا السياق، تتطرق الدكتورة عثمان حاج نور محاسن، أستاذة متخصصة في الاقتصاد، الى "الجامعة… مهد الابتكار وريادة الأعمال"، موضحةً كيف يمكن للفكرة الأكاديمية أن تتطوّر إلى منتجٍ قابلٍ للتسويق، وكيف يمكن للجامعة أن تكون فاعلًا اقتصاديًا لا مجرد مؤسسة تعليمية.

بقلم: الدكتورة عثمان حاج نور محاسن - أستاذ متخصص في الاقتصاد
البحث والربح.. الجامعات تدخل زمن الاقتصاد الذكي
ريادة الأعمال المؤسسية تمثل مدخلًا إداريًا حديثًا يقوم على توظيف الأبعاد الابتكارية والإبداعية داخل المؤسسات من أجل خلق فرص جديدة واستثمار الموارد بطرق غير تقليدية، يصعب على المنافسين فهمها أو تقليدها. فهي ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل منظومة فكرية وسلوكية تُحوّل بيئة العمل إلى فضاءٍ منتجٍ للأفكار والمبادرات، وتسهم في بناء ميزة تنافسية مستدامة تُعزّز مكانة المؤسسة في السوق.
جوهر هذا المفهوم يكمن في القدرة على بناء شيءٍ من لا شيء، أي تحويل الموارد البسيطة إلى قيمة مضافة عبر الحسّ بالفرص واستشرافها في الوقت المناسب، حتى وإن بدت في نظر الآخرين غامضة أو متناقضة. وتستند ريادة الأعمال المؤسسية إلى أربعة أبعاد أساسية هي: الابتكار بوصفه روح المبادرة، والتفرّد كعلامة تميّز في السوق، والمبادأة كقدرة على السبق لا التقليد، والمخاطرة المحسوبة التي توازن بين الطموح والواقعية، لتجعل من المؤسسة كيانًا رياديًا قادرًا على التجدّد والنمو المستدام.
مميزات المشاريع الريادية.. حين تتحول الفكرة إلى منظومة نجاح متكاملة
تتميّز المشاريع الريادية بقدرتها على كسر الأنماط التقليدية وتجاوز الأنظمة القديمة التي تعيق التطوّر، إذ تسعى إلى استبدال التقنيات البالية بأخرى حديثة تُوفّر الوقت والجهد وتُقلّل التكاليف، مما يسمح للفريق بالتركيز على جوهر العمل والإنتاجية. هذا التوجّه نحو التحديث المستمر لا يهدف فقط إلى تسريع وتيرة الأداء، بل إلى خلق بيئة ديناميكية تستجيب للتغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية، ما يجعل المشروع أكثر استعدادًا للمنافسة والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي.
كما تنفرد هذه المشاريع بامتلاكها هدفًا واضحًا ومحددًا يشكّل البوصلة التي تُوجّه كل الجهود، مع مساحة واسعة للأفكار الجديدة التي تُعزّز هذا الهدف وتغذّيه برؤى مبتكرة. فالمشاريع الريادية لا تكتفي برسم مسارٍ ثابت، بل تُتيح للمشاركين فيها حرية التفكير خارج الأطر التقليدية، مما يُنتج حلولًا غير مسبوقة ويخلق فرصًا جديدة للنمو. وضوح الهدف مع مرونة التفكير يشكلان معًا مزيجًا متوازنًا يضمن السير بثقة نحو تحقيق النتائج المرجوة.
ومن بين أبرز ملامح المشروع الريادي أيضًا وجود رؤية استراتيجية واضحة ومخططٍ دقيقٍ لتحويل الأهداف إلى واقع ملموس. فالرؤية ليست شعارات تُرفع، بل خارطة طريق تحدد الاتجاهات الكبرى وتُترجم الأهداف إلى خططٍ عملية قابلة للقياس والتنفيذ. هذا التخطيط المسبق يُمكّن المشروع من التعامل مع التحديات بمرونة، واستثمار الموارد بأعلى كفاءة، وضمان أن كل خطوة تقود نحو الغاية المنشودة دون هدرٍ للجهد أو الزمن.
كما أنه لا يمكن لأي مشروع ريادي أن ينجح دون قيادة كفؤة تمتلك روح المبادرة والقدرة على الإلهام. فالقائد الريادي ليس مجرّد مديرٍ إداري، بل ربان يمتلك الرؤية، ويقود الفريق نحو الإبداع، ويحفّزه على تجاوز العقبات بثقةٍ وحكمة. هذه القيادة تشكّل العمود الفقري للمشروع، لأنها تجمع بين المهارة التنظيمية والرؤية المستقبلية، وتضمن أن تظل كل الجهود منسجمة وموجّهة نحو تحقيق النجاح والاستدامة.
عندما تتحول القاعات إلى منصات ابتكار.. والجامعة إلى حاضنة للأفكار الريادية
تُصبح الجامعة بيئة خصبة لريادة الأعمال عندما تُدرك أن طلابها وباحثيها ليسوا مجرد متلقين للمعرفة، بل يمثلون مصدرًا حيًا للفكر الإبداعي والطاقة الابتكارية. فالإيمان بأن هؤلاء الشباب يمتلكون القدرة على تحديد المشكلات وصياغة حلول جديدة هو الخطوة الأولى نحو بناء منظومة جامعية تُنتج الأفكار بدل أن تستهلكها، وتُحرّر الطاقات الكامنة داخل القاعات والمخابر لتتحول إلى مشاريع قادرة على صناعة الفارق في السوق والمجتمع.
كما تتعزّز هذه البيئة حين تتوافر العقول المبدعة والباحثون الجادّون الذين يتناولون القضايا بعُمقٍ ومسؤولية، ويعتمدون منهج التفكير النقدي والتحليلي بدل التكرار والاجترار. فوجود نُخب علمية تمتلك روح المبادرة والبحث الحقيقي يجعل الجامعة فضاءً للابتكار لا مجرد مؤسسة تعليمية، حيث تتحول الأفكار إلى فرضيات، والفرضيات إلى تجارب، والتجارب إلى مشاريع واقعية. بهذا المعنى، يصبح كل بحثٍ علميٍّ بذرة مشروع، وكل محاضرة ورشة تفكيرٍ في حلٍّ ممكنٍ لمشكلةٍ قائمة.
ويُعدّ إيمان الجامعة بدورها في ترقية البحث العلمي أحد أهم ركائز التحوّل نحو الريادة، إذ إن دعم البحث لا يعني تمويله فحسب، بل توفير بيئة محفزة ومشجعة، تكرّم الباحث وتحتضن مجهوده، وتُتيح له أدوات العمل الحديثة. فكل جامعة تؤمن بأن المعرفة طريق التنمية تُصبح مركزًا للإبداع، وكلما زادت ثقة الجامعة في قدرات طلابها وباحثيها، زاد عطاؤهم في تحويل أفكارهم إلى حلولٍ عملية ومشاريع إنتاجية.
ولا يمكن لأي منظومة ريادية جامعية أن تزدهر دون بنية تحتية معرفية وتقنية متكاملة. فالمختبرات ومراكز البحث وورش العمل التدريبية تُشكّل أساسًا لا غنى عنه لتطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق. كما تسهم الجامعة من خلال بناء فرق عملٍ متكاملة من طلابٍ ذوي اختصاصات مختلفة في تعزيز روح التعاون، ما يفتح الباب أمام أفكارٍ مشتركة تجمع بين الإبداع العلمي والمعرفة الإدارية والمهارات التقنية، وهو ما يشكّل نواة حقيقية لأي مشروع ريادي ناجح.
تتكامل هذه المنظومة حين تُتيح الجامعة جسور تواصلٍ فعّالة مع السوق والمستثمرين، مستثمرةً شبكتها الواسعة من العلاقات لتسهيل وصول الباحثين إلى مصادر التمويل والخبرة. هذا الانفتاح على العالم الخارجي، إلى جانب غرس ثقافة المبادرة وتشجيع المخاطرة المحسوبة، يُحوّل الجامعة إلى بيئة حقيقية للريادة، حيث تُولد المشاريع من رحم الأفكار، وتُصقل بالعِلم والتجريب، ثم تنطلق نحو السوق بثقةٍ ووضوح رؤية.
من الأدراج إلى الأسواق.. هكذا يتحول البحث الأكاديمي إلى مشروع ريادي حيّ
يبدأ ربط البحث الأكاديمي بريادة الأعمال حين تتبنى الجامعات سياسات واضحة تدعم الابتكار وتحوّل المعرفة إلى قيمة اقتصادية. فحين تتكامل استراتيجيات الجامعات مع برامج التنمية الاقتصادية، وتُدعَم بسياسات حكومية موجهة نحو تمويل المشاريع الإبداعية، يتحول البحث العلمي من نشاطٍ نظري إلى محرّك عملي يُسهم في زيادة عدد المشاريع الريادية ويعزّز مكانة الجامعة كرافعة للتنمية.
كما يتطلب هذا التحوّل تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاع الأعمال، من مؤسسات اقتصادية وشركات استثمار ورأس مالٍ مغامر، بحيث يُموَّل البحث العلمي وفقًا لاحتياجات السوق ويُوجَّه نحو إنتاج حلولٍ قابلة للتسويق. هذه الشراكات لا توفر التمويل فحسب، بل تفتح أيضًا قنواتٍ لتبادل الخبرات وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات تواكب متطلبات العصر
وفي هذا الإطار، تُعدّ برامج تدريب طلاب الدراسات العليا خطوة حاسمة في بناء عقلية ريادية داخل الأوساط الأكاديمية، من خلال تلقينهم مهارات تحويل أفكارهم البحثية إلى مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الباحث والجامعة والدولة معًا. هذه البرامج تُغرس في الطالب روح المقاول الباحث، الذي يرى في بحثه مشروعًا اقتصاديًا لا مجرد رسالة علمية.
كما يُسهم بناء جسور تواصل فعالة بين الطلاب والمستثمرين والموجهين في خلق بيئة ريادية متكاملة، حيث يتلقى الباحث دعمًا عمليًا من خبراء القطاع الخاص، ويتعلّم كيفية تقديم فكرته بلغة السوق والمستثمرين، مما يُسهّل انتقالها من المختبر إلى حاضنة الأعمال ثم إلى السوق.
ولتشجيع الابتكار، يجب أن تُطلق الجامعات مسابقاتٍ وبرامج دعمٍ موجّهة للمشاريع الهادفة، تُحفّز الباحثين على التفكير التطبيقي، وتمنحهم فرص عرض أفكارهم أمام لجان تمويلٍ وتحكيمٍ واقعية، وهو ما يُرسّخ ثقافة الريادة ويكسر عزلة البحث الأكاديمي.
لا يكتمل هذا الربط دون توفير فضاءات عمل مشتركة وحاضنات داخل الجامعات، تمكّن الطلاب والباحثين من تطوير أفكارهم ضمن بيئة عملية متكاملة. فحين يمتلك الباحث مكتبًا ومختبرًا وموجّهًا ومستثمرًا قريبًا منه، يصبح الطريق بين الورقة البحثية والمشروع الاستثماري أقصر وأكثر واقعية.
كيف تدخل الجامعة عالم ريادة الأعمال بثقة؟
حتى تتمكّن الجامعة من الانتقال من مجرد منبر أكاديمي إلى فاعل اقتصادي في سوق ريادة الأعمال، لا بد أن تجمع بين أصالة الفكرة وقوة التنفيذ. فالابتكار هو الخطوة الأولى في هذا التحول، إذ ينبغي أن تكون مشاريع الباحثين والأكاديميين قائمة على أفكار جديدة وغير تقليدية، تُقدّم حلولًا واقعية لمشكلات قائمة وتلبّي حاجات حقيقية في السوق. ولا يكتمل هذا المسار دون التركيز على جودة المنتج أو الخدمة، والتسويق الفعّال الذي يضمن بناء سمعة تنافسية، تجعل الجامعة قادرة على دخول السوق لا كمراقب بل كمنافسٍ يمتلك بصمته الخاصة.
كما يتعيّن على الجامعة أن تعمل على فهم عملائها المحتملين، سواء كانوا مؤسسات اقتصادية أو فاعلين اجتماعيين أو مستهلكين مباشرين، لأن معرفة السوق المستهدف تمثل حجر الأساس في بناء أي مشروع ناجح. فالتعامل مع السوق يحتاج إلى وعي دقيق بحاجاته، وتصورٍ واضحٍ عن الفجوات الموجودة فيه، لتتمكن الجامعة من تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ تملأ تلك الفجوات وتحقق قيمة مضافة.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي مشروع جامعي أن ينجح دون خطة عمل واضحة تحدد طبيعة السوق المستهدف والميزة التنافسية التي يتمتع بها المشروع. فتميّز الفكرة لا يُقاس بجِدّتها فحسب، بل بقدرتها على التفوّق على المنافسين في الجودة أو السعر أو سرعة التنفيذ. كما أن تحليل المنافسة ورصد الفرص المتاحة يمنح المشروع رؤية واقعية تُمكّنه من التكيّف مع متغيرات السوق وتحديد أفضل نقاط الدخول إليه.
ويجب أن تتضمن خطة العمل أيضًا هيكلًا ماليًا وتشغيليًا متكاملًا يوضّح كيفية تحقيق الإيرادات، وتأمين الموارد المالية اللازمة للإطلاق، وتقدير تكاليف التشغيل والتسويق، وتحديد مراحل تطوير المنتج. فالتخطيط المالي السليم لا يضمن فقط استدامة المشروع، بل يوفّر ثقةً أكبر لدى الشركاء والممولين، ويُظهر أن الجامعة قادرة على الجمع بين الرؤية الأكاديمية والانضباط الاقتصادي.
كما أن نجاح الجامعة في دخول السوق يعتمد على قدرتها على بناء فرق عمل متكاملة تجمع بين الكفاءات العلمية والمهارات التقنية والإدارية، من البحث والتطوير إلى الإنتاج والتسويق. فالفريق المتناسق هو العمود الفقري لأي مشروع ناجح، شرط أن يملك كل فرد فيه وعيًا بدوره وإيمانًا بمسؤولياته ضمن رؤية مشتركة تسعى لتحقيق هدفٍ واحد.
لا بد من التركيز على تأمين التمويل والمرونة في التسيير، إذ إن التحديات السوقية تفرض استعدادًا دائمًا للتكيف مع المتغيرات وتقبّل الأخطاء والتعلّم منها. فالمشاريع الجامعية لا تنجح بالخطط الجامدة، بل بالقدرة على التعديل والتطوير المستمر، بما يضمن مواجهة المفاجآت واستثمار الفرص الجديدة، وتحويل التجارب إلى دروسٍ تُعزز الأداء وتُقرّب الجامعة أكثر من تحقيق حضورٍ حقيقي وفعّال في عالم ريادة الأعمال.

الطريق من الفكرة إلى السوق لا يمرّ فقط عبر المعرفة، بل يحتاج إلى بيئةٍ حاضنةٍ تمنح المبتكر الأمان، وتوفّر له الدعم المادي واللوجستي، وتؤمن بأن الخطأ ليس فشلًا بل خطوة نحو النضج. وبين من يحتضن الفكرة ومن يُهملها، تتحدد مصائر المشاريع. وهنا يطرح الدكتور رضوان عباسي، الباحث في مجال المناجمنت وريادة الأعمال، سؤالًا محوريًا ضمن محور "بيئة حاضنة… من منصة انطلاق إلى مقبرة أفكار"، متسائلًا بعمق: من يحتضن الحاضنة؟، في محاولةٍ لتشخيص واقع البيئات الريادية عالميًا، واستخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها محليًا.

د. رضوان عباسي - باحث في مجال المناجمنت وريادة الأعمال
سؤال النجاح في ريادة الأعمال.. من يحتضن الحاضنة؟
يعتبر الأستاذ رضوان عباسي، الباحث في ريادة الأعمال، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أن الحاضنة تعد حلقةٌ ضمن نظامٍ بيئيٍّ متكاملٍ يشكّل الأكسجين الحقيقي لأي فكرةٍ تسعى إلى الحياة. ويؤكد أن النجاح في تحويل الحاضنات إلى مصانعٍ للمشاريع الريادية لا يتحقق إلا حين تُحتضن هي الأخرى داخل بيئةٍ مرنةٍ ومتكاملةٍ، تتفاعل فيها الجامعات مع المستثمرين، والقوانين مع العقول، والقطاعان العام والخاص مع روح الابتكار. فالحاضنة، كما يقول، قد تكون جسرًا يربط الفكرة بالسوق، وقد تتحول إلى فخٍّ بيروقراطي يخنقها، والفرق بين الحالتين تصنعه المنظومة التي تعمل فيها، لا الفكرة التي تبدأ بها.
يرى الأستاذ في ريادة الأعمال، رضوان عباسي، أن المشكلة في عالم ريادة الأعمال ليست في ندرة الأفكار، بل في البيئة التي تُمنح لها. فالفكرة، مهما كانت عبقرية، لا تملك القدرة على الحياة إن لم تجد الأكسجين اللازم لتتنفسه. من هنا، تظهر أهمية الحاضنات كمحطات انطلاقٍ أساسية نحو السوق، غير أنّها في كثيرٍ من الأحيان تنقلب إلى فخّ بيروقراطي يُنهك المبتكر بدل أن يمكّنه. فبدل أن تكون الحاضنة جسرًا يُوصل الفكرة إلى مرحلة التنفيذ، تتحول في بعض النماذج إلى متاهةٍ إدارية تُهدر الوقت والطاقة، وتُفرغ الفكرة من زخمها الإبداعي.
ووفق عباسي، المفهوم الحقيقي للحاضنة يتجاوز فكرة المكتب أو البرنامج التدريبي المحدود، ليشمل دورها كحلقةٍ داخل منظومة أوسع تُعرف باسم “النظام البيئي الريادي”. هذا النظام لا يقوم على جهةٍ واحدة، بل هو شبكة مترابطة من الفاعلين: رواد الأعمال، المستثمرين، الجامعات، المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. كل عنصرٍ فيها يشكّل خيطًا ضمن نسيجٍ معقّد يضمن تدفق الأفكار وتحوّلها إلى مشاريع منتجة. ومن دون هذا التكامل، تفقد الحاضنة معناها وتتحوّل من بيئة مساعدة إلى عبءٍ إضافي على كاهل الرياديين.
ويشير إلى أن الحاضنة، في جوهرها، ليست كيانًا مكتفيًا بذاته، وإنما كائنًا يحتاج إلى بيئة أكبر تحتضنه هو الآخر. فإذا كانت الحاضنة مسؤولة عن احتضان الفكرة وتمكينها من النمو، فإنّها بدورها تحتاج إلى من يحتضنها ضمن منظومةٍ اقتصادية مرنة ومتعاونة. ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بمدى توفر الحاضنات، بل بمدى قدرتها على العمل داخل شبكةٍ حية تتفاعل مع جميع المكونات، وتوفّر التمويل، والتشريعات، والتدريب، والتسويق، في وقتٍ واحد.
ويضيف عباسي أن المفارقة الكبرى بين الحاضنات الناجحة وتلك التي تفشل في إخراج مشروع واحد ناجح تكمن في مدى المرونة والتكامل داخل البيئة المحيطة بها. ففي النماذج المتقدمة، لا تعمل الحاضنة بمعزلٍ عن السوق أو الجامعة أو المستثمرين، بل تنسج علاقات تفاعلية مع كل الأطراف. أما في البيئات الأقل نضجًا، فغالبًا ما تكون الحاضنة هيكلاً إداريًا جامدًا يخضع لقوانين معقّدة ويُنظر إليه كبرنامجٍ رسمي أكثر من كونه أداةً ديناميكية. النتيجة واضحة: الأفكار تبقى حبيسة القاعات والاجتماعات، وتختنق قبل أن تجد طريقها إلى السوق.
ويخلص الخبير إلى أنّ النجاح في تحويل الحاضنة إلى جسرٍ حقيقي نحو السوق يتطلب تغييرًا في الفلسفة قبل الآليات. فالحاضنة ليست مشروعًا مؤسساتيًا فحسب، وإنما رؤيةٌ تؤمن بأن الأفكار الصغيرة قد تحمل في طيّاتها مشاريع وطنية كبرى. ومن دون هذه الرؤية، تتحول الحاضنات إلى غرف انتظارٍ طويلة لا تغادرها الأفكار. وعليه، فإن إصلاح بيئة ريادة الأعمال يبدأ من تحرير الحاضنات من قبضة البيروقراطية، ومنحها صلاحياتٍ ومساحاتٍ حقيقية لتكون جسور عبور، لا فخاخًا تُغرق المواهب في رمالٍ إدارية متحركة.
وصفة النجاح العالمية.. تكامل العقول مع رأس المال والقانون
كما يرى الأستاذ رضوان عباسي أن أي بيئة حاضنة مثالية لا يمكن أن تقوم على عنصرٍ واحد، بل على مزيجٍ متكامل من المكونات التي تتفاعل في ما بينها وفق منطقٍ يشبه "الوصفة العالمية". هذه الوصفة لا تخضع للجغرافيا أو الثقافة، بقدر ما تعتمد على إرادةٍ مشتركة تجمع بين العقول المبدعة، ورأس المال المغامر، والتشريعات المرنة، والمؤسسات الأكاديمية، في منظومةٍ متناغمة تتقاطع فيها المصالح والرؤى. فنجاح الحاضنات نتاج ثمرة لتصميمٍ بيئيٍّ واعٍ يُعيد تعريف العلاقة بين الفكرة والسوق، وبين المبتكر والمستثمر، وبين الجامعة والحكومة.
ويُؤكد عباسي أن رواد الأعمال والأفكار الريادية يشكّلون نقطة الانطلاق لأي نظامٍ بيئي ناجح، إذ يحملون الشغف والجرأة والرغبة في المخاطرة، وهي عناصر لا يمكن تعويضها بأي تمويلٍ أو هيكل إداري. هؤلاء الرواد هم الوقود الذي يُشعل ديناميكية السوق ويخلق الحلول الجديدة. غير أنّ شجاعتهم تحتاج إلى دعمٍ مادي ومعنوي، وهنا يأتي دور المستثمرين الذين يضخّون "رأس المال الجريء" باعتباره الوقود الذي يحوّل الخيال إلى منتجٍ تجاري. فالتمويل في البيئات الريادية رهان على المستقبل، وشراكة في بناء اقتصادٍ جديد لا يعتمد على الموارد التقليدية.
ويُضيف أن الحكومة والقطاع العام يمثلان الضمان المؤسسي لهذه المنظومة، عبر وضع تشريعاتٍ محفّزة وسياساتٍ مبسطة تجعل من تأسيس الشركات عملية سهلة وسريعة، بدل أن تكون معركة بيروقراطية تُرهق أصحاب الأفكار. كما تبرز الجامعات ومراكز البحث كمصدرٍ دائم للأفكار والمواهب، إذ تُحوّل البحث العلمي من غايةٍ أكاديمية إلى وقودٍ اقتصادي. فكل جامعة تفتح مختبراتها للتطبيق العملي تسهم في إنتاج شركة ناشئة جديدة، وكل باحثٍ يجد طريقه إلى السوق يصبح حلقة وصلٍ بين النظرية والتطبيق.
ويرى عباسي أن دور القطاع الخاص لا يقل أهمية، فهو الشريك الطبيعي لريادة الأعمال عبر فتح الأسواق أمام المشاريع الناشئة وتبني الحلول المبتكرة في سلاسل إنتاجه. أما المؤسسات الداعمة الأخرى – مثل مراكز الأبحاث، المستشارين، المنظمات غير الربحية والبنوك – فهي تشكّل البنية التحتية الناعمة التي تربط بين أطراف المنظومة، وتضمن تدفق المعلومات، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات التعاون. وكلما كان هذا التكامل قويًا، ازدادت فرص خروج شركاتٍ قادرة على المنافسة والاستدامة.
ويؤكد الخبير على أن "الوصفة العالمية" ليست سرًّا غامضًا، بل منهجية واضحة أثبتت التجارب نجاحها في مختلف الدول: من وادي السيليكون في الولايات المتحدة إلى برلين وسنغافورة ولندن. العامل الحاسم في جميعها هو التكامل لا التفرد، والتعاون لا التنازع. فحيث تتكامل العقول مع رأس المال والقانون، تنشأ بيئة تزرع الثقة وتُثمر الثروة. أما حين يختل هذا التوازن، تبقى الأفكار حبيسة الورق، وتتحول الحاضنات إلى أرشيفٍ لأحلامٍ مؤجلة.
البيئة التي تحتضن الحاضنة..
ويرى الأستاذ رضوان عباسي أن الحاضنة، مهما بلغت كفاءتها، لا يمكن أن تنجح ما لم تكن بدورها محتضَنة داخل بيئة أوسع، تُؤمّن لها الدعم المؤسسي والمرونة التشغيلية والروابط الضرورية مع السوق. فالحاضنة جزء من نظامٍ بيئي أشمل، تتفاعل فيه عناصر متعددة تصنع مجتمعةً المناخ الملائم للابتكار. ومن الخطأ النظر إلى الحاضنات باعتبارها عصًا سحرية تحوّل الأفكار إلى شركاتٍ ناشئة، لأنها في جوهرها ليست سوى أداةٍ داخل منظومةٍ أكبر تحتاج هي الأخرى إلى الاحتضان والرعاية والتغذية المتواصلة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
ويُوضح عباسي أن الأنظمة البيئية الناجحة تُقاس بمدى ترابطها وتكاملها مع بقية المكونات: الجامعات التي ترفدها بالبحث والمعرفة، المستثمرين الذين يمدّونها بالتمويل، والمؤسسات الحكومية التي توفر الأطر القانونية والتشريعية المرنة. فحين تعمل كل هذه الأطراف بتناغم، تتحول الحاضنة إلى منصة انطلاقٍ حقيقية، وحين تنعزل أو تُترك دون دعم، تصبح عبئًا إداريًا ومجرد هيكلٍ تنظيمي يستهلك الموارد دون أن ينتج أثرًا اقتصاديًا ملموسًا.
ويُشير إلى أن التجارب العالمية تثبت أن النجاح لا يرتبط بالموقع الجغرافي بقدر ما يرتبط بوجود بيئةٍ حية تحتضن كل الحلقات ضمن شبكةٍ واحدة. ففي وادي السيليكون مثلًا، كان النجاح نتيجة تعايش الجامعات الكبرى مع المستثمرين المغامرين، وتعاون الحاضنات مع الشركات العملاقة، في ظلّ منظومةٍ قانونية تحفّز التجريب وتحتفي بالفشل كجزءٍ من التعلم. أما في البيئات التي تهيمن فيها البيروقراطية، وتُعطّل فيها الموافقات، وتُغيب فيها روح الشراكة، فإن الحاضنات تبقى مجرد عناوين على الورق لا أثر لها في السوق.
ويؤكد عباسي أن الحاضنة الفاعلة تشبه "كائنًا بيولوجيًا" يحتاج إلى تغذيةٍ مستمرة من بيئته، عبر تدفقاتٍ دائمة من الأفكار والتمويل والمواهب. فإذا اختنق أحد هذه التدفقات، أصيبت الحاضنة بالجمود. ولهذا، فإن بناء منظومةٍ حاضنة لا يقتصر على إنشاء الهياكل، بل يتطلب ثقافة مؤسساتية تُقدّر الابتكار، وتُكافئ المخاطرة، وتؤمن بأن الفشل محطة على طريق النجاح لا نهاية له.

في الجزائر، الميدان يبوح بأسراره الخاصة، حيث تزهر الأفكار رغم قلة الموارد، ويشقّ الشباب طريقهم وسط تحدياتٍ إداريةٍ وماليةٍ وثقافيةٍ متعددة. التجارب المحلية تشهد أن روح المقاولاتية تنبض بقوة، وأن الإبداع الجزائري لا يقلّ تميزًا، بل يحتاج فقط إلى مناخٍ يُفسح له المجال. في هذا الإطار، يتحدث إسكندر طورش، إطار وعضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لتنمية الاقتصاد والمقاولاتية، برؤية عملية عن "التجارب المحلية والواقع العملي للمقاولاتية في الجزائر"، مسلطًا الضوء على قصصٍ وشواهد تُثبت أن الطريق نحو الريادة ممكنٌ رغم العوائق.

إسكندر طورش - إطار وعضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لتنمية الاقتصاد والمقاولاتية
بين شغف الشباب وجدار البيروقراطية.. الطريق الشاق لريادة الأعمال في الجزائر
استعرض إسكندر طورش، الإطار وعضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لتنمية الاقتصاد والمقاولاتية، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، عددًا من النماذج الشبابية التي نجحت في فرض نفسها داخل الساحة الاقتصادية الوطنية، مؤكدًا أن هذه التجارب تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب الجزائري في مجال المقاولاتية، رغم ما يواجهونه من تحديات تمويلية وإدارية وتسويقية. كما قدّم قراءة تحليلية لأبرز العقبات التي تحول دون توسع المشاريع الناشئة، واقتراحات عملية لتحويل المنظمات الوطنية إلى منصات فاعلة قادرة على مرافقة رواد الأعمال ودعمهم في مسار التأسيس والنمو.
أكد إسكندر طورش، أنّ الواقع الجزائري يعجّ بنماذج شبابية استطاعت أن تكتب قصص نجاح ملهمة رغم الصعوبات. هذه النماذج، بحسبه، تثبت أنّ روح المبادرة لا تحتاج بالضرورة إلى بيئة مثالية، بقدر ما تحتاج إلى إصرار، رؤية، وقدرة على التكيّف مع التحديات. فالطريق نحو النجاح في عالم المقاولاتية ليس مفروشًا بالورود، لكنه أيضًا ليس مغلقًا أمام من يمتلك الفكرة والجرأة على تحويلها إلى مشروع حيّ.
ويضيف طورش أنّ ما يميّز هذه النماذج هو أنّها لم تنتظر دعمًا خارجيًا أو ظروفًا استثنائية، وانطلقت من إيمانها العميق بقدراتها الذاتية، وقدرتها على تحويل الأفكار إلى مؤسسات منتجة. فكل قصة من هذه القصص تحمل في طياتها دروسًا في التصميم والمثابرة، وتعبّر عن جيل جديد من الشباب الجزائري الذي لا يكتفي بالحلم، بل يسعى إلى بنائه على أرض الواقع.
ومن بين هذه النماذج، يبرز اسم يوسف بوعافية، مؤسس شركة "أوبتيموم تكنولوجي" التي تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. استطاع يوسف أن يبني شركته من الصفر، ويحوّلها إلى واحدة من أبرز الشركات الجزائرية في قطاع التقنية، بفضل إصراره على تقديم حلول مبتكرة وتنافسية في السوق المحلية. نجاحه يعكس بوضوح التحول الذي يشهده المشهد الريادي في الجزائر، حيث أصبح الشباب يقتحمون مجالات كانت سابقًا حكراً على الشركات الكبرى أو الأجنبية.
وفي ميدان مختلف تمامًا، اختارت أمينة بن عيسى أن تخوض غمار صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية من خلال شركتها "بيوتيفول بروداكتس". استطاعت أمينة أن تبني علامة تجارية جزائرية أصيلة، تجمع بين الجودة والهوية المحلية، لتفرض نفسها في السوق وتشق طريقها نحو التصدير إلى دول أخرى. هذه التجربة تمثل نموذجًا للريادة النسوية في الجزائر، وتؤكد أنّ الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات الإبداعية المرتبطة بالحياة اليومية والمستهلك المحلي.
أما محمد بودية، مؤسس شركة "إينوفا تكنولوجي"، فقد جعل من الابتكار قاعدة أساسية لمشروعه، حيث طوّر حلولاً تكنولوجية متقدمة مكنته من حصد جوائز دولية، وأثبت أنّ الريادة الجزائرية قادرة على المنافسة عالميًا. قصته تُبرز أهمية الجمع بين الموهبة التقنية والرؤية الاستراتيجية، وتؤكد أنّ الشباب الجزائري لا يفتقر إلى الكفاءات، بل إلى من يفتح له الأبواب ويمدّ له الجسور نحو الأسواق الكبرى.
ويؤكد المتحدث على أنّ هذه النماذج الثلاثة ليست سوى غيض من فيض، وأن الجزائر تزخر بعشرات القصص التي تنتظر من يسردها ويستثمر فيها. فكل نجاح جزائري هو دليل على أنّ المقاولاتية هو خيار تنموي واقعي، وأنّ بناء اقتصاد قوي يبدأ من تشجيع هذه المبادرات الشابة التي تثبت يومًا بعد يوم أنّ الحلم ممكن حين يجد الإصرار طريقه إلى العمل.
تحديات متشابكة تعرقل صعود المقاولين الشباب
ويُجمع المتابعون على أن المقاولاتية أصبحت أحد المفاتيح الرئيسة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، غير أن الطريق أمام الشباب الراغب في خوض غمارها لا يزال مليئًا بالعراقيل. وفي هذا السياق، يؤكد إسكندر طورش، الإطار وعضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لتنمية الاقتصاد والمقاولاتية، أن التحديات التي تواجه المقاولين الشباب ليست أحادية البعد، بل متعددة ومتداخلة، ما يجعل من الضروري تبني مقاربة شاملة لمعالجتها.
أولى هذه التحديات تتعلق بجانب التمويل، الذي يمثل العقبة الأبرز أمام كل فكرة طموحة. فغالبًا ما يصطدم الشباب المتخرج حديثًا من الجامعة أو المقبل على تأسيس مشروعه بشروط بنكية صعبة ومعايير تمويل صارمة تتطلب ضمانات كبيرة لا تتوفر لدى معظمهم. هذه الوضعية تُضعف من قدرة الأفكار المبتكرة على التحول إلى مؤسسات حقيقية، وتُبقي الكثير من المشاريع في مرحلة الحلم، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
أما في الجانب الإداري والقانوني، فتبرز البيروقراطية كأحد أكثر المعوقات إحباطًا للمبادرة، حيث تستغرق الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات والحصول على التراخيص وقتًا طويلاً وجهدًا مضاعفًا. كما أن نقص التوجيه القانوني والمشورة المتخصصة للأعمال الناشئة يزيد من تعقيد المشهد، ويجعل كثيرًا من رواد الأعمال الشباب يواجهون وحدهم تحديات لا يملكون لها خبرة أو أدوات كافية.
وفي الجانب الاقتصادي والتسويقي، يجد الشباب أنفسهم في مواجهة منافسة شرسة من الشركات الكبرى القائمة منذ سنوات، فضلًا عن محدودية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، ما يقلّص من فرص انتشار منتجاتهم وخدماتهم. يُضاف إلى ذلك تقلبات السوق وعدم استقرار الطلب، ما يجعل التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الناشئة أمرًا معقدًا يتطلب مرونة عالية وقدرة على التكيّف السريع.
كما يواجه المقاولون الشباب تحديات فنية وتقنية، أبرزها نقص المهارات التقنية اللازمة لتطوير المشاريع، وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والموارد التي تمكّنهم من تحديث منتجاتهم أو خدماتهم. ويُضاف إلى هذه التحديات بعد البنية التحتية، لاسيما في بعض المناطق التي لا تزال تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الطرق الجيدة، الكهرباء المستقرة، أو شبكات الاتصال السريعة، ما يحدّ من فرص توسّع المشاريع الناشئة ويدفعها إلى الانكماش بدل النمو.
ويؤكد طورش على أن هذه التحديات مترابطة، ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال حلول شاملة ومتكاملة تشارك فيها كل الأطراف: الحكومة عبر إصلاح المنظومة البيروقراطية والتمويلية، والقطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات دعم وتكوين، إلى جانب مؤسسات المواكبة التي يقع على عاتقها تأطير الشباب وتزويدهم بالأدوات العملية التي يحتاجونها لدخول السوق بثقة وكفاءة.
منظمات وطنية برؤية جديدة..
ويرى إسكندر طورش، أنّ المنظمات الوطنية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة المقاولاتية، إذا تجاوزت حدودها التقليدية كإطار تنظيمي إلى فضاء عملي يوفّر للمقاولين الشباب ما يحتاجونه من دعم وتمكين. فالدور الجديد لهذه المنظمات يجب أن يتحول من التمثيل أو التنسيق إلى رافعة تنموية حقيقية تستثمر في الطاقات الشابة وتفتح أمامها أبواب السوق.
ويؤكد طورش أنّ أول خطوة في هذا المسار هي تطوير البنية التحتية، سواء المادية أو الرقمية، عبر إنشاء مراكز دعم حقيقية للمشاريع الناشئة، تُقدّم خدمات التوجيه، التدريب، والمتابعة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل. كما يشدد على ضرورة بناء منصات إلكترونية ذكية تتيح للمقاولين الشباب عرض مشاريعهم، طلب التمويل، والحصول على الاستشارات، في بيئة رقمية متكاملة تعكس التحولات التي يشهدها العالم الاقتصادي اليوم.
أما في الجانب المالي، فيقترح طورش العمل على تنويع آليات التمويل وتحديثها، من خلال إدماج أدوات جديدة مثل التمويل الجماعي والاستثمار في رأس المال المخاطر، إلى جانب القروض والمنح الكلاسيكية. فالتمويل، في نظره، لا يجب أن يكون حاجزًا أمام الطاقات الإبداعية، بل أداة تمكينية تساعد الأفكار على النمو والتوسع، مع خلق شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص لاحتضان المشاريع الواعدة ومرافقتها في مراحلها الأولى.
ويرى طورش كذلك أنّ دعم المقاولين الشباب يتطلب الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريبية نوعية تُعزّز المهارات التقنية والإدارية، وتمكّن الشباب من أدوات التسيير الحديثة وفنون التسويق والابتكار. كما يدعو إلى بناء شبكات من الخبراء والمستشارين لمرافقة المشاريع الناشئة وتزويدها بالخبرة العملية التي تفتقر إليها في بداياتها، معتبرًا أن الخبرة الموجهة قد تكون أحيانًا أهم من التمويل نفسه.
ولا يقلّ بعد الشراكة والتعاون أهمية، إذ يشدد طورش على ضرورة نسج علاقات متينة مع القطاع الخاص، الذي يمكن أن يكون شريكًا ماليًا وتقنيًا، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الدولي للاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا. كما لا يمكن إغفال أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم القانوني للمشاريع الناشئة لضمان حمايتها واستدامتها، بالتوازي مع ترويج ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتحفيز الشباب على خوض غمار المقاولاتية بثقة.
ويختم طورش بالتأكيد على أن المنظمات الوطنية، إذا ما تبنّت هذه الرؤية الشمولية، يمكنها أن تتحول من مجرد هياكل تسييرية إلى منصات فاعلة للتمكين الاقتصادي، تخلق بيئة خصبة لولادة مشاريع مبتكرة، وتُسهم بشكل ملموس في بناء اقتصاد وطني قائم على المبادرة والمعرفة والابتكار.

إذا كانت التجارب المحلية قد أثبتت أن الفكرة يمكن أن تجد طريقها إلى النور رغم الصعوبات، فإن الحاضنات تبقى المحكّ الحقيقي الذي تُختبر فيه الأفكار، وتُصقل فيه المهارات، وتتحول فيه الأحلام إلى مشاريع واقعية. من داخل هذه الفضاءات الحيوية، تتضح ملامح الطريق بين النظرية والتطبيق، وتُسمع الأصوات التي تعرف جيدًا معنى التحدي اليومي في رحلة التأسيس. ومن هذا المنطلق، يقدّم نجم الدين بوزيد، مدير حاضنة أعمال، مداخلة عملية "من التجربة الجزائرية… دروس من داخل الحاضنات"، يكشف فيها عن كواليس الممارسة الميدانية، وما يواجهه رواد الأعمال من عقباتٍ وفرصٍ، في سبيل تحويل الفكرة إلى منتجٍ يقتحم السوق ويصنع الفارق.

نجم الدين بوزيد - مدير حاضنة أعمال بالجزائر
من الزائر إلى المستثمر.. حكاية “خدمات” في حاضنة business valley
يتحدث نجم الدين بوزيد، مدير حاضنة الأعمال business valley، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، عن التجربة الجزائرية في مجال الحاضنات من زاوية الممارسة اليومية، لا التنظير الأكاديمي، معتبرًا أن الحاضنات في الجزائر ما تزال في مرحلة البذور التي تبحث عن هوية واضحة بين الطموح والواقع. ويستعرض بوزيد من خلال تجربته العملية، أبرز التحديات التي تواجه هذه المنصات، بدءًا من البيروقراطية وضعف التمويل، وصولًا إلى غياب منطق السوق في التسيير، كما يروي قصةً مُلهِمة لفريقٍ استطاع أن يتحول من فكرة بسيطة إلى شركة ناشئة ناجحة داخل الحاضنة. ويرى أن تجاوز التحديات يتطلب تغييرًا في الفلسفة العامة نحو تمكين الحاضنات من لعب دورٍ استثماري حقيقي، مؤكدًا أن قيمتها لا تُقاس بالأموال التي تُمنح، وإنما بالخبرة، والعلاقات، والمرافقة التي تُقدَّم لتمنح الفكرة فرصة الحياة والنمو.
يرى نجم الدين بوزيد، أن التجربة الجزائرية في مجال الحاضنات ما تزال في مرحلة البذور، إذ لم تتحول بعد إلى منصات قوية قادرة على صناعة شركات ناشئة بمعايير عالمية، لكنها أيضًا ليست مجرّد نسخة بيروقراطية من الفكرة الأصلية. فالمشهد الحالي يعكس ملامح تجربة انتقالية تسعى إلى التوازن بين الطموح والواقع، بين الرغبة في احتضان الأفكار المبتكرة، والقيود الإدارية والاقتصادية التي تحدّ من انطلاقتها. ويؤكد بوزيد أن ما يحدث اليوم هو بداية لتجربة محلية تتلمّس طريقها وسط تحديات متشابكة، تحاول فيها المؤسسات تجاوز مرحلة “الهيكل الإداري” لتتحول إلى فضاءات إنتاج فعلي للابتكار.
ويُوضح أن ما يميز هذه المرحلة هو ظهور جيل من الشباب وجد لأول مرة فضاءً يُرافقه من الفكرة إلى النموذج الأولي، ويمنحه شعورًا بالانتماء إلى منظومةٍ تؤمن بقدراته. هذه الحاضنات فتحت أبوابها لعشرات المبتكرين الذين كانوا يفتقرون في السابق إلى الدعم والتأطير، فوفّرت لهم التدريب والمرافقة، وقرّبتهم من بيئة ريادة الأعمال. غير أن هذه النجاحات الصغيرة تبقى محدودة ما لم تُدعّم بآلياتٍ تمويلية واضحة، وبشبكات تسويقٍ حقيقية، إذ لا يكفي أن نزرع الفكرة في ذهن الشاب، بل يجب أن نهيئ لها السوق الذي تستقرّ فيه وتنمو من خلاله.
ويُبرز بوزيد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحاضنات الجزائرية هو ضعف التمويل وغياب الآليات المرنة لتمويل المراحل الأولى من المشاريع، وهي المرحلة التي تحتاج فيها الفكرة إلى “الأوكسجين المالي” أكثر من أي وقتٍ آخر. فغياب رأس المال الجريء وندرة المستثمرين المغامرين يجعلان من رحلة التحوّل من النموذج الأولي إلى الشركة الناشئة عملية بطيئة وشاقة. كما أن محدودية السوق المحلية تعمّق من الأزمة، إذ تظل الكثير من المشاريع محصورة داخل المختبر أو النموذج التجريبي دون أن تجد مساحة حقيقية للتوسع أو التصدير.
ويُضيف أن البيروقراطية ما تزال تشكّل عبئًا على رواد الأعمال الشباب، خاصةً حين تتحوّل الإجراءات الإدارية من وسيلة ضبطٍ وتنظيم إلى حاجزٍ يعيق الإبداع. فبطء المعاملات، وتعدد الجهات المتدخّلة، وغموض بعض النصوص التنظيمية، تُسهم في إضعاف الحافز لدى المبتكرين وتُطيل من دورة حياة الفكرة قبل الوصول إلى السوق. لذلك، يرى بوزيد أن تجاوز هذه التحديات يتطلّب إصلاحًا عميقًا للمنظومة، وتكاملًا فعليًا بين الحاضنات والمؤسسات التمويلية والجامعات والقطاع الخاص، حتى تتحول الحاضنات إلى “مصانع أفكارٍ حقيقية” بدل أن تبقى مجرد مكاتب تأطيرٍ إداري.
من زائرٍ إلى شريكٍ ممول... قصة "خدمات" التي وُلدت في حاضنة
ويرى نجم الدين بوزيد، أن قصة فريق "خدمات" تمثل واحدة من أكثر النماذج إلهامًا في مسار الحاضنات الجزائرية، إذ تُجسّد بوضوح كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى مشروعٍ رياديٍّ متكامل حين تتوفر البيئة الحاضنة والدعم المناسب. فالبداية كانت من تحدي "أوراس ميتاب"، الذي تزامن مع فعاليات باتنة إكسبو 2.0، حيث شارك الفريق لأول مرة بفكرةٍ ناشئة تهدف إلى تقديم حلولٍ خدمية متكاملة للمجتمع المحلي. ورغم تواضع الإمكانيات، استطاع الفريق أن يفرض نفسه في المنافسة، ويصل إلى المراتب الثلاث الأولى، في إنجازٍ فتح أمامه أبواب المرافقة المجانية داخل حاضنة بيزنس فالي. كانت تلك لحظة التحوّل الكبرى التي انتقل فيها الحلم من الخيال إلى التخطيط، ومن الفكرة إلى أولى خطوات التجسيد العملي.
ويضيف بوزيد أن المرحلة الثانية من مسار الفريق كانت حاسمة في رسم ملامح المشروع الريادي، فقد تطورت الفكرة داخل الحاضنة لتصبح نموذجًا أوليًا جاهزًا بالتعاون مع الشريك التقني. وفي باتنة إكسبو 3.0، عاد الفريق مجددًا، لكن هذه المرة بصفة عارضين، لا مشاركين، ليقدّموا منتجهم أمام الجمهور ويختبروا مدى قابلية السوق لاستيعاب فكرتهم. كانت التجربة بمثابة "الامتحان الحقيقي"، حيث جمعوا آراء المستخدمين الأوائل، واستفادوا منها لإجراء دراسة دقيقة للسوق وتحسين خصائص التطبيق. النجاح الميداني أعاد الثقة للفريق، وأثبت أن الفكرة التي بدأت بخطوطٍ بسيطة على ورقة، باتت اليوم مشروعًا قابلاً للحياة، مدعومًا بتجربةٍ ميدانية ومعطياتٍ واقعية.
ويُبرز بوزيد أن النقلة النوعية جاءت حين استطاع الفريق إقناع أحد المستثمرين بتمويل مشروعهم، وهو ما شكّل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الاحترافية. فقد أتاح التمويل إنشاء مقرٍ تجاري رسمي، وإطلاق التطبيق على نطاقٍ أوسع، ليُصبح مشروع "خدمات" واقعًا ملموسًا في السوق المحلي لولاية باتنة. التطبيق الذي يجمع بين البساطة والفعالية، استطاع في وقتٍ قصير جذب مئات العمال الفعليين، وتقديم أكثر من 45 خدمة مختلفة، ما جعله نموذجًا رائدًا في مجال الخدمات الإلكترونية المحلية، وفتح الباب أمام خططٍ طموحة للتوسع نحو العاصمة وقسنطينة خلال المرحلة القادمة.
ويختم بوزيد بالقول إن العودة إلى باتنة إكسبو 4.0 كانت لحظة رمزية تحمل الكثير من الدلالات، فالفريق الذي بدأ مسيرته كـ"زائرٍ بسيط" عاد هذه المرة بصفة شريكٍ ممولٍ للحدث الذي احتضن بدايته. هذه الرحلة التي مرّت بثلاث محطات أساسية — زائر، عارض، فشريك ممول — تُلخص فلسفة الحاضنات الحقيقية: تحويل الطموح إلى مشروع، والمبتكر إلى رائد أعمال، والفكرة إلى قصة نجاحٍ ترويها السوق.
حين تشتغل الحاضنات بمنطق السوق... لا بمنطق الملفات
كما يرى نجم الدين بوزيد، أن الفارق الجوهري بين الحاضنات في الجزائر ونظيراتها في الخارج يكمن في الفلسفة التي تُدار بها المنظومة، فبينما تشتغل الحاضنات العالمية بمنطق السوق والنتائج، لا تزال العديد من الحاضنات الجزائرية رهينة المنطق الإداري والشكلي. ففي التجارب الدولية، الحاضنة تُعامل كمؤسسة استثمارية هدفها خلق القيمة الاقتصادية وتحويل الأفكار إلى مشاريعٍ قابلة للتمويل والنمو، أما في الجزائر، فغالبًا ما يُنظر إليها كمرفقٍ عامٍّ يخضع للمعايير البيروقراطية التي تقيس الأداء بعدد الملفات والنشاطات بدل الأثر الملموس في السوق. هذه الفجوة في الرؤية هي التي تُفسّر بطء التحوّل من مرحلة التأطير إلى مرحلة الإنتاج.
ويُوضح بوزيد أن الحاضنات في الخارج تتحرك ضمن منظومةٍ متكاملة تحكمها المرونة والتكامل، فهي تمتلك شبكاتٍ واسعة من المستثمرين الجاهزين لتمويل المشاريع الواعدة، وتستفيد من قوانين محفزة للابتكار، وإجراءاتٍ سريعة تسمح للمشاريع بالانتقال من الفكرة إلى السوق دون عراقيل. هناك، تعتبر الشركة الناشئة “استثمارًا واعدًا”، يُقاس بما يخلقه من وظائف وما يحققه من قيمةٍ مضافة، لا “ملفًا إداريًا” يحتاج إلى الموافقة. المنطق السائد في هذه التجارب يقوم على دعم المغامرة، وتقدير المخاطرة، وتشجيع روح المبادرة، وهي العناصر التي تجعل من الحاضنة محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي.
ويشير إلى أن الوضع في الجزائر مختلف، إذ ما تزال الحاضنة تُعامل في كثير من الحالات كهيكلٍ إداريٍّ يخضع لإجراءاتٍ جامدة، تُركّز على تسيير الملفات بدل صناعة المشاريع. في هذا الإطار، يُقاس النجاح بعدد الورشات المنظّمة، أو الملفات المفتوحة، أو الاجتماعات المنعقدة، بينما يُهمل المؤشر الأهم: كم مشروعًا تموّل؟ وكم شركة ناشئة خرجت إلى السوق وحققت مبيعات؟ هذه النظرة الشكلية تجعل الحاضنة أحيانًا أداة توثيق أكثر منها فضاءً للخلق، وتحدّ من قدرتها على لعب دورٍ فعّال في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
ويُشدّد بوزيد على أن التحوّل من "منطق الملفات" إلى "منطق السوق" هو الخطوة المفصلية التي تحتاجها المنظومة الجزائرية لتلتحق بالنماذج العالمية. فالحاضنة الناجحة تلك التي تُطلق الشركات وتفتح الأسواق وتخلق فرص العمل. ولتحقيق ذلك، يجب إعادة تعريف مفهوم الحاضنة، وتحريرها من القوالب الإدارية، ومنحها استقلالية في القرار والتمويل، مع تمكينها من بناء شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين. وحده هذا التكامل يمكن أن يحوّل الحاضنة من مؤسسة تتابع "الأنشطة" إلى منصةٍ تُنتج "النجاحات"، ومن فضاء إداري مغلق إلى ورشة حقيقية لريادة الأعمال.
حين تُعوّض الحاضنة غياب المال... برأس مالٍ من نوعٍ آخر
ويشير نجم الدين بوزيد، أن الحاضنة يمكن أن تكون بديلاً جزئيًا عن رأس المال في المراحل الأولى من المشروع، إذ لا تُقدّم الأموال بالمعنى التقليدي، لكنها توفر ما يعادلها من دعمٍ غير مالي يُمكّن الفكرة من العيش والنمو حتى تصل إلى مرحلةٍ تصبح فيها قادرة على جذب المستثمرين. فالمشاريع الناشئة في بداياتها لا تحتاج دائمًا إلى السيولة بقدر ما تحتاج إلى بيئةٍ آمنة تُقلّل من التكاليف والمخاطر، وتمنحها فرصة التعلّم، والتجريب، والاندماج في منظومة ريادة الأعمال. وهنا بالضبط تكمن القيمة الحقيقية للحاضنة: في قدرتها على أن تكون “رأس مالٍ غير نقدي” يُغذي المشروع بالخبرة والعلاقات والمعرفة.
ويُوضح بوزيد أن أول ما تقدمه الحاضنة هو الفضاء، إذ توفّر للشباب رواد الأعمال مكانًا للعمل المجاني أو شبه المجاني، مزوّدًا بالخدمات الأساسية، وهو ما يُخفّض بشكلٍ كبير من الأعباء المالية للمشاريع في بداياتها. فبدل أن يُنفق الريادي جزءًا كبيرًا من ميزانيته على الإيجار والتجهيز، يجد في الحاضنة بنية تحتية جاهزة للعمل، تسمح له بالتركيز على تطوير الفكرة بدل القلق على المصاريف. هذه الخطوة البسيطة تمنح المشروع هامش تنفّسٍ ضروري في فترةٍ حساسة، حيث كل دينار محسوب، وكل تأخيرٍ في الإقلاع قد يكون قاتلًا.
ويُضيف أن الحاضنة تُقدّم كذلك ما يُعرف بـ"رأس المال المعرفي"، وهو ما يتجسّد في التأطير المهني والاستشارات القانونية والتجارية، فضلًا عن التكوين المستمر في مجالات الإدارة، التسويق، ونمذجة الأعمال. فالمرافقة التي تُوفّرها الحاضنة تُعدّ استثمارًا غير مباشر في قدرات صاحب المشروع، وتُجنّبه الوقوع في أخطاء مكلفة ماليًا وزمنيًا. ومع مرور الوقت، يصبح هذا التأطير هو الفارق بين مشروعٍ ينهار في أول اختبارٍ واقعي، وآخرٍ يواصل طريقه بثقةٍ نحو السوق.
ويؤكد بوزيد أن الحاضنة لا تعمل في عزلة، بل تلعب دور الوسيط النشط بين رواد الأعمال ومصادر التمويل، من خلال الربط المباشر بالمستثمرين أو مؤسسات الدعم المالي، وبناء شبكة علاقاتٍ واسعة تُعتبر في حد ذاتها شكلاً من أشكال رأس المال. هذه الشبكة، التي تضم خبراء ومستشارين وممولين، تفتح أمام صاحب المشروع فرصًا جديدة، وتُعزز قدرته على الوصول إلى التمويل في المراحل التالية. فالحاضنة لا تُغني عن رأس المال بشكلٍ دائم، لكنها تُوفّر الأرضية التي تُعوّض غيابه مؤقتًا، وتُجهّز المشروع ليكون أكثر إقناعًا وجاذبية للمستثمر حين يحين الوقت.