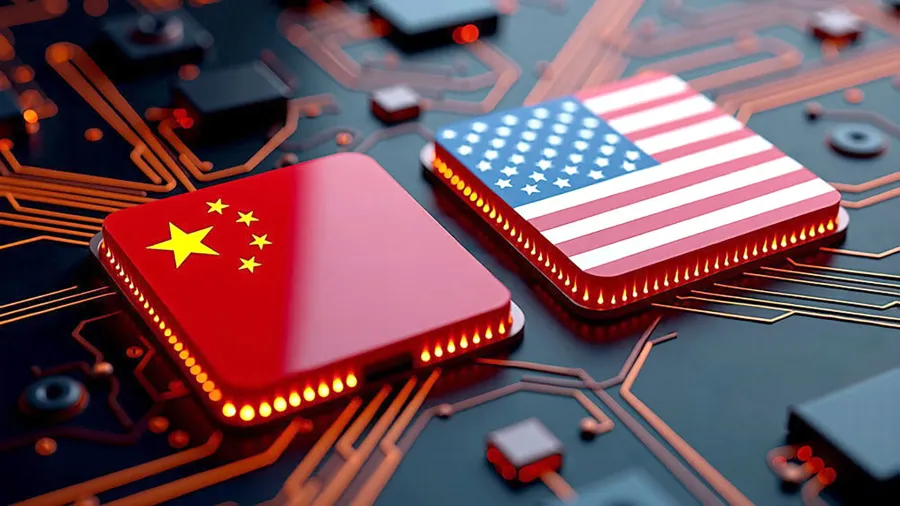التضخم ليس رقما في نشرات البنوك، بل هو جوع صامت يلتهم الأجور ويهز استقرار الحكومات، إنه اختبار عالمي يبدأ من رغيف الخبز ولا ينتهي عند صناديق الاقتراع...
في كل مرة تُعلن فيها البنوك المركزية عن نِسب التضخم، يخيّل للناس أن الأمر لا يعدو كونه أرقاما باردة على ورق، لكنها في الواقع أشبه بميزان حرارة يكشف عن الحمى التي تعصف بجسد الاقتصاد العالمي. التضخم هو مرض خفي يزحف بخطوات بطيئة حتى يستقر في تفاصيل حياة الشعوب، ويحوّل النقود إلى أوراق أقل قيمة، والأجر الشهري إلى ظلّ لا يكفي لتغطية الحاجات الأساسية. ولأنه صامت، فهو لا يعلن عن نفسه دفعة واحدة، بل يتسلل إلى الأسعار تدريجيا حتى يصحو المواطن فجأة على واقع لم يتخيله: دخله هو نفسه، لكن حاجاته تضاعفت وأسعاره انفجرت.
هذا "المرض الصامت" ليس وليد أزمة واحدة، وإنما نتيجة تراكمية لصدمات متلاحقة عرفها العالم قبل عدة عقود وظهر بشكل أكبر في أقل من خمس سنوات. فمنذ جائحة كورونا التي عطّلت المصانع وأغلقت الموانئ وأوقفت حركة الطيران والتجارة، إلى الحرب في أوكرانيا التي أشعلت أسعار الغاز والحبوب، أصبح التضخم سلاحًا غير مرئي يضرب الجميع من دون تمييز. ومن المفارقات أن الأزمة لم تعترف بالحدود ولا بالأنظمة الاقتصادية، فأصابت الدول الغنية كما الفقيرة، وأربكت الأسواق في الشمال والجنوب، حتى باتت كل الحكومات تواجه السؤال نفسه: كيف يمكن علاج مرض يضرب العالم بأسره؟
واللافت أن التضخم لا يُقاس فقط بمؤشرات الاقتصاد، بل يُقاس قبل ذلك بوجوه الناس. فحين تجد أسرة متوسطة الدخل مضطرة للتخلي عن وجبة لحم أسبوعية أو عن رحلة صغيرة كانت تقوم بها كل صيف، فاعلم أن المرض وصل إلى العظم. وعندما ترى طوابير المواطنين في دول عديدة يصطفون من أجل شراء أساسيات كالخبز والزيت، تدرك أن التضخم لم يعد مجرد مفهوم في تقارير "الفاو" أو بيانات صندوق النقد، بل تحول إلى معاناة حيّة تطرق أبواب البيوت. هنا بالذات يكمن صمته المخيف: يشتغل في الخفاء، لكنه يترك أثره الصارخ في الجيوب والموائد والأحلام الصغيرة.
وإذا كان الاقتصاد في العادة يتعامل مع الدورات والأزمات بنوع من المرونة، فإن التضخم الحالي كسر هذه القاعدة. إذ جاء في وقت لم يتعافَ فيه العالم بعد من جائحة كورونا، ووجد في الحرب بأوكرانيا أرضًا خصبة ليتجذر ويتمدّد. وهكذا، تحوّل إلى معركة مفتوحة بين البنوك المركزية التي ترفع أسعار الفائدة لكبحه، والحكومات التي تخشى أن تؤدي تلك السياسات إلى ركود أشد وطأة. إنها معركة لا مدافع فيها ولا دبابات، لكنها تترك وراءها ضحايا من نوع آخر: ملايين المواطنين الذين يخسرون قدرتهم الشرائية يوماً بعد يوم.
بهذا المعنى يصبح التضخم امتحانًا حضاريًا بامتياز، لأنه يكشف هشاشة الأنظمة الاقتصادية مهما بدت قوية. فمن كان يظن أن أوروبا ستعاني من فواتير طاقة تهدد صناعاتها الثقيلة، أو أن أمريكا ستسجل أعلى نسب تضخم منذ أربعة عقود؟ التضخم يُعرّي الواقع، ويضع العالم أمام مرآة لا تجامل أحدًا، تمامًا كما يفعل المرض مع الجسد: يكشف نقاط الضعف التي لم تكن تُرى من قبل. ولهذا لم يعد التضخم مجرد شأن اقتصادي، بل صار جزءًا من حوار يومي يتداول فيه الناس أسعار السلع أكثر مما يتحدثون عن السياسة أو الرياضة، وكأن العالم كله يعيش في عيادة واحدة، ينتظر تشخيصًا لمرضٍ لم يجد له أحد علاجًا ناجعًا بعد.
من كورونا إلى أوكرانيا.. جذور الأزمة الممتدة
إذا كان التضخم قد بدا كـ"مرض صامت" ينهش جسد الاقتصاد العالمي، فإن السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو: من أين يأتي هذا المرض؟ للإجابة، لا بد أن نعود إلى جذوره القريبة، حيث اجتمعت الأزمات على نحو لم يشهده العالم منذ عقود. البداية كانت مع جائحة كورونا، التي باغتت الكرة الأرضية مطلع 2020، فأغلقت الحدود وأقفلت المصانع وأربكت سلاسل الإمداد. لوهلةٍ صار العالم أشبه بقرية معزولة، تُعاني من ندرة السلع وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع. حينها بدأت بذور التضخم الأولى، إذ ارتفعت أسعار الكمامات والمواد الطبية ثم لحقت بها أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يكتشف الناس أن الجائحة زرعت أيضًا فيروسًا آخر في الاقتصاد العالمي اسمه "التضخم".
وما إن بدأ العالم يلتقط أنفاسه تدريجيًا، حتى جاءت الحرب في أوكرانيا لتصب الزيت على النار. هذه الحرب لم تكن مجرد صراع جغرافي بين دولتين، بل تحولت بسرعة إلى أزمة عالمية لأن أوكرانيا وروسيا تُعدّان من كبار موردي الحبوب والطاقة. توقفت صادرات القمح، وارتفعت أسعار الغاز، وأصبح العالم كله يتحدث عن أزمة غذاء عالمية تهدد مئات الملايين. وهكذا، فإن التضخم الذي بدأ بطيئًا مع كورونا، وجد في حرب أوكرانيا وقودًا إضافيًا جعله يتسارع بشكل غير مسبوق.
تداعيات الحرب لم تقف عند حدود أوروبا الشرقية، بل امتدت إلى كل بيت في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ارتفعت أسعار الخبز في القاهرة، وفواتير الغاز في برلين، وأسعار الوقود في نيروبي. بدا وكأن الكرة الأرضية تحولت إلى سوق واحد ضخْم، حيث أي أزمة في منطقة ما تنعكس مباشرة على موائد العائلات في أبعد مكان. وهنا برزت حقيقة أن التضخم ليس شأنًا داخليًا لأي دولة، وإنما هو نتيجة مباشرة لتشابك الاقتصاد العالمي وتداخل مصالحه.
وفي ظل هذا الترابط العابر للحدود، أصبح من المستحيل على أي حكومة أن تعزل نفسها عن تداعيات الأزمة. فحتى الدول الغنية، التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وجدت نفسها عاجزة أمام موجات الغلاء. والمفارقة أن الإجراءات التي لجأت إليها لم تكن سوى مسكنات وقتية، كتقديم إعانات محدودة أو تخفيض بعض الضرائب، لكنها لم تعالج أصل الداء. وبذلك صار واضحًا أن التضخم الحالي ليس مجرد دورة اقتصادية طبيعية، بل هو أزمة ممتدة الجذور، نابعة من أحداث غير مسبوقة في حجمها وتأثيرها.
وبين كورونا وأوكرانيا خيط رفيع لكنه واضح: كلاهما كشف هشاشة النظام العالمي أمام الأزمات الكبرى. فكما أظهر الوباء أن الصحة العامة يمكن أن تشل الاقتصاد في أيام معدودة، أظهرت الحرب أن الأمن الغذائي والطاقة يمكن أن يقلب موازين الاستقرار في العالم بأسره. وبذلك يصبح التضخم الحالي ابنًا شرعيًا لهاتين الأزمتين، وامتدادًا مباشرًا لهما، وهو ما يفسر لماذا يصفه كثير من الخبراء بأنه "الأكثر عنادًا" مقارنة بكل موجات التضخم التي عرفها العالم من قبل.
سلاسل الإمداد حين تنهار.. كيف تشتعل الأسعار؟
وإذا كانت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا قد شكّلتا جذور التضخم الحالي، فإن القاسم المشترك بينهما يتمثل في شلل سلاسل الإمداد العالمية. تلك السلاسل، التي كانت تبدو في نظر الاقتصاديين مثل شبكة عنكبوتية دقيقة لكنها متينة، سرعان ما تبيّن هشاشتها حين تعرضت للاهتزاز. فالمصانع التي توقفت في الصين خلال الإغلاق الشامل، عطّلت مصانع السيارات في ألمانيا، وأخّرت إنتاج الإلكترونيات في كوريا، ورفعت أسعار الأجهزة في أسواق إفريقيا. هنا ظهر أن العالم يعيش فعلاً في "قرية اقتصادية واحدة"، وأن أي انقطاع في خيط صغير من شبكة الإمداد يكفي لإرباك السوق بأكملها.
لقد عرف العالم للمرة الأولى معنى أن تكون البضاعة موجودة في الميناء ولا تصل إلى الرفوف. مئات السفن عالقة في الموانئ، آلاف الحاويات تنتظر، وأسعار النقل البحري تضاعفت مرات عديدة. هذا التعطل كان بداية انفجار الأسعار في أسواق الغذاء والدواء والطاقة. وما إن هدأت الجائحة قليلاً حتى جاءت الحرب في أوكرانيا لتزيد الوضع سوءاً، إذ تعطلت موانئ البحر الأسود وتوقفت شحنات القمح والزيوت، وهو ما جعل سلاسل الإمداد أكثر هشاشة، وفتح الباب أمام جوع حقيقي يطرق أبواب الملايين.
وتجلّت الأزمة أكثر في المواد الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمعات: القمح، الزيت، الوقود. فعندما يتأخر القمح الأوكراني عن الوصول إلى مصر أو تونس، تتصاعد أسعار الخبز وتزداد طوابير المواطنين أمام المخابز. وعندما تتوقف شحنات الغاز الروسي، ترتفع فواتير التدفئة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة. ومع كل حلقة تنقطع من سلسلة الإمداد، تشتعل الأسعار في بقعة جديدة من العالم، وكأن التضخم نار تنتقل من بيت إلى آخر عبر أسلاك خفية لا يراها أحد.
وما يزيد من تعقيد المشهد أن الحلول ليست سهلة. فإعادة بناء سلاسل الإمداد تحتاج إلى وقت طويل واستثمارات هائلة. صحيح أن بعض الدول حاولت تنويع مصادرها، لكن الشبكة العالمية بقيت مرتبطة بخيوط محدودة، خاصة في المواد الحساسة كالحبوب والوقود والرقائق الإلكترونية. وهذا الارتباط جعل أي اضطراب يتحول مباشرة إلى ارتفاع جنوني للأسعار. بمعنى آخر، لم تعد الأزمة مرتبطة فقط بالأحداث الكبرى مثل الجائحة والحرب، بل صارت جزءاً من طبيعة العولمة نفسها التي ربطت الأسواق بشكل وثيق وسريع التأثر.
وهكذا، فإن التضخم الذي وصفناه سابقاً بـ"المرض الصامت"، والذي وجد جذوره في كورونا وأوكرانيا، أخذ جسده الحقيقي في انهيار سلاسل الإمداد. هذه السلاسل تحولت إلى مرآة تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام الأزمات. ومع كل انقطاع جديد، يُولد تضخم جديد، ويترسخ شعور عالمي بأن الأسعار لم تعد تحت السيطرة. ومن هنا يمكن القول إن التضخم الحالي ليس فقط نتيجة أحداث طارئة، بل هو انعكاس مباشر لانكشاف العالم على نفسه عبر شبكة إمداد أثبتت أنها أضعف من أن تتحمل الصدمات.
الطبقة المتوسطة.. من وسادة أمان إلى خط هشاشة
حين تنهار سلاسل الإمداد وتشتعل الأسعار كما رأينا، يكون أول المتأثرين هم الفقراء الذين يعيشون أصلاً على هامش الحاجة. لكن المدهش – والمقلق في آن واحد – أن التضخم هذه المرة لم يتوقف عند حدود الفقراء، بل اندفع نحو الطبقة المتوسطة، تلك الطبقة التي طالما اعتُبرت "وسادة الأمان" لأي مجتمع. فالمعلم، والموظف الإداري، والطبيب الشاب، والمهندس في بداية مساره… كلهم وجدوا أنفسهم فجأة أمام واقع جديد: دخلهم ثابت تقريباً، لكن نفقاتهم اليومية تتضاعف. لقد أصبح التضخم يمحو ما تبقى من استقرار هذه الفئة التي كانت تمثل التوازن بين الغنى والفقر.
تاريخياً، لعبت الطبقة المتوسطة دورًا حاسمًا في ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي. فهي التي تحافظ على دوران عجلة الاقتصاد من خلال استهلاكها، وهي التي توفر قاعدة واسعة للتعليم والصحة والخدمات. لكنها حين تدخل في دائرة العجز، يتحول المجتمع بأسره إلى ما يشبه طاولة بلا أرجل، لا تستطيع الوقوف طويلاً. وهنا يظهر البعد الأخطر للتضخم: ليس فقط في رفع الأسعار، بل في إضعاف "العمود الفقري" للمجتمع. ومع اختلال هذا العمود، يصبح السقوط مسألة وقت لا أكثر.
والواقع أن صورة الطبقة المتوسطة اليوم تكاد تكون متشابهة في مختلف القارات. في أوروبا، تراجع مستوى المعيشة بعد أن تضاعفت فواتير التدفئة. في أمريكا اللاتينية، أصبحت رحلات الترفيه أو شراء سيارة جديدة حلمًا بعيد المنال. في إفريقيا وآسيا، بات الحصول على وجبة متوازنة تحديًا يوميًا. كل هذه المظاهر تشير إلى أن التضخم حوّل الطبقة المتوسطة من فئة مستقرة إلى "خط هشاشة"، يقترب يومًا بعد يوم من حافة الفقر.
ومع تآكل الطبقة المتوسطة، يزداد الشعور العام بالظلم وفقدان العدالة. فبينما تستطيع الطبقات الغنية مواجهة التضخم عبر تحويل أموالها إلى استثمارات أو أصول محمية، لا يجد المواطن العادي سوى راتبه الشهري الذي يتبخر نصفه مع نهاية الأسبوع. وهنا تنشأ فجوة اجتماعية خطيرة: أغنياء يزدادون ثراءً لأنهم يملكون أدوات الحماية، وفقراء ومتوسطي الدخل يزدادون عجزًا لأنهم يفتقدونها. إنها وصفة جاهزة لاضطرابات اجتماعية، لا سيما في الدول التي لم توفر شبكات أمان اجتماعي قوية.
ومن هنا نفهم أن التضخم هو تحوّل اجتماعي عميق. فقد ضرب أسس الاستقرار التي كانت تبنيها الطبقة المتوسطة عبر عقود. فإذا كان انهيار سلاسل الإمداد قد كشف هشاشة الاقتصاد العالمي، فإن انهيار الطبقة المتوسطة يكشف هشاشة المجتمعات نفسها. وكأن العالم يمرّ بمرحلة انتقالية حيث لم يعد السؤال: "كم ارتفعت الأسعار؟"، بل أصبح: "من بقي واقفًا بعد العاصفة؟" — وهنا تتهيأ الأرضية للانتقال إلى الفئة الأكثر هشاشة على الإطلاق: الأسر الفقيرة التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع جوع بلغة الأرقام.
الأسر الفقيرة.. الضحية الأولى لجوع الأرقام
إذا كانت الطبقة المتوسطة قد تحولت إلى خط هشاشة، فإن الأسر الفقيرة لم يكن أمامها سوى الانكسار المباشر أمام موجة التضخم. هذه الأسر التي كانت تكافح أصلًا من أجل توفير وجبتين في اليوم، وجدت نفسها فجأة في معركة غير متكافئة، حيث ترتفع أسعار السلع الأساسية بينما يبقى الدخل راكدًا عند مستويات متدنية. هنا لم يعد التضخم مجرد "مرض صامت" كما وصفناه سابقًا، بل صار سيفًا مسلطًا على رقاب الملايين، يقتطع من قوتهم اليومي بلا رحمة، ويدفعهم إلى طرق أبواب الإعانات والجمعيات الخيرية بحثًا عن كسرة خبز أو لتر زيت.
في كثير من الدول النامية، أصبحت صور الطوابير الطويلة أمام المخابز أو مراكز توزيع المواد الغذائية مشهدًا متكررًا. أطفال يقفون في البرد أو تحت الشمس، نساء يحملن أوعية فارغة، ورجال يجرون عربات صغيرة لعلهم يظفرون بحصة محدودة. هذه المشاهد هي تعبير حيّ عن كيفية ترجمة التضخم في حياة الناس الأكثر هشاشة. إنه يحوّل الاحتياجات الأساسية – الخبز، الحليب، الأرز – إلى أحلام صعبة المنال، ويجعل البقاء نفسه معركة يومية.
والأخطر أن التضخم لم يكتفِ بحرمان الأسر الفقيرة من الغذاء، بل امتد أثره إلى التعليم والصحة. فحين تضطر الأسرة إلى إنفاق كل دخلها على الأكل والشرب، فإنها تُقصِّر في تعليم أبنائها أو في شراء الأدوية. وهكذا يتحول التضخم إلى دائرة مغلقة من الحرمان: سوء تغذية يضعف الأطفال، تعليم ناقص يقلل فرص العمل، وأمراض غير معالجة تضعف المجتمع أكثر. وكأن الجوع بلغة الأرقام يكتب مستقبلًا أكثر قتامة للأجيال القادمة.
ولا تقتصر تداعيات التضخم على الجانب المعيشي فقط، بل تمتد إلى الكرامة الإنسانية نفسها. فالفقير الذي كان يكتفي بالقليل ليحافظ على كبريائه، يجد نفسه اليوم مضطرًا لمدّ يده طلبًا للمساعدة، أو للاقتراض بفوائد مرهقة، أو حتى لبيع ممتلكاته البسيطة. هذا التحول يترك جروحًا نفسية عميقة لا تقل خطورة عن الجوع المادي، لأنه يحطم ثقة الإنسان بنفسه، ويشعره بالعجز أمام أسرته ومجتمعه.
وبذلك، فإن التضخم يكشف عن وجهه الأكثر قسوة حين يضرب الأسر الفقيرة. فإذا كان انهيار الطبقة المتوسطة يعني تهديد الاستقرار الاجتماعي، فإن سحق الفقراء يعني تهديد الاستقرار الإنساني ذاته. ومن هنا يصبح التضخم ليس فقط امتحانًا لجيوب المواطنين، بل امتحانًا لضمير الحكومات والمجتمع الدولي: هل يتركون ملايين الفقراء يواجهون مصيرهم وحدهم؟ أم يبتكرون سياسات وأدوات تحمي هؤلاء من أن يتحولوا إلى وقود لغضب شعبي وانفجار اجتماعي قد يغير وجه العالم؟ ومن هذه النقطة، يُصبح الحديث عن الغذاء والطاقة ضرورة لا يمكن تجاوزها، لأنهما القلب النابض للتضخم الذي أشعل حياة الفقراء قبل غيرهم.
فاتورة الغذاء والطاقة.. نار تلتهم جيوب المواطنين
حين ننتقل من معاناة الأسر الفقيرة إلى جوهر التضخم، نجد أنفسنا أمام أكثر مجالين يمسّان الحياة مباشرة: الغذاء والطاقة. فهما ليسا مجرد سلعتين في الأسواق، بل هما عصب المعيشة اليومي، وأي اضطراب في أسعارهما يتحول فورًا إلى زلزال في حياة الناس. لذلك كان طبيعيًا أن يكون الغذاء والطاقة هما "الوقود الحقيقي" للتضخم، وهما أيضًا المرآة التي تعكس قسوته. ففي كل مرة تعلن فيها نشرة الأخبار عن ارتفاع أسعار القمح أو الغاز أو النفط، يدرك المواطن أن الفاتورة التي سيدفعها في نهاية الشهر ستلتهم جزءًا أكبر من دخله، حتى لو لم يتغير دخله فلسًا واحدًا.
لقد كشفت الأزمة الأوكرانية تحديدًا أن العالم بأسره يقف على "مائدة واحدة". فحين توقفت شحنات القمح من البحر الأسود، ارتفع ثمن الخبز في تونس والقاهرة والدار البيضاء. وحين أُغلق صنبور الغاز الروسي، وجدت الأسر الأوروبية نفسها أمام فواتير تدفئة لم تعرفها منذ عقود. وهكذا أصبح الغذاء والطاقة بمثابة خيط واحد يربط مصير العائلات في الجنوب والشمال. وما يزيد من خطورة هذا الترابط أن الأسعار لم تعد مرتبطة فقط بالعرض والطلب التقليدي، بل صارت رهينة الأزمات الجيوسياسية، حيث يكفي تصريح من عاصمة كبرى أو انفجار في خط أنابيب ليشتعل السوق في غضون ساعات.
وإذا كان الفقراء قد عانوا من فقدان القدرة على توفير حاجاتهم الأساسية، فإن الطبقة المتوسطة وجدت نفسها مكبلة بفاتورة كهرباء أو غاز تتضاعف، وبسلة غذائية تزداد كلفتها أسبوعًا بعد آخر. حتى في الدول الغنية، أصبح الحديث عن "التدفئة أو الطعام" معضلة حقيقية لبعض الأسر. هذه المفارقة تكشف أن التضخم في مجال الغذاء والطاقة لا يميز بين فقير وغني، بل يضع الجميع في مواجهة مباشرة مع نار تلتهم الجيوب بلا هوادة. الفرق الوحيد أن الأغنياء يملكون طرقًا للتكيف، بينما المواطن العادي يجد نفسه محاصرًا بلا مخرج.
واللافت أن هذه الأزمة لم تُظهر فقط هشاشة الأسواق العالمية، بل فضحت كذلك عجز السياسات المحلية، فالكثير من الحكومات لجأت إلى حلول ترقيعية: دعم الخبز مؤقتًا، أو تخفيض ضريبة الكهرباء لفترة محدودة، أو تقديم إعانات مباشرة للأسر الأشد فقرًا. لكنها لم تتمكن من معالجة أصل المشكلة، لأن أسعار الغذاء والطاقة تتحدد في أسواق عالمية لا تخضع لسيطرة أي حكومة منفردة. وهذا ما يجعل التضخم في هذين المجالين أشبه بقدر يغلي فوق نار سياسية واقتصادية يصعب إطفاؤها.
حين يصبح التضخم صندوق اقتراع صامت
التضخم تحول إلى لاعب سياسي صامت، يشارك في الانتخابات من دون أن يترشح، ويصوت من دون أن يحمل بطاقة اقتراع. فهو يقلب المعادلات الانتخابية، ويغيّر المزاج الشعبي، ويحدد مصير الحكومات أكثر مما تفعل البرامج والشعارات. حين ترتفع أسعار الخبز والطاقة والدواء، فإن المواطن العادي لا يقرأ البيانات الرسمية، بل يصوّت بلسانه الغاضب وجيبه الفارغ. وهكذا يصبح التضخم "صندوق اقتراع صامتًا"، يحسم نتائج الانتخابات قبل أن تُفتح مراكز التصويت.
لقد أظهرت التجارب الحديثة أن الغلاء قادر على إسقاط حكومات مهما كانت قوتها، أو على الأقل تقليص شرعيتها. ففي أوروبا، لعب التضخم دورًا بارزًا في صعود أصوات المعارضة التي اتهمت الحكومات بالعجز عن حماية المواطنين من فواتير الطاقة. وفي أمريكا اللاتينية، كان التضخم وقودًا لاحتجاجات أطاحت بوزراء واقتصاديين كبار. حتى في بعض الدول الإفريقية، صار الشارع يتحدث عن الأسعار أكثر مما يتحدث عن السياسة، وكأن التضخم أصبح برنامجًا انتخابيًا بحد ذاته، لا يحتاج إلى حملات دعائية أو وعود براقة.
والمفارقة أن التضخم لا يفرّق بين أنظمة ديمقراطية وأخرى سلطوية. ففي الأنظمة الديمقراطية، يُترجم مباشرة في صناديق الاقتراع، حيث يعاقب الناخبون الحكومات على فشلها الاقتصادي. أما في الأنظمة السلطوية، فيتحول إلى غضب شعبي يعبَّر عنه بالاحتجاجات أو الإضرابات أو حتى الانفجارات الاجتماعية. وفي كلا الحالتين، يبقى التضخم هو العامل الحاسم في إعادة رسم المشهد السياسي، لأنه يمس حياة الناس في أكثر تفاصيلها خصوصية: رغيف الخبز، فواتير الماء والكهرباء، تكاليف النقل.
وإذا كانت الحكومات تملك عادة أوراقًا عديدة لتسويق سياساتها أو تلميع صورتها، فإنها في مواجهة التضخم تفقد معظم أوراقها. فلا خطاب سياسي قادر على إقناع مواطن يشعر أن راتبه يتبخر، ولا وعود انتخابية قادرة على تغطية ثلاجة فارغة. هنا يصبح الاقتصاد أقوى من السياسة، والواقع اليومي أقوى من أي دعاية إعلامية. ولعل هذا ما يفسر لماذا يُنظر إلى التضخم باعتباره تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي، حتى في الدول التي تبدو محصنة بالمؤسسات والقوانين.
ومن هنا نفهم أن التضخم، الذي بدأنا الحديث عنه كـ"مرض صامت" ثم رأيناه ينهش الطبقة المتوسطة والفقراء ويشتعل في أسعار الغذاء والطاقة، يجد اليوم ترجمته السياسية الكاملة. فهو لم يعد مجرد تحدٍ اقتصادي، بل تحول إلى اختبار يومي للشرعية السياسية. ومع كل ارتفاع في الأسعار، يُضاف صوت جديد إلى صندوق الاقتراع الصامت، ليقرر في النهاية من يبقى في الحكم ومن يغادر المسرح. ومن هذه النقطة، يصبح الطريق مفتوحًا للحديث عن الشارع الغاضب، الذي يخرج من الصمت إلى العلن حين يعجز الصندوق الصامت عن إحداث التغيير المطلوب.
الشارع الغاضب.. من الاحتجاجات إلى إسقاط الحكومات
حين يفشل "صندوق الاقتراع الصامت" في إيصال الرسالة، يخرج الشارع ليعلنها بصوت مرتفع. التضخم الذي يتسلل أولًا إلى جيوب المواطنين، ثم يتجسد في أرقام الإحصاءات، سرعان ما يتحول إلى هتافات في الساحات. الجوع لا يعرف لغة البيانات الرسمية، بل يعرف لغة الاحتجاج والإضراب والتظاهر. ولهذا، لم يكن مستغربًا أن تشهد دول عديدة موجات غضب شعبي ارتبطت مباشرة بارتفاع الأسعار. في لحظة ما، يتحول المواطن من متسوق في السوق إلى متظاهر في الشارع، ومن دافع للضرائب إلى مطالب بإسقاط الحكومة.
لقد أظهرت العقود الأخيرة أن التضخم واحد من أكثر العوامل قدرة على إشعال الاحتجاجات. ففي العالم العربي، شكّل ارتفاع أسعار الخبز والوقود شرارة لانتفاضات عُرفت باسم "ثورات الخبز". وفي أمريكا اللاتينية، كان الغلاء سببًا مباشرًا لمظاهرات حاشدة أطاحت برؤساء وسياسيين. وحتى في أوروبا، خرجت حركة "السترات الصفراء" من رحم شعور عام بأن فواتير الوقود أصبحت عبئًا لا يطاق. وفي كل هذه الحالات، كان التضخم هو الخيط الرفيع الذي ربط الأسواق بالسياسة، وحوّل الأزمة الاقتصادية إلى عاصفة اجتماعية.
وما يزيد الأمر خطورة أن الاحتجاجات الناجمة عن التضخم لا تكون عادة منظمة أو قابلة للتفاوض بسهولة. فهي تنطلق من حاجات يومية أساسية، ومن شعور بالظلم لا يحتاج إلى وساطة فكرية. المواطن الذي لا يستطيع شراء الخبز أو دفع فاتورة الكهرباء، لا ينتظر برنامجًا سياسيًا ليغضب، بل يخرج إلى الشارع بدافع البقاء نفسه. ولهذا، فإن هذه الاحتجاجات غالبًا ما تكون عفوية وشاملة، تضم فئات مختلفة من المجتمع، ما يجعلها أصعب على الحكومات في الاحتواء والسيطرة.
ومع تراكم الغضب، تتراجع قدرة الأنظمة على المناورة. فالإجراءات التجميلية كالدعم المؤقت أو الخطاب الإعلامي المهدئ تفقد أثرها أمام إصرار الناس الذين يعيشون واقعًا قاسيًا. وهنا يتجلى التضخم كقوة مدمرة للاستقرار السياسي، لأنه لا يترك للحكومات ترف الوقت. كل يوم يتأخر فيه الحل يعني مزيدًا من الاحتقان، وكل شهر يمر من دون معالجة جذرية يعني اقتراب احتمال سقوط الحكومة أو اهتزاز النظام بأكمله.
وهكذا، يتضح أن التضخم ليس فقط "صندوق اقتراع صامتًا" كما رأيناه سابقا، بل هو أيضًا "صوت الشارع الغاضب" الذي يمكن أن يطيح بالحكومات. إنه يمزج بين الصمت والصراخ، بين الرقم في نشرة الأخبار والهتاف في الساحة. ومن هذه النقطة، يصبح من الضروري الانتقال إلى الحديث عن كيف تراوغ الحكومات هذا الشبح، وما الاستراتيجيات التي تلجأ إليها لتأجيل انفجاره أو احتوائه.
بين الأرقام والسياسات.. كيف تراوغ الحكومات شبح التضخم؟
حين يشتعل الشارع وتتعالى الأصوات الغاضبة، تجد الحكومات نفسها أمام تحدٍّ مصيري: كيف يمكن احتواء شبح التضخم قبل أن يتحول إلى عاصفة سياسية جارفة؟ في هذه اللحظة، تدخل السياسة على خط الأرقام، وتبدأ محاولات الترويض عبر أدوات متعددة، تبدأ من الخطاب الإعلامي المطمئن ولا تنتهي عند سياسات نقدية ومالية متشابكة. غير أن هذه المحاولات كثيرًا ما تكون أشبه بسباق مع الزمن، لأن التضخم سريع الحركة، بينما سياسات الحكومات بطيئة الأثر. فيبقى المواطن في المنتصف، يترقب حلولًا لا تأتي بالسرعة التي يحتاجها.
أول ما تلجأ إليه الحكومات عادة هو البنوك المركزية، التي ترفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. هذه الأداة الكلاسيكية تهدف إلى تقليل الطلب وخفض الاستهلاك، لكنها في الوقت ذاته ترفع كلفة القروض وتثقل كاهل المستثمرين والأسر على حد سواء. وهنا يتجلى التناقض: فالحل الاقتصادي قد يتحول إلى عبء اجتماعي، ما يجعل السياسات النقدية سلاحًا ذا حدين. وفي الوقت الذي تهدأ فيه الأسعار قليلًا، قد يتباطأ النمو الاقتصادي، فتجد الحكومة نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ.
ولم تقتصر المواجهة على السياسات النقدية، بل امتدت إلى الإجراءات المالية. فبعض الدول حاولت دعم السلع الأساسية بشكل مباشر، غير أن هذه الحلول كثيرًا ما تصطدم بميزانيات منهكة، خاصة في الدول النامية، حيث لا تستطيع الخزائن تحمل أعباء الدعم طويلًا. أما في الدول الغنية، فقد لجأت الحكومات إلى سياسات الضرائب التصاعدية أو إلى ضخ حزم مالية لتخفيف العبء عن الأسر، لكنها بدت أيضًا حلولًا مؤقتة لا تُغير من مسار التضخم العالمي.
وتبرز هنا أيضًا ورقة الخطاب السياسي، إذ تحاول الحكومات كسب الوقت عبر مخاطبة شعوبها بوعود الإصلاح والاحتواء. غير أن هذا الخطاب غالبًا ما يفقد بريقه بسرعة، لأن الناس لا تقيس الوعود بالكلمات، بل بما يضعونه على موائدهم وما يدفعونه في فواتيرهم. التضخم لا يترك للحكومات مجالًا للمناورة اللغوية طويلاً، لأنه يُقاس يوميًا في الأسواق والمتاجر. ولهذا فإن أي فجوة بين الخطاب والواقع تتحول بسرعة إلى وقود جديد للغضب الشعبي.
من هنا نفهم أن الحكومات، مهما حاولت، لا تملك سوى المراوغة المؤقتة أمام التضخم. فهي قادرة على تهدئة آثاره لبعض الوقت، لكنها لا تستطيع اقتلاعه من جذوره، لأنه مرتبط بعوامل عالمية تتجاوز حدودها. فإذا كان التضخم قد بدأ كمرض صامت وامتد إلى الشارع الغاضب، فإنه اليوم يضع الحكومات في معركة معقدة بين الأرقام والسياسات. ومع كل تأجيل أو مراوغة، يظل السؤال مفتوحًا: هل تستطيع هذه السياسات الصمود طويلًا؟ أم أن المستقبل يحمل موجات أعنف لا تنفع معها الحلول الجزئية؟
المستقبل المجهول.. هل ينتهي عصر الغلاء أم يبدأ للتو؟
بعد هذا المسار الطويل الذي أخذنا من المرض الصامت إلى الشارع الغاضب، يظل السؤال الأكبر يطرق الأذهان: هل نحن أمام أزمة عابرة ستنتهي كما انتهت أزمات سابقة، أم أننا ندخل عهدًا جديدًا يُمكن وصفه بـ"عصر الغلاء المستدام"؟ في الحقيقة، تبدو الإجابة أكثر تعقيدًا مما يتصور البعض، لأن التضخم الحالي هو نتاج سلسلة متشابكة من العوامل الصحية والجيوسياسية والبيئية والمالية. ولذلك يخشى كثير من الخبراء أن تكون موجة الغلاء هذه بداية لمرحلة طويلة من عدم الاستقرار.
أحد المؤشرات المقلقة أن التضخم لم يعد مرتبطًا فقط بالأحداث الظرفية مثل جائحة كورونا أو الحرب في أوكرانيا، بل صار يعكس تحولات أعمق في بنية الاقتصاد العالمي. فالانتقال نحو الطاقات النظيفة، والتغير المناخي الذي يهدد المحاصيل الزراعية، والتوترات المستمرة بين القوى الكبرى، كلها عوامل تضيف ضغوطًا مستمرة على الأسعار. بمعنى آخر، قد يكون التضخم القادم ابنًا للتحولات البنيوية لا للأزمات الطارئة، وهو ما يجعل مواجهته أكثر تعقيدًا وأطول زمنًا.
وفي المقابل، ثمة من يراهن على قدرة التكنولوجيا والابتكار على كبح جماح الغلاء. فالتوسع في الرقمنة، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتطوير بدائل للطاقة والغذاء، قد يخفف من حدة الأزمة. غير أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة، ما يجعل أثرها بطيئًا أمام تسارع التضخم اليومي. وهنا يظل الفارق واضحًا: المواطن يحتاج إلى حل فوري لشراء رغيف خبز أو دفع فاتورة كهرباء، بينما الحلول الاستراتيجية قد لا تؤتي أكلها إلا بعد سنوات.
ولعل أكثر ما يثير القلق هو البعد السياسي والاجتماعي للمستقبل. فالتضخم، كما رأينا، لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل تحول إلى عامل يهدد استقرار الحكومات ويفتح الباب أمام احتجاجات قد تتكرر في أكثر من قارة. وإذا استمر الغلاء في تثبيت أقدامه، فإن العالم قد يشهد موجة جديدة من الاضطرابات السياسية، وربما إعادة تشكيل لخريطة التحالفات والأنظمة. فالغلاء لا يعرف الحدود، وهو قادر على أن يربك الموازين الدولية كما أربك الأسواق المحلية.
التضخم صار قصة إنسانية كبرى تبدأ من رغيف الخبز وتنتهي عند استقرار الحكومات. رأيناه "مرضًا صامتًا" تسلل إلى جيوب المواطنين، و"جذورًا ممتدة" من كورونا إلى أوكرانيا، و"سلاسل إمداد" انهارت فاشتعلت الأسعار، وطبقة متوسطة فقدت توازنها، وفقراء سحقهم الجوع، وفواتير غذاء وطاقة التهمت المداخيل. ورأيناه أيضًا يتحول إلى "صندوق اقتراع صامت" يعاقب الحكومات، و"شارع غاضب" يطيح بها، فيما تبقى السياسات بين المراوغة والتأجيل. واليوم، يطل التضخم على العالم كسؤال مفتوح: هل ينتهي عصر الغلاء مع أول انفراج في الأزمات؟ أم أننا ندخل مرحلة جديدة يصبح فيها الجوع بلغة الأرقام العنوان الأبرز لزمن قادم؟
ولفهم هذا الزلزال الصامت الذي يربك الأسواق ويقلب موازين الدول، كان لا بد من العودة إلى جذوره النظرية ومساراته الخفية، حيث تتقاطع الأفكار الاقتصادية مع السياسات النقدية في محاولة لإدراك كيف يولد التضخم، ولماذا يعاند كل محاولات السيطرة عليه، وكيف تحاول الحكومات كبح جماحه عبر أدوات تبدو دقيقة كالإبر، لكنها تُستخدم في جسد اقتصاد ضخم يئن تحت الضغوط. ومن هنا تنطلق آراء مجموعة من الخبراء والباحثين الذين وضعوا هذه الظاهرة تحت المجهر، محللين مفاهيمها، مفككين أسبابها وأنواعها، ومستعرضين تجارب دولية حول سياسات استهداف التضخم، في محاولة للإجابة عن السؤال الجوهري: هل يمكن وقف زحف التضخم قبل أن يلتهم جيوب المواطنين ويزعزع استقرار الحكومات، أم أننا أمام ظاهرة تتطلب أدوات غير تقليدية لفك طوق «جوع الأرقام» الذي يخنق العالم بصمت؟

في زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة، يبقى التضخم أكثر الظواهر الاقتصادية التصاقًا بحياة الناس اليومية، فهو من يحدد ما إذا كانت قوتهم الشرائية في صعود أو انهيار. في مساهمته التحليلية، يقدّم الدكتور جورج ناصر شواقفة، أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد بجامعة عجلون الوطنية في الأردن، قراءة شاملة في مفهوم التضخم، مبرزًا أهم النظريات التي حاولت تفسير أسبابه، ليضع القارئ أمام صورة أوضح لكيفية نشوء هذه الظاهرة ولماذا تظل عصية على السيطرة رغم الجهود المبذولة عبر العقود.

الدكتور جورج ناصر شواقفة - أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد في جامعة عجلون الوطنية – الأردن
من سيولة النقود إلى الإنتاجية.. الطريق البسيط لفهم التضخم
أعطى الدكتور جورج ناصر شواقفة، أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد في جامعة عجلون الوطنية – الأردن، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، قراءة وافية لمفهوم التضخم وأبرز النظريات التي حاولت تفسير أسبابه. وأكد أن التضخم هو انعكاس مباشر لاختلالات عميقة في توازن القوى الاقتصادية، تتجلى بوضوح في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للنقود، وهو ما يجعله واحدا من أكثر الظواهر تأثيرا في حياة الأفراد واستقرار المجتمعات.
يرى الدكتور جورج ناصر شواقفة، أن التضخم يُعد من أبرز الظواهر الاقتصادية التي تترك بصمة واضحة على حياة الأفراد والمجتمعات. وهو لا يقتصر على كونه مجرد رقم يُسجّل في تقارير المؤسسات الدولية، بل هو حالة متواصلة من الارتفاع في المستوى العام للأسعار تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للنقود. ويؤكد أن هذه الظاهرة لا تظهر فجأة، وإنما تتجسد عبر تراكمات تدريجية تجعل المواطن يشعر بأن ما يحمله من نقود لم يعد قادرا على شراء نفس الكمية من السلع والخدمات كما كان في السابق.
ويشير الدكتور شواقفة إلى أن الأدبيات الاقتصادية قد قدّمت تعريفات متعددة للتضخم، لكنها تتفق في جوهرها على فكرة واحدة، وهي أن التضخم يعكس انخفاض القوة الشرائية للنقود. فحين ترتفع الأسعار بشكل عام ومتواصل، تفقد العملة جزءا من قيمتها، ويصبح ما كان يُشترى بمبلغ معين سابقا يتطلب ضعف هذا المبلغ أو أكثر. وهذا يعني أن التضخم، من الناحية العملية، هو الوجه الآخر لغلاء الأسعار ورخص النقود في الوقت ذاته.
ويضيف أن بعض الباحثين ركزوا على زاوية محددة في تعريف التضخم. من خلال تعريفه بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وما يترتب عليه من تدهور في القوة الشرائية للنقود. أو من خلال ربطه بالارتفاع في الدخول النقدية مثل الأجور والأرباح، في إشارة إلى أن الظاهرة لا تنحصر فقط في الأسعار، بل قد ترتبط أيضا بالحركة النقدية نفسها. ومع ذلك، يبقى العامل المشترك بين هذه التعريفات هو أن التضخم يعكس خللا في التوازن الاقتصادي العام.
ومن الناحية الإجرائية، يوضح الدكتور شواقفة أن التضخم يمكن فهمه بوصفه ارتفاعًا مستمرًا وعامًا للأسعار نتيجة الزيادة المفرطة في كمية النقود المتداولة، بالتوازي مع انخفاض القدرة على الحصول على السلع والخدمات. وهذا يعني أن الظاهرة ليست مجرد ارتفاع عابر للأسعار بسبب ظرف طارئ، وإنما هي مسار متواصل يعكس علاقة غير متوازنة بين النقود المتداولة في السوق وما يقابلها من سلع وخدمات حقيقية.
ويخلص في هذا السياق إلى أن التضخم يعبر عن حالة اختلال في توازن القوى الاقتصادية، قد تكون هذه القوى هيكلية أو غير هيكلية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي. فحين يكون هناك فرق بين حجم الطلب الكلي الفعلي على السلع وحجم العرض الكلي الفعلي منها، تظهر فجوة واضحة تنعكس مباشرة في شكل ارتفاع الأسعار السائدة. وهكذا يصبح التضخم مرآة لعدم التوازن في الأسواق، ومؤشرًا على عمق المشكلات التي يعانيها الاقتصاد، سواء في بنيته الداخلية أو في تفاعله مع المؤثرات الخارجية.
من شراهة الطلب إلى ارتفاع التكلفة.. كيف يشتعل التضخم؟
وبعد أن وضع الدكتور جورج ناصر شواقفة الأساس لفهم التضخم بوصفه انعكاسًا لاختلال التوازن بين الطلب والعرض، انتقل إلى عرض أهم النظريات التي حاولت تفسير هذه الظاهرة، وفي مقدمتها نظرية تضخم الطلب وسحب التكلفة. فهذه النظرية تُعد من أبرز الإسهامات الفكرية في تفسير العلاقة بين ارتفاع الأسعار وسلوك الاقتصاد الكلي، لأنها تربط مباشرة بين قوى السوق الأساسية – أي العرض والطلب – وبين مستوى الأسعار السائد.
ويشرح الدكتور شواقفة أن جوهر هذه النظرية يقوم على أن الأسعار ترتفع عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات أكبر من قدرة الاقتصاد على تلبية هذا الطلب عبر العرض الكلي. ففي هذه الحالة، يتولد ضغط مستمر على السوق، حيث يسعى المستهلكون لاقتناء المزيد من السلع، بينما يعجز الإنتاج عن مجاراة هذه الزيادة، ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار. هذا الارتفاع لا يعكس زيادة حقيقية في قيمة السلع بقدر ما يعكس عدم التوازن بين الرغبة في الاستهلاك والقدرة على الإنتاج.
ويضيف أن النظرية لا تتوقف عند جانب الطلب فقط، بل تدمج أيضًا ما يُعرف بـ"سحب التكلفة"، أي الارتفاع في تكاليف الإنتاج الذي يُجبر المنتجين على رفع أسعار السلع. فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع أجور العمال أو أسعار المواد الأولية، تنعكس هذه الزيادات في تكلفة المنتج النهائي، مما يؤدي إلى زيادة عامة في الأسعار. وهكذا يتضح أن التضخم يمكن أن يكون نتيجة ضغط الطلب أو نتيجة ارتفاع التكلفة، أو نتيجة تفاعل الاثنين معًا في وقت واحد.
ويلفت الدكتور شواقفة إلى أن هذه النظرية اهتمت أيضًا ببيان كيفية انتقال أثر التضخم عبر الاقتصاد. فارتفاع الأسعار في قطاع معين – كالطاقة أو الغذاء – سرعان ما ينتقل إلى قطاعات أخرى بسبب الاعتماد المتبادل بين السلع والخدمات. وهنا تظهر الطبيعة "المعدية" للتضخم، حيث تنتشر آثاره بسرعة عبر مختلف مفاصل الاقتصاد. ولذلك يُنظر إلى هذه النظرية باعتبارها من أكثر النماذج قدرة على تفسير اتساع نطاق الظاهرة.
ويخلص إلى أن نظرية تضخم الطلب وسحب التكلفة تقدم إطارًا عمليًا لفهم كيف ولماذا يختلف حجم التضخم بين دولة وأخرى أو بين فترة وأخرى. فهي تُظهر أن السعر النهائي لا يتحدد فقط وفق قوانين العرض والطلب البسيطة، بل يتأثر أيضًا بعوامل مؤسسية مثل سياسات البنوك المركزية وتكاليف الإنتاج. وهذا ما يجعلها نظرية شاملة، لأنها تفسر التضخم باعتباره نتاجًا مباشرًا للتفاعل بين قوى السوق والمتغيرات الاقتصادية الكلية، وتكشف في الوقت ذاته عن هشاشة التوازن الاقتصادي في مواجهة أي اضطراب داخلي أو خارجي.
عندما تصبح النقود هي الملاذ.. قراءة في تفضيل السيولة
وبعد أن عرض الدكتور جورج ناصر شواقفة نظرية تضخم الطلب وسحب التكلفة، أوضح أن فهم التضخم لا يكتمل من دون التطرق إلى نظرية تفضيل السيولة، التي تمثل جانبًا آخر في تفسير الظاهرة من زاوية نقدية بحتة. فهذه النظرية تنطلق من فكرة أساسية مفادها أن النقود تتمتع بأعلى درجات السيولة مقارنة بجميع الأصول الأخرى، أي أنها الأداة الأكثر مرونة وسهولة في التداول والاستخدام، وهو ما يجعلها محط تفضيل الأفراد والمؤسسات.
ويبين الدكتور شواقفة أن النقود، بكونها الأكثر سيولة، تؤثر مباشرة في سلوك الأفراد والشركات على حد سواء. فحين تحتفظ الشركات أو الأفراد بالنقد بدلًا من استثماره في أصول أو مشاريع، فإن كمية النقود المتداولة ترتفع في السوق، وهو ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية. ويصبح التضخم هنا نتيجة طبيعية لتفضيل السيولة على الاستثمار المنتج، إذ تزداد القدرة الشرائية النقدية المتاحة، بينما لا يقابلها بالضرورة زيادة في السلع والخدمات المعروضة.
كما يشير إلى أن هذه النظرية تُبرز العلاقة الوثيقة بين عرض النقود ومستوى الأسعار. فكلما ارتفع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد من دون زيادة مماثلة في الإنتاج، انعكس ذلك على شكل ارتفاع عام في الأسعار. ومن هنا، فإن التحكم في عرض النقود يُعد أحد أهم أدوات السياسات النقدية في مواجهة التضخم. فالبنوك المركزية عندما تتحكم بمعدلات الفائدة أو تضبط حجم الكتلة النقدية، فإنها في الواقع تمارس دورًا أساسيًا في موازنة تفضيل السيولة وتأثيره على الأسعار.
ويؤكد الدكتور شواقفة أن أهمية هذه النظرية تكمن في أنها تكشف جانبًا خفيًا من التضخم، لا يرتبط مباشرة بتكاليف الإنتاج أو طلب المستهلكين، بل يرتبط بعوامل نقدية وسلوكية. فاختيار الأفراد والمؤسسات للاحتفاظ بالنقد يعكس في الوقت ذاته توقعاتهم بشأن المستقبل. فإذا سادت حالة من عدم اليقين أو الخوف من الأزمات، يزداد الميل للاحتفاظ بالنقود، وهو ما يزيد بدوره الضغوط التضخمية، حتى في غياب زيادة حقيقية في الطلب على السلع والخدمات.
ويخلص إلى أن نظرية تفضيل السيولة تضع النقود في قلب تفسير التضخم، إذ تجعل من حركة النقد وسلوك الأفراد والمؤسسات في التعامل معه عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار الأسعار. فهي تؤكد أن التضخم ليس مجرد نتيجة ميكانيكية لاختلال العرض والطلب، بل هو أيضًا نتاج لخيارات نقدية وسلوكيات اقتصادية تحركها التوقعات والمخاوف. وبهذا المعنى، تقدم النظرية رؤية مكمّلة للنظريات الأخرى، لتوضح أن السيطرة على التضخم لا تكون فقط عبر ضبط الأسواق، بل أيضًا عبر إدارة السيولة وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج.
الإنتاجية تحت المجهر.. لماذا يضعف الاقتصاد مع التضخم؟
ويُكمل الدكتور جورج ناصر شواقفة، عرضه لأبرز النظريات المفسرة للتضخم متوقفًا عند نظرية الإنتاجية الحدية، التي تُعد من النظريات المهمة في ربط الظاهرة بمستويات الإنتاج والكفاءة الاقتصادية. فهذه النظرية تنطلق من أن التضخم لا ينشأ فقط من زيادة الطلب أو تفضيل السيولة، بل يرتبط أيضًا بمستوى الإنتاجية في الاقتصاد، أي بقدرة عوامل الإنتاج على تحقيق قيمة مضافة حقيقية.
ويشرح الدكتور شواقفة أن الإنتاجية الحدية تعني ببساطة مقدار الزيادة في الناتج عند إضافة وحدة جديدة من أحد عناصر الإنتاج، مثل العمل أو رأس المال. فإذا كان التضخم مرتفعًا، فإن هذا يضغط على كلفة عناصر الإنتاج، ويؤدي إلى تراجع قدرتها على تحقيق زيادة ملموسة في الناتج. وهنا تظهر العلاقة العكسية: فكلما انخفض التضخم، ارتفعت الإنتاجية، وكلما ارتفع التضخم، تراجعت. وهذه العلاقة تجعل من التضخم عاملًا مؤثرًا في تحديد كفاءة الاقتصاد وقدرته على النمو.
كما يوضح أن النظرية تربط بين التضخم والأرباح بشكل مباشر. ففي حال انخفاض معدلات التضخم، تتحسن بيئة الإنتاج، ويستطيع المستثمرون تحقيق أرباح أكبر بفضل ارتفاع الإنتاجية. أما إذا ارتفعت معدلات التضخم، فإن ارتفاع التكاليف يقلل من هذه الأرباح، ويضعف الحافز على الاستثمار والتوسع. ومن هنا، فإن التضخم لا يُنظر إليه فقط كتهديد للقوة الشرائية للمستهلكين، بل أيضًا كعائق أمام ديناميكية الإنتاج وقدرة الاقتصاد على الابتكار والتجديد.
ويشير الدكتور شواقفة إلى أن أهمية هذه النظرية تكمن في ربطها بين المدى القصير والمدى الطويل. ففي المدى القصير قد يبدو التضخم وسيلة لدفع عجلة الاقتصاد من خلال زيادة الدخول النقدية وتحريك الأسواق، لكن في المدى الطويل يؤدي إلى إضعاف الإنتاجية وتآكل الأرباح، وبالتالي إلى نتائج عكسية تقوّض الاستقرار الاقتصادي. وهذا ما يجعل من السيطرة على التضخم شرطًا أساسيًا لاستمرار النمو المستدام.
ويخلص إلى أن نظرية الإنتاجية الحدية تكمل باقي النظريات بتقديم منظور مختلف: فهي تضع الإنتاج في قلب تفسير الظاهرة، وتبين أن التضخم ليس مجرد نتيجة لتغيرات في الطلب أو العرض النقدي، بل هو أيضًا انعكاس مباشر لمدى قدرة عوامل الإنتاج على العمل بكفاءة. ومن هذا المنطلق، يرى الدكتور شواقفة أن مواجهة التضخم لا تقتصر على ضبط الأسواق أو السيولة النقدية، بل تتطلب أيضًا تعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، حتى يكون الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات والضغوط التضخمية.

إذا كان فهم التضخم كنظرية يساعدنا على إدراك أبعاده العامة، فإن الغوص في جذوره يكشف لنا لماذا يتفشى بهذه السرعة وكيف تتعدد صوره بين اقتصاد وآخر. من هنا، تقودنا الأستاذة هالة أونيس، أستاذة الاقتصاد بجامعة قسنطينة 2، إلى تفكيك خيوط هذه الظاهرة عبر عرض لأسبابها المباشرة وغير المباشرة، وشرح لأنواعها المختلفة، لتضع بين أيدينا مفاتيح أساسية لفهم كيف يتحول التضخم من مجرد أرقام في التقارير إلى واقع يضغط على جيوب المواطنين ويهدد استقرار الحكومات.

الأستاذة هالة أونيس - أستاذة الاقتصاد بجامعة قسنطينة 2
حين تفقد النقود وزنها.. قراءة في وجوه الغلاء الأربعة
عددت الأستاذة هالة أونيس، أستاذة الاقتصاد بجامعة قسنطينة 2، في تصريحها لـ"الأيام نيوز"، أبرز الأسباب التي تقف وراء ظاهرة التضخم، مبرزة في الوقت ذاته أهم أنواعه التي تتجلى في الاقتصادات العالمية بدرجات متفاوتة. وأكدت أن التضخم ليس نتيجة عامل واحد فقط، وإنما هو حصيلة مجموعة من العوامل النقدية والمالية والإنتاجية وحتى الخارجية، الأمر الذي يجعله من أكثر التحديات تعقيدًا أمام استقرار الاقتصاديات الوطنية.
أوضحت الأستاذة هالة أونيس، أن التضخم يُعتبر في جوهره ظاهرة نقدية بحتة حين يتجاوز عرض النقود معدل نمو الإنتاج، فتكون النتيجة الطبيعية هي ارتفاع الأسعار بشكل متواصل. فعندما تضخ الحكومات أو الأنظمة النقدية كميات كبيرة من النقود في الاقتصاد من دون أن يقابلها ارتفاع مماثل في حجم السلع والخدمات، تصبح النقود المتداولة أكبر من حجم ما هو معروض في السوق. وهذا الخلل يترجم مباشرة إلى غلاء الأسعار، لأن القيمة الشرائية للنقود تتراجع أمام محدودية العرض.
وأضافت أن من بين الأسباب الرئيسية للتضخم أيضًا لجوء الحكومات إلى تمويل عجز الموازنات العامة عبر سياسات مالية توسعية. فحين لا تكفي الإيرادات لتغطية النفقات، تلجأ الدولة إلى الاستدانة أو طباعة النقود لتغطية الفجوة، وهو ما يؤدي إلى ضخ سيولة إضافية في السوق تزيد الضغوط على الأسعار. هذه السياسة قد تبدو حلاً قصير الأمد لمعالجة الأزمات المالية، لكنها على المدى الطويل تولد موجات تضخمية ترهق الاقتصاد وتضعف الاستقرار النقدي.
كما لفتت أونيس إلى أن التضخم يرتبط مباشرة بالتقلبات في الطلب الكلي والعرض الكلي. فعندما يزيد الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنفاق الحكومي بما يفوق قدرة العرض على تلبية هذه الزيادة، ينشأ تضخم سببه قصور الإنتاج عن مجاراة الطلب. وهذا ما يفسر كيف أن أي تحرك غير متوازن في عناصر الاقتصاد الكلي قد يُترجم سريعًا إلى موجة غلاء عامة، إذ يتحول فائض الطلب إلى قوة دافعة للأسعار نحو الأعلى.
وبيّنت أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يمثل بدوره عاملًا رئيسيًا في تغذية التضخم. فكلما ارتفعت الأجور أو أسعار المواد الأولية أو عناصر الإنتاج الأخرى، يعمد المنتجون إلى رفع أسعار السلع لتعويض هذه التكاليف الإضافية. وبذلك يصبح التضخم انعكاسًا مباشرًا لزيادة كلفة الإنتاج، وهو ما يُعرف بتضخم التكاليف. وهذا النوع من التضخم يفرض ضغوطًا مزدوجة، إذ يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، ويثقل كاهل المؤسسات المنتجة من جهة أخرى.
واختتمت أونيس حديثها حول الأسباب مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الأجور بشكل يفوق نمو الإنتاجية لأسباب سياسية أو اجتماعية يساهم كذلك في إذكاء التضخم، إضافة إلى الضعف المصرفي الذي يميز العديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة التوسع المفرط في منح القروض. فكلما تزايد الإقراض بلا ضوابط صارمة، ارتفع حجم السيولة في السوق من دون أن يقابلها إنتاج فعلي، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع عام في الأسعار. وهذه العوامل مجتمعة تبرز أن التضخم ليس سببًا واحدًا، بل هو محصلة تراكمات معقدة تتشابك فيها السياسات المالية والنقدية مع العوامل الاجتماعية والإنتاجية.
عندما تترك الأسعار حرة… يولد التضخم الظاهر
وأكدت الأستاذة هالة أونيس، أن أول أنواع التضخم يتمثل فيما يُعرف بـ"التضخم الظاهر" أو "الحقيقي"، ويُطلق عليه أيضًا "التضخم المفتوح". ويُقصد به الحالة التي ترتفع فيها الأسعار بشكل حرّ من دون تدخل الدولة في تحديدها أو ضبطها، بحيث يترك السوق لقوانين العرض والطلب وحدها مهمة تحديد المستويات السعرية. وهذا النوع يعكس الصورة الطبيعية للتضخم حين يكون السوق متروكًا لآليات التوازن التقليدية بين ما يُعرض من سلع وخدمات وما يُطلب منها.
وأوضحت أن التضخم الظاهر غالبًا ما يُعتبر أحد أهم أشكال التضخم التي تواجهها الاقتصادات في سياق تطورها، لأنه يظهر بوضوح في الدول التي تمتلك جهازًا إنتاجيًا مرنًا وقادرًا على الاستجابة للتغيرات، وكذلك في الاقتصادات المتقدمة التي تعتمد على آليات السوق المفتوح. ففي مثل هذه الحالات، تكون الأسعار مرآة حقيقية للتفاعل بين العرض والطلب، ومع ذلك فإنها تعكس أيضًا الضغوط التضخمية الناتجة عن أي اختلال بين الجانبين.
وأضافت أن هذا النوع من التضخم يمكن أن يظهر كذلك في الدول السائرة في طريق النمو، حيث تتوسع قاعدة الإنتاج تدريجيًا لكن لا تزال غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد. وفي هذه الحالة، تصبح الأسعار عرضة لارتفاعات مستمرة كلما تجاوز الطلب قدرة العرض على التلبية، وهو ما يجعل التضخم الظاهر مؤشرًا على محدودية الطاقة الإنتاجية من جهة، وعلى تنامي الحاجة إلى تنظيم السياسات الاقتصادية من جهة أخرى.
كما بيّنت أن التضخم الظاهر يضع الحكومات أمام معادلة صعبة، فهي من جهة تُدرك أن الأسعار تعكس التوازن الطبيعي بين قوى السوق، ومن جهة أخرى تجد نفسها مضطرة للتدخل إذا تجاوزت هذه الارتفاعات حدودًا معينة تهدد الاستقرار الاجتماعي. وهنا يتضح أن ترك الأسعار حرة لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد محصّن من آثار التضخم، بل إن التجربة أثبتت أن الحرية المطلقة للأسعار قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى اضطرابات اقتصادية أوسع.
وتؤكد أونيس على أن التضخم الظاهر ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو صورة حقيقية لما يواجهه الاقتصاد من تحديات داخلية. فهو يكشف عن مدى كفاءة السوق في الاستجابة للطلب، وعن قدرة العرض على مواكبة الاستهلاك، وعن حدود التدخل الحكومي في تسيير النشاط الاقتصادي. لذلك يُنظر إليه كنوع أساسي من أنواع التضخم التي تُقاس بها حيوية الاقتصاد ودرجة مرونته أمام التحولات.
تجميد الأسعار قسرًا.. تضخم يخفي أزماته تحت السطح
وأشارت الأستاذة هالة أونيس، إلى أن النوع الثاني من التضخم هو ما يُعرف بـ"التضخم المكبوت"، وهو حالة تختلف تمامًا عن التضخم الظاهر. ففي حين تعكس الأسعار في التضخم الظاهر حركة العرض والطلب بشكل حرّ، فإن التضخم المكبوت ينشأ عندما تتدخل السلطات الحكومية مباشرة لتحديد المستويات العليا للأسعار، ومنعها من الارتفاع إلى مستوياتها الطبيعية. وبذلك يبدو المشهد السعري هادئًا ومتحكمًا فيه ظاهريًا، بينما الحقيقة أن الضغوط التضخمية تظل قائمة في الخلفية.
وأوضحت أن التضخم المكبوت هو نتيجة مباشرة لسياسات الدولة الهادفة إلى الحد من استمرارية الارتفاعات السعرية واستفحالها. فبدل أن تسمح للأسعار بأن تعكس التوازن الحقيقي بين العرض والطلب، تضع الدولة سقوفًا سعرية وتفرض رقابة تموينية صارمة لضبط الأسواق. هذه الآلية قد تُعطي انطباعًا بأن الأسعار مستقرة، لكنها في الواقع تؤجل فقط ظهور المشكلة، لأن جذور التضخم تبقى قائمة ومؤثرة.
وأضافت أن هذا النوع من التضخم غالبًا ما يظهر في الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المخططة مركزيًا، أو تلك التي تسيطر فيها الدولة على عناصر الإنتاج والتوزيع بشكل كامل. ففي مثل هذه الاقتصادات، تعتمد الحكومات على التسعير الجبري كوسيلة للتحكم في السوق، لكن هذا التدخل لا يلغي الظاهرة، بل يخلق فجوة بين الأسعار المفروضة إداريًا والواقع الاقتصادي الفعلي. ومع مرور الوقت، تتفاقم هذه الفجوة لتتحول إلى أزمات أعمق مثل نقص السلع أو ظهور الأسواق الموازية.
وبيّنت أونيس أن خطورة التضخم المكبوت تكمن في كونه ظاهرة خفية، لا يلمسها المواطن بشكل مباشر في البداية بسبب ثبات الأسعار، لكنه يعاني آثارها لاحقًا في شكل ندرة السلع أو تراجع جودتها. كما أن تراكم هذه الأوضاع قد يؤدي إلى انفجار سعري مفاجئ بمجرد رفع الدولة للقيود، فتقفز الأسعار بسرعة لتعكس مستوياتها الحقيقية، مسببة صدمة اقتصادية واجتماعية.
واختتمت بالقول إن التضخم المكبوت يوضح بجلاء أن التدخل الإداري وحده ليس حلاً طويل الأمد لمواجهة التضخم. فالتسعير الجبري والرقابة الصارمة قد يهدئان السوق مؤقتًا، لكنهما لا يعالجان الأسباب الجذرية للظاهرة. لذلك، يبقى التضخم المكبوت مؤشرًا على غياب التوازن الحقيقي في الاقتصاد، وعلى الحاجة إلى إصلاحات أعمق تضمن استقرار الأسعار من خلال معالجة العوامل الهيكلية لا عبر القرارات الظرفية.
غلاء يعبر الحدود.. كيف تنتقل الأسعار العالمية إلى جيوبنا؟
وتشير الأستاذة هالة أونيس، الى نوع آخر من أنواع التضخم يتمثل فيما يُعرف بـ"التضخم المستورد". ويظهر هذا الشكل من التضخم عندما ترتفع الأسعار العالمية للسلع والخدمات، فينعكس ذلك مباشرة على الأسعار المحلية في الدول المستوردة. فاقتصادات عديدة تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الأولية أو السلع الوسيطية أو حتى السلع النهائية، ومع أي زيادة في أسعارها على المستوى الدولي، تنتقل هذه الزيادة تلقائيًا إلى الأسواق الداخلية.
وبيّنت أن التضخم المستورد لا يرتبط فقط بارتفاع أسعار الغذاء أو الطاقة عالميًا، بل يشمل أيضًا مختلف السلع والخدمات التي تدخل عبر السوق الدولية. فإذا ارتفعت كلفة استيراد المواد الأولية أو السلع المصنعة أو حتى بعض الخدمات، فإن المنتجين المحليين يجدون أنفسهم مضطرين لرفع الأسعار لتعويض الزيادة. وهكذا يصبح المستهلك المحلي رهينة لتقلبات الأسواق العالمية التي لا يملك أي سيطرة عليها.
وأضافت أن هذا النوع من التضخم يتضح أكثر في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الخارج لتأمين احتياجاتها. ففي هذه الحالات، يكون الاقتصاد الوطني هشًا أمام أي تغيرات في الأسعار الدولية، سواء كانت نتيجة الأزمات الجيوسياسية، أو تقلبات أسعار النفط، أو حتى التحولات المناخية التي تؤثر في المحاصيل الزراعية. ومع كل أزمة عالمية، ترتفع الأسعار داخليًا حتى لو لم يتغير حجم الإنتاج المحلي.
كما لفتت إلى أن التضخم المستورد يمثل تحديًا خاصًا للحكومات، لأنه لا ينشأ من عوامل داخلية يمكن التحكم فيها عبر السياسات النقدية أو المالية، بل يأتي من الخارج. وهذا يضع صناع القرار أمام معضلة حقيقية، إذ عليهم مواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية من دون امتلاك أدوات مباشرة لتغيير مسارها. وغالبًا ما تلجأ الدول في هذه الحالة إلى دعم بعض السلع أو فرض قيود مؤقتة على الاستيراد، لكنها حلول جزئية لا تمنع الظاهرة من الاستمرار.
واختتمت أونيس بالقول إن التضخم المستورد يكشف الترابط الوثيق بين الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي. ففي عالم العولمة وسلاسل الإمداد المتشابكة، لم يعد التضخم شأنًا داخليًا بحتًا، بل أصبح انعكاسًا لتقلبات الأسواق الدولية. ولذلك ترى أن مواجهة هذا النوع من التضخم تتطلب استراتيجيات بعيدة المدى، مثل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، بدلًا من الاكتفاء بالحلول الظرفية التي لا تصمد أمام الأزمات العالمية.
حين تفقد النقود قيمتها.. ملامح الكارثة المسماة بالتضخم المفرط
كما تشير الأستاذة هالة أونيس، الى أن أخطر أشكال التضخم يتمثل فيما يُعرف بـ"التضخم المفرط". ويُقصد به الارتفاع الكبير والمتسارع في الأسعار إلى درجة تفقد فيها النقود قيمتها الأساسية كوسيلة للتبادل ومخزن للقيمة. ففي ظل هذا النوع من التضخم، تصبح النقود عاجزة عن أداء دورها، إذ يتزايد تداولها بسرعة، لكن قدرتها الشرائية تتراجع بشكل حاد، ما يُدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى النقدية.
وبيّنت أن التضخم المفرط ليس مجرد ارتفاع اعتيادي للأسعار كما في الأنواع الأخرى، بل هو حالة قصوى تؤدي إلى انهيار الثقة في العملة الوطنية. فإذا استمر هذا التضخم من دون ضوابط، يفقد الناس إيمانهم بالنقود ويتجهون إلى البحث عن بدائل للتبادل مثل العملات الأجنبية أو حتى المقايضة. وهذا الوضع يؤدي إلى تآكل النظام النقدي برمته، ويدفع الاقتصاد نحو أزمة خانقة.
وأضافت أن التاريخ يقدم أمثلة عديدة على التضخم المفرط، خاصة بعد الحروب الكبرى. فقد شهدت بعض الدول عقب الحرب العالمية الثانية معدلات تضخم مدمرة أدت إلى انهيار أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذه الحالات، لم يعد بالإمكان التحكم في الأسعار أو استعادة استقرار العملة بسهولة، بل احتاجت الدول إلى إصلاحات جذرية وإعادة بناء مؤسساتها النقدية والمالية من الصفر.
كما أشارت أونيس إلى أن خطورة التضخم المفرط لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الجوانب السياسية والاجتماعية. فهو يزعزع استقرار الحكومات، ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، إذ يجد المواطن نفسه عاجزًا عن تلبية أبسط حاجاته اليومية. ومع فقدان الثقة في العملة والنظام الاقتصادي، يتراجع الاستقرار السياسي، وتظهر موجات من الاحتجاجات التي قد تهدد كيان الدولة ذاته.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التضخم المفرط يمثل حالة قصوى يجب على الحكومات أن تتفادى الوصول إليها بكل الوسائل الممكنة. فبينما قد تتمكن السياسات النقدية والمالية من التعامل مع الأنواع الأخرى من التضخم بدرجات متفاوتة، فإن السيطرة على التضخم المفرط تكاد تكون شبه مستحيلة بعد تفاقمه. ومن هنا، ترى أن الوقاية من هذه الظاهرة عبر سياسات اقتصادية رشيدة تبقى الخيار الأنجع لحماية الاقتصاد والمجتمع من تداعياتها الكارثية.

بعد أن تعرفنا على التضخم وأسبابه وأنواعه، نصل إلى سؤال محوري: كيف يمكن للدول أن تواجه هذه الظاهرة وتضبطها؟ في هذا السياق، يقدّم الدكتور بن مريم محمد، أستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، شرحًا مبسطًا لسياسة استهداف التضخم باعتبارها أداة حديثة للسيطرة على الأسعار. ومن خلال تعريف واضح لهذه السياسة، ثم استعراض لعلاقتها بالناتج الاقتصادي، يضعنا أمام صورة أقرب لفهم كيف يمكن تحويل الأرقام إلى بوصلة توجه السياسات النقدية.

بقلم: الدكتور بن مريم محمد - أستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف
من نيوزيلندا إلى الجزائر.. رحلة استهداف التضخم بين النظرية والتطبيق
سعت كل الدول إلى مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها خطرًا حقيقيًا على النشاط الاقتصادي، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وتولدت قناعات راسخة لدى واضعي السياسة النقدية بأن استقرار الأسعار يجب أن يكون الهدف الطويل المدى للسياسة النقدية. وتبيّن أيضًا منذ نهاية الثمانينيات أن التأثير على التضخم بشكل غير مباشر عن طريق المقاربة التقليدية القائمة على التحكم في المتغيرات الوسيطة (الاستهدافات الوسيطة التقليدية) كمعدلات الفائدة، سعر الصرف والمجاميع النقدية لم تكن فعّالة في تحقيق ذلك الهدف، مما دفع إلى تبني أسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية مبني على مقاربة مباشرة للحد من التضخم، سواء من قبل بعض الدول المتقدمة أو النامية مع بداية التسعينيات. ويُعرف هذا الأسلوب بسياسة استهداف التضخم (Inflation Targeting Policy)، وتُعتبر نيوزيلندا أول دولة تبنّت استهداف معدل التضخم سنة 1990، وفتحت الطريق للدول الصناعية الأخرى والناشئة لاتباع هذه السياسة بهدف تخفيض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة.
إن الارتفاع المستمر للأسعار يشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار النشاط الاقتصادي في أي دولة، إلا أن الآثار السلبية للتضخم تكون أكبر وأعمق في الدول النامية. ولقد تولدت القناعة لدى العديد من الأكاديميين ومخططي السياسة النقدية بأن استقرار الأسعار يجب أن يكون الهدف الطويل الأجل للسياسة النقدية، وهو الأمر الذي دفع بعدد من الدول الصناعية والنامية منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين إلى تبني سياسة استهداف التضخم.
استهداف التضخم… خطوة نحو استقرار الأسعار أم عائق أمام النمو؟
تُعد سياسة استهداف التضخم إطارًا حديثًا نسبيًا لإدارة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، وذلك من خلال التركيز على معدل التضخم. وتتمثل هذه السياسة في إعلان صريح من قبل السلطة النقدية بأن هدف السياسة النقدية هو تحقيق مستوى محدد لمعدل التضخم خلال فترة زمنية معينة.
تعرّف سياسة استهداف التضخم على أنها استراتيجية للسياسة النقدية تتضمن خمسة عناصر: الإعلان العام عن أهداف رقمية للتضخم في الأجل المتوسط؛ الالتزام باستقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية؛ اعتماد استراتيجية شاملة للمعلومات التي تتضمن العديد من المتغيرات؛ زيادة الشفافية في استراتيجية السياسة النقدية من خلال الاتصال بالجمهور والأسواق حول الخطط والأهداف والقرارات المتخذة من السلطات النقدية؛ وأخيرًا، تعزيز المساءلة للبنك المركزي لتحقيق الأهداف المسطرة حول معدل التضخم.
فهي بالتالي سياسة نقدية يتم فيها الإعلان لعامة الجمهور عن هدف معين لمعدل التضخم والسعي لتحقيقه من خلال إدارة أدوات السياسة النقدية، مثل استخدام سعر الفائدة لتوجيه معدل التضخم الفعلي نحو المطلوب أو المرغوب.
ويُعتبر استهداف التضخم إطارًا للسياسة النقدية يمكّن البنك المركزي من ضمان انخفاض معدلات التضخم، ويتمثل هذا الاستهداف في تحديد معدل أو مجال للتضخم تعمل السلطات النقدية على تحقيقه في غضون الفترة المحددة مسبقًا. ويتيح هذا الإجراء الإعلان عن توقعات التضخم في وقت مبكر، وكذا رسم التدابير اللازمة للسيطرة على الأسعار. وعموماً، يتطلب استهداف التضخم من البنك المركزي حدًا أدنى من الاستقلالية وإنشاء نظام ملائم للتحليل والتنبؤ.
ويُعرّف أيضًا على أنه نظام للسياسة النقدية يتميز بالإعلان عن الهدف الرسمي أو هدف كمي لمعدل التضخم، ويُعتبر تخفيض معدل التضخم في الأجل الطويل أهم أهداف السلطات النقدية، وذلك من خلال توفر ثلاثة شروط أساسية لاستهداف التضخم: استقلالية البنك المركزي. والتضخم هو الاستهداف الوحيد. ووجود علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية والتضخم وإمكانية التنبؤ بها.
نلاحظ أن التعريف الأول تضمن كل المتطلبات التي تجعلنا نقول عن الدول التي تستوفيها إنها تطبق سياسة استهداف التضخم، بينما ركزت التعريفات الأخرى على الشروط الأساسية لاستهداف التضخم، كأن تكون هناك علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم، وأن يمكن التنبؤ بها. فاستقرار هذه العلاقة يمكّن السلطات النقدية من توجيه معدل التضخم الفعلي للوصول به إلى المعدل المستهدف.
ومن خلال التعاريف السابقة، يمكن أن نعرّف سياسة استهداف التضخم على أنها سياسة تتضمن الإعلان العام عن هدف كمي لمعدل التضخم يمكن التنبؤ به، ويتم التركيز على تحقيقه كهدف رئيسي للسياسة النقدية في المدى الطويل، في ظل وجود شروط معينة مثل استقلالية البنك المركزي واستقرار العلاقة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم.
بين التضخم وتقلب الناتج.. ماذا تقول النظريات الاقتصادية؟
لا يزال موضوع العلاقة بين تطبيق سياسة استهداف التضخم وتأثيرها على تقلبات الناتج حديثًا نسبيًا، إذ لم يتم اعتماد هذا الأسلوب الحديث لإدارة السياسة النقدية إلا ابتداءً من تسعينيات القرن العشرين فقط. وبرغم الفترة القصيرة لتطبيق هذه السياسة، فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من الباحثين وصانعي السياسات الاقتصادية، حيث ركزوا على العلاقة بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي، خاصة بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي. وقد بحثوا في طبيعة هذه العلاقة وكيفية تأثير التضخم أو الكتلة النقدية على النمو الاقتصادي، إما عن طريق تكوين نماذج رياضية لإثبات هذه العلاقة، أو من خلال دراسات تجريبية على العديد من البلدان عبر عينات إحصائية، أو بدراستها في بلد معين.
التضخم والناتج.. خيوط علاقة تكشفها التحليلات
إن تحليل العلاقة النظرية بين تأثير التضخم على تقلبات الناتج يستمد أساسه من العلاقة النظرية بين التضخم والنمو الاقتصادي. فلا توجد نظريات مستقلة بذاتها درست العلاقة بين استهداف التضخم وتقلبات الناتج، بل جرى الاعتماد على التأصيل النظري بين التضخم والنمو الاقتصادي لفهم وتفسير العلاقة النظرية بين استهداف التضخم وتقلب الناتج.
ويُعتبر نموذج Tobin (1956) أول نموذج أظهر إمكانية تأثير النقود على مستوى النشاط من خلال تعديل محفظة العائلات، كما وضّح التأثير الإيجابي لزيادة التضخم على مستوى النشاط في المدى البعيد. فقد اعتبر النقود كأصل مالي، وإذا انخفضت مردودية النقود تحت تأثير التضخم، فإن الأفراد يفضّلون الاحتفاظ بالأصول الحقيقية في محافظهم، وهذا يفسَّر بارتفاع في الاستثمار وبالتالي نمو أكبر، أي أن ارتفاع التضخم يساهم بطريقة غير مباشرة في زيادة نمو الناتج. ويتفق هذا التفسير مع نهج منحنى فيليبس الذي يربط بين التضخم والبطالة، حيث يفترض أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض في معدلات البطالة، وبالتالي يؤثر إيجابيًا على النمو.
وفي المقابل، قدّم Sidrauski (1967) تفسيرًا نظريًا معاكسًا لنموذج Tobin، حيث افترض أن النقود تُعد من بين مركبات دالة المنفعة للعائلات، لأنها تعطي تدفقًا من الخدمات الناتجة عن حيازتها. ووفقًا لنتائج نموذجه، فإن النقود تُظهر حيادية كبيرة، أي ليس لها أي أثر لا في المدى القصير ولا في المدى الطويل، وبالتالي ليس لها تأثير على نمو الناتج. وفي هذا النموذج، يتحدد معدل نمو الناتج بصورة خارجية عن طريق معدل نمو الاستبقاء. كما قام Gylfason (1991) باشتقاق علاقة ارتباط سالبة بين معدل التضخم ومعدل نمو الناتج في المدى الطويل.
ومن هنا نستخلص أن هناك اختلافًا وعدم اتفاق نظري حول طبيعة العلاقة بين استهداف التضخم وتقلبات الناتج، أو حتى بين التضخم والنمو الاقتصادي. فقد تباينت الآراء حول ما إذا كان التضخم مؤشرًا إيجابيًا للنمو أم عقبة أمامه، مما يطرح السؤال: هل تنطبق هذه التباينات على نتائج الدراسات التطبيقية التي اختبرت هذه العلاقة؟
من النظريات إلى الأرقام.. نتائج تكشف أثر التضخم على النمو
توصلت نتائج دراستين تجريبيتين لكل من Taoufik & Villieu وPatrick Rajhi من خلال عينة إحصائية مكونة من 61 دولة للفترة (1960-1985) والولايات المتحدة الأمريكية للفترة (1950-1987)، إلى أن هناك تأثيرًا سلبيًا للتضخم على نمو الناتج، مع استمرار تأثير الصدمات النقدية في المدى الطويل على الناتج الداخلي الخام.
بينما يرى Rajhi أن هناك علاقة ارتباط موجبة بين تطور الكتلة النقدية ونمو الناتج على المدى الطويل بالنسبة للدول التي يكون معدل التضخم المتوسط فيها ضعيفًا (دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)
وقد وضع كل من Bruno Olivier & Musso Patrick نموذجًا يوضح العلاقة بين النقود ونمو الناتج بالتركيز على العلاقة بين التضخم والنمو، وتوصلا إلى أن استهداف التضخم (أي تخفيض معدل التضخم إلى الصفر) يؤدي إلى انخفاض محسوس في معدل ادخار العائلات، وبالتالي تباطؤ في النمو الاقتصادي، إلى جانب وجود علاقة سلبية بين تقلبات التضخم وتقلبات الناتج، خاصة إذا كانت معدلات التضخم مرتفعة.
وفي دراسة لـ Roger Scott حول تقلبات التضخم والناتج خلال الفترتين (1991-2000) و(2001-2009)، أي منذ بداية اعتماد سياسة استهداف التضخم قبل عشرين سنة، توصل إلى عدة نتائج من بينها:
أشار إلى أن البنوك المركزية لا يمكنها من خلال السياسة النقدية تحقيق مختلف الأهداف المتضاربة (مربع كالدور)، وبالتالي عليها ألا تركز فقط على تخفيض معدل التضخم في كل الأوقات، وإنما تنصرف إلى تحقيق أهداف أخرى على المدى المتوسط، في مقدمتها زيادة الناتج.
تعرضت كل من الاقتصادات منخفضة الدخل المستهدفة وغير المستهدفة للتضخم لانخفاضات كبيرة في تقلبات التضخم والناتج، مع تحقيق البلدان التي اعتمدت نهج استهداف التضخم انخفاضات أكبر خاصة في تقلب التضخم.
أما الاقتصادات مرتفعة الدخل فقد شهدت البلدان المستهدفة للتضخم تراجعًا ضئيلاً في تقلب الناتج بين الفترتين، في حين أن البلدان غير المستهدفة للتضخم شهدت تقلبًا أكبر في الناتج.
ومن خلال ما سبق، يمكن القول إنه لا يوجد توافق نظري ولا تطبيقي حول علاقة تأثير التغير في معدل التضخم على التغير في معدل نمو الناتج. فقد تأخذ هذه العلاقة أثرًا إيجابيًا أو سلبيًا للتضخم على نمو الناتج. وبالتالي، فإن اعتماد سياسة استهداف التضخم لا يقدم تفسيرًا كاملاً وواضحًا لتقلبات الناتج.

إذا كان استهداف التضخم يبدو كأداة قادرة على ضبط الأسعار، فإن نجاحه لا يتحقق إلا بتوفر شروط أساسية. هنا تأخذنا الأستاذة دين مختارية، من المركز الجامعي الشريف بوشوشة بآفلو، إلى عمق هذه الشروط التي تُعتبر المفتاح لأي تجربة ناجحة. فهي توضّح كيف أن استقلالية البنك المركزي، وشفافية السياسات النقدية، إضافة إلى الانسجام بين القرار الاقتصادي والسياسي، تشكّل الأرضية الصلبة التي يقوم عليها استقرار الأسعار واستعادة ثقة الأسواق.

دين مختارية - أستاذة جامعية بالمركز الجامعي الشريف بوشوشة بآفلو – ولاية الأغواط
السياسة النقدية على المحك.. متى ينجح استهداف التضخم في حماية الأسعار؟
تشدد الأستاذة دين مختارية، أستاذة جامعية بالمركز الجامعي الشريف بوشوشة بآفلو – ولاية الأغواط، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، على أن استهداف التضخم غدا أداة عملية تنتهجها البنوك المركزية حول العالم لضبط إيقاع الأسعار وحماية الاستقرار النقدي. وأوضحت أن الحديث عن الشروط العامة والأولية لهذه السياسة هو ضرورة لضمان فاعلية الأدوات المالية في مواجهة الضغوط التضخمية، خاصة في ظل تقلبات اقتصادية عالمية تفرض على الدول البحث عن مقاربات أكثر دقة وشفافية لإدارة سياستها النقدية.
توضح الأستاذة دين مختارية أن استهداف التضخم برز كخيار حديث لإدارة السياسة النقدية، بعدما أولت البنوك المركزية اهتمامًا متزايدًا باستقرار الأسعار وجعلته في صدارة أولوياتها. ففكرة التحكم في التضخم لم تعد مقتصرة على متابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل تقليدي، وإنما أصبحت تقوم على تحديد أهداف واضحة ومعلنة للرأي العام، تعكس نضجًا مؤسساتيًا ورغبة في تعزيز ثقة المواطنين بالسياسة النقدية.
وتشير الأستاذة إلى أن هذا التوجه يقوم على أساس بسيط لكنه عميق: التزام البنك المركزي بنسبة معينة من التضخم، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، خلال فترة زمنية محددة، ليصبح مسؤولاً أمام المجتمع عن تحقيقها. وهنا لا يقتصر الأمر على تحديد رقم تقني، بل يتجاوز ذلك إلى تعزيز الشفافية وضمان تواصل مستمر مع الرأي العام بشأن مسار الأسعار والقرارات المتخذة للتحكم بها.
وترى أن نجاح هذه السياسة يرتبط بمدى حرية البنك المركزي في توظيف أدواته المختلفة، بعيدًا عن الضغوط الخارجية. فالاستقلالية هنا شرطًا عمليًا يمكّن المؤسسة النقدية من التحرك بمرونة لامتصاص الصدمات الاقتصادية، مع توفير معلومات عامة ومنتظمة حول استراتيجيتها لتفادي أي غموض أو ارتباك في الأسواق.
وبذلك يصبح استهداف التضخم إطارًا شاملًا يحدد العلاقة بين البنك المركزي والجمهور، حيث يَعد البنك بتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، ويُسأل في الوقت نفسه عن أي انحراف عن الهدف المعلن. وهو ما يجعل هذه السياسة أقرب إلى عقد ثقة متبادل بين المؤسسات النقدية والمجتمع، غايته النهائية تعزيز مصداقية الدولة في مواجهة واحدة من أعقد التحديات الاقتصادية.
شروط عامة تضع استقرار الأسعار في صدارة الأولويات
وتؤكد الأستاذة دين مختارية أن الحديث عن استهداف التضخم لا يمكن أن ينفصل عن الشروط العامة التي تضمن فعاليته. فهذه الشروط تمثل الخصائص الجوهرية التي يجب أن تتميز بها أي دولة تسعى لاعتماد هذه السياسة النقدية. وإذا غاب أحدها، فإن التجربة تصبح ناقصة وقد تفشل في تحقيق أهدافها.
أول هذه الشروط هو الالتزام المؤسساتي الواضح بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأول للسياسة النقدية. ويعني ذلك أن يكون هناك تعهد طويل الأمد من طرف السلطات النقدية يجعل من التحكم في التضخم أولوية قصوى، بعيدًا عن الأهداف الثانوية التي قد تُربك المسار وتضعف النتائج.
كما تضيف أن نجاح هذا التوجه يتطلب آلية فنية متقدمة لدى البنك المركزي، تمكّنه من قياس معدل التضخم المحلي بشكل دقيق، وإخضاعه لمساءلة مباشرة حول مدى تحقيق الهدف المعلن. وفي حال حدوث أي انحراف، يجب أن يقدم البنك تفسيرات مقبولة للرأي العام، وهو ما يعزز روح الشفافية ويرفع منسوب الثقة في المؤسسة النقدية.
وتشير إلى أن الشروط العامة تشمل أيضًا اعتماد استراتيجية معلومات شاملة لا تقتصر على الأرقام النقدية أو أسعار الصرف فقط، بل تجمع بين مختلف المتغيرات الاقتصادية المؤثرة. وهذا ما يمكّن البنك المركزي من بناء توقعات أكثر واقعية بشأن التضخم، ويتيح له التنبؤ بمساره في وقت مبكر، ومن ثم وضع التدابير الملائمة للسيطرة على الأسعار قبل انفلاتها.
الاستقلالية والوضوح… مفاتيح النجاح في مواجهة التضخم
كما توضح الأستاذة دين مختارية أن الشروط الأولية لاستهداف التضخم تمثل حجر الزاوية في نجاح هذه السياسة، فهي ليست مجرد مكمل للشروط العامة، بل ركيزة أساسية تضمن استمرارية الاستقرار النقدي على المدى الطويل. وتبرز في مقدمة هذه الشروط مسألة الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي، إذ لا يمكن الحديث عن ضبط التضخم في ظل خضوعه لتوجيهات تمويل العجز الحكومي أو انشغاله بأهداف متناقضة.
وتشير إلى أن استقلالية البنك المركزي تعني أن تكون أدواته النقدية موجهة بشكل فعال نحو هدف وحيد هو التحكم في معدل التضخم، مع إبعادها عن أي تدخل سياسي أو تمويل لعجز الموازنة. وبهذا يصبح البنك أكثر قدرة على استخدام سعر الفائدة والسياسة النقدية بمرونة ودون ضغوط، بما يساعد على استقرار التضخم وضمان ثقة المتعاملين الاقتصاديين.
كما تضيف أن وضوح الهدف يعد من بين أهم المتطلبات الأولية، إذ يجب أن يكون التضخم هو الهدف الوحيد للبنك المركزي، دون مزاحمة من أهداف أخرى قد تتعارض معه. فالتجارب العالمية أثبتت أن تعدد الأهداف يؤدي غالبًا إلى فشل في تحقيق أي منها في الوقت المحدد، وهو ما يقوّض مصداقية السلطة النقدية ويفقدها ثقة الأسواق.
وتبرز أيضًا أهمية وجود علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم، وهو ما يفرض على البنك المركزي أن يمتلك نموذجًا حركيًا يتيح التنبؤ بمسار الأسعار بدقة. لكن هذه المهمة ليست سهلة، خاصة في الدول التي تعاني من تأخيرات زمنية طويلة لفاعلية أدواتها النقدية. وهنا تكمن إحدى التحديات الكبرى في ضمان أن تؤدي هذه الأدوات إلى نتائج ملموسة على التضخم دون فقدان المصداقية.
وتؤكد أن حتى في حال استيفاء بعض هذه الشروط الأولية بشكل جزئي أو كامل، يمكن للسلطات النقدية أن تقترب من تحقيق معدلات استقرار معقولة للتضخم. لكن النجاح الحقيقي يظل مرهونًا بقدرة البنك المركزي على ترسيخ استقلاليته، وضبط أدواته بمرونة، وتكريس هدف واضح لا ينازعه أي هدف آخر.
من النظرية إلى الواقع.. كيف تصنع الشروط نتائج ملموسة؟
وتخلص الأستاذة دين مختارية في تصريحها إلى أن الشروط العامة والأولية لاستهداف التضخم هي أدوات عملية تصنع الفارق بين استقرار نقدي هش واستقرار حقيقي مستدام. فحين تتوافر هذه الشروط، يمكن للسلطة النقدية أن تعلن عن أهدافها الرقمية وتلتزم بمواعيد محددة لتحقيقها، ما يعزز ثقة المتعاملين في السوق ويقلل من هامش الارتباك والتوقعات العشوائية.
وترى أن التزام البنك المركزي بمساءلة علنية وشفافة، وتفسيره لأي انحراف عن الهدف المعلن، يرسخ ثقافة جديدة تقوم على المكاشفة وتحمل المسؤولية. وهو ما يجعل من سياسة استهداف التضخم خيارًا لا يقتصر على ضبط الأسعار فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز مصداقية المؤسسات النقدية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.
كما تشير إلى أن توفر استقلالية حقيقية للبنك المركزي يسمح له بالتركيز على التضخم كهدف وحيد بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو التمويلية. فحين ينشغل البنك بأهداف متعارضة، تصبح السياسة النقدية بلا بوصلة، أما حين يكون هدفها واضحًا، فإن النتائج تنعكس مباشرة على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطن.
وتؤكد في الأخير أن نجاح سياسة استهداف التضخم لا يقاس فقط بالأرقام المسجلة في جداول الإحصاء، بل بمدى شعور الأسر بقدرتها على التكيف مع الأسعار، وبمدى استقرار الحكومات في مواجهة الأزمات الاقتصادية. لذلك، فإن استكمال الشروط العامة والأولية معًا هو الطريق نحو بناء سياسة نقدية أكثر صلابة وقدرة على مواجهة تقلبات عالم اليوم.

بعد المرور على الأسس النظرية والشروط العامة، يصبح من المهم النظر في التجارب الواقعية التي جسدت هذه السياسات على الأرض. من هنا تأخذنا الدكتورة بومعزة آمنة، أستاذة بجامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي، في جولة عبر التجربة البريطانية مع استهداف التضخم، لتبيّن كيف تحولت هذه السياسة النقدية الحديثة إلى أداة فعّالة في تحقيق الاستقرار المالي، وما العوامل التي جعلت بريطانيا إحدى النماذج الناجحة في هذا المجال.

بقلم: الدكتورة بومعزة آمنة - أستاذة بجامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي
من ضباب الأزمات إلى وضوح الأهداف.. رحلة بريطانيا مع التضخم
منذ تسعينيات القرن الماضي انتهجت العديد من دول العالم أسلوبا حديثا في إدارة السياسة النقدية، حيث كان أول تطبيق للإطار الاستهداف الكامل للتضخم (Fully fledged inflation targeting) في نيوزيلندا عام 1990، أعقبها كل من كندا وبريطانيا في عامي 1991 و1992 على التوالي، منذ ذلك الوقت تحرص العديد من البنوك المركزية على تطبيقه إلى أن بلغ عدد الدول التي تتبع هذه السياسة منذ ذلك الوقت وحتى عام 2019 نحو 40 دولة، وتتنوع هذه الدول ما بين دول صناعية متقدمة ودول أخرى ناشئة أو نامية.
أخذت السياسة النقدية في المملكة المتحدة عدة أشكال قبل تبني سياسة الاستهداف، ولكنها في الفترة الأخيرة تمت صياغتها بحيث تستهدف الاستقرار في مستوى الأسعار كهدف رئيسي من أجل تحقيق أهداف أخرى على المدى القصير مثل تقليل تقلبات الأسعار المحلية، وكذلك أهداف أخرى على المدى الطويل مثل دعم النمو الاقتصادي. فلقد شهدت المملكة خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية 1929 ركوداً ما دفع البنك المركزي إلى تنشيط الطلب الكلي عن طريق سياسة نقدية توسعية للدعم الاقتصادي. أين تبنت المملكة عدة أنظمة لسياسة استهداف التضخم عبر سعر الصرف من المراحل السابقة (1948-1971) سعر الصرف المرن (1971-1976)، المستهدفات النقدية (1976-1987)، سعر الصرف المستهدف (1987-1992)، استهداف التضخم (قبل استقلالية البنك المركزي 1992-1997)، استهداف التضخم (بعد استقلالية البنك المركزي 1997 – إلى الآن).
كما كان ينظر إلى السياسة النقدية التي سبقت اعتماد سياسة استهداف التضخم على أنها الأداة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، فكان تبني أسعار فائدة منخفضة أداة لتشجيع الاستثمار وضوابط الائتمان المستعملة لكبح جماح الاقتراض الاستهلاكي، إذ أظهرت ضغوط الطلب الزائد تضخماً أعلى وتدهوراً في ميزان المدفوعات، وبذلك لم تكن أدوات السياسة النقدية التقليدية قادرة على السيطرة على تلك الضغوط وفشلت في تحقيق أهدافها سنة 1979. ومنذ ذلك الوقت، أجري العديد من الإصلاحات الموجهة للسوق وخاصة أسواق العمل، كما أثبتت الأهداف النقدية أنها دليل غير موثوق، لذلك فإن اعتماد سياسة استهداف التضخم كانت قرارات سعر الفائدة غالبا ما يتم اتخاذها ردًا على أي أزمة من خلال اجتماع شهري بين رئيس اللجنة ومحافظ بنك إنجلترا وفريقهم الاستشاري، وفي سنة 1992 كان معدل التضخم يقترب من %5 وكانت السياسة النقدية تفتقر إلى المصداقية في مكافحة التضخم، وعلى إثر هذا تم اعتماد سياسة استهداف التضخم كإحدى بدائل السياسة النقدية للتحكم في مستويات التضخم في البلاد.
كيف غيّرت بريطانيا قواعد اللعبة؟
تبنى بنك إنجلترا سياسة استهداف التضخم في نهاية عام 1992 بمعدل تضخم مستهدف %5.2، فيما تم في عام 1997 تحديث الإطار العام للسياسة النقدية مع وضع أهداف البنك المركزي، وتعزز استقلاليته، حيث كان الإجراء الأول للمستشار "جوردون براون" هو تسليم المسؤولية عن تحقيق استهداف التضخم لبنك إنجلترا وتحديدًا لجنة السياسات، والتي تتكون من خمسة مسؤولين بالبنك وأربعة خبراء خارجيين.
في عام 2003 أعلن المستشار دخول الاتحاد الأوروبي والذي سيتم على إثره تغيير الإجراء المستهدف إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك. الجديد بالذكر أن معدل التضخم ظل منحرفًا فوق المستهدف لفترة 6 سنوات والتي نفذ خلالها البنك المركزي سياسات نقدية توسعية ظل الفائدة تستقر قريبًا من الصفر، يعزى ارتفاع التضخم لمعدلات تفوق المستهدف في عامين من هذه الفترة وهما عامي 2006 و2007، إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وزيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية، وكذلك زيادة الضرائب.
تقوم لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، وهي لجنة مستقلة، بوضع السياسة النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف التي يتم التشاور حولها بالتعاون مع جهات أخرى. هدفت السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية إلا أنه في الفترة الأخيرة كاد البنك المركزي أن يفقد مصداقيته وعدم قدرته على السيطرة على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة نتيجة لارتفاعها خلاف التوقعات. حيث أثرت أدوات السياسة النقدية غير التقليدية (التيسير الكمي) على كفاءة سياسة استهداف المستهدف.
في هذا الصدد أرجع محافظ بنك إنجلترا هذا الارتفاع إلى بعض العوامل المؤقتة. في أعقاب ذلك ومن أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التضخم المستهدف بنحو %2 سنوياً. كما يحرص البنك المركزي على تعزيز شفافية السياسة النقدية كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية استهداف التضخم حيث يصدر البنك تقرير التضخم كل ثلاثة أشهر، يتيح التقرير لأعضاء لجنة السياسة النقدية التداول والتحاور لتحديد التضخم المستهدف وبالتالي عزم من مبدأ مساعدتهم في نشر فهم السياسة النقدية لدى الفئات المختلفة.

إذا كانت بريطانيا قدّمت نموذجًا أوروبيًا في إدارة التضخم، فإن أمريكا اللاتينية تروي قصة أخرى لا تقل إثارة. ففي مساهمتها، تسلّط الدكتورة فنازي فطيمة الزهراء، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة 20 أوت 1955 – سكيكدة، الضوء على تجربتي تشيلي والبرازيل، وهما من أبرز الدول التي نجحت في كبح جماح التضخم عبر سياسة الاستهداف، لتكشف للقارئ كيف تحولت هذه البلدان من ساحات أزمات مالية متكررة إلى أمثلة على الانضباط النقدي والقدرة على تحقيق النمو مع الاستقرار.

بقلم: الدكتورة فنازي فطيمة الزهراء - أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة
من سانتياغو إلى ساو باولو.. دروس من أمريكا اللاتينية في كبح جماح التضخم
شهدت تشيلي خلال النصف الثاني من القرن العشرين تقلبات على صعيد المستوى العام للأسعار وسعر الصرف نتيجة لعدم التنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي، إلا أن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم كان أكثر المشاكل الاقتصادية التي تؤرق الحكومة التشيلية لعقود من الزمان خصوصاً عندما بلغ التضخم معدلات مرتفعة في منتصف السبعينات نتيجة لعجز التمويل التضخمي "التضخم المفرط" لعجز الموازنة. وعلى الرغم من بدء الحكومة في تقييد سياساتها النقدية والمالية مصحوبة بالإصرار في التنفيذ في ظل برنامج إصلاحي طويل الأجل، إلا أن النتيجة كانت غير مرضية في التنفيذ نتيجة لعدد من الأسباب من ضمنها الصدمات الخارجية، صياغة التوقعات التضخمية بطريقة غير منهجية إلى الهيمنة المالية، وهو الأمر الذي دفع بالحكومة التشيلية للجوء إلى سياسة استهداف التضخم كحل لمعضلة التضخم.
رحلة التشيلي مع استهداف التضخم… خطوات مدروسة نحو الاستقرار
تبنت تشيلي سياسة استهداف التضخم ابتداءً من عام 1990 بعد حصول ارتفاع في التضخم بنسبة زيادة 20%، لذا كانت تشيلي من بين بعض البلدان التي تبنت سياسة استهداف التضخم عند مستوى يتجاوز مقدار 20%، ولقد اتبعت تشيلي منهجاً مختلفاً في استهداف التضخم إذ تم تحديد معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي وبالتشاور مع الحكومة ليعتبر هدفاً أساسياً، والحفاظ على نظم المدفوعات كهدف ثانوي.
ولقد اعتمدت السلطات النقدية على تنفيذ عدد من الإجراءات في إطار التبني الفعلي لسياسة استهداف التضخم، يمكن إبرازها فيما يلي:
- منح الاستقلالية للبنك المركزي سنة 1989 وتصميم العديد من البرامج الاقتصادية لكبح جماح التضخم؛
- تركيز هدف البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار المحلية، حيث تبنى البنك المركزي تاريخياً استهداف التضخم في عام 1990 من خلال استهداف تضخم مقداره 3% كهامش تقلب بحدود 1%.
- تعويم سعر الصرف وتعميق أسواق مشتقات الصرف الأجنبي وتحرير الحساب الرأسمالي وميزان المدفوعات (صندوق النقد العربي، 2020، ص 35).
- تم اعتماد مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) لقياس التضخم فهو أكثر شمولية إزاء مؤشر غلاء المعيشة.
عندما تصبح الأرقام شهادة نجاح.. تقييم تجربة التشيلي مع استهداف التضخم
تعتبر تجربة التشيلي مثالا جيداً للدول النامية، حيث تمكن البنك المركزي في تشيلي من تخفيف الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم فهي تجربة ناجحة. إذ استطاع النزول بمعدل التضخم السنوي من 30% بداية المرحلة (1990) إلى حوالي 3% في نهاية 1990، كما ارتفع معدل نمو الناتج بشكل ملحوظ ليصل إلى أعلى من 8% سنوياً خلال الفترة (1990 وحتى عام 1997).
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي بالتشيلي استطاع بعد ذلك المحافظة على معدلات تضخم منخفضة ضمن حدود المعدل المستهدف أو حتى مقاربة لها ما عدا سنة 2008 أين بلغ معدل التضخم حاجز 9% وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 التي ضربت الاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعله يحوز على إعجاب المؤسسات الدولية والباحثين
ويمكن إيعاز نجاح الشيلي لعدد من العوامل منها
- التنامي والانسجام التام بين القيادة السياسية والنقدية بشأن ضرورة تطبيق سياسة استهداف التضخم بغرض تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي
- تزايد درجة الوعي لدى السلطات السياسية والنقدية بأهمية تحقيق الاستقرار السعري بعد التكاليف الباهظة التي تكبدتها هذه الدول نتيجة ممارستها سياسة التمويل التضخمي، وانتهاج إصلاحات اقتصادية قادت إلى التحول نحو اقتصاد السوق وبالتالي التأثير إيجابا في أداء الاقتصاد الكلي وتخفيض معدلات التضخم.
كيف تحولت السياسة النقدية في البرازيل إلى أداة للاستقرار؟
يعد استهداف التضخم في دول أمريكا اللاتينية عموما من أفضل تجارب الدول النامية في مجال هذه السياسة نظرا للنتائج الإيجابية المحققة، حيث عرفت المنطقة مستويات مرتفعة جدا للتضخم في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
قبل أن تلجأ البرازيل إلى تبني سياسة استهداف التضخم كان سعر الصرف هو المرتكز الأساسي للسياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وبدأ البنك المركزي في ذلك الوقت في تقييد سياساته النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة الاسمية للمحافظة على سياسة سعر الصرف الثابت ضمن الحدود المسموحة. وكان لهذه السياسة آثار إيجابية في تخفيض معدلات التضخم عن طريق أثر انتقال رفع قيمة العملة الوطنية إلى الأسعار المحلية، غير أن الآثار الجانبية لسعر الصرف كانت أقوى من معدلات التضخم حيث أدّى ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة العجز في الميزان الجاري لميزان المدفوعات وزيادة معدلات الدين. هذه الاختلالات دفعت الحكومة إلى تنفيذ استراتيجية استقرار الاقتصاد الكلي للاستمرار في جذب رؤوس الأموال.
سيرورة الإصلاح النقدي في البرازيل… وصفة النجاح في مواجهة الغلاء
أمام تفاقم الوضع الاقتصادي البرازيلي وتزامناً مع تعويم العملة في جانفي 1999، تم تبني نظام استهداف التضخم في جوان من نفس السنة وفقا لمرسوم البنك المركزي تحت رقم 3088، حيث تم توكيل مهمة إدارة النظام إلى المجلس الوطني للنقد، المكون من وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي. وتم تحديد نسبة 8% كمعدل تضخم مستهدف للسداسي المتبقي لسنة 1999، و6% و 4% للسنتين 2000، 2001، مع هامش تقلب مقدر بـ ±2%، وهذا من أجل منح بعض الحرية للرد على صدمات العرض المفاجئة وتجنب ردود الأفعال إذا لم يتحقق الهدف.
وعلى الرغم من ذلك كان هنالك شكوك بصدد جدوى استراتيجية استهداف التضخم البرازيلية في نجاحها في خفض التضخم لمستويات تقل عن 10% على ضوء المشكلات المالية الحادة التي تُحيط بالاقتصاد البرازيلي. واعتمد البنك المركزي في سياسته هذه على مجموعة من النماذج الاقتصادية الكلية ذات الصلة بالسياسة النقدية مع الأخذ في الاعتبار عدد من المتغيرات مثل سعر الفائدة الحقيقي، وصدمات الطلب، تحرير التجارة. استهدف البنك المركزي تحقيق معدل التضخم في حدود 5.4% مع هامش مسموح به في حدود 2% وهبوطا 4.4% صعودا.
استهدفت البرازيل بانخفاض قيمة العملة المحلية ثلاثة مرات بنسبة بلغت 4.8% في عام 1999، و 5.18% في عام 2001، و 2.53% في عام 2002 على التوالي. وأرجع عدد من الاقتصاديين الانخفاضات المسجلة في معدلات التضخم إلى التوقعات النقدية السلبية الكبيرة التي صاحبت فترة ما قبل تعويم العملة البرازيلية، أما فترة ما بعد التعويم فقد بدأ الانتقال التدريجي لسعر الصرف نحو السعر التوازني.
قراءة في حصيلة البرازيل مع استهداف التضخم
منذ تقديم الخطة الحقيقية تمتع الاقتصاد البرازيلي في أغلبه باستقرار الأسعار، والذي تم تعزيزه من خلال تنفيذ الإصلاحات البنيوية والمؤسسية، بما في ذلك نظام استهداف التضخم في عام 1999. كان نظام استهداف التضخم ناجحاً حيث نجح في الحفاظ على معدل التضخم الفعلي ضمن الحدود المسموحة في أغلب السنوات منذ اعتماده في عام 1999.
وقد سمح النظام بالسيطرة على التضخم عند مستويات منخفضة نسبياً والتقارب مع المعايير الدولية، وحتى عند مواجهة الصدمات الكبرى التي دفعت معدل التضخم إلى ما هو أبعد من هامش التغير، فقد عمل نظام استهداف التضخم على إعادة التضخم في نهاية المطاف إلى المسار المستهدف. كما ساعدت الالتزامات المنتظمة واستراتيجية الاتصال الخاصة بالسياسة النقدية في تعزيز مستويات عالية من الشفافية والمساءلة، ولا سيما من خلال المنشورات والتقارير الدورية للبنك المركزي البرازيلي.
وتوفّر مصداقية البنك المركزي البرازيلي إمكانية أكبر للتنبؤ بالتوقعات الاقتصادية، وتحسين خطط الأسر والشركات والحكومة. حيث تحرّك معدل التضخم خارج هامش التغير في سبع سنوات: 2001، 2002، 2003، 2015، 2017، 2021 و2022.
وكما هو مطلوب بموجب الإطار التنظيمي، يقدّم محافظ البنك المركزي البرازيلي، تقريراً إلى رئيس مجلس النقد الوطني (CMN)، الذي يقدّم وصفاً تفصيلياً لأسباب عدم تحقيق الهدف المسموح به، والفترة الزمنية التي من المتوقع أن تدخل التدابير حيز التنفيذ خلالها. ويُعد هذا الترتيب آلية أساسية لزيادة شفافية السياسة النقدية، وتلاشي المخاوف الأولية المرتبطة بمخاطر الهيمنة المالية الناجمة عن تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى انضباط السياسة المالية بما يتلاءم ومتطلبات النظام الجديد.