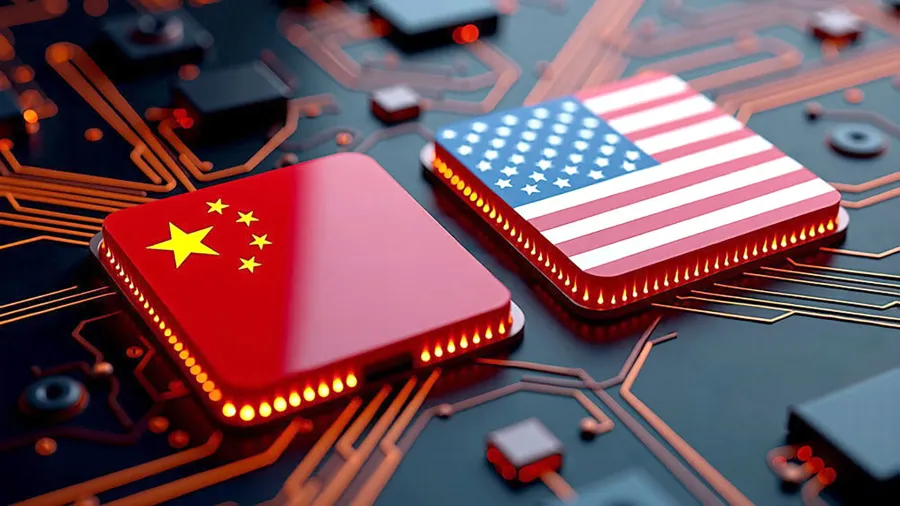بين حبّة سيليكون لا تُرى بالعين وحروب كبرى تُلهِب الاقتصاد العالمي، يتكشّف صراع جديد يعيد رسم موازين القوة. من واشنطن إلى بكين، ومن مضيق تايوان إلى أسواق الذكاء الاصطناعي، تتحوّل الرقاقة إلى نفط القرن الحادي والعشرين.
يقال إن قطعة سيليكون لا يتجاوز حجمها "حبة أرز" يمكن أن تهز اقتصادات بحجم قارات، وتُشعل صراعًا بين أكبر قوتين في العالم، هذه الرقاقة التي تختبئ في قلب الهاتف المحمول، وتتحكم في محرك السيارة، وتوجه الصواريخ في الفضاء، غدت أشبه بعملة خفية تساوي مليارات الدولارات، وأضحت سلاحا استراتيجيا لا يقل تأثيرا عن النفط في القرن العشرين. من مختبرات ستينيات القرن الماضي إلى أسواق اليوم المزدحمة بالذكاء الاصطناعي، ارتقت الرقاقة من تفصيل تقني إلى عصب الاقتصاد العالمي، حتى صار مصير الأمم يُقاس بعدد الشرائح التي تنتجها أو تمنعها، وباتت هذه "الحبة" الصغيرة تختصر قصة صراع تكنولوجي يعيد رسم موازين القوة في العالم.
قطعة لا تكاد تُرى بالعين، بحجم حبة أرز وملمس هش كأنها ذرة غبار، قد تختزن سرّ القوة في عصرنا، فهذه الرقاقة الإلكترونية التي تلمع في صمت داخل هاتف أو حاسوب، باتت أيقونة جديدة للسلطة، تُقاس بها هيبة الدول كما كان النفط يومًا يُقاس ببراميله السوداء.
عرف العالم من قبل حكايات الفحم والنفط وكيف تحولا إلى شرايين الثورة الصناعية ومحركات الحروب الكبرى، لكن مع دخول القرن الحادي والعشرين، صعد نجم السيليكون ليحتل عرش الثروات ولم يعد الوقود ما يشعل المحركات فحسب، بل الشرائح الدقيقة التي تُشغّل المصانع والمستشفيات والمطارات والجيوش، حيث صارت الرقاقة نفطًا بلا أنابيب، وذهبًا بلا مناجم، وشرطًا خفيًا لحياة حديثة لا تسير ساعة واحدة من دونه.
ولعل أكثر ما يثير الدهشة أن هذه القوة تختبئ في أبسط تفاصيل يومياتنا، فهي من تفتح قفل الهاتف، وتُدير محرك السيارة، وتُرشد الطائرة عبر الغيوم، وتراقب نبضات القلب في غرفة الإنعاش. قطعة صغيرة، لكنها تُمسك بخيوط عالم كامل، كما كان النفط يومًا يُمسك بعجلة الصناعة والطاقة. الفرق الوحيد أن النفط كان يُرى ويُشمّ، أما الرقاقة فهي تسكن بين طبقات زجاجية، صامتة لكنها نافذة إلى كل شيء.
وكما أشعل النفط صراعات على المضائق وخطوط الإمداد، تُشعل الرقاقة اليوم نزاعات على المختبرات والمصانع والممرات البحرية، إذ لم يعد الخوف من برميل يتأخر في مضيق هرمز، بل من شحنة شرائح تُعطَّل في مضيق تايوان، هكذا تتكرر القصة بلغة أخرى، كأن التاريخ يُبدل أدواته فقط، ويعيد المشهد ذاته: موارد تُشعل التنافس، وجغرافيا تضيف إليها نارًا جديدة.
إن ندرة النفط كانت في باطن الأرض، أما ندرة الرقاقة ففي عقول المبدعين ودقة المختبرات. هي ليست منحة طبيعية تُستخرج، وإنما صناعة مركّبة تحتاج إلى علم وخيال ورأس مال هائل، ولهذا، فإنّ من يمتلك سرها يمتلك مفتاح المستقبل، ومن يفقده يجد نفسه على هامش اقتصاد لا يرحم.
ومن هذه المفارقة المدهشة، بين "الحبة" التي تُلتقط بأطراف الأصابع، و"القوة" التي تُسيطر على مصائر الأمم، يظهر أن القرن الجديد وجد نفطه الخاص: مادة لا تُحرق في محركات، بل تُشغَّل بها العقول والخوارزميات.. إنها الرقاقة، نفط جديد يكتب فصول صراع العمالقة، ويصنع لأصغر الأشياء أكبر المعاني.
رحلة الرقاقة.. من مختبرات الستينيات إلى قلب الاقتصاد الرقمي
في ستينيات القرن الماضي، لم يكن أحد يتخيل أن دوائر صغيرة مرسومة على لوح من السيليكون ستغيّر مجرى التاريخ، كانت البداية أشبه بحكاية علمية متواضعة: باحثون في معامل وادي السيليكون يرسمون خيوطًا كهربائية أدق من الشعر، يضعونها جنبًا إلى جنب على شريحة لا يتجاوز حجمها بوصة واحدة، لم يكونوا يدركون أنهم يضعون البذرة الأولى لعصر جديد.
ومن تلك الشرارة انطلقت ثورة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً، فقد تحولت الرقاقة من مجرد أداة لتقليص حجم الحواسيب إلى العمود الفقري لثورة رقمية غيّرت طريقة العمل والتواصل والتفكير. كل عقد كان يضيف طبقة جديدة: من الحواسيب الضخمة إلى الحواسيب الشخصية، ومن الهواتف المحمولة إلى الهواتف الذكية، ومن الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي. وكل مرة كانت الرقاقة هي الجندي المجهول الذي يقف خلف هذه الطفرات.
لقد صارت الشرائح الإلكترونية أشبه بمخطوطات حديثة تكتب بلغة الأصفار والواحد، تسافر في أسلاك وأقمار صناعية بدل أن يحملها ساعي البريد أو حمامة زاجلة، لكنها مثل تلك الرسائل القديمة، كانت تفتح آفاقًا وتُقرب المسافات وتُغير مصائر الشعوب، فمن دونها، ما كان ليولد الاقتصاد الرقمي، ولا لتزدهر التجارة الإلكترونية، ولا لتقوم صناعات البرمجيات التي باتت تضاهي اقتصادات دول بأكملها.
وما بين الستينيات واليوم، انتقلت الرقاقة من رمز للتجريب العلمي إلى معيار للتقدم الحضاري، لقد أصبحت مثل الطابع البريدي في القرن التاسع عشر: تحمل على سطحها تاريخًا غير مكتوب، وتُعلن عن سيادة دول، وتُعرّف بمكانتها في خريطة العالم. غير أن الفرق أن الطابع كان يزيّن الرسائل، بينما الرقاقة اليوم تُزيّن عقول الآلات التي تدير العالم.
إنها رحلة نصف قرن فقط، لكنها تكفي لإدراك كيف يمكن لاكتشاف صغير أن يتحول إلى قاعدة اقتصاد عالمي. فمن مختبرات متواضعة في كاليفورنيا، إلى مصانع عملاقة في تايوان وكوريا الجنوبية، إلى حروب تجارية بين واشنطن وبكين، ارتقت الرقاقة إلى مقام جديد: مقام من يكتب مصائر الأمم بلغة التكنولوجيا.
وهكذا، كما كانت للبريد قصة مع الحضارة، للرقاقة أيضًا حكايتها الخاصة. فهي لم تعد قطعة سيليكون في مختبر، بل أصبحت بطاقة عبور إلى عالم جديد، وبوصلة تحدد موقع الدول بين الكبار والصغار. رحلة قصيرة في الزمن، لكنها طويلة في أثرها، لتصبح الرقاقة اليوم مرآة يرى فيها العالم وجهه الرقمي الجديد.
الرقاقة التي تسكن هواتفنا وتدير جيوشنا
قد يبدو الهاتف الذكي قطعة زجاجية باردة، والسيارة مجرد معدن متحرك، والطائرة جسدًا ضخمًا يخترق الغيوم… لكن في أعماق كل هذه الآلات ينبض قلب صغير لا يُرى، قلب من السيليكون اسمه الرقاقة. هي الكائن الصامت الذي يرافقنا في كل لحظة، من فتح قفل الهاتف صباحًا إلى آخر رسالة نبعثها قبل النوم. دون أن نشعر، صار العالم يستيقظ على دقاته وينام على إيقاعه.
الرقاقة هي مثل ساعي بريد جديد، يحمل ملايين الأوامر والمعلومات كل ثانية، ويسلمها بدقة متناهية من دون أن يطرق أبوابنا. فإذا كان ساعي البريد قد عرف أسماءنا وعناويننا، فإن الرقاقة تعرف اليوم وجوهنا وبصمات أصابعنا ودقات قلوبنا. إنها الوسيط الخفي بين الإنسان والآلة، بين الرغبة والأمر، بين الحاجة والاستجابة.
ومن المدهش أن هذا الكائن المتناهي الصغر تجاوز الحياة اليومية ليتحكم في أقدار الدول وجيوشها. فالصاروخ لا ينطلق إلا إذا أذنت له شريحة دقيقة، والدبابة لا تتحرك إلا بفضل رقاقة تدير أنظمتها، والطائرات المسيّرة ليست سوى قطع معدنية بلا روح لولا الشرائح التي تعطيها عيونًا وآذانًا وذاكرة. لقد أصبحت الحروب تُخاض على لوحات سيليكون قبل أن تُخاض في ساحات القتال.
هكذا تتشابك الأبعاد الإنسانية والعسكرية في قطعة صغيرة. فهي من تجعل محادثة عائلية ممكنة، وهي نفسها من تحدد هدفًا عسكريًا على بعد آلاف الكيلومترات. في لحظة واحدة، يمكن للرقاقة أن تكون أداة للحب والتواصل، وأداة للقوة والتدمير. إنها مفارقة هذا العصر: أصغر الأشياء تتحكم في أعظم القرارات.
والأكثر شاعرية أن هذه القطعة لا ترفع صوتًا ولا تُعلن حضورًا. فهي تعمل في صمت، ككاتب رسائل مجهول، يكتب ملايين الأسطر كل ثانية دون أن يطلب توقيعًا أو يشهد تصفيقًا. ومع ذلك، فإنها هي التي تُحرّك اقتصادًا عالميًا وتُحدد مسار حياة مليارات البشر.
بهذا المعنى، تحولت الرقاقة من مجرد "مكوّن تقني"، الى كائنًا حيًا ينسج خيوط حياتنا المعاصرة. فهي تسكن جيوبنا في الهواتف، وترافقنا في الطرقات عبر السيارات، وتحلق معنا في السماء على أجنحة الطائرات، وتجلس معنا حتى في غرف النوم عبر الأجهزة الذكية. ومن هنا، يتضح أن الرقاقة لم تعد جزءًا من حياتنا… بل صارت الحياة نفسها.
واشنطن وبكين.. حين تتحول التكنولوجيا إلى سياسة
ليست الشرائح الإلكترونية مجرد دوائر منقوشة على لوح سيليكون، بل هي اليوم جواز سفر إلى عرش القوة. وحين يتعلق الأمر بالعرش، لا يبقى في الساحة سوى عمالقة يعرفون أن من يتأخر لحظة قد يخسر قرنًا. هكذا دخلت الولايات المتحدة والصين في مواجهة صامتة تارة، وصاخبة تارة أخرى، عنوانها المعلن هو التجارة، لكن جوهرها الحقيقي هو السلطة.
في واشنطن، تُعامَل الرقاقة كما لو كانت سلاحًا استراتيجيًا، أشبه برأس نووي رقمي، يخضع للقوانين والقيود ويُراقَب عند الحدود كما تُراقَب الذخائر. فهي ورقة ضغط تُستعمل في لعبة الأمم، تمنح حليفًا قوة، وتترك خصمًا في عجز قاتل. ومن هنا جاءت العقوبات، وحملات الحظر، وتضييق الخناق على كل من يجرؤ على بيع "العقل الإلكتروني" إلى بكين.
أما الصين، فقد رأت في الأمر أكثر من مجرد سباق تجاري. إنها معركة وجود، معركة من أجل السيادة الرقمية التي تضمن لها مكانًا لا يُزاح في النظام العالمي الجديد. فبينما تحاول واشنطن إغلاق الأبواب، تبني بكين مختبراتها الخاصة، وتغرس استثماراتها في عمق الأرض وفي عقول علمائها، عازمة على أن تصنع رقاقة تحمل ختمها وحدها، لا بصمة غيرها.
هكذا وُلد مصطلح جديد في العلاقات الدولية: "تسييس التكنولوجيا". فلم تعد الابتكارات تخرج من المختبرات إلى الأسواق مباشرة، بل تمر أولًا عبر أروقة السياسة ومكاتب الأمن القومي. الرقاقة اليوم مثل برميل النفط في زمن الحرب، أو حبة القمح في زمن المجاعة: ورقة تُقلب المعادلات، وتُغير مصائر الدول، وتُشعل نار التنافس بين القوى الكبرى.
ولعل المفارقة أن هذه الحرب لا تُخاض في ميادين مكتظة بالجنود، بل في مصانع محصنة ومعامل مغلقة على أسرارها. هناك، في صمت الآلات، تُكتب فصول صراع قد يحدد ملامح القرن كله. ومن فوق الطاولات الدبلوماسية، تتحول الرقاقة إلى أداة تفاوض، وكلمة سر تفتح أو تغلق أبواب التحالفات.
إنها لحظة فارقة في التاريخ: حين تتحول التكنولوجيا إلى سياسة، ويصبح الابتكار مرادفًا للسيادة، والرقاقة مرآة تعكس من يحكم العالم ومن يكتفي بالمشاهدة. إنها ليست مجرد قطعة من السيليكون، بل حجر شطرنج متوهج، يتنافس على امتلاكه لاعبان لا يقبلان الخسارة.
مضيق تايوان.. مفتاح التكنولوجيا ومصير التجارة
هناك على الخريطة، بين اليابان والصين والفلبين، يختبئ ممر مائي ضيق لا يتجاوز بضع مئات الكيلومترات، لكنه يتحكم في شريان الاقتصاد الرقمي للعالم كله. مضيق تايوان، هذا الخط الأزرق الرفيع على سطح الكرة الأرضية، صار أشبه بعنق زجاجة، تمر عبره الشرائح الإلكترونية كما تمر أنفاس الحياة عبر القصبة الهوائية. فإذا انسدّ لحظة، اختنق العالم كله.
فالمصانع التي تنتج أعظم الرقائق وأكثرها تعقيدًا تقف على الضفة التايوانية، كأنها حارس بوابة لا يُفتح إلا بإذن. وأمام هذا الواقع، باتت كل سفينة تجارية تعبر المضيق تحمل على ظهرها أكثر من حاويات وبضائع؛ تحمل ثقل توازنات استراتيجية، وخوفًا من أن تتحول لحظة توتر سياسي إلى شرارة توقف قوافل التجارة.
إنه المكان الذي تلتقي فيه الجغرافيا بالاقتصاد، والخرائط بالسياسات. فالمضيق تحول الى عقدة صراع، حيث تنظر الصين إليه كجزء من جسدها التاريخي، بينما تراه الولايات المتحدة حائط صد يجب حمايته بكل الوسائل. وبين الرؤيتين، يبقى العالم كله رهينة مرور شاحنات دقيقة كُتبت على لوحات سيليكونية لا تُقدّر بثمن.
ولعل المفارقة أن مضيقًا صغيرًا كهذا، قد لا يلفت نظر سائح يبحث عن بحر صافٍ أو شاطئ هادئ، أصبح مسرحًا لمعادلة معقدة: من يسيطر عليه يسيطر على حركة الشرائح، ومن يسيطر على الشرائح يسيطر على مفاتيح التكنولوجيا الحديثة، ومن يسيطر على التكنولوجيا يمسك بمصير القرن.
هكذا تحوّل المضيق إلى بركان جيوسياسي خامد فوق بحر، يخشاه العالم لأنه قد يستيقظ في أي لحظة. كل توتر عسكري أو مناورات بحرية تعني أن الاقتصاد الرقمي العالمي يحبس أنفاسه، كما يحبس مريض صدره في انتظار زفير يحرره.
إن مضيق تايوان ليس مجرد خط على الخريطة، بل خط حياة، أو بالأحرى خط موت محتمل لاقتصاد عالمي مترابط. ومن هنا، يبدو أن "عنق الزجاجة" هذا قد أصبح نقطة ارتكاز في صراع العمالقة، حيث يمكن لشرارة صغيرة في بحر ضيق أن تُشعل نارًا كبرى تعيد رسم خريطة العالم.
الحرب التكنولوجية.. اختبار القانون الدولي
ومنذ وُلد القانون الدولي، كان يحاول أن يضبط صخب الحروب وصراعات الحدود ويضع لها قواعد تشبه إشارات المرور في طرق مزدحمة. لكنه اليوم يجد نفسه أمام ساحة جديدة لا تُشبه ما عرفه من قبل: حرب بلا مدافع ولا خنادق، حرب تُخاض في مصانع مغلقة ومعامل سرية، اسمها الحرب التكنولوجية.
كيف يمكن لنصوص وُلدت بعد الحرب العالمية الثانية أن تلاحق شرائح إلكترونية أصغر من الظفر؟ كيف لمعاهدات صيغت لتنظيم تبادل القمح والفحم أن تستوعب صراعًا على السيليكون والذكاء الاصطناعي؟ هنا تبدو ثغرات القانون كشقوق في جدار قديم يحاول أن يواجه عاصفة لا ترحم.
فالولايات المتحدة تسوّغ عقوباتها التجارية على الصين بوصفها دفاعًا عن الأمن القومي، بينما ترى بكين أن الأمر ليس سوى اعتداء مقنّع على حقها في التنمية والابتكار. بين "الشرعية" و"السيادة" تضيع الحقيقة، ويصبح القانون أداة يُلوّح بها كل طرف حين يخدم مصالحه، ويهملها حين تعيق مساره.
ومع ذلك، لا يغيب صوت القانون تمامًا. فالمحاكم الدولية، واتفاقيات التجارة، ومؤسسات التحكيم الاقتصادي، تحاول أن تضع خطوطًا حمراء، ولو أنها تبدو أحيانًا كطباشير على رصيف تمحوه أول موجة مطر سياسي. لكنها تبقى محاولة لإبقاء العالم داخل إطار من النظام، حتى لو كان هشًّا ومرنًا.
إنها لحظة اختبار عسير للقانون الدولي: هل يستطيع أن يكون مظلة تقي من أمطار الصراع التكنولوجي، أم أنه مجرد مظلة مثقوبة تتسرب منها قطرات النفوذ والقوة؟ قد ينجح في تهدئة بعض النزاعات عبر وساطات ومفاوضات، لكنه عاجز عن ضبط صراع يتسارع بسرعة الضوء ويُدار بخوارزميات لا تعرف الانتظار.
في النهاية، تبدو الحرب التكنولوجية كمرآة تعكس حدود القانون الدولي نفسه. فهي تكشف أن النصوص وحدها لا تكفي، وأن العقلانية السياسية هي التي تحدد إن كان القانون سيُحترم أم يُتجاوز. وهكذا يصبح القانون شاهدًا على الصراع، أكثر مما هو حكمًا فيه، يراقب بعين قلقة حربًا جديدة كُتبت بلغة السيليكون لا بلغة البارود.
ذكاء اصطناعي بلا حدود… الرقاقة وقود المستقبل
يُقال إن المستقبل يكتبه الحالمون، لكن الحقيقة أن من يكتبه اليوم ليست الأقلام ولا الأوراق، بل شرائح صغيرة تُسمّى الرقائق. فهي التي تغذي خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتمنحها القدرة على التفكير والتعلم والتوقّع. ومن دونها، يبقى الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة طموحة، تمامًا كما يبقى المحرك بلا وقود قطعة معدن لا حياة فيها.
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي هو المسرح الجديد للقوة. الشركات تتنافس على تطوير تطبيقات تُشبه العقول، والدول تسابق الزمن لتضع بصمتها في هذا السباق غير المسبوق. في قلب كل هذه الطموحات، تختبئ الرقاقة كجندي مجهول، صامت لكنه حاسم، يقرر إن كان البرنامج سيعمل في جزء من الثانية أو لن يعمل أبدًا.
والمفارقة أن هذه الرقاقة الواحدة يمكن أن تختصر الفارق بين قوة عظمى وأخرى تبحث عن مكان لها. فالولايات المتحدة تراهن على الحفاظ على ريادتها عبر شركاتها العملاقة، بينما تتحرك الصين بخطى سريعة، كمن يحاول أن يقفز فوق عقود من التأخر دفعة واحدة. في هذا السباق، الرقاقة هي جواز المرور إلى نادي الكبار في عالم الذكاء الاصطناعي.
ومع كل خطوة يخطوها الذكاء الاصطناعي، يزداد اعتمادنا على هذه الشرائح. فهي التي تجعل السيارة ذاتية القيادة ممكنة، والطبيب الآلي قادرًا على التشخيص، والروبوتات عاملة في المصانع، والخدمات الرقمية أكثر قربًا من البشر. كأنها قناديل صغيرة تنير طريق البشرية نحو عالم جديد، عالم تُديره الخوارزميات لا الورق والقوانين.
لكن السؤال الذي يطل برأسه هو: هل نحن نتحكم في الرقاقة، أم أنها هي التي بدأت تتحكم فينا؟ فإذا كانت بالأمس وسيلة لتسهيل الحياة، فهي اليوم تكتب مسارها وتحدد خياراتها، حتى صار المستقبل نفسه مرهونًا بقدرة هذه الشرائح على التطور والتكاثر.
إن الرقاقة باتت وقود للذكاء الاصطناعي والشرارة التي قد تشعل ثورة جديدة، ثورة لا تُقاس فيها الثروات بالذهب أو النفط، وإنما بعدد الترانزستورات التي تسكن قطعة سيليكون. ومن هنا، يبدو أن من يسيطر على الرقاقة، يسيطر على المستقبل بأكمله.
الاقتصاد العالمي على وقع الشرائح الإلكترونية
لقد عرفت البشرية أزمات اقتصادية بسبب الجفاف أو الحروب أو انهيار الأسواق، لكن الأزمة التي تلوح اليوم مصدرها أصغر من أن تُرى بالعين المجرّدة. رقاقة واحدة متأخرة في مصنع بتايوان أو كوريا قد توقف خط إنتاج في أوروبا، أو تعطل صناعة سيارات في أمريكا، أو ترفع الأسعار في أسواق إفريقيا. إنها شبكة دقيقة، متشابكة، كأنها شرايين جسد هائل، إذا انسدّ فيها عرق صغير أصيب الكائن كله بالشلل.
ولعل المفارقة أن هذه القطعة الصغيرة لا تحكم فقط المصانع والآلات، بل تتحكم أيضًا في جيوب الناس العاديين. فكلما اضطربت سلاسل إنتاج الشرائح، ارتفعت أسعار الهواتف والسيارات والأجهزة، وتضاعفت معاناة المستهلك. كأن العالم كله أصبح رهينة ورشة صغيرة، تُدار بدقة متناهية، لكن أي خلل فيها يترك أثرًا مدوّيًا في حياة المليارات.
إن الاقتصاد العالمي اليوم يعيش على وقع الشرائح، كما كان يعيش بالأمس على وقع أسعار النفط. لكن الفرق أن النفط كان يُباع في براميل تُرى وتُخزّن وتُقاس، بينما الرقاقة تُسعّر بالمعرفة والبحث والابتكار. إنها ثروة لا تُستخرج من باطن الأرض، بل تُستخرج من عقول العلماء وأجهزة الليزر والمختبرات المعقّدة.
هكذا أصبح الاقتصاد الجديد اقتصاد معرفة بامتياز، حيث تتحول الدول المنتِجة للرقاقات إلى مراكز ثقل، فيما تُضطر الدول الأخرى إلى التكيف مع إيقاع لا تتحكم فيه. فمن لم يواكب هذه الموجة سيظل دائمًا مستهلكًا، تابعًا لإيقاع يُعزَف في أماكن أخرى.
وبهذا، يتضح أن الرقاقة هي قلب نابض يحدد صحة الاقتصاد العالمي. فإذا توقفت نبضاته، تعطلت الحياة الاقتصادية، وإذا تسارعت، اندفعت الأسواق إلى آفاق غير مسبوقة. إنها المايسترو الصغير الذي يقود أوركسترا الاقتصاد في القرن الجديد.
الدول الناشئة.. رهائن حرب الرقائق
وفي زحمة الصراع بين واشنطن وبكين، تجد الدول الناشئة نفسها كمتفرج حائر في مسرح مكتظ بالعمالقة. فهي لا تملك مصانع عملاقة تُنتج الشرائح، ولا مختبرات متطورة تُنافس الكبار، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع الاستغناء عن هذه القطعة الصغيرة التي تُحرك اقتصاداتها وحياتها اليومية. كأنها تقف بين المطرقة والسندان: مطرقة الحاجة وسندان الهيمنة.
فالمصانع في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تنتظر وصول الشحنات لتُشغّل خطوط الإنتاج، والجامعات والمراكز البحثية تحتاج إلى الشرائح لتواكب التطورات، والحكومات تدرك أن التخلف عن ركب الرقاقات يعني التخلف عن قطار التنمية كله. ومع ذلك، فإن أي قرار أمريكي بحظر التصدير أو أي خطوة صينية بالاحتكار تترك هذه الدول مكشوفة، كأنها جزر صغيرة وسط محيط هائج.
لقد تحولت الرقاقة بالنسبة للدول الناشئة إلى ما يشبه الهواء: لا يُرى لكنه شرط أساسي للحياة. فهي لا تدخل فقط في الهواتف والسيارات، بل في المعدات الطبية، وفي شبكات الطاقة، وفي كل تفاصيل البنية التحتية الرقمية. غيابها يعني شللًا اقتصاديًا يصعب تجاوزه، وحضورها يعني استمرار عجلة التنمية.
والمفارقة أن هذه الدول كثيرًا ما تتحول إلى ساحات نفوذ بين القوى الكبرى، فيُعرض عليها الاستثمار تارة، وتُفرض عليها الشروط تارة أخرى. كأن الرقاقة بطاقة دعوة إلى تحالفات سياسية واقتصادية، من يقبلها يدخل اللعبة، ومن يرفضها يبقى على الهامش.
إن معاناة هذه الدول تكمن في أنها لا تُحدد قواعد اللعبة، لكنها تدفع ثمنها، فهي تُجبر على التكيّف مع تقلبات السوق العالمية، وعلى تحمّل أعباء الاضطراب في سلاسل التوريد. وكلما ارتفعت حدة الصراع بين واشنطن وبكين، زادت هشاشتها، كما لو أن كل موجة جديدة في بحر الصراع تتركها تترنح على شاطئ غير مستقر.
وبهذا، تبدو الدول الناشئة وكأنها رهينة صراع لم تختَر خوضه. فهي في حاجة إلى الرقاقة كمن يحتاج إلى الماء، لكنها لا تملك بئرها الخاص، بل تنتظر دائمًا أن يفتح لها الكبار صنابير الإمداد. وبين المطرقة والسندان، يبقى السؤال معلقًا: هل تستطيع هذه الدول أن تجد لنفسها مكانًا في اقتصاد السيليكون، أم أنها ستظل مجرد متلقٍ لنتائج صراع لا يرحم؟
هل تستحق "حبة سيليكون" أن تعيد رسم النظام العالمي؟
قد يَبدو ضربًا من المبالغة أن قطعة صغيرة لا تتجاوز حجم الظفر يمكن أن تعيد تشكيل خرائط النفوذ بين الأمم، لكن التاريخ علمنا أن الأشياء الصغيرة كثيرًا ما صنعت تحولات كبرى. فطلقة واحدة أشعلت الحرب العالمية الأولى، وكساد في بورصة واحدة زعزع الاقتصاد العالمي، واليوم تأتي "حبة سيليكون" لتضع العالم على أعتاب نظام جديد.
هذه الرقاقة التي تسكن أجهزتنا وتتحكم في مصانعنا وجيوشنا تحولت إلى رمز لمعادلة القوة. من يمتلكها يمتلك المستقبل، ومن يفتقدها يظل تابعًا لإيقاع يفرضه الآخرون. كأنها عملة غير مرئية، تحدد ثمن السيادة في القرن الحادي والعشرين.
ومع كل خطوة تتخذها واشنطن أو بكين، يزداد وضوح السؤال: هل نحن أمام حرب باردة جديدة تُدار بالشرائح بدل الصواريخ؟ وإذا كان القرن العشرون قد عُرف بسباق التسلح النووي، فهل سيتذكر المؤرخون القرن الحادي والعشرين بوصفه قرن الرقائق؟ هنا يتجلى المعنى العميق: التكنولوجيا لم تعد أداة بيد السياسة، وإنما أصبحت هي السياسة ذاتها.
لكن المفارقة تكمن في أن هذه "الحبة" الصغيرة لا تُهدد بالدمار فقط، بل تبشر أيضًا بآفاق جديدة. فهي وقود الذكاء الاصطناعي الذي قد يُعالج أمراضًا مستعصية، ويدير مدنًا أكثر ذكاءً، ويوفر طاقات أنظف. إنها تحمل في طياتها بذرة أمل وبذرة خطر معًا، كأنها مرآة تعكس وجهين متناقضين للعصر.
وفي خضم هذا الصراع، يطل السؤال على القارئ العادي: ما علاقة كل ذلك بحياته اليومية؟ والحقيقة أن فاتورة الهاتف الذكي، أو سعر السيارة، أو حتى تكلفة دواء في المستشفى، قد تكون كلها انعكاسًا لصراع يدور بعيدًا عنه، لكنه يطرق بابه في نهاية المطاف. إن النظام العالمي يُرسم في المؤتمرات الكبرى فقط، ويُعاد تشكيله في مصانع السيليكون، وفي شريحة تُطبع عليها ملايين الدوائر الدقيقة.
هكذا، يصبح السؤال مشروعًا: هل تستحق "حبة سيليكون" أن تُشعل حربًا باردة جديدة وتعيد رسم خريطة العالم؟ ربما لا تكمن الأهمية في حجمها، بل فيما تحمله من قدرة على التحكم في كل ما يحيط بنا. لقد دخلنا عصرًا صار فيه الصغير يحكم الكبير، وعصرًا يمكن أن تختصر فيه رقاقة واحدة قصة البشرية بأكملها.
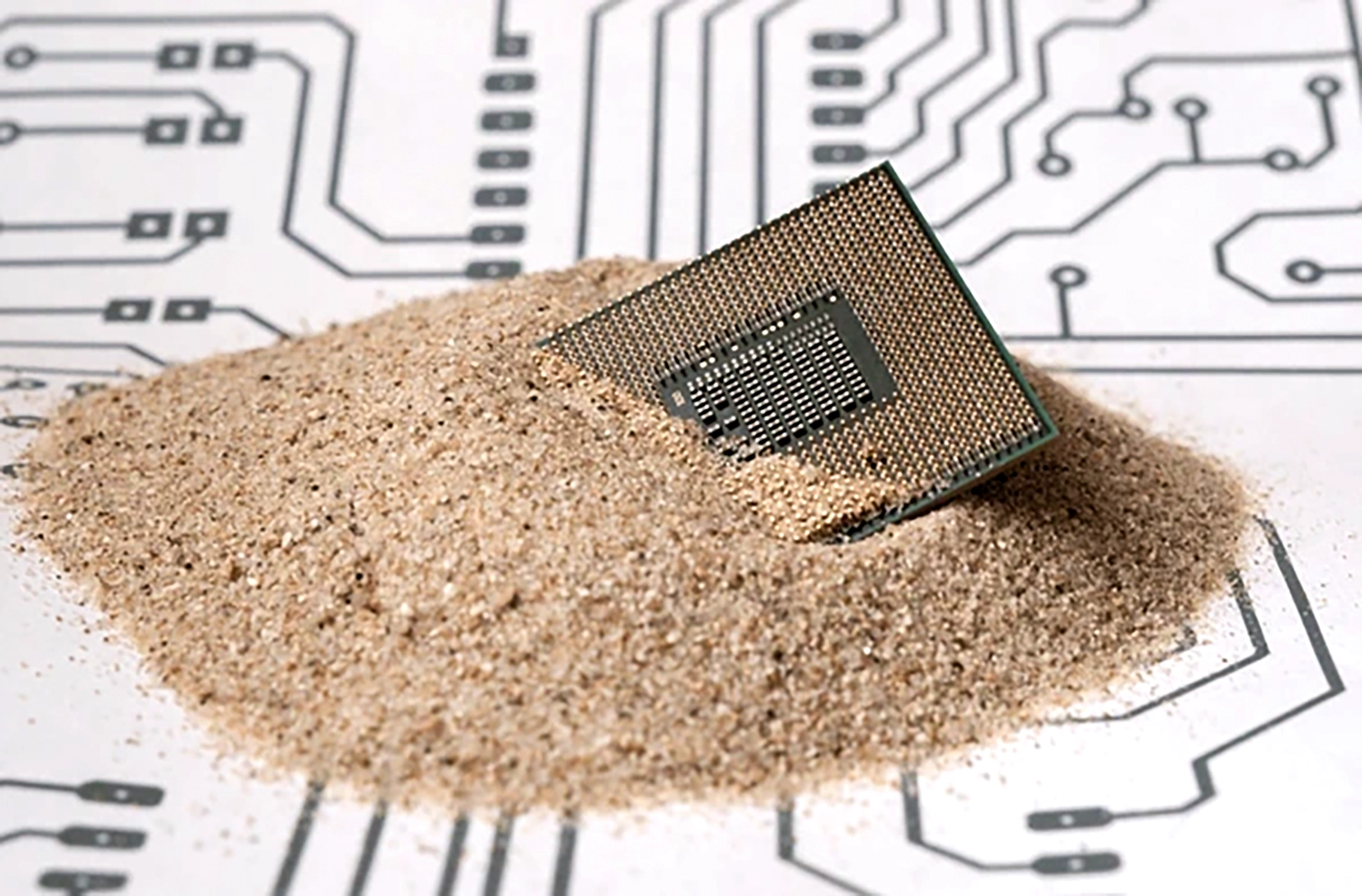
أعطت الدكتورة سعدي راضية، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3، في مساهمتها المكتوبة لـ"الأيام نيوز"، تعريفاً دقيقاً للرقاقة الإلكترونية باعتبارها "قطعة صغيرة بحجم حبة أرز لكنها تختصر في داخلها قيمة تكنولوجية واقتصادية هائلة"، مبيّنةً الفارق الجوهري بين السيليكون كمادة خام تحتكر الصين إنتاجها بنسبة تفوق 80%، وبين أشباه الموصّلات المتقدمة التي تهيمن عليها تايوان عبر شركتها العملاقة TSMC. وتؤكد أن هذا التمايز في السيطرة بين طرفين مختلفين على مرحلتين أساسيتين من سلسلة القيمة، جعل من الرقاقة أشبه بـ "النفط الجديد".

الدكتورة سعدي راضية - أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية -جامعة الجزائر 3-
من رمل الكوارتز إلى حبة السيليكون.. كيف وُلد نفط القرن الجديد؟
قبل التطرّق إلى الأبعاد الاقتصادية لحرب الرقائق الإلكترونيّة، وهي بحجم "حبّة الأرز"، يجب أوّلًا تعريفها وتوضيح أهمّيتها في العالم لأجل فهم الصراع القائم حولها. لذلك وجب تبيين الفرق بين كلّ من مصطلح "الرّقائق الإلكترونيّة" ومصطلح "السّيليكون"، والدول المسيطرة على كلّ منهما على حِدة.
من المهمّ التمييز بين "السّيليكون" كمادّة خام تُنتَج من خلال صَهر مادّة "الكُوارتز"، وهي صناعة تهيمن عليها الصين عالميًّا، وبين استخدام هذه المادّة (السّيليكون) كأساس في إنتاج "الرّقائق الإلكترونيّة" التي تهيمن عليها تايوان، حيث تختلف الدول الرائدة في كلّ مجال بشكل كبير.
فنجد أنّ الصين تهيمن بشكل قاطع على إنتاج السّيليكون المعدني (الخام) في العالم بنسبة 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفقًا لبيانات عام 2024، يليها بفارق كبير كلّ من روسيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكيّة، والنرويج.
ويعود هذا الفارق إلى عدة عوامل من بينها:
وفرة الموارد: تمتلك الصين احتياطات ضخمة من "الكوارتز" الذي يتم تصهيره لاستخراج مادة السيليكون؛
الطاقة: تتطلب عملية إنتاج السيليكون كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، وتتمتع الصين بقدرة إنتاج طاقة كبيرة بأسعار تنافسية؛
الطلب الداخلي: جزء كبير من السيليكون المنتج في الصين يستخدم داخليا في صناعات متنوعة مثل صناعة سبائك الألمنيوم والكيماويات القائمة على السيليكون وصناعة الخلايا الشمسية وحتى في منتجات التجميل.
بينما تُلقب تايوان بـ "عملاق أشباه الموصلات" بسبب سيطرتها على مراحل هامة في عملية الإنتاج، وهي ليست مجرد مصنّع، بل مركز الابتكار والتصنيع الأكثر تطورًا في العالم.
وتكمن أهمية تايوان في صناعة الرقائق في عدة عوامل رئيسية:
السيطرة على الإنتاج المتقدم: تُسيطر تايوان على أكثر من 90% من إنتاج الرقائق المتقدمة في العالم، هذه الرقائق هي التي تُستخدم في الهواتف الذكية الحديثة، ومعالجات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، من خلال شركة TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، وهي رائدة في تطوير تكنولوجيا الطباعة الحجرية (lithography) الأكثر تعقيدًا، والتي تسمح بإنتاج رقائق أصغر وأكثر كفاءة، وتعمل TSMC كمصنع للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل، وكوالكوم، وإنفيديا، التي تُصمم الرقائق ولكنها لا تُصنّعها بنفسها؛
القدرة على الإنتاج الضخم: تايوان لديها القدرة على إنتاج كميات هائلة من الرقائق بسرعة وكفاءة فائقتين، مما يجعلها ضرورية لسلاسل التوريد العالمية.
تحديات ومخاوف تواجه تايوان:
بالرغم من هيمنتها في هذا المجال إلا أنها تواجه تحديات من بينها:
الاعتماد على مصادر خارجية: تعتمد تايوان على مصادر خارجية لتوفير المواد الخام مثل السيليكون، وهو ما يُعتبر نقطة ضعف؛
التهديدات الجيوسياسية: يُثير التوتر السياسي بين الصين وتايوان قلقًا عالميًا، أي نزاع عسكري محتمل يمكن أن يُهدد إمدادات الرقائق، وهو ما يدفع بعض الدول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى محاولة تعزيز إنتاجها المحلي لتقليل الاعتماد على تايوان.
وبالتالي تلعب تايوان دورًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه في الاقتصاد العالمي، مما يجعلها محورًا استراتيجيًا في الصراع التكنولوجي والجيو-سياسي.
الأبعاد الاقتصادية لحرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين:
جذور الصراع الصينوأمريكي:
تعود جذور الصراع الصينوأمريكي إلى سنة 1949م أي منذ قيام دولة الصين، حيث لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بـ "بيجين" كعاصمة لها بل بمدينة "تايبيه" الواقعة بتايوان كممثل وحيد وشرعي لجمهورية الصين الشعبية (أنظر تاريخ الحرب الأهلية الصينية)، الأمر الذي أنشأ عداوة مستمرة بين البلدين إلى يومنا هذا.
في خطوة تُعرف باسم "حرب الرقائق"، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2022 قيودًا صارمة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق الالكترونية إلى الصين، بهدف الحد من قدرة الصين على تطوير تقنيات متقدمة، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق التكنولوجي والاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة، فقد سنّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون "الرقائق والعلوم" (Chips and Science Act) لضخ 52 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق المحلية.
تعود أسباب القيود الأمريكية على الصين إلى:
استقرار الأمن القومي: إذ تعتبر الولايات المتحدة أن تطوير الصين للرقائق المتقدمة يشكل تهديدًا لأمنها القومي، حيث يمكن استخدام هذه الرقائق في تطبيقات عسكرية متقدمة وأنظمة أسلحة، مما يعزز من القدرات العسكرية الصينية؛
المحافظة على التفوق التكنولوجي: تهدف واشنطن إلى إبطاء تقدم الصين في صناعة الرقائق المتطورة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان أن تبقى الولايات المتحدة في صدارة السباق التكنولوجي؛
الهيمنة الاقتصادية: تسعى الولايات المتحدة إلى السيطرة على سلاسل التوريد العالمية للرقائق، وتقليل اعتمادها على المصنعين الأجانب مثل تايوان، معززةً بذلك صناعتها المحلية.
سرقة التكنولوجيا: تتّهم الولايات المتحدة الصين بسرقة الأسرار التكنولوجية من الشركات الأمريكية، مما دفعها إلى فرض قيود لمنع نقل التكنولوجيا الحساسة.
تأثير هذه القيود على الاقتصاد الصيني:
صعوبة الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة: أثرت القيود الأمريكية بشكل كبير على الشركات الصينية، خاصة تلك التي تعتمد على الرقائق المتقدمة في منتجاتها، مثل شركة هواوي.
تشجيع الابتكار المحلي: دفعت القيود الأمريكية الصين إلى تكثيف جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الرقائق، من خلال استثمار مليارات الدولارات في البحث والتطوير، بهدف بناء سلسلة توريد محلية.
التحالفات العالمية: حاولت الولايات المتحدة إقناع حلفائها مثل هولندا واليابان، بفرض قيود مماثلة على الصين، للحد من قدرتها على الحصول على المعدات والبرمجيات اللازمة لتصنيع الرقائق.
الرد الصيني وتداعيات الحرب:
تعرف الصين بنزعتها القومية وردودها الانتقامية، إذ سعت إلى مواجهة القيود الأمريكية بمايلي:
الاستثمار في الصناعة المحلية: ضخت استثمارات هائلة في صندوق خاص لدعم صناعة الرقائق، بهدف تسريع وتيرة الابتكار والإنتاج المحلي، بتمويلها لمبالع طائلة في شركاتها المحلية مثل SMIC لتمويل الأبحاث والتصنيع، بهدف تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.
التوتر التجاري: أدت هذه القيود إلى تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، حيث تبادلا الإجراءات العقابية، بما في ذلك قيود على تصدير بعض المعادن النادرة من الصين مثل: الجاليوم والجرمانيوم والتي تعتبر اساسية في صناعة الرقائق الالكترونية، مما يعكس استعدادها لاستخدام سيطرتها على المواد الخام كورقة ضغط.
تحديات للشركات الأمريكية: أثرت القيود أيضًا على الشركات الأمريكية، مثل "إنفيديا"، التي خسرت مليارات الدولارات بسبب منعها من بيع رقائقها المتقدمة في السوق الصينية الضخمة.
تأثير حرب الرقائق على سلاسل الإمداد العالمية
تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لحرب الرقائق الإلكترونية مجرد التنافس التجاري، لتشكل صراعًا جيوسياسيًا يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ويؤثر على كافة القطاعات الصناعية، إذ تعتمد صناعات حيوية مثل: السيارات، الإلكترونيات الاستهلاكية، الآلات الصناعية والصناعات العسكرية بشكل كبير على أشباه الموصلات، وبالتالي أي انقطاع في سلسلة التوريد يؤدي إلى تأثيرات كارثية من بينها:
نقص في المنتجات: يؤدي نقص الرقائق إلى تعطل خطوط الإنتاج، مما يتسبب في نقص حاد في السلع الأساسية وبالتالي يؤثر على أرباح الشركات، فخلال جائحة كورونا تسبب نقص الرقائق في خفض إنتاج السيارات عالميًا بمليارات الدولارات.
زيادة التكاليف: يؤدي نقص العرض إلى ارتفاع أسعار الرقائق، مما يرفع من تكاليف الإنتاج ويُمرر في النهاية إلى المستهلك في شكل تضخم.
التقليل من الكفاءة الاقتصادية: يدفع هذا الصراع إلى فصل الاقتصاديات الكبرى عن بعضها، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحساسة، مما يؤدي إلى إنشاء سلاسل توريد مستقلة وموازية، هذا الانفصال ورغم أنه يعزز الأمان الاستراتيجي للدول، إلا أنه يقلل من الكفاءة الاقتصادية العالمية.
ظهور تحالفات: من جهة أخرى تُجبر هذه الحرب الدول الأخرى على اتخاذ موقف، مما يعزز التحالفات القائمة أو يشكل تحالفات جديدة، على سبيل المثال: تتعاون الولايات المتحدة مع اليابان، كوريا الجنوبية وهولندا لفرض مزيد من الضغط على الصين، مما يؤدي إلى ظهور "كتل" تكنولوجية واقتصادية جديدة.
انعكاساتها على اقتصاديات الدول الأخرى خارج ثنائية واشنطن- بيجين:
بالتأكيد تُعد حرب الرقائق الإلكترونية بين واشنطن وبكين معركة ذات تأثيرات تتجاوز البلدين لتشمل الاقتصادات العالمية بأسرها، هذه الانعكاسات تظهر بشكل مختلف حسب موقع كل دولة في سلسلة التوريد العالمية للرقائق.
الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة: مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وهولندا تجد نفسها في موقف حرج:
تايوان (المورد الرئيسي): تشكل شركة TSMC التايوانية، التي تنتج أكثر من 90% من الرقائق الأكثر تطورًا في العالم، قلب هذا الصراع. تايوان مضطرة للانحياز للولايات المتحدة لحماية نفسها عسكرياً، مما يجعلها عرضة للضغوط الصينية.
كوريا الجنوبية واليابان: تُعد كوريا الجنوبية واليابان لاعبين رئيسيين في صناعة الرقائق، حيث تمتلكان شركات عملاقة مثل "سامسونج" و"سك هاينكس"، هذه الدول تتعاون مع الولايات المتحدة في فرض قيود على التصدير إلى الصين، لكنها في نفس الوقت تخشى خسارة السوق الصينية الضخمة التي تعتبر أحد أكبر عملائها.
الاقتصادات الأوروبية: يُحاول الاتحاد الأوروبي شق طريق خاص به لتقليل اعتماده على كل من الصين والولايات المتحدة:
تعتمد الصناعات الأوروبية، خاصة صناعة السيارات بشكل كبير على الرقائق الإلكترونية، أي أنّ الاضطرابات في سلاسل التوريد تؤثر مباشرة على إنتاجها، استجابةً لذلك أطلق الاتحاد الأوروبي "قانون الرقائق الأوروبي" بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للرقائق داخل القارة، بهدف استقطاب استثمارات ضخمة من الشركات العالمية مثل إنتل لبناء مصانع في أوروبا، ولكن بالرغم من محاولاتها، لا تزال أوروبا محاصرة بين الضغوط الأمريكية للحفاظ على القيود، والمصالح التجارية الكبيرة مع الصين.
الاقتصادات الناشئة والدول العربية: تتأثر الاقتصادات الناشئة بشكل غير مباشر ولكن بشكل عميق من خلال:
ارتفاع التكاليف: يؤدي اضطراب سلاسل التوريد والقيود التجارية إلى ارتفاع أسعار الرقائق، مما يزيد من تكلفة المنتجات الإلكترونية والتقنية التي تعتمد عليها هذه الدول.
تباطؤ التقدم التكنولوجي: قد يؤدي منع وصول التقنيات المتقدمة إلى تباطؤ خطط هذه الدول في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
في المقابل، قد يمثل هذا الصراع فرصة لبعض الدول الغنية بالمواد الخام الأساسية لصناعة الرقائق (مثل المعادن النادرة)، حيث قد تسعى القوى الكبرى لتأمين إمداداتها من هذه الدول خارج ثنائية الصين- تايوان.
من المرجح أن تؤدي حرب الرقائق الإلكترونية إلى إعادة رسم موازين القوى الاقتصادية الدولية وتفتح الباب أمام نظام عالمي جديد قائم على التكنولوجيا، وبالتالي إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي، هذا الصراع ليس مجرد نزاع تجاري، بل هو معركة استراتيجية للسيطرة على "نفط القرن الحادي والعشرين"، فالرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات، هي القلب النابض لكل التكنولوجيا الحديثة، وإن السيطرة عليها تعني السيطرة على مستقبل الابتكار الاقتصادي والعسكري.
تأثير حرب الرقائق على موازين القوى الاقتصادية الدولية:
تحاول الولايات المتحدة من خلال سباق التوطين سن قوانين مثل "CHIPS and Science Act"، من أجل إعادة إنتاج الرقائق إلى أراضيها، وهو ما يشجع شركات مثل TSMC التايوانية وIntel الأمريكية على بناء مصانع ضخمة في الولايات المتحدة، مما يقلل من اعتمادها على سلاسل التوريد الآسيوية ويعزز أمنها القومي، في المقابل تستثمر الصين مبالغ هائلة في شركاتها المحلية مثل SMIC لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
هذا السباق نحو التوطين يخلق بيئة من الانقسام التكنولوجي يؤدي بدوره إلى خلق معسكرين تكنولوجيين: أحدهما بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، والآخر بقيادة الصين، وتُجبر الدول الأصغر على الاختيار بين المعسكرين، مما يفرض عليها قيودًا تكنولوجية واقتصادية، وهو ما يعكس حربًا باردة جديدة ولكن هذه المرة ليست أيديولوجية فحسب، بل هي تكنولوجية بالأساس.
نحو نظام عالمي جديد قائم على التكنولوجيا
تعتبر الرقائق العصب الرئيسي للتكنولوجيا المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمومية، والشبكات العسكرية المتقدمة، فالتفوق التكنولوجي أصبح الآن مرادفًا للقوة الجيوسياسية، الدول التي تسيطر على صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي هي التي ستمتلك أدوات التأثير والسيطرة في المستقبل، فالتحكم في التكنولوجيا يمنح الدول القدرة على تطوير أسلحة متقدمة، وتحسين قدراتها الاستخباراتية، وحتى التأثير على الرأي العام عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
باختصار، حرب الرقائق هي صراع على القوة والنفوذ، وتداعياتها الاقتصادية ستستمر في التأثير على العالم لسنوات قادمة، لأنّ التحكم في تصنيع الرقائق في القرن الواحد والعشرين بمثابة التحكم في إمدادات النفط في القرن العشرين، فمن يمتلك التكنولوجيا يستطيع أن يقود العالم.
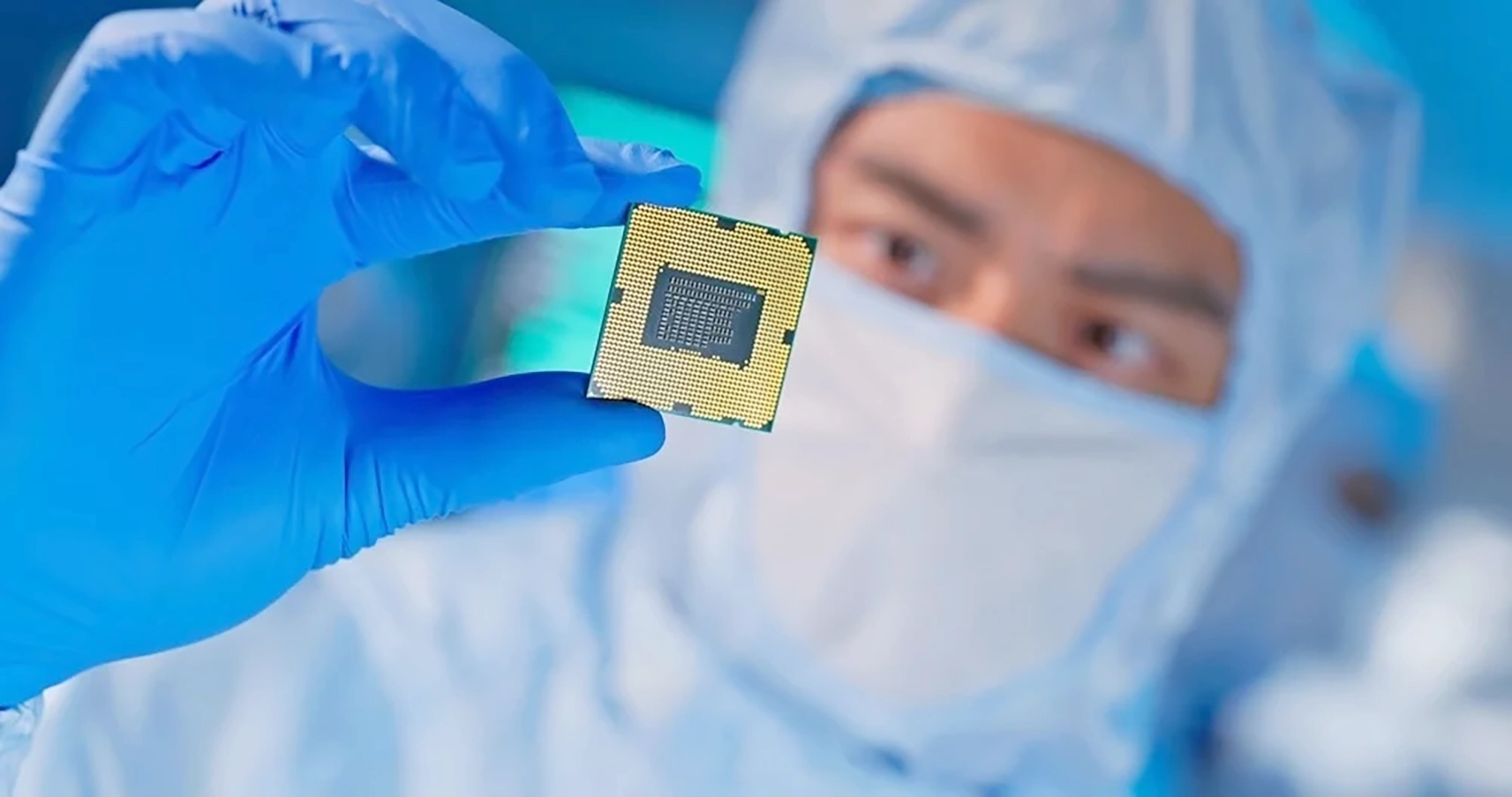
ترى الدكتورة نبيلة بن يحيى، أستاذة التعليم العالي بجامعة الجزائر 3، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن صناعة الرقائق الإلكترونية تتمركز بين أيدي عدد محدود من الفاعلين الكبار، على رأسهم الشركات التايوانية والكورية والأمريكية والأوروبية، وهو ما يمنحهم سلطة غير مسبوقة على مسار التكنولوجيا العالمية. فالرقاقة التي لا يتجاوز حجمها بضعة نانومترات أصبحت اليوم تمثل "العقل الخفي" لكل الأجهزة الإلكترونية، ومن يهيمن على إنتاجها وتطويرها يملك بالضرورة مفاتيح النفوذ في العلاقات الدولية المعاصرة.

الدكتورة نبيلة بن يحيى - أستاذة التعليم العالي بجامعة الجزائر 3
التكنو-بوليتكس.. حين تتحول التكنولوجيا إلى أداة صراع دولي
توضح الدكتورة نبيلة بن يحيى أن شركة TSMC التايوانية تمثل اليوم القلب النابض لصناعة الرقائق الإلكترونية عالميًا، بعد أن استحوذت على أكثر من 56% من الحصة السوقية في الربع الثالث من سنة 2022. هذه المكانة جعلتها المزود الأساسي لشركات عملاقة مثل آبل، إنتل، إنفيديا وهواوي، حيث تعتمد منتجات هذه الشركات بشكل مباشر على قدرات المصنع التايواني. ومن خلال هذا النفوذ غير المسبوق، تحولت TSMC إلى لاعب استراتيجي يمسك بخيوط الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتشير بن يحيى إلى أن أرباح الشركة بلغت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في فترة قصيرة، وهو ما يعكس حجم الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها. فالتكنولوجيا الحديثة، بدءًا من الهواتف الذكية وصولًا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باتت قائمة على ما تنتجه هذه الشركة من رقائق دقيقة. وهذا ما جعل تايوان، عبر TSMC، تتحول إلى "المفتاح" الذي لا يمكن تجاوزه في أي حساب استراتيجي دولي متعلق بالابتكار أو الأمن التكنولوجي.
وتبرز الباحثة أن TSMC صارت رمزًا للقوة الصناعية والمالية. فهي الشركة التايوانية الأولى التي أتاحت أسهمها للتداول في بورصة نيويورك منذ عام 1997، وتُقدَّر قيمتها السوقية بحوالي 550 مليار دولار، ما يجعلها من أعلى شركات أشباه الموصلات قيمة في العالم. هذا الموقع الريادي لم يأتِ من فراغ، بل بفضل استثمارات هائلة في البحث والتطوير، وبنية تحتية متطورة جعلت منها المصنع الأكثر تقدمًا في التكنولوجيا النانوية.
كما تضيف بن يحيى أن تايوان تستحوذ بفضل TSMC على نحو 92% من الرقائق عالية التقنية بدقة 10 نانومترات، وهي الأكثر تقدمًا في العالم. هذه الرقائق قادرة على تخزين حجم هائل من البيانات في مساحات متناهية الصغر، ما يمنحها مكانة خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعات العسكرية. لذلك، أصبح أي اضطراب سياسي أو عسكري يهدد استقرار تايوان بمثابة تهديد مباشر لسلاسل التوريد العالمية.
وتؤكد أن سيطرة TSMC على هذا القطاع لا تعني مجرد تفوق اقتصادي لتايوان، وإنما تشكل ركيزة أساسية في إعادة تعريف القوة العالمية. فمن خلال هذه الشركة، برزت الجزيرة الصغيرة كفاعل جيوسياسي يصعب تجاوزه، وباتت محورًا أساسيًا في معادلات الصراع التكنولوجي بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين.
سامسونغ الكورية… المنافس الأقرب
وإذا كانت تايوان قد نجحت عبر TSMC في فرض هيمنتها على سوق الرقائق الإلكترونية، فإن كوريا الجنوبية لم تقف بعيدًا عن هذا السباق المحموم، ودخلت بقوة عبر شركة سامسونغ التي تُعد المنافس الأقرب للعملاق التايواني. تشير الدكتورة نبيلة بن يحيى إلى أن سامسونغ استحوذت على 15.5% من الحصة السوقية في الفترة نفسها، مسجلة أرباحًا تجاوزت 5.5 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر لاعب عالمي في هذا القطاع. هذا الحضور الكوري يعكس إرادة سياسية واقتصادية في تقليص الفجوة مع تايوان، وضمان موقع متقدم في سلاسل التوريد العالمية.
وتوضح الباحثة أن سامسونغ لم تكتف بدور ثانوي، واستثمرت بشكل واسع في تطوير تقنيات الطباعة النانوية وتحسين كفاءة الإنتاج. وبفضل هذا التوجه، تمكنت من تقديم منتجات تنافس من حيث الجودة والسرعة والابتكار، وهو ما جعلها الخيار المفضل لعدد من الشركات العالمية الباحثة عن بديل استراتيجي بعيدًا عن الاحتكار التايواني. وبهذا أصبحت كوريا الجنوبية تمثل ركيزة أساسية في استقرار أسواق الرقائق العالمية.
وتبرز بن يحيى أن المنافسة بين TSMC وسامسونغ هي انعكاس لصراع أوسع بين دول شرق آسيا، التي باتت تتحكم فعليًا في مستقبل التكنولوجيا العالمية. فالتقارب الجغرافي بين تايوان وكوريا الجنوبية، مع ما يرافقه من تشابك اقتصادي، جعل من هذه المنطقة مركز ثقل لا يمكن لأي قوة دولية تجاوزه. وفي الوقت نفسه، فإن التوترات الجيوسياسية في شرق آسيا تزيد من حساسية هذا التنافس، وتجعل استمراره رهينًا باستقرار الإقليم ككل.
وتضيف أن سامسونغ، رغم قوتها، تبقى في مواجهة تحديات كبيرة، على رأسها اللحاق بالتقدم التكنولوجي المذهل الذي تحققه TSMC في مجال الرقائق المتقدمة بدقة 10 نانومترات وما دونها. ومع ذلك، فإن قدراتها المالية الضخمة واستثماراتها المستمرة تجعلها قادرة على تقليص هذه الفجوة بمرور الوقت. وفي ظل هذا السباق، تتعزز أهمية كوريا الجنوبية كشريك استراتيجي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الصعود الصيني.
وتؤكد المتحدثة على أن صعود سامسونغ تحول إلى ورقة ضغط جيوسياسية، إذ يمنح كوريا الجنوبية موقعًا محوريًا في معادلات الأمن التكنولوجي الدولي. ومن هنا يظهر الترابط الواضح: فبينما تمسك تايوان بمفتاح السيطرة، تحاول كوريا الجنوبية أن تكون الضامن البديل، ما يجعل التنافس بين الشركتين أشبه بسباق لتحديد مستقبل الرقائق، وبالتالي مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.
الشركات الأمريكية… قوة التصميم والابتكار
وبعد أن رسمت تايوان وكوريا الجنوبية معالم الهيمنة في مجال التصنيع، تنتقل بوصلة الصراع نحو الولايات المتحدة، التي برزت عبر شركاتها الكبرى كفاعل رئيسي في تصميم الرقائق الإلكترونية. وتشير الدكتورة نبيلة بن يحيى إلى أن شركات مثل كوالكوم وإنفيديا هي مؤسسات تحتكر عقل التصميم، بما تملكه من براءات اختراع وقدرة على توجيه مسار التطور التكنولوجي. فقد تجاوزت أرباح كوالكوم 29 مليار دولار في عام 2021، فيما تخطت إيرادات إنفيديا 24 مليار دولار في الفترة نفسها، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في هذا السوق العالمي شديد التنافسية.
وتوضح الباحثة أن ما يميز الولايات المتحدة في هذا المجال ليس الإنتاج الضخم، بل الابتكار القائم على البحث العلمي والقدرة على تطوير معالجات متقدمة تخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة. فهذه الشركات الأميركية تضع البصمة الأولى التي تُبنى عليها الصناعة بأكملها، قبل أن تنتقل التصاميم إلى مصانع كبرى مثل TSMC أو سامسونغ لتحويلها إلى منتجات مادية. وبهذا يتجسد التكامل بين التصميم الأميركي والتصنيع الآسيوي كمعادلة تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي.
وتضيف بن يحيى أن هذه الهيمنة في مجال التصميم جعلت الشركات الأميركية في موقع تفاوضي قوي، سواء أمام حلفائها أو خصومها. فهي تمثل العقل الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ما يمنح الولايات المتحدة أداة استراتيجية لممارسة الضغط وإعادة رسم موازين القوة في سلاسل التوريد العالمية. وبذلك يصبح الابتكار التكنولوجي الأميركي بمثابة سلاح غير تقليدي في سياق الصراع الجيوسياسي.
كما تشير إلى أن هذه الشركات تجد نفسها أمام تحديات متعددة، أهمها الحاجة المستمرة لمواكبة الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، في ظل سباق عالمي محموم لتطوير معالجات أكثر سرعة وكفاءة. وهذا يدفعها إلى ضخ استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، من أجل الحفاظ على موقعها الريادي.
وتؤكد على أن الدور الأميركي في تصميم الرقائق لا ينفصل عن التنافس بين تايوان وكوريا الجنوبية في التصنيع، بل يكمله ويعززه، فإذا كانت آسيا تتحكم في خطوط الإنتاج، فإن الولايات المتحدة تحتكر مفاتيح الابتكار، ما يجعل السوق العالمي رهينة لتوازن دقيق بين الشرق والغرب في آن واحد.
أوروبا… من التبعية إلى محاولة الاستقلال
وبعد أن كشفت موازين القوة في مجال الرقائق عن ثنائية آسيوية–أمريكية تجمع بين التصنيع والتصميم، تبرز أوروبا كقوة ثالثة تحاول كسر حلقة التبعية. وتشير الدكتورة نبيلة بن يحيى إلى أن القارة العجوز لم تتمكن من اللحاق بآسيا وأمريكا في حجم الإنتاج أو التصميم، لكنها تمتلك أوراقًا استراتيجية نادرة تمنحها موقعًا استثنائيًا. أبرز هذه الأوراق يتجسد في الشركة الهولندية ASML، التي تحتكر صناعة آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطورة، وهي التقنية الوحيدة القادرة على إنتاج الرقائق الأكثر تقدماً في العالم.
وتوضح أن الدور الألماني يُكمل هذه الصورة، حيث تُعتبر شركة كارل زايس إس إم تي المزود الوحيد عالمياً للمرايا والعدسات المستخدمة في معدات صناعة الرقائق المتقدمة. هذا الاحتكار يضع أوروبا في قلب الصناعة، ليس من خلال الإنتاج الضخم، بل عبر التحكم في الأدوات الضرورية التي لا غنى عنها لسلاسل التوريد العالمية.
كما تبرز الباحثة أن أوروبا تجد نفسها في موقف معقد بين الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من جهة، والحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الصين من جهة أخرى. هذا التوازن الدقيق يعكس محاولة أوروبية لانتزاع مساحة من الاستقلالية في عالم يتسم بحدة الاستقطاب التكنولوجي.
وتؤكد بن يحيى على أن أوروبا لا تزال في طور الانتقال من موقع التبعية إلى موقع الفاعل، لكن هذا المسار يظل هشًا ما لم يُدعّم بقدرات إنتاجية مستقلة.
حين تتحول التكنولوجيا إلى أداة صراع
وبعد أن استعرضت كيف تملك أوروبا أوراقاً استراتيجية تجعلها لاعباً لا يمكن تجاوزه في سلسلة صناعة الرقائق، تنتقل الدكتورة نبيلة بن يحيى إلى بُعد أعمق، وهو البعد السياسي للتكنولوجيا أو ما يُعرف بـ التكنو-بوليتكس. فالعلاقات الدولية لم تعد تُقاس فقط بالقوة العسكرية أو النفوذ الاقتصادي، بل أضحت التكنولوجيا عنصراً حاسماً في صياغة التوازنات، حيث تتحول الرقاقة الإلكترونية من مجرد مكوّن تقني إلى أداة لإعادة رسم خرائط النفوذ العالمي.
وتشير الباحثة إلى أن السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة تجعل من الرقائق الإلكترونية شبيهة بما كان يمثله النفط في القرن العشرين، إذ باتت تُحدد موازين القوة وتُوجّه طبيعة التحالفات والصراعات. فالشركات التي تهيمن على صناعة الرقائق ليست مجرد كيانات اقتصادية، بل أدوات استراتيجية تُستخدم لتعزيز النفوذ الدولي وتقييد المنافسين. وهذا ما يفسر التنافس المحموم بين الصين والولايات المتحدة على التفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة.
كما توضح أن هذا التداخل بين التكنولوجيا والسياسة يُعيد تشكيل مفهوم القوة نفسه. فبدلاً من الاعتماد على مؤشرات تقليدية كحجم الجيوش أو الناتج المحلي، أصبح تأثير التكنولوجيا على طبيعة الأفعال وردود الأفعال الدولية هو المعيار الجديد للقوة. وبالتالي، فإن الصراع لم يعد محصوراً في ميادين القتال أو أسواق المال، بل انتقل إلى مختبرات البحث ومراكز الابتكار وسلاسل التوريد.
وتلفت بن يحيى إلى أن التكنو-بوليتكس يُبرز أيضاً تعقيدات جديدة في العلاقات الدولية، حيث تجد الدول نفسها مضطرة للتعامل مع شركات عملاقة تتحكم في مصائر اقتصاداتها. وهذا يعكس تحوّلاً في أدوار الفاعلين الدوليين، إذ لم تعد الدول وحدها اللاعب الرئيسي، بل باتت الشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات جزءاً من معادلة النفوذ.
وتختتم الدكتورة نبيلة بن يحيى تصريحها لـ"الأيام نيوز" بالتأكيد على أن صناعة الرقائق الإلكترونية تحولت إلى قلب الصراع الجيوسياسي العالمي، حيث تتقاطع مصالح الدول مع نفوذ الشركات العملاقة، ويتداخل الاقتصاد بالتكنولوجيا والسياسة في مشهد معقد. وترى أن السيطرة على هذه الصناعة تمثل اليوم معياراً جديداً للقوة، يحدد موقع الفاعلين الدوليين في النظام العالمي المقبل، مما يجعل أي خلل في موازينها انعكاساً مباشراً على استقرار العلاقات الدولية ومسارها المستقبلي.
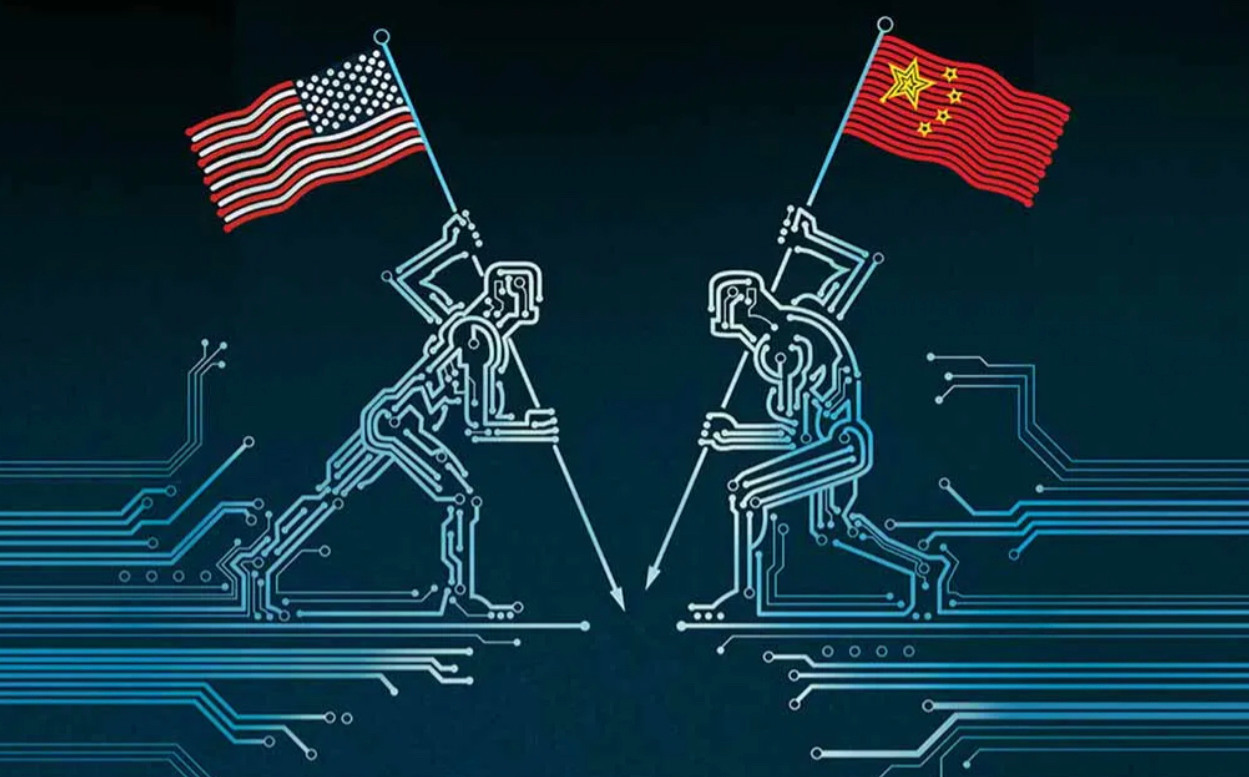
تتحدث الباحثة لبنى جصاص، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، عن مضيق تايوان الذي لم يعد مجرد ممر بحري يفصل بين الصين والجزيرة التايوانية، بل تحوّل إلى "عنق زجاجة" تمر عبره تجارة الرقائق الإلكترونية التي تقوم عليها الصناعات الحديثة والاقتصاد الرقمي العالمي. وتشير إلى أن الموقع الجغرافي الحساس للمضيق جعله في قلب الصراع بين بكين وتايبيه، المدعومة من واشنطن، حيث تتقاطع الحسابات الاقتصادية مع رهانات الأمن والسيادة. وبذلك صار أمن المضيق مسألة لا تخص شرق آسيا وحده، وإنما قضية دولية ترتبط باستقرار سلاسل التوريد العالمية ومستقبل النظام التكنولوجي برمته.

الدكتورة جصاص لبنى - باحثة أكاديمية بجامعة باجي مختار – عنابة
من معارك المدافع إلى حروب الشرائح.. كيف تغيّر وجه الصراع في شرق آسيا؟
ترى الباحثة لبنى جصاص أن مضيق تايوان تحول من ممر مائي ضيق يفصل بين البر الصيني والجزيرة التايوانية، الى شريان رئيسي للاقتصاد العالمي. وتوضح أن هذا المضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 180 كيلومتراً، يحتضن سنوياً أكثر من 400 ألف رحلة بحرية، ويمثل معبراً لحوالي 19% من التجارة الدولية، ما يجعله واحداً من أهم النقاط الحيوية في خريطة النقل البحري العالمي.
وتشير الباحثة إلى أن أهمية المضيق تتضاعف بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي يربط بين شمال شرق آسيا وجنوبها الشرقي والشرق الأوسط، حيث تعتمد كبرى اقتصادات العالم، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، على هذا الطريق البحري لتأمين احتياجاتها. وتضيف أن وصول الموانئ الصينية في هونغ كونغ وشمال البلاد يعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الملاحة في المضيق، وهو ما يجعله رئة حيوية ليس للصين وحدها، بل للمنطقة بأكملها.
وتعتبر جصاص أن الأهمية الاستراتيجية للمضيق تشمل أيضاً صادرات تايوان التي تضاعفت بشكل مذهل خلال العقود الماضية. فحجم المبادلات التجارية بين الصين وتايوان ارتفع من 46 مليون دولار عام 1978 إلى 191.3 مليار دولار في 2019، وهو ما يعكس أن المضيق، رغم كونه ساحة صراع سياسي، ظل أيضاً جسراً اقتصادياً يربط بين الضفتين.
كما تؤكد الباحثة أن تايوان فرضت نفسها في قلب هذه المعادلة من خلال صناعتها المتقدمة للرقائق الإلكترونية، إذ تحتكر مع شركتها العملاقة TSMC أكثر من نصف الإنتاج العالمي لهذه الشرائح الدقيقة. وتوضح أن هذا الاحتكار جعل المضيق ممراً لنقل السلع والنفط، وأيضا معبراً لسلعة استراتيجية تُعد اليوم بمثابة "نفط القرن الحادي والعشرين"، وهي الرقائق الإلكترونية.
وتخلص جصاص إلى أن أمن مضيق تايوان بات عاملاً لا ينفصل عن أمن الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ أن أي اضطراب في حركته سينعكس مباشرة على سلاسل التوريد التكنولوجية، من الهواتف الذكية إلى الصناعات العسكرية. ومن هنا، ترى أن المضيق بات عقدة استراتيجية ترسم بقاء أو اختناق جزء معتبر من التجارة الدولية الحديثة.
من معارك المدافع إلى صراع الشرائح
وتضيف الباحثة لبنى جصاص أن فهم الأهمية الاستراتيجية لمضيق تايوان اليوم لا يكتمل دون العودة إلى جذوره التاريخية، حيث كان هذا الممر منذ منتصف القرن العشرين مسرحاً لصدامات عسكرية متكررة. وتوضح أن أولى هذه الأزمات اندلعت سنة 1949 مع نهاية الحرب الأهلية الصينية، حين انسحب القوميون إلى تايوان وأعلن الشيوعيون قيام جمهورية الصين الشعبية. ومنذ ذلك التاريخ ظل المضيق بؤرة توتر دائم، تتقاطع فيه الحسابات العسكرية مع الطموحات السياسية.
وتشير جصاص إلى أن خمسينيات القرن الماضي شهدت أخطر هذه المواجهات، عندما قصفت القوات الصينية جزيرتي كينمين وماتسو التابعتين لتايوان، في حين تدخلت الولايات المتحدة لدعم حليفتها ومنع سقوطها بيد بكين. وتؤكد أن هذه الأزمات، التي امتدت إلى حدود سنة 1959، رسخت في الذاكرة أن أي اضطراب في المضيق سرعان ما يتحول إلى أزمة إقليمية تتداخل فيها القوى الكبرى.
وترى الباحثة أن التسعينيات أعادت إحياء هذا المشهد مع إطلاق الصين صواريخ بالستية في محيط تايوان عقب زيارة رئيسها إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفع واشنطن لإرسال حاملات طائرات إلى المنطقة في استعراض واضح للقوة. وتوضح أن هذه التطورات أبرزت أن المضيق لم يكن مجرد خط بحري للتجارة، وإنما ساحة اختبار لإرادة الدول، ومسرحاً لمعادلة معقدة بين الصين وتايوان والولايات المتحدة.
وتضيف جصاص أن المشهد تغير مع مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حيث انتقلت الأزمة من لغة المدافع إلى لغة الشرائح الإلكترونية. فتايوان التي كانت سابقاً مجرد جزيرة متنازع عليها، أصبحت اليوم مركزاً عالمياً لإنتاج الرقائق الدقيقة، وهو ما زاد من تعقيد الصراع. وتعتبر أن السيطرة على هذه الصناعة جعلت من تايوان لاعباً لا يمكن تجاوزه، وحولت مضيقها البحري إلى رهان استراتيجي جديد.
وتخلص الباحثة إلى أن ما كان في الماضي صراعاً عسكرياً تقليدياً أصبح اليوم حرباً تكنولوجية بامتياز، تُخاض بأساليب اقتصادية واستراتيجية أكثر منها عسكرية مباشرة. ومن هنا، تؤكد أن تطور طبيعة النزاع في مضيق تايوان يجسد تحوّل العالم من زمن البارود إلى زمن السيليكون، حيث باتت الشرائح الإلكترونية هي الوقود الجديد لصراعات القرن الحادي والعشرين.
الرقاقة.. نفط القرن الحادي والعشرين
وتوضح الباحثة لبنى جصاص أن انتقال الصراع من لغة المدافع إلى لغة الشرائح لم يكن مجرد تغيير في أدوات المواجهة، بل تحوّل جذري في مفهوم القوة نفسه. فإذا كانت المدافع في الماضي تقيس النفوذ بالمساحة المحتلة، فإن الرقاقة اليوم تقيسه بقدرة الدول على التحكم في اقتصاد المعرفة. وتعتبر أن هذه القطعة الصغيرة المصنوعة من السيليكون أصبحت بمثابة "نفط القرن الحادي والعشرين"، بما تحمله من قيمة استراتيجية تفوق أحياناً الموارد التقليدية كالذهب أو البترول.
وتشير جصاص إلى أن الرقائق الإلكترونية لم تعد محصورة في أجهزة الحواسيب، وصارت تدخل في كل تفاصيل الحياة الحديثة: من الهواتف الذكية والأجهزة الطبية، إلى السيارات الكهربائية والطائرات والصواريخ. وتضيف أن هذه الشرائح هي المحرك الخفي للثورة الرقمية التي يعيشها العالم، بحيث يصعب تخيل قطاع صناعي أو خدمي اليوم من دون اعتماد مباشر أو غير مباشر عليها.
وتؤكد الباحثة أن ندرة هذه الصناعة وتعقيدها جعلاها أشد قيمة من الموارد الطبيعية الناضبة. فالرقاقة الواحدة قد تتطلب سنوات من البحث، ومليارات الدولارات من الاستثمارات، وشبكة معقدة من المواد الأولية والتجهيزات المتقدمة. ولهذا، فإن امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها يضع الدولة في مصاف القوى العظمى، في حين يترك فقدانها الاقتصادات الأخرى رهينة للخارج.
كما تعتبر جصاص أن الهيمنة التايوانية على هذه الصناعة، عبر شركة TSMC العملاقة، جعلت من الجزيرة لاعباً محورياً في موازين القوى العالمية. فاحتكارها لإنتاج الشرائح المتقدمة بدقة أقل من 14 نانومتراً منحها نفوذاً يفوق حجمها الجغرافي والسياسي، وحوّلها إلى مركز ثقل اقتصادي يستحيل تجاوزه في حسابات أي قوة كبرى.
وتخلص الباحثة إلى أن الرقاقة تحولت من مجرد مكوّن صناعي، الى ورقة استراتيجية تحدد مكانة الدول في النظام العالمي. فهي تشبه النفط في القرن العشرين من حيث قدرتها على إعادة تشكيل التحالفات، لكنها تتجاوزه لأنها ليست مجرد مصدر للطاقة، بل عقل يُشغّل كل آلة في عصر الرقمنة. ومن هنا، تؤكد أن الرهان على الرقاقة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل خياراً وجودياً يحدد من يقود ومن يتبع في القرن الجديد.
واشنطن وبكين.. معركة الهيمنة على السيليكون
وترى الباحثة لبنى جصاص أن توصيف الرقاقة باعتبارها "نفط القرن الحادي والعشرين" يفسر إلى حد بعيد شراسة التنافس بين الولايات المتحدة والصين. فإذا كان النفط قد أشعل حروب القرن الماضي، فإن السيليكون أصبح وقوداً لمعادلة جديدة، تتصارع فيها القوتان الأكبر على من يملك زمام هذه الصناعة. وتوضح أن كل طرف يدرك أن التفوق في عالم الرقائق ليس مجرد تفوق اقتصادي، وإنما ورقة استراتيجية تعني السيادة في الذكاء الاصطناعي، والقدرة على التحكم في الصناعات العسكرية والرقمية على حد سواء.
وتشير جصاص إلى أن الولايات المتحدة تعاملت مع الرقاقة كسلاح استراتيجي لا يختلف عن الصواريخ أو الطائرات الحربية، ففرضت قيوداً صارمة على تصدير الشرائح المتقدمة إلى الصين، ومنعت الشركات الحليفة من بيع معدات الطباعة المتطورة لها. كما أطلقت برامج ضخمة لإعادة التصنيع إلى أراضيها، مثل خطة "إعادة صناعة أشباه الموصلات" التي رُصد لها أكثر من 90 مليار دولار، في محاولة لتقليل الاعتماد على آسيا واحتواء الصعود الصيني.
وتضيف الباحثة أن الصين من جهتها تبنّت استراتيجية طويلة المدى عبر برنامج "صُنع في الصين 2025"، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق والوصول إلى نسبة 94% من الإنتاج محلياً. وقد ضخت مئات المليارات في مشاريع البحث والتطوير، واستحوذت على شركات أجنبية متخصصة، محاولةً سد الفجوة التكنولوجية التي تفصلها عن منافسيها. وتعتبر جصاص أن هذه السياسة جعلت من بكين لاعباً صاعداً يقترب بخطى متسارعة من النادي المغلق للدول المهيمنة على السيليكون.
وتؤكد الباحثة أن المواجهة بين الطرفين لم تعد مقتصرة على الجانب الصناعي، وتحولت إلى معركة جيوسياسية تُدار عبر التحالفات الدولية. فواشنطن تضغط على حلفائها الأوروبيين والآسيويين لمنع توريد التقنيات المتقدمة إلى الصين، في حين توسع بكين شراكاتها مع دول نامية توفر المواد الأولية النادرة أو تفتح أسواقاً جديدة لمنتجاتها. وهكذا، صارت الرقاقة أداة لإعادة تشكيل خارطة النفوذ والتحالفات على المستوى العالمي.
وتخلص جصاص إلى أن ما يجري بين الولايات المتحدة والصين حول السيليكون يتجاوز مجرد حرب تجارية، الى صراع على القيادة العالمية. فمن يسيطر على دورة إنتاج الرقاقة من البحث إلى التصنيع يضمن لنفسه موقع الريادة في الاقتصاد الرقمي، ويملك مفاتيح المستقبل في عالم تُدار فيه الثروات والعلاقات بخيوط من السيليكون.
عنق الزجاجة الذي يرسم ملامح المستقبل
وتضيف الباحثة لبنى جصاص أن هذا التنافس المحموم بين واشنطن وبكين ما كان ليأخذ بعده الحالي لولا وجود نقطة حساسة تختصر المشهد كله: مضيق تايوان. فالمعركة على السيليكون لا تجري في فراغ، بل تتمركز في هذا الممر البحري الضيق الذي تحوّل إلى "عنق زجاجة" تتحكم من خلاله تايوان في جزء معتبر من مستقبل التكنولوجيا العالمية. وتوضح أن أي خلل في أمن هذا المضيق يعني مباشرة اهتزاز سلاسل التوريد وانقطاع شرايين الاقتصاد الرقمي.
وتشير الباحثة إلى أن شركة TSMC التايوانية، التي تسيطر على أكثر من نصف سوق الرقائق المتقدمة في العالم، جعلت من المضيق رهينة لتوازن دقيق بين الأمن والسياسة والتجارة. فأي توتر عسكري أو مناورات قرب الممر تعني تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وهو ما يفسر حجم الحشد الأمريكي حول الجزيرة والدعم المتزايد لها.
وتؤكد جصاص أن الصين، رغم إدراكها لأهمية المضيق، لا تستطيع المخاطرة بعرقلة الملاحة فيه بسهولة، لأن جزءاً كبيراً من تجارتها يمر عبره أيضاً. وهنا تكمن المفارقة: الممر الذي يمنحها منفذاً حيوياً هو ذاته الذي يضعها في مواجهة مع القوى الكبرى. وهو ما يجعل من إدارة الأزمة مسألة دقيقة، تحتاج إلى موازنة بين الرغبة في السيطرة والضرورة في الاستقرار.
كما تعتبر الباحثة أن المضيق لم يعد مجرد جغرافيا بحرية، بل صار نقطة ارتكاز لمعادلة جيوسياسية واقتصادية أكبر. فكل سفينة تمر من هناك لا تحمل فقط بضائع وسلعاً، بل تحمل معها رهانات النظام العالمي الجديد: من يملك المرور الآمن يملك السيطرة على التكنولوجيا، ومن يملك السيطرة على التكنولوجيا يرسم ملامح المستقبل.
وتخلص جصاص إلى أن عنق الزجاجة هذا هو الذي سيحدد إن كان العالم يتجه نحو تعاون يضمن تدفق الرقائق واستقرار الأسواق، أم نحو صراع قد يشل الاقتصاد الرقمي العالمي. وهكذا، يصبح المضيق مرآة لمستقبل العلاقات الدولية: ضيق في مساحته، لكنه واسع في تداعياته، قادر على رسم مسار القرن الحادي والعشرين بأكمله.
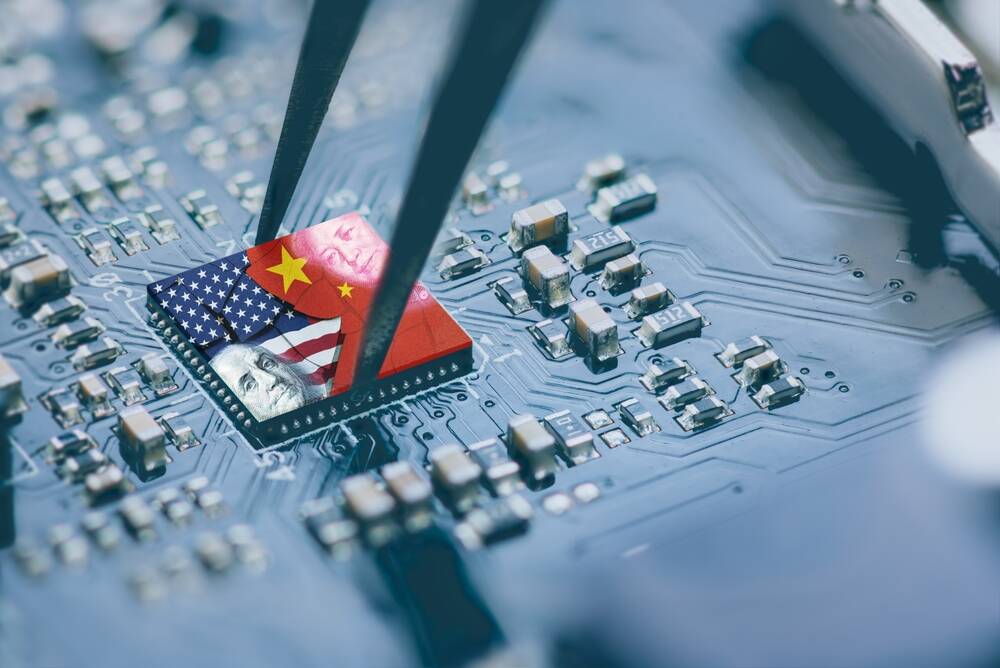
يرى الدكتور ساعد رشيد، أكاديمي وباحث جزائري بجامعة تيارت، في تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي غدا المحرك الأساسي لمعادلات الاقتصاد والسياسة في القرن الحادي والعشرين، حيث تُقاس مكانة الدول بمدى قدرتها على تطوير هذه التكنولوجيا وامتلاك أدواتها. ويؤكد أن الرقائق الإلكترونية، تلك القطع الصغيرة التي تختزن بداخلها سر الثورة الرقمية، تمثل البنية التحتية الخفية التي يقوم عليها هذا الذكاء، بحيث تتحول من مجرد مكوّن تقني إلى رهان استراتيجي يرسم ملامح النفوذ الدولي. ومن هنا، يصبح السباق نحو الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة انعكاسا للتجاذبات العالمية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، في معركة يتجاوز مداها حدود المختبرات لتطال مستقبل النظام العالمي برمته.

الدكتور ساعد رشيد، أكاديمي وباحث -جامعة تيارت-
من الرقاقة إلى الهيمنة.. واشنطن وبكين في سباق العقول الرقمية
يؤكد الدكتور ساعد رشيد، أن التاريخ الإنساني حافل بمحطات فارقة صنعت تحولات كبرى في حياة البشر، بدءا من الثورة الزراعية، مرورا بالثورة الصناعية، وصولا إلى الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم. وإذا كانت هذه المراحل قد نقلت المجتمعات من نمط إلى آخر، فإن بروز الذكاء الاصطناعي يكرّس لحظة جديدة أكثر عمقًا وتأثيرًا، حيث بات يشكل علامة فارقة في المشهد التكنولوجي والمعرفي العالمي.
ويضيف أن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأبرز في رسم مسارات الاقتصاد والسياسة والمجتمع على حد سواء. فقد ساهم انفجار المعرفة وتراكم الابتكارات في جعل الذكاء الاصطناعي يتصدر أولويات الأجندات الدولية، كونه يوفر حلولًا ثورية لمعضلات قديمة تتعلق بالصحة والغذاء والطاقة والتعليم، فضلًا عن دوره في صياغة ملامح القوة العالمية.
غير أن هذه التحولات لم تبقَ في إطارها التقني البحت، وسرعان ما تحولت إلى رهانات سياسية واقتصادية كبرى، إذ باتت الدول تسعى إلى السيطرة على هذه التكنولوجيا باعتبارها أداة لتحقيق النفوذ الدولي. وهنا يبرز الصراع الصيني–الأمريكي كأحد أهم تجليات هذا التنافس، حيث ترى كل من واشنطن وبكين في الذكاء الاصطناعي بوابة نحو قيادة النظام العالمي الجديد، ومفتاحًا لترجيح موازين القوى لصالحها.
ويشير الباحث إلى أن الرهانات الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن فصلها عن البنية التحتية التي تقوم عليها، والمتمثلة في الرقائق الإلكترونية. هذه الأخيرة، بحجمها الدقيق، تختزن القدرة على تشغيل المصانع والهواتف والسيارات والجيوش، ما يجعلها بمنزلة "نفط القرن الحادي والعشرين"، وورقة ضغط مركزية في التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى.
وبذلك يتضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مسار تطور طبيعي للتكنولوجيا، وإنما ميدانًا لصراع شرس بين الولايات المتحدة والصين، تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات الاستراتيجية، ويختبر فيه العالم حدود التوازن بين الابتكار والهيمنة. ومن هنا، فإن أي مقاربة لفهم مستقبل هذه التقنية لا بد أن تنطلق من قراءة هذا الصراع بوصفه الإطار الأوسع الذي يحدد مآلاته.
الذكاء الاصطناعي.. ساحة للتجاذب الصيني–الأمريكي
ويرى الدكتور ساعد رشيد، أن التفاعلات الصينية–الأمريكية تمثل أحد أهم النماذج التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل هذا القطاع من أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين وأكثرها حساسية. فالصراع بين البلدين لم يعد مجرد تنافس اقتصادي أو تكنولوجي، إذ تحوّل إلى رهان استراتيجي أعمق، يهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوة العالمية وترسيخ النفوذ على المستويات كافة.
ويشير الباحث إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لتجسيد الأهداف القومية والعسكرية للدولتين، حيث تسعى واشنطن إلى الحفاظ على تفوقها التاريخي من خلال تعبئة مواردها، في حين ترد بكين بتسخير إمكاناتها الهائلة ورؤيتها طويلة المدى لاقتحام المشهد العالمي. وبذلك، غدا الذكاء الاصطناعي عنوانًا لمعركة سيادة تكنولوجية تتقاطع فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية.
ويؤكد أن هذا الصراع يأخذ أبعادًا متشعبة، إذ يمتد من مراكز الأبحاث والابتكار إلى مصانع الرقائق الإلكترونية التي تُعد العمود الفقري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. فالتفوق في هذا المجال يعني امتلاك القدرة على التحكم في المستقبل، سواء عبر تطوير منظومات الأسلحة الذكية أو قيادة الثورة الرقمية التي تُعيد تشكيل كل القطاعات الحيوية. ومن هنا، فإن المسألة أصبحت سباقًا محمومًا نحو بناء نظام عالمي جديد ولم تعد مجرد تنافس على السوق التكنولوجي.
كما يوضح أن تجاذب القوى بين واشنطن وبكين يعكس أيضًا سباقًا في إعداد الكفاءات واستقطاب العقول المبدعة. فالتفوق في الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارًا ضخمًا في الموارد البشرية، وهو ما يدفع كلا البلدين إلى ضخ مليارات الدولارات في برامج البحث والتطوير، وتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة. وهذا بدوره يعزز مكانة الذكاء الاصطناعي كحجر زاوية في الاستراتيجيات الوطنية للدول الكبرى.
ويخلص الدكتور رشيد إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل اليوم المحور الأساسي في مسار العلاقات الصينية–الأمريكية، بما يحمله من إمكانات وفرص، وما يثيره في الوقت نفسه من مخاطر وتحديات. فهو المجال الذي ستُحسم فيه، على الأرجح، معركة الريادة العالمية في العقود القادمة، ما يجعله قلب الصراع التكنولوجي والاقتصادي الجديد بين العملاقين.
الذكاء الاصطناعي.. رافعة للهيمنة الدولية
كما يرى الدكتور ساعد رشيد، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية لتطوير المنتجات والخدمات، وتحول إلى رافعة استراتيجية تُمكّن الدول من تعزيز نفوذها في النظام العالمي. فالولايات المتحدة ما زالت تقود السباق، بفضل امتلاكها لبنية تحتية متطورة وشركات عملاقة تسيطر على الأسواق العالمية، غير أن الصين بدورها تسجّل تقدمًا متسارعًا، ما يهدد بتقليص الفجوة بين العملاقين في السنوات المقبلة. هذا التنافس يجعل من الذكاء الاصطناعي أداة لإعادة تشكيل موازين القوى.
ويشير الباحث إلى أن الولايات المتحدة تتصدر حاليًا معظم التصنيفات في مجال الذكاء الاصطناعي، غير أن التفوق الأمريكي يواجه تحديًا صينيًا صريحًا، إذ تستثمر بكين موارد هائلة وتضع سياسات طموحة تتيح لها دخول مجالات الابتكار والتطبيق بشكل واسع. هذا التوجه يعكس قناعة صينية بأن الذكاء الاصطناعي ضرورة وجودية لضمان موقعها في النظام الدولي.
كما يوضح أن السباق بين واشنطن وبكين يكتسب طابعًا متعدد الأبعاد؛ فإلى جانب البعد التكنولوجي، يبرز البعد العسكري والأمني، حيث يُوظَّف الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة ذكية وأنظمة دفاعية متقدمة، بما يجعل السيطرة عليه مسألة أمن قومي. هذا البعد يعمّق من خطورة المنافسة، إذ تصبح التكنولوجيا وسيلة لحسم صراعات المستقبل.
ويؤكد الدكتور رشيد أن التنافس الصيني–الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي يُغذيه كذلك البعد الحضاري والفلسفي. فالنموذج الأمريكي قائم على الانفتاح والابتكار المدفوع بالمبادرات الخاصة، بينما النموذج الصيني يُبنى على التخطيط المركزي والقدرة على تعبئة الموارد بسرعة هائلة. هذا الاختلاف في الرؤى لا يعكس فقط تباينًا في السياسات، بل يكشف عن رؤيتين متناقضتين لمستقبل النظام الدولي.
وفي ضوء ذلك، يخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مركزيًا في المعادلة الجيوسياسية الجديدة. فمن خلاله تُدار الصراعات الاقتصادية، وتُعالج القضايا العالمية الكبرى مثل المناخ والتنمية المستدامة، وتُحدد ملامح التفوق بين الأمم. وبذلك، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أصبح "نفط القرن الحادي والعشرين"، ومن يسيطر عليه يملك مفاتيح القوة والنفوذ في المستقبل.
الذكاء الاصطناعي.. رؤى مستقبلية
ويشدد الدكتور ساعد رشيد، على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يمكن تركه لرحمة التطورات العشوائية أو الاستخدامات غير المنضبطة، بل يحتاج إلى إطار منظم يقوم على ضبط الاستعمالات وتوجيهها نحو خدمة الإنسانية. من هنا، يرى أن الخطوة الأولى تكمن في العمل على تقنين وأخلقة أنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى لا تتحول هذه التكنولوجيا إلى مصدر تهديد للمجتمعات بدل أن تكون أداة تقدم.
ويضيف أن التعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتطلب منهجًا صارمًا يجمع بين الجذرية والصرامة، لأن التراخي في هذا المجال قد يفتح الباب أمام توظيفات أيديولوجية أو عسكرية تُفاقم من التوترات العالمية. لذلك، أوصى الباحث بضرورة كشف هذه التهديدات مبكرًا، ومعالجة التداعيات المحتملة عبر آليات رقابية دولية.
كما اعتبر أن تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف يُمثل مدخلًا أساسيًا لتقليص المخاطر وتحييد الآثار السلبية. فالذكاء الاصطناعي، بتطبيقاته المتسارعة، يحتاج إلى شبكات تبادل للمعلومات وخبرات مشتركة، تضمن الحد من الانزلاقات المحتملة وتمنح فرصًا متساوية للاستفادة من العوائد. بهذا المعنى، فإن البعد الجماعي يصبح ضرورة لا غنى عنها.
ولم يغفل الباحث الإشارة إلى ضرورة وضع حدود واضحة أمام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الملفات الحساسة، خصوصًا تلك المتعلقة بالتسلح النووي، الفضاء، أو حتى المجال البيولوجي. فهذه الجوانب الحساسة لا تحتمل التجريب أو الاستغلال الأيديولوجي، وهو ما يستدعي وضع أطر قانونية وأخلاقية صارمة تحكم استخدامها وتضبط مخرجاتها.
ويخلص الدكتور ساعد رشيد، إلى أن الذكاء الاصطناعي تحول إلى ساحة صراع مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة، تتجاوز حدود المختبرات إلى قلب الاستراتيجيات الجيوسياسية. هذا الصراع، الذي تشتد فصوله في ميدان حرب الرقائق الإلكترونية، يكشف أن السيطرة على هذه الصناعة الدقيقة باتت مرادفًا للهيمنة على مستقبل الاقتصاد العالمي والنفوذ الدولي. فبينما تسعى واشنطن لتثبيت تفوقها عبر استثمارات وتشريعات هائلة، تواصل بكين تحديها بخطط طموحة ومشاريع عملاقة، ما يجعل من الذكاء الاصطناعي ورهاناته التكنولوجية والاقتصادية عنوانًا رئيسيًا للصراع الدولي في العقود القادمة.
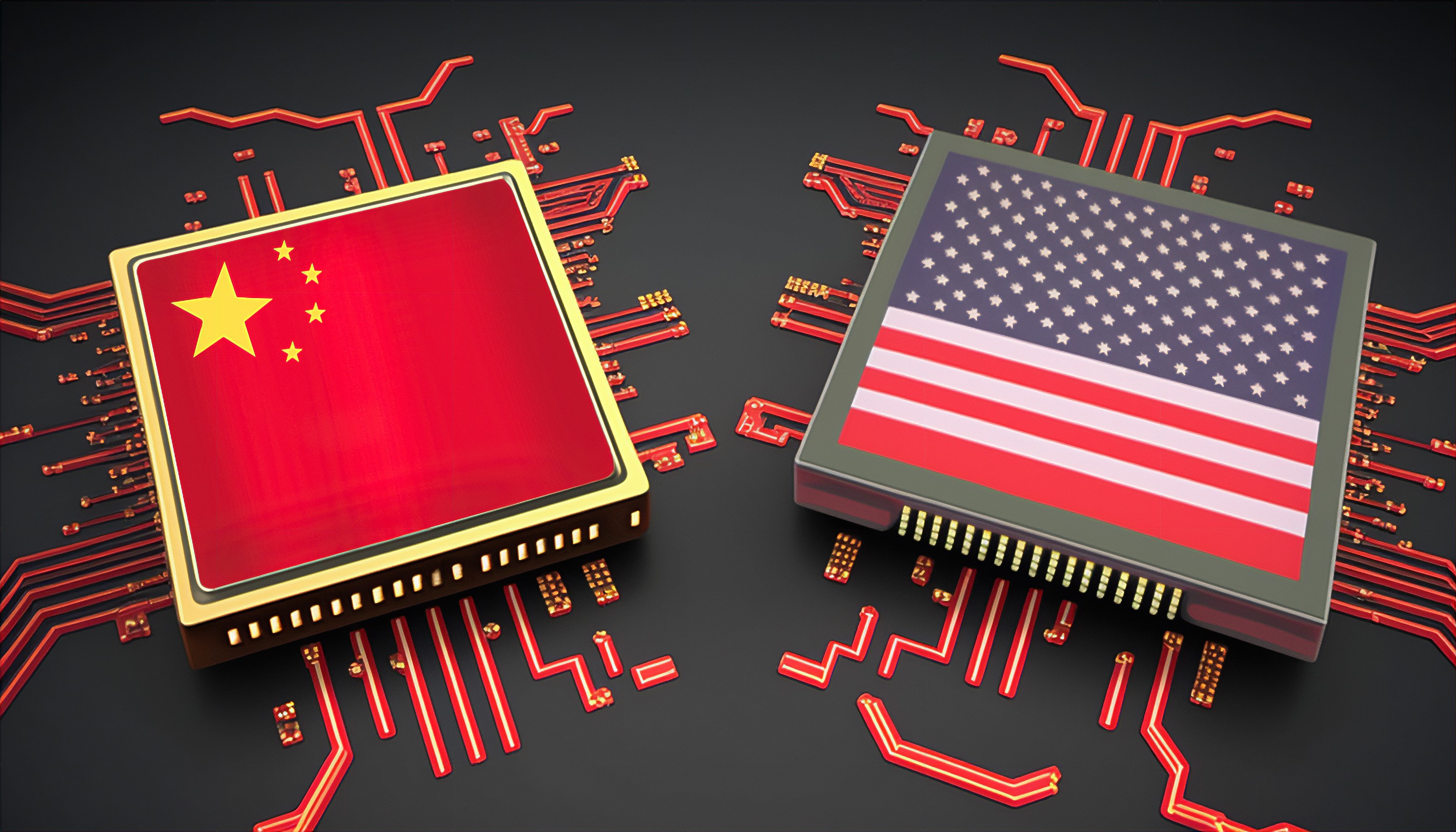
يرى الدكتور عبد الجبار بن عرعور، أستاذ محاضر بجامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2، في تصريح لـ"الأيام نيوز"، أن الحرب التكنولوجية أصبحت أحد أبرز مظاهر العلاقات الدولية المعاصرة، بعدما انتقلت من كونها منافسة اقتصادية وتجارية إلى صراع استراتيجي تُوظف فيه التكنولوجيا المتقدمة كأداة لإعادة تشكيل موازين القوى. ويؤكد أن هذا الصراع، الذي تمثل فيه الصين والولايات المتحدة الأمريكية النموذج الأوضح، يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة القانون الدولي على استيعاب تحدياته، وإيجاد آليات ناجعة لإدارته وضبط مساراته، في ظل التداخل المعقد بين الاقتصاد، السياسة، والأمن.

الدكتور عبد الجبار بن عرعور - أستاذ محاضر بجامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2
بين التحكيم والعقوبات.. أي دور للقانون الدولي في صراع السيليكون؟
يشير الدكتور عبد الجبار بن عرعور إلى أن العلاقات الدولية لم تعد تُدار فقط من خلال الدبلوماسية التقليدية أو المواجهات العسكرية المباشرة، إذ دخلت التكنولوجيا بقوة لتكون ميدانًا جديدًا للصراع بين القوى الكبرى. فالمعارك التي تُخاض اليوم لا ترتبط فقط بالأسواق أو النفوذ السياسي، وإنما تتجسد في السباق نحو امتلاك التفوق التكنولوجي الذي يُحدد بدوره معالم القوة والنفوذ على الصعيد العالمي.
ويضيف أن الحرب التكنولوجية، بما تحمله من رهانات متصلة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والأمن السيبراني، تعكس تحولًا استراتيجيًا في طبيعة التنافس الدولي. فالقوى الكبرى باتت تعتبر أن السيطرة على التكنولوجيا هي المدخل الحقيقي لتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية معًا، وهو ما يفسر حدة الصراع الراهن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا الإطار، يؤكد أن نموذج بكين وواشنطن يُجسد أوضح صورة لهذا الصراع، حيث تعمل الأولى على تقليص الفجوة التكنولوجية عبر استثمارات هائلة ومشاريع وطنية طموحة، بينما تسعى الثانية للحفاظ على ريادتها عبر تشريعات صارمة وتحالفات مع القوى التكنولوجية الصاعدة. وهكذا، تتحول الحرب التكنولوجية إلى عنصر محدد لموازين القوى الدولية، وإلى اختبار حقيقي لقدرة القانون الدولي على مجاراة هذه التحولات.
الحرب التجارية التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة
يؤكد الدكتور عبد الجبار بن عرعور أن الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة أخذت بُعدًا تجاريًا واضحًا، حيث لم تعد المسألة مرتبطة فقط بالتفوق العلمي أو البحثي، بل تحولت إلى نزاع مفتوح حول سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية. فالولايات المتحدة سعت إلى فرض قيود وعقوبات صارمة على الشركات الصينية، وعلى رأسها تلك العاملة في قطاع الرقائق الإلكترونية، بهدف الحد من قدرتها على الوصول إلى التقنيات المتقدمة التي تُعد أساسًا للتفوق في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وفي المقابل، عملت الصين على مواجهة هذه الضغوط عبر استراتيجيات متعددة، أبرزها الاستثمار الضخم في البحث والتطوير، وتبني سياسة الاكتفاء الذاتي التكنولوجي من خلال برامج مثل "صُنع في الصين 2025". وقد ضخّت بكين مئات المليارات من الدولارات لدعم شركاتها الوطنية وتعزيز قدرتها على تصنيع الرقائق المتقدمة محليًا، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الغرب وتحقيق السيادة التكنولوجية.
ويرى الدكتور بن عرعور أن هذه الحرب التجارية لم تقتصر تداعياتها على البلدين فقط، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي برمته، حيث تضررت سلاسل الإمداد، وارتفعت تكاليف الإنتاج، ووجدت العديد من الدول نفسها مضطرة إلى الانحياز لهذا الطرف أو ذاك. وهكذا، بات الصراع التجاري التكنولوجي بين واشنطن وبكين مرشحًا لإعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الدولي، بل وربما لفتح الباب أمام نظام عالمي جديد تُحدد فيه التكنولوجيا معايير القوة والهيمنة.
إدارة الحرب التكنولوجية وفق منظور القانون الدولي
ويرى الدكتور عبد الجبار بن عرعور أن الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة لا يمكن فهمها فقط كبُعد اقتصادي أو تجاري، بل يجب النظر إليها من زاوية القانون الدولي الذي يوفر مجموعة من الآليات لتسويتها. ويشير إلى أن أولى هذه الوسائل تتمثل في الطرق السياسية والدبلوماسية، حيث يلجأ الطرفان إلى التفاوض المباشر أو عبر وسطاء دوليين من أجل ضبط قواعد المنافسة التكنولوجية. فالمبادرات الدبلوماسية تمثل أداة لتخفيف حدة التوتر ومنع الانزلاق نحو صدام مفتوح يضر بالاقتصاد العالمي.
أما المسار الثاني، فيتمثل في أدوات الإكراه التي قد تُفرض في إطار القانون الدولي لتسوية النزاعات التجارية. فالولايات المتحدة والصين تبادلتا فرض القيود والإجراءات العقابية، مثل العقوبات الاقتصادية وحظر التصدير ومنع التوريد، كوسائل ضغط تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوة في قطاع التكنولوجيا. وهذه السياسات، وإن كانت تُضعف مؤقتًا أحد الأطراف، إلا أنها غالبًا ما تُعقّد فرص الوصول إلى تسوية مستدامة وتفتح المجال أمام مزيد من التصعيد.
ويضيف أن القانون الدولي يتيح أيضًا سُبلًا قضائية لحل النزاعات التكنولوجية، أبرزها التحكيم الدولي واللجوء إلى المنظمات القضائية المختصة. فآليات مثل التحكيم الإلكتروني أو الوساطة عبر المنظمات الدولية تمثل خيارًا مطروحًا لتسوية الخلافات بطريقة سلمية. غير أن نجاح هذه الأدوات يبقى مرهونًا بمدى استعداد الأطراف للقبول بقرارات ملزمة، والاعتراف بأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة تنافسية، بل قضية عالمية تتطلب تعاونًا يتجاوز حدود السيادة الوطنية.
مستقبل الحرب التكنولوجية... بين الفخ التاريخي وإمكانات القانون الدولي
ويؤكد الدكتور عبد الجبار بن عرعور أن مستقبل الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا يمكن عزله عن السياق التاريخي للنزاعات بين القوى الصاعدة والقوى المهيمنة. ففي قراءته للأدبيات الفكرية، خاصة أطروحات الباحث "غرايم أليسون" حول حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة، يتضح أن السؤال الجوهري يتمثل فيما إذا كانت واشنطن وبكين ستنجحان في الإفلات من المواجهة العسكرية؟
ويضيف أن التحذيرات الفكرية لا تستند إلى التهويل بقدر ما تعكس واقعًا تُظهره سجلات التاريخ. فالمسار الحالي للتوترات، إذا استمر دون ضوابط أو آليات عقلانية، يجعل احتمالية اندلاع مواجهة كبرى خلال العقود القادمة أكبر بكثير مما يُتصور اليوم. هذه القراءة التاريخية تضع القادة في البلدين أمام مسؤولية مضاعفة، إذ أن أي استمرار في نفس أساليب إدارة الصراع القائمة منذ أكثر من عقد قد يقود إلى حرب يصعب تفاديها.
غير أن الدكتور بن عرعور يشير في المقابل إلى أن الحرب ليست قدرًا محتومًا لا يمكن تجنبه، فالتاريخ يقدم أيضًا نماذج لنجاحات تمكنت فيها القوى الكبرى من إدارة تنافسها مع خصومها دون الوصول إلى مواجهة شاملة. وهنا يبرز دور القانون الدولي كإطار مرجعي يوفر للدول أدوات بديلة للتعامل مع النزاعات التكنولوجية. فبدل الانزلاق نحو الصدام، يمكن للولايات المتحدة والصين أن تعتمدا على التفاوض، التحكيم، وآليات التسوية السلمية لصياغة قواعد جديدة تضبط المنافسة وتُجنب العالم تداعيات حرب مدمرة.
القانون الدولي بين حتمية الصراع وإمكانات التسوية
ويلخص الدكتور عبد الجبار بن عرعور رؤيته بالتأكيد على أن الحرب التكنولوجية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز مجرد التنافس الاقتصادي لتتحول إلى قضية تكريس للهيمنة وأسبقية التفوق. فكل طرف يسعى إلى تثبيت موقعه في النظام الدولي، الأمر الذي يجعل التساؤل قائمًا حول ما إذا كان مصير هذا الصراع سينتهي بمواجهة عسكرية، أم أن هناك إمكانات واقعية لتفاديها عبر أدوات أخرى. وهنا يستحضر فكر "غرايم أليسون" الذي نبّه إلى أن استمرار المسارات الحالية يرفع احتمالات الحرب بشكل مقلق، خاصة مع صعود الصين كقوة اقتصادية ثانية عالميًا، وما يرافق ذلك من تحديات للنظام الدولي القائم.
ومن بين أبرز النتائج التي يشير إليها، أن دراسة موضوع القانون الدولي وتحديات التكنولوجيا باتت مسألة محورية لفهم التحولات الجارية. فالقواعد القانونية الدولية لم تعد قادرة على البقاء في شكلها التقليدي أمام سرعة الابتكارات التكنولوجية واتساع نطاق استخدامها في السياسة والاقتصاد والأمن. لذا، فإن إعادة النظر في تطور القانون الدولي بما يتناسب مع هذا الواقع يُعتبر ضرورة لتأطير التفاعلات بين القوى الكبرى.
ويخلص الدكتور بن عرعور إلى أن القانون الدولي هو الميكانيزم الأنجع لإدارة هذه الحرب التجارية التكنولوجية، شرط أن تكون عقلانية ومنضبطة. فكلما ارتفع منسوب العقلانية في إدارة الصراع بين بكين وواشنطن، زادت فرص القانون الدولي في أن يؤدي دوره كوسيلة لتنظيم التنافس، والعكس صحيح. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الطرح يبقى مرهونًا بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف، وبانخراط الفاعلين الدوليين في إثراء النقاش حول هذه القضية باعتبارها إحدى أهم قضايا العلاقات الدولية في زمن الثورة التكنولوجية.
ويؤكد الدكتور عبد الجبار بن عرعور، في ختام تصريحه لـ"الأيام نيوز"، أن الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة ليست مجرد منافسة اقتصادية أو صراع حول الرقائق والذكاء الاصطناعي، بل هي اختبار حقيقي لمدى قدرة القانون الدولي على التكيف مع تحولات غير مسبوقة في العلاقات الدولية. فالقانون الدولي، إذا ما أُحسن توظيفه بعقلانية سياسية، يمكن أن يشكل الإطار الأنجع لتجنب انزلاق العالم نحو مواجهة مفتوحة، من خلال توفير آليات للتسوية والتحكيم والتفاوض. ومن هنا، تصبح الحاجة ملحة لإعادة تطوير قواعده بما يستجيب لتحديات التكنولوجيا الحديثة، حتى يظل أداة لضبط التوازن بين القوى الكبرى، ويضمن أن يبقى التنافس في حدود المشروعية الدولية بدل أن يتحول إلى حرب تقوض النظام العالمي برمته.