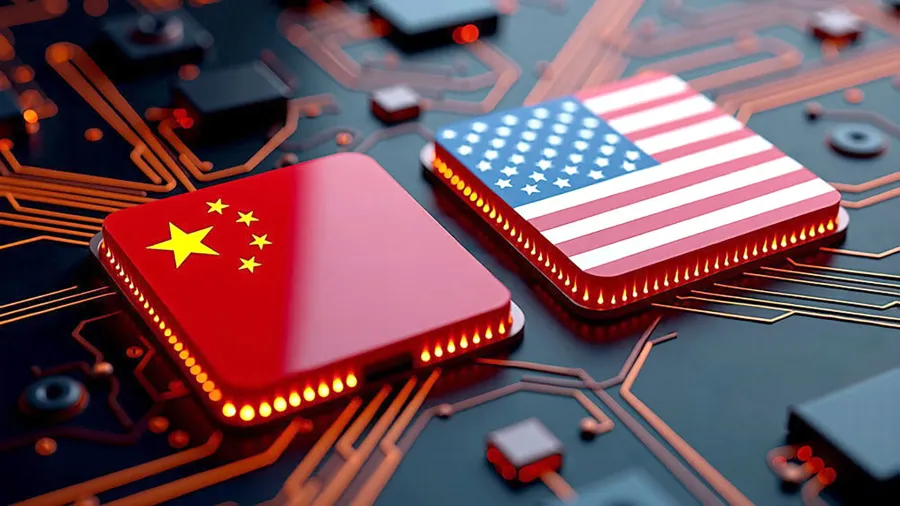حين تصحو إفريقيا، لا تفعل ذلك دفعة واحدة ولا بأمر من الخارج، بل بنبض داخلي يوقظ الذاكرة ويستدعي المستقبل في آن واحد ومنذ الخميس، تعيش الجزائر على إيقاع حدث يتجاوز كونه معرضًا اقتصاديًا إلى كونه إعلانًا عن يقظة قارية: الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025). هنا لم تكن الأجنحة مجرد فضاءات تجارية، بل منصات لرواية كبرى تحيكها القارة حول هويتها، سيادتها، وأحلامها المؤجلة.
من أول وهلة، بدا المعرض مشروعًا اقتصاديًا ضخمًا، لكن القراءة المتأنية تكشف أنه يتجاوز لغة الأرقام، فقد شارك أكثر من 2000 عارض و35 ألف مؤسسة من 170 دولة، في لحظة تعكس حجم الرغبة الإفريقية في إعادة صياغة شبكة التبادل بعيدًا عن شروط القوى الخارجية، والأرقام المتداولة عن ضعف التجارة البينية ــ 15% فقط من مجموع المبادلات ــ كانت حاضرة كجرس إنذار، لكن خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قلبها إلى فرصة، حين شدّد على ضرورة تحويل هذا الهامش الضيق إلى رهان عملي لبناء أسواق إفريقية مترابطة.
إفريقيا اليوم تدفع سنويًا نحو 90 مليار دولار لسد فجوة البنية التحتية، لكن هذه الفاتورة ليست عائقًا فقط، بل دعوة إلى التعاون. من هنا جاء التركيز على مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا والنيجر بالجزائر وصولًا إلى أوروبا، المشروع ليس مجرد خط أنابيب، بل شريان يربط القارة بأسواق عالمية وفق شروط أكثر عدلاً، ويمنح الجزائر دورًا محوريًا في رسم خريطة الطاقة.
سوناطراك، الحاضرة بقوة، لم تكتف بتسويق قدراتها في النفط والغاز، بل أبرزت جانب التكوين من خلال معهد بومرداس، لتؤكد أن صناعة المستقبل لا تقوم على الموارد وحدها، بل على المعرفة وتوطين الخبرة.
وفي السياق نفسه، شهدت أروقة المعرض توقيع عقود لافتة مثل اتفاقية "السويدي إلكتريك-الجزائر" لتصدير كوابل كهربائية إلى كوت ديفوار بقيمة 100 مليون دولار، وهو نموذج مصغر لديناميكية جديدة تتجاوز منطق تصدير المواد الخام نحو خلق قيمة مضافة حقيقية.
السياسة في ثوب الاقتصاد
غير أن الاقتصاد لم يكن وحده في الواجهة، حيث تحول المعرض سريعًا إلى قمة سياسية مصغّرة. حضور قادة أفارقة، على غرار رئيس الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو والرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أضفى طابعًا استراتيجيًا على النقاشات، الجزائر استثمرت المناسبة لتعيد تثبيت صورتها كمنصة للتوازنات الإقليمية. ست اتفاقيات وُقعت مع الموزمبيق، شملت مجالات الثقافة، التعليم، الأمن، والإعلام، لتؤكد أن الدبلوماسية الاقتصادية لم تعد ترفًا بل جزءًا من هندسة التكامل الإفريقي.
رسالة الرئيس تبون كانت واضحة: السيادة السياسية ليست ممكنة دون تكامل اقتصادي، وأي مشروع نهضة لا يمكن أن يظل رهينة الخارج. وهنا يتضح البعد الأعمق للمعرض: إنه محاولة لرسم خريطة سيادة جديدة، تبدأ من السوق وتصل إلى القرار السياسي.
الجاليات… الذاكرة التي تعود إلى الجسد
من أبرز ما ميّز الحدث حضور يوم الجاليات الإفريقية، إذ أن المشهد لم يكن فولكلوريًا ولا احتفاليًا فقط، بل سياسيًا بامتياز، الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، أعلن تسجيل 2500 طلب من كفاءات جزائرية في الخارج للمساهمة في مشاريع حيوية مثل تصنيع السيارات وقطع الغيار، الرقم مهم في ذاته، لكنه يصبح أكثر دلالة حين يُقرأ في سياق استراتيجية إعادة ربط الشتات الإفريقي بجسده الأم.
هنا تتحوّل الهجرة من نزيف إلى رافعة، ومن غياب إلى حضور جديد، لتقول الجزائر عبر هذا اليوم إن الانتماء لا يُختزل في الحدود الترابية، بل يمتد عبر الذاكرة والمعرفة، وإن الجالية ليست مجرد ملحق خارجي بل شريك في بناء الداخل.
الثقافة كجسر للنهضة
لكن إفريقيا التي تصحو لا تكتفي بالاقتصاد والسياسة، الهوية الثقافية حضرت بقوة، ليس كشعار بل كأفق عملي. معارض مثل "بصمات إفريقية" جمعت فنانين من مختلف البلدان، وأظهرت كيف يمكن للوحة أو منحوتة أن تكون مرآة لقارة كاملة. مقالات فكرية قُدمت خلال الفعاليات حملت عناوين لافتة مثل "إيقاظ الفكر الإفريقي"، لتذكّر بأن النهضة تبدأ من كسر استعمار العقول، وإحياء اللغات المحلية التي تمثل شرطًا أوليًا لأي استقلال ثقافي حقيقي.
في حوار فكري، تحدّث المترجم الجزائري عمار قواسمية عن دور الترجمة في حفظ الهوية أو تمييعها. كانت كلماته بمثابة إنذار: أن الترجمة ليست مجرد نقل، بل معركة على المعنى ذاته، في قارة تضم أكثر من 2000 لغة وتواجه خطر ذوبان تنوعها لصالح لغات المستعمر القديم.
الشباب… مفتاح الغد
أحد أهم أبعاد الحدث كان الحضور الشبابي، المعرض لم يكن سوقًا للتجار فقط، بل مساحة للابتكار. من الزراعة المستدامة إلى الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، بدا واضحًا أن القارة تراهن على جيل جديد يرفض أن يظل عالقًا في الماضي، فيما أعلنت الجزائر مضاعفة المنح الدراسية للطلبة الأفارقة وإنشاء معاهد تكوين متخصصة، في خطوة تترجم قناعة بأن المعرفة هي العملة الجديدة للتكامل.
افتتاح صالون السيارات الإفريقي كان بدوره رسالة قوية، والحديث عن إنتاج 3.5 إلى 5 ملايين سيارة سنويًا بحلول 2035 لم يعد حلمًا بعيدًا، حيث أن نسب الإدماج المرتفعة في بعض البلدان، والتعاون الإقليمي في هذا المجال، عكست بداية تشكّل "وعي صناعي" إفريقي يرفض أن يظل أسير الاستيراد والاستهلاك.
الجيوسياسي أيضًا لم يكن بعيدًا، النقاشات التي جرت على هامش المعرض كشفت أن إفريقيا لم تعد مجرد هامش في النظام العالمي، بل ساحة صراع وتوازن بين القوى الكبرى، لكن الجديد هو أن القارة تريد أن تكون فاعلًا مستقلًا لا مجرد مجال نفوذ. السوق الإفريقية الموحدة، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية العابرة للحدود، كلها مؤشرات على إرادة لبناء قوة جماعية قادرة على التفاوض الندّي مع الخارج.
فلسطين في قلب إفريقيا
في قلب كل هذه النقاشات، لم تغب القضية الفلسطينية. الرئيس تبون استثمر المناسبة ليصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، مؤكدًا أن أي حل خارج إطار دولة فلسطينية على حدود 1967 هو وهم. كان لافتًا أن الخطاب الفلسطيني لم يُطرح كهامش، بل كجزء من مشروع النهضة القارية نفسه. الجزائر أرادت أن تؤكد أن إفريقيا لا تبني سيادتها على حساب القضايا العادلة، بل عبر تبنيها. وهكذا صار المعرض، اقتصاديًا وثقافيًا، منبرًا سياسيًا لمقاومة كل أشكال الإبادة والهيمنة.
حين ينفض الغبار عن المعرض، يبقى السؤال الأهم: هل كانت الجزائر مجرد مضيف، أم أنها بصدد تكريس نفسها قاطرة فعلية للتكامل الإفريقي؟ المؤشرات ترجّح الخيار الثاني، فمن أنبوب الغاز إلى يوم الجاليات، ومن المعاهد التكوينية إلى العقود الصناعية، كانت الجزائر تقول إنها ليست مجرد منصة عبور، بل ورشة بناء مشتركة.
القارة إذن تصحو، لا على وقع شعارات بل على أرضية مشاريع ملموسة. وإذا كان المعرض قد فتح نافذة على المستقبل، فإن الرهان الحقيقي يبدأ بعد انتهائه: في القدرة على تحويل العقود إلى مصانع، والاتفاقيات إلى واقع، والأحلام إلى نهضة جماعية.

بين الحلم والوحدة.. كيف تحوّل الجاليات الإفريقية الشتات إلى استثمار؟
سلسبيل شعبان
في الجزائر، تلتقي أصوات القارة وهي تبحث عن موقع جديد في خريطة الاقتصاد العالمي: من شهادات تستحضر تضحيات الجاليات الإفريقية في معارك التحرر، إلى إطلاق مؤسسات مالية وصناعية تعِدُ بإحداث قطيعة مع زمن التبعية، مرورًا بقمم وندوات تضع الاستثمار والتصنيع في قلب الأجندة. المشهد لا يقتصر على استعراض قدرات، بل يعكس انتقال إفريقيا إلى لحظة مفصلية تتقاطع فيها الذاكرة مع رهانات المستقبل.
في افتتاح "يوم الجاليات الإفريقية"، استعاد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، الرابط التاريخي الذي جمع المهاجرين بأوطانهم، قائلاً: "إن هذه الرابطة الوثيقة التي ما فتئت السلطات العليا في الدولة تعمل على تعزيزها باستمرار، إنما تحمل اليوم مغزى عميقًا ونحن على بعد أسابيع قليلة من إحياء الذكرى الرابعة والستين لليوم الوطني للهجرة."
وأضاف: "التزام الجاليات الإفريقية بالأمس بالمساهمة في مسيرة النضال من أجل تحرير قارتنا يتواصل اليوم في أشكال جديدة، تستند إلى خبراتها وكفاءاتها ومواردها المتعددة."
هنا تحضر الجزائر في دورها التاريخي كحاضنة لذاكرة التحرر، لكنها أيضًا تطرح نفسها كفاعل حيوي في تعبئة طاقات المهجر لخدمة التنمية. غريب ذكّر بأن الجزائر عضو في اللجنة العليا لتنفيذ "عقد الجذور والجاليات الإفريقية"، ما يمنح رسالته بعدًا مؤسساتيًا وليس رمزيًا فحسب.
شركة للتجارة والتوزيع.. من المواد الخام إلى القيمة المضافة
من جهة أخرى، جاء الإعلان عن إنشاء الشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع، برعاية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك)، كخطوة عملية تستجيب لواحد من أبرز تحديات القارة: تصدير المواد الخام دون تصنيعها.
هيثم الميارني، مدير الخدمات المصرفية للتجارة العالمية بالبنك، قال في مداخلته: "القارة الإفريقية تمتلك كل المقومات للنجاح في بناء صناعة متكاملة، قادرة على تعزيز التجارة البينية وتكريس مسار الازدهار الاقتصادي المشترك."
المغزى من هذه الخطوة أن القارة تحاول، لأول مرة بجدية، كسر الحلقة التي أبقتها لعقود مجرد "خزان مواد أولية"، والتوجه نحو بناء سلاسل قيمة داخلية.
قمة وكالات الاستثمار.. أرقام تكشف التحدي
في قمة وكالات ترقية الاستثمار الإفريقية، التي جمعت أكثر من ثلاثين وكالة وهيئة، طُرحت أرقام لا تخلو من القلق: التجارة البينية للقارة، رغم ارتفاعها إلى نحو 208 مليار دولار في 2024، لا تزال تمثل 15% فقط من إجمالي المبادلات، وهو مستوى ضعيف إذا ما قورن بتكتلات اقتصادية أخرى كالاتحاد الأوروبي أو "الآسيان". هذا الواقع دفع الجزائر عبر وكالتها الوطنية لترقية الاستثمار إلى التأكيد على استعدادها لقيادة مبادرات تنسيقية تسمح بتبادل الخبرات، الترويج المشترك للفرص، وصياغة رؤية جماعية تتجاوز حدود الخطابات.
كلمات المشاركين تلاقت حول ضرورة إحداث إصلاح مؤسساتي عميق يضع وكالات الاستثمار في موقع الفاعل الأساسي، لا مجرد وسيط إداري. مديرو البنوك، الخبراء، وممثلو الهيئات الدولية شددوا على أن إفريقيا تملك الموارد والسوق، لكنها تحتاج إلى بناء ثقة مؤسساتية تعزز قدرتها على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، بدل الاكتفاء بتدفق الرساميل قصيرة الأمد.
وفي هذا السياق، جاءت مداخلة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، لتؤكد أن القارة لا تحتاج فقط إلى مشاريع استثمارية متفرقة، بل إلى "فضاء استثماري متكامل قادر على جذب الاستثمارات الكبرى وتوطينها"، مضيفة أن الهدف هو صياغة مقاربات عملية تضع إفريقيا في موقع الشريك الفاعل، لا التابع، على الساحة الاقتصادية الدولية. وأبرزت أن معرض التجارة البينية الإفريقية يمثل أكثر من منصة للتعارف؛ إنه "مختبر عملي لتحويل الخطاب السياسي إلى مشاريع ملموسة، وللربط بين المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بالفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية".
بهذا الطرح، أعادت منصوري التأكيد على أن معركة التكامل ليست فقط أرقامًا وبيانات اقتصادية، بل هي أيضًا معركة سردية وموقع سياسي: هل تظل إفريقيا مجرد سوق مفتوحة للآخرين، أم تصبح كتلة اقتصادية بملامحها الخاصة قادرة على فرض شروطها؟
صالون السيارات الإفريقي.. حلم صناعي يتبلور
افتتاح صالون السيارات الإفريقي كان من أبرز المحطات، الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، أوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق : "القارة تشهد حركية صناعية يتم من خلالها تعزيز سلاسل القيم من خلال استغلال الإمكانيات الموجودة في أراضيها، بما يمكن من إقامة قاعدة صناعية ذات قيمة مضافة وقادرة على خلق الثروة، مضيفًا أن الجزائر "تتموقع إلى جانب بلدان أخرى ضمن رواد الصناعات الميكانيكية، حيث بلغت نسب الإدماج في بعض الأصناف الوطنية 70 بالمائة."
كمال رزيق، وزير التجارة الخارجية، شدد من جهته على أن تخصيص حدث كامل للسيارات "رسالة بشأن التطور الذي تشهده صناعة المركبات بأنواعها في القارة، وخطى التقدم المستمر للتحكم في كل سلسلة القيم."
أما مارتينا بيان، رئيسة الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، فقد رسمت أفقًا طموحًا: "إفريقيا قادرة، في حال توحيد جهودها، على تصنيع ما بين 3.5 و5 ملايين سيارة سنويًا في آفاق 2035. ما ينقصنا ليس السوق ولا الموارد ولا الكفاءات، بل شجاعة التنفيذ والانضباط."
هذه الكلمات تعكس ما يمكن وصفه بـ "لحظة وعي صناعي" في القارة، فالسؤال لم يعد: هل نملك المقومات؟ بل: هل نملك الجرأة لتنفيذ السياسات الصناعية؟
المشهد العام يوحي بأن الجزائر تحاول تقديم نفسها كقاطرة لهذا المشروع القاري، فهي تستحضر الماضي التحرري لتؤكد استمرارية الرسالة، وتعرض قدراتها في الصناعات الميكانيكية الثقيلة والخفيفة كإسهام في المشروع الصناعي الإفريقي، وتواكب التحولات المؤسسية في مجالات التجارة والاستثمار.
ما يجمع بين "يوم الجاليات"، وإطلاق الشركة القارية للتجارة، وندوات الاستثمار، وصلون السيارات، هو فكرة الانتقال من الشعارات إلى الأدوات التنفيذية. إفريقيا، التي طالما تحدثت عن التكامل والوحدة، تبدو اليوم بصدد وضع اللبنات الأولى لمشروع عملي. والجزائر، من موقعها كأرض احتضنت نضالات التحرر، تحاول أن تحتضن اليوم نضالات من نوع آخر: معركة الصناعة، التجارة، والاستثمار.

قمة الجزائر.. رسائل السيادة الإفريقية في زمن التحولات
الحاج عيسى بن معمر
ليست كل القمم سواء، ففي الجزائر، اجتمع القادة الأفارقة لا ليكتبوا محضرًا بروتوكوليًا عابرًا، بل ليبعثوا رسالة تتجاوز حدود القارة نحو العالم بأسره. كان حضور الرئيس عبد المجيد تبون في قلب المشهد أشبه بإشارة البدء لمرحلة جديدة في هندسة التوازنات، حيث بدا أن الجزائر لا تكتفي بالجلوس في مقعد المتفرج بل تريد أن تعود إلى طاولة الكبار كصاحبة رؤية ومشروع. إن رمزية جمع الزعماء الأفارقة تحت سقف واحد، وفي لحظة يتسابق فيها الكبار على السيطرة على موارد القارة وأسواقها، تعكس أن إفريقيا لم تعد مجرد مجال نفوذ يُتنازع عليه من الخارج، بل فضاءً يُعاد فيه إنتاج القرار السيادي بلسان أبنائها، لقد أراد الرئيس تبون من خلال هذه اللحظة أن يقول للعالم: إفريقيا ليست أرضًا سائبة ولا مخزنًا للثروات وحده، بل فضاء سيادي يملك إرادة اقتصادية وسياسية متجددة.
الحضور الإفريقي الكثيف لم يكن مجرد استجابة لدعوة بروتوكولية، بل تعبيرًا عن قناعة بأن الجزائر تملك رصيدًا تاريخيًا يجعلها مؤهلة لتكون نقطة التقاء، فهي التي دفعت بدمها من أجل التحرر الوطني، وهي التي حملت صوت الجنوب في المحافل الدولية، وهي اليوم تريد أن تستثمر هذا الرصيد في مشروع اقتصادي عابر للحدود.
البعد الاقتصادي للقمة بدا جليًا في كل تفاصيلها، إذ لم يعد الأمر يتعلق بخطابات عن التضامن أو الأمن المشترك، بل بخطط عملية لفتح الأسواق، وربط البنى التحتية، وتحرير التجارة من قيود الحدود، حيث الجزائر التي تعيش مرحلة إعادة بناء اقتصادي داخلي، تدرك أن قوتها تكمن في عمقها الإفريقي، وأن بناء شبكة اقتصادية عابرة للقارة سيجعلها أقل تبعية للأسواق الأوروبية وأكثر قدرة على المناورة أمام الضغوط العالمية، وبهذا المعنى فإن ما أراده الرئيس تبون يتجاوز الاقتصاد إلى السياسة، إذ كل مشروع تكامل اقتصادي يعني بالضرورة إعادة توزيع موازين القوى وخلق فضاء مستقل عن الهيمنة الخارجية.
إن الرسالة الأعمق التي حملتها القمة، والتي أراد الرئيس تبون أن تصل إلى القوى الكبرى، هي أن إفريقيا قادرة على التحدث بصوت واحد حين يتعلق الأمر بمصيرها الاقتصادي، في عالم تتسارع فيه التحولات، أين تشتد المنافسة على الطاقة والمعادن النادرة والأسواق الناشئة، تريد الجزائر أن تقول إنها لن تسمح بأن يبقى القرار الاقتصادي للقارة مرهونًا بإملاءات من وراء البحار، لقد كان مشهد الزعماء الأفارقة وهم يتقاسمون الرؤية حول مستقبل القارة بمثابة إعلان سياسي واقتصادي، أن زمن التبعية المطلقة قد انتهى، وأن زمن المبادرة الإفريقية قد بدأ.
لكن ثمة بعد آخر في الرسالة الجزائرية، وهو أن الحضور الإفريقي لا يهدف فقط إلى بناء أسواق مشتركة، بل إلى صياغة هوية سياسية جديدة للقارة، قوامها الاستقلالية والندية. فالجزائر أرادت أن تُظهر أن الاستثمار في البعد الإفريقي ليس خيارًا تكميليًا، بل ركيزة استراتيجية لموقعها الجيوسياسي ولعل أهم ما يجعل هذه اللحظة مفصلية هو أن الجزائر تقرأ بوضوح التحولات الدولية، وتفهم أن القارة الإفريقية باتت محط أنظار الجميع: من الصين إلى أمريكا، ومن روسيا إلى أوروبا، لذلك فإن احتضانها لهذا التجمع هو في جوهره رسالة مزدوجة: إعلان استعدادها لتكون بوابة اقتصادية وسياسية للقارة، ورفض أن يُختطف القرار الإفريقي من الخارج.
الحدث لم يكن احتفالًا رمزيًا بقدر ما كان تأسيسًا لرؤية عملية، ففي كل كلمة ألقيت كانت تترسخ قناعة بأن الوحدة الاقتصادية هي الطريق الوحيد لتعزيز السيادة السياسية، وما بين سطور كلمات الرئيس تبون، كان يبرز التأكيد على أن إفريقيا لا تحتاج إلى وصاية ولا إلى إملاءات، بل إلى تحرير إرادتها الاقتصادية، وهنا تكمن قوة الرسالة: أن التنمية ليست مجرد شعارات، بل مشروع تحرر ثانٍ، لا يقل أهمية عن تحرر الأمس من الاستعمار.
وإذا كان التاريخ قد جعل من الجزائر رمزًا للتحرر الوطني في القرن الماضي، فإنها تريد اليوم أن تجعل من نفسها منصة للتحرر الاقتصادي في القرن الحالي، ذلك أن رهانها على الأسواق الإفريقية لا ينفصل عن رهانها على بناء استقلالية القرار السياسي، إذ لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة في عالم تحكمه المصالح. لهذا فإن ما جرى لم يكن مجرد قمة عابرة، بل محطة تاريخية تُؤسس لمسار جديد في علاقة إفريقيا بذاتها وبالعالم.
بهذا المعنى، فإن حضور الرئيس تبون والزعماء الأفارقة لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل كان مشهدًا مكثفًا لمعركة رسائل: رسالة إلى الجبهة الداخلية مفادها أن البلاد تستعيد دورها الريادي، ورسالة إلى إفريقيا بأن زمن التشتت يجب أن ينتهي، ورسالة إلى القوى الكبرى بأن إفريقيا قررت أن تكون فاعلًا لا مفعولًا به.
إن ما شهدته الجزائر هو أكثر من مجرد حدث دبلوماسي، إنه إعلان عن بداية مرحلة جديدة، عنوانها أن إفريقيا قررت أن تكون لنفسها، ومن قلب الجزائر، أراد الرئيس تبون أن يطلق هذه الصرخة، لتكون بداية لزمن لا يكتفي بالتحرر من الاستعمار القديم، بل يسعى للتحرر من كل أشكال التبعية الاقتصادية والسياسية. إنها بداية معركة التحرر الثاني، والجزائر تعلن أنها في طليعته.

إفريقيا ومعركة الأسواق.. شيفرة الانتقال من التبعية إلى الفاعلية
مها عزالدين
في البدء كانت التجارة أشبه بشريانٍ يربط القرى بالمدن، والبحار بالصحاري، والأمم بأحلامها في الخبز والحرير والذهب، لكنها لم تبقَ مجرد تبادل للسلع، بل تحولت مع الزمن إلى مرآة تعكس موازين القوى وصراع النفوذ، والأسواق التي وُلدت كجسر للتكامل باتت اليوم ساحات حروب صامتة تُدار بالرسوم الجمركية، وحروب العملات، والتحكم في الممرات البحرية. وهنا لم يعد التاجر الفاعل الوحيد، بل دخلت الحكومات والشركات العملاقة والمؤسسات المالية العابرة للقارات لتضع قواعد لعبة معقدة تجعل من التجارة العالمية فضاءً للصراع أكثر مما هو فضاء للتعاون.
في قلب هذه العاصفة تقف الدول النامية، خصوصًا الإفريقية منها، عالقة بين مطرقة السياسات التي تفرضها القوى الكبرى وسندان حاجاتها الداخلية للتنمية والاستقرار، فهي مطالبة باللحاق بقطار عالمي سريع دون أن تمتلك التذكرة الكاملة أو المقعد المضمون. ومن هنا يبرز المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025 كمنصة تسعى لكسر معادلة التبعية، وصياغة فضاء بديل يجعل من إفريقيا فاعلًا مستقلًا لا مجرد هامش في النظام الدولي.
البعد الاقتصادي.. من الموارد إلى سلاسل القيمة
رغم امتلاك إفريقيا ثروات طبيعية هائلة من النفط والغاز والمعادن النادرة والموارد الزراعية، إلا أن التجارة البينية بين دولها لا تتجاوز 15%، مقابل أكثر من 60% في الاتحاد الأوروبي ونحو 50% في آسيا. هذا الرقم يلخص مأزق القارة: أسواق مجزأة، بنية تحتية ضعيفة، أنظمة جمركية متنافرة، وطرق تجارية غير مكتملة. النتيجة أن الثروات تُصدَّر خامًا إلى الخارج وتعود سلعًا مصنعة بأضعاف قيمتها.
المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025 لا يطرح نفسه كسوق للمنتجات فحسب، بل كمحاولة لإعادة هندسة المشهد الاقتصادي عبر بناء شبكات إمداد إفريقية–إفريقية، وتشجيع التصنيع المحلي، وتوجيه الاستثمارات نحو سلاسل قيمة متكاملة. فالقارة لن تتقدم ما لم تتحرر من رهن المواد الأولية، وتستثمر في الصناعات التحويلية، والزراعة الذكية، والتكنولوجيا الرقمية. رهان المعرض إذن هو تحويل إفريقيا من “مخزن موارد” إلى “ورشة إنتاج عالمية”.
البعد السياسي.. التجارة كأداة سيادة
التجارة لم تعد فعلًا اقتصاديًا خالصًا، بل أداة سيادة تستخدمها القوى الكبرى. الولايات المتحدة والصين حولتا الرسوم الجمركية إلى سلاح في حربهما الباردة الجديدة، أوروبا تفرض معايير صارمة لحماية أسواقها، والتكتلات الآسيوية تبني مجالات نفوذ عبر الاتفاقيات التجارية.
إفريقيا ليست بمنأى عن هذه الصراعات؛ السيطرة على موانئها وممراتها البحرية تعني السيطرة على مستقبلها الاقتصادي. الصين عبر مبادرة “الحزام والطريق” بنت موانئ وخطوط سكك حديدية، الولايات المتحدة تحاول موازنة هذا النفوذ بتحالفات واستثمارات، أوروبا تستند إلى ميراثها التاريخي، فيما تبحث روسيا وتركيا والهند عن موطئ قدم في السوق الصاعدة. وسط هذا التشابك، يصبح المعرض الإفريقي أكثر من مجرد حدث اقتصادي: إنه إعلان سياسي عن رغبة القارة في التفاوض ككتلة موحدة بدل أن تكون دولًا متفرقة يسهل ابتلاعها.
بين البنية التحتية والإرادة السياسية
لكن التحول من طموح إلى واقع يحتاج ما هو أبعد من المعارض. التكامل الاقتصادي يتطلب شبكات طرق وسكك حديدية عابرة للحدود، موانئ حديثة، أنظمة جمركية موحدة تقلل من كلفة التبادل، وإرادة سياسية تتجاوز الحسابات الضيقة. كما يحتاج إلى بناء ثقة بين دول لطالما مزقتها النزاعات والحروب، وإلى مكافحة الفساد وضعف الحوكمة الذي يُفرغ المشاريع الكبرى من مضمونها.
ورغم هذه العقبات، تفتح لحظة 2025 فرصًا استثنائية: الصراع الصيني–الأمريكي يدفع الشركات متعددة الجنسيات لإعادة توزيع إنتاجها وتقليل المخاطر، وإفريقيا بما تملكه من سوق شابة وموارد ضخمة مرشحة لتكون بديلًا. غير أن هذا لن يتحقق ما لم تثبت قدرتها على توفير بيئة استثمارية جذابة، ويد عاملة مؤهلة، وبنية تحتية ملائمة.
الجغرافيا والجيواقتصاد.. الممرات البحرية كجبهات صراع
الممرات البحرية الإفريقية – من قناة السويس إلى باب المندب، ومن خليج غينيا إلى رأس الرجاء الصالح – تمثل شرايين التجارة العالمية، يمر عبرها أكثر من 30% من حركة السلع والطاقة. لهذا تتسابق القوى الكبرى على إنشاء قواعد بحرية وموانئ لوجستية في جيبوتي والصومال وتنزانيا وغانا. في هذا السياق يصبح المعرض أيضًا تعبيرًا عن وعي متنامٍ بأن السيادة الاقتصادية لا تنفصل عن السيطرة على الجغرافيا، وأن من يملك الموانئ يملك مستقبل القارة.
التجارة البينية ليست غاية بذاتها، بل وسيلة لتقوية الموقف الإفريقي في السوق الدولية. حين تدخل القارة مفاوضات عالمية كتكتل موحد، تكون كلمتها أثقل من أي دولة منفردة. اتفاقية التجارة الحرة القارية تسعى لهذا الهدف، والمعرض يمثل فضاءً عمليًا لترجمة الاتفاقية إلى صفقات واقعية.
السنوات المقبلة ستكشف إن كانت إفريقيا قادرة على الانتقال من موقع الهامش إلى موقع المركز. التغير المناخي سيضغط على اقتصاداتها الزراعية، الثورة الرقمية ستفرض إعادة هيكلة عميقة لأسواق العمل، والتحولات الجيوسياسية ستجعلها ساحة تنافس متجدد بين القوى الكبرى.
في خضم هذه التحديات، سيكون لمعارض مثل IATF 2025 دور محوري: إما أن تتحول إلى منصات لتغيير قواعد اللعبة، أو تبقى مجرد احتفالات رمزية بلا أثر. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل ستنجح إفريقيا في جعل أسواقها جسرًا للتحرر والتنمية، أم تظل ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين؟ ما هو مؤكد أن معركة الأسواق قد بدأت، وأن معرض 2025 يمثل أول اختبار حقيقي لإرادة القارة في رسم مستقبلها الاقتصادي والسياسي.
 المترجم عمار قواسمية
المترجم عمار قواسمية
حوار مع المترجم عمار قواسمية.. الترجمة في إفريقيا.. جسر بين الثقافات أم أداة لطمس الهوية؟
حاورته ربيعة خطاب
في قارةٍ يتجاور فيها أكثر من ألفَي لغة، وتتشابك في فضائها الثقافات والأديان والتقاليد، تتحول الترجمة من مجرد أداة لغوية إلى جسر معقد يربط بين العوالم، ويحمل على عاتقه مهمة مزدوجة: حفظ الذاكرة الجماعية، ونقل المعارف عبر الحدود. وفي إفريقيا، حيث يتداخل الإرث الشفهي العريق مع تحديات العولمة، يصبح المترجم شاهدًا على صراع خفي بين الحفاظ على الخصوصية والانفتاح على الآخر.
في هذا السياق، كان لجريدة "الأيام نيوز" لقاء مع الأستاذ عمار قواسمية، أستاذ اللغة الإنجليزية، والمترجم المحترف بين العربية والفرنسية والإنجليزية، والمدقق اللغوي، وصاحب المشروع المستقل في خدمات الترجمة والتدقيق. حديثٌ يغوص في عمق إشكاليات الترجمة في السياق الإفريقي، ويكشف كيف يمكن للثقافة المحلية أن تعيد تشكيل النصوص، وما يواجهه المترجمون من معضلات في نقل المفاهيم بين لغات القارة والعالم، في زمن تتقاطع فيه الحاجة للتواصل مع ضرورة صون الهوية.
الأيام نيوز: كيف تؤثر الثقافة المحلية على طريقة الترجمة في إفريقيا؟ وهل تختلف قواعد الترجمة من ثقافةٍ لأخرى؟
الأستاذ قواسمية عمار: الثقافةُ المحليةُ هي منظومةُ مرجعيّاتٍ ودلالاتٍ تشكِّلُ معنى النصّ ذاته. لذا، فالترجمة في إفريقيا تتأثر بثلاثة عناصر رئيسة: البُنَى المعرفية (نُظُم التصنيف، مثل علاقات القرابة)، القِيَم (مقامات الشرف، وعلاقات السنّ والسُّلطة)، والأنساق البلاغية الشفاهية (أمثال، أساطير، أغاني، تقنيات السجع والتكرار). ومن هذا المنطلق، يستحيل القول بوجود «قواعد ترجمة» عالمية واحدة تعمل بالشكل نفسه في كل ثقافة. وما يتغير هو الاستراتيجية الترجميّة؛ فبينما تختار بيئة ما استراتيجية التقريب/التوطين، قد تختار أخرى سياسة التغريب.
الأيام نيوز: في المجتمعات الإفريقية التقليدية، كيف تترجم مفاهيم مثل "السلطة"، "الأسرة"، أو "الشرف" دون أن تفقد معناها الثقافي؟
الأستاذ قواسمية عمار: المفتاح هو "ترجمةُ الوظيفة الدلالية والاجتماعية" لا مجرد الكلمات. أي: أن نسأل قبل الترجمة عن الدور الذي يضطلع به المفهوم في المجتمع، ثم نختار الشكل اللغوي المناسب. على سبيل المثال، السلطة التقليدية قد تترجم بـ chefferie coutumière مع توضيح إذا كانت ذات صبغة مقدسة أو إدارية، والأسرة تتطلب تحديد نظام القرابة، بينما الشرف قد يحتاج إلى ترجمة مصحوبة بمثال وظيفي يوضح نطاقه في المجتمع المحلي.
الأيام نيوز: هل واجهت حالات كان من الصعب فيها ترجمة تعبيرات ثقافية أو أمثال شعبية من لغة إفريقية إلى لغة أجنبية؟ كيف تعاملت معها؟
الأستاذ قواسمية عمار: نعم، فالأمثال والتعابير هي «مختزلات ثقافية» تحمل تاريخًا وصورًا مجازية لا تقبل النقل الحرفي. للتعامل معها، نحدد وظيفتها في الخطاب، ثم نختار بين التقريب بمثل محلي مقابل، أو الحفظ مع الشرح، أو التحرير الوظيفي بحيث يؤدي النص المترجم نفس الوظيفة البلاغية.
الأيام نيوز: ما مدى تأثير الموروث الشفهي في بناء اللغة والثقافة الإفريقية؟ وكيف تتعامل الترجمة مع ذلك؟
الأستاذ قواسمية عمار: الموروث الشفهي هو العمود الفقري للغة والثقافة الإفريقية، فهو يزود اللغة بالصور البلاغية وتراكيب السرد وقيم الهوية. في الترجمة، يمكن التعامل معه بالتوثيق والتحقيق، والنقل الأسلوبي لمحاكاة السجع أو التكرار، وإضافة الحواشي الثقافية، وأحيانًا دعم النص بوسائط متعددة للحفاظ على الإيقاع الشفهي.
الأيام نيوز: هل ترى أن الترجمة يمكن أن تكون وسيلة لحماية الهوية الثقافية في إفريقيا أم أنها قد تؤدي إلى تمييعها؟
الأستاذ قواسمية عمار: يمكن أن تكون وسيلة للحماية إذا استُخدمت للتوثيق والنشر وتمكين الموروث المحلي، لكنها قد تؤدي إلى التمييع إذا مورست بسياسة التقريب المفرط أو خلت من الحواشي التفسيرية، أو إذا خضعت لضغوط السوق التي تهمش اللغات الصغرى لصالح اللغات العالمية.
الأيام نيوز: هل تعتقد أن الترجمة ساهمت في نشر الأدب والفكر الإفريقي عالميًا؟ وما أبرز التحديات في هذا المسار؟
الأستاذ قواسمية عمار: نعم، فقد كانت الترجمة جسرًا نقل الأدب الإفريقي إلى العالم، مثل أعمال تشينوا أتشيبي ونغوجي واثيونغو. لكن التحديات تشمل ندرة المترجمين المتخصصين في اللغات الإفريقية، وهيمنة معايير السوق، وغياب الدعم المؤسسي لمشاريع الترجمة المستدامة.
الأيام نيوز: ما هي مسؤولية المترجم عند نقل نصوص دينية أو فكرية من ثقافة إلى أخرى داخل إفريقيا؟
الأستاذ قواسمية عمار: مسؤولية المترجم مضاعفة؛ إذ يجب الحفاظ على الأمانة الدلالية، والتحقق المرجعي، والتحييد الثقافي عند الحاجة. مثلًا، عند ترجمة كلمة serigne في الولوف إلى العربية، قد يفضل القول «الشيخ الروحي» مع حاشية، بدل الاكتفاء بـ«شيخ» لتجنب إسقاط دلالات غير مقصودة.
الأيام نيوز: في ظل الهيمنة الغربية على النشر، هل تجد أن هناك تحريفًا أو اختزالًا لثقافة الشعوب الإفريقية أثناء الترجمة إلى اللغات الأوروبية؟
الأستاذ قواسمية عمار: نعم، ويظهر ذلك في انتقاء الموضوعات لإرضاء القارئ الغربي، وتطويع الأسلوب، والإسقاط الأيديولوجي. أحيانًا تُختزل القصص الشفاهية إلى مجرد حكايات غرائبية، ويُحذف بعدها الطقسي أو القيمي.
الأيام نيوز: هل هناك ما يكفي من الاهتمام بترجمة الإنتاج الثقافي الإفريقي إلى لغات إفريقية أخرى؟
الأستاذ قواسمية عمار: لا، فالترجمة البينية بين اللغات الإفريقية ما تزال محدودة بسبب ضعف البنية التحتية، وتعدد اللغات، ونقص التمويل. لكنها إذا فُعلت، ستعزز الهوية القارية، وتنشر الإبداع، وتحفظ التنوع اللغوي.
الأيام نيوز: إفريقيا تضم أكثر من 2000 لغة... هل يُشكل هذا التعدد مصدر قوة أم عائقًا أمام الوحدة؟
الأستاذ قواسمية عمار: هو سيف ذو حدين؛ مصدر قوة إذا أُدير بتخطيط لغوي جيد، وعائق إذا تُرك بلا تنظيم. تجربة تنزانيا في اعتماد السواحلية كلغة مشتركة مثال على نجاح إدارة التعدد.
الأيام نيوز: هل تُستخدم الترجمة في إفريقيا كأداة لبناء الحوار بين الثقافات المختلفة داخل الدولة الواحدة؟
الأستاذ قواسمية عمار: نعم، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى مركزي في السياسات اللغوية. فهي تُقرب بين المجتمعات وتُمكن الإعلام، لكن تواجه تحديات مثل نقص المترجمين وضعف التمويل.
الأيام نيوز: كيف تنظر إلى العلاقة بين اللغة الأم والانتماء الثقافي في إفريقيا؟ وهل توجد محاولات لتعزيز استخدام اللغات المحلية؟
الأستاذ قواسمية عمار: اللغة الأم هي الحاضنة الأولى للانتماء الثقافي، وفقدانها يعني فقدان جزء من الهوية. توجد محاولات مثل التعليم ثنائي اللغة، وإدماج الفنون المحلية في المناهج، ومبادرات النشر الرقمي باللغات الإفريقية لتعزيز حضورها في الحياة العامة.
الأيام نيوز: ما هي أبرز اللغات الغربية المهيمنة في إفريقيا وعلاقتها بامتدادات الاستعمار الحديث؟ وما مكانة اللغة العربية في القارة الإفريقية، وإمكانات استثمارها في تعزيز التبادل والتفاعل الثقافي العربي–الإفريقي أو الجزائري–الإفريقي؟ وكيف يمكن للترجمة أن تسهم في حماية العديد من اللغات الإفريقية المهددة بالاندثار؟
الأستاذ قواسمية عمار: تتصدر اللغات الغربية المهيمنة في إفريقيا اليوم الفرنسية، وهي أثر مباشر للاستعمار الكولونيالي، إذ تنتشر في أكثر من 20 دولة إفريقية من السنغال إلى مدغشقر، تليها الإنجليزية التي خلّفها الاستعمار البريطاني وأصبحت لغة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية، ثم البرتغالية في أنغولا وموزمبيق وغينيا-بيساو، وأخيراً الإسبانية في مناطق محدودة مثل غينيا الاستوائية. هذه اللغات ما زالت تُستعمل كأدوات لإدامة النفوذ السياسي والاقتصادي عبر "الفرنكوفونية" أو "الكومنولث"، مع استمرار التبعية المعرفية، حيث تُنتَج المعرفة وتُحدَّد المعايير باللغات المستعمِرة سابقاً، كما في ساحل العاج حيث تظل الإدارة والقضاء بالفرنسية رغم انتشار لغات محلية كالباولي.
أما اللغة العربية، فامتدادها في إفريقيا شمالاً وشرقاً وغرباً جعلها منذ قرون لغة دينية وثقافية وتجارية، ووسيطاً بين الشمال والجنوب عبر طرق القوافل، فضلاً عن كونها لغة إدارة وعلم في مراكز تاريخية مثل تمبكتو وغاو. ويمكن اليوم استثمارها كلغة جسر للتبادل الثقافي العربي–الإفريقي أو الجزائري–الإفريقي، خصوصاً إذا دُعمت برامج تعليم العربية للناطقين باللغات الإفريقية، والعكس بالعكس، ما يعزز التفاعل الحضاري.
أما الترجمة، فهي أداة لحماية اللغات الإفريقية المهددة بالاندثار، عبر ترجمة الأدب الشفهي إلى لغات واسعة الانتشار لضمان توثيقه، وتشجيع الترجمة البَينية بين اللغات الإفريقية نفسها للحفاظ على التواصل بين المجتمعات، إضافة إلى رقمنة المحتوى العلمي والأدبي والفني الإفريقي على الإنترنت. ويبرز مثال مشروع "بانالاك" الذي ترجم نصوصاً شفهية من لغة الولوف إلى الفرنسية والعربية، ما ساعد في حفظ التراث السنغالي ونشره.

حيث تتلاقى الأجيال والأفكار.. أفق إفريقيا الجديد
حميد سعدون
في قلب العاصمة، بين أروقة المعارض العلمية وقاعات التكوين المهني، تتجسد رؤية الجزائر لإفريقيا، رؤية تجمع بين الابتكار، المعرفة، والطاقة البشرية. الجزائر، التي لطالما كانت ملتقى للتاريخ والثقافة في القارة، اختارت اليوم أن تكون جسراً يمتد عبر الزمن والقارة، موصلاً بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد، وبين أفكار الشباب وطموحات الدول الإفريقية الشقيقة.
خلال فعاليات الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025، أطلق كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، دعوة واضحة لتعزيز التعاون العلمي البيني الإفريقي. وأكد أن الابتكار في قطاع الطاقة ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لتأمين موارد الطاقة للقارة بأكملها، بما يتوافق مع أهداف أجندة إفريقيا 2063. ودعا إلى تشبيك الجامعات ومراكز البحث، والمشاركة في مشاريع بحث مشتركة، والاعتماد على مفهوم الابتكار المفتوح، الذي يتيح تبادل الخبرات وتعميم الحلول المستدامة.
وزيارة جناح الابتكار الإفريقي كشفت عن مجموعة من المشاريع المبتكرة، شملت الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، والزراعة المستدامة، إلى جانب حلول متقدمة في الطاقات المتجددة. وقد أشاد المسؤول الجزائري بالمستوى العالي للإبداع الذي أظهرته الفرق البحثية الشابة، مشددًا على أن دعم هذه المبادرات يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.
وفي موازاة ذلك، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، عن مضاعفة عدد المنح المخصصة للشباب الأفارقة ابتداءً من السنة التكوينية المقبلة. وأضاف أن الشباب الأفريقي كان يحصل سابقًا على 500 منحة سنويًا، وأن هذا الرقم سيتم رفعه بشكل ملموس، مع إطلاق معهد إفريقي جديد للتكوين المهني في ولاية بومرداس خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس إرادة الجزائر في نقل خبراتها، وتوفير فرص التدريب والمهارات التقنية للشباب من مختلف الدول الإفريقية.
تتجلى الواقعية في تفاصيل هذه المبادرات: من توفير منح دراسية وعلمية ملموسة، إلى إنشاء معاهد تدريبية مجهزة بأحدث التجهيزات، مرورًا بمشاريع بحثية تطبق تقنيات حديثة في الطاقة والزراعة. كل ذلك يجمع بين الطموح والقدرة على التنفيذ، ويظهر أن الجزائر لا تقدم وعودًا صورية، بل تبني أسسًا حقيقية للتكامل الإفريقي.
الخطوات ملموسة، لكن الرسالة أعمق من الأرقام: أجيال من الشباب تتقاطع، أفق واحد يربط الماضي بالحاضر والمستقبل بالقارة كلها. كل تجربة تدريبية، كل مشروع بحثي، كل ابتكار، هو جزء من شبكة أوسع من التعاون الإفريقي، يهدف إلى بناء قدرات مشتركة وتعزيز استقلالية القارة في مجالات الطاقة والمعرفة والتكوين المهني.
وهكذا، يتحول الحوار بين الجزائر والدول الإفريقية من علاقات ثنائية إلى شراكة استراتيجية متكاملة، حيث يصبح المستقبل مشتركًا، والقدرات العلمية والعملية مضافة إلى إرث القارة. الجزائر، بروحها التضامنية وعمقها التاريخي، تقدم نموذجًا حقيقيًا للقيادة الإفريقية القائمة على المعرفة والتدريب والابتكار، وتجعل من الشباب محركًا أساسيًا للتغيير المستدام.
بين المعامل والورشات، وبين الجامعات والمعاهد، يولد التواصل بين الأفكار، وتتكامل الرؤى لتشكل نموذجًا واقعيًا للتعاون الإفريقي. المعرفة ليست هدفًا بحد ذاتها، والطاقة ليست مجرد أداة، بل كل مشروع، وكل منحة، وكل تجربة، تشكل خيوطًا تربط القارة بأكملها، وتمنح الشباب فرصة فعلية للمساهمة في صناعة مستقبلهم، بدل أن يكونوا متلقين فقط.
الواقع يلتقي مع الطموح في هذا الأفق المشترك: الجزائر توفر البنية التحتية، الخبرة، والمنصات التعليمية، بينما يتحمل الشباب مسؤولية التعلم والتطوير والابتكار. كل خطوة عملية، كل تجربة ملموسة، تؤكد أن التكامل الإفريقي ليس شعارًا، بل مشروعًا قابلاً للتنفيذ، مستندًا إلى إرادة حقيقية، وموارد علمية وبشرية متاحة، وأفق مشترك يربط بين الدول، الشباب، والمعرفة.
وفي هذا السياق، يصبح الأفق واحدًا: أجيال تتقاطع، طاقات تُستثمر، وأحلام تتحول إلى مشاريع، لتثبت أن إفريقيا قادرة على صنع مستقبله بنفسها، وأن الجزائر اختارت أن تكون قلب هذا التعاون، وصوت هذا المستقبل المشترك، بين الإبداع، التدريب، والطاقة المستدامة.