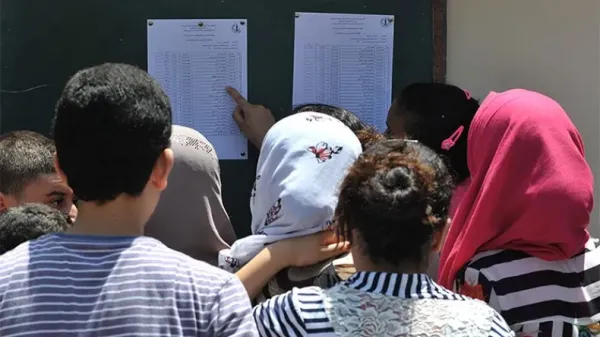إنّ أكبر خيانة يُمكن أن يرتكبها الإنسان في حقّ نفسه وأهله ومجتمعه ودينه ألّا يكون وفيًّا لاسمه، خاصة إذا كان يحمل اسمًا من أسماء الأنبياء والرُّسل عليهم السلام. وتكون الخيانة أكبر وأخطر عندما يكون هذا الإنسان في موقع مسؤولية يستوجب الأمانة والإخلاص والنّزاهة.. فيُفترض بمن تسمّى باسم النبيّ محمد - صلى الله عليه وسلّم - أن يكون على قدرٍ كبيرٍ من الخُلق في القول والسّلوك والمعاملة والعمل، من باب الوفاء لهذا الاسم الذي قال الله تعالى في صاحبه نبيّنا أكرم الخلق أجمعين "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" (القلم، الآية: 4). إنّ الوفاء لأسمائنا مسؤوليةٌ أيضًا، فلا يُعقل أنّ مَن يحمل اسمًا جليلا مثل اسم "محمد"، يقوم بأعمال منافية للأخلاق ومسيئة لجوهر الإسلام، بل إن بعضا مِمّن يحملون اسم "محمد" ذهبوا إلى حدّ العبث بالمقدّسات الإسلامية، ومناصرة أهل الظلم والطّغيان، والتنكّر للمسلمين والمستضعفين، ومنهم من عمل على ابتداع دين جديد! وليت هؤلاء "المُحمّدون" تحلّوا ببعض الجرأة والشجاعة وخلعوا عنهم اسم "محمد"، إكرامًا للنبيّ محمد صلى الله عليه وسلّم، واحترامًا لمليارين من المسلمين منتشرين في جهات الأرض الأربع. وليت هؤلاء "المحمّدون" اختاروا - على الأقل - تغيير أسمائهم على الطريقة "القبرصيّة"، فقد نشرت مجلة "الهلال" المصرية، في شهر ماي 1934، مقالا عن الأسماء جاء فيه: "وفي بعض أنحاء قبرص أسماءٌ يُقال لها: (قطن على صوف)، أي أنها مزيج من أسماء مسيحية وأسماء إسلامية، كقولهم: ميخائيل محمد، وجورج مصطفى، ونقولا عثمان..". ربّما تحتاج هذه الطريقة "القبرصية" إلى بعض التعديل حتى تنسجم مع "المحمّدين" من أنصار الديانة الجديدة "الإبراهيمية"، فتصير الأسماء: قطنًا على صوف على خيش، فيُقال مثلا: أفيخاي ميخائيل محمد، أو موردخاي جورج محمد.. وطبعا نحن ندعو إلى خلع اسم محمدٍ عن أمثال هؤلاء الناس مِمّن خانوا أسماءهم وتنكّروا لما فيها من معاني ودلالات وقِيَم، بل نحن ندعو إلى إقامة "محكمة الأسماء" تختصّ بتجريد الإنسان من اسمه - الديني - إذا ما أساء لقيمته ومعناه! ولن نتساءل: كم محمّدًا وإبراهيم وعيسى وموسى وإسحاق ويعقوب.. سيُجرّدون من أسمائهم؟ لن نذهب إلى أبعد من ذلك وندعو إلى ما دعا إليه أحد الأمريكيين بالاستغناء عن الأسماء وتعويضها بالأرقام تمامًا مثل المساجين، وربّما إنّ هذا الأمر يُحقّق العدالة والمساواة بين جميع البشر ولن يكون هناك كيلٌ بمكيالين ولا خيانة للأسماء! وفي هذا السياق، نشرت مجلة "الهلال"، في العدد المذكور سابقا، قائلة: "ولمّا كانت الأسماء في العالم قد تعدّدت حتى بلغت مئات الألوف، فقد اقترح أحد الأميركيين على دولته سنّ قانون للاستغناء عن الأسماء بأرقام معيّنة تلافيًا لكثير مِمّا يقع من الالتباس"، وهنا نستذكر الصرخات التي أطلقها إخوتنا الفلسطينيين في وجه العالم: لسنا أرقامًا! ربّما لن يطول الزّمن ويصير الإنسان في المجتمع المعلوماتي مجرّد رقم أو "كود بار".. من يدري؟! لن ننجرف أكثر خلف هذه الأفكار التي ستسوقنا حتمًا إلى قراءة مقولة: "لكل إنسان من اسمه نصيب".. فإن كانت هذه المقولة تعني الإنسان المُسلم وحده، فلا عجب أن يأتي أولئك "المحمّدون" بما يُناقض جوهر الإسلام! نعم، لن ننجرف أكثر ونترك للقارئ أن يستغرق في قضيّة الأسماء على ضوء الأفكار والرؤى والمعلومات التي أفاض بها باحثونا وكُتّابنا الأفاضل حينما توجّهت إليهم جريدة "الأيام نيوز" بهذه التساؤلات: اختيار الأسماء للمواليد من القضايا التي قد تبدو صغيرة وهيّنة ولكنها كبيرة وخطيرة وقد تؤثّر على مستقبل الأبناء واندماجهم في مجتمعهم. ويحدث أن يُنكر الأبناء أسماءهم ويخجلون منها لا سيما عند البنات اللواتي قد يؤثّر الاسم في زواجهن ويكون سببًا في رفض الزواج بهن.. والأمر يمتدّ إلى مجالات الأدب والفنون، فيلجأ الأدباء والفنانون إلى "اختراع" أسماء شهرة تُخفي أسماءهم الحقيقية، أو يلجؤون إلى النشر بأسماء مستعارة لاعتبارات عديدة منها عدم "اقتناعهم" بأسمائهم.. هل تعتبرون اختيار أسماء المواليد ثقافةً قائمة بذاتها ولها أصولها التي يجب مراعاتها؟ وماذا عن التوجّه إلى اختيار أسماء غريبة عن الثقافة العربية مثل اختيار أسماء من مسلسلات أجنبية؟ وما مدى تأثير ذلك على الثقافة المجتمعية مستقبلا؟ وماذا عن اختيار الأدباء والفنانين لأسماء شهرة أو الكتابة بأسماء مستعارة؟ وما هي تجربتكم في تسمية أبنائكم؟ وهل تذكرون حكايات عن تسمية الأبناء بتسميات غريبة للحفاظ عليهم من الموت والحسد.. وفقا للاعتقادات الشعبية؟ عزيزي القارئ أنت لك رأيٌ أيضًا في قضيّة الأسماء، ويسعدنا أن تفيدنا به وتعبّر عنه من باب الوفاء لاسمك أو للأسماء الأصيلة التي نتوجّه إلى الانسلاخ عنها إذا لم نتدارك الأمر ونؤسّس لما نُسمّيه: وعي الأسماء!
 عبد الوهاب برانية
ماذا قال التاريخ عن "بني أنف الناقة"؟
فلسفة الأسماء وتأثيرها على الهوية الثقافية عند العرب
د. عبد الوهاب برانية (جامعة الأزهر - مصر)
هل يمكن أن تكون الأسماء جزءًا من الهوية الثقافية للمجتمعات، بحيث تعكس القيم والتقاليد والمعتقدات المتداولة بين الشعوب؟
إن الأسماء في الحقيقة تحمل في خلفياتها أبعادًا عميقة، تتجاوز النطق الحَرفي لمكوّناتها اللغوية البسيطة، إلى ما هو أعمق بكثير من مجرد التّسمية المباشرة، فللأسماء دلالتها غير المباشرة على أفكار ورؤى مَن يحمل الاسم أو من قام بتسجيله.
ولكن مع التطور السريع المتلاحق في مكتسبات المجتمعات، تراجع هذا الارتباط الشديد بين الاسم وما يحمل من هويات حامله الثقافية والحضارية، إذ بدأت بعض الأسماء تفقد جزءًا من ارتباطها بالهوية الثقافية والتقاليد المرعية، ممّا أوجد تحدّيات جديدة على المجتمع، أضحى من الواجب عليه التنبّه لها، والحذر منها، وإيجاد حلولٍ لإيقاف تمدّدها وتشعّبها.
فالاسم الذي نختاره مبكرا لأطفالنا هو في الحقيقة أكثر من شارة تعريفيّة بصاحبه، بل إنه فوق ذلك إعلان عن هويتنا الثقافية، ورسم صورة لواقعنا، وخارطة لمستقبلنا.
ومن ينظر في أسماء العرب، يجد أنها تعبّر عن بيئتهم التي كانوا يعيشون فيها، ومن خلال هذه الأسماء وحدها يمكن للإنسان أن يقف على كثير من تفاصيل حياتهم، ويحدّد صورةً تتّفق مع شكل ومستوى معيشتهم في تلك البيئة. وقد جاء في كتاب "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب" للقلقشندي: "غالب أسماء العرب منقولة عمّا يدور في خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه، إما من الوحوش كأسد ونمر، وإما من النبات كنَبت وحنظلة، وإما من الحشرات كحيّة وحنش، وإما من أجزاء الأرض كفِهر وصَخر".
وإذا كانت أسماء العرب في كلام "القلقشندي" (ت 821هـ) تعبّر عن حياتهم الحسيّة، فإنها لم تقف عند هذا الحد، وإنما عكست أيضا أحوالهم النفسية والأمنية والمزاجية، ولما كانت حياة العرب لا تنفك عن النزاعات والمواجهات والحروب التي تمتد لتبلغ عقودا من الزمان كحربَي: البسوس وداحس والغبراء، كان من متطلبات ذلك أن ينشئوا أبناءهم منذ البداية على الشدة والقسوة، فتطلّب ذلك أن يطلقوا عليهم من الأسماء والألقاب ما يبث الرهبة والرعب في قلوب خصومهم، فاختاروا لأبنائهم أسماء تحمل من تلك الدلالات ما يحقق الغرض النفسي الذي راحوا يهدفون إليه، فتجد من أبنائهم من يُسمّى: كلبا: ليثا، ضرغاما، أبا فراس.. فسمّوا أولادهم بأسماء السّباع ترهيبا لأعدائهم، وبما غلظ من الشجر والنبات، وكل ما له شوك مثل: طلحة، قتادة، وبما غلظ من الأرض وخشن مثل: حجر، جندل، أو بأسماء الحرب وأدواتها مثل: حرب، سيف، حسام، كنانة، مُهنّد، سهم، وفي ذلك كلّه دلالات لا تخفى على طبيعة الحياة القاسية التي كان العرب يعيشونها، في معاركهم التي لا تكاد تنتهي إحداها حتى تقوم أخرى.
وقد نجد في تسميات العرب ما يدل على مستوى المعيشة الاقتصادي، حيث كانت الحياة العربية شديدة القسوة وانتشر فيها الفقر والعوز وعمّ القحط والجوع، لذا وجدناهم يتمدحون بالكرم والسخاء وإشعال النار للتائهين والغرباء الضالين في الفيافي والصحراوات، وارتبط بعض التّسميات عندهم بهذه الأخلاق مثل: هاشم، مُطعم، فـ "هاشم" هو جَدُّ النبي (صلى الله عليه وسلم) "هاشم بن عبد المطلب" كان يُسمَّى: عَمْرًا، وهو أَول من ثرَد الثَّريدَ وهَشَمه فسُمّي هاشِماً؛ كما يقول "ابن منظور" (ت 711هـ) في "لسان العرب"، قد مدحه أحد الشعراء قائلا:
عَمْرُو العُلا هَشَمَ الثَّريدَ لِقَومه -- ورِجالُ مكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجافُ!
ومن ذلك أيضا: مُطْعِم، جَفْنَة؛ فـ "العرب كانت تسمّي السيد المِطْعام جفنة؛ لأنه يضعها ويطعم الناس فيها فسُمّي باسمها"؛ وجاء في "تهذيب اللغة" لـ "أبي منصور الأزهري" (ت 370هـ) أن "العرب تسمّي الخبز عاصما وجابرا". وفي كل ذلك إشارةٌ إلى طبيعة الأجواء الاقتصاديّة التي كان العرب يعيشونها، ويعتمدون في جانبٍ كبير منها على جود الموسرين، وسخاء المثرين على المعدمين ومن لا يقدرون على مواجهة متطلبات الحياة.
وتعكس بعض تسميّاتهم جوانب حياتية أخرى عند العرب، كانت ناجمة عن الاقتتال المستمر، وفناء الناس في الحروب، فلا يفلت من سعار الحروب إلا قلّة من الناس، ولمّا كان الأمر كذلك وجدناهم يسمّون أبناءهم: (حيا، شيبة، سالما، معمرا) تفاؤلًا بامتداد حياتهم واستبقاء أعمارهم.
وظل العرب في جاهليتهم على هذه الحال، حتى جاء الإسلام، فغيّر من طبيعة الحياة العربية، ونعى على العرب ما انتشر بينهم من بعض العادات السيئة - ولا مجال لذكرها هنا- ومن ذلك التغيير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تسمية الأبناء بأسماءٍ حسنة، تبعث على الارتياح، فتعطي الأمل في الحياة، وبدّل أسماء أناس إلى غير ما سُمُّوا به، فبدّل اسم رجل من "حَزْن" بمعنى (صعب) إلى "سهل"، وآخر من "حرب" إلى "سِلم"، وغيّر اسم امرأة من "عاصية" إلى "مطيعة"، كأنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهيّئ العرب لحياة جديدة تنهض على غير التنازع والتنابذ والقساوة، وتبعث على اللين والرقّة.
ولم يقتصر انتقاء الأسماء عند النبي صلى الله عليه وسلم على الأشخاص، وإنما تعدّاه إلى الأمكنة والمواطن، فمدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إليها كانت تُسمّى "يثرب" فغيرها إلى "طيبة" كراهية التثريب وهو اللوم والتّعيير. وقد ظهرت مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أكبر في الألقاب التي كان يمنحها لأصحابه، كالصديق لأبي بكر والفاروق لعمر، وغيرهما من الصحابة كأسد الله وسيف الله وأمين الأمة، فقد تركت هذه الألقاب من الأثر في نفوس أصحابها ما جعلهم يتفانون في إثبات استحقاقه، لا يعوزهم إخلاص ولا يجلّلهم عُجبٌ ورياء.
وفي زمننا هذا أصبح اختيار الاسم متّسعا عمّا قبل، فاتساع رقعة التواصل المجتمعي بين الشعوب، عن طريق وسائل الإعلام وانتشار التكنولوجيا، ووسائل التواصل الرقمية الحديثة، كل ذلك سهّل عملية اختيار الأسماء، وإن كنت أظن أنها تخضع للتقليد أكثر مما تخضع لمعنى الاسم ومفهومه، فقد يحمل بعضهم اسمًا لا يعرف معناه، ولا أصل استخدامه، وحتى من اختاروه له لا يعرفون من ذلك شيئا، فأضحت فلسفة الاختيار غير موجودة عند كثير من الناس.
وربّما وجدنا ظاهرة منتشرة بين الناس، دافعها شكلي فقط، وليست قائمة على رؤية وفكر، وإنما على تأثر وتقليد أعمى خالٍ من الفلسفة والتّبرير المُقنع، تتمثل تلك الظاهرة في إقبال الكثيرين وخاصة من فئة الإناث، بتغيير الاسم بشكل رسمي، وليت في هذا التغيير ما يقنع المحيط الاجتماعي المراقب للمشهد، ولكن ربما كان الاسم القديم المستبدَل به غيره أكثر أصالة ودلالة على القيمة والمكانة والخُلق من الجديد المستحدث، ولا أرى إلّا أن في ذلك تراجعا أخلاقيا وقيميا ما كان ينبغي أن يحدث.
إنّ اختيار أسماء الأولاد ليس بالأمر الهيّن، الذي يمكن أن يمرّ في حياتنا، دون أن نوليه الاهتمام الذي يستحقه، فالاسم يصاحب المُسمّى به مدة حياته، وليت الأمر يتوقّف عند هذا الحد، وإنما ينتقل من الآباء إلى الأبناء، والأحفاد، وربما كان في الاسم ما يثير السخرية في أحد مراحله، فيجعل حامله يخزى من ذكره، ويستحيي من إعلانه، فيخفيه قدر الطاقة، وكم من أناس أعرف ذلك في أسمائهم، وألقاب عوائلهم، فكنت ألاحظ توقّفهم باسمهم عند حدٍّ معيّن يخفون فيه ما يستشعرون الحرج منه من أسمائهم وألقاب عائلاتهم، ولو أن أهليهم اختاروا لهم اسما حسنا لما أورثوهم ذلك التحفّظ والتخفّي والتّواري، وقد ذكّرني ذلك بـ (بني أنف الناقة) تلك القبيلة العربية التي كان أفرادها إذا سئلوا عن قبيلتهم لا يذكرون الاسم إلا خافضين أصواتهم مرغمين أنوفهم، حتى هيأت لهم الظروف أن يمرّ "الحطيئة" الشاعر بديارهم فيُضَيِّفونه ويكرمونه فينظم فيهم أبياتا منها:
قوم هم الأنف والأذناب غيرهمُ -- ومن يُسَوِّي بأنف الناقة الذَّنَبَا
فتحوّلوا من حال إلى حال، فإذا سئلوا عما كانون يخجلون من الإجابة عنه بالأمس، إذا هم بعد بيت "الحطيئة" يشمخون بأنوفهم ويرفعون أصواتهم قائلين: "من بني أنف الناقة"، بلا خجل ولا تحفظ وتوار.
ويبقى على الأسر واجب، أراه من صميم واجباتها نحو أولادها، أنهم فوق اختيارهم الاسم الحسن لأولادهم عليهم بأن يبصروهم بمعاني أسمائهم، ومناسبة التسمية، وأن يوقفوهم على تاريخ آبائهم وأجدادهم حتى يكون ذلك درسا في تواصل الأجيال ينتقل من الآباء إلى الأبناء ويتوارثه من بعدهم الأحفاد.
عبد الوهاب برانية
ماذا قال التاريخ عن "بني أنف الناقة"؟
فلسفة الأسماء وتأثيرها على الهوية الثقافية عند العرب
د. عبد الوهاب برانية (جامعة الأزهر - مصر)
هل يمكن أن تكون الأسماء جزءًا من الهوية الثقافية للمجتمعات، بحيث تعكس القيم والتقاليد والمعتقدات المتداولة بين الشعوب؟
إن الأسماء في الحقيقة تحمل في خلفياتها أبعادًا عميقة، تتجاوز النطق الحَرفي لمكوّناتها اللغوية البسيطة، إلى ما هو أعمق بكثير من مجرد التّسمية المباشرة، فللأسماء دلالتها غير المباشرة على أفكار ورؤى مَن يحمل الاسم أو من قام بتسجيله.
ولكن مع التطور السريع المتلاحق في مكتسبات المجتمعات، تراجع هذا الارتباط الشديد بين الاسم وما يحمل من هويات حامله الثقافية والحضارية، إذ بدأت بعض الأسماء تفقد جزءًا من ارتباطها بالهوية الثقافية والتقاليد المرعية، ممّا أوجد تحدّيات جديدة على المجتمع، أضحى من الواجب عليه التنبّه لها، والحذر منها، وإيجاد حلولٍ لإيقاف تمدّدها وتشعّبها.
فالاسم الذي نختاره مبكرا لأطفالنا هو في الحقيقة أكثر من شارة تعريفيّة بصاحبه، بل إنه فوق ذلك إعلان عن هويتنا الثقافية، ورسم صورة لواقعنا، وخارطة لمستقبلنا.
ومن ينظر في أسماء العرب، يجد أنها تعبّر عن بيئتهم التي كانوا يعيشون فيها، ومن خلال هذه الأسماء وحدها يمكن للإنسان أن يقف على كثير من تفاصيل حياتهم، ويحدّد صورةً تتّفق مع شكل ومستوى معيشتهم في تلك البيئة. وقد جاء في كتاب "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب" للقلقشندي: "غالب أسماء العرب منقولة عمّا يدور في خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه، إما من الوحوش كأسد ونمر، وإما من النبات كنَبت وحنظلة، وإما من الحشرات كحيّة وحنش، وإما من أجزاء الأرض كفِهر وصَخر".
وإذا كانت أسماء العرب في كلام "القلقشندي" (ت 821هـ) تعبّر عن حياتهم الحسيّة، فإنها لم تقف عند هذا الحد، وإنما عكست أيضا أحوالهم النفسية والأمنية والمزاجية، ولما كانت حياة العرب لا تنفك عن النزاعات والمواجهات والحروب التي تمتد لتبلغ عقودا من الزمان كحربَي: البسوس وداحس والغبراء، كان من متطلبات ذلك أن ينشئوا أبناءهم منذ البداية على الشدة والقسوة، فتطلّب ذلك أن يطلقوا عليهم من الأسماء والألقاب ما يبث الرهبة والرعب في قلوب خصومهم، فاختاروا لأبنائهم أسماء تحمل من تلك الدلالات ما يحقق الغرض النفسي الذي راحوا يهدفون إليه، فتجد من أبنائهم من يُسمّى: كلبا: ليثا، ضرغاما، أبا فراس.. فسمّوا أولادهم بأسماء السّباع ترهيبا لأعدائهم، وبما غلظ من الشجر والنبات، وكل ما له شوك مثل: طلحة، قتادة، وبما غلظ من الأرض وخشن مثل: حجر، جندل، أو بأسماء الحرب وأدواتها مثل: حرب، سيف، حسام، كنانة، مُهنّد، سهم، وفي ذلك كلّه دلالات لا تخفى على طبيعة الحياة القاسية التي كان العرب يعيشونها، في معاركهم التي لا تكاد تنتهي إحداها حتى تقوم أخرى.
وقد نجد في تسميات العرب ما يدل على مستوى المعيشة الاقتصادي، حيث كانت الحياة العربية شديدة القسوة وانتشر فيها الفقر والعوز وعمّ القحط والجوع، لذا وجدناهم يتمدحون بالكرم والسخاء وإشعال النار للتائهين والغرباء الضالين في الفيافي والصحراوات، وارتبط بعض التّسميات عندهم بهذه الأخلاق مثل: هاشم، مُطعم، فـ "هاشم" هو جَدُّ النبي (صلى الله عليه وسلم) "هاشم بن عبد المطلب" كان يُسمَّى: عَمْرًا، وهو أَول من ثرَد الثَّريدَ وهَشَمه فسُمّي هاشِماً؛ كما يقول "ابن منظور" (ت 711هـ) في "لسان العرب"، قد مدحه أحد الشعراء قائلا:
عَمْرُو العُلا هَشَمَ الثَّريدَ لِقَومه -- ورِجالُ مكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجافُ!
ومن ذلك أيضا: مُطْعِم، جَفْنَة؛ فـ "العرب كانت تسمّي السيد المِطْعام جفنة؛ لأنه يضعها ويطعم الناس فيها فسُمّي باسمها"؛ وجاء في "تهذيب اللغة" لـ "أبي منصور الأزهري" (ت 370هـ) أن "العرب تسمّي الخبز عاصما وجابرا". وفي كل ذلك إشارةٌ إلى طبيعة الأجواء الاقتصاديّة التي كان العرب يعيشونها، ويعتمدون في جانبٍ كبير منها على جود الموسرين، وسخاء المثرين على المعدمين ومن لا يقدرون على مواجهة متطلبات الحياة.
وتعكس بعض تسميّاتهم جوانب حياتية أخرى عند العرب، كانت ناجمة عن الاقتتال المستمر، وفناء الناس في الحروب، فلا يفلت من سعار الحروب إلا قلّة من الناس، ولمّا كان الأمر كذلك وجدناهم يسمّون أبناءهم: (حيا، شيبة، سالما، معمرا) تفاؤلًا بامتداد حياتهم واستبقاء أعمارهم.
وظل العرب في جاهليتهم على هذه الحال، حتى جاء الإسلام، فغيّر من طبيعة الحياة العربية، ونعى على العرب ما انتشر بينهم من بعض العادات السيئة - ولا مجال لذكرها هنا- ومن ذلك التغيير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تسمية الأبناء بأسماءٍ حسنة، تبعث على الارتياح، فتعطي الأمل في الحياة، وبدّل أسماء أناس إلى غير ما سُمُّوا به، فبدّل اسم رجل من "حَزْن" بمعنى (صعب) إلى "سهل"، وآخر من "حرب" إلى "سِلم"، وغيّر اسم امرأة من "عاصية" إلى "مطيعة"، كأنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهيّئ العرب لحياة جديدة تنهض على غير التنازع والتنابذ والقساوة، وتبعث على اللين والرقّة.
ولم يقتصر انتقاء الأسماء عند النبي صلى الله عليه وسلم على الأشخاص، وإنما تعدّاه إلى الأمكنة والمواطن، فمدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إليها كانت تُسمّى "يثرب" فغيرها إلى "طيبة" كراهية التثريب وهو اللوم والتّعيير. وقد ظهرت مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أكبر في الألقاب التي كان يمنحها لأصحابه، كالصديق لأبي بكر والفاروق لعمر، وغيرهما من الصحابة كأسد الله وسيف الله وأمين الأمة، فقد تركت هذه الألقاب من الأثر في نفوس أصحابها ما جعلهم يتفانون في إثبات استحقاقه، لا يعوزهم إخلاص ولا يجلّلهم عُجبٌ ورياء.
وفي زمننا هذا أصبح اختيار الاسم متّسعا عمّا قبل، فاتساع رقعة التواصل المجتمعي بين الشعوب، عن طريق وسائل الإعلام وانتشار التكنولوجيا، ووسائل التواصل الرقمية الحديثة، كل ذلك سهّل عملية اختيار الأسماء، وإن كنت أظن أنها تخضع للتقليد أكثر مما تخضع لمعنى الاسم ومفهومه، فقد يحمل بعضهم اسمًا لا يعرف معناه، ولا أصل استخدامه، وحتى من اختاروه له لا يعرفون من ذلك شيئا، فأضحت فلسفة الاختيار غير موجودة عند كثير من الناس.
وربّما وجدنا ظاهرة منتشرة بين الناس، دافعها شكلي فقط، وليست قائمة على رؤية وفكر، وإنما على تأثر وتقليد أعمى خالٍ من الفلسفة والتّبرير المُقنع، تتمثل تلك الظاهرة في إقبال الكثيرين وخاصة من فئة الإناث، بتغيير الاسم بشكل رسمي، وليت في هذا التغيير ما يقنع المحيط الاجتماعي المراقب للمشهد، ولكن ربما كان الاسم القديم المستبدَل به غيره أكثر أصالة ودلالة على القيمة والمكانة والخُلق من الجديد المستحدث، ولا أرى إلّا أن في ذلك تراجعا أخلاقيا وقيميا ما كان ينبغي أن يحدث.
إنّ اختيار أسماء الأولاد ليس بالأمر الهيّن، الذي يمكن أن يمرّ في حياتنا، دون أن نوليه الاهتمام الذي يستحقه، فالاسم يصاحب المُسمّى به مدة حياته، وليت الأمر يتوقّف عند هذا الحد، وإنما ينتقل من الآباء إلى الأبناء، والأحفاد، وربما كان في الاسم ما يثير السخرية في أحد مراحله، فيجعل حامله يخزى من ذكره، ويستحيي من إعلانه، فيخفيه قدر الطاقة، وكم من أناس أعرف ذلك في أسمائهم، وألقاب عوائلهم، فكنت ألاحظ توقّفهم باسمهم عند حدٍّ معيّن يخفون فيه ما يستشعرون الحرج منه من أسمائهم وألقاب عائلاتهم، ولو أن أهليهم اختاروا لهم اسما حسنا لما أورثوهم ذلك التحفّظ والتخفّي والتّواري، وقد ذكّرني ذلك بـ (بني أنف الناقة) تلك القبيلة العربية التي كان أفرادها إذا سئلوا عن قبيلتهم لا يذكرون الاسم إلا خافضين أصواتهم مرغمين أنوفهم، حتى هيأت لهم الظروف أن يمرّ "الحطيئة" الشاعر بديارهم فيُضَيِّفونه ويكرمونه فينظم فيهم أبياتا منها:
قوم هم الأنف والأذناب غيرهمُ -- ومن يُسَوِّي بأنف الناقة الذَّنَبَا
فتحوّلوا من حال إلى حال، فإذا سئلوا عما كانون يخجلون من الإجابة عنه بالأمس، إذا هم بعد بيت "الحطيئة" يشمخون بأنوفهم ويرفعون أصواتهم قائلين: "من بني أنف الناقة"، بلا خجل ولا تحفظ وتوار.
ويبقى على الأسر واجب، أراه من صميم واجباتها نحو أولادها، أنهم فوق اختيارهم الاسم الحسن لأولادهم عليهم بأن يبصروهم بمعاني أسمائهم، ومناسبة التسمية، وأن يوقفوهم على تاريخ آبائهم وأجدادهم حتى يكون ذلك درسا في تواصل الأجيال ينتقل من الآباء إلى الأبناء ويتوارثه من بعدهم الأحفاد.
 د. شعبان عبد الجيِّد
خواطر وآراء حول فلسفة الأسماء
د. شعبان عبد الجيِّد (كاتب من مصر)
ماذا لو لم يكن لك اسم؟
فكرةٌ قد تبدو ساذجة!
لكنها تضعُك أمام جوهر ذاتك
قَبل ـ وبعدَ ـ أن يمنحك (الآخرون)
اسمَك الذي تُعرَفُ به!
حين يُولَد الإنسان، وحتى قبل أن يُولَد، يضع له أبواه اسمًا يخصّه، يدلُّ عليه ويُنادَى به، ولا أعتقد أن ثمة جماعة بشرية متحضّرة، منذ أن خلق الله آدم وسمَّاه إلى يوم الناس هذا، لا تطلق على أبنائها أسماءً تحدِّدُهم وتعَيِّنُهم، وكان يحدث كثيرًا، وبخاصةٍ في أرياف مصر وصعيدها، أن يُسمّى المولود بأكثر من اسم، منعًا للحسد أو خوفًا من موته صغيرًا، وأعرف كثيرين من أبناء جيلي وأهل قريتي يُعرفون باسمَين مختلفَين، أحدهما رسمي مسجلٌ في الأوراق الحكومية، وآخر للشهرة يعرفه الأقارب والجيران والزملاء، وقد حدث هذا معي شخصِيًّا؛ فلقد سمَّاني والدي، رحِمه الله، (شعبان) تَيَمُّنًا بليلة النصف من شعبان التي وُلِدت فيها، ولأنهم كانوا يخافون أن أموت صغيرًا مثلما سبق أن مات أربعةُ إخوةٍ لي صغارًا، (فتحي وبكري وطِلِب وجمال) فقد سمَّوني (شَحَّات)، وهو المتسوِّل، الذي يلحّ على النّاس طالبًا الصّدقةَ والإحسانَ، وقد ظلَّ أهلي وأصدقاءُ أبي ينادونني به فترةً طويلة، وكانت والدتي امرأة طيبةً جدًّا، وترتبك حين يسألها أحد عن (شعبان)، لأنها اعتادت سماعَ الاسم الثاني، وكان أحد معارفنا حين يزورنا يقول لها: (يا أم شحات.. الأستاذ شعبان هنا)؟!! وكأنني اثنانِ لا واحد. ولولا أن الله سلَّمَ وسُجِّلتُ في الأوراق الرسمية بالاسم الأول لصرتُم تقرؤون هذا المقال لرجلٍ آخر غيري، له اسم مختلفٌ عن اسمي، وربما طبيعة غير طبيعتي؛ فكما يقال: لِكُلِّ رجلٍ من اسمِه نصيب.
وكانت أسماء الأشخاص في قريتنا متنوعة، قلّما تتكرّر في العائلة الواحدة، يستوي في هذا أسماء الذكور وأسماء الإناث، اللهم إلا أن يُسمَّى الحفيدُ باسم جدِّه، وإن لم يكن هذا شائعًا في جيلنا بصورةٍ واضحة. وفي قريةٍ مجاورة لنا كانت تكثر أسماء (نوح وجاد ومختار) بصورة واضحة، وكان بعضهم يتندَّر على ذلك فيقول: إنك لو وقفت في أحد الشوارع وناديت: يا مختار، فسوف يخرج لك ثُلُثُ الشارع! وعرفت فيما بعد أن وراء ذلك أسبابًا كثيرة؛ وأن الأسماء لا توضع اعتباطًا، وقد (تُعَلَّلُ) خلافًا لما هو معروف، وقد تكون لها مناسبة فرضتها ودعت إليها، وهو ما جعلني أفكر طويلًا في (فلسفة الأسماء ودلالاتها)، وأحاول أن أصل في ذلك إلى رأيٍ مُقنع وتفسير منطقي.
في اللغة: الاسم هو ما يُعرف به الشيء ويُستدلُّ به عليه، واسمُ الشيء علامته، مشتق من سموتُ لأنه تنويهٌ ورِفعة. وهو عند النّحاة: ما دلَّ على معنى في نفسه غيرَ مقترنٍ بزمن. ويروي "الصُّوليُّ" في أماليه أن أبا زيدٍ حكَى أن العربَ تقول: هذا اسم وهذا سِم وسُم، وأنشد: بسم الذي في كلِّ سورةٍ سِمُه.
وفي القرآن: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (سورة البقرة، الآية: 31)، قيل هي أسماء الأشياء، وقيل هي الأسماء الحسنى. وقيل: علَّمَه اسمَ كلِّ دابة، وكلِّ طير، وكلِّ شيء. وقيل: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودابة، وسماء، وأرض، وسهل، وبحر.. وأشباه ذلك من الأمم وغيرِها. وذهب "الجاحظ" في رسائله إلى أن الأسماء التي تدور بين الناس إنما وُضعَت علاماتٍ لخصائص الحالات لا لنتائج التركيبات.
وذهب "أدونيس" في مقال له عن "الأسماء" (مجلة كلمات، يناير/ جانفي 1988) إلى أنه "حين أسمِيَ (باللغة) شيئًا، أهيمن عليه، لأنني أكون قد عرفته. فالمعرفة.. قوة امتلاك، وقوة تخيُّل، وهكذا يصبح هذا الشيء مكانًا لرغباتي. الشيء الذي لم أسَمِّه بعد، لا أعرفه، ولا أعرف كيف أسلُكُ إزاءه، لا يَدَ لي عليه".
ولا يعطيني الاسم مسمّاه، أي أن اللغة لا تعطيني الشيء الذي أسميه بها، إلا بعد أن "تميته". فحين أقول: "هذا الطفل" أكون قد "أمَتُّه"، أي جرَّدته من جسديّته المادية، وحولته إلى فكرة، أو وجود ذهني، فالتسمية (اللغة) تعطيني غيابًا ما، تعطيني "فكرة" الشيء، أو "وجوده الذهني"، ومن هنا تتخطّى الفكرة مادتها، ويتجاوز الاسم مسمَّاه.
وقد فرَّقوا بينه وبين اللقب والكُنية؛ فاللقب في اللغة هو النبز، وهو ما أشعر بمدحٍ كـ "زين العابدين"، أو ذمٍّ كـ "أنف الناقة". أمَّا الكُنيةُ فهي أن تتكلم بشيءٍ وتريد غيرَه، وهي على ثلاثة أوجُه: أحدها أن يُكنى عن الشيء الذي يُستفحَشُ ذِكرُه، والثاني أن يُكنَى الرجلُ باسمٍ توقيرًا وتعظيمًا، والثالث أن تقوم الكُنية مقام السم، فيُعرف صاحبها بها كما يُعرف باسمه؛ مثل أبي لهب، اسمه عبد العُزَّى، عُرف بكنيةٍ فسمَّاه الله بها، وهي في عُرف النّحاةِ ما كان في أوله أب أو أم، كأبي عبد الله وأم الخير.
والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يُعنَى بالتسمية، لأن الحيوان لا يميز بين أفراد الجنس الواحد، فهي جميعها في نظره سواء. ومع ذلك فقد اعتاد الناس أن يُطلقوا أسماء الأعلام على المدن والأنهار والأقطار، بل على أفراد بعض الحيوانات أيضًا. واشتُهر العربُ بتسمية جيادهم بأسماء الأعلام، كما يفعل أصحاب جياد السّباق في هذه الأيام، وكما يفعل بعض الناس إذ يطلقون أسماء الأعلام على ما يتألَّفونه من الحيوانات كالكلاب والقطط وما أشبه.
والأرجح، كما قرأت في مجلة الهلال (مايو 1934)، أن التسمية من مميزات المدنية، وأن الإنسان في طَور الهمجية لم يكن يسمِّي أفراد جنسه بأسماء الأعلام، فلما تقدَّم قليلًا شرع في التسمية وحرَصَ أن يكون في الاسم ما يشفّ عن "شخصية" المُسمَّى وصفاته. وما يزال المتوحّشون حتى الآن يستغنون عن التسمية بذكر صفات المسمَّى ونوع قرابته من المتكلم أو زعيم القبيلة أو ما إلى ذلك، فيقولون مثلًا: "الرجل الطويل ابن الزعيم" أو "الرجل ذو العين الواحدة" وهلمَّ جرًّا..
وبعض المتوحشين يمتنعون عن تسمية أولادهم بأسماء الأعلام خشية الأرواح الشريرة، لئلَّا تستحسِن تلك الأسماء فتقبض أرواح أصحابها، ولاتّقاء هذه المصيبة يلقّبون أولادهم بصفات ذميمة كقولهم: "القذر" و"البشع" و"الدميم" و"الجبان" و"الوغد"... وفي قبائل أخرى من المتوحشين يُسمّى الطفل باسمٍ يدل على حدث تاريخي مثل "القحط" و"الحرب" وهما من الأسماء الشائعة حتى الآن. وقد يستعمل بعص المتوحشين الكنية (وهي علم مصَدَّر بلفظ الأب أو الابن أو الأم أو الأخت) فيقولون: أبو الماء وأم الشجرة وبنت الحرب، ومنهم من يغيّر اسم الولد إذا بلغ، فيعطيه اسمًا جديدًا يظل مكتومًا إلا عن المقرّبين، وقد يُقام لمثل هذه التسمية احتفالٌ خاص.
وكانت عادة العرب وغيرهم من الأمم قديمًا أن يختاروا للذكور من أولادهم أسماء تُشعِر أعداءَهم بالشدة والبأس والقوة والشجاعة لتُلقي الرعب في قلوبهم. فمن أسماء العرب: معارك، محارب، حرب، شجاع، صنديد، شديد، دهشان، غضبان، هراس، ناعب، وحش، منصور، ولهذه الأسماء ما يقابلها عند الفرنجة مثل: جيرالد، سافيدج، فيكتور.
وفي كتاب "فقه اللغة وسر العربية" لـ "أبي منصور الثعالبي" فصلٌ قصيرٌ "في تسمية العرب أبناءَها بالشنيع من الأسماء"، جاء فيه: وهي من سنن العرب، إذ تسمّي أبناءَها بحجَر، وكلب، ونمر، وذئب، وأسد، وما شبهها. وكان بعضهم إذا وُلد لأحدهم ولدٌ سماه بما يراه ويسمعه، مما يتفاءل به؛ فإن رأى حجرًا أو سمعه، تأوَّل فيه الشدة والصلابة والصبر والبقاء، وإن رأى كلبًا تأوَّل فيه الحراسة والأُلفة وبعد الصوت، وإن رأى نمِرًا تأوّل فيه المنَعة والتيه والشكاسة، وإن رأى ذئبًا تأوَّل فيه المهابة والقدرة والحشمة.
وقال بعض الشعوبية لابن الكلبي: لِمَ سَمَّت العربُ أبناءَها بكلب وأوس وأسد وما شاكلها، وسمَّت عبيدَها بيُسر وسعد ويُمن؟ فقال وأحسن: لأنها سمَّت أبناءَها لأعدائها وسمّت عبيدَها لأنفسِها.
وقد ذكر الأستاذ "العقاد" في مقال له عن (فلسفة الأسماء، في مجلة الرسالة، نوفمبر 1937) أنه كان يعجب لأناسٍ يُدعَون بأسماء الكلاب والحشرات، ويحسب أنها ألقابُ تحقير، أطبقها عليهم الأعداء أو المُهكِّمون الماجنون، ثم غلبت عليهم فعُرِفوا بها بدلًا من أسمائهم، ولكنه علم أن أسماء الكلاب والحشرات هي أسماؤهم التي دعاهم بها آباؤهم وأمهاتهم، وأن الآباء والأمهات قصدوا إلى ذلك قصدًا ليعيش لهم أولئك الأبناء، كأنما يحقِّرونهم ويشبّهونهم بالحيوان الأعجم والحشرة المَهينة ليزهد فيهم الموت ويأنف من أن يأخذهم إليه.
ويقول "العقاد" أيضًا، وكأنما يفسِّر كلام "الثعالبي": كنَّا في إحدى المكتبات العامة فدخل خادمٌ زنجي له اسمٌ من أسماء الجواهر، فقال أستاذٌ واقفٌ معنا: ألا ترون مركّب النقص يفعل فعله في أسماء هؤلاء الخدم؟ إنهم يشعرون بما لهم من بخس القيمة فيعوضونها بنفاسة الأسماء.
وكان هذا التعليل يستقيم على هذا الوجه لو أن الخدم الزنوج يختارون الأسماء لأنفسهم ولا يختارها النخّاسون والسادة الذين يشترونهم، ولكن الواقع أنهم يُسمَّون بغير علمٍ منهم، وعلى غير معرفةٍ باللغة العربية ولا بأسماء الجواهر والرياحين فيها أو في غيرها.
وإنما الحقيقة على ما يبدو لي أن رغبة السادة هي الملحوظة في التسمية لا رغبة العبيد والخدم المَبيعين، ولهذا يقصرون تسمية العبيد على نوع من أربعة أنواع بين الأسماء: المقتنيات النفيسة وما شابهها من الرياحين الجميلة، أو ألفاظ التفاؤل، أو الشهور والأيام التي تم فيها الشراء أو تمت فيها الولادة، وإلا فكلمة عبد مضافًا إليها اسم من أسماء الله الحسنى كعبد الله وعبد الكريم وعبد الباسط وما يُشعر بالتفاؤل والدعاء خاصة.
فالخِصيان والعبيد يسمَّون بجوهر وفيروز ومرجان وياقوت ولؤلؤ وألماس كأنهم قنِيّة نفيسة يباهي بها صاحبها؛ ويلحق بهذا تسميتهم بريحان وكافور ونرجس كأنهم من أدوات التجميل والزينة في البيوت".
ومن طريف ما قرأته في هذا المقام، دفاعًا عن مثل هذه الأسماء، ما قاله العلامة "محمد بشير الإبراهيمي" في المقارنة بين ما كان عليه حال العرب في الزمن الماضي وحالهم اليوم بالنظر إلى أسمائهم وألقابه وكُناهم: من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم سمةً للطفولة، والكنية عنوانًا على الرجولة، ولذلك كانوا لا يكتنّون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين وبنات، لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم، ولا يرضون بهذه الكُنَى والألقاب الرّخوة إلا لعبيدهم. وما راجت هذه الكُنى والألقاب الرخوة بين المسلمين إلا يوم تراخت العُرَى الشادّة لمجتمعهم، فراج فيهم التخنُّث في الشمائل والتأنّث في الطباع والارتخاء في العزائم والنفاق في الدين، ويوم نسي المسلمون أنفسَهم فأضاعوا الأعمالَ التي يتمجَّد بها الرجال، وأخذوا بالسّفاسف التي يتلهَّى بها الأطفال، وفاتتهم العظمة الحقيقية فالتمسوها في الأسماء والكُنَى والألقاب؛ ولقد كان العرب صخورًا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخر وجندلة، وكانوا غصصًا وسمومًا يوم كان فيهم مرة وحنظلة، وكانوا أشواكًا وأحساكًا يوم كان فيهم قتادة وعَوسجة، فانظر ما هم اليوم؟ وانظر أي أثرٍ تتركه الأسماء في المسمَّيات؟ واعتبر ذلك في كلمة (سيدي) وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة، وأفلتت من أيدينا القيادة، ولماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة، ولو قالها قائلٌ لِعُمَرَ لهاجَت شِرَّتُه، ولَبادرَت بالجوابِ دِرَّتُه.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بحسن اختيار الأسماء، ويقول إن خيرَها ما عُبِّد وما حُمِّد، ويقول إن (من حق الولد على والده أن يُحسِنَ اسمَه). ومما يؤثَر أن عبد المطلب، جدَّ النبي، حينما بشّروه بولادته، قال: "سمُّوه محمدًا؛ فإني لأرجو أن يُحمَد في الأرض وفي السماء".
وكان للإسلام أثرُه الواضح في التسميات، حيث التفتت إلى أسماء الأنبياء وصحابتهم؛ فالمسلمون تسمَّوا باسمَي النبي الواردَين في القرآن، وهما: محمد وأحمد، استجابةً لقوله صلى الله عليه وسلم: "تسمُّوا باسمِي"، كما تسمَّوا باسم غيره من الأنبياء عليهم السلام، وأخذوا بحظٍّ وافرٍ من أسماء الخلفاء الراشدين، والصحابة رضوان الله عليهم. وتسمَّى النصارى باسم عيسى وغيره من الأنبياء ممن يعتقدون نبوتهم كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى، وكذلك أسماء الحواريين. وأمَّا ما يُستحسَن من الأسماء وردت الشريعة بالندب إلى التسمية به، كأسماء الأنبياء عليهم السلام وعبد الله، وعبد الرحمن. ففي سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تسمُّوا بأسماء الأنبياء"، وأحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومُرَّة. وأما ما يُستقبَح فهو ما وردت بالنهي عنه، إمَّا لكراهة لفظه، كحرب ومُرَّة، وإمَّا للتطيّر به، كرباح وأفلح ونجيح وراجح ورافع، ونحوها، ففي صحيح مسلم وغيره النهيُ عن التسمية بمثل ذلك، وورد في جامع الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يغيِّرُ الاسمَ القبيح.
ويرى الدكتور "عمر فروخ" في مقاله "الأسماء المعبَّدة والأسماء المجدَّدة" (مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مايو 1938) إلى أن الشيعة يختلفون مع أهل السنة والجماعة في أنهم يضيفون إلى كلمة "عبد" غيرَ أسماء الله الحسنى، فيسمّون عبد الرسول وعبد النبي وعبد الصاحب (علي بن أبي طالب) وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد المحسن (والمحسن يقال فيه إنه ولد للإمام علي من فاطمة، ولكنه ولد ميِّتًا). وكذلك يسمّون عبد الجوَّاد، والجوَّاد هو في التاريخ الشيعي تاسع الأئمة أبو جعفر محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق.
غير أن الشيعة إذا سمّوا عبد الرسول أو عبد الحسين فإن لفظ "عبد" لا يكون هنا عابدًا، بل خادمًا؛ يدلُّنا على ذلك استعراضُ عددٍ من الأسماء عند الفرس: غلام علي، غلام حيدر (وحيدر هو علي بن أبي طالب)، غلام حسين، غلام محمد، غلام رضا.
ومن اللافت، وعلى الجانب الآخر، أن العرب أنفسَهم قد عمدوا منذ الجاهلية إلى تسمية بناتهم بأسماء فيها معنى الرقة والجمال، المأخوذة من الطبيعة النباتية ذات الروائح الزكية، والألوان اليانعة كزهرة وريحانة ووردة، أو بأسماء فيها تيمُّن بالسَّعد كسعاد وسعدَى وفوز وميمونة ونُعم، أو فيها معنى الأمن كآمنة وسُكَينة، أو أسماء فيها معنى الحُسن كجميلة ومليحة وحبيبة وهيفاء وربيعة ومزنة، أو ذات جَرس مستحَبّ كلُبنى وليلى وهند ودعد، أو فيها صفة الأنوثة مثل مَيَّة وفاطمة وعائشة وخديجة ومليكة وخولة وماوية ولبابة وعصماء وشيماء وتيماء وغير ذلك.
ونظرًا لما للأنثى من موقعٍ مُحبّب في القلوب فإن العرب سمُّوا بعض ذكورهم بأسماء إناث، مثل أسامة بن زيد وأسماء بن خارجة، وأذينة التعبدي، وأميّة بن أبي سفيان، وثعلبة بن حاطب، وحذيفة بن اليمان، وجارية بن قدام التميمي، وجبلة بن الأيهم، وجنادة بن أبي أمية، ومثلها أسماء: عنترة وخزيمة وحمزة وربيعة.
وقد وضع "ابن قتيبة" في "أدب الكاتب: بابًا بيَّن فيه أصول أسماء الناس المُسمَّين بأسماء النبات، مثل: ثمامة وعلقمة وسلمة وقتادة، أو بأسماء الطير، مثل: يعقوب وهيثم وعكرمة، أو بأسماء السباع، مثل: أسد، أوس، حيدرة، نهشل، كلثوم، أو بأسماء الهوام، مثل: حنش، ومازن، وذَر، وجندب، أو بأسماء الصفات وغيرها، مثل: قتيبة، زهير، نوفل، عاتكة، رباب..
لقد كان الاسم الشخصي عند العرب، كما هو عليه الآن، عنوانًا للوجود الإنساني، لأن الوعي بالاسم هو وجهٌ من أوجه الوعي بالذات. واستكشاف الاسم العربي هو استكشاف للذات العربية وبنيتها الثقافية والاجتماعية والنفسية، ورصد لتطوّر هذه الذات وتحوّلها في الزمان والمكان.
وفي مقاله عن "خصوصية الأسماء العربية ودلالاتها" (مجلة التراث العربي، أبريل 2005) يذهب الأستاذ "محمد قرانيا" إلى أن الاسم الفردي (الشخصي) لا يزال يشتغل وفقًا لمنطق "الدوائر المتسعة"، على الطريق التي يرسم بها سقوط الحصى على الماء، دوائر تتسع حتى تتلاشَى. فعلى المستوى الطبقي، تغدو الطبقة السائدة (الغنية) مركز الدوائر؛ فهي التي تنتج الجديد من الأسماء، أو تمحو البائد منها، لتميز ذاتَها من بقي الطبقات ومن الشائع من الأسماء، ثم تتسع الدوائر نحو الطبقات الدنيا مبتعدةً عن المركز. أمَّا على المستوى المجالي، فتبقى المدينة هي مركز الدوائر المتسعة: تنتج الأسماء وتدفعها إلى دائرة القرية، ثم إلى دائرة الأرياف، حيث تتلاشى الأسماء في الهامش مع الدوائر المتّسعة.
وقد لاحظتُ في الفترة الأخيرة، وأنا أعيش في قرية من ريف المنوفية، أن ناسها البسطاء قد تأثّروا بأسماء شخصيات المسلسلات التركية والهندية، وأخذوا يسمّون أبناءهم بها، فكثرت عندنا أسماء مثل: أيان، كيان، رفيف، مهنَّد، إيلين، سيلين، سيليا، عدنان، نهال، كاتيا. وهو تقليدٌ لا أراه محمود العاقبة، وقد يمثل تهديدًا للهوية المصرية والعربية على المدى البعيد.
وهناك من يقولون إن علاقة الاسم بالإرث العائلي لم تعد خافية على أحد؛ فحين يحمل المولود الجديد اسم جَدِّه يكون دلالةً على التواصل بين الأجيال في العائلة الواحدة، كما أن العلاقة بين الاسم والشخصية لم تعد مثار جدل، ولا غرابة في أن يطلب المشعوذون اسم الشخص واسم أمّه لمعرفتهم المسبقة بهذه العلاقة التي تلخص السمات الأساسية للشخصية.
إنّ القول بأن الاسم هو مجرد رامزٍ أو دالٍّ يبقى منقوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الميكانيزمات الداخلية للشخص والإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه، فالاسم مكوِّنٌ أساسيٌّ من مكونات الشخصية أو هو أهمّها؛ حتى أن الطفل يعملُ على أن يكون صورة مطابقة لاسمه.
ومنذ تسعين سنة (يناير/ جانفي 1935) نشرت مجلة "الهلال" مقالًا للأستاذ "أمير بقطر" عن "فلسفة الأسماء"، ذهب فيه إلى أن الاعتزاز بالأسماء منشؤه غريزة الحيازة والاستيلاء على الأشياء وامتلاكها بغير شريك، كالمال والحيوان والمتاع والبنين والزوجة. ومع أن الأسماء لا ثمن لها، وهي ملك مشاع بين الجميع، فإن الناس يحرصون عليها ويمانعون في أمر تغييرها، لما يجدون فيها من الإيناس بعد أن ألِفوها وألِفَ الغيرُ معرفتَهم بها. ويمانع كثير من الدول في تغيير أسماء الأفراد بغير سبب جوهري.
ولا يزال أصل هذه الغريزة واضحًا بين القبائل والأمم التي تعيش على الفطرة؛ فإن الجار احترامًا لجاره والصديق احترامًا لصديقه لا يسمّي مولوده الجديد باسم جاره أو صديقه أو ابن أحدهما، إبقاءً لما بينهما من حق الجوار والصداقة. وإذا مات أحدُ هؤلاء امتنع معارفُه عن ذكر الأسماء المماثلة لاسم الميت خشية أن يكون في ذكرها تجريح لأهل الميت. ولا تزال هذه العادةُ مشاهدةً في فلَّاحي مصر، وقد يتخاصمون ويتقاتلون إذا لم يُحرَص على هذه العادات. ومن هذا يتبيَّن أن ما ذكره "شكسبير" في إحدى رواياته من الاستفهام الإنكاري في قوله: "ما أهميةُ الاسم؟" (What's in a name?) لا يتفق مع الواقع.
وقد سمعت إحدى السيّدات في قريتنا وهي تحذِّر ابنتها من أن تذكر اسمها لأحد، وكأنه سيخطفها إذا عرفه. وأذكر أن رجلًا مُسِنًّا سأل فتاةً صغيرة عن اسمها أو اسم أبيها، فقالت له في لهجة غاضبةٍ متحدِّية: "مِش عارفة.. وانت ما لَك انت؟؟"!.
الأسماء المُستعارة في الأدب العربي
هذه ظاهرة عرفها الأدب العربي، وهي موجودةٌ في الآداب العالمية أيضًا، وبخاصةٍ في العصر الحديث، وقد عالجها الأستاذ "يوسف أسعد داغر" في (مجلة الأديب، أفريل 1948) وذهب إلى أن الكاتب يعمد إلى التستّر تحت اسمٍ مستعارٍ مدفوعًا إلى ذلك بلونٍ من الأحاسيس والمشاعر الدقيقة مثل (الحشمة والأدب)، وقد يكون الدّاعي إلى التستر مركز الكاتب في الهيئة الاجتماعية والمنزلة المرموقة التي يحتلها في السلَّم الاجتماعي، كأن يكون، من رجال الدين أو الدنيا أو من رجال الجيش أو القضاء البارزين، فيرون أن الاعتصام بالتّعمية أدعَى لهم إلى التعبير عمّا يجول في الخاطر من رأي جديدٍ أو فكرٍ طريف.
وقد يحمل الكاتب على التستر تحت اسمٍ مستعار بواعثُ أخرى، منها أن يكون اسمه أو شهرته، أو كنيته، باعثًا على الاستهجان أو المجون أو العبث، فيطلِّق الكاتب اسمَه الحقيقي ليتلبَّسَ باسم جديد. والجنسُ قد يكون باعثًا للكاتب على تغيير اسمه، فهنالك نساء كاتبات شهيرات برزن في عملهن الأدبي تحت اسمٍ مستعار من أسماء الرجال وعُرِفن به، كما هي الحال مع "جورج صاند" في الأدب الفرنسي.
قد يكون المؤلف سيِّدًا كبيرًا في بني قومه، فلا يرضيه أن يتنزّل إلى مصاف الكَتبة ومهنة الكتابة، وهي حرفة ينظرون إليها بإشفاق، فيرون أن يتنكّروا للحقيقة بأسماء مستعارة. وقد يكون المجد الباطل باعثًا على التستّر وراء اسم مستعار؛ فإذا ما لاقى الكتاب النجاحَ وشقّ طريقه إلى الجمهور وأقبل عليه القرّاء يتلقفونه، برز الكاتب الحقيقي وحسر عن اسمه وكنيته.
ويتيح الاسم المستعار (assumed name) للكاتب أن يقول كل ما يريده بصراحةٍ تامة، دون أن يخشى ردّة فعل المجتمع الذي لا يفرّق في الخلق الأدبي بين الخيال والتخيّل والواقع. وكثيرًا ما يدفع الاسم الحقيقي لكُتّاب بارزين أن يتحفظوا في كلامهم، ويتردّدوا في تعبيراتهم، وربما في أفكارهم، مراعاةً لتقاليد المجتمع وحفاظًا على مكانتهم الأدبية والثقافية.
هذه هي الأسباب العامة التي قد يعتصم الكاتب بأحدها، أو بأكثر من واحدٍ منها، لكتم حقيقة اسمه وهويته فيتخفَّى وراء اسمٍ مستعار. ومن يتتبّع تاريخ الأدب المعاصر في الآداب العالمية تبدَّى له من ذلك أمثلة عديدة للأسماء المستعارة، يجد تحت كل واحدٍ منها الدافعَ الذي حدا بالكاتب لإيثار الاسم المستعار.
وفي الأدب العربي المعاصر تجارب كثيرة للمؤلفين بأسماء مستعارة، لعل أشهر تجربة في هذا المجال هي لـ "أدونيس"، الذي اختفى اسمه الحقيقي "علي أحمد سعيد"، أما "أنسي الحاج" فكتب بعدة أسماء منها "سراب العارف" و"عابر"، وكتب "توفيق يوسف عواد" باسم "حمّاد"، و"فؤاد حداد" باسم "أبو الحن"، و"عائشة عبد الرحمن" باسم "بنت الشاطئ"، و"مَلَك حفني ناصف" باسم "باحثة البادية"، والشاعرة "عائشة أرناؤوط" باسم "عشتار"، وأصدر "رئيف خوري" كتيِّبًا عن فلسطين باسم "الفتى العربي"، وكتب "غسان كنفاني" مقالات باسم "فارس فارس"، واختار الروائي "حسن داود" اسمه هذا، بدلًا من اسمه الحقيقي "حسن زبيب"، وكتب "إلياس خوري" باسم "خليل أيوب" و"مروان العاصي"، وكتب "بشارة عبد الله الخوري" باسم "الأخطل الصغير"، كما وقعت "مــاري إليـــاس زيــــادة"، باسم "كنار" و"ماريا" و"مي زيادة". وقد وضع الأستاذ "يوسف أسعد داغر" معجمًا كبيرًا في هذا الموضوع، يقع في ثلاثمائة صفحة، سمَّاه (معجم الأسماء المستعارة وأصحابها، لا سيما في الأدب العربي الحديث"، فليرجع إليه من يشاء.
ويلاحظ أن المرأة الأديبة تلجأ إلى الاسم المستعار أكثر من الرجل، يدعوها إلى ذلك أحيانًا خوفُها من أن تكون تجربتها الإبداعية قاصرة، فهي تحتمي بالاسم المستعار لتكتشف مدى رضى المجتمع عن إنتاجها، لا سيما أن المرأة مرهفة الحس، تضيق بالنقد الذي قد يضع حدًّا لطموحها الأدبي. كذلك كان من أسباب هذا التستر تقاليد المجتمعات المحافظة التي ترى أن اسم الأسرة حقٌّ مشتركٌ للأسرة، لا يجوز مسُّه أو التفريط فيه.
فنَّانون بأسماء مستعارة
أما في مجال التمثيل والغناء، فإن الأسماء المستعارة لكبار النجوم والمشاهير أكثر من نحصيها هنا، ولكنني أذكر على سبيل المثال أن "نجيب الريحاني" اسمه الأصلي هو "نجيب إلياس ريحانة"، و"تحية كاريوكا" اسمها الأصلي "بدرية محمد كريم"، و"عمر الشريف" اسمه الأصلي "ميشيل ديمتري شلهوب"، و"راقية إبراهيم" اسمها الأصلي "راشيل إبراهام ليفي"، و"شادية" اسمها الحقيقي "فاطمة شاكر"، و"صباح" اسمها الحقيقي "جانيت جورج فغالي"، و"هدى سلطان" اسمها الحقيقي "بهيجة عبد العال الحو"، وهي أخت "محمد فوزي"، أما "أحمد رمزي" فاسمه الحقيقي "رمزي محمود بيومي"، و"رجاء الجداوي" اسمها الأصلي "نجاة علي حسين"، و"نجلاء فتحي" اسمها الأصلي "فاطمة الزهراء حسين"، و"عبد الحليم حافظ" اسمه الحقيقي "عبد الحليم شبانة"، و"شريفة فاضل" اسمها الحقيقي "فوقية محمود أحمد ندا"، و"فيروز" اسمها الحقيقي "نهاد وديع حداد"، و"مديحة يسري" اسمها الأصلي "هنومة حبيب خليل"، و"ليلى طاهر" اسمها الحقيقي "شرويت مصطفى فهمي"، و"نور الشريف" اسمه الحقيقي "محمد جابر"..
غرائبُ الأسماء وطرائفُها
كان شائعًا في حواري القاهرة وأحيائها الشعبية أن يختار كثيرٌ من الناس لأبنائهم أسماء غريبة، قد تبدو لنا مضحكةً هذه الأيام، وكانوا يفعلون ذلك ليطيلوا أعمارهم ويدفعوا العين عنهم؛ ومن أمثلة ذلك: دقدق، حُكشة، شَكعه، بلبع، سَنْكحلو، زَمْلُوط، زعطوط، شحَّات، زعزوع، كعبلها، بخاطرها، شنن، زِنْباعي، جُعلُص، بُقلُظ، دحروج، زعرب، شرشومة، بحبح، حزنبل، بظاظة، كرشة، عيطة، حتاتة، عاشور، حرحش، لِهيطة، قزامل، زُعرُب..
ويروي لنا الدكتور "شكري عيَّاد" أن امرأة سكنَت حارتهم، وكان كلُّ أطفالها يموتون (ذلك قبل تقدُّم الطب واختراع الأمصال والمضادات الحيوية) ثم رُزِقَت بنتًا فسمَّتها "خيشة"، كي تقتحمها عيون الناس فلا تصاب بالحسد، وعاشت الطفلة، ورُزِقت أمُّها بمولودٍ ذكرٍ فسمَّته "شوال" للسبب نفسِه.
ويَدلُّ كثيرٌ من ألقاب العائلات على أصل مواطنها الأولى مثل: الشامي، المغربي، التركي، الهندي.. كما أن منها ما يُشعِر بحرفة أو صناعة أو وظيفة أو مركز اجتماعي خاص، مثل: الجعيدي، السحار، البستاني، الجنايني، الجّمَّال، الخادم، الكنفاني، الفسخاني، المستكاوي، الشبكشي، الهجان، الكحكي، الجزار، الفولي، القزّاز، العسكري، الزلباني، الحنّاوي، السكاكيني، الجندي، العمدة، الأفندي، السحرتي، المراكبي، الطحَّان..
ولبعض الألقاب غرابتها أيضًا: فمنها ما يدل على معانٍ غريبة، ربما كانت ثقيلة أو مستهجنة، ولكنها اشتهرت، فأصبحت سهلةً ذائعةً مقبولة، مثل: البِلِط، الجحش، البرش، أبو شناف، حفيشة، عجور، شبايك، الهبَّاب..
وبمناسبة الألقاب أذكر أن العرب لم يكونوا يهتمّون بالألقاب أو يلتفتون إليها، ولم تظهر فيهم إلا منذ بداية الدولة العباسية بعد اختلاطهم بالفرس وغيرهم من الأمم التي كانت تمجِّد السلطان وتعدُّه ظلَّ الله في أرضه؛ فكان لخلفاء بني العباس ألقابٌ أطلقوها على أنفسهم مثل: السفاح، المنصور، الهادي، المهدي، الرشيد، الأمين، المأمون، المعتصم، الواثق، المتوكِّل، المستنصر. وسار على نهجهم الأمويون في الأندلس ومن جاء بعدهم من ملوك الطوائف، حتى انتهى أمرُ الألقاب في عهد ملوك الطوائف إلى أن صارت موضع سخرية ومجال استهزاء، على حد قول شاعرهم "الحسن بن رشيق القيرواني:":
ممّا يُزَهِّــدُني فـي أرضِ أندلسٍ -- أسماءُ مُعتَـــضدٍ فيـــــها ومُعتَمِدِ
ألقابُ مملكةٍ في غيرِ موضعِها -- كالهِرِّ يَحكِي انتفاخًا صَولَة الأسدِ
وكان أكثر من استعملَ الألقاب في الممالك الإسلامية هم: بنو بويه، الفاطميون، الأيوبيون، المماليك، سلاطين آل عثمان، وكذلك أمراؤهم ووزراؤهم ورجال دولتهم، فقد أسرف هؤلاء جميعًا في حمل الألقاب حتى غدت لهم كالأغلال لا ينفكُّون عنها.
وكثيرٌ من الأسماء كنيات كُنِيَ بها أصحابها في الأصل لصفة خاصة، ومن أمثلة ذلك: أبو شادوف، أبو قورة، أبو لبدة، أبو طاقية، أبو الروس، أبو الغيط، أبو كرش، أبو سنة، أبو دراع، أبو ريشة، أبو ليفة، أبو لحاف، أبو سيف، أبو دومة، أبو لقمة، أبو جبل، أبو اخربها.
ولا أظن أن المصريين منفردون وحدهم بهذه الأسماء الغريبة والمضحكة؛ فهناك ما يماثلها في كافة دول الأرض بلغات أصحابها، وهو ما يدلُّ على أن العقل البشري يفكِّر على نمطٍ واحدٍ مهما بعدت الشُّقَّةُ واتّسعت المسافة. ومن الواضح أن هذه الأسماء قد انقرضت تمامًا، أو أنها في طريقها إلى الانقراض؛ فلم يعد الناس، إلا نادرًا جدًّا، يُسَمُّون أبناءَهم: (أم الخير، ست أبوها، زنوبة مِهاود، مِقاوي، شمروخ) وصار الاتجاه إلى الأسماء الخفيفة الرشيقة في لفظها، مثل: (تامر، لؤي، أنس، سوسن، هند، ريم، نورهان، ياسمين).
ولعلَّ هذا مما يبشِّرُ بالخير ويُوحِي بالجَمال، في هذه الأيام التي قلَّ فيها الخيرُ وعَزَّ فيها الجَمال!
د. شعبان عبد الجيِّد
خواطر وآراء حول فلسفة الأسماء
د. شعبان عبد الجيِّد (كاتب من مصر)
ماذا لو لم يكن لك اسم؟
فكرةٌ قد تبدو ساذجة!
لكنها تضعُك أمام جوهر ذاتك
قَبل ـ وبعدَ ـ أن يمنحك (الآخرون)
اسمَك الذي تُعرَفُ به!
حين يُولَد الإنسان، وحتى قبل أن يُولَد، يضع له أبواه اسمًا يخصّه، يدلُّ عليه ويُنادَى به، ولا أعتقد أن ثمة جماعة بشرية متحضّرة، منذ أن خلق الله آدم وسمَّاه إلى يوم الناس هذا، لا تطلق على أبنائها أسماءً تحدِّدُهم وتعَيِّنُهم، وكان يحدث كثيرًا، وبخاصةٍ في أرياف مصر وصعيدها، أن يُسمّى المولود بأكثر من اسم، منعًا للحسد أو خوفًا من موته صغيرًا، وأعرف كثيرين من أبناء جيلي وأهل قريتي يُعرفون باسمَين مختلفَين، أحدهما رسمي مسجلٌ في الأوراق الحكومية، وآخر للشهرة يعرفه الأقارب والجيران والزملاء، وقد حدث هذا معي شخصِيًّا؛ فلقد سمَّاني والدي، رحِمه الله، (شعبان) تَيَمُّنًا بليلة النصف من شعبان التي وُلِدت فيها، ولأنهم كانوا يخافون أن أموت صغيرًا مثلما سبق أن مات أربعةُ إخوةٍ لي صغارًا، (فتحي وبكري وطِلِب وجمال) فقد سمَّوني (شَحَّات)، وهو المتسوِّل، الذي يلحّ على النّاس طالبًا الصّدقةَ والإحسانَ، وقد ظلَّ أهلي وأصدقاءُ أبي ينادونني به فترةً طويلة، وكانت والدتي امرأة طيبةً جدًّا، وترتبك حين يسألها أحد عن (شعبان)، لأنها اعتادت سماعَ الاسم الثاني، وكان أحد معارفنا حين يزورنا يقول لها: (يا أم شحات.. الأستاذ شعبان هنا)؟!! وكأنني اثنانِ لا واحد. ولولا أن الله سلَّمَ وسُجِّلتُ في الأوراق الرسمية بالاسم الأول لصرتُم تقرؤون هذا المقال لرجلٍ آخر غيري، له اسم مختلفٌ عن اسمي، وربما طبيعة غير طبيعتي؛ فكما يقال: لِكُلِّ رجلٍ من اسمِه نصيب.
وكانت أسماء الأشخاص في قريتنا متنوعة، قلّما تتكرّر في العائلة الواحدة، يستوي في هذا أسماء الذكور وأسماء الإناث، اللهم إلا أن يُسمَّى الحفيدُ باسم جدِّه، وإن لم يكن هذا شائعًا في جيلنا بصورةٍ واضحة. وفي قريةٍ مجاورة لنا كانت تكثر أسماء (نوح وجاد ومختار) بصورة واضحة، وكان بعضهم يتندَّر على ذلك فيقول: إنك لو وقفت في أحد الشوارع وناديت: يا مختار، فسوف يخرج لك ثُلُثُ الشارع! وعرفت فيما بعد أن وراء ذلك أسبابًا كثيرة؛ وأن الأسماء لا توضع اعتباطًا، وقد (تُعَلَّلُ) خلافًا لما هو معروف، وقد تكون لها مناسبة فرضتها ودعت إليها، وهو ما جعلني أفكر طويلًا في (فلسفة الأسماء ودلالاتها)، وأحاول أن أصل في ذلك إلى رأيٍ مُقنع وتفسير منطقي.
في اللغة: الاسم هو ما يُعرف به الشيء ويُستدلُّ به عليه، واسمُ الشيء علامته، مشتق من سموتُ لأنه تنويهٌ ورِفعة. وهو عند النّحاة: ما دلَّ على معنى في نفسه غيرَ مقترنٍ بزمن. ويروي "الصُّوليُّ" في أماليه أن أبا زيدٍ حكَى أن العربَ تقول: هذا اسم وهذا سِم وسُم، وأنشد: بسم الذي في كلِّ سورةٍ سِمُه.
وفي القرآن: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (سورة البقرة، الآية: 31)، قيل هي أسماء الأشياء، وقيل هي الأسماء الحسنى. وقيل: علَّمَه اسمَ كلِّ دابة، وكلِّ طير، وكلِّ شيء. وقيل: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودابة، وسماء، وأرض، وسهل، وبحر.. وأشباه ذلك من الأمم وغيرِها. وذهب "الجاحظ" في رسائله إلى أن الأسماء التي تدور بين الناس إنما وُضعَت علاماتٍ لخصائص الحالات لا لنتائج التركيبات.
وذهب "أدونيس" في مقال له عن "الأسماء" (مجلة كلمات، يناير/ جانفي 1988) إلى أنه "حين أسمِيَ (باللغة) شيئًا، أهيمن عليه، لأنني أكون قد عرفته. فالمعرفة.. قوة امتلاك، وقوة تخيُّل، وهكذا يصبح هذا الشيء مكانًا لرغباتي. الشيء الذي لم أسَمِّه بعد، لا أعرفه، ولا أعرف كيف أسلُكُ إزاءه، لا يَدَ لي عليه".
ولا يعطيني الاسم مسمّاه، أي أن اللغة لا تعطيني الشيء الذي أسميه بها، إلا بعد أن "تميته". فحين أقول: "هذا الطفل" أكون قد "أمَتُّه"، أي جرَّدته من جسديّته المادية، وحولته إلى فكرة، أو وجود ذهني، فالتسمية (اللغة) تعطيني غيابًا ما، تعطيني "فكرة" الشيء، أو "وجوده الذهني"، ومن هنا تتخطّى الفكرة مادتها، ويتجاوز الاسم مسمَّاه.
وقد فرَّقوا بينه وبين اللقب والكُنية؛ فاللقب في اللغة هو النبز، وهو ما أشعر بمدحٍ كـ "زين العابدين"، أو ذمٍّ كـ "أنف الناقة". أمَّا الكُنيةُ فهي أن تتكلم بشيءٍ وتريد غيرَه، وهي على ثلاثة أوجُه: أحدها أن يُكنى عن الشيء الذي يُستفحَشُ ذِكرُه، والثاني أن يُكنَى الرجلُ باسمٍ توقيرًا وتعظيمًا، والثالث أن تقوم الكُنية مقام السم، فيُعرف صاحبها بها كما يُعرف باسمه؛ مثل أبي لهب، اسمه عبد العُزَّى، عُرف بكنيةٍ فسمَّاه الله بها، وهي في عُرف النّحاةِ ما كان في أوله أب أو أم، كأبي عبد الله وأم الخير.
والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يُعنَى بالتسمية، لأن الحيوان لا يميز بين أفراد الجنس الواحد، فهي جميعها في نظره سواء. ومع ذلك فقد اعتاد الناس أن يُطلقوا أسماء الأعلام على المدن والأنهار والأقطار، بل على أفراد بعض الحيوانات أيضًا. واشتُهر العربُ بتسمية جيادهم بأسماء الأعلام، كما يفعل أصحاب جياد السّباق في هذه الأيام، وكما يفعل بعض الناس إذ يطلقون أسماء الأعلام على ما يتألَّفونه من الحيوانات كالكلاب والقطط وما أشبه.
والأرجح، كما قرأت في مجلة الهلال (مايو 1934)، أن التسمية من مميزات المدنية، وأن الإنسان في طَور الهمجية لم يكن يسمِّي أفراد جنسه بأسماء الأعلام، فلما تقدَّم قليلًا شرع في التسمية وحرَصَ أن يكون في الاسم ما يشفّ عن "شخصية" المُسمَّى وصفاته. وما يزال المتوحّشون حتى الآن يستغنون عن التسمية بذكر صفات المسمَّى ونوع قرابته من المتكلم أو زعيم القبيلة أو ما إلى ذلك، فيقولون مثلًا: "الرجل الطويل ابن الزعيم" أو "الرجل ذو العين الواحدة" وهلمَّ جرًّا..
وبعض المتوحشين يمتنعون عن تسمية أولادهم بأسماء الأعلام خشية الأرواح الشريرة، لئلَّا تستحسِن تلك الأسماء فتقبض أرواح أصحابها، ولاتّقاء هذه المصيبة يلقّبون أولادهم بصفات ذميمة كقولهم: "القذر" و"البشع" و"الدميم" و"الجبان" و"الوغد"... وفي قبائل أخرى من المتوحشين يُسمّى الطفل باسمٍ يدل على حدث تاريخي مثل "القحط" و"الحرب" وهما من الأسماء الشائعة حتى الآن. وقد يستعمل بعص المتوحشين الكنية (وهي علم مصَدَّر بلفظ الأب أو الابن أو الأم أو الأخت) فيقولون: أبو الماء وأم الشجرة وبنت الحرب، ومنهم من يغيّر اسم الولد إذا بلغ، فيعطيه اسمًا جديدًا يظل مكتومًا إلا عن المقرّبين، وقد يُقام لمثل هذه التسمية احتفالٌ خاص.
وكانت عادة العرب وغيرهم من الأمم قديمًا أن يختاروا للذكور من أولادهم أسماء تُشعِر أعداءَهم بالشدة والبأس والقوة والشجاعة لتُلقي الرعب في قلوبهم. فمن أسماء العرب: معارك، محارب، حرب، شجاع، صنديد، شديد، دهشان، غضبان، هراس، ناعب، وحش، منصور، ولهذه الأسماء ما يقابلها عند الفرنجة مثل: جيرالد، سافيدج، فيكتور.
وفي كتاب "فقه اللغة وسر العربية" لـ "أبي منصور الثعالبي" فصلٌ قصيرٌ "في تسمية العرب أبناءَها بالشنيع من الأسماء"، جاء فيه: وهي من سنن العرب، إذ تسمّي أبناءَها بحجَر، وكلب، ونمر، وذئب، وأسد، وما شبهها. وكان بعضهم إذا وُلد لأحدهم ولدٌ سماه بما يراه ويسمعه، مما يتفاءل به؛ فإن رأى حجرًا أو سمعه، تأوَّل فيه الشدة والصلابة والصبر والبقاء، وإن رأى كلبًا تأوَّل فيه الحراسة والأُلفة وبعد الصوت، وإن رأى نمِرًا تأوّل فيه المنَعة والتيه والشكاسة، وإن رأى ذئبًا تأوَّل فيه المهابة والقدرة والحشمة.
وقال بعض الشعوبية لابن الكلبي: لِمَ سَمَّت العربُ أبناءَها بكلب وأوس وأسد وما شاكلها، وسمَّت عبيدَها بيُسر وسعد ويُمن؟ فقال وأحسن: لأنها سمَّت أبناءَها لأعدائها وسمّت عبيدَها لأنفسِها.
وقد ذكر الأستاذ "العقاد" في مقال له عن (فلسفة الأسماء، في مجلة الرسالة، نوفمبر 1937) أنه كان يعجب لأناسٍ يُدعَون بأسماء الكلاب والحشرات، ويحسب أنها ألقابُ تحقير، أطبقها عليهم الأعداء أو المُهكِّمون الماجنون، ثم غلبت عليهم فعُرِفوا بها بدلًا من أسمائهم، ولكنه علم أن أسماء الكلاب والحشرات هي أسماؤهم التي دعاهم بها آباؤهم وأمهاتهم، وأن الآباء والأمهات قصدوا إلى ذلك قصدًا ليعيش لهم أولئك الأبناء، كأنما يحقِّرونهم ويشبّهونهم بالحيوان الأعجم والحشرة المَهينة ليزهد فيهم الموت ويأنف من أن يأخذهم إليه.
ويقول "العقاد" أيضًا، وكأنما يفسِّر كلام "الثعالبي": كنَّا في إحدى المكتبات العامة فدخل خادمٌ زنجي له اسمٌ من أسماء الجواهر، فقال أستاذٌ واقفٌ معنا: ألا ترون مركّب النقص يفعل فعله في أسماء هؤلاء الخدم؟ إنهم يشعرون بما لهم من بخس القيمة فيعوضونها بنفاسة الأسماء.
وكان هذا التعليل يستقيم على هذا الوجه لو أن الخدم الزنوج يختارون الأسماء لأنفسهم ولا يختارها النخّاسون والسادة الذين يشترونهم، ولكن الواقع أنهم يُسمَّون بغير علمٍ منهم، وعلى غير معرفةٍ باللغة العربية ولا بأسماء الجواهر والرياحين فيها أو في غيرها.
وإنما الحقيقة على ما يبدو لي أن رغبة السادة هي الملحوظة في التسمية لا رغبة العبيد والخدم المَبيعين، ولهذا يقصرون تسمية العبيد على نوع من أربعة أنواع بين الأسماء: المقتنيات النفيسة وما شابهها من الرياحين الجميلة، أو ألفاظ التفاؤل، أو الشهور والأيام التي تم فيها الشراء أو تمت فيها الولادة، وإلا فكلمة عبد مضافًا إليها اسم من أسماء الله الحسنى كعبد الله وعبد الكريم وعبد الباسط وما يُشعر بالتفاؤل والدعاء خاصة.
فالخِصيان والعبيد يسمَّون بجوهر وفيروز ومرجان وياقوت ولؤلؤ وألماس كأنهم قنِيّة نفيسة يباهي بها صاحبها؛ ويلحق بهذا تسميتهم بريحان وكافور ونرجس كأنهم من أدوات التجميل والزينة في البيوت".
ومن طريف ما قرأته في هذا المقام، دفاعًا عن مثل هذه الأسماء، ما قاله العلامة "محمد بشير الإبراهيمي" في المقارنة بين ما كان عليه حال العرب في الزمن الماضي وحالهم اليوم بالنظر إلى أسمائهم وألقابه وكُناهم: من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم سمةً للطفولة، والكنية عنوانًا على الرجولة، ولذلك كانوا لا يكتنّون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين وبنات، لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم، ولا يرضون بهذه الكُنَى والألقاب الرّخوة إلا لعبيدهم. وما راجت هذه الكُنى والألقاب الرخوة بين المسلمين إلا يوم تراخت العُرَى الشادّة لمجتمعهم، فراج فيهم التخنُّث في الشمائل والتأنّث في الطباع والارتخاء في العزائم والنفاق في الدين، ويوم نسي المسلمون أنفسَهم فأضاعوا الأعمالَ التي يتمجَّد بها الرجال، وأخذوا بالسّفاسف التي يتلهَّى بها الأطفال، وفاتتهم العظمة الحقيقية فالتمسوها في الأسماء والكُنَى والألقاب؛ ولقد كان العرب صخورًا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخر وجندلة، وكانوا غصصًا وسمومًا يوم كان فيهم مرة وحنظلة، وكانوا أشواكًا وأحساكًا يوم كان فيهم قتادة وعَوسجة، فانظر ما هم اليوم؟ وانظر أي أثرٍ تتركه الأسماء في المسمَّيات؟ واعتبر ذلك في كلمة (سيدي) وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة، وأفلتت من أيدينا القيادة، ولماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة، ولو قالها قائلٌ لِعُمَرَ لهاجَت شِرَّتُه، ولَبادرَت بالجوابِ دِرَّتُه.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بحسن اختيار الأسماء، ويقول إن خيرَها ما عُبِّد وما حُمِّد، ويقول إن (من حق الولد على والده أن يُحسِنَ اسمَه). ومما يؤثَر أن عبد المطلب، جدَّ النبي، حينما بشّروه بولادته، قال: "سمُّوه محمدًا؛ فإني لأرجو أن يُحمَد في الأرض وفي السماء".
وكان للإسلام أثرُه الواضح في التسميات، حيث التفتت إلى أسماء الأنبياء وصحابتهم؛ فالمسلمون تسمَّوا باسمَي النبي الواردَين في القرآن، وهما: محمد وأحمد، استجابةً لقوله صلى الله عليه وسلم: "تسمُّوا باسمِي"، كما تسمَّوا باسم غيره من الأنبياء عليهم السلام، وأخذوا بحظٍّ وافرٍ من أسماء الخلفاء الراشدين، والصحابة رضوان الله عليهم. وتسمَّى النصارى باسم عيسى وغيره من الأنبياء ممن يعتقدون نبوتهم كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى، وكذلك أسماء الحواريين. وأمَّا ما يُستحسَن من الأسماء وردت الشريعة بالندب إلى التسمية به، كأسماء الأنبياء عليهم السلام وعبد الله، وعبد الرحمن. ففي سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تسمُّوا بأسماء الأنبياء"، وأحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومُرَّة. وأما ما يُستقبَح فهو ما وردت بالنهي عنه، إمَّا لكراهة لفظه، كحرب ومُرَّة، وإمَّا للتطيّر به، كرباح وأفلح ونجيح وراجح ورافع، ونحوها، ففي صحيح مسلم وغيره النهيُ عن التسمية بمثل ذلك، وورد في جامع الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يغيِّرُ الاسمَ القبيح.
ويرى الدكتور "عمر فروخ" في مقاله "الأسماء المعبَّدة والأسماء المجدَّدة" (مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مايو 1938) إلى أن الشيعة يختلفون مع أهل السنة والجماعة في أنهم يضيفون إلى كلمة "عبد" غيرَ أسماء الله الحسنى، فيسمّون عبد الرسول وعبد النبي وعبد الصاحب (علي بن أبي طالب) وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد المحسن (والمحسن يقال فيه إنه ولد للإمام علي من فاطمة، ولكنه ولد ميِّتًا). وكذلك يسمّون عبد الجوَّاد، والجوَّاد هو في التاريخ الشيعي تاسع الأئمة أبو جعفر محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق.
غير أن الشيعة إذا سمّوا عبد الرسول أو عبد الحسين فإن لفظ "عبد" لا يكون هنا عابدًا، بل خادمًا؛ يدلُّنا على ذلك استعراضُ عددٍ من الأسماء عند الفرس: غلام علي، غلام حيدر (وحيدر هو علي بن أبي طالب)، غلام حسين، غلام محمد، غلام رضا.
ومن اللافت، وعلى الجانب الآخر، أن العرب أنفسَهم قد عمدوا منذ الجاهلية إلى تسمية بناتهم بأسماء فيها معنى الرقة والجمال، المأخوذة من الطبيعة النباتية ذات الروائح الزكية، والألوان اليانعة كزهرة وريحانة ووردة، أو بأسماء فيها تيمُّن بالسَّعد كسعاد وسعدَى وفوز وميمونة ونُعم، أو فيها معنى الأمن كآمنة وسُكَينة، أو أسماء فيها معنى الحُسن كجميلة ومليحة وحبيبة وهيفاء وربيعة ومزنة، أو ذات جَرس مستحَبّ كلُبنى وليلى وهند ودعد، أو فيها صفة الأنوثة مثل مَيَّة وفاطمة وعائشة وخديجة ومليكة وخولة وماوية ولبابة وعصماء وشيماء وتيماء وغير ذلك.
ونظرًا لما للأنثى من موقعٍ مُحبّب في القلوب فإن العرب سمُّوا بعض ذكورهم بأسماء إناث، مثل أسامة بن زيد وأسماء بن خارجة، وأذينة التعبدي، وأميّة بن أبي سفيان، وثعلبة بن حاطب، وحذيفة بن اليمان، وجارية بن قدام التميمي، وجبلة بن الأيهم، وجنادة بن أبي أمية، ومثلها أسماء: عنترة وخزيمة وحمزة وربيعة.
وقد وضع "ابن قتيبة" في "أدب الكاتب: بابًا بيَّن فيه أصول أسماء الناس المُسمَّين بأسماء النبات، مثل: ثمامة وعلقمة وسلمة وقتادة، أو بأسماء الطير، مثل: يعقوب وهيثم وعكرمة، أو بأسماء السباع، مثل: أسد، أوس، حيدرة، نهشل، كلثوم، أو بأسماء الهوام، مثل: حنش، ومازن، وذَر، وجندب، أو بأسماء الصفات وغيرها، مثل: قتيبة، زهير، نوفل، عاتكة، رباب..
لقد كان الاسم الشخصي عند العرب، كما هو عليه الآن، عنوانًا للوجود الإنساني، لأن الوعي بالاسم هو وجهٌ من أوجه الوعي بالذات. واستكشاف الاسم العربي هو استكشاف للذات العربية وبنيتها الثقافية والاجتماعية والنفسية، ورصد لتطوّر هذه الذات وتحوّلها في الزمان والمكان.
وفي مقاله عن "خصوصية الأسماء العربية ودلالاتها" (مجلة التراث العربي، أبريل 2005) يذهب الأستاذ "محمد قرانيا" إلى أن الاسم الفردي (الشخصي) لا يزال يشتغل وفقًا لمنطق "الدوائر المتسعة"، على الطريق التي يرسم بها سقوط الحصى على الماء، دوائر تتسع حتى تتلاشَى. فعلى المستوى الطبقي، تغدو الطبقة السائدة (الغنية) مركز الدوائر؛ فهي التي تنتج الجديد من الأسماء، أو تمحو البائد منها، لتميز ذاتَها من بقي الطبقات ومن الشائع من الأسماء، ثم تتسع الدوائر نحو الطبقات الدنيا مبتعدةً عن المركز. أمَّا على المستوى المجالي، فتبقى المدينة هي مركز الدوائر المتسعة: تنتج الأسماء وتدفعها إلى دائرة القرية، ثم إلى دائرة الأرياف، حيث تتلاشى الأسماء في الهامش مع الدوائر المتّسعة.
وقد لاحظتُ في الفترة الأخيرة، وأنا أعيش في قرية من ريف المنوفية، أن ناسها البسطاء قد تأثّروا بأسماء شخصيات المسلسلات التركية والهندية، وأخذوا يسمّون أبناءهم بها، فكثرت عندنا أسماء مثل: أيان، كيان، رفيف، مهنَّد، إيلين، سيلين، سيليا، عدنان، نهال، كاتيا. وهو تقليدٌ لا أراه محمود العاقبة، وقد يمثل تهديدًا للهوية المصرية والعربية على المدى البعيد.
وهناك من يقولون إن علاقة الاسم بالإرث العائلي لم تعد خافية على أحد؛ فحين يحمل المولود الجديد اسم جَدِّه يكون دلالةً على التواصل بين الأجيال في العائلة الواحدة، كما أن العلاقة بين الاسم والشخصية لم تعد مثار جدل، ولا غرابة في أن يطلب المشعوذون اسم الشخص واسم أمّه لمعرفتهم المسبقة بهذه العلاقة التي تلخص السمات الأساسية للشخصية.
إنّ القول بأن الاسم هو مجرد رامزٍ أو دالٍّ يبقى منقوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الميكانيزمات الداخلية للشخص والإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه، فالاسم مكوِّنٌ أساسيٌّ من مكونات الشخصية أو هو أهمّها؛ حتى أن الطفل يعملُ على أن يكون صورة مطابقة لاسمه.
ومنذ تسعين سنة (يناير/ جانفي 1935) نشرت مجلة "الهلال" مقالًا للأستاذ "أمير بقطر" عن "فلسفة الأسماء"، ذهب فيه إلى أن الاعتزاز بالأسماء منشؤه غريزة الحيازة والاستيلاء على الأشياء وامتلاكها بغير شريك، كالمال والحيوان والمتاع والبنين والزوجة. ومع أن الأسماء لا ثمن لها، وهي ملك مشاع بين الجميع، فإن الناس يحرصون عليها ويمانعون في أمر تغييرها، لما يجدون فيها من الإيناس بعد أن ألِفوها وألِفَ الغيرُ معرفتَهم بها. ويمانع كثير من الدول في تغيير أسماء الأفراد بغير سبب جوهري.
ولا يزال أصل هذه الغريزة واضحًا بين القبائل والأمم التي تعيش على الفطرة؛ فإن الجار احترامًا لجاره والصديق احترامًا لصديقه لا يسمّي مولوده الجديد باسم جاره أو صديقه أو ابن أحدهما، إبقاءً لما بينهما من حق الجوار والصداقة. وإذا مات أحدُ هؤلاء امتنع معارفُه عن ذكر الأسماء المماثلة لاسم الميت خشية أن يكون في ذكرها تجريح لأهل الميت. ولا تزال هذه العادةُ مشاهدةً في فلَّاحي مصر، وقد يتخاصمون ويتقاتلون إذا لم يُحرَص على هذه العادات. ومن هذا يتبيَّن أن ما ذكره "شكسبير" في إحدى رواياته من الاستفهام الإنكاري في قوله: "ما أهميةُ الاسم؟" (What's in a name?) لا يتفق مع الواقع.
وقد سمعت إحدى السيّدات في قريتنا وهي تحذِّر ابنتها من أن تذكر اسمها لأحد، وكأنه سيخطفها إذا عرفه. وأذكر أن رجلًا مُسِنًّا سأل فتاةً صغيرة عن اسمها أو اسم أبيها، فقالت له في لهجة غاضبةٍ متحدِّية: "مِش عارفة.. وانت ما لَك انت؟؟"!.
الأسماء المُستعارة في الأدب العربي
هذه ظاهرة عرفها الأدب العربي، وهي موجودةٌ في الآداب العالمية أيضًا، وبخاصةٍ في العصر الحديث، وقد عالجها الأستاذ "يوسف أسعد داغر" في (مجلة الأديب، أفريل 1948) وذهب إلى أن الكاتب يعمد إلى التستّر تحت اسمٍ مستعارٍ مدفوعًا إلى ذلك بلونٍ من الأحاسيس والمشاعر الدقيقة مثل (الحشمة والأدب)، وقد يكون الدّاعي إلى التستر مركز الكاتب في الهيئة الاجتماعية والمنزلة المرموقة التي يحتلها في السلَّم الاجتماعي، كأن يكون، من رجال الدين أو الدنيا أو من رجال الجيش أو القضاء البارزين، فيرون أن الاعتصام بالتّعمية أدعَى لهم إلى التعبير عمّا يجول في الخاطر من رأي جديدٍ أو فكرٍ طريف.
وقد يحمل الكاتب على التستر تحت اسمٍ مستعار بواعثُ أخرى، منها أن يكون اسمه أو شهرته، أو كنيته، باعثًا على الاستهجان أو المجون أو العبث، فيطلِّق الكاتب اسمَه الحقيقي ليتلبَّسَ باسم جديد. والجنسُ قد يكون باعثًا للكاتب على تغيير اسمه، فهنالك نساء كاتبات شهيرات برزن في عملهن الأدبي تحت اسمٍ مستعار من أسماء الرجال وعُرِفن به، كما هي الحال مع "جورج صاند" في الأدب الفرنسي.
قد يكون المؤلف سيِّدًا كبيرًا في بني قومه، فلا يرضيه أن يتنزّل إلى مصاف الكَتبة ومهنة الكتابة، وهي حرفة ينظرون إليها بإشفاق، فيرون أن يتنكّروا للحقيقة بأسماء مستعارة. وقد يكون المجد الباطل باعثًا على التستّر وراء اسم مستعار؛ فإذا ما لاقى الكتاب النجاحَ وشقّ طريقه إلى الجمهور وأقبل عليه القرّاء يتلقفونه، برز الكاتب الحقيقي وحسر عن اسمه وكنيته.
ويتيح الاسم المستعار (assumed name) للكاتب أن يقول كل ما يريده بصراحةٍ تامة، دون أن يخشى ردّة فعل المجتمع الذي لا يفرّق في الخلق الأدبي بين الخيال والتخيّل والواقع. وكثيرًا ما يدفع الاسم الحقيقي لكُتّاب بارزين أن يتحفظوا في كلامهم، ويتردّدوا في تعبيراتهم، وربما في أفكارهم، مراعاةً لتقاليد المجتمع وحفاظًا على مكانتهم الأدبية والثقافية.
هذه هي الأسباب العامة التي قد يعتصم الكاتب بأحدها، أو بأكثر من واحدٍ منها، لكتم حقيقة اسمه وهويته فيتخفَّى وراء اسمٍ مستعار. ومن يتتبّع تاريخ الأدب المعاصر في الآداب العالمية تبدَّى له من ذلك أمثلة عديدة للأسماء المستعارة، يجد تحت كل واحدٍ منها الدافعَ الذي حدا بالكاتب لإيثار الاسم المستعار.
وفي الأدب العربي المعاصر تجارب كثيرة للمؤلفين بأسماء مستعارة، لعل أشهر تجربة في هذا المجال هي لـ "أدونيس"، الذي اختفى اسمه الحقيقي "علي أحمد سعيد"، أما "أنسي الحاج" فكتب بعدة أسماء منها "سراب العارف" و"عابر"، وكتب "توفيق يوسف عواد" باسم "حمّاد"، و"فؤاد حداد" باسم "أبو الحن"، و"عائشة عبد الرحمن" باسم "بنت الشاطئ"، و"مَلَك حفني ناصف" باسم "باحثة البادية"، والشاعرة "عائشة أرناؤوط" باسم "عشتار"، وأصدر "رئيف خوري" كتيِّبًا عن فلسطين باسم "الفتى العربي"، وكتب "غسان كنفاني" مقالات باسم "فارس فارس"، واختار الروائي "حسن داود" اسمه هذا، بدلًا من اسمه الحقيقي "حسن زبيب"، وكتب "إلياس خوري" باسم "خليل أيوب" و"مروان العاصي"، وكتب "بشارة عبد الله الخوري" باسم "الأخطل الصغير"، كما وقعت "مــاري إليـــاس زيــــادة"، باسم "كنار" و"ماريا" و"مي زيادة". وقد وضع الأستاذ "يوسف أسعد داغر" معجمًا كبيرًا في هذا الموضوع، يقع في ثلاثمائة صفحة، سمَّاه (معجم الأسماء المستعارة وأصحابها، لا سيما في الأدب العربي الحديث"، فليرجع إليه من يشاء.
ويلاحظ أن المرأة الأديبة تلجأ إلى الاسم المستعار أكثر من الرجل، يدعوها إلى ذلك أحيانًا خوفُها من أن تكون تجربتها الإبداعية قاصرة، فهي تحتمي بالاسم المستعار لتكتشف مدى رضى المجتمع عن إنتاجها، لا سيما أن المرأة مرهفة الحس، تضيق بالنقد الذي قد يضع حدًّا لطموحها الأدبي. كذلك كان من أسباب هذا التستر تقاليد المجتمعات المحافظة التي ترى أن اسم الأسرة حقٌّ مشتركٌ للأسرة، لا يجوز مسُّه أو التفريط فيه.
فنَّانون بأسماء مستعارة
أما في مجال التمثيل والغناء، فإن الأسماء المستعارة لكبار النجوم والمشاهير أكثر من نحصيها هنا، ولكنني أذكر على سبيل المثال أن "نجيب الريحاني" اسمه الأصلي هو "نجيب إلياس ريحانة"، و"تحية كاريوكا" اسمها الأصلي "بدرية محمد كريم"، و"عمر الشريف" اسمه الأصلي "ميشيل ديمتري شلهوب"، و"راقية إبراهيم" اسمها الأصلي "راشيل إبراهام ليفي"، و"شادية" اسمها الحقيقي "فاطمة شاكر"، و"صباح" اسمها الحقيقي "جانيت جورج فغالي"، و"هدى سلطان" اسمها الحقيقي "بهيجة عبد العال الحو"، وهي أخت "محمد فوزي"، أما "أحمد رمزي" فاسمه الحقيقي "رمزي محمود بيومي"، و"رجاء الجداوي" اسمها الأصلي "نجاة علي حسين"، و"نجلاء فتحي" اسمها الأصلي "فاطمة الزهراء حسين"، و"عبد الحليم حافظ" اسمه الحقيقي "عبد الحليم شبانة"، و"شريفة فاضل" اسمها الحقيقي "فوقية محمود أحمد ندا"، و"فيروز" اسمها الحقيقي "نهاد وديع حداد"، و"مديحة يسري" اسمها الأصلي "هنومة حبيب خليل"، و"ليلى طاهر" اسمها الحقيقي "شرويت مصطفى فهمي"، و"نور الشريف" اسمه الحقيقي "محمد جابر"..
غرائبُ الأسماء وطرائفُها
كان شائعًا في حواري القاهرة وأحيائها الشعبية أن يختار كثيرٌ من الناس لأبنائهم أسماء غريبة، قد تبدو لنا مضحكةً هذه الأيام، وكانوا يفعلون ذلك ليطيلوا أعمارهم ويدفعوا العين عنهم؛ ومن أمثلة ذلك: دقدق، حُكشة، شَكعه، بلبع، سَنْكحلو، زَمْلُوط، زعطوط، شحَّات، زعزوع، كعبلها، بخاطرها، شنن، زِنْباعي، جُعلُص، بُقلُظ، دحروج، زعرب، شرشومة، بحبح، حزنبل، بظاظة، كرشة، عيطة، حتاتة، عاشور، حرحش، لِهيطة، قزامل، زُعرُب..
ويروي لنا الدكتور "شكري عيَّاد" أن امرأة سكنَت حارتهم، وكان كلُّ أطفالها يموتون (ذلك قبل تقدُّم الطب واختراع الأمصال والمضادات الحيوية) ثم رُزِقَت بنتًا فسمَّتها "خيشة"، كي تقتحمها عيون الناس فلا تصاب بالحسد، وعاشت الطفلة، ورُزِقت أمُّها بمولودٍ ذكرٍ فسمَّته "شوال" للسبب نفسِه.
ويَدلُّ كثيرٌ من ألقاب العائلات على أصل مواطنها الأولى مثل: الشامي، المغربي، التركي، الهندي.. كما أن منها ما يُشعِر بحرفة أو صناعة أو وظيفة أو مركز اجتماعي خاص، مثل: الجعيدي، السحار، البستاني، الجنايني، الجّمَّال، الخادم، الكنفاني، الفسخاني، المستكاوي، الشبكشي، الهجان، الكحكي، الجزار، الفولي، القزّاز، العسكري، الزلباني، الحنّاوي، السكاكيني، الجندي، العمدة، الأفندي، السحرتي، المراكبي، الطحَّان..
ولبعض الألقاب غرابتها أيضًا: فمنها ما يدل على معانٍ غريبة، ربما كانت ثقيلة أو مستهجنة، ولكنها اشتهرت، فأصبحت سهلةً ذائعةً مقبولة، مثل: البِلِط، الجحش، البرش، أبو شناف، حفيشة، عجور، شبايك، الهبَّاب..
وبمناسبة الألقاب أذكر أن العرب لم يكونوا يهتمّون بالألقاب أو يلتفتون إليها، ولم تظهر فيهم إلا منذ بداية الدولة العباسية بعد اختلاطهم بالفرس وغيرهم من الأمم التي كانت تمجِّد السلطان وتعدُّه ظلَّ الله في أرضه؛ فكان لخلفاء بني العباس ألقابٌ أطلقوها على أنفسهم مثل: السفاح، المنصور، الهادي، المهدي، الرشيد، الأمين، المأمون، المعتصم، الواثق، المتوكِّل، المستنصر. وسار على نهجهم الأمويون في الأندلس ومن جاء بعدهم من ملوك الطوائف، حتى انتهى أمرُ الألقاب في عهد ملوك الطوائف إلى أن صارت موضع سخرية ومجال استهزاء، على حد قول شاعرهم "الحسن بن رشيق القيرواني:":
ممّا يُزَهِّــدُني فـي أرضِ أندلسٍ -- أسماءُ مُعتَـــضدٍ فيـــــها ومُعتَمِدِ
ألقابُ مملكةٍ في غيرِ موضعِها -- كالهِرِّ يَحكِي انتفاخًا صَولَة الأسدِ
وكان أكثر من استعملَ الألقاب في الممالك الإسلامية هم: بنو بويه، الفاطميون، الأيوبيون، المماليك، سلاطين آل عثمان، وكذلك أمراؤهم ووزراؤهم ورجال دولتهم، فقد أسرف هؤلاء جميعًا في حمل الألقاب حتى غدت لهم كالأغلال لا ينفكُّون عنها.
وكثيرٌ من الأسماء كنيات كُنِيَ بها أصحابها في الأصل لصفة خاصة، ومن أمثلة ذلك: أبو شادوف، أبو قورة، أبو لبدة، أبو طاقية، أبو الروس، أبو الغيط، أبو كرش، أبو سنة، أبو دراع، أبو ريشة، أبو ليفة، أبو لحاف، أبو سيف، أبو دومة، أبو لقمة، أبو جبل، أبو اخربها.
ولا أظن أن المصريين منفردون وحدهم بهذه الأسماء الغريبة والمضحكة؛ فهناك ما يماثلها في كافة دول الأرض بلغات أصحابها، وهو ما يدلُّ على أن العقل البشري يفكِّر على نمطٍ واحدٍ مهما بعدت الشُّقَّةُ واتّسعت المسافة. ومن الواضح أن هذه الأسماء قد انقرضت تمامًا، أو أنها في طريقها إلى الانقراض؛ فلم يعد الناس، إلا نادرًا جدًّا، يُسَمُّون أبناءَهم: (أم الخير، ست أبوها، زنوبة مِهاود، مِقاوي، شمروخ) وصار الاتجاه إلى الأسماء الخفيفة الرشيقة في لفظها، مثل: (تامر، لؤي، أنس، سوسن، هند، ريم، نورهان، ياسمين).
ولعلَّ هذا مما يبشِّرُ بالخير ويُوحِي بالجَمال، في هذه الأيام التي قلَّ فيها الخيرُ وعَزَّ فيها الجَمال!
 عمّار بلخضرة
أسماء فتيات لبلدان ومُدن.. وأخرى بلا معنى!
الأسماء العربية بين الأصالة والحداثة
عمّار بلخضرة (كاتب وناقد من تونس)
الأسماء عناوين أصحابها ودوالٌّ عليهم حتّى وإن تشابهت بين الناس وهو أمر مألوف عندنا وعند كلّ الشعوب تقريبا. على أنّ الإنسان في كلّ العصور والأمصار يهيم باسمه ويعشقه عشقا فطريّا أحيانا لأنّه دليل عليه في حياته وأثر منه بعد مماته، بل هو كما يرى أحد المختصين في دراسة إنتربولوجيا الأسماء "شفرته السرّية في التعامل مع الأخرين". وليس المهمّ ـ حسب تصوّر بعض الدارسين لمسائل الهويّة ـ أن يُحبّ الإنسان اسمه أو يكرهه لأنّ اختيار الاسم ليس أمرا شخصيّا ذاتيًّا وإنّما يتعدّاه إلى شخوص آخرين قد تكون لهم تبريرات ما في اختيار ذاك الاسم (سنعود إلى ذلك لاحقا)، على أنّنا في العصر الحديث أعدنا النّظر في هذه المسألة وصار بإمكان الإنسان أن يُسمّي نفسه من جديد إذا لم يرق له اسمه الذي سُمّي به من قبل أبويه، فالقانون يسمح له أن يُعيد تسمية نفسه وِفق حكم قضائيّ يُصدره القضاء بطلب منه. فما العلاقة بين الاسم والمسمّى عند العرب عبر التّاريخ؟
الاسم عند العرب بين الجاهليّة والإسلام
يعتقد الكثير من المِؤرّخين والباحثين الإنتربولوجيين أنّ العرب اختاروا أسماءهم انطلاقا من بيئتهم التي كانوا ينتمون إليها، لذلك أنت قادر من خلال ذلك على تبيُّن خصائص تلك البيئة وتفاصيلها، بل إنّك مُدرك لتفاصيل حياة أفرادها وسماتهم وطريقة عيشهم. ولذلك قال "القلقشندي" (ت 821هـ/ 1418م) في كتابه "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب": "غالب أسماء العرب منقولة عما يدور في خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه، إمّا من الوحوش كأسد ونمر، وإمّا من النّبات كنَبت وحنظلة، وإمّا من الحشرات كحيّة وحنش، وإمّا من أجزاء الأرض كفِهر وصَخر".
الأثر الإسلامي في الأسماء
ولعلّ المتتبّع لواقع العرب بعد الإسلام، يجد أنّ الدّين الجديد قد غيّر هذا الواقع في مستويات عدّة تغييرا جذريّا، من ذلك أثره في الأسماء وهو أمر لافت للانتباه، ويرى المؤرّخون العرب وفقهاؤهم أنّ للنبيّ (صلى الله عليه وسلّم) فلسفةٌ خاصّة في تسمية الأعلام من المواليد الجدد وحتّى من الكبار الذين دخلوا في الإسلام. فتغيير الاسم أو تبديله سلوك نبويّ له رمزيّته فإذا أسلم الإنسان فكأنه وُلد من جديد فاستحقّ اسمًا جديدًا، على أنّ هذه الأسماء الجديدة تخرج من دائرة الأسماء القديمة ذات الدلالات الخشنة والقاسية أو التي تحمل دلالات غير محمودة أو فَألًا سيّئا. وقد يكون الاسم المُغيَّر - بعد إسلام صاحبِه - من الأسماء التي لها دلالة وَثَنِيّة، مثل عبد العزى وعبد مناف، وقد ذكر هشام بن محمد بن الكلبي (ت 204هـ/819م) - في كتابه "كتاب الأصنام" - أنه "كانت العَرَبُ تُسَمِّي بِأَسمَاء يُعَبِّدونها، لا أَدرِي أعبَّدُوهَا للأصنام أم لَا؟ منها: عبد يَا ليل، وعبد غنم، وعبد كلال، وعبد رِضا!".
وقد أشار "أبو داود" إلى معانٍ أخرى تُجمِل الفلسفة النبويّة في اختيار الأسماء، وذلك في: "باب في تغيير الاسم القبيح"؛ قال فيه: "وغيَّرَ النبي (صلى الله عليه وسلم) اسمَ العاصِ وعزيزٍ وعَتَلَةَ وشَيطانٍ والحَكَمِ وغُرابٍ وحُبابٍ، وشهابٍ فسمّاه هشامًا، وسمّى المُضْطَجِعَ المُنْبَعِثَ".
وكان للعرب قبل الإسلام وبعده ولَعٌ كبير بالكُنَى والكنية كما قال "الجرجاني": ما صُدِّر بأبٍ أو أمٍّ أو ابن أو بنت نحو: أبو عمرو وأم كلثوم وابن آوى وبنت وردان. وقال "ابن الأثير": لما كان أصل الكنية أن تكون بالأولاد تعيّن أن تكون بالذين ولدوهم كأبي الحسن في كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن لم يكن له ابن وكان له بنت كنّوه بها. على أنّ العرب كانوا يتفاءلون خيرا بالكُنى كما يفعلون بالأسماء ويتناقلونها ويتوارثونها، فقد قال "الجاحظ": "وعلى ذلك سمّت الرعية بنيها وبناتها بأسماء رجال الملوك ونسائهم، وعلى ذلك صار كلّ عليّ يُكنّى بأبي الحسن، وكل عمر يكنّى بأبي حفص، وأشباه ذلك".
وقد عرف التاريخ الإسلامي كُنًى معيّنة ارتبطت بأسماء معيّنة أيضا صارت تُطلق على من يتسمّى بتلك الأسماء، فمن اسمه محمد يكنّى عادة: أبا القاسم، وإن لم يكن له ولد اسمه القاسم، وإبراهيم يُكنّى أبا إسحاق أو أبا إسماعيل، وإسحاق: أبا يعقوب، وعبد الملك: أبا الوليد، وزيد: أبا أسامة، وهكذا... وقد يُشتقّ للمرء من معنى اسمه كنية تعبّر عن حاله كأبي الطيّب لمن اسمه طاهر لما بين الطُّهر والطّيب من التناسب، وكذا أبو الغارات للمجاهد وذو القرنين لعظيم الملك والجاحظ لجحوظ عينيه والمعرّي نسبة إلى قريته معرّة النعمان والأصفهاني نسبة إلى أصله الأصفهاني..
على أنّ غرابة الكنية قد تتسبّبُ في شهرة الإنسان أحيانا وتميّزه عن غيره، من ذلك ما ذكره "أبو حيان الأندلسي" (ت 745هـ/1344م) حينما قال: "إذا كانت الكنية غريبة لا يكاد يشترك فيها أحد مع من تكنّى بها في عصره فإنه يطير بها ذِكرُه في الآفاق، وتتهادى أخبارَه الرِّفاق.. كما جرى في كنيتي بـ "أبي حيّان" واسمي محمّد، فلو كانت كنيتي أبا عبد الله أو أبا بكر - ممّا يقع فيه الاشتراك - لم أشتهر تلك الشهرة!".
الأسماء في عصرنا..
إنّ الباحث في أصول الأسماء العربية في عصرنا الحاضر يرى أنّها قد تأثّرت بعوامل مختلفة متباينة منها ما هو جغرافي ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو حضاري. وكثيرٌ من الدراسات وقفَت على هذا التنوّع لتستنتج الكثير من أشكال الثقافات السائدة في المجتمعات والتقاليد التي تحكم الأسماء والمسمّيات وتفرضها على العامة.. فأنت في الخليج العربيّ وفي بقاع كثيرة من بلاد الشام ما زلت تصطدم في أسمائهم بتلك الكنى التي ألفناها عند العرب القدامى إمّا تيمّنًا بهم أو لاعتقادهم أنّ ذلك من دواعي السّير على نهج أهل السنّة والجماعة.. فمن اسمه عليّ يُنادى بأبي الحسين أو أبي الحسن حتّى وإن لم يكن متزوجا أصلا، والأمر ذاته بالنسبة إلى من اسمه محمّد (أبو القاسم) وإبراهيم (أبو إسحاق).. ولعلّ هذا التصوّر للأسماء متّصل بصفة جليّة بعادات أهل المشرق في الملبس (الدّشداشة والإزار) والأكل (استعمال اليد مثلا)..
بيد أنّ المُتّجه غربًا قبلة أهل المغرب العربي، يقع على تقاليد أخرى في التّسمية منها ما يتّصل بالعادات والتقاليد التي ساهم الاستعمار في إرسائها تكريسا للجهل والتخلّف من قبيل تسميتهم لـ "سالم" حتّى يسلم من الموت لاسيما إذا كان الزوجان لم يقدرَا على الحفاظ على أبنائهم السابقين، وكذلك "عائشة" بالنسبة إلى البنت حتى تعيش وتكبر بين أبويها وأسرتها.. ومنها ما يُنسب إلى وليّ صالح تيمّنا به وتبرّكا كعبد القادر (نسبة إلى سيدي عبد القادر بأحد المدن التونسية) وعبد السّلام، وعبد النبيّ وغير ذلك الكثير.. فقد كان الناس يؤمنون كثيرا بالأولياء الصالحين ويُصدّقون بشدّة المُشعوذين الذين كانوا يقترحون تلك الأسماء ويفرضونها على الآباء والأمّهات. وقد أحدث ذلك في الكثير من الأحيان شرخا نفسيّا هائلا على الأبناء الذين ظلّوا يُعانون من تلك التسميات التي جعلتهم في أحيان كثيرة مَدعاة للسخرية والتّنمّر..
ومن الأسماء ما كان رغبة من الأب أو الأمّ في الرّيف خصوصا في تخليد أسماء آبائهم أو أمّهاتهم أو حتى أجدادهم فيسمّون أبناءهم بأسماء قد تبدو للجيل الحاضر أسماء قديمة تقلقهم وتزعجهم وتجعلهم مجالا للتنمّر وأحيانا للصّدام مع آبائهم، بل إنّ العديد منهم يلجؤون إلى القضاء لتغيير أسمائهم بحكم قضائي وهذا ممكن على الأقل في البلاد التونسية على سبيل المثال.
بيد أنّ تطوّر الحياة وتحوّل مفرداتها العلمية والحضارية وولوج العالم في متاهات العلم وتكنولوجيا الاتصالات جعل كثيرا من المفاهيم تتبدّل بين الناس وحياتهم، ما أدّى إلى تنمية مواهبهم الذاتية في ابتكار أسماء جديدة لها علاقة بالحياة الجديدة ومفرداتها المتنوعة، فقد لجأ أهل المدن إلى مسميات حديثة كأسماء دول عربية وآسيوية وغربية خاصّة عند الإناث لدواع جماليّة (مهدية، توزر، بغداد، تونس، آسيا، هند، تركية، باريس..)، كما أن وسائل الإعلام - ومنها التلفاز والسينما - أسهمت في ذيوع أسماء فنّانات عربيات وأجنبيات مكّنت ابن المدينة من أن يتجاذبها كتسميات لمواليده الجديدة لاسيما من الإناث (شريهان ـ نانسي ـ هيفا ـ شريفة ـ أليسا ـ ماجدولين ـ ساندرا ـ نجلاء...). كما نجد فئة أخرى تنتقي من الأسماء ما ظهر حديثا لا سيما في تلك المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني المُصوّرة التي يتأثّرون بها ويُعجبون بأبطالها فيُسمّون أبناءهم الجدد على اسم أولئك الأبطال كمهنّد ونور في إحدى المسلسلات التركية الشهيرة... غير أنّهم أحيانا يسمّون أبناءهم بأسماء غير عربية، يُحاول الواحد منهم البحث في مرجعياتها العربية والدّينيّة فلا يلقى لها أصولا من قبيل: شريهان ونانسي وإليسا وسندرا وماجدولين... وتلك مشكلة يُعاني منها الكثير من الأبناء في العصر الحاضر ، فيُحسّ الواحد منهم بالغربة والوحشة وهو يعيش باسم لا علاقة له بالبيئة التي يعيش فيها وينتمي إليها.
وصفوة القول، فإنّ الأسماء والمسمّيات في عالمنا العربي تتنوّع من مكان إلى آخر حضريًّا وريفيا، بل إنّها تعيش صداما قويا بين الأسماء ذات المرجعية الغربيّة التي طرأت على مجتمعاتنا الحديثة بسبب الغزو الثقافي والحضاري للغرب، والأسماء ذات المرجعية الدينيّة بسبب أنّ المنطقة العربية هي منطقة إسلامية ضاربة في العمق التاريخي للدين الإسلامي. ولعلّ هذا الصّدام يُطرح في سياق صدام أوسع وأكبر حينما يتحوّل إلى مضمون حضاريّ ثقافيّ نراه في الصراع بين حضارة شرقية وأخرى غربية تُلقي بظلالها على مستويات الحياة المختلفة لا يمكن أن نُخرج منها مسألة التّسمية وأثرها في الأجيال الراهنة.
عمّار بلخضرة
أسماء فتيات لبلدان ومُدن.. وأخرى بلا معنى!
الأسماء العربية بين الأصالة والحداثة
عمّار بلخضرة (كاتب وناقد من تونس)
الأسماء عناوين أصحابها ودوالٌّ عليهم حتّى وإن تشابهت بين الناس وهو أمر مألوف عندنا وعند كلّ الشعوب تقريبا. على أنّ الإنسان في كلّ العصور والأمصار يهيم باسمه ويعشقه عشقا فطريّا أحيانا لأنّه دليل عليه في حياته وأثر منه بعد مماته، بل هو كما يرى أحد المختصين في دراسة إنتربولوجيا الأسماء "شفرته السرّية في التعامل مع الأخرين". وليس المهمّ ـ حسب تصوّر بعض الدارسين لمسائل الهويّة ـ أن يُحبّ الإنسان اسمه أو يكرهه لأنّ اختيار الاسم ليس أمرا شخصيّا ذاتيًّا وإنّما يتعدّاه إلى شخوص آخرين قد تكون لهم تبريرات ما في اختيار ذاك الاسم (سنعود إلى ذلك لاحقا)، على أنّنا في العصر الحديث أعدنا النّظر في هذه المسألة وصار بإمكان الإنسان أن يُسمّي نفسه من جديد إذا لم يرق له اسمه الذي سُمّي به من قبل أبويه، فالقانون يسمح له أن يُعيد تسمية نفسه وِفق حكم قضائيّ يُصدره القضاء بطلب منه. فما العلاقة بين الاسم والمسمّى عند العرب عبر التّاريخ؟
الاسم عند العرب بين الجاهليّة والإسلام
يعتقد الكثير من المِؤرّخين والباحثين الإنتربولوجيين أنّ العرب اختاروا أسماءهم انطلاقا من بيئتهم التي كانوا ينتمون إليها، لذلك أنت قادر من خلال ذلك على تبيُّن خصائص تلك البيئة وتفاصيلها، بل إنّك مُدرك لتفاصيل حياة أفرادها وسماتهم وطريقة عيشهم. ولذلك قال "القلقشندي" (ت 821هـ/ 1418م) في كتابه "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب": "غالب أسماء العرب منقولة عما يدور في خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه، إمّا من الوحوش كأسد ونمر، وإمّا من النّبات كنَبت وحنظلة، وإمّا من الحشرات كحيّة وحنش، وإمّا من أجزاء الأرض كفِهر وصَخر".
الأثر الإسلامي في الأسماء
ولعلّ المتتبّع لواقع العرب بعد الإسلام، يجد أنّ الدّين الجديد قد غيّر هذا الواقع في مستويات عدّة تغييرا جذريّا، من ذلك أثره في الأسماء وهو أمر لافت للانتباه، ويرى المؤرّخون العرب وفقهاؤهم أنّ للنبيّ (صلى الله عليه وسلّم) فلسفةٌ خاصّة في تسمية الأعلام من المواليد الجدد وحتّى من الكبار الذين دخلوا في الإسلام. فتغيير الاسم أو تبديله سلوك نبويّ له رمزيّته فإذا أسلم الإنسان فكأنه وُلد من جديد فاستحقّ اسمًا جديدًا، على أنّ هذه الأسماء الجديدة تخرج من دائرة الأسماء القديمة ذات الدلالات الخشنة والقاسية أو التي تحمل دلالات غير محمودة أو فَألًا سيّئا. وقد يكون الاسم المُغيَّر - بعد إسلام صاحبِه - من الأسماء التي لها دلالة وَثَنِيّة، مثل عبد العزى وعبد مناف، وقد ذكر هشام بن محمد بن الكلبي (ت 204هـ/819م) - في كتابه "كتاب الأصنام" - أنه "كانت العَرَبُ تُسَمِّي بِأَسمَاء يُعَبِّدونها، لا أَدرِي أعبَّدُوهَا للأصنام أم لَا؟ منها: عبد يَا ليل، وعبد غنم، وعبد كلال، وعبد رِضا!".
وقد أشار "أبو داود" إلى معانٍ أخرى تُجمِل الفلسفة النبويّة في اختيار الأسماء، وذلك في: "باب في تغيير الاسم القبيح"؛ قال فيه: "وغيَّرَ النبي (صلى الله عليه وسلم) اسمَ العاصِ وعزيزٍ وعَتَلَةَ وشَيطانٍ والحَكَمِ وغُرابٍ وحُبابٍ، وشهابٍ فسمّاه هشامًا، وسمّى المُضْطَجِعَ المُنْبَعِثَ".
وكان للعرب قبل الإسلام وبعده ولَعٌ كبير بالكُنَى والكنية كما قال "الجرجاني": ما صُدِّر بأبٍ أو أمٍّ أو ابن أو بنت نحو: أبو عمرو وأم كلثوم وابن آوى وبنت وردان. وقال "ابن الأثير": لما كان أصل الكنية أن تكون بالأولاد تعيّن أن تكون بالذين ولدوهم كأبي الحسن في كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن لم يكن له ابن وكان له بنت كنّوه بها. على أنّ العرب كانوا يتفاءلون خيرا بالكُنى كما يفعلون بالأسماء ويتناقلونها ويتوارثونها، فقد قال "الجاحظ": "وعلى ذلك سمّت الرعية بنيها وبناتها بأسماء رجال الملوك ونسائهم، وعلى ذلك صار كلّ عليّ يُكنّى بأبي الحسن، وكل عمر يكنّى بأبي حفص، وأشباه ذلك".
وقد عرف التاريخ الإسلامي كُنًى معيّنة ارتبطت بأسماء معيّنة أيضا صارت تُطلق على من يتسمّى بتلك الأسماء، فمن اسمه محمد يكنّى عادة: أبا القاسم، وإن لم يكن له ولد اسمه القاسم، وإبراهيم يُكنّى أبا إسحاق أو أبا إسماعيل، وإسحاق: أبا يعقوب، وعبد الملك: أبا الوليد، وزيد: أبا أسامة، وهكذا... وقد يُشتقّ للمرء من معنى اسمه كنية تعبّر عن حاله كأبي الطيّب لمن اسمه طاهر لما بين الطُّهر والطّيب من التناسب، وكذا أبو الغارات للمجاهد وذو القرنين لعظيم الملك والجاحظ لجحوظ عينيه والمعرّي نسبة إلى قريته معرّة النعمان والأصفهاني نسبة إلى أصله الأصفهاني..
على أنّ غرابة الكنية قد تتسبّبُ في شهرة الإنسان أحيانا وتميّزه عن غيره، من ذلك ما ذكره "أبو حيان الأندلسي" (ت 745هـ/1344م) حينما قال: "إذا كانت الكنية غريبة لا يكاد يشترك فيها أحد مع من تكنّى بها في عصره فإنه يطير بها ذِكرُه في الآفاق، وتتهادى أخبارَه الرِّفاق.. كما جرى في كنيتي بـ "أبي حيّان" واسمي محمّد، فلو كانت كنيتي أبا عبد الله أو أبا بكر - ممّا يقع فيه الاشتراك - لم أشتهر تلك الشهرة!".
الأسماء في عصرنا..
إنّ الباحث في أصول الأسماء العربية في عصرنا الحاضر يرى أنّها قد تأثّرت بعوامل مختلفة متباينة منها ما هو جغرافي ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو حضاري. وكثيرٌ من الدراسات وقفَت على هذا التنوّع لتستنتج الكثير من أشكال الثقافات السائدة في المجتمعات والتقاليد التي تحكم الأسماء والمسمّيات وتفرضها على العامة.. فأنت في الخليج العربيّ وفي بقاع كثيرة من بلاد الشام ما زلت تصطدم في أسمائهم بتلك الكنى التي ألفناها عند العرب القدامى إمّا تيمّنًا بهم أو لاعتقادهم أنّ ذلك من دواعي السّير على نهج أهل السنّة والجماعة.. فمن اسمه عليّ يُنادى بأبي الحسين أو أبي الحسن حتّى وإن لم يكن متزوجا أصلا، والأمر ذاته بالنسبة إلى من اسمه محمّد (أبو القاسم) وإبراهيم (أبو إسحاق).. ولعلّ هذا التصوّر للأسماء متّصل بصفة جليّة بعادات أهل المشرق في الملبس (الدّشداشة والإزار) والأكل (استعمال اليد مثلا)..
بيد أنّ المُتّجه غربًا قبلة أهل المغرب العربي، يقع على تقاليد أخرى في التّسمية منها ما يتّصل بالعادات والتقاليد التي ساهم الاستعمار في إرسائها تكريسا للجهل والتخلّف من قبيل تسميتهم لـ "سالم" حتّى يسلم من الموت لاسيما إذا كان الزوجان لم يقدرَا على الحفاظ على أبنائهم السابقين، وكذلك "عائشة" بالنسبة إلى البنت حتى تعيش وتكبر بين أبويها وأسرتها.. ومنها ما يُنسب إلى وليّ صالح تيمّنا به وتبرّكا كعبد القادر (نسبة إلى سيدي عبد القادر بأحد المدن التونسية) وعبد السّلام، وعبد النبيّ وغير ذلك الكثير.. فقد كان الناس يؤمنون كثيرا بالأولياء الصالحين ويُصدّقون بشدّة المُشعوذين الذين كانوا يقترحون تلك الأسماء ويفرضونها على الآباء والأمّهات. وقد أحدث ذلك في الكثير من الأحيان شرخا نفسيّا هائلا على الأبناء الذين ظلّوا يُعانون من تلك التسميات التي جعلتهم في أحيان كثيرة مَدعاة للسخرية والتّنمّر..
ومن الأسماء ما كان رغبة من الأب أو الأمّ في الرّيف خصوصا في تخليد أسماء آبائهم أو أمّهاتهم أو حتى أجدادهم فيسمّون أبناءهم بأسماء قد تبدو للجيل الحاضر أسماء قديمة تقلقهم وتزعجهم وتجعلهم مجالا للتنمّر وأحيانا للصّدام مع آبائهم، بل إنّ العديد منهم يلجؤون إلى القضاء لتغيير أسمائهم بحكم قضائي وهذا ممكن على الأقل في البلاد التونسية على سبيل المثال.
بيد أنّ تطوّر الحياة وتحوّل مفرداتها العلمية والحضارية وولوج العالم في متاهات العلم وتكنولوجيا الاتصالات جعل كثيرا من المفاهيم تتبدّل بين الناس وحياتهم، ما أدّى إلى تنمية مواهبهم الذاتية في ابتكار أسماء جديدة لها علاقة بالحياة الجديدة ومفرداتها المتنوعة، فقد لجأ أهل المدن إلى مسميات حديثة كأسماء دول عربية وآسيوية وغربية خاصّة عند الإناث لدواع جماليّة (مهدية، توزر، بغداد، تونس، آسيا، هند، تركية، باريس..)، كما أن وسائل الإعلام - ومنها التلفاز والسينما - أسهمت في ذيوع أسماء فنّانات عربيات وأجنبيات مكّنت ابن المدينة من أن يتجاذبها كتسميات لمواليده الجديدة لاسيما من الإناث (شريهان ـ نانسي ـ هيفا ـ شريفة ـ أليسا ـ ماجدولين ـ ساندرا ـ نجلاء...). كما نجد فئة أخرى تنتقي من الأسماء ما ظهر حديثا لا سيما في تلك المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني المُصوّرة التي يتأثّرون بها ويُعجبون بأبطالها فيُسمّون أبناءهم الجدد على اسم أولئك الأبطال كمهنّد ونور في إحدى المسلسلات التركية الشهيرة... غير أنّهم أحيانا يسمّون أبناءهم بأسماء غير عربية، يُحاول الواحد منهم البحث في مرجعياتها العربية والدّينيّة فلا يلقى لها أصولا من قبيل: شريهان ونانسي وإليسا وسندرا وماجدولين... وتلك مشكلة يُعاني منها الكثير من الأبناء في العصر الحاضر ، فيُحسّ الواحد منهم بالغربة والوحشة وهو يعيش باسم لا علاقة له بالبيئة التي يعيش فيها وينتمي إليها.
وصفوة القول، فإنّ الأسماء والمسمّيات في عالمنا العربي تتنوّع من مكان إلى آخر حضريًّا وريفيا، بل إنّها تعيش صداما قويا بين الأسماء ذات المرجعية الغربيّة التي طرأت على مجتمعاتنا الحديثة بسبب الغزو الثقافي والحضاري للغرب، والأسماء ذات المرجعية الدينيّة بسبب أنّ المنطقة العربية هي منطقة إسلامية ضاربة في العمق التاريخي للدين الإسلامي. ولعلّ هذا الصّدام يُطرح في سياق صدام أوسع وأكبر حينما يتحوّل إلى مضمون حضاريّ ثقافيّ نراه في الصراع بين حضارة شرقية وأخرى غربية تُلقي بظلالها على مستويات الحياة المختلفة لا يمكن أن نُخرج منها مسألة التّسمية وأثرها في الأجيال الراهنة.
 بسيم عبد العظيم عبد القادر
قراءة في تاريخ وثقافة الأسماء العربية..
د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر)
إنَّ اختيار الأسماء للمواليد من القضايا التي قد تبدو صغيرة وهيّنة، ولكنها كبيرة وخطيرة وقد تؤثّر على مستقبل الأبناء واندماجهم في مجتمعهم، وقد كان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عيه وسلم يغير أسماء بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكان إذا وفد عليه وافد ليعلن إسلامه بين يديه، يسأله عن اسمه، فإن كان اسما مألوفا ولا يسبب لصاحبه حرجا أو أذى أقرَّه عليه، وإن رأى النبي في اسمه وعورة أو ظلالا غير مستحسنة غيَّر اسمه، وقد يستجيب الصحابي ويفرح باسمه الجديد، وقد يفضّل الإبقاء على اسمه فلا ينكر عليه النبي ذلك لأنه شهر بهذا الاسم وعرف به بين أقرانه، وسمّاه به أبوه، ومثال ذلك أنه سأل أحد الصحابة عن اسمه فقال: حَزْن، فقال له النبي بل أنت سهل، فقال يا رسول الله اسمي سمّاني به أبي، ولم يوافق على تغيير اسمه، وقال بعد ذلك لا تزال فينا حزونة.
وكانت للعرب تقاليدها في تسمية أبنائها وعبيدها، وكانت لهم فلسفة في ذلك فتجد بعضهم يسمّون أبناءهم بأسماء الحيوانات المفترسة أو الجبال مثل: أسد ونمر وفهد وصخر، بينما يسمّون عبيدهم بأسماء سهلة ورقيقة، وقد علّلوا ذلك بأنهم إنما يسمون أبناءهم لأعدائهم حتى يلقوا الرعب في قلوبهم، بينما يسمّون عبيدهم لهم مثل سعد وسعيد وغير ذلك من الأسماء السهلة الخفيفة على اللسان وعلى الآذان جميعا.
والأسماء في التراث العربي لها دلالات غنيّة ومعانٍ عميقة ترتبط بالثقافة والتقاليد العربية، فاختيار الأسماء كان يعكس القيم الاجتماعية، والمعتقدات، والأمل في الصفات التي يُراد أن يحملها المولود.
بعض دلالات الأسماء في التراث العربي
بسيم عبد العظيم عبد القادر
قراءة في تاريخ وثقافة الأسماء العربية..
د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر)
إنَّ اختيار الأسماء للمواليد من القضايا التي قد تبدو صغيرة وهيّنة، ولكنها كبيرة وخطيرة وقد تؤثّر على مستقبل الأبناء واندماجهم في مجتمعهم، وقد كان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عيه وسلم يغير أسماء بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكان إذا وفد عليه وافد ليعلن إسلامه بين يديه، يسأله عن اسمه، فإن كان اسما مألوفا ولا يسبب لصاحبه حرجا أو أذى أقرَّه عليه، وإن رأى النبي في اسمه وعورة أو ظلالا غير مستحسنة غيَّر اسمه، وقد يستجيب الصحابي ويفرح باسمه الجديد، وقد يفضّل الإبقاء على اسمه فلا ينكر عليه النبي ذلك لأنه شهر بهذا الاسم وعرف به بين أقرانه، وسمّاه به أبوه، ومثال ذلك أنه سأل أحد الصحابة عن اسمه فقال: حَزْن، فقال له النبي بل أنت سهل، فقال يا رسول الله اسمي سمّاني به أبي، ولم يوافق على تغيير اسمه، وقال بعد ذلك لا تزال فينا حزونة.
وكانت للعرب تقاليدها في تسمية أبنائها وعبيدها، وكانت لهم فلسفة في ذلك فتجد بعضهم يسمّون أبناءهم بأسماء الحيوانات المفترسة أو الجبال مثل: أسد ونمر وفهد وصخر، بينما يسمّون عبيدهم بأسماء سهلة ورقيقة، وقد علّلوا ذلك بأنهم إنما يسمون أبناءهم لأعدائهم حتى يلقوا الرعب في قلوبهم، بينما يسمّون عبيدهم لهم مثل سعد وسعيد وغير ذلك من الأسماء السهلة الخفيفة على اللسان وعلى الآذان جميعا.
والأسماء في التراث العربي لها دلالات غنيّة ومعانٍ عميقة ترتبط بالثقافة والتقاليد العربية، فاختيار الأسماء كان يعكس القيم الاجتماعية، والمعتقدات، والأمل في الصفات التي يُراد أن يحملها المولود.
بعض دلالات الأسماء في التراث العربي
-
الصفات الحميدة: كثيرٌ من الأسماء كانت تُختار لتعبّر عن صفات محبوبة مثل "كريم" الذي يدلّ على الجود والسخاء، و"شجاع" الذي يدل على الشجاعة.
القوة والشجاعة: كانت الأسماء مثل: أسد، ليث، صقر.. تُستخدم للدلالة على القوة والشجاعة، وهي صفات مُحبّبة في المجتمع القَبَلي العربي.
الجمال والطبيعة: أسماء مثل: ورد، زهرة.. وتشير إلى الجَمال والرقّة، بينما "نجم" و"قمر" تعكس الجمال السماوي.
الارتباط الديني: الأسماء مثل: عبد الله، عبد الرحمن، محمد.. تحمل دلالات دينية مرتبطة بالله ورسوله، وهي أسماء شائعة في التراث العربي الإسلامي.
الرجاء والأمل: مثل: أمل، رجاء.. تعبّر عن التطلع نحو مستقبل مشرق، بينما أسماء مثل: سعيد، فرح.. تعبّر عن السعادة والسرور.
الحيوانات والصفات المرتبطة بها: استخدام أسماء الحيوانات كان شائعاً، مثل: فهد، نمر، للإشارة إلى الشجاعة والذكاء وسرعة البديهة.
-
الارتباط بالله وأسمائه الحسنى: الأسماء مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم.. وتشير إلى العبودية لله وتوحيده، وهي من الأسماء المُستحبّة في الإسلام لأنها تذكِّر بالله تعالى وصفاته.
الأنبياء والرُّسل: مثل: محمد، إبراهيم، يوسف، موسى، عيسى.. وترتبط بالأنبياء والرُّسل الذين وردَت قصصهم في القرآن، وهي تحمل معاني النبوَّة، والصبر، والإيمان، والفضيلة.
صفات حميدة ومفاهيم إيجابية: مثل: نور، هدى، رحمة، سلام.. تعبّر عن صفات إيجابية وروحانية مُحبّبة في الإسلام، فهي تشير إلى الهداية، والنور الإلهي، والرحمة الإلهية، والسلام.
أسماء أماكن وأحداث: بعض الأسماء تشير إلى أماكن أو أحداث مهمّة ذُكرت في القرآن مثل: بدر (غزوة بدر)، صفا، مروة (الصفا والمروة).
الرمزية الدينية والأمل: مثل: جنّات، فردوس.. تشير إلى الجنة وما تحمله من وعد للمؤمنين بالنعيم الأبدي، بينما "صابر" و"شكر" ترتبط بالصبر والشكر كقيم أساسية في الدين الإسلامي.
أسماء النساء الصالحات: أسماء مثل: مريم (والدة النبي عيسى) تحمل قدسية خاصة، حيث ذُكرت في القرآن كمثال للطهارة والتقوى.
-
1. الأسماء المستحبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الأسماء التي تحمل معاني العبودية لله، مثل: عبد الله، عبد الرحمن، فقد قال: "إنَّ أحب أسمائكم إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن" (رواه مسلم).
2. أسماء الأنبياء والرُّسل: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية الأبناء بأسماء الأنبياء، فقد قال: "تسمّوا بأسماء الأنبياء" (رواه أبو داود). وذلك لأنها تحمل في طيّاتها معاني الفضيلة والإيمان والصبر.
الأسماء التي تعبّر عن معانٍ إيجابية: مثل "حسن" و"حسين"، وهما اسما حفيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعنيان الجمال والخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفضّل الأسماء التي تحمل معاني الجمال والأخلاق الرفيعة.
تغيير الأسماء ذات المعاني السيئة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيّر الأسماء التي تحمل معاني غير محمودة أو سيئة، مثلما غيّر اسم "عاصية" إلى "جميلة"، وقال: "إنكم تُدعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم" (رواه أبو داود).
الأسماء المرتبطة بالشجاعة والقوة: كان العرب يستخدمون الأسماء التي تدل على القوة والبأس، وقد أقرّ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مثل: "أسد" و"حمزة"، نسبة إلى سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب.
الرمزية الدينية: الأسماء التي تعكس معاني دينية وروحانية مثل: "نور" و"هدى"، كانت مُحبَّبة لأنها تعكس الإيمان والهداية.
-
الهوية الثقافية والاجتماعية
-
2. الرمزية والدلالات النفسية
-
التأثير التاريخي والأسطوري
-
الرمزية الاجتماعية والسياسية
-
الجوانب اللغوية والإبداعية
 أ.د. صبري فوزي أبو حسين
هل أنت "اسم على مُسمّى"؟
عتبة الأسماء في الخطاب الإسلامي
أ.د. صبري فوزي أبو حسين (أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بجامعة الأزهر)
لا ريب أن للأسماء أثرًا في حياة أصحابها، وقد أثبتت الدراسات النفسية ذلك منذ مرحلة الطفولة؛ فالطفل يـتأثر باسمه سلبًا أو إيجابًا؛ لأنه يلتصق به مدى حياته، وبعض العُقد النفسية راجعة إلى الأسماء السلبية المنفّرة والمحزنة والمتسبّبة في ألوان من التنمّر، وبعض الأصحّاء نفسيًّا والمتوازنين اجتماعيًّا، إنما كانوا هكذا بسبب اسمهم الإيجابي الجاذب والمُسعد... ومن ثم كانت عناية الإسلام بتسمية المولود عناية خاصة في خطابات متنوعة قرآنيًّا ونبويًّا وآثاريًّا، وما ذاك إلا لأن الاسم عتبة رئيسة في حياة البشر في كل زمان ومكان. ومن ثم كان مصطلح (عتبة الأسماء) مهيمنًا على الخطاب النقدي الحداثي المعاصر.
و(العتبة) مصطلح إجرائي من أبجديات المنهج السيميائي في مقاربة النصوص الأدبية، ويقال له "النص المحيط" (paritexte)، وهو مجموع المعطيات التي تُسيِّج النص وتحميه وتدافع عنه وتُميِّزه عن غيره وتُعيِّن موقعه في جنسه، وتحثّ القارئ على اقتنائه، وهي العناوين، والمقتبسات والإهداء والأيقونات وأسماء المؤلفين والناشرين"، ومنه (عتبة الأسماء) التي تنطلق من أن لكل اسم في النص دلالة وإشارة، سواء كان اسم شخص أو مكان أو آلة أو أيّ شيء فاعل في النص، لا سيما تلك التي اختيرت عن قصد.
وليست (عتبة الاسم) مصطلحًا حداثيًّا وافدًا بل هي موجودة في تراثنا وجودًا دلاليًّا لا اصطلاحيًّا، ومن أدلة ذلك قول "بشامة بن حزن النهشلي":
إني امرؤ أسِمُ القصائد للعدا -- إن القصائد شرُّها أغفالُها
وقوله: أسِمُ القصائد، وسم القصيدة عبارة عن ذكر من قيلت برسمه من ممدوح أو مهجو! ومن يطالع فهارس المؤلفين والمُصنِّفين في تراثنا يجد قصدية عند أسلافنا إلى الاهتمام بعتبة الأسماء في عناوين مؤلَّفاتهم مثلا، وفي عناوين قصائدهم، وفي عناوين طبقات أدبائهم، وعلمائهم، وبلدانهم، ومن يطالع حديث أسلافنا عن الأسماء يجد للتسمية في تراثنا دلالات، أشاروا إليها في غير خطاب، بين ديني، ولغوي، وأدبي.
وقد شاع في خطابنا اليومي ما يدلّ على إدراك جمعي لعتبة الأسماء حيث يقال: "كلٌ له من اسمه نصيب"، أو: "لكل إنسان من اسمه نصيب"، أو "اسم على مُسمّى"، وفي نظري أنّ الأسماء رزق، وأن للاسم دورًا في مجريات حياة صاحبه، ولكن ليس هذا قاعدة مطردة محتومة، بل على سبيل التغليب والإجمال.
وممّن تناول هذه القضية بالدرس والتحليل الإمام "ابن القيم" (ت751هـ) في الفصل التاسع من كتابه "تحفة المودود في أحكام المولود" تحت عنوان "بيان ارتباط معنى الاسم بالمُسمّى"، وفي فصل: "في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الأسماء والكنى" من كتابه "زاد المعاد"، وقد قال معبرًا عن (عتبة الأسماء) تعبيرًا علميًّا دقيقًا: "لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسمّيات، وللمسمّيات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل:
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب -- إلا ومعناه إن فكرت في لقبه".
ومِمَّن درَس (عتبة الأسماء) دراسة شرعية دقيقة الشيخ "إبراهيم المزروعي" في رسالته: "الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة"، ودلّل فيه على مكانة الاسم حياتيًّا وإسلاميًّا، فقال: الاسم عنوان المُسمّى، ودليل عليه، وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يُدعى به في الدنيا والآخرة، ولذلك اعتنى الإسلام بتسمية المولود ورغّب في بعض الأسماء ومنع من بعضها... وقد اتفق العلماءُ على وجوب تسمية المولود ذكراً كان أو أنثى، وعلى أهمية ذلك، فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرجَ من ظلمات الأرحام، والاسم أول صفة تميّزه في بني جنسه، والاسمُ أول فعلٍ يقوم به الأب مع مولوده مما له صفة التوارث والاستمرار، والاسم أولُ وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة. واسم المولود عنوان عليه، فهو يدل على المولود لشدة المناسبة بين الاسم والمُسمّى، فلكل مسمّى من اسمه نصيب، وقلَّ أن يوجد اسم مثلا إلا وهو يتناسب مع المسمى به، لأن للأسماء تأثيرا في المسميات في الحُسن والقبح والخفة والثقل، واللطافة والكثافة". وهاك عرضًا لأهم الخطابات الإسلامية وأعمقها في الحديث عن عتبة الأسماء وسيميائياتها:
لفظة "الاسم" في القرآن الكريم
من يطالع "معجم ألفاظ القرآن الكريم" الصادر عن مجمع اللغة العربية يجد أن مادة (س/ م/ و) في القرآن الكريم وردت مشتقاتها المتنوعة في آيات مجيدة كثيرة، فقد ورد استعمالها فعلا (8 مرات) منها قول الله تعالى: "وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ" (سورة مريم، الآية: 36). وورد لفظ (الاسم) (27) مرة، بمعنى علامة الشيء وما يُعرف به. وورد (اسم الله): لفظ الجلالة الجامع لمعاني صفات الله الكاملة، في قول الله تعالى: "وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ" (سورة الأعلى، الآية: 15). وورد الجمع (أسماء) (12 مرة) في قول الله تعالى: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (سورة البقرة، الآية: 31)؛ قيل: معناه علَّمَ آدمَ أَسماءَ جميعِ المخلوقات بجميع اللغات العربيةِ والفارسية والسُّريانِيَّة والعِبرانيَّة والروميَّة وغيرِ ذلك من سائرِ اللغات، فكان آدمُ، على نبيِّنا محمدٍ وعليه أَفضل الصلاة والسلام، وولدُه يتكَلَّمون بها، ثم إنَّ ولدَه تفرَّقوا في الدنيا وعَلِقَ كلٌّ منهم بلغة من تلك اللغات، ثم ضَلَّت عنه ما سِواها لبُعدِ عَهدِهم بها. وفي قول الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ" (سورة الأعراف، الآية: 180)، أي الأسماء التي اختصّ بها الله تعالى، وأثبتَها لنفسه، وأثبتَها له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والتي آمنَ بها المؤمنون جميعهم.
وورد في القرآن الكريم لفظ (السَمِيّ) مرتين، بمعنى المُسمَّى باسمِك، تقول: هو سَمِيُّ فلان إذا وافَق اسمُه اسمَه كما تقول هو كَنِيُّه. وفي التنزيل العزيز: "لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا" (سورة مريم، الآية: 7)؛ قال ابن عباس: لم يُسَمَّ قبلَه أَحدٌ بيَحْيى، وقيل: معنى لم نَجعل له من قبلُ سَمِيّاً أَي نَظِيراً ومِثلاً، وقيل: سُمِّيَ بيَحْيى؛ لأَنه حَيِيَ بالعِلمِ والحكمة. وقوله عز وجل: "هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا" (سورة مريم، الآية: 65)؛ أَي نَظِيراً يستَحِقُّ مثلَ اسمِه، ويقال مُسامِياً يُسامِيه؛ قال "ابن سيده": ويقال هل تَعلَمُ له مِثلاً؛ وجاء أَيضاً: لم يُسَمَّ بالرَّحْمنِ إلا اللهُ، وتأْويلُه، والله أَعلم، هل تعلمُ سَمِيّاً يستَحِق أَن يقال له خالِقٌ وقادِرٌ وعالِمٌ لِما كان ويكون، فكذلك ليس إلا من صفات الله، عز وجل؛ قال الشاعر:
وكمْ مِنْ سَمِيٍّ ليسَ مِثْلَ سَمِيِّهِ -- مِنَ الدَّهرِ، إلا اعْتادَ عَيْنيَّ واشِلُ
عتبة الأسماء في السيرة النبوية
أورد كتاب السيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب الاسم الحسن، وأمر "إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه"، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه في دار "عقبة بن رافع"، فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء "سهيل بن عمرو" إليه "، "هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إلا سهل لكم من أمركم". ويروى أنه ندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجل يحلبها، "فقال: ما اسمك؟ قال: مرّة، فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: ما اسمك؟، قال: أظنه حرب، فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: ما اسمك؟، فقال: يعيش، فقال: احلبها". ولم يقتصر الأمر على أسماء الشخصيات فقد كان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها، كما مرّ في بعض غزواته بين جبلين، فسأل عن اسمَيهما، فقالوا: فاضح ومخز، فعدل عنهما، ولم يجز بينهما.
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، وفي هذا - والله أعلم - تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء؛ لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن، والوصف المناسب له. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمَّى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله ".
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة ". وثبت عنه أنه قال: "لا تسمّين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح؛ فإنك تقول: أثمت هو؟ فلا يكون، فيقال: لا". وثبت عنه أنه غيّر اسم "عاصية"، وقال: أنت "جميلة"، وكان اسم جويرية برة، فغيّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسم جويرية، وقالت زينب بنت أم سلمة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُسمّى بهذا الاسم، فقال: لا تزكوا أنفسكم، اللهُ أعلم بأهل البِرِّ منكم". ومن عناية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسماء الأماكن ما رُوي أنه قد غيّر اسم المدينة المنورة، كما ورد في الصحيحين: "... يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكِيرُ خبَثَ الحديد"... وهكذا تتوالى الخطابات والسلوكيات النبوية الشريفة الدالة على عناية كبيرة بأسماء أولاد الصحابة وبناتهم، وبتوجيههم فيها توجيهًا نبيلاً ساميًا راقيًا، وفاعلاً ومؤثرا.
الاسم لغويًّا
لفظة (الاسم) من الجذر اللغوي (س/ م/ و) الذي يدل على الارتفاع والعلو والتميز والمفاخرة، قال "ابن فارس" في معجمه "مقاييس اللغة": "السين والميم والواو أصل يدل على العلو"؛ وجاء في معجم "لسان العرب" لابن منظور: "السُّمُوُّ: الارتِفاعُ والعُلُوُّ، تقول منه: سَمَوتُ وسَمَيْتُ...وسَمَا الشيءُ يَسمُو سُمُوًّا، فهو سامٍ: ارتَفَع. وسَمَا به وأَسْماهُ: أَعلاهُ. ويقال للحَسيب وللشريف: قد سَما. وإذا رَفَعتَ بَصَرك إلى الشيء قلت: سَما إليه بصري، وإذا رُفِعَ لك شيءٌ من بعيدٍ فاسْتَبَنْتَه قلت: سَما لِي شيءٌ. يقال سموت، إذا علوت. وسما بصره: علا... وسماوة الهلال، وكل شيء: شخصه، والجمع سماو... ويقال: إن أصل "اسم" سُمُوٌّ، وهو من العلو؛ لأنه تنويه ودلالة على المعنى.
واسم الشيءِ وسَمُه وسِمُه وسُمُه وسَماهُ: علامَتُه. وقال "الزجّاج": معنى قولنا اسمٌ هو مُشتَق من السُّموِّ وهو الرِّفْعَة، قال: والأَصل فيه سِمْوٌ ِ. وقال الجوهري: والاسمُ مُشْتَقٌّ من سَموْتُ لأَنه تَنويهٌ ورِفعَةٌ، وفيه أَربعُ لُغاتٍ: اسمٌ وأُسْمٌ، بالضم، وسِمٌ وسُمٌ؛ ويُنشَد:
واللهُ اسْماكَ سُماً مُبَاركَا -- آثَركَ الله بِهِ إيثَاركَا
وأَلِفُ الاسم أَلفُ وَصلٍ، وربما جَعَلَها الشاعر أَلِفَ قَطْعٍ للضرورة كقول "الأَحْوص":
وما أَنا بالمَخسُوسٍ في جِذْمِ مالِكٍ -- ولا مَنْ تَسَمَّى ثم يَلْتَزِمُ الإسْما
وإذا نَسَبت إلى الاسم قلتَ سِمَوِيّ وسُموِيّ، وإنْ شئت اسْمِيٌّ، تَرَكته على حاله، وجمع الأَسماءِ أَساميُّ وأَسامٍ؛ قال:
ولنا أَسامٍ ما تَلِيقُ بغَيرِنا -- ومَشاهِدٌ تَهتَلُّ حِينَ تَرانا
وقال أَبو العباس: الاسمُ رَسمٌ وسِمَة تُوضَعُ على الشيء تُعرف به؛ قال "ابن سيده": والاسمُ اللفظُ الموضوعُ على الجوهَرِ أَو العَرَض لتَفصِل به بعضَه من بعضٍ ...
عتبة الأسماء في خطاب السّلف الصالح
ولما كان بين الأسماء والمسميّات من الارتباط والتّناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر كما كان "إياس بن معاوية" وغيره يرى الشخص، فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ، وضد هذا العبور من الاسم إلى مسمّاه كما سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا عن اسمه، فقال: جمرة، فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب، قال: مِمّن؟ قال: من الحرقة، قال: فمنزلك؟ قال: بحرَّة النار، قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى، قال: اذهب فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمر كذلك، فعبر "عمر" من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها. أي أنه - رضي الله عنه - طبق ما يُسمّى في المنهج السيميائي (عتبة الأسماء).
كما ورد عَن ابنِ المُسَيَّبِ عَن أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا اسمُكَ؟ قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ [يحثه النبي هنا على تغيير اسمه]، قَالَ: لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَت الحُزُونَةُ فِينَا بَعدُ". و"الحزونة": هي الصعوبة وشدّة الخُلُق.
وقد ورد في تلقيب الأمام الذهبي بـ "الذّهبي"؛ لأنه "كان يزن الرجال كما يزن الجواهريُّ الذهبَ". ونقل المؤرخون وأصحاب السِّيَر والتراجم قول "محمد بن طاهر المقدسي": "سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول: رجلان جليلان يجمعهما لقبان قبيحان: عبد الله بن محمد الضعيف. وإنما كان ضعيفاً في بدنه، لا في حديثه. ومعاوية بن عبد الكريم الضّال، وإنما ضلّ في طريق مكة". وفي هذا المعنى يقول "محمد بن كناسة" (ت207هـ):
وسمّيتُه يحيى؛ ليحيا، ولم يكن -- إلى ردِّ أمرِ الله فيه سبيلُ
تيممتُ فيه الفألَ حين رُزِقْتُه -- ولم أدرِ أن الفألَ فيه يَفيلُ
فليس الارتباط بين الاسم وصاحبه قاعدة حتميّة مطردة، ولا قدرًا ملازمًا؛ بل قد يدل دلالة إشارية، لا سيما عند القوم الذين يفهمون معاني الأسماء.
عتبة الأسماء في حياتي
أذكر أن أستاذي الدكتور "شوقي حمادة" - رحمه الله تعالى - سألني في امتحان التعيين (الشفوي) بمرحلة الإجازة العالية "الليسانس" عن اشتقاق اسمي (صبري)، واسم أبي (فوزي)، واسم جدّي (عبد الله)، فقلت له على البديهة: "أنا (صبرُ) أبي، وأبي (فوزُ) أبيه، وهما مركبان مضافان إلى ياء المتكلم، أو منسوبان إلى المصدرين: (الصبر)، و(الفوز)، وجدّي (عبد ربه). وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثين سنة على هذا السؤال أعتقد يقينًا أن حياتي كلها قائمة على (الصبر)، حيث أنتقل من كفاح إلى كفاح، ومن تعب إلى تعب، حتى صرت كلما عانيت من شيء في المواصلات والانتقالات أصرخ قائلاً: رحم الله من سمّاني (صبري)! وعندما أقارن حياتي بحياة أبي - رحمه الله - أعرف يقينًا أنه عاش (فوزًا)، وكان فوز أبيه!
ولعل مِمَّا يتّصل بهذه العتبة في حياتي تجربتي في تسمية أولادي، فالكبرى تأنّقتُ في اختيار اسمها، فاخترت لها اسمًا نادرًا وصل إليَّ من خلال مطالعتي في مادة (ي/ م/ ن) في المعجم الوسيط أيام كنت أعمل محررًا في إدارة المعجمات بهذا الصرح العلمي العربي العتيق، إذا وقفت أمام هذه المادة: (يَمن) فلان يَيْمن يُمْنًا وميمنةً: كَانَ مُبَارَكًا عَلَيْهِم، وَيمن الله فلَانا يُمنًا: جعله مُبَارَكًا فَهُوَ مَيْمُون. و(يمن) فلَان على آله ولآله (يَيْمن) يُمنًا وميمنةً: يمن فَهُوَ يامن وَيَمِين وأيمن... و(الأَيْمن): من يصنع بيمناه، وَخلاف الْأَيْسَر، وَهُوَ جَانب الْيَمين أَو مَا فِي ذَلِك الجَانِب، وَهِي يمناء.. فالمادة كلها دائرة حول البركة، فقلت: عندما أتزوج وأرزق بأولاد سأسمّي بنتي (يمناء)، فكانت الكبرى (يمناء)، وهي بحمد الله بركة في البيت، ثم كان أن تخفف من حالة الإغراب في التسمية هذه فسميت الأسماء الإسلامية المسنونة (عبد الرحمن)، و(فاطمة)، و(مريم)، حفظهم الله!
غربة العرب المعاصرين في أسمائهم...
ويلاحظ منذ النصف الثاني من القرن العشرين وجود تأثر سلبي في العقل العربي الشعبي في اختياره أسماء أولاده، يظهر ذلك في اختيار أسماء بناتهم من قائمة أسماء راجعة إلى أشهر المُمثّلات والمغنّيات، بل والراقصات، ثم ازدادت التّسميات نزولا في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، فوجدنا أسماء: الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، على سمارة، الدخلاوية، حمو بيكا، شواحة، علاء فيفى، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدى شطة، وزة مطرية، وغيرهم ممن يسمّون: "مطربو المهرجانات الشعبية".
ومن الطريف أن معظمهم كان يقصد قصدًا إلى هذه الأسماء الشاذة الغريبة قصدًا إلى إحداث (ترند/ إثارة) يصنع له نجومية، وقد كان! ثم لمّا تحقّقَت له النجومية أخذوا يغيّرون من أسمائهم إلى أسماء مقبولة اجتماعيًّا فقد رصدت مواقع إخبارية أن نقابة المهن الموسيقية فرضت تغيير أسماء بعض مطربي المهرجانات بمصر، من أجل قبول طلبات انضمامهم إلى النقابة، وضمّت قائمة المطربين المتغيّرة أسماؤهم عديد من نجوم المهرجانات، فتغير اسم "حمو بيكا" إلى "محمد محمود"، و"حسن شاكوش" إلى "حسن منصور"، و"عنبة" إلى "عناب"! هذا إضافة إلى ظاهرة التسمية بأسماء أجنبية خالصة، عند طبقة اجتماعية منسحقة أمام الغرب وذائبة فيه، فهي مُتغرِّبة ومُتفرْنِجة وكارهة للعروبة ولكل ما هو عربي! حتى صارت مناطقهم الخاصة التي ينعزلون فيها عن بقية أبناء الشعب، كالتي وصفها "المتنبي" قائلا:
مغاني الشِّعْب طِيبًا في المغاني -- بمنزلة الربيع من الزمانِ
ولكن الفتى العربيَّ فيها -- غريبُ الوجه واليد واللسانِ
ملاعبُ جِنَّة لو سار فيها -- سـليـمــانٌ لسـار بترجمانِ!
أ.د. صبري فوزي أبو حسين
هل أنت "اسم على مُسمّى"؟
عتبة الأسماء في الخطاب الإسلامي
أ.د. صبري فوزي أبو حسين (أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بجامعة الأزهر)
لا ريب أن للأسماء أثرًا في حياة أصحابها، وقد أثبتت الدراسات النفسية ذلك منذ مرحلة الطفولة؛ فالطفل يـتأثر باسمه سلبًا أو إيجابًا؛ لأنه يلتصق به مدى حياته، وبعض العُقد النفسية راجعة إلى الأسماء السلبية المنفّرة والمحزنة والمتسبّبة في ألوان من التنمّر، وبعض الأصحّاء نفسيًّا والمتوازنين اجتماعيًّا، إنما كانوا هكذا بسبب اسمهم الإيجابي الجاذب والمُسعد... ومن ثم كانت عناية الإسلام بتسمية المولود عناية خاصة في خطابات متنوعة قرآنيًّا ونبويًّا وآثاريًّا، وما ذاك إلا لأن الاسم عتبة رئيسة في حياة البشر في كل زمان ومكان. ومن ثم كان مصطلح (عتبة الأسماء) مهيمنًا على الخطاب النقدي الحداثي المعاصر.
و(العتبة) مصطلح إجرائي من أبجديات المنهج السيميائي في مقاربة النصوص الأدبية، ويقال له "النص المحيط" (paritexte)، وهو مجموع المعطيات التي تُسيِّج النص وتحميه وتدافع عنه وتُميِّزه عن غيره وتُعيِّن موقعه في جنسه، وتحثّ القارئ على اقتنائه، وهي العناوين، والمقتبسات والإهداء والأيقونات وأسماء المؤلفين والناشرين"، ومنه (عتبة الأسماء) التي تنطلق من أن لكل اسم في النص دلالة وإشارة، سواء كان اسم شخص أو مكان أو آلة أو أيّ شيء فاعل في النص، لا سيما تلك التي اختيرت عن قصد.
وليست (عتبة الاسم) مصطلحًا حداثيًّا وافدًا بل هي موجودة في تراثنا وجودًا دلاليًّا لا اصطلاحيًّا، ومن أدلة ذلك قول "بشامة بن حزن النهشلي":
إني امرؤ أسِمُ القصائد للعدا -- إن القصائد شرُّها أغفالُها
وقوله: أسِمُ القصائد، وسم القصيدة عبارة عن ذكر من قيلت برسمه من ممدوح أو مهجو! ومن يطالع فهارس المؤلفين والمُصنِّفين في تراثنا يجد قصدية عند أسلافنا إلى الاهتمام بعتبة الأسماء في عناوين مؤلَّفاتهم مثلا، وفي عناوين قصائدهم، وفي عناوين طبقات أدبائهم، وعلمائهم، وبلدانهم، ومن يطالع حديث أسلافنا عن الأسماء يجد للتسمية في تراثنا دلالات، أشاروا إليها في غير خطاب، بين ديني، ولغوي، وأدبي.
وقد شاع في خطابنا اليومي ما يدلّ على إدراك جمعي لعتبة الأسماء حيث يقال: "كلٌ له من اسمه نصيب"، أو: "لكل إنسان من اسمه نصيب"، أو "اسم على مُسمّى"، وفي نظري أنّ الأسماء رزق، وأن للاسم دورًا في مجريات حياة صاحبه، ولكن ليس هذا قاعدة مطردة محتومة، بل على سبيل التغليب والإجمال.
وممّن تناول هذه القضية بالدرس والتحليل الإمام "ابن القيم" (ت751هـ) في الفصل التاسع من كتابه "تحفة المودود في أحكام المولود" تحت عنوان "بيان ارتباط معنى الاسم بالمُسمّى"، وفي فصل: "في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الأسماء والكنى" من كتابه "زاد المعاد"، وقد قال معبرًا عن (عتبة الأسماء) تعبيرًا علميًّا دقيقًا: "لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسمّيات، وللمسمّيات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل:
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب -- إلا ومعناه إن فكرت في لقبه".
ومِمَّن درَس (عتبة الأسماء) دراسة شرعية دقيقة الشيخ "إبراهيم المزروعي" في رسالته: "الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة"، ودلّل فيه على مكانة الاسم حياتيًّا وإسلاميًّا، فقال: الاسم عنوان المُسمّى، ودليل عليه، وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يُدعى به في الدنيا والآخرة، ولذلك اعتنى الإسلام بتسمية المولود ورغّب في بعض الأسماء ومنع من بعضها... وقد اتفق العلماءُ على وجوب تسمية المولود ذكراً كان أو أنثى، وعلى أهمية ذلك، فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرجَ من ظلمات الأرحام، والاسم أول صفة تميّزه في بني جنسه، والاسمُ أول فعلٍ يقوم به الأب مع مولوده مما له صفة التوارث والاستمرار، والاسم أولُ وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة. واسم المولود عنوان عليه، فهو يدل على المولود لشدة المناسبة بين الاسم والمُسمّى، فلكل مسمّى من اسمه نصيب، وقلَّ أن يوجد اسم مثلا إلا وهو يتناسب مع المسمى به، لأن للأسماء تأثيرا في المسميات في الحُسن والقبح والخفة والثقل، واللطافة والكثافة". وهاك عرضًا لأهم الخطابات الإسلامية وأعمقها في الحديث عن عتبة الأسماء وسيميائياتها:
لفظة "الاسم" في القرآن الكريم
من يطالع "معجم ألفاظ القرآن الكريم" الصادر عن مجمع اللغة العربية يجد أن مادة (س/ م/ و) في القرآن الكريم وردت مشتقاتها المتنوعة في آيات مجيدة كثيرة، فقد ورد استعمالها فعلا (8 مرات) منها قول الله تعالى: "وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ" (سورة مريم، الآية: 36). وورد لفظ (الاسم) (27) مرة، بمعنى علامة الشيء وما يُعرف به. وورد (اسم الله): لفظ الجلالة الجامع لمعاني صفات الله الكاملة، في قول الله تعالى: "وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ" (سورة الأعلى، الآية: 15). وورد الجمع (أسماء) (12 مرة) في قول الله تعالى: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (سورة البقرة، الآية: 31)؛ قيل: معناه علَّمَ آدمَ أَسماءَ جميعِ المخلوقات بجميع اللغات العربيةِ والفارسية والسُّريانِيَّة والعِبرانيَّة والروميَّة وغيرِ ذلك من سائرِ اللغات، فكان آدمُ، على نبيِّنا محمدٍ وعليه أَفضل الصلاة والسلام، وولدُه يتكَلَّمون بها، ثم إنَّ ولدَه تفرَّقوا في الدنيا وعَلِقَ كلٌّ منهم بلغة من تلك اللغات، ثم ضَلَّت عنه ما سِواها لبُعدِ عَهدِهم بها. وفي قول الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ" (سورة الأعراف، الآية: 180)، أي الأسماء التي اختصّ بها الله تعالى، وأثبتَها لنفسه، وأثبتَها له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والتي آمنَ بها المؤمنون جميعهم.
وورد في القرآن الكريم لفظ (السَمِيّ) مرتين، بمعنى المُسمَّى باسمِك، تقول: هو سَمِيُّ فلان إذا وافَق اسمُه اسمَه كما تقول هو كَنِيُّه. وفي التنزيل العزيز: "لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا" (سورة مريم، الآية: 7)؛ قال ابن عباس: لم يُسَمَّ قبلَه أَحدٌ بيَحْيى، وقيل: معنى لم نَجعل له من قبلُ سَمِيّاً أَي نَظِيراً ومِثلاً، وقيل: سُمِّيَ بيَحْيى؛ لأَنه حَيِيَ بالعِلمِ والحكمة. وقوله عز وجل: "هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا" (سورة مريم، الآية: 65)؛ أَي نَظِيراً يستَحِقُّ مثلَ اسمِه، ويقال مُسامِياً يُسامِيه؛ قال "ابن سيده": ويقال هل تَعلَمُ له مِثلاً؛ وجاء أَيضاً: لم يُسَمَّ بالرَّحْمنِ إلا اللهُ، وتأْويلُه، والله أَعلم، هل تعلمُ سَمِيّاً يستَحِق أَن يقال له خالِقٌ وقادِرٌ وعالِمٌ لِما كان ويكون، فكذلك ليس إلا من صفات الله، عز وجل؛ قال الشاعر:
وكمْ مِنْ سَمِيٍّ ليسَ مِثْلَ سَمِيِّهِ -- مِنَ الدَّهرِ، إلا اعْتادَ عَيْنيَّ واشِلُ
عتبة الأسماء في السيرة النبوية
أورد كتاب السيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب الاسم الحسن، وأمر "إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه"، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه في دار "عقبة بن رافع"، فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء "سهيل بن عمرو" إليه "، "هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إلا سهل لكم من أمركم". ويروى أنه ندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجل يحلبها، "فقال: ما اسمك؟ قال: مرّة، فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: ما اسمك؟، قال: أظنه حرب، فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: ما اسمك؟، فقال: يعيش، فقال: احلبها". ولم يقتصر الأمر على أسماء الشخصيات فقد كان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها، كما مرّ في بعض غزواته بين جبلين، فسأل عن اسمَيهما، فقالوا: فاضح ومخز، فعدل عنهما، ولم يجز بينهما.
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، وفي هذا - والله أعلم - تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء؛ لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن، والوصف المناسب له. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمَّى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله ".
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة ". وثبت عنه أنه قال: "لا تسمّين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح؛ فإنك تقول: أثمت هو؟ فلا يكون، فيقال: لا". وثبت عنه أنه غيّر اسم "عاصية"، وقال: أنت "جميلة"، وكان اسم جويرية برة، فغيّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسم جويرية، وقالت زينب بنت أم سلمة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُسمّى بهذا الاسم، فقال: لا تزكوا أنفسكم، اللهُ أعلم بأهل البِرِّ منكم". ومن عناية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسماء الأماكن ما رُوي أنه قد غيّر اسم المدينة المنورة، كما ورد في الصحيحين: "... يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكِيرُ خبَثَ الحديد"... وهكذا تتوالى الخطابات والسلوكيات النبوية الشريفة الدالة على عناية كبيرة بأسماء أولاد الصحابة وبناتهم، وبتوجيههم فيها توجيهًا نبيلاً ساميًا راقيًا، وفاعلاً ومؤثرا.
الاسم لغويًّا
لفظة (الاسم) من الجذر اللغوي (س/ م/ و) الذي يدل على الارتفاع والعلو والتميز والمفاخرة، قال "ابن فارس" في معجمه "مقاييس اللغة": "السين والميم والواو أصل يدل على العلو"؛ وجاء في معجم "لسان العرب" لابن منظور: "السُّمُوُّ: الارتِفاعُ والعُلُوُّ، تقول منه: سَمَوتُ وسَمَيْتُ...وسَمَا الشيءُ يَسمُو سُمُوًّا، فهو سامٍ: ارتَفَع. وسَمَا به وأَسْماهُ: أَعلاهُ. ويقال للحَسيب وللشريف: قد سَما. وإذا رَفَعتَ بَصَرك إلى الشيء قلت: سَما إليه بصري، وإذا رُفِعَ لك شيءٌ من بعيدٍ فاسْتَبَنْتَه قلت: سَما لِي شيءٌ. يقال سموت، إذا علوت. وسما بصره: علا... وسماوة الهلال، وكل شيء: شخصه، والجمع سماو... ويقال: إن أصل "اسم" سُمُوٌّ، وهو من العلو؛ لأنه تنويه ودلالة على المعنى.
واسم الشيءِ وسَمُه وسِمُه وسُمُه وسَماهُ: علامَتُه. وقال "الزجّاج": معنى قولنا اسمٌ هو مُشتَق من السُّموِّ وهو الرِّفْعَة، قال: والأَصل فيه سِمْوٌ ِ. وقال الجوهري: والاسمُ مُشْتَقٌّ من سَموْتُ لأَنه تَنويهٌ ورِفعَةٌ، وفيه أَربعُ لُغاتٍ: اسمٌ وأُسْمٌ، بالضم، وسِمٌ وسُمٌ؛ ويُنشَد:
واللهُ اسْماكَ سُماً مُبَاركَا -- آثَركَ الله بِهِ إيثَاركَا
وأَلِفُ الاسم أَلفُ وَصلٍ، وربما جَعَلَها الشاعر أَلِفَ قَطْعٍ للضرورة كقول "الأَحْوص":
وما أَنا بالمَخسُوسٍ في جِذْمِ مالِكٍ -- ولا مَنْ تَسَمَّى ثم يَلْتَزِمُ الإسْما
وإذا نَسَبت إلى الاسم قلتَ سِمَوِيّ وسُموِيّ، وإنْ شئت اسْمِيٌّ، تَرَكته على حاله، وجمع الأَسماءِ أَساميُّ وأَسامٍ؛ قال:
ولنا أَسامٍ ما تَلِيقُ بغَيرِنا -- ومَشاهِدٌ تَهتَلُّ حِينَ تَرانا
وقال أَبو العباس: الاسمُ رَسمٌ وسِمَة تُوضَعُ على الشيء تُعرف به؛ قال "ابن سيده": والاسمُ اللفظُ الموضوعُ على الجوهَرِ أَو العَرَض لتَفصِل به بعضَه من بعضٍ ...
عتبة الأسماء في خطاب السّلف الصالح
ولما كان بين الأسماء والمسميّات من الارتباط والتّناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر كما كان "إياس بن معاوية" وغيره يرى الشخص، فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ، وضد هذا العبور من الاسم إلى مسمّاه كما سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا عن اسمه، فقال: جمرة، فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب، قال: مِمّن؟ قال: من الحرقة، قال: فمنزلك؟ قال: بحرَّة النار، قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى، قال: اذهب فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمر كذلك، فعبر "عمر" من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها. أي أنه - رضي الله عنه - طبق ما يُسمّى في المنهج السيميائي (عتبة الأسماء).
كما ورد عَن ابنِ المُسَيَّبِ عَن أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا اسمُكَ؟ قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ [يحثه النبي هنا على تغيير اسمه]، قَالَ: لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَت الحُزُونَةُ فِينَا بَعدُ". و"الحزونة": هي الصعوبة وشدّة الخُلُق.
وقد ورد في تلقيب الأمام الذهبي بـ "الذّهبي"؛ لأنه "كان يزن الرجال كما يزن الجواهريُّ الذهبَ". ونقل المؤرخون وأصحاب السِّيَر والتراجم قول "محمد بن طاهر المقدسي": "سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول: رجلان جليلان يجمعهما لقبان قبيحان: عبد الله بن محمد الضعيف. وإنما كان ضعيفاً في بدنه، لا في حديثه. ومعاوية بن عبد الكريم الضّال، وإنما ضلّ في طريق مكة". وفي هذا المعنى يقول "محمد بن كناسة" (ت207هـ):
وسمّيتُه يحيى؛ ليحيا، ولم يكن -- إلى ردِّ أمرِ الله فيه سبيلُ
تيممتُ فيه الفألَ حين رُزِقْتُه -- ولم أدرِ أن الفألَ فيه يَفيلُ
فليس الارتباط بين الاسم وصاحبه قاعدة حتميّة مطردة، ولا قدرًا ملازمًا؛ بل قد يدل دلالة إشارية، لا سيما عند القوم الذين يفهمون معاني الأسماء.
عتبة الأسماء في حياتي
أذكر أن أستاذي الدكتور "شوقي حمادة" - رحمه الله تعالى - سألني في امتحان التعيين (الشفوي) بمرحلة الإجازة العالية "الليسانس" عن اشتقاق اسمي (صبري)، واسم أبي (فوزي)، واسم جدّي (عبد الله)، فقلت له على البديهة: "أنا (صبرُ) أبي، وأبي (فوزُ) أبيه، وهما مركبان مضافان إلى ياء المتكلم، أو منسوبان إلى المصدرين: (الصبر)، و(الفوز)، وجدّي (عبد ربه). وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثين سنة على هذا السؤال أعتقد يقينًا أن حياتي كلها قائمة على (الصبر)، حيث أنتقل من كفاح إلى كفاح، ومن تعب إلى تعب، حتى صرت كلما عانيت من شيء في المواصلات والانتقالات أصرخ قائلاً: رحم الله من سمّاني (صبري)! وعندما أقارن حياتي بحياة أبي - رحمه الله - أعرف يقينًا أنه عاش (فوزًا)، وكان فوز أبيه!
ولعل مِمَّا يتّصل بهذه العتبة في حياتي تجربتي في تسمية أولادي، فالكبرى تأنّقتُ في اختيار اسمها، فاخترت لها اسمًا نادرًا وصل إليَّ من خلال مطالعتي في مادة (ي/ م/ ن) في المعجم الوسيط أيام كنت أعمل محررًا في إدارة المعجمات بهذا الصرح العلمي العربي العتيق، إذا وقفت أمام هذه المادة: (يَمن) فلان يَيْمن يُمْنًا وميمنةً: كَانَ مُبَارَكًا عَلَيْهِم، وَيمن الله فلَانا يُمنًا: جعله مُبَارَكًا فَهُوَ مَيْمُون. و(يمن) فلَان على آله ولآله (يَيْمن) يُمنًا وميمنةً: يمن فَهُوَ يامن وَيَمِين وأيمن... و(الأَيْمن): من يصنع بيمناه، وَخلاف الْأَيْسَر، وَهُوَ جَانب الْيَمين أَو مَا فِي ذَلِك الجَانِب، وَهِي يمناء.. فالمادة كلها دائرة حول البركة، فقلت: عندما أتزوج وأرزق بأولاد سأسمّي بنتي (يمناء)، فكانت الكبرى (يمناء)، وهي بحمد الله بركة في البيت، ثم كان أن تخفف من حالة الإغراب في التسمية هذه فسميت الأسماء الإسلامية المسنونة (عبد الرحمن)، و(فاطمة)، و(مريم)، حفظهم الله!
غربة العرب المعاصرين في أسمائهم...
ويلاحظ منذ النصف الثاني من القرن العشرين وجود تأثر سلبي في العقل العربي الشعبي في اختياره أسماء أولاده، يظهر ذلك في اختيار أسماء بناتهم من قائمة أسماء راجعة إلى أشهر المُمثّلات والمغنّيات، بل والراقصات، ثم ازدادت التّسميات نزولا في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، فوجدنا أسماء: الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، على سمارة، الدخلاوية، حمو بيكا، شواحة، علاء فيفى، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدى شطة، وزة مطرية، وغيرهم ممن يسمّون: "مطربو المهرجانات الشعبية".
ومن الطريف أن معظمهم كان يقصد قصدًا إلى هذه الأسماء الشاذة الغريبة قصدًا إلى إحداث (ترند/ إثارة) يصنع له نجومية، وقد كان! ثم لمّا تحقّقَت له النجومية أخذوا يغيّرون من أسمائهم إلى أسماء مقبولة اجتماعيًّا فقد رصدت مواقع إخبارية أن نقابة المهن الموسيقية فرضت تغيير أسماء بعض مطربي المهرجانات بمصر، من أجل قبول طلبات انضمامهم إلى النقابة، وضمّت قائمة المطربين المتغيّرة أسماؤهم عديد من نجوم المهرجانات، فتغير اسم "حمو بيكا" إلى "محمد محمود"، و"حسن شاكوش" إلى "حسن منصور"، و"عنبة" إلى "عناب"! هذا إضافة إلى ظاهرة التسمية بأسماء أجنبية خالصة، عند طبقة اجتماعية منسحقة أمام الغرب وذائبة فيه، فهي مُتغرِّبة ومُتفرْنِجة وكارهة للعروبة ولكل ما هو عربي! حتى صارت مناطقهم الخاصة التي ينعزلون فيها عن بقية أبناء الشعب، كالتي وصفها "المتنبي" قائلا:
مغاني الشِّعْب طِيبًا في المغاني -- بمنزلة الربيع من الزمانِ
ولكن الفتى العربيَّ فيها -- غريبُ الوجه واليد واللسانِ
ملاعبُ جِنَّة لو سار فيها -- سـليـمــانٌ لسـار بترجمانِ!
 شوقِيّة عروق منصور (كاتبة وشاعرة من فلسطين)
حتى لا ننسى..
صبرا وشاتيلا ونكسة.. أسماء فتيات في فلسطين!
شوقِيّة عروق منصور (كاتبة وشاعرة من فلسطين)
بقدر ما الاسم قد يكون سهلا، بقدر ما يحمل في حروفه حياة كاملة، وما بين هذه الحروف يخرج نبض الفخر والاعتزاز أو لعنة الواقع.. هناك أسماء تشعر كأنها ارتدت الشخصية، وهناك أسماء تشعر أنها أقصر أو أوسع أو لا تليق بحامل الاسم.. هناك أسماء عندنا حملت أسماء مجازر تاريخية فلسطينية، عندنا اسم فتيات: "صبرا" و"شاتيلا"، عندنا أسماء لها علاقة بتواريخ الهزائم، عندنا امرأة باسم "نكسة"..
غالبا في المجتمع الفلسطيني، الأسماء تكون وراثية وحفاظا على استمرارية العائلة.. استمرارية اسم الجدّ، مثلا أنا أطلقتُ اسم "محمود" على ابني البكر على اسم والد زوجي، ويعتبر إطلاق اسم الجدّ فخرا وقوة استمرارية للعائلة كأنّ الحفيد يمثل توقيع حضور العائلة في المجتمع.. أيضا عندنا أسماء لها علاقة بالتاريخ العربي، اسم زوجي "تميم" فقد كان والده يقرأ التاريخ وأُعجب جدًّا بـ "بني تميم" وشدة بأس هذه القبيلة.
أنا أطلقت على ابنتي الكبرى "ميسون"، فقد كنتُ في المدرسة معجبة بشموخ وقوة شخصية "ميسون الكلبية" زوجة "معاوية بن أبي سفيان" التي تحدّته ورفضت العيش في قصره وقالت باعتزاز:
لَبيتٌ تخفق الأرواح فيه -- أحب إليّ من قصر منيف
ولبس عباءة وتقرّ عيني -- أحب اليّ من لبس الشّفوف
وأكل كُسَيرة من كسر بيتي -- أحب إليّ من أكل الرغيف
وأصوات الرياح بكل فجٍّ -- أحب إليَّ من نقر الدّفوف
وكلبٌ ينبح الطُّرّاق دوني -- أحب إليَّ من قطٍّ أليف
وبكر يتبع الأظعان صعب -- أحب إليّ من بعل زفوف
وخرقٌ من بني عمّي نحيف -- أحب إليّ من علج عنوف
خشونة عيشتي في البدو أشهى -- إلى نفسي من العيش الطّريف
فما أبغي سوى وطني بديلا -- وما أبهاه من وطن شريف
أما ابنتي الوسطى "سجى"، فقد أحببتُ الآية الكريمة الثانية في سورة "الضحى": "وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ"، وسجى بمعنى أنّ الليل اقبل بظلامه. والابنة الثالثة "كيان"، فقد أطلقتُ عليها اسم "كيان" لأنّها وُلدت في 15 – 11 – 1988 عندما أعلن "ياسر عرفات" في "قصر الصنوبر" بالجزائر عن قيام الدولة الفلسطينية. أمّا آخر الأبناء عندي "آدم" فهو على اسم سيدنا آدم عليه السلام (أبو البشر).
وتبقى الأسماء هي ليست من اختيارنا عندما نولد بل هي اختيار أمّهات وآباء وأجداد يحرصون على أن يحمل المواليد أسماء مميزة.. ولكن من العروف لكل زمن له من الأسماء ما قد تكون على أسماء قادة عسكريين كانت صفاتهم الانتصار.. غير أننا نرى في هذا الزمن الاهتمام بأسماء غريبة دخيلة على مجتمعنا مثل أسماء من شعوب بعيدة عنا.. وتقليد تلك الأسماء كنوع من التباهي وغالبا لا نعرف معنى تلك الأسماء.. أو أسماء مطربين ومطربات، أو أسماء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والتّرندات.. وكما قالوا لكل عصر فنونه!
شوقِيّة عروق منصور (كاتبة وشاعرة من فلسطين)
حتى لا ننسى..
صبرا وشاتيلا ونكسة.. أسماء فتيات في فلسطين!
شوقِيّة عروق منصور (كاتبة وشاعرة من فلسطين)
بقدر ما الاسم قد يكون سهلا، بقدر ما يحمل في حروفه حياة كاملة، وما بين هذه الحروف يخرج نبض الفخر والاعتزاز أو لعنة الواقع.. هناك أسماء تشعر كأنها ارتدت الشخصية، وهناك أسماء تشعر أنها أقصر أو أوسع أو لا تليق بحامل الاسم.. هناك أسماء عندنا حملت أسماء مجازر تاريخية فلسطينية، عندنا اسم فتيات: "صبرا" و"شاتيلا"، عندنا أسماء لها علاقة بتواريخ الهزائم، عندنا امرأة باسم "نكسة"..
غالبا في المجتمع الفلسطيني، الأسماء تكون وراثية وحفاظا على استمرارية العائلة.. استمرارية اسم الجدّ، مثلا أنا أطلقتُ اسم "محمود" على ابني البكر على اسم والد زوجي، ويعتبر إطلاق اسم الجدّ فخرا وقوة استمرارية للعائلة كأنّ الحفيد يمثل توقيع حضور العائلة في المجتمع.. أيضا عندنا أسماء لها علاقة بالتاريخ العربي، اسم زوجي "تميم" فقد كان والده يقرأ التاريخ وأُعجب جدًّا بـ "بني تميم" وشدة بأس هذه القبيلة.
أنا أطلقت على ابنتي الكبرى "ميسون"، فقد كنتُ في المدرسة معجبة بشموخ وقوة شخصية "ميسون الكلبية" زوجة "معاوية بن أبي سفيان" التي تحدّته ورفضت العيش في قصره وقالت باعتزاز:
لَبيتٌ تخفق الأرواح فيه -- أحب إليّ من قصر منيف
ولبس عباءة وتقرّ عيني -- أحب اليّ من لبس الشّفوف
وأكل كُسَيرة من كسر بيتي -- أحب إليّ من أكل الرغيف
وأصوات الرياح بكل فجٍّ -- أحب إليَّ من نقر الدّفوف
وكلبٌ ينبح الطُّرّاق دوني -- أحب إليَّ من قطٍّ أليف
وبكر يتبع الأظعان صعب -- أحب إليّ من بعل زفوف
وخرقٌ من بني عمّي نحيف -- أحب إليّ من علج عنوف
خشونة عيشتي في البدو أشهى -- إلى نفسي من العيش الطّريف
فما أبغي سوى وطني بديلا -- وما أبهاه من وطن شريف
أما ابنتي الوسطى "سجى"، فقد أحببتُ الآية الكريمة الثانية في سورة "الضحى": "وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ"، وسجى بمعنى أنّ الليل اقبل بظلامه. والابنة الثالثة "كيان"، فقد أطلقتُ عليها اسم "كيان" لأنّها وُلدت في 15 – 11 – 1988 عندما أعلن "ياسر عرفات" في "قصر الصنوبر" بالجزائر عن قيام الدولة الفلسطينية. أمّا آخر الأبناء عندي "آدم" فهو على اسم سيدنا آدم عليه السلام (أبو البشر).
وتبقى الأسماء هي ليست من اختيارنا عندما نولد بل هي اختيار أمّهات وآباء وأجداد يحرصون على أن يحمل المواليد أسماء مميزة.. ولكن من العروف لكل زمن له من الأسماء ما قد تكون على أسماء قادة عسكريين كانت صفاتهم الانتصار.. غير أننا نرى في هذا الزمن الاهتمام بأسماء غريبة دخيلة على مجتمعنا مثل أسماء من شعوب بعيدة عنا.. وتقليد تلك الأسماء كنوع من التباهي وغالبا لا نعرف معنى تلك الأسماء.. أو أسماء مطربين ومطربات، أو أسماء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والتّرندات.. وكما قالوا لكل عصر فنونه!
 محمد عواد
الشيخ بطّة والعمّ أبو صُرم وحكايا أخرى..
الأسماء والألقاب في المجتمعات العربية
محمد عواد (كاتب وروائي من مصر)
تحضرني طرفة كنا نتداولها في طفولتنا، وظلت مرتبطة بأذهاننا، إلى يومنا هذا، أذكرها جيدا، أبتسم حين تعيد ذاكرتي موقفها، حيث توفيت والدة أحدهم، فاجتمع الناس للمشاركة في تشييعها، وكان ابنها الشاب يبكي أمّه بحرقة منقطعة النظير، تنثال الدموع من فوق وجنتيه، فتصيغ خطَّي عبرة عليهما، يلطم خدّيه، وينعى فراقها، بسير بين المشيعين الذين يفترشون أديم قريتنا في انتظار الانتهاء من تكفينها، لدفنها!
رق قلب أحدهم لحاله، كنّا ندعوه: "العمّ علي أبو صُرم"، كان يكره الأمر هذه التسمية، كنا ننطق كنيته في عدم حضوره، لا يجرؤ أحدنا أن يفعلها أمامه ونكتفي بمناداته: "العم علي" وحسب، خوفا من غضبته وبطشه، إن فعلها أحدنا معه!
تقدّم "العم علي" نحو الشاب، يبتغي مواساته ويخفّف عنه لواعجه وحزنه، احتضنه وربّت على كتفيه ومسح فوق رأسه، بلّلَت دموعه جلباب "العم علي"، تحدث إليه: "لا تجزع يا ولدي، إنها سنة الحياة، كفاك بكاء، لن يعيد الأمر إليك أمك، كن الآن يقظا، لتدرك مقلتاك من قدِمَ من الناس ليشاركك حزنك وفقدك، كفاك بكاء يا ولدي".
يعيد الشاب احتضانه، وما زالت دمعاته تجري مجرى النهر فوق كتف "العم علي"، وبصوتٍ أجشٍّ سمعه الجميع، اختلطَت فيه نبرات أحزانه ولوعات فقده، يردّ الشاب عليه وخدّه مُستلقي فوق جناحه: "ماتت أمي يا عمّ علي أبو صرم، ماتت أمي يا عم علي أبو صرم، مات..." ولم يكمل العبارة. فأزاحه "العمّ علي" بعيدا عن صدره، مخاطبا إياه بنبرة حازمة: "بقولك إيه! سِيبَك من (صرمي)، وركّز في أمك اللي ماتت".. تحوَّل المأتم إلى ساحة من الضحك المكبوت، وترك العمُّ العزاءَ، وهو يتحدث إلى نفسه، أظنّه كان يلعن الفقيدة وولدها!
الأسماء العربية في أوطاننا من الخليج إلى المحيط، تتنوّع حسب معطيات عدة، وتتحكّم فيها ثقافات مختلفة، وسوف نناقش الأمر لاحقا، لكن يطغى عليها صنفان من الأسماء، انتشارهما يخضع لهويتنا الدينية، وائتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الأسماء، ما حُمِّد وعُبِّد"، فمحمد وأحمد ومحمود وحامد وحمدان.. وعبّد أسماء الله عزّ وجل جميعها، تملأ ربوع أمتنا، من أدناها حتى أقصاها، بنسبة لا تقل عن العشرين في المائة من الأسماء على الأقل!!
ثم نعود مرة أخرى إلى تأثير الثقافات المختلفة من مكان إلى آخر على إشكاليات الأسماء، على المجمل في الوطن العربي، فجغرافية الأوطان تتأثر بالأمر، فيفينا أسماء أشقائنا في المغرب العربي، ربما تتباين عن أسماء أشقائنا في الخليج وفي الشام، فأسماء أهل البداوة أيضا تختلف عن أسماء من يسكنون الحضر، في المساحة الجغرافية نفسها أو البلد الواحد. فعلى سبيل المثال، يُسمّي عربان مصر "فهد"، ولا تجده في مدينة من مدنها، هنا تؤثر الثقافة البيئية على نوعية الأسماء، بما يتناسب مع نفسية أصحابها، و"أيدولوجياتهم"!
لا يقف الأمر عند هذا الحد، فحتى الانتماءات الدينية الإسلامية تؤثر في الأمر، فتجد مثلا: علي، حسين، كاظم، زين العابدين.. في أوساط أشقائنا "الشيعة" في العراق، وتجد: أبو بكر، عمر، فاطمة، عائشة.. في المناطق السنيّة من الوطن العربي.
وليس هذا فقط، فالحروب، ودعوات الاستقلال، تؤثر في الأمر أيضا، فتجدنا في "مصر" أثناء الحروب مع العدو، انتشر اسم: ناصر، منتصر، فواز، وكذلك لو راقبنا أسماء إخوتنا في فلسطين فنجد المنتشر منها على سبيل المثال: جهاد، نضال، كنانة، وما شابه.
ولا نقف عند هذا الأمر أيضا، فتخضع المسميات أيضا إلى ما نسمّيه الهوية الأصولية، فنجد أسماء مثل: عتبة، شرحبيل، قيس، لأسماء الأشقاء في الحجاز.. وعبد الملك، وهشام، في سوريا.
أما الأسماء الأخرى المعجمية، فكثيرة أيضا، والتي ظهرت في مجتمعاتنا العربية، نتيجة لأسباب عدة، أولها الاستعمار الذي حاول جاهدا طمس الهوية العربية بقدر ما استطاع، فظهرت أسماء لا تمتّ للغتنا الجميلة بأيّ أواصر قربى، مثل الأسماء الفرنسية: سوزان، سيليا، والتركية مثل: جلستان، هانم، شوكت، وما شابه!!
والأمر الآخر، هو اعتقاد الناس بأنّ ارتباط الأسماء الأعجمية بأسماء أبنائهم يضفي نوعا ما من التقدمية والرقي والانفتاح، وهذا مناف تماما للحقيقة، فالمعجم العربي مليء بأجمل الأسماء كنيةً ورمزا. وأيضا صار للأسماء الفارسية نصيب عظيم من تلك الأسماء الأعجمية نظرا للموسيقى والجزل اللذين تتمتع بهما، دون دراية عن معناها الحقيقي في لغتهم.
ثم نذهب بعد ذلك إلى ألقاب الأشخاص، وهو أن يقرن اسما ما بعد أسمه، ولا يذكر فيه لا أباه ولا جده، وهذا الأمر منتشر جدا في أقطارنا العربية لأسباب عدة، فبعضهم يستخدمه للتباهي بفصيله وقومه أو ربما عشيرته، فنجدهم يقولون: محمد الشريف، ليدّعي - كذبًا أو صدقًا - نسبه لرسول الله مثلا، أو يستخدم مدينته فيقول: حسين السامرائي، أو غيث الطرابلسي، أو سالم الأسكندراني، فيستخدم الأمر، ليميّز هوية صاحبه، ضاربا بقدر أبيه وجده عرض الحائط!
ويُستخدم اللقب أيضا الترهيب أحيانا، والفخر أيضا في أحيان أخرى، رابطا أسمه باسم قبيلة عظيمة، أو عائلة موسرة، أو بلدة يغلب على أهلها الغلظة والعنف، فيقول مثلا: أحمد العرباوي، أو جمال العزيزي، أو جاسم اليمني، وما شابه.. وبكل أسف، مع تغلغل الحداثة في مجتمعاتنا العربية، بدأت كثيرٌ من الأسماء العربية في الانقراض، وحلّ محلّها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان.
وفي النهاية، نأتي إلى أسوء ما في الأمر، هو تلك الألقاب التي صارت تباع وتشترى، وتلك الصفات التي صار الناس يصبغونها على أنفسهم، رغبة في حصولهم على تقدير مجتمعي تسبغه عليهم مسمّيات ما تسبق أسماءهم، وعلى سبيل المثال: الأستاذ الدكتور، البروفسور، الاستشاري، الخبير، الباحث، العالم، وهذا لا يعني أن مثل هؤلاء ليسوا موجودين بيننا، ولكن يجب أن تخبرنا عنهم أعمالهم، وقدرها عن قدرهم، لا أن يشتروا تلك الألقاب أو ينتزعوها انتزاعا من مصادرها، فالقيمة هي التي تستطيع أن تصنع اللقب، أما اللقب فلا يستطيع أن يصنع القيمة !!
ومرة أخرى نعود إلى طرفة من طُرف الأسماء، حدثني بها أحدهم في طفولتي، من أهل قرية تجاور قريتي في جنوب مصر، فلقد كان في قريتهم رجل يُدعى: "شجاع"، وكان سلوكه في المجمل أقرب إلى طبيعة النساء، وكانت نسوة تلك القرية يذهبن إلى زيارة قبور مواتهم في فجر يوم العيد، ويصطحبن "شجاع" معهن، بمنطق "ظل رجل خير من شمس امرأة"، ولا خوف منه عليهن في المجمل، فلم يكن أزواجهن يشعرون عليهن بالغيرة من رفقته لهن، فهو يستطيع حمايتهن من نباح الرجاء عليهن في الظلمة!!
خرجن ذات مرة، فعوى ذئب على جمعهن، فقلن: "هذا ذئب يا شجاع؟"، فردّ عليهن قائلا: "هنا وجب أن أعود إلى البيت، لأخبر أمي بالأمر".
والأجمل من هذا مع صديق لي، بل وقريب أيضا، طيَّب الله ثراه، كان يُدعى: "إبراهيم"، وكنّا صِبية نلعب الكرة في باحة قريتنا، وحين كان يعدو (رحمه الله) كان يفرد ذراعيه جانبا، بما يشبه محاولة "البطة" للطيران، فأطلقنا عليه لقب: "بطّة"..
كبرنا، ونزحنا إلى القاهرة، وعمل "إبراهيم" إماما وخطيبا لمسجد في حي نسكن فيه، وكنا نُكنّيه فيما بيننا بـ "الشيخ بطة"، ولم يكن يتضايق كثيرا، حتى أكرمه الله بزيجته وانتقل إلى مسكن لم نعرف عنه غير الشارع الشعبي الضيق الذي كان يقطنه، وظللنا نسأل الجيران عن "الشيخ بطة" حتى عرفوه، وهم بين مُتعجِّب وضاحك، فأشاروا إلى البناية التي يقطنها، ولم يكونوا يعرفون في أيّ شقّة يقطن فيها صديقنا، فوقفنا أسفل البناية، وبدأنا في النداء عليه فرادى وجمعا: "يا شيخ بطة، يا شيخ بطة"، فما كان منه إلا أن ترك رفيقته، ونظر علينا من شرفة وحدته، وفي يده إناء ضخم مملوء بالماء العسر، وسكبه فوق رؤوسنا، فعدونا ولم ندر لماذا فعل معنا هذا، ولم نهنّئه بزيجته، وهو لم يعد يصادقنا بعدها، رحمه الله تعالى..
محمد عواد
الشيخ بطّة والعمّ أبو صُرم وحكايا أخرى..
الأسماء والألقاب في المجتمعات العربية
محمد عواد (كاتب وروائي من مصر)
تحضرني طرفة كنا نتداولها في طفولتنا، وظلت مرتبطة بأذهاننا، إلى يومنا هذا، أذكرها جيدا، أبتسم حين تعيد ذاكرتي موقفها، حيث توفيت والدة أحدهم، فاجتمع الناس للمشاركة في تشييعها، وكان ابنها الشاب يبكي أمّه بحرقة منقطعة النظير، تنثال الدموع من فوق وجنتيه، فتصيغ خطَّي عبرة عليهما، يلطم خدّيه، وينعى فراقها، بسير بين المشيعين الذين يفترشون أديم قريتنا في انتظار الانتهاء من تكفينها، لدفنها!
رق قلب أحدهم لحاله، كنّا ندعوه: "العمّ علي أبو صُرم"، كان يكره الأمر هذه التسمية، كنا ننطق كنيته في عدم حضوره، لا يجرؤ أحدنا أن يفعلها أمامه ونكتفي بمناداته: "العم علي" وحسب، خوفا من غضبته وبطشه، إن فعلها أحدنا معه!
تقدّم "العم علي" نحو الشاب، يبتغي مواساته ويخفّف عنه لواعجه وحزنه، احتضنه وربّت على كتفيه ومسح فوق رأسه، بلّلَت دموعه جلباب "العم علي"، تحدث إليه: "لا تجزع يا ولدي، إنها سنة الحياة، كفاك بكاء، لن يعيد الأمر إليك أمك، كن الآن يقظا، لتدرك مقلتاك من قدِمَ من الناس ليشاركك حزنك وفقدك، كفاك بكاء يا ولدي".
يعيد الشاب احتضانه، وما زالت دمعاته تجري مجرى النهر فوق كتف "العم علي"، وبصوتٍ أجشٍّ سمعه الجميع، اختلطَت فيه نبرات أحزانه ولوعات فقده، يردّ الشاب عليه وخدّه مُستلقي فوق جناحه: "ماتت أمي يا عمّ علي أبو صرم، ماتت أمي يا عم علي أبو صرم، مات..." ولم يكمل العبارة. فأزاحه "العمّ علي" بعيدا عن صدره، مخاطبا إياه بنبرة حازمة: "بقولك إيه! سِيبَك من (صرمي)، وركّز في أمك اللي ماتت".. تحوَّل المأتم إلى ساحة من الضحك المكبوت، وترك العمُّ العزاءَ، وهو يتحدث إلى نفسه، أظنّه كان يلعن الفقيدة وولدها!
الأسماء العربية في أوطاننا من الخليج إلى المحيط، تتنوّع حسب معطيات عدة، وتتحكّم فيها ثقافات مختلفة، وسوف نناقش الأمر لاحقا، لكن يطغى عليها صنفان من الأسماء، انتشارهما يخضع لهويتنا الدينية، وائتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الأسماء، ما حُمِّد وعُبِّد"، فمحمد وأحمد ومحمود وحامد وحمدان.. وعبّد أسماء الله عزّ وجل جميعها، تملأ ربوع أمتنا، من أدناها حتى أقصاها، بنسبة لا تقل عن العشرين في المائة من الأسماء على الأقل!!
ثم نعود مرة أخرى إلى تأثير الثقافات المختلفة من مكان إلى آخر على إشكاليات الأسماء، على المجمل في الوطن العربي، فجغرافية الأوطان تتأثر بالأمر، فيفينا أسماء أشقائنا في المغرب العربي، ربما تتباين عن أسماء أشقائنا في الخليج وفي الشام، فأسماء أهل البداوة أيضا تختلف عن أسماء من يسكنون الحضر، في المساحة الجغرافية نفسها أو البلد الواحد. فعلى سبيل المثال، يُسمّي عربان مصر "فهد"، ولا تجده في مدينة من مدنها، هنا تؤثر الثقافة البيئية على نوعية الأسماء، بما يتناسب مع نفسية أصحابها، و"أيدولوجياتهم"!
لا يقف الأمر عند هذا الحد، فحتى الانتماءات الدينية الإسلامية تؤثر في الأمر، فتجد مثلا: علي، حسين، كاظم، زين العابدين.. في أوساط أشقائنا "الشيعة" في العراق، وتجد: أبو بكر، عمر، فاطمة، عائشة.. في المناطق السنيّة من الوطن العربي.
وليس هذا فقط، فالحروب، ودعوات الاستقلال، تؤثر في الأمر أيضا، فتجدنا في "مصر" أثناء الحروب مع العدو، انتشر اسم: ناصر، منتصر، فواز، وكذلك لو راقبنا أسماء إخوتنا في فلسطين فنجد المنتشر منها على سبيل المثال: جهاد، نضال، كنانة، وما شابه.
ولا نقف عند هذا الأمر أيضا، فتخضع المسميات أيضا إلى ما نسمّيه الهوية الأصولية، فنجد أسماء مثل: عتبة، شرحبيل، قيس، لأسماء الأشقاء في الحجاز.. وعبد الملك، وهشام، في سوريا.
أما الأسماء الأخرى المعجمية، فكثيرة أيضا، والتي ظهرت في مجتمعاتنا العربية، نتيجة لأسباب عدة، أولها الاستعمار الذي حاول جاهدا طمس الهوية العربية بقدر ما استطاع، فظهرت أسماء لا تمتّ للغتنا الجميلة بأيّ أواصر قربى، مثل الأسماء الفرنسية: سوزان، سيليا، والتركية مثل: جلستان، هانم، شوكت، وما شابه!!
والأمر الآخر، هو اعتقاد الناس بأنّ ارتباط الأسماء الأعجمية بأسماء أبنائهم يضفي نوعا ما من التقدمية والرقي والانفتاح، وهذا مناف تماما للحقيقة، فالمعجم العربي مليء بأجمل الأسماء كنيةً ورمزا. وأيضا صار للأسماء الفارسية نصيب عظيم من تلك الأسماء الأعجمية نظرا للموسيقى والجزل اللذين تتمتع بهما، دون دراية عن معناها الحقيقي في لغتهم.
ثم نذهب بعد ذلك إلى ألقاب الأشخاص، وهو أن يقرن اسما ما بعد أسمه، ولا يذكر فيه لا أباه ولا جده، وهذا الأمر منتشر جدا في أقطارنا العربية لأسباب عدة، فبعضهم يستخدمه للتباهي بفصيله وقومه أو ربما عشيرته، فنجدهم يقولون: محمد الشريف، ليدّعي - كذبًا أو صدقًا - نسبه لرسول الله مثلا، أو يستخدم مدينته فيقول: حسين السامرائي، أو غيث الطرابلسي، أو سالم الأسكندراني، فيستخدم الأمر، ليميّز هوية صاحبه، ضاربا بقدر أبيه وجده عرض الحائط!
ويُستخدم اللقب أيضا الترهيب أحيانا، والفخر أيضا في أحيان أخرى، رابطا أسمه باسم قبيلة عظيمة، أو عائلة موسرة، أو بلدة يغلب على أهلها الغلظة والعنف، فيقول مثلا: أحمد العرباوي، أو جمال العزيزي، أو جاسم اليمني، وما شابه.. وبكل أسف، مع تغلغل الحداثة في مجتمعاتنا العربية، بدأت كثيرٌ من الأسماء العربية في الانقراض، وحلّ محلّها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان.
وفي النهاية، نأتي إلى أسوء ما في الأمر، هو تلك الألقاب التي صارت تباع وتشترى، وتلك الصفات التي صار الناس يصبغونها على أنفسهم، رغبة في حصولهم على تقدير مجتمعي تسبغه عليهم مسمّيات ما تسبق أسماءهم، وعلى سبيل المثال: الأستاذ الدكتور، البروفسور، الاستشاري، الخبير، الباحث، العالم، وهذا لا يعني أن مثل هؤلاء ليسوا موجودين بيننا، ولكن يجب أن تخبرنا عنهم أعمالهم، وقدرها عن قدرهم، لا أن يشتروا تلك الألقاب أو ينتزعوها انتزاعا من مصادرها، فالقيمة هي التي تستطيع أن تصنع اللقب، أما اللقب فلا يستطيع أن يصنع القيمة !!
ومرة أخرى نعود إلى طرفة من طُرف الأسماء، حدثني بها أحدهم في طفولتي، من أهل قرية تجاور قريتي في جنوب مصر، فلقد كان في قريتهم رجل يُدعى: "شجاع"، وكان سلوكه في المجمل أقرب إلى طبيعة النساء، وكانت نسوة تلك القرية يذهبن إلى زيارة قبور مواتهم في فجر يوم العيد، ويصطحبن "شجاع" معهن، بمنطق "ظل رجل خير من شمس امرأة"، ولا خوف منه عليهن في المجمل، فلم يكن أزواجهن يشعرون عليهن بالغيرة من رفقته لهن، فهو يستطيع حمايتهن من نباح الرجاء عليهن في الظلمة!!
خرجن ذات مرة، فعوى ذئب على جمعهن، فقلن: "هذا ذئب يا شجاع؟"، فردّ عليهن قائلا: "هنا وجب أن أعود إلى البيت، لأخبر أمي بالأمر".
والأجمل من هذا مع صديق لي، بل وقريب أيضا، طيَّب الله ثراه، كان يُدعى: "إبراهيم"، وكنّا صِبية نلعب الكرة في باحة قريتنا، وحين كان يعدو (رحمه الله) كان يفرد ذراعيه جانبا، بما يشبه محاولة "البطة" للطيران، فأطلقنا عليه لقب: "بطّة"..
كبرنا، ونزحنا إلى القاهرة، وعمل "إبراهيم" إماما وخطيبا لمسجد في حي نسكن فيه، وكنا نُكنّيه فيما بيننا بـ "الشيخ بطة"، ولم يكن يتضايق كثيرا، حتى أكرمه الله بزيجته وانتقل إلى مسكن لم نعرف عنه غير الشارع الشعبي الضيق الذي كان يقطنه، وظللنا نسأل الجيران عن "الشيخ بطة" حتى عرفوه، وهم بين مُتعجِّب وضاحك، فأشاروا إلى البناية التي يقطنها، ولم يكونوا يعرفون في أيّ شقّة يقطن فيها صديقنا، فوقفنا أسفل البناية، وبدأنا في النداء عليه فرادى وجمعا: "يا شيخ بطة، يا شيخ بطة"، فما كان منه إلا أن ترك رفيقته، ونظر علينا من شرفة وحدته، وفي يده إناء ضخم مملوء بالماء العسر، وسكبه فوق رؤوسنا، فعدونا ولم ندر لماذا فعل معنا هذا، ولم نهنّئه بزيجته، وهو لم يعد يصادقنا بعدها، رحمه الله تعالى..
 سعاد عبد القادر القصير
"أسامينا... وشو تعبو أهالينا تا لاقوها..."
حامل! أين لائحة الأسماء؟
سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
بشّرَتهم بحملها، فطالبوها بلائحة الأسماء، لم يعرفوا نوع الجنين بعد، فوضعوا لائحةً بأسماء الذّكور، وأخرى بأسماء الإناث، وبدأت حرب الأسامي! وصدح صوت "فيروز" بين أروقة المكان وهي تردّد: "أسامينا.. شو تعبوا أهالينا تا لاقوها.. وشو افتكروا فينا..". أيّ اسم ستختارين لمولودك؟ "ييي شو بشع، مش حرام تسمّي هيك اسم قديم؟"، لم يعجبهم، فتلجأ إلى خيار آخر، "يي مش حلو تقيل عاللسان"، ويدخل الأهل في دوّامة اسم الطّفل.
هناك مثل عربيّ يقول:" الطّفل يأتي ويأتي اسمه معه"، هكذا يبدأ الأهل بالتّهرب من ضغط البيئة المحيطة بهم، بحجّة أنّهم مهما وضعوا من احتمالات فإنّ القدر سيلعب دوره، ولكن هل يعني ذلك أنّ الأمّ والأب متّفقان؟
جرت العادات، التي لم تزل سارية حتى اليوم في بعض المناطق، أن يُسمّى المولود باسم الجدّ إن كان ذكرًا أو الجدّة إن كانت أنثى، وكم من مشكلات وصلت حتى الطّلاق بسبب رفض أحد الطّرفين لهذه العادة إمّا كرهًا بالاسم، أو كرهًا بالشّخص نفسه لغياب العلاقة الطّيبة معه، فالمعادلة هنا بسيطة كيف سأحبّ طفلي وأنا أكره اسمه؟
ولكنّ هذه العادات بدأت تتقلّص شيئًا فشيئًا نتيجة لتحديّات جديدة، إذ بدأ الأهل يبحثون عن أسماء تُعبّر عن ثقافتهم المستجدّة، فمع الانفتاح والعولمة وتداخل الثّقافات، بدأ الانخراط الثّقافيّ يطال الأسماء، حتى بدأ البحث عمّا هو خفيف على السّمع واللّسان مع التّميّز بالمعنى أجدى وأرقى..
وعلى سبيل الفكاهة، هناك نكتة عن رجل يُخبر أخاه أنّه سمّى ابنته "باريفاز" ويعني كحّة الهدهد الحيران لحظة غروب الشّمس، فيُخبره أخوه أنّه سمّى ابنته "جمبوليلا" وهو صوت ورق المشمش اليابس حين يأكله الخروف. وما هذه الفكاهة إلّا للاستهزاء بمنطق العصر في تسمية أبناء الجيل اليوم، لكنّها سخريةٌ تحمل في باطنها الكوميديا السّوداء اللّاذعة، وما أكثر التّغيّرات التي تدخل حياتنا فنتقبّلها عبر هذه الكوميديا، ولكن هل الأهل مخطئون؟
عادة ما يتمنّى الأهل الأفضل لأبنائهم، ويتجلّى ذلك منذ اللّحظة الأولى التي يُنعم الله بها عليهم بنعمة الأبوّة والأمومة، فلكلّ امرئٍ من اسمه نصيب، ولم يعد الآباء المستجدّون يكتفون بالاسم العربيّ التّقليديّ لاعتبارات كثيرة.
وللعولمة الدّور الأوّل والأساسيّ في هذا الاتّجاه، فمع تداخل الثّقافات، ابتعد النّاس عن اللّغة الواحدة، وبدأ الافتتان بالأسماء الأجنبيّة، خصوصًا تلك المرتبطة ببطل مسلسل أو فيلم أحبّه المتابعون وتمنّوا إنجاب طفل مشابه بالشّكل والشّخصيّة والسّلوك، متغاضين عن دور التّربية والبيئة المحيطة به، وكأنّ الاسم وحده يكفي لوضع حجر الأساس في تكوين شخصيّة الطّفل كما يجب لها أن تكون.
هذا من ناحية، أمّا من ناحية أخرى، فإنّ العالم العربيّ تفشّت فيه الصّراعات الدّينيّة والطّائفيّة والمذهبيّة والحزبيّة، ممّا جعل فئة غير قليلة تبتعد عن الأسماء الواضحة والصّريحة الانتماء، بهدف حماية الطّفل من أيّ تعدّيات أو مضايقات من الممكن أن يتعرّض لها عند اندماجه في المجتمع في المستقبل، وبمنطق "ابتعد عن الشّر وغنِّ له"، يبحث الأهل عن اسم مشترك مقبول من الجميع، غير واضح المعالم، يضع الطّفل في الأمان المجتمعيّ ويقيه من الاضطهادات المحتملة.
أمّا من منظور مختلف، فإنّ البعض مقتنع تمامًا أنّ الطّفل - وبسبب الأوضاع الاقتصاديّة المتردّية في بعض البلاد العربيّة - وقبل أن يولد، سيكون التّغرّب مصيرًا حتميًّا له، إمّا لمتابعة دراسته، أو للعمل وتأمين حياته المستقبليّة، انطلاقًا من اليأس الذي ينمو يومًا بعد يوم تجاه مصير العالم العربي، ولضمان اندماجه في عالم المهجر، يلجأ الأهل إلى اختيار اسم سهل اللّفظ، فيبتعدون عن الأسماء التي تحتوي على حروف عربيّة صعبة النّطق في اللّسان الغربي، فيستسهلون الابتعاد عن الأسماء الطويلة والصّعبة، وتضيق دائرة الاحتمالات ليصبح الاختيار أكثر راحة.
هل هذا يعني أنّ الثّقافة العربيّة باتت مُهدَّدة بسبب الاتّجاه إلى أسماء جديدة تواكب الثّقافات المتشابكة؟
هذا الموضوع شائك جدًّا، فالمجتمع العربيّ بعاداته وتقاليده وانتماءاته الثّقافيّة والدّينيّة سيبقى محميًّا إلى حدّ ما أمام الاستعمار الثّقافي، واتّباع موضة الأسماء العصريّة قد يكون له أثر على البيئة العربيّة، ولكن ليس إلى درجة تهديد وجودها.
وفي النّهاية، وبعد أن يقع الاختيار على الاسم الموعود، سيبقى هناك مؤيّدون ومعارضون، وكأنّ هذا القرار يحتمل المشاركة الجماعيّة، وكأنّ الجميع معنيّون برسم خارطة طريق الطّفل المنتظر.
سعاد عبد القادر القصير
"أسامينا... وشو تعبو أهالينا تا لاقوها..."
حامل! أين لائحة الأسماء؟
سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
بشّرَتهم بحملها، فطالبوها بلائحة الأسماء، لم يعرفوا نوع الجنين بعد، فوضعوا لائحةً بأسماء الذّكور، وأخرى بأسماء الإناث، وبدأت حرب الأسامي! وصدح صوت "فيروز" بين أروقة المكان وهي تردّد: "أسامينا.. شو تعبوا أهالينا تا لاقوها.. وشو افتكروا فينا..". أيّ اسم ستختارين لمولودك؟ "ييي شو بشع، مش حرام تسمّي هيك اسم قديم؟"، لم يعجبهم، فتلجأ إلى خيار آخر، "يي مش حلو تقيل عاللسان"، ويدخل الأهل في دوّامة اسم الطّفل.
هناك مثل عربيّ يقول:" الطّفل يأتي ويأتي اسمه معه"، هكذا يبدأ الأهل بالتّهرب من ضغط البيئة المحيطة بهم، بحجّة أنّهم مهما وضعوا من احتمالات فإنّ القدر سيلعب دوره، ولكن هل يعني ذلك أنّ الأمّ والأب متّفقان؟
جرت العادات، التي لم تزل سارية حتى اليوم في بعض المناطق، أن يُسمّى المولود باسم الجدّ إن كان ذكرًا أو الجدّة إن كانت أنثى، وكم من مشكلات وصلت حتى الطّلاق بسبب رفض أحد الطّرفين لهذه العادة إمّا كرهًا بالاسم، أو كرهًا بالشّخص نفسه لغياب العلاقة الطّيبة معه، فالمعادلة هنا بسيطة كيف سأحبّ طفلي وأنا أكره اسمه؟
ولكنّ هذه العادات بدأت تتقلّص شيئًا فشيئًا نتيجة لتحديّات جديدة، إذ بدأ الأهل يبحثون عن أسماء تُعبّر عن ثقافتهم المستجدّة، فمع الانفتاح والعولمة وتداخل الثّقافات، بدأ الانخراط الثّقافيّ يطال الأسماء، حتى بدأ البحث عمّا هو خفيف على السّمع واللّسان مع التّميّز بالمعنى أجدى وأرقى..
وعلى سبيل الفكاهة، هناك نكتة عن رجل يُخبر أخاه أنّه سمّى ابنته "باريفاز" ويعني كحّة الهدهد الحيران لحظة غروب الشّمس، فيُخبره أخوه أنّه سمّى ابنته "جمبوليلا" وهو صوت ورق المشمش اليابس حين يأكله الخروف. وما هذه الفكاهة إلّا للاستهزاء بمنطق العصر في تسمية أبناء الجيل اليوم، لكنّها سخريةٌ تحمل في باطنها الكوميديا السّوداء اللّاذعة، وما أكثر التّغيّرات التي تدخل حياتنا فنتقبّلها عبر هذه الكوميديا، ولكن هل الأهل مخطئون؟
عادة ما يتمنّى الأهل الأفضل لأبنائهم، ويتجلّى ذلك منذ اللّحظة الأولى التي يُنعم الله بها عليهم بنعمة الأبوّة والأمومة، فلكلّ امرئٍ من اسمه نصيب، ولم يعد الآباء المستجدّون يكتفون بالاسم العربيّ التّقليديّ لاعتبارات كثيرة.
وللعولمة الدّور الأوّل والأساسيّ في هذا الاتّجاه، فمع تداخل الثّقافات، ابتعد النّاس عن اللّغة الواحدة، وبدأ الافتتان بالأسماء الأجنبيّة، خصوصًا تلك المرتبطة ببطل مسلسل أو فيلم أحبّه المتابعون وتمنّوا إنجاب طفل مشابه بالشّكل والشّخصيّة والسّلوك، متغاضين عن دور التّربية والبيئة المحيطة به، وكأنّ الاسم وحده يكفي لوضع حجر الأساس في تكوين شخصيّة الطّفل كما يجب لها أن تكون.
هذا من ناحية، أمّا من ناحية أخرى، فإنّ العالم العربيّ تفشّت فيه الصّراعات الدّينيّة والطّائفيّة والمذهبيّة والحزبيّة، ممّا جعل فئة غير قليلة تبتعد عن الأسماء الواضحة والصّريحة الانتماء، بهدف حماية الطّفل من أيّ تعدّيات أو مضايقات من الممكن أن يتعرّض لها عند اندماجه في المجتمع في المستقبل، وبمنطق "ابتعد عن الشّر وغنِّ له"، يبحث الأهل عن اسم مشترك مقبول من الجميع، غير واضح المعالم، يضع الطّفل في الأمان المجتمعيّ ويقيه من الاضطهادات المحتملة.
أمّا من منظور مختلف، فإنّ البعض مقتنع تمامًا أنّ الطّفل - وبسبب الأوضاع الاقتصاديّة المتردّية في بعض البلاد العربيّة - وقبل أن يولد، سيكون التّغرّب مصيرًا حتميًّا له، إمّا لمتابعة دراسته، أو للعمل وتأمين حياته المستقبليّة، انطلاقًا من اليأس الذي ينمو يومًا بعد يوم تجاه مصير العالم العربي، ولضمان اندماجه في عالم المهجر، يلجأ الأهل إلى اختيار اسم سهل اللّفظ، فيبتعدون عن الأسماء التي تحتوي على حروف عربيّة صعبة النّطق في اللّسان الغربي، فيستسهلون الابتعاد عن الأسماء الطويلة والصّعبة، وتضيق دائرة الاحتمالات ليصبح الاختيار أكثر راحة.
هل هذا يعني أنّ الثّقافة العربيّة باتت مُهدَّدة بسبب الاتّجاه إلى أسماء جديدة تواكب الثّقافات المتشابكة؟
هذا الموضوع شائك جدًّا، فالمجتمع العربيّ بعاداته وتقاليده وانتماءاته الثّقافيّة والدّينيّة سيبقى محميًّا إلى حدّ ما أمام الاستعمار الثّقافي، واتّباع موضة الأسماء العصريّة قد يكون له أثر على البيئة العربيّة، ولكن ليس إلى درجة تهديد وجودها.
وفي النّهاية، وبعد أن يقع الاختيار على الاسم الموعود، سيبقى هناك مؤيّدون ومعارضون، وكأنّ هذا القرار يحتمل المشاركة الجماعيّة، وكأنّ الجميع معنيّون برسم خارطة طريق الطّفل المنتظر.
 وحيد حمّود
" لبسنا قشرة الحضارة.. والرّوح جاهليّة"..
الأسماء العربية والانسلاخ الحضاريّ
وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
ما يحدث مخيفٌ حقًّا، لا أكتب ما أكتبه لأخيفكم، إنّنا ننسلخ عن عروبتنا شيئًا فشيئا، منذ بدء الثورة التّكنولوجيّة التي تحوّل معها الكون حاليًّا إلى أصغر من قريةٍ كونيّة. ونحن - وأقصد العرب - نمضي من انسلاخ إلى انسلاخ، من انصهارٍ إلى انصهار، نذوب في الحضارات الآتية من خارج المنزل، فنتقمّصها كما لو أنّنا مجرّد (Manoukain) يعرض جسده بكلّ ما يأتيه، منبهرًا فيه، دون أن يتقبّل أصلًا الحكم الموضوعيّ من النّاس والمجتمع والبيئة.
ولكن، ماذا عن الأسماء؟ أسماء أبنائنا في ظلّ ما نراه من هذا الانسلاخ الحضاريّ؟
في البدء علينا أن نعترف أنّ اللّغة هي التي تُخبرنا عن علوّ شأن قومٍ أو دنوّهم، وهنا أقصد من ناحية الحكم وصنع القرار السّياسي والسّلطة، ووفقًا لإحصائيّات رسميّة، تتصدر الإنجليزية قائمة الدّول التي تتحدّث بهذه اللغة بـ 58 دولة، تليها الفرنسية بـ 29 دولة، فيما تأتي العربية في المركز الثالث معتمدة في 23 دولة.
من هنا نُدرك خطورة الوضع الذي نحن فيه، فنحن بعد أن كنّا سادة العالم صرنا نحيا على هامشه، لا قرار لنا ولا انتصار! والأمر الآخر الذي يُروّج له، هو أنّ التّحدّث بالعربيّة أمرٌ مخجل، ويحوّل الشّخص إلى شخص رجعيّ بدائيّ، وهذا الأمر نراه في دولنا العربيّة وشروط التّوظيف المعتمدة خصوصًا، فالتّحدّث باللّغة الإنجليزيّة أو الفرنسيّة هو الشّرط الأساسيّ للقبول، في حين أنّ اللّغة العربيّة مُستبعَدة تمامًا، وهذا الأمر ينعكس على تعامل الأفراد فيما بينهم، إذ تكون لغة التّواصل عبر البريد وبين الموظفين هي الإنجليزية أيضًا، كلّ هذا يشكّل أساسًا جاهزًا لرفض كلّ ما يمتّ للعربيّة بصلة، فتتأثّر العائلة العربيّة تلقائيًّا بهذا المنهج التّعاملي، ممّا يأخذنا نحو معضلة اختيار الأسماء، وهنا نسأل: كيف يختار الشّريكان العربيّان أسماء مولودهما الجديد؟
لا شكّ أنّنا أمام اندثار لأسماء بناتٍ عربيّات عديدة مثل: فاطمة، سُكَينة، عائشة، خديجة، ليلى، سميرة، علياء، سمر، رقيّة، بُثينة، عبلة... وغيرها العديد العديد من الأسماء التي تندثر في ظلّ هذه الهجمة التي نواجهها عبر تبريرات تحمل السّمّ في داخلها ومنها: "الاسم الرّجعيّ" و"الاسم القديم" و"الاسم الذي ذهبت موضته"، لننطلق نحو اختيار أسماء أجنبيّة مع إظهار مرادفاتها العربيّة لكي نحفظ ماء الوجه أمام أسئلة بيئتنا التي ما زالت شبه محافظة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستبقى بيئتنا العربيّة تقاوم هذه الهجمات وتحافظ على هذا التّشبّث الخجول بوجه الهجمات الشّرسة التي تدخل في مسامات أفكارنا؟
إنّنا حقًّا أمام معضلة كبيرة ينبغي علينا جميعًا الوقوف عندها، الأمر خطير جدًّا، إنّ المجتمعات العربيّة تتحوّل شيئًا فشيئًا إلى مجتمعاتٍ لا تشبه العرب بشيء، تغيَّر لباسنا، تغيَّرت عاداتنا، تغيّرت مناهجنا، تغيّرت أفكارنا، تغيّرت أسماؤنا، ما الذي بقي؟ لا شيء يشير إلينا غير هذا الموقع الجغرافيّ الذي نعيش فيه، وخلافًا لذلك فكلّ شيء أصابته لعنة التّغيير الأعمى.
وهنا أستذكر قول "نزار قبّاني"، الشاعر السوريّ الكبير، في قصيدته "هوامش على دفتر النّكسة" يقول:
خلاصة القضيّة
توجز في عبارة
لقد لبسنا قشرة الحضارة
والرّوح جاهليّة...
يا لشدّة أحقيّة ما قاله منذ سنوات خلت، قبل أن نندفع هذا الاندفاع العجيب الغريب في تلقّي كلّ ما هو غريب عنّا، لو كان بيننا اليوم لبكى كثيرًا، أسماؤنا خُلعت عن أجسادنا يا "نزار"، لقد صارت "ليلى" "تِيا" وصار "قَيس" "روميو"، وماتت قصص الحبّ التي تغنّينا بها، لقد سُلخت عنّا أكثر الأسماء التي نحبّها، لأنّا توهّمنا أنّها أسماء رجعيّة وقديمة ولا تُماشي الموضة، بئسًا لموضةٍ تخلع عنّا أغلى ما نملكه: حضارتنا!
وحيد حمّود
" لبسنا قشرة الحضارة.. والرّوح جاهليّة"..
الأسماء العربية والانسلاخ الحضاريّ
وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
ما يحدث مخيفٌ حقًّا، لا أكتب ما أكتبه لأخيفكم، إنّنا ننسلخ عن عروبتنا شيئًا فشيئا، منذ بدء الثورة التّكنولوجيّة التي تحوّل معها الكون حاليًّا إلى أصغر من قريةٍ كونيّة. ونحن - وأقصد العرب - نمضي من انسلاخ إلى انسلاخ، من انصهارٍ إلى انصهار، نذوب في الحضارات الآتية من خارج المنزل، فنتقمّصها كما لو أنّنا مجرّد (Manoukain) يعرض جسده بكلّ ما يأتيه، منبهرًا فيه، دون أن يتقبّل أصلًا الحكم الموضوعيّ من النّاس والمجتمع والبيئة.
ولكن، ماذا عن الأسماء؟ أسماء أبنائنا في ظلّ ما نراه من هذا الانسلاخ الحضاريّ؟
في البدء علينا أن نعترف أنّ اللّغة هي التي تُخبرنا عن علوّ شأن قومٍ أو دنوّهم، وهنا أقصد من ناحية الحكم وصنع القرار السّياسي والسّلطة، ووفقًا لإحصائيّات رسميّة، تتصدر الإنجليزية قائمة الدّول التي تتحدّث بهذه اللغة بـ 58 دولة، تليها الفرنسية بـ 29 دولة، فيما تأتي العربية في المركز الثالث معتمدة في 23 دولة.
من هنا نُدرك خطورة الوضع الذي نحن فيه، فنحن بعد أن كنّا سادة العالم صرنا نحيا على هامشه، لا قرار لنا ولا انتصار! والأمر الآخر الذي يُروّج له، هو أنّ التّحدّث بالعربيّة أمرٌ مخجل، ويحوّل الشّخص إلى شخص رجعيّ بدائيّ، وهذا الأمر نراه في دولنا العربيّة وشروط التّوظيف المعتمدة خصوصًا، فالتّحدّث باللّغة الإنجليزيّة أو الفرنسيّة هو الشّرط الأساسيّ للقبول، في حين أنّ اللّغة العربيّة مُستبعَدة تمامًا، وهذا الأمر ينعكس على تعامل الأفراد فيما بينهم، إذ تكون لغة التّواصل عبر البريد وبين الموظفين هي الإنجليزية أيضًا، كلّ هذا يشكّل أساسًا جاهزًا لرفض كلّ ما يمتّ للعربيّة بصلة، فتتأثّر العائلة العربيّة تلقائيًّا بهذا المنهج التّعاملي، ممّا يأخذنا نحو معضلة اختيار الأسماء، وهنا نسأل: كيف يختار الشّريكان العربيّان أسماء مولودهما الجديد؟
لا شكّ أنّنا أمام اندثار لأسماء بناتٍ عربيّات عديدة مثل: فاطمة، سُكَينة، عائشة، خديجة، ليلى، سميرة، علياء، سمر، رقيّة، بُثينة، عبلة... وغيرها العديد العديد من الأسماء التي تندثر في ظلّ هذه الهجمة التي نواجهها عبر تبريرات تحمل السّمّ في داخلها ومنها: "الاسم الرّجعيّ" و"الاسم القديم" و"الاسم الذي ذهبت موضته"، لننطلق نحو اختيار أسماء أجنبيّة مع إظهار مرادفاتها العربيّة لكي نحفظ ماء الوجه أمام أسئلة بيئتنا التي ما زالت شبه محافظة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستبقى بيئتنا العربيّة تقاوم هذه الهجمات وتحافظ على هذا التّشبّث الخجول بوجه الهجمات الشّرسة التي تدخل في مسامات أفكارنا؟
إنّنا حقًّا أمام معضلة كبيرة ينبغي علينا جميعًا الوقوف عندها، الأمر خطير جدًّا، إنّ المجتمعات العربيّة تتحوّل شيئًا فشيئًا إلى مجتمعاتٍ لا تشبه العرب بشيء، تغيَّر لباسنا، تغيَّرت عاداتنا، تغيّرت مناهجنا، تغيّرت أفكارنا، تغيّرت أسماؤنا، ما الذي بقي؟ لا شيء يشير إلينا غير هذا الموقع الجغرافيّ الذي نعيش فيه، وخلافًا لذلك فكلّ شيء أصابته لعنة التّغيير الأعمى.
وهنا أستذكر قول "نزار قبّاني"، الشاعر السوريّ الكبير، في قصيدته "هوامش على دفتر النّكسة" يقول:
خلاصة القضيّة
توجز في عبارة
لقد لبسنا قشرة الحضارة
والرّوح جاهليّة...
يا لشدّة أحقيّة ما قاله منذ سنوات خلت، قبل أن نندفع هذا الاندفاع العجيب الغريب في تلقّي كلّ ما هو غريب عنّا، لو كان بيننا اليوم لبكى كثيرًا، أسماؤنا خُلعت عن أجسادنا يا "نزار"، لقد صارت "ليلى" "تِيا" وصار "قَيس" "روميو"، وماتت قصص الحبّ التي تغنّينا بها، لقد سُلخت عنّا أكثر الأسماء التي نحبّها، لأنّا توهّمنا أنّها أسماء رجعيّة وقديمة ولا تُماشي الموضة، بئسًا لموضةٍ تخلع عنّا أغلى ما نملكه: حضارتنا!