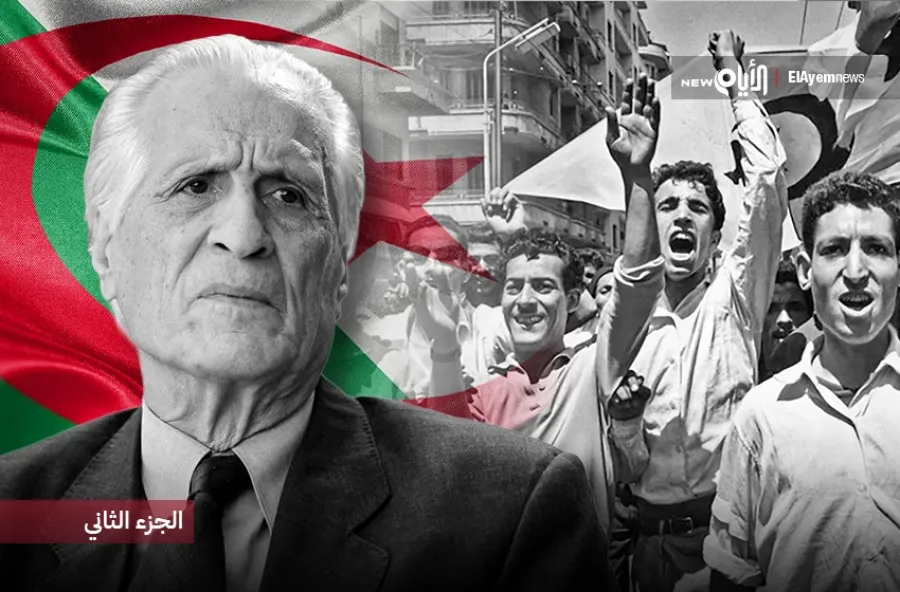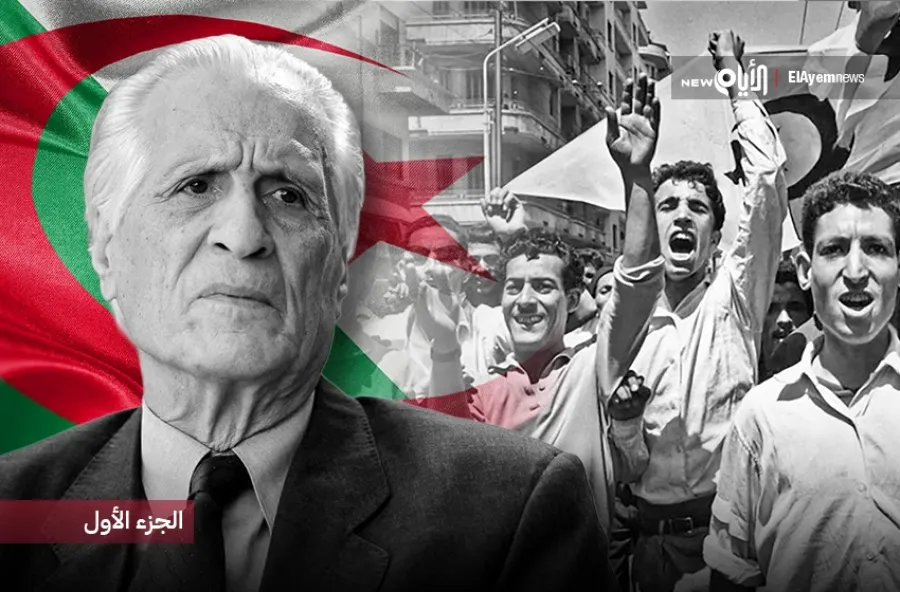يُحيل اسم إفريقيا في ذهنية الكثيرين إلى أقوامٍ شبه عُراة يرتدون الأسمال ويحملون الحِراب وهم يدورون حول نيران متأجّجة ويرقصون على وقع طبولٍ خشبيّة كبيرة، ويسكنون في أكواخ من القشّ! في الحقيقة، هذه هي الصورة رسمها الغرب للأفارقة الذين ينتشرون في البلدان الواقعة بعد الصحراء الكبرى الجزائرية، رغم أنّ الغرب وصل إلى هذه المناطق في بدايات القرن الثامن عشر، أي بعد أن وصلها العرب المُسلمون بحوالي عشرة قرون. فإذا كانت هذه الصورة الغربية الظالمة المُشوّهة للأفارقة لها أغراضها التي اعتمدها الغرب لتبرير الاستعمار بدعوى أنه ليس استعمارًا وإنّما هو "حملة حضارية" للرقي بالشعوب الإفريقية وإدخالها في عصر التقدّم والمدنيّة.. فما هو مُبرّرنا نحن في الاحتفاظ بهذه الصورة أو بعضٍ من تفاصيلها لا سيما وأنّ أسلافنا هم من أسهموا في تأسيس الممالك الإسلامية الكبرى في بلدان مثل: مالي، غانا، النيجر؟ يُطلق على المناطق التي تقع بعد صحرائنا الكبرى تسمية "السودان الغربي" وهي تضمّ: مالي، السينغال، غامبيا، بوركينافاسو، الطوغو، البينين، نيجيريا، الكاميرون، الغابون، الكونغو.. وهناك "السودان الأوسط" و"يضم بحيرة تشاد والمناطق المحيطة بإفريقيا الوسطى"، بالإضافة إلى "السودان الشرقي "ويضم مناطق واد النيل وروافده جنوب النوبة، والمعروف عند العرب بالزنج". وسنُجيز لأنفسنا القول بأنّ "السودان الغربي" هو البلدان الإفريقية الواقعة جنوب صحرائنا الكبرى الجزائرية. من أبرز المؤرّخين الجزائريين الذين ركّزوا جهودهم على إفريقيا والسودان الغربي، الدكتور "عبد القادر زبادية" (1933 - 2013) الذي يُعتبر "رائد الدراسات الإفريقية"، وله مؤلّفات وتحقيق لمخطوطات في الشأن الإفريقي، بالإضافات إلى مقالات مبثوثة في المجلات العربية والجزائرية، وهذه واحدةٌ من مقالاته التي نشرها بمجلة "الأصالة" الجزائرية في شهر جانفي 1978، وتناول فيها " ملامح الحركة التعليمية في تمبكتو خلال القرن السادس عشر". وتعيد جريدة "الأيام نيوز" نشر المقالة للتأكيد على أهميّة دراسة تاريخ إفريقيا لا سيما البلدان التي يربطنا بها تاريخ عميق وتمثّل امتدادا للتراث الإسلامي، وأيضًا لتصحيح النظرة الغربية الظالمة لإفريقيا من خلال اكتشاف مدينة "تمبكتو" التي كانت حاضرة للإشعاع العلمي والمعرفي خلال القرون الوسطى أو قرون الظلام في أوروبا، واكتشاف جهود علماء الجزائر من أمثال: المغيلي، التادلسي.. في إرساء النهضة العلمية في إفريقيا انطلاقا من "تمبكتو"، والتي امتدت إلى بلدان إفريقية أخرى ما زالت فيها مساجد ومدارس علمائنا قائمة وشاهدة إلى الآن على عمق العلاقات (الجزائرية - الإفريقية). واعتقادنا بأنّ استثمار الموروث الحضاري والإسلامي المشترك يُمكنه أن يكون من بين الأسلحة القوية التي نواجه بها مُخطّطات الغرب الذي يحاول في كل حين أن يُجدّد أدواته ووسائله الاستعمارية! وفيما يلي نترك القارئ يستكشف "تمبكتو" خلال ما يُسمّى القرون الوسطى وكيف كانت حاضرة للإشعاع العلمي والمعرفي الإسلامي باللغة العربية، في توقيت كان الغرب الأوروبي مستغرقًا في ظلامه! حركة التعليم رأت "تمبكتو" في القرن السادس عشر نشاطا فيما يختصّ بحركة التدريس، وقد ضمّت مدارسها العديد من الطلاب والأساتذة، كما رأت لأول مرة في تاريخ السودان الغربي، اتساع التعليم الجامعي، وتوارد عليها في تلك الأثناء عددٌ من الأساتذة من بلدان المغرب العربي، فساهموا في تنشيط التعليم وتعميقه. وفي تلك الفترة بدأ العلماء السودانيون في الإنتاج، فكتبوا شروحًا لعددٍ من المؤلفات الهامة التي أُلِّفت خارج السودان الغربي، وقد صاحب ذلك انتظام مراحل التعليم، وأخذ طابعًا عامًّا، كانت له مميزاته وخصائصه. مراحل التعليم كان التعليم في "تمبكتو" خلال القرن السادس عشر، يُقسّم إلى ابتدائي وثانوي وعالٍ. وكان التعليم الابتدائي تتجسّم فيه المرحلة الأولى الأساسية لكل الطلاب. هذا بالإضافة إلى أن مرحلته هي الوحيدة التي يبدو أنه كان يُراعى فيها - إلى حدٍّ ما - مستوى السن، فكان التلاميذ في السلك الابتدائي لا يتجاوزون في أغلبيتهم مرحلة الصِّبا. وبعد أن يُنهي الطالب مرحلة التعليم الابتدائي، يدخل إلى مرحلة التعليم الثانوي والعالي، ولم يكن لهاتين المرحلتين عُرف معين في السنّ، كما أن الفروق بينهما لم تكن واضحة، ولعل مردّ ذلك إلى أن هاتين المرحلتين كان التعليم فيهما حرًّا بالنسبة لانخراط الطلبة. أما في المرحلة الابتدائية، فلا شك أن الآباء هم الذين كانوا يقودون أبناءهم إلى معلمِّي الصبيان، ويجبرونهم على الدّوام، كما يراقبون مدى استيعابهم. وكانت مرحلة التعليم الثانوي تمتاز بأنّ الكتب التي تُدرّس فيها، هي الكتب المُبسّطة، وكان يتولّى تدريسها غالبا مَن يسمون بـ "الأشياخ". ويبدو أن الأشياخ في العُرف العام آنذاك، كانوا متوسطّي الثقافة بالنسبة للأساتذة، ولكن عددا من الأساتذة تعاطوا أيضا تدريس مثل هذه المُؤلّفات، وهذا مما يجعل الانفصال بين المرحلتين واضحا للباحث، لأن أولئك الأساتذة - في الوقت نفسه - كانوا يجمعون إلى ذلك، تدريس أمّهات الكتب المُفصّلة في الموضوع نفسه، ويبدو أنهم كانوا يقسّمون أوقاتهم خلال النهار، فيدرِّسون مثلا في الصباح لطلاب المستوى الثانوي، ثم يجلسون بعد الظُّهر لطلاب المرحلة العليا أو العكس. ومن هنا يبدو الانتظام في المراحل التي يمرّ بها الطالب من حيث التدرّج في مستويات التعليم بين المراحل، ووجود منهج قارٍّ لكل مرحلة. علماء جزائريون في مدارس تمبكتو كان من أبرز مَن وفد عليها من علماء المغرب العربي واكتسبوا بها شهرة في تلك الأثناء: محمد بن عبد الكريم المغيلي (الجزائر)، سيدي يحيى التادلسي (الجزائر)، مخلوف البليالي (الجزائر)، إبراهيم الزلفي، وكذا عدد هام من علماء "توات" (الجزائر). من الجدير بالذكر هنا أن كل التأثيرات الخارجية التي عرفها السودان الغربي في ميدان الحضارة، حتى نهاية القرن السابع عشر، كان الفضل فيها يعود للمغاربة وللمصريين بالدرجة الأولى. وبالنظر للعوامل الجغرافية، فإن المغاربة كانوا أكثر تأثيرا من المصريين، أمّا الأوروبيون فإنهم حتى القرن الثامن عشر كانوا لم يتجاوزوا السواحل، وحتى نهاية القرن السابع عشر، ظلت معلوماتهم عن الداخل نظرية بحتة، وحتى نهاية القرن الرابع عشر بقي اكتشاف داخل القارة الإفريقية عموما، والسودان الغربي بشكل خاص، للعرب وحدهم. ولعل أول محاولة أوروبية للوصول إلى المناطق الواقعة جنوب المغرب الأقصى كانت هي رحلة الأخوين "فيفالدي" (Vivaldi) من "جنوة" (الإيطالية)، اللذين حاولا الوصول إلى "ربودي أرو" (وادي الذهب) سنة 1291م، ولكن غابت أخبارهما من ساعتئذ. وفي 1447 حاول الرحّالة الإيطالي "مالفانت" الوصول إلى "تمبكتو" عن طريق "توات" (الجزائر)، ولكنه لم يتمكّن، فبقي أياما في تلك الواحة ثم عاد.. ومن هنا، فإنّنا نميل إلى الاعتقاد بأنّ كل تقدّم أحرزه السودان الغربي في ميدان التعليم، ظل إسلاميا وبتأثير من الحضارة العربية وحدها، وهذا حتى بداية القرن العشرين. أساتذة التعليم الثانوي والعالي كان الأساتذة في المرحلتين الثانوية والعالية، لا يتعاطون تعليم القراءة والكتابة، ولذا كان على كل طالب أن يدخل المدرسة الابتدائية أولا، ليتزوّد منها بما يمكنه من معرفة القراءة والتسجيل، وهذا قبل أن يجلس في حلقة أيّ أستاذ كان.. لا يشير المؤرخون السودانيون من تلك الفترة لتلاميذ المرحلة الابتدائية إلا بعبارة (الصبيان). كان الأساتذة في هاتين المرحلتين يجلسون للتّدريس، ويتحلّق حولهم الطلاب، ويجلس الطالب في حلقة ما حسب رغبته في المادة التي يكون الأستاذ بصدد تدريسها أولا، ثم حسب قدرته على الفهم والاستيعاب. تحدّث "ابن بطوطة" (القرن الرابع عشر) عن حرص السودانيين على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وتعليمهم الأخلاق منذ الصغر، ويذكر من أمثلة ذلك عن أحدهم أنه كتّف ابنه بحبلٍ يوم العيد، ولم يفكّ وثاقه رغم توسّل البعض إليه في ذلك، حتى حفظ الجزء الذي طُلب منه. مشايخ وأساتذة تحدّث " محمود كعت التمبكتي" (مؤرخ من القرن الرابع عشر) مثلا عن مُدرِّس كان يشرح رسالة "ابن أبي زيد القيرواني" لـ "الأسقيا داود" سماه بـ (الشيخ). وتحدّث كل من "السعدي" و"أحمد بابا" عن عدد ممّن أخذا عليهم، فوصفَا من درّسوهما الكتبَ المُفصّلة الكبيرة فى مادة ما، مثل "ألفية ابن مالك" و"العاصمية" بـ (الأساتذة)، ووصفا اللذين كانا قد أخذا عليهم مثل "الرسالة" و"ابن عاشر" و"الأجرومية" بـ (الأشياخ)، وهناك فريق ثالث كانا قد أخذا عليهم، مثل الأجرومية والألفية معا، أو الرسالة وخليل، فوصفاهما بـ (شیخي وأستاذي). المناهج رأت مناهج التّدريس منحى وحدويًّا بين كل البلدان الإسلامية، وخاصة منذ القرن الرابع الهجري. وكان العُرف السائد والجاري به العمل، هو أن التلميذ يدخل الكُتّاب أوّلا، لتعلّم القراءة والكتابة والخط ويحفظ شيئا من القرآن، وقد تساعد إمكانيات المعلّم على تلقينه أوّليات في الفرائض والحساب واللغة أيضًا، على أن هذا كان قليل الحصول في بلاد المغرب العربي على ما يظهر، وظل يغلب على منهج المغاربة في المرحلة الابتدائية الاقتصار على تحفيظ القرآن مع تعليم الكتابة والخط. وبما أنّ السودانيين أخذوا أساليب التعليم مباشرة عن المغاربة، فإن منهج هؤلاء هو الذي يبدو أنه ظل يجري به العمل لديهم. أما مناهج المرحلتين: الثانوية والعالية، فقد كانت واسعة حقا، وكانت المواد الأساسية فيها هي: النحو وفقه اللغة، الحديث والفقه، التفسير والتجويد، التوحيد والمنطق، ثم الحساب وشيء من العروض. وكانت المناهج في المرحلتين مرتبطة ببعضها غالبا، بمعنى أن الطالب يدرس المؤلَّفات المُبسّطة في موضوع ما خلال المرحلة الأولى (الثانوية)، ثم يتدرّج إلى دراسة المؤلفات المُفصّلة مع شروحها وحواشيها بعد ذلك وفي الموضوع نفسه. ومن المؤكد أنّ المناهج كانت تشمل صفوة ما بلغته الحضارة الإسلامية في ميدان المعارف، غير أنه لا يبدو أن تلك المناهج قد عصمت الناس من بعض الانحراف، ذلك أن المتتبّع لسيرة غالبية المدرّسين في "تمبكتو" خلال تلك الفترة، يجد لديهم نوعا من الصوفية المبالغ فيها، ممّا حمل الكثيرين من بينهم يعتقدون بالغيبيات، ويعملون لحمل الناس على تصديقهم، وكان المتخرّجون على أيديهم يتطبّعون بتلك الروح في الغالب. زخرَت كتابات كل من "أحمد بابا"، و"عبد الرحمان السعدي" و"محمود كعت"، أثناء الحديث عن أشياخهم وأساتذتهم، بذكر كل ما كان يدّعي معظمهم الاتصاف به من "معرفة الغيب" و(انطباق ما يرونه في المنام على واقع المستقبل)، و(توقيفهم لنزول المطر على طلابهم حين يجتمعون بهم في العراء)، أو مثل (انفتاح باب قبر الرسول على مصراعيه لأحدهم حين الحج)، و(انشقاق مياه النيجر إلى شطرين أثناء عبور آخر للنهر)، وغير ذلك.. وهم يفسّرون هذا دائما بكون أولئك العلماء الذين تتّفق لهم مثل تلك الخوارق من (أولياء الله). ولعل مردّ ذلك كله إلى بقاء الروح الأسطورية القديمة في النفوس، وليس لما ذهب إليه "الأسقيا محمد" في رسالته إلى "المغيلي" مثلا من أن العلماء في بلاده لا يفهمون العربية فهمًا جيدا، ثم يؤدّي بهم الادّعاء إلى القول بما ليس في القرآن، لأنّ أولئك المدرّسين كان يبدو من أعمالهم التضلّع الكافي بما يدرسون، وقد ترك أغلبهم شروحًا وحواشي للمواد التي كانوا يدرّسونها وقد قيّدها عليهم طلابهم، وبقيت موجودة حتى الآن وهي تؤكد تضلّعهم في العربية وفي المواد التي كانوا يدرّسونها. إضاءات حول المناهج الدراسية يذكر العلامة "ابن خلدون" في تاريخه اختلافا بين المغاربة والمشارقة في مناهج التدريس، فحواه أن المغاربة يبدؤون بتحفيظ القرآن قبل أيّ شيء آخر، في حين كان المشارقة يجمعون إلى ذلك بقية الفعاليات التي توصل التلميذ إلى الفهم. لم تسعفنا المصادر بما يؤكد أو ينفي الافتراض بأنّ الطب كان من المواد التي تحتويها المناهج، مع وجود إشارات إلى تداول كتاب "السيوطي" في الطب بين الناس، كما أن عددا من مرضى العيون كانوا يقصدون الأساتذة المشهورين بـ (قدح العيون) على حد تعبير "محمود كعت"، وكانوا حينما يجدون على أيديهم الشفاء يقدّمون لهم كثيرا من الهدايا. أما العروض (أوزان الشعر)، فبالرغم من أنه كان من المواد التي تُدرَّس، إلا أن إنتاج السودانيين في ميدان الشعر ظل ضعيفا في تلك الفترة، ولعل مردّ ذلك إلى أن أساس الإنتاج الشعري لا تكفي فيه معرفة القواعد وحدها! ممّا يلفت النظر أن عددًا من المؤلفات المغاربية عُرفت في "تمبكتو" خلال تلك الفترة، ولم تعرف في المشرق، مثل: "جامع المعيار" للونشريسي و"أرجوزة المغيلي" في المنطق، فقد كانا من بين المُصنّفات التي كان يتناولها المدرِّسون بالشرح لطلابهم في مساجد "تمبكتو"، في حين أن كتب المشارقة عُرفت كلها، سواء في المغرب العربي أو في السودان الغربي.