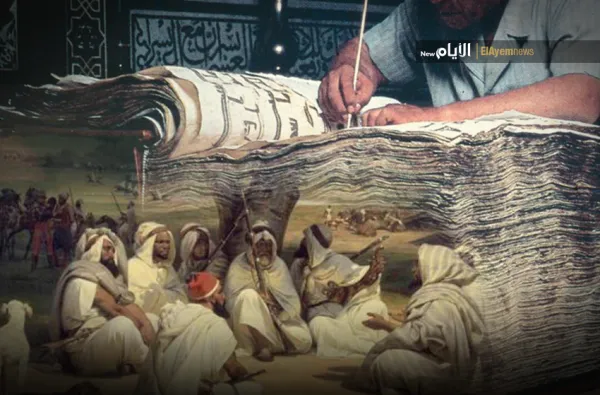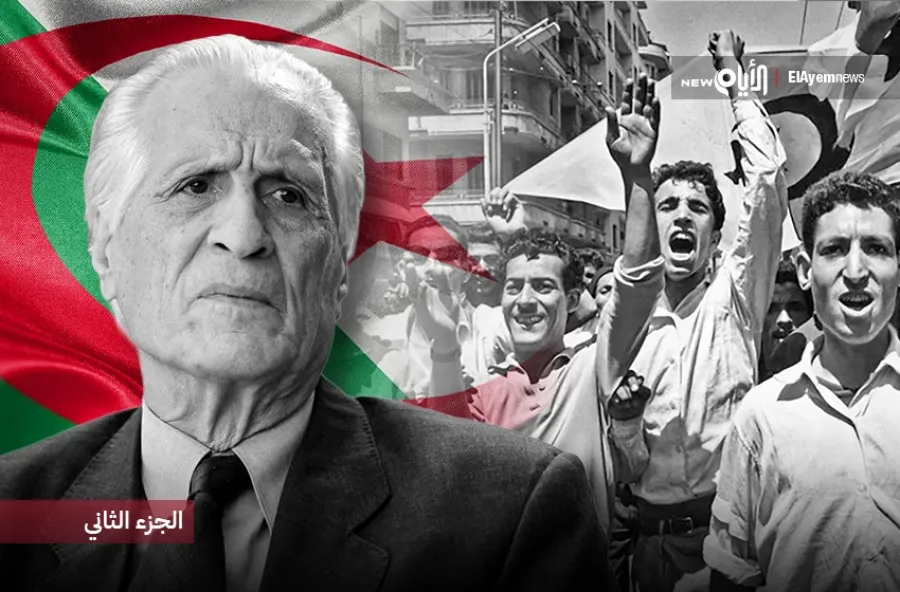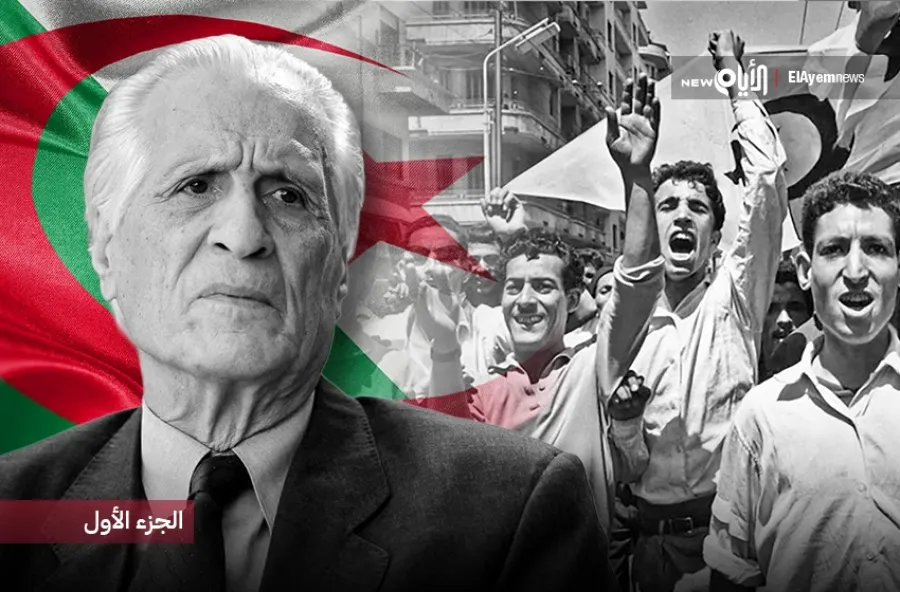سُئِل الشيخ العلاّمة "عبد الرحمان الجيلالي" عن سبب تأليفه لكتاب "تاريخ الجزائر العام" الذي صدر سنة 1953، فأجاب قائلا: "لأنني رأيتُ الجزائر مهضومة التاريخ، كتبتُ تاريخ الجزائر". وسبَقَه الشيخ "مبارك بن محمد الميلي" بكتابه "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" الذي ظهر الجزء الأول منه سنة 1928 واعتبره الإمام "ابن باديس" بأنه "بعثٌ لحياة الأمة الجزائرية". وكذلك أصْدَر "أحمد توفيق المدني" كتابه "كتاب الجزائر" سنة 1932 ردًّا على الاحتفالات الفرنسية بمئوية احتلالها للجزائر. إضافة إلى عشرات المقالات التي تَحدّتْ الاستعمار الفرنسي، وأرادت التأسيس لكتابة تاريخية جزائرية وطنية تُعرّف الجزائريين بتاريخهم الحقيقي الذي عملت فرنسا على تشويهه وتحريفه وتزييفه. التاريخ المُحرّم كانت الكتابة عن التاريخ الجزائري بأبعاده الإسلامية والعربية من "المُحرّمات" والجرائم التي يُعاقب عليها الاستعمار الفرنسي، لا سيما بعد أن أصدر سنة 1904 قانون المنظومة التعليمية الذي يستبعد من التعليم الحرّ كل ما يتعلّق بالتاريخ الإسلامي والوطني وجغرافية الجزائر الطبيعية والبشرية. وقد كان عددُ المؤرّخين الجزائريين قليلٌ جدا، ولا يستطيع المؤرّخ الجزائري أن يكتب ما يتعارض أو يتصادم مع الكتابات الفرنسية عن الجزائر في المدارس والإعلام والمطبوعات. أقلامٌ جزائرية مُغامِرةٌ ظهرت أقلامٌ جزائريةٌ "غامرت" بكتابة تاريخ الجزائر، لا سيما في المرحلة التي تبلورت فيها الحركة الإصلاحية ونشطت فيها جمعية العلماء المُسلمين. وكانت الكتابات تهدف إلى إعادة بعث الهوية الجزائرية بكل أبعادها الإسلامية والعربية والثقافية، وفي هذا السياق، اعتبر الإمام "عبد الحميد بن باديس" كتاب "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" للشيخ "مبارك الميلي" بأنّه "بعثٌ لحياة الأمة الجزائرية". كما أن الشيخ "عبد الرحمان الجيلالي" قال بأن الهدف من تأليفه لكتابه "تاريخ الجزائر العام" هو بثّ الوعي القومي لدى الجزائريين، وإثارة الشعور فيهم وهم يقرؤون الكتاب بأنهم ينتمون إلى أمة تمتلك "تاريخا ماجِدًا تستطيع أن تفتخر به". الجيل الأوّل من المُؤرّخين الجزائريين يُمكن اعتبار سنة 1930 هي الحدّ الفاصل بين جيلين من الكّتاب الجزائريين الذين كتبوا عن تاريخ الجزائر، وأصدروا كتبهم مطبوعةً. فالجيل الأول كان قبل سنة 1930 من حيث نشره لكتبه "التاريخية"، ومن أهمّ أسمائه نذكُرُ الدكتور العلاّمة "محمد بن أبي شنب" (1869-1929م) صاحب الكُتُب المُحَقَّقة: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم التلمساني (نُشِر 1908)، عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة في بجاية للغبريني (نُشِر 1910)، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (نُشِر 1920). كما نذكُر، من ذلك الجيل، المؤرّخ ومفتي المالكية "أبو القاسم الحفناوي" (1852-1943م) صاحب كتاب "تعريف الخلف برجال السلف". ويُلاحظ أن الكاتبيْن ركّزا على التأريخ لعلماء وأعلام الجزائر في مراحل معيّنة من تاريخ الجزائر، وكُتبهما ما زالت تمثّل مراجع مهمّة للباحثين والدارسين. بمعنى أنّهما لم يقوما بإنجاز كتابة تاريخية جزائرية تُعرّي وتفضح الكتابات الفرنسية التي سعت إلى عزل الجزائر عن انتمائها الوطني والعربي والإسلامي، وكانت، تلك الكتابات، أقرب إلى إحياء التراث الجزائري وبعث علمائه ورموزه، والأمر لا يخلو من قيمة، آنذاك، تُؤكّد بأن الجزائر لها تاريخها وثقافتها وفنونها، عكس ما كان الاستعمار الفرنسي يزعمه ويسعى إلى طمسه ومَحوِه. الجيل الثاني من المؤرخين الجزائريين الجيل الثاني من المؤرّخين الجزائريين، ظهرت كتاباته قبيل وبعد سنة 1930 وهي السنة التي أعلنت فيها فرنسا عن احتفالاتها المئوية باحتلال الجزائر، وظهرت بالتَّزامن معها أو في سياق الاحتفالات ذاتها، بعض الكتابات الفرنسية المُستفزّة للفكر والوجدان الجزائري، مثل كتاب "أسلمة إفريقيا الشمالية، القرون المظلمة للمغرب"، وكتاب "بلاد البربر الإسلامي والمشرق في العصر الوسيط". وقد تكون الكتابات التاريخية الجزائرية للجيل الثاني قد ظهرت كَرِدّة فعل على الاحتفالات المئوية الفرنسية، وردًّا على كتابات الفرنسيين، ولكنها تُمثّل انطلاقة حقيقية لكتابة التاريخ الجزائري بمنهجية تُدرك أهدافها وغاياتها، وتصبّ في سياق الحركة الإصلاحية التي ركّزت أعمالها ونشاطاتها على إحياء الأمة الجزائرية واستنهاض فكرها وبعث موروثها في مواجهات المُخطّطات الاستعمارية. المؤرّخ التونسي "عثمان الكعاك" مَثّلت كتابات الجيل الثاني من المؤرّخين الجزائريين بداية المواجهة الفعلية مع الاستعمار الفرنسي، ودحض افتراءاته وأكاذيبه التي ابتدعها لتزوير وتشويه التاريخ الجزائري. وقد برزت أسماءُ "مبارك الميلي" و"أحمد توفيق المدني" و"عبد الرحمان الجيلالي"، وأسماءٌ أخرى من جمعية العلماء المسلمين، دون أن نغفل ذكْر التونسي الشيخ "عثمان الكعاك" الذي أصدر كتابا في التاريخ الوطني الجزائري سنة 1925 تحت عنوان "موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي". لم يكن هناك كُتبٌ ومراجع لتدريس التاريخ الجزائري في المدارس الحرة، لا سيما مدارس جمعية العلماء المُسلمين، فكل الكتابات والكتب كانت مُوجّهةً من طرف الاستعمار الفرنسي وتخدم غاياته وأهدافه. وقد كان ظهور كتب للتاريخ الوطني الجزائري "فتحًا" كبيرا وقوة داعمة لحركة الإصلاح وتنشئة الجزائريين على تاريخهم الحقيقي. وفي هذا السياق، كشف العلاّمة "عبد الرحمان الجيلالي" بأنه كان يجد صعوبة شديدة في تدريس تاريخ الجزائر "الحقيقي" عندما كان مُعلمًا في مدرسة الشبيبة الإسلامية، وقال بأن كتاب "مختصر تاريخ الجزائر العام" للمؤرخ التونسي "عثمان الكعاك" (1903-1976م) هو الكتاب الوحيد الذي كان متوفّرا، آنذاك، باللغة العربية، وهذا من الأسباب التي دفعتْه إلى تأليف كتابه "تاريخ الجزائر العام". سؤال في الكتابة التاريخية الوطنية والسؤال المُلحّ هو: كيف استطاع المؤرّخون الجزائريون، في تلك الفترة، من تأليف كتُبٌ في التاريخ الوطني الجزائري، رغم قلة أو ندرة المراجع التي يمكنهم الاستناد عليها، إضافة إلى ظروف "الحصار" التي فرضها الاستعمار الفرنسي على هذا النوع من الكتابات التي تُجدّد الأمة الجزائرية وتبعثها من جديد بأبعادها الوطنية والإسلامية والعربية؟ سنترك الإجابة إلى موضوعات قادمة نُبحر فيها مع بعض تلك الكتب، لنَقِفَ على مدى الجهد والتضحية و"المغامرة" التي تحمّل مسؤوليتها رُوّاد الكتابة التاريخية الجزائرية الوطنية.